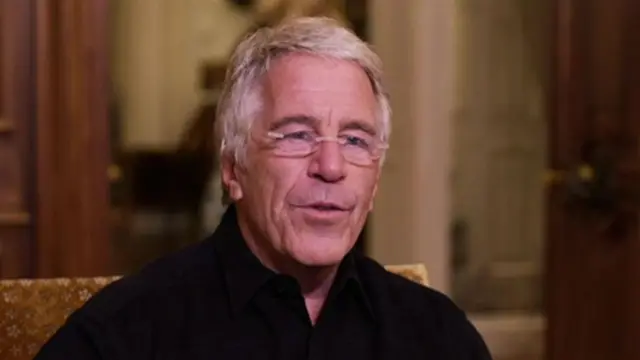الأوبئة - المغرب المعاصر - كورونا هذه أهم الأوبئة التي عرفها المغرب المعاصر وهكذا تم علاجها

-

تيلي ماروك
نشرت في : 29/04/2020ينتمي تاريخ الأوبئة لما يمكن تسميته بالتاريخ المنسي، وهو التاريخ الذي لا نجده حاضرا بقوة عند جل الإخباريين والمؤرخين منذ العصر الوسيط إلى حدود الفترة المعاصرة، بحيث هيمنت في مصادرهم ومراجعهم الوقائع السياسية والعسكرية، مع التركيز على تاريخ الأسر الحاكمة بدل «العامة» والمراكز بدل الهوامش والانتصارات بدل الهزائم، وقد شهد المغرب على امتداد تاريخه أزمات حادة، تنوعت بين الأوبئة والمجاعات والجفاف والقحط، مخلفة هزات قوية ساهمت بدرجة كبيرة في تأخر المغرب. سوف تركز هذه المساهمة على جانب الأوبئة خلال فترة «الحماية» على وجه التحديد وتتوقف عند أهم الأوبئة التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة وطرق العلاج المعتمدة قبيل وفي ظل الاستعمار، ثم طبيعة السياسة الصحية الكولونيالية الفرنسية بالمغرب.

جوائح وأوبئة متتالية
كانت الأزمات الاقتصادية والديمغرافية قبل فترة الاستعمار المباشر للمغرب تشكل معطى بنيويا، كان له تأثيره العميق على تطور البلاد. فخلال السنوات الممتدة من 1847 و1851 تعرض المغرب لأزمة غذائية حادة تزامنت مع الجفاف الذي تسبب في ضياع المحاصيل وغلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للساكنة ونضوب المراعي وموت الدواب، إلخ.. وفي الفترتين 1854-1855 و1859-1860 ستظهر موجة جديدة لوباء الكوليرا، الذي كان يُهلِك المئات يوميا، خصوصا في مدينة فاس والدار البيضاء وسلا وتطوان، مما أدى إلى خلق حالة من الفزع، جعلت السكان يهربون من مدنهم، فيموتون في الطرق. بعدها توالت الأزمات، وصولا إلى 1878-1883، حيث ستظهر كارثة كبرى أدت إلى نتائج فظيعة، أبرزها المجاعة والجفاف وانتشار أمراض الكوليرا والجدري وتيفوئيد. وقد أورد المختار السوسي في الجزء 15 من كتابه «المعسول» نصا للفقيه محمد بن عبد الله البوشواري حول هذه الأزمة، جاء فيه: «ومما وقع في هذا العام (1295ه/1878م) أن بني عمران (أيت با عمران) قد أكلوا لحوم الموتى وجبدوهم من القبور وأكلوهم. وقيل لي بعث واحد منهم إلى امرأة جسيمة ضخمة حتى وصلته فذبحها وأكلها... وكم من إنسان قتل ولده فأكله. وكم من واحد طرح ولده الصغير في موضع وتركه عرضة للضياع. وأكلت القبائل أموال المرابطين في السهل..».
لم ينته مسلسل الجوائح والأوبئة عند هذا الحد، بل استمر خلال السنوات اللاحقة مخلفا خسائر طبيعية وبشرية، نتج عنها الركود الديمغرافي والفقر والبطالة والهجرة ولم يعد -أمام هذا الوضع- جزء كبير من السكان قادرا على التحمل، فانتفضت العديد من المناطق، مثل الشاوية، دكالة، الرحامنة ومزاب، وغيرها...
استعمار فرنسي وزكام إسباني
خلال فترة «الحماية»، استمرت الكوارث والأوبئة رغم توفر الإدارة الاستعمارية على وسائل متطورة في مجال الطب. ففي السنوات الأولى بعد توقيع المعاهدة قضى الطاعون بمنطقة الشاوية لوحدها على ما يقارب 10000 شخصا، وذلك خلال سنتي 1911 و1912، وخلال السنة الموالية عرف المغرب وباء التيفوس وحمى المستنقعات (Paludisme) خلفا كل يوم مئات الضحايا في ربوع البلاد، وبعدها بخمس سنوات (1918-1919) حل الزكام الاسباني، وهو نوع من الطاعون الرئوي (Peste pulmonaire)، انتشر في صفوف الجنود والأطباء والممرضين ولم يسلم منه حتى كبار الموظفين الإداريين والعسكريين (مثل صامويل بيارني Samuel Biarnay رئيس مصلحة الأحباس والكولونيل هنري بيريو H. Berriau رئيس مصلحة الاستخبارات..)، محدثا حالة من الفزع بمدينتي الدار البيضاء وطنجة وغيرهما.
عاود مرض التيفوس الانتشار مجددا سنة 1928، خصوصا بمنطقة وادي زم، مخلفا العديد من الموتى، ومن بين الإجراءات الوقائية التي دعت إلى اتخاذها مصالح إدارة الاستعمار الفرنسي المعنية التأكيد على أهمية النظافة وضرورة استحمام السجناء والعمال واستعمال الوسائل المطهرة من الجراثيم، كما عملت على عزل الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض وتقنين وسائل النقل، وبناء عليه تم منع «الأهالي»المغاربة من مغادرة وادي زم صوب البيضاء أو تادلا بدون رخصة وإقفال السوق الأسبوعي. وفي صيف نفس السنة سوف تنتشر حمى المستنقعات في مناطق واسعة من المغرب، حيث قدرت بعض الجرائد إصابة 50 % من المغاربة المقيمين في منطقة النفوذ الفرنسي و30 % على الأقل من الأوربيين (هذه النسب تضمنها مقال نشرته جريدة Le Cri Marocain بتاريخ 06 أكتوبر 1928، يحمل عنوان «الوضعية الصحية»)، وقد كانت مدينة الدار البيضاء الأكثر تضررا، حيث فقدت نصف اليد العاملة المحلية وشُلت مصانعها وركدت تجارتها وجل أنشطتها الاقتصادية.

ليوطي يؤسس هيئة صحية
أولت إدارة الاستعمار الفرنسي أهمية بالغة للمجال الصحي، فعند تولي الجنرال ليوطي المسؤولية كمقيم عام سنة 1912 أسس هيئة صحية خاصة بالفرق العسكرية (Assitance d'Etat du service desanté des troupes) وشيد المستشفيات وعمل على توفير الأدوية والمضادات، وفي هذا الإطار تم تأسيس معهد باستور بالرباط، فاستطاع الطب الكولونيالي الفرنسي بذلك محاصرة العديد من الأمراض مثل الزهري والرمد وأمراض العيون والقضاء على الطاعون والكوليرا ثم الحد من أضرار التيفوس. علما أن عدد الأطباء كان قليلا، بحيث يشير أحمد تفاسكا في كتابه «تطور الحركة العمالية في المغرب» أن المغرب لم يكن سنة 1925 سوى على 133 طبيبا، منهم طبيبان عربيان، 28 صيدليا (ضمنهم صيدلي عربي واحد)، 12 طبيب أسنان، 40 مولدة و3 عقاقيريين، بالإضافة إلى 12 صيدليا و11 طبيب أسنان سمح لهم بممارسة المهنة رغم عدم توفرهم على شهادات علمية تخول لهم ذلك، تمركز جميعهم في مناطق تجمع الجاليات الأوربية في المدن الكبرى والمناطق الزراعية الخصبة.
يضيف تفاسكا أن المغرب خلال سنة 1928 كان يتوفر على معدل طبيب واحد لكل 36790 نسمة، وبالنسبة للجالية الأوربية طبيب لكل 787 نسمة والجالية الفرنسية لوحدها طبيب لكل 738 نسمة. أما بالنسبة للمغاربة فالمعدل هو طبيب لكل 36010 نسمة (المعدلات لا تشمل أفراد الجيش الفرنسي)،هذا وقد ارتفع عدد العاملين في قطاع الصحة سنة 1936 ليبلغ 202 طبيبا، 72 صيدليا، 69 طبيب أسنان، 111 مولدة و5 عقاقيريين.
أبحاث ودراسات علمية
ستعمل فرنسا بهذه الإمكانيات على محاربة الأمراض والأوبئة، فحثت المتخصصين على إعداد الأبحاث والدراسات العلمية حولها، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الأبحاث حول مرض الجذام المعدي لوحده 89 بحثا قام بها أشهر الأطباء والمراقبين المدنيين الفرنسيين وأبحاث أخرى حول داء البرص والفذة الدرقية ومرض الزهري، وأقيمت ثلاثة مراكز استشفائية في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش بهدف مكافحته، كما شرعت سلطات الاستعمار الفرنسي في تعيين أطباء متخصصين في الأمراض التناسلية. هذه الأخيرة التي أنجزت حولها خلال الثلاثينات والأربعينات العديد من التقارير، أكدت ارتفاع عدد المصابين بها (مرض الزهري على وجه التحديد)، لتقوم بتنظيم ومراقبة الدعارة باعتبارها مصدر رئيسي للإصابة بالزهري وانتشاره، وذلك بفحص «العاهرات» ومعالجة المصابين وإقامة المستوصفات والقيام بحملات التوعية. في حين انصب اهتمام بعض الأطباء على داء الرمد، فابتدأت الدراسات حوله بشكل رسمي سنة 1927.
كان الغرض من وراء إنجاز الدراسات العلمية حول الأمراض والأوبئة في المغرب هو درء الأخطار التي قد تمس المستعمرِين في المقام الأول وقد تم إشراك المغاربة بشكل محدود. أما بخصوص المرافق الصحية، فقد شرعت الإقامة العامة في إقامتها منذ توقيع معاهدة «الحماية»، بحيث تم تشييد مستشفيات جهوية في مازكان (الجديدة) والرباط وعيادات في الدار البيضاء وبور ليوطي (القنيطرة) ثم شملت الغرب والمغرب الشرقي، وذلك بالموازاة مع عمليات التوسع الاستعماري، كما تم إنشاء مصنع لإنتاج اللقاح في الرباط سنة 1913 وفي سنة 1919 سيتم الرفع من ميزانية قطاع الصحة وإحداث مجموعات طبية متنقلة في أقصى شمال منطقة النفوذ الفرنسي (تازة وورغة العليا) سنة 1924.
إجراءات قاسية لمنع تفشي الأوبئة
لقد أقامت المصالح الصحية التابعة للإقامة العامة الفرنسية نطاقات صحية قاسية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة وضبطت الهجرات التي كانت تتم من الشمال صوب الجنوب فرارا من المجاعات والأمراض ونظمت عمليات التلقيح في المدن والبوادي المغربية، وقد انزعج المغاربة من هذه الإجراءات ونفروا من عمليات التجميع القسري عندما ظهر وباء التيفوس وفروا من هذه الأماكن. ويؤكد ألبير عياش ذلك في كتابه «المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية»، حيث أشار إلى الحذر المتعاظم الذي أبداه المغاربة حيال التجمع التعسفي الذي كانت تأمر به السلطات الاستعمارية دون أي اعتبار إنساني، مضيفا أن أطباء الصحة العمومية سجلوا في محاضرهم نفور المغاربة من هذا النوع من التجميع. وفي نفس الصدد، أثناء السنوات التي عمت الكوارث والأوبئة بقوة (1937، 1938، 1944 و1945) قامت المصالح الصحية الاستعمارية بترحيل وطرد جماعيين للمرضى المغاربة من المدن (الساحلية منها خصوصا).
لقد أقام الاستعمار الفرنسي التمييز في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المغاربة والأوربيين، فعلى سبيل المثال، أقامت السلطات التابعة للإقامة العامة مستشفى «لوسي» (مولاي اسماعيل حاليا) سنة 1911 لاستقبال الجنود الفرنسيين الجرحى أثناء عمليات الغزو الأولى، ثم صار يقدم خدمات علاجية لكافة الأوربيين بمدينة مكناس، في حين تم تأسيس «المستوصف الأهلي» الصغير المعروف بمستوصف Poulain لاستقبال المغاربة.
لقد تعرض المغرب على امتداد تاريخه لأصناف من الأوبئة والجوائح والسِّغاب، كانت على درجة كبيرة من الشدة والقسوة، عانى على إثرها المغاربة من فتك ونزيف حادين، لكن كان دائما الجانب المشرق خلال الأزمات في بعض الفترات، هو صمودهم وتحليهم بروح التضامن والتآزر واللحمة.

هنا نستعرض أشكال العلاج/المداواة التي كانت سائدة خلال الفترة التي سبقتها والتي استمرت خلال فترة الاستعمار وما بعده.. حيث كان يعتقد جزء كبير من المغاربة أن الأمراض تأتي من كائنات غير مرئية كالجن والعفاريت أو من «العين» والسحر و»التوكال»، وهي في آخر المطاف قضاء من عند الله.
من طرق العلاج التي وجد الفرنسيون المغاربة يتعاطونها، ما يلي:
– الاستطباب بالكتابة: وهي عملية يقوم بها «لفقيه» للمريض بعدما يحصل منه على المعلومات المتعلقة به وبمرضه، فيكتب آيات قرآنية وجملا غير مفهومة ويرسم الجداول في حرز مربع أو مستطيل الشكل ويقدمه للمريض لارتدائه أو وضعه في الماء واحتسائه أو حرقه واستنشاق دخانه... وقد احترفها العديد من الدجالين والمشعوذين، مستغلين محدودية وعي أشخاص في وضعية المرض.
– العلاج بالحيوانات والحشرات والطيور: كان بعض المغاربة حين يصابون بالحمى يحرقون الصراصير ويستنشقون دخانها، وعند الإصابة بأمراض مزمنة أكلوا السلحفاة المطبوخة مع الكسكس لعلاج مرض الزهري، واللقلاق لعلاج النوار..
– الاستشفاء بالحامات: وهي العيون الحارة المساعدة التي كان يُعتقد أنها تساعد على علاج بعض الأمراض، مثل حامة «مولاي يعقوب» التي تقع بالقرب من فاس، والتي كانت مركزا يقصده المرضى من كل المناطق لعلاج عدة أمراض، مثل الجذام، البرص، الزهري والمفاصل، إلخ...
– الاستشفاء ببركة الأولياء: كان لدى جل المغاربة اعتقاد راسخ أن «الأولياء الصالحين» يجلبون اليمن والبركات ويقضون حوائجهم ويشفونهم من الأمراض.
التداوي بالكي: كان الكي وسيلة لعلاج عرق النساء (Sciatique) والحمى وأمراض المعدة باستعمال آلات حديدية محماة بالنار، يتم وخز المريض بها في البطن أو أعلى العنق..
الاستطباب بالجراحة: كانت عمليات الجراحة خلال هذه الفترة تقليدية، خصوصا الحجامة، حيث يقوم المعالج بشفط الدماء التي تعيق سير الدورة الدموية بواسطة «المحجبة» (قارورة من الزنك أو الزجاج أو الخشب..)، ثم «الفصد»، حيث كان يُشق العضو الملدوغ للمريض باستخدام شفرات حادة.