الأدب المغربي المُهاجر في الأدب المغربي المُهاجر
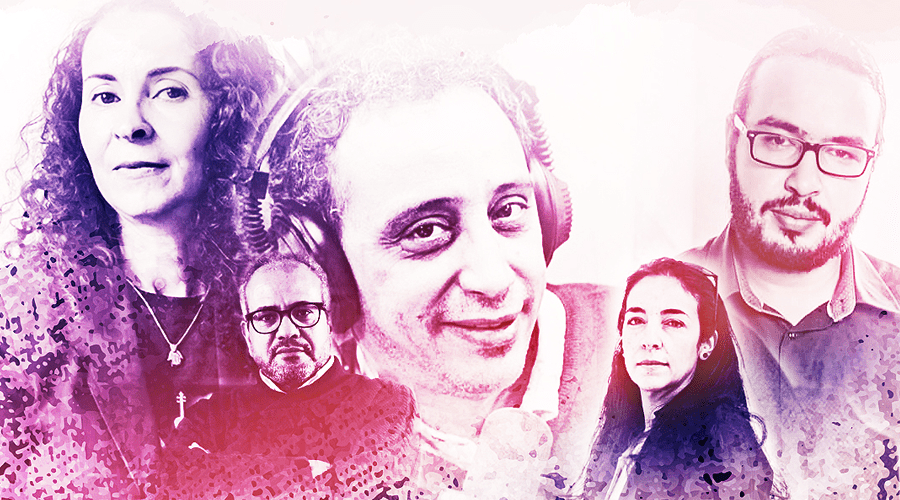
-

Télé Maroc
نشرت في : 11/02/2022
أصبح الأدب المغربي في المهجر ظاهرة ملموسة تتزايد أكثر بسبب عدة عوامل قد تكون الصدفة أحيانا عاملا أساسيا، وقد تكون أيضا لأسباب قسرية أحيانا أخرى. غير أنه من الملاحظ أنّ هذا الأدب المهجري عرف عدة تحولات من أهمها أنّه لم يعد مقتصرا على مجال الشعر بل أصبح يقتحم مجالات عدة كالسرد الروائي والقصصي والكتابة السينمائية والمسرحية، إضافة إلى الكتابة بلغات المهجر بكل ما تعنيه هذه التجربة من مرارة الغربة من جهة، والمعاناة من صعوبة الاندماج وإشكالات الهوية من جهة أخرى...إنّ الكتابة من موقع الهجرة لا تحمل فقط هموم الهجرة وما يحيط بها من غربة وإشكالات مرتبطة بها، بل بالدرجة الأولى همّ البعد عن المشهد الثقافي والإبداعي لأرض الوطن حيث يعيش عزلة مضاعفة في دار الهجرة أولا وفي أرض الوطن ثانية. لكن ميزة هذا الأدب التي يحققها رغم حجم المعاناة وقسوة البعد وانعدام شروط تواصله وتفاعله مع محيطه الطبيعي في المغرب أو في الديار المهجرية، تتمثل في كونه يلقي الضوء على عالم آخر وواقع مغاير تماما، تبرز فيه تلك العلاقة الشائكة والملتبسة بين الأنا والآخر، التي تسعى إلى ترميمها على شكل مواطنة جديدة تكسّر الحدود بين هوية منغرسة في تربتها وعالم جديد، هو عالم الهجرة. لذلك، ورغم البعد الجغرافي والسياق الثقافي الذي يندرج فيه بات الآن، من المؤكد والضروري الأخذ بعين الاعتبار هذا الأدب المهجري بوصفه مكونا من مكونات الأدب المغربي ورافدا من روافده بإمكانه أن يشكل إضافة أخرى تعكس صورة للشخصية المغربية في مختلف أبعادها.
هشام ناجح: لا أحد يغترب عبثا
عندما نحلق عاليا، ندرك هشاشتنا الذاتية، وتحدونا الرغبة في معانقة الحياة على أديم الأرض كلوعة مبهمة، كأننا لم نعرف صفة المشي يوما. إنها اللحظة الحقيقية لتقويم الانهيارات؛ لهذا كانت والدتي تعلم ثقل هذه اللحظة، كلما تعبت من شقاوتي، وقرفت من سلوكاتي، تدعو أن يعطيني الله طيّارة إن شاء. أخيرا استجاب الله لدعوتها، وأنا في عمر النبوة. الطائرة وجهتنا نحو الآفاق اللامتناهية. نحن لا نغترب عبثا. ثمة ظروف تحددها سياقات منسوجة في مستودعات الروح. إنها النداءات الخاصة التي كانت تدعوني من الهناك، بعدما انفلت الوطن من بين يدي، وأعطاني بظهره، شاهرا في وجهي سبابته بحركة بذيئة. الوطن الذي لم يعد يرغب في، ولم أعد أرغب فيه. ذقت فيه أبشع أيام التشرد والجوع وظلم القربى. الطائرة تشق السحاب في تماه مع أبهتي المؤجلة. أرقب الانتقال السامي، مستبدلا كلمة الوطن بـ «المشروع»، وفق المفهوم الغرامشي.
لقد حل الصباح بداخلي. أمشي.. أمشي، وأمشي، والعمة فرنسا باسطة يدها وجسدها وعيونها الخضراء والزرقاء الفاتنة، الفتانة. تدعوني بأن أتصالح مع جسدي، ولغتي، بعيدا عن عقدة الاستذناب.
يا إلهي حل الليل أيضا بداخلي. لا مجال للسواد والأحلام الخبيئة. نور على نور.. أمشي.. أمشي، وأمشي، وليل العمة فرنسا ينحني من الزهو، يتمايل من فرط النشوة، ليس كليل الوطن عندما تعوي كلابه الجائعة السفاحة.
أمشي.. أمشي، وأمشي، وأنا أرقب الفجر على جادة نهر «لادور»، متنسما روائح الكرواسون والقهوة، ومتنغما بأطيط أحذية العمال وهم يخدشون جلال الصمت.
أمشي... أمشي، وأمشي ودار الهجرة تفتح بابها لعشيقتي اللعوب السيدة الكتابة، تبدو نشوى هي الأخرى؛ من جلاء المعاينة، والتنفس من جوهر ذاتها. الكتابة الحقة هي التي تزحزح غبار التمثلات، وتغترب لتتجدد. يا لعظمة القلم المهاجر أو المسافر الذي يسفر عن الأقنعة التي تطبع وجهه منزل الحضر عن مكانه، ومنزل الخفض عن نفسه. يا لعظمة المساحات الشاسعات من الحرية المتنامية داخل كينونة الكتابة. إن الهجرة تعيد تركيبات الذاكرة والمخيال والاستحضار تحت يافطة «اكتب من أنت لتعرف من أنت». وتلقي بك إلى أتون الانغمارات والتنويعات لتنتج ما أنت في أشد الحاجة إليه، فتمرغ وجه اللغة في وحل اللاوعي، في وحل الخبايا والخفايا النفسية، وفي خضم المشاكسات التي لا تنتهي إلا بالتسويات بينكما على طاولة توازن الرعب. منذ أن تحرر جواز سفري أدركت الكتابة مباهجها من جهة دلالة الذوق، الجمال، الحماس، والتقاطعات. على هذا النحو تشتغل الكتابة من تلقاء نفسها على مقومات الهجرة. فلكل مطار حكاية، لكل قطار حكاية، ولكل خطوة حكاية. ولنفسح المجال هذه المرة لدنيا زاد عوض شهرزاد التي استولت على الحكاية منذ البداية، حتى نترجم الصمت والإيماءات إلى سرديات مرويات.
أمشي.. أمشي وأمشي، والعمة فرنسا باسطة يدها في تماه مع أبهتي المؤجلة...
*هشام ناجح- كاتب مغربي مقيم في فرنسا
فريدة العاطفي: الهجرة والكتابةالهجرة تجربة جد مهمة في حياة من يعيشها، وتقود إلى عالم نفسي مليء بالمتناقضات، فهي من جهة اقتلاع من التربة الأصلية، ومن جهة أخرى انفتاح على عالم آخر يضم بين جدرانه عوالم عديدة ومختلفة. إذا كان علم النفس يخبرنا بأن اللاوعي هو ما يحدد قدرنا، وهو يتشكل بالأساس منذ بطن الأم وعلى امتداد الطفولة، فهذا يفسر إلى حد كبير الإحساس بالغربة والحنين الذي يصحبه معه المهاجر في سنواته الأولى، ومع مرور السنين يصبح البلد المستقبل وطنا آخر... ليعيش المهاجر تجربة نفسية يمد فيها جسرا بين بلدين وتسمى عند الكتاب والمختصين في العلوم الإنسانية تجربة بين/ بين.
بالمقابل هي دعوة للحرية والانطلاق ورغبة في مستقبل أفضل. لكنها في كل الأحوال سلبية كانت أم إيجابية تظل فرصة حقيقية للقاء عميق مع الذات واكتشاف متواصل لها يطرح الأسئلة الأكثر أهمية حول موضوع الهوية، هل هي نواة ثابتة أم بنية نفسية في تشكل مستمر؟
بالنسبة لي كانت هجرتي كما أحداث كثيرة في حياتي اختيارية وقسرية حتى أنني لا أكاد أميز الخيط الفاصل بينهما، كانت قسرية لأني هاجرت حين وجدت أن الوطن الأول لن يضمن لي العيش الكريم، ولن يؤمن لي مستقبلا، واختيارية لأنني كنت مدفوعة بعشق كبير للحرية وحساسية أكبر رافضة الظلم. قادتني هذه الحساسية إلى مجال حقوق الإنسان فأصبحت من نشيطاته وبدأت أكون خبرة، لكن لم يكن لدي تكوين قانوني، فهاجرت لدراسة حقوق الإنسان في المعهد الدولي لحقوق الإنسان بمدينة ليون الفرنسية، وبقيت فيها مدفوعة بشغف متجدد نحو أحاسيس جديدة ومختلفة بالكرامة والحرية والديموقراطية منحتها لي فرنسا. وسط هذا المد والجزر بين الجبر والاختيار بين الحزن والفرح ... هاجرت لأنتقل من مواطنة مغربية إلى إنسانة تحس أنها تنتمي للعالم بكل رحابته.
أما الكتابة فعلاقتي بها سابقة على الهجرة، أعتقد أنها مثل أشكال إبداعية أخرى تعبر عن رغبة بوح قد تكون بعيدة جدا تمتد جذورها إلى الطفولة وبطن الأم، وما قبلهما ...إلى ما قد يرثه الإنسان من صفات وأقدار لأجداد لم يعرفهم، لكنهم يصاحبونه دون أن يدري ويساهمون بأدوار متفاوتة في تشكيل قدره.
بالنسبة للأجيال التي عاشت في مجتمعات لم تكن تستمع إلى الطفل جيدا، قد تكشف الكتابة عن رغبة هذا الطفل في أن يعبر ويستمع الآخرون إليه، رغبة تظل تبحث لها عن متنفس على امتداد الحياة. الكتابة إذن سابقة على الهجرة لكن الهجرة تساهم في تحديد طبيعتها، لأنها ستؤثر على نوعية المواضيع التي يختارها الكاتب المهاجر، ونوعية الأماكن والأحداث، ومستوى الحرية التي يكتب بها، وأحيانا مستوى الجرأة، والأسئلة الوجودية والفكرية التي سيطرحها. ومن هنا خصوصية وتفرد ما يسمى بكتابة الهجرة.
*فريدة العاطفي- كاتبة مغربية مقيمة في فرنسا
عبد الإله الصالحي: شكرا جزيلا يا جيل دولوزكانوا يستشهدون بكَ
ويهمسون باسمكَ كنبي قادم من بعيد
من فمه تصدح موسيقى لا يُشَق لها غبار.فرنسيتي لم تكن تسعفني لكي أشتري حتى الخبز بشكل لائق
لكن رنين اسمكَ
في المناقشات الجانبية كان له سحر خاص
طالما أخجلني من فرط الجهل.الهجرة حق مقدس، قلتَ ذات مرة.
لم يقلها أحد قبلكَ ولم يجرأ على ترديدها أحد بعدكَ
في هذه البلاد التي تزوجناها عن حب
أنا ومحمد وعبد القادر وفاطمة
وعرب آخرون تضيق بأسمائهم المغبرة هذه القصيدة.
حتى الآن لم أعثر على أحد يشرح لي طلاسم عبارتك المبهمة.
القوانين تقول العكس من حكومة لأخرى
والبواب فرنسي من أصل برتغالي
ويحتقر الفلاسفة.كنتُ في المترو أتلصص على صفحة جريدة يقرأها أحد الركاب
كان اسمك مكتوبا بحروف بارزة وكان العنوان موتكَ.
رميتَ بنفسكَ من النافذة على ما يبدو
لماذا إذن كل الذين يحبونك حتى العمى
يعشقون الحياة أكثر من أي شيء آخر.
خجلت مرة أخرى من جهلي العميق بكَ
وكرهت نفسي بعربية فصيحة
رغم تأفف صاحب الجريدة الأسود.الهجرة حق مقدس
عبارةُ يكفي أنها قيلت ذات يوم
لكي أستيقظ كل صباح
محتميا بكَ يا دولوز.
وحدةسبعمائة ألف امرأة يعشن وحيدات في باريس.
أعمارهن تتراوح بين الثلاثين والأربعين
عازبات أو مطلقات أو
أمهات.
كان صوت المذيع في غاية الحياد
وهو يلوك هذا الرقم العادي من تفاصيل المدنية الحديثة
مختتما نشرة الأخبار.سبعمائة ألف امرأة وحيدة
يا رجل
وأنت تعذب نفسك أمام شاشة الكمبيوتر منذ ساعتين
باحثا عن جملة مناسبة تعكس بؤس العيش بدون امرأة.*عبد الإله الصالحي- شاعر وإعلامي مغربي مقيم في فرنسا
ليلى العلمي: ما رواه المغربيليلى العلمي من مواليد مدينة الرباط 1968 استكملت دراستها العليا في المغرب، وعملت مدة في الصحافة المغربية المكتوبة بالفرنسية قبل أن تنتقل إلى أمريكا لتحصل على الدكتوراه في علم اللغويات. بدأت مسيرة ليلى العلمي الإبداعية باللغة الإنجليزية بروايتها (الطفل السري) المرشحة لجائزة أورانج... إلى روايتها الشهيرة (ما رواه المغربي) التي رشحت إلى جائزة بوليتزر في الأدب التي نالت إعجاب القراء والنقاد، وتروي فيها قصة إستيفانكو الزموري المغربي الذي يعد من أوائل مستكشفي أمريكا. تقول عنها الصحافة الأمريكية عن رواية (ما رواه المغربي): «تشعر بأنّ الرواية تاريخية ومعاصرة في الوقت نفسه... سرد الحكاية في نظر ليلى العلمي هو صراع لإرادة الأقوى بين الخير والشر وحرب على النسيان. لأنّها رأت في قصة إستيفانكو عبرة روحية وأخلاقية».
حكاية لافلوريدةفي عام أربعة وثلاثين وتسعمئة بعد هجرة سيد المرسلين، وأنا أعدّ من سنّي ثلاثين عاما، ومن أسري خمسة، ألفيت نفسي على حرف الأرض التي نعرفها، في مسيرة طويلة وراء سنيور دورانتس، في أرض خضرة نضرة يسمّيها هو وقومه القشتاليون لافلوريدة. ولا علم عندي بما يسميها قومي في أزمور، فما كان منادو المدينة يرفعون عقائرهم بشيء إلّا أخبار المجاعة والزلازل والثورات جنوب بلاد البربر، ولا علم لديهم عن هذه البلاد. لكن لعلمي بأعراف التسمية لدينا نحن العرب فإني أجزم أننا كنّا سنسميها بلاد الهنود، على أنّ الهنود أنفسهم ولابدّ يسمّونها كذلك اسما بلسانهم، وإن لم يعرفه سنيور دوارنتس ولا غيره ممّن في حملتنا. وقد ذكر لي سنيور دورانتس أنّ لافلوريدة جزيرة كبيرة، أكبر من قشتالة نفسها، وأنّها تمتدّ من الساحل الذي أرسينا به إلى البحر الكاهل (المحيط الهادئ)، فمن المحيط إلى المحيط على حدّ زعمه. وكلّ هذه الأرض سيحكمها بانفيلو دي نارفاييز قائد الأسطول الحربي، وإن كنت في قرارة نفسي، ودون أن ينطق لساني بهذا الرأي، أشكّ أو أتعجّب أن يسلّم ملك إسبانية حكم أرض أكبر من بلاده لأحدٍ من رعيه.
كنّا في قافلة نقصد في مسيرنا مملكة الأبلاتشي في الشمال، وهي التي سمع عنها القائد سنيور نارفاييز من هنود أسرهم بعد أن أرست مراكب الأسطول على ساحل لافلوريدة. ورغم أنّي لم آت إلى هنا بمحض إرادتي فإني ارتحت أيّما ارتياح في اللحظة التي لمست قدماي البرّ، فقد كان في الرحلة التي قطعنا بها بحر الظلمات من المنغّصات والمكدّرات ما لا يعلمه إلّا من أسلم نفسه لسطوة البحر. فخبز الرحلة يابس، وشرابها نجس، ومظاهرها دنسة، ومع تقارب الناس في أماكن ضيقة أمدا ليس قصيرا تسوء أخلاقهم وتقبح أمزجتهم وتكثر شكاياتهم. غير أنّ أسوأ ما في الرحلة هي الرائحة، وهي رائحة زنخ أجساد الرجال إذا ما جفاها الماء مدة، واختلط بها دخان المجامر وروث الخيول وزبل الدجاج التي التصقت بحيطان الزرائب مع تنظيفها يوما بعد يوم. وإنّها لرائحة تزكم أنف المرء حالما ينزل إلى المقصورات الدنيا.
كما أن فضولي مستثار حول هذه البلاد إثر ما سمعته، أو ما تناهى إلى سمعي، من سيدي وأصحابه من أحاديث كثيرة عن الهنود، ومنها دعواهم أنّهم ذوو جلد أحمر وعيون بلا جفون، وأنّهم كفّار يدفعون البشر قرابين لآلهتهم، وأنّهم يجرعون مشارب عجيبة يصنعونها فتكشف لهم حجب الغيب، وأنّهم يسيرون هم ونساؤهم عراة لا يكسو عوراتهم شيء، وهذا ما استنكرته واستعصى عليّ تصديقه، فصرفته على أنّه من باب المبالغة والتهويل. وهذه البلاد مع ذلك أسرت خيالي حتّى لم تعد مجرّد مقصدٍ للسفر، بل أرض فيها العجائب والغرائب التي لا يستحضرها إلّا عقل أبرع الرواة في أسواق البربر. وكذا هو أثر رحلة المرء لمّا يقطع عباب بحر الظلمات، وإن كان مرغما عليها دون خيار ولا رغبة. فإنّه يهوي في مغبة مطامح الآخرين ومطامعهم إلى غير رجعة.
وكان ترك السفينة بادئ الأمر قاصرا على جمع صغير من القادة والجنود من كل مركب، ولما كان سنيور دورانتس قائد سفينتنا فقد اختار عشرين رجلا وبمعيتهم هذا الفقير إلى ربه مصطفى بن محمد للنزول، فركبنا زوارق التجديف حتى بلغنا الشاطئ. ووقف سيدي بمقدمة المركب، يضع يدا على خاصرته والأخرى على قائم سيفه، كهيئة من يقف أمام نحات ليقدّ صورته من الحجر، ويتّضح في مظهره مشاوفته إلى احتراز ثروات العالم الجديد.
سعيد أنوس: Central Stationمَرَّ مِنْ هنا التّائهون،
مَرَّ مِنْ هنا المُتعبون
والباحِثونَ عَنِ العَيْشِ
أوِ الحَقيقةِ،
مَرَّ مِنْ هنا الجائعونَ واليَتامَى
واللاّهثونَ وراءَ ثَدْيِ الْأُمَّهاتِ
الآمِلونَ في أوراقِ الإقامَةِ
والمواطنة ِالجديدةِ
المغَفَّلونَ وَالْقَتَلَةُ
تُجّارُ العُشبِ الأخضرِ
وَتُجّارُ الغُبارِ الأبيضِ
مَرَّ مِنْ هنا أولُ السُّلالاتِ
وَآخِرُ السُّلالاتِ
مَرَّ مِنْ هُنا المُعْتَقَلونَ القُدامى
في حُلَلِهِم الجديدةِ
مَرَّ مِنْ هُنا الفلاسِفَةُ
والزّنادِقةُ ..والمَلاحِدَةُ
والسَّلفيونَ ..والعَدَمِيونَ
والشّعراءُ أيضاً...
مَرَّ مِنْ هُنا الذي يقولُ - حَرامٌ -
لأيِّ فِعْلِ عَقْلٍ سَليمٍ
حالِماً بِشَريعَتِهِ الخاصَّةِ
واهِماً أنَّها شَريعَةُ اللهِ
مَرَّ مِنْ هُنا
الأجْدادُ وَالْأحْفادُ،
الأصْدقاءُ والأعْداءُ
والّذين لا طائِلَ مِنْهُم
حاصِدو الخساراتِ المُسْتَديمَةِ
حامِلو الاِكْتئابِ المُزْمِنِ
زاعِمينَ أنَّ المَنْخولْيا
لَيْسَتْ مِنْ شِيَّمِهِمْ
مَرَّ مِنْ هُنا زُنوجٌ
في بَياضِهِمُ الأنيق
تارِكينَ كُتُبَ تاريخِهِمْ عِنْدَ شُبّاكِ التَّذاكِرِ
كَما مَرَّ مُسْرِعاً رَجُلٌ أَصْفَرُ
يَحْمِلُ بِضاعَتَهُ الاِفْتِراضِيَّة...
مَرَّ مِنْ هُنا خِلاسِيّونَ وَهُنودٌ
وشَرْكَسٌ وَعِراقيونَ أَنْجادُ
فيما اللُّغاتُ تُدَحْرِجُ حِكْمَتَها
عَلى سَلالِمِ الْكهْرَباءِ
وَمَرَّ مِنْ هُنا شِتاءٌ دافِئٌ
وَ صَيْفٌ مُمْطِرٌ
وَ رَبيعٌ بارِدٌ
وَخَريفٌ بَيْنَ بَيْن .
*سعيد أنوس- شاعر مغربي مقيم في بلجيكا
محمد الزلماطي: الكتابة والهجرة.. يقينيات خاطئةكنت هناك في بروكسيل وتحديدا في السان جيل، اكتريت «استوديو» صغيرا تملكه سيدة فرنسية نحيفة من أصول أرجنتينية وزوجها القادم من جزر الأنتيل بلونه الخلاسي وبنيته القوية ورأسه الأصلع وقرطه الفضي الغليظ الذي يتدلى من إحدى أذنيه... كان مولعا بالسفر بالدراجات النارية الضخمة من نوع الهارلي والكاوازاكي.. أما الآن فإنه يرافق زوجته كل أحد لتنظيف سلالم وأدراج المسكنين اللذين يملكانهما ويكريان شققهما الصغيرة للمهاجرين الأجانب باعتبارهما فضاء مشتركا تقع مسؤولية الاهتمام به على المالك.. كنت أقطن في الطابق الثاني، وكان هناك بولوني وصومالي يقطنان الطابقين الأول والأرضي ... كان المسكنان بشققهما الصغيرة عبارة عن «بابل» أخرى.. روائح مطبخ وموسيقى ولغات مختلفة تتعايش في فضاء مشترك تقريبا!!. قبل ذلك كنت قد أقمت في فندق في منطقة «ميدي» البروكسيلية لأيام عديدة رفقة عدد من زملائي.. مكثنا فيه ريثما يتدبر كل منا أمر العثور على سكن قار.
كنت قد «هاجرت» إلى بروكسيل (بلجيكا) لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة هناك، بعد أن تم اختياري إلى جانب العديد من رجال التعليم عبر اجتياز مباراة انتقاء تنظمها وزارة التعليم، فمكثت هناك عشر سنوات كاملة.
كانت الإقامة في الفندق تتضمن وجبة الفطور، وكنا كل صباح نلاحظ أحد زملائنا ينزل من غرفته ثم يدخل مطعم الفندق وفي يده قلم ومفكرة من تلك التي تقدمها الأبناك والمؤسسات هدايا لزبنائها بمناسبة رأس سنة ميلادية جديدة... لولا أن مفكرة صديقنا كانت تعود لسنة أسبق.. كل صباح كان يدون يومياته وخواطره وربما «فرحه» بهذه الهجرة... وكان من حين لآخر يقرأ علينا ما يدونه، وبعض ما كان يعتبره شعراً.. ربما كان هذا جزءاً من تمثل خريج كلية الآداب، هذا، عن الهجرة وعلاقتها بالكتابة والإبداع، وأنها تستفز الإلهام وتصلح أعطابه وتستحث اللغة وتثيرها، وتوفر شروط ومناخات إنجاز مشاريع أدبية.. الأمر ليس بهذه البساطة الآلية. من المؤكد أن الانتقال إلى مجتمع آخر بقيم وقوانين أخرى مختلفة عما ألفناه في مجتمعنا، قد يدفع إلى مراجعة الكثير من اليقينيات التي ترسبت في سلوكنا ولا شعورنا ويغير رؤيتنا للعالم، وهذا في حد ذاته سيؤثر على ما نكتب ونبدع ولكنه لن يحقق معجزات.
ربما كان لدينا في المغرب تمثل مبالغ فيه للهجرة، وربما كان المغاربة ينظرون لمهاجريهم بإعجاب غامض. في فترة زمنية سابقة، بعيدة نوعا ما، كانت للنصوص المذيلة باسم مدينة أوروبية لكاتب مغربي مهاجر- المنشورة في الملاحق والصفحات الثقافية- نكهة استثنائية وتلقّ خاص لدينا كقراء، اليوم لم يعد الأمر كذلك. لقد تحررت النصوص من هذه العتبة المريبة.
كنت هناك، وعلى عكس ما كنت أتصور وما كان رائجا في الأوساط الثقافية في المغرب، من كون الكتاب المقيمين بالمهجر يعيشون أوضاعا جيدة ومريحة ويستفيدون مما «حفاوة» دول الإقامة ومن تقديرها واحترامها للكتاب والمبدعين... وجدت كتابا ومبدعين يتصارعون مع متطلبات الحياة، يعملون ساعات طويلة في مهن بعيدة عن عالم الأدب والثقافة، مهن قاسية أحيانا... قد لا يرضى خريج جامعة كسول بامتهانها هنا...
*محمد الزلماطي- كاتب مغربي كان مقيما في بلجيكا
محمد مسعاد: «الهجرة كتجربة دائمة»
كان السفر ذات أحدٍ من أيام الخريف. هل كان سفرا؟ أم هجرة؟ كنت متأكدا من أمر واحد. أنه لم يكن هروبا. ولو أنني لا ألوم أحدا على ذلك. هرب الكثير من كتاب ألمانيا ومبدعيها وفنانينها، من بطش الرايخ الثالث الذي استغل الديموقراطية، وحول العالم إلى جحيمٍ، أودى بحياة الملايين من البشر. هرب هؤلاء جميعا، فعاشوا وعاشت أفكارُهم.
هاجرت الأديان هجراتها الكبرى، فحافظت على نفسها. وهاجرت الأفكار فاستمرت. وحين ضاق الأفق بفيلسوف العرب ابن رشد، حمل زاده واحتمى بالآخر.
كانت الهجرة داخلي هجرات. هجرة متعددة في الزمان والمكان. هجرة فتحت اسمي الشخصي وجراحاته على آفاق أخرى. الهجرة بالنسبة لي ذات بعدين أساسيين: الأول يقوي درجة التنسيب عند المرء الذي يخلخل يقينه. أما البعد الثاني فمرتبط بالأول، بل يأتي كنتيجة له. إذ أن القدرة على التنسيب تجعل المرء قادرا على احترام اختلاف الآخر، بغض النظر عن بشرته ولسانه ومعتقداته وميولاته الجنسية. إن الهجرة، إذن، قوةٌ إبداعيةٌ بلسان جوليا كريستيفا في كتابها «الآخرون هم نحن أنفسنا».
هاجرتُ من المغرب إلى ألمانيا قبل هجرتي هذه. هاجرت منذ أن كنت طفلا، وأنا أنصت إلى ذلك الجندي المغربي الذي وجد نفسه يحارب ضد النازية. كان باصالح يحكي عن هذه الحرب التي وجد نفسه في خضمها، بكثير من الشجن.
في مرحلة أخرى، أصبحت الهجرة هجرةً نصية، تسافر بالذات نحو البعيد. حيث الآداب والفلسفة الألمانية تأخذك إلى دهاليز، لم تكن سهلة المنال، عن طريق لغة دافئةٍ وجذابةٍ وأنيقةٍ ومكثفةٍ. لغةٌ عميقةٌ، نزلت سائلة على ألسنة العظماء، من غوته إلى شيلر ومن هيغل إلى ماركس ومن هولدرلين إلى بيتهوفن، الذي حول المثالية الألمانية إلى سمفونياتٍ خالدةٍ.
هجرة تسربت إلى الداخل كجِذْرٍ ينبت في صمت. يدخل في عناق مع لغاتي المتعددة، التي غرفت منها في المغرب: العربيِّ منها والأمازيغي، المسلم واليهودي، الأندلسي وذلك الآتي من أفريقيا. مرة يأتي مسترسلا مكتوبا وأخرى تتناقله المحكيات.
نتذكر جميعا قولة «مثل خرافة صيف» التي أبدعتها الصحافة الألمانية عن صيف 2006. ذلك الصيف الذي شهد تنظيم ألمانيا لكأس العالم. كان صيفا استثنائيا بكل المقاييس. لم تفز ألمانيا بكأس العالم للأسف، ولكنها ربحت نفسها، وربحتنا جميعا، ضيوفا وأناس البلد. استطاعت ألمانيا أن تعلن رسميا وفاة عقدة الذنب، التي تملكتها في علاقتها مع ذاتها ومع الآخرين، كأنها أخذت حكمة المعلم الكبير غوته حين قال: «شعب لا يكرم غرباءه مآله الزوال».
أكاد أجازف بالقول بأنني أتحسر، لكوني لم أعِشْ معجزة الألمان وهي تهدم جدار برلين، غير أنني ألتمس التعويض في ذلك، من خلال ما حققناه جميعا عن طريق عبقرية المونديال المنظم تحت شعار: «العالم ضيفا عند الأصدقاء»، وكذلك كان.
تمكنت ألمانيا من التغلب على عقدة الذنب، وكذا على الشيزوفرينيا التي حكمتها طيلة عقود في علاقتها بمهاجريها، وذلك بعد استيعابها لمقولة الكاتب الكبير ماكس فريش: «طلبنا يدا عاملة، فجاءنا بشر».
نعم إننا بشر. جميعنا بشر، بغض النظر عن الطريق الذي سار فيه كل فرد في رحلته الكبيرة إلى الدار، التي تقيه شر الخيانة التي تسكنه. كلٌ منا خائنٌ بطبعه. يخون اليوم، ما تعلمه البارحة. الخيانة محو دائم. الإنسان في رحلة بحث دائم. الخيانة مرادف للشك. الخيانة نقيض اليقين. التنشئة الاجتماعية خيانة مستمرة. والهوية وهم لمن يريدها جامدة.
هل أنا مغربي؟ هل أنا ألماني؟ من أنا إذن؟
أنا إنسان. الوطن بالنسبة لي، ليس مجرد مكان، بل هو شعور بالأساس. أو كما قال رونيه كونيغ ذات مرة: «أنا مواطن عالمي، هاجرت مرة، سأظل مهاجرا إلى الأبد». والله ولي المسافرين.
*محمد مسعاد- كاتب مغربي مقيم في ألمانيا
جمال المعتصم بالله.. الحديقة الغربية
الحديقة الغربية تسألُني: تُرى كيف هي الآن كِتاباتك؟
1 ـ
أذهبُ إلى النافذةِ الغربية للشقّة رقم 1 على شارع ستيوارت، وأنظُرُ: أرى الأمطار تدخلُ على الصيفِ ـ على شهر غشت، غشت المحطّات، غشت الذكريات، غشت الميلاد الـ 2019. لا أضعُ أيّما رمزٍ في النافذة الغربية. إنّها بالكاملِ جغرافيا. لا علاقة للنافذة الغربية بِلُغتي. النافذةُ الغربية هي محضُ مكانٍ جغرافيٍّ، أرى من خلالِها بعضاَ من شارع ستيوارت وأمطاره القديمة والصيْفيّة، وأيضاَ أرى شارع البهجة القديم الأقدم من كلِّ عيد ميلادٍ .
2 ـ
أذهبُ إلى النافذة الغربية وأنظُرُ: لا أرى أكثر مِمّا يراهُ الغريبُ .
3 ـ
الغرباء الآن، في هذه المناسبة القديمة لا يُساعِدون الزِلزال كما في أُسطورة السيّد أحمد بركات. الغرباء الآن، في هذا العنوان الشخصيّ، يشيخون بِكلِّ حيواتِهم. الغرباء في هذه المناسبة القديمة يقِفون أمام النافذة الأُخرى، مُحاوِلين النظر إلى الحديقة ـ حديقة المنزلِ الأخير ـ الحديقة الظّلماء .
4 ـ
الغرباء القدامى، يوجدون هنا وهناك .
وحينما يذهبُ الغرباء القدامى إلى النافذة الغربية أذهبُ إليها .
أذهبُ إلى النافذةِ الغربية لِكيْ ـ أحياناَ وحين تسمحُ بذلك الأعصابُ ـ أكتُبَها .
5 ـ
خاتِمةٌ اسمها 62 :
قليلٌ منك أيُّها العمرُ .
6 ـ
خاتمةٌ اسمها أبويٌّ وطويل :
غينٌ وهي غين الغابة الأُولى .
ياءٌ تأتي في كلِّ الحروف وفي كلِّ الذكريات .
ميمٌ وهو الحرفُ الأوّلُ المفتوحُ على كلِّ شيء حيٍّ .
سينٌ وسوف أُحِبّهُ طِوال الحزنِ البحريِّ .
7 ـ
إن هي إلّا أسماءٌ
تنتابُني وأنتابُها
يوميّاً
رغم النوافذ ورغم كلِّ وثائق الهجرة إلى كندا .
*جمال المعتصم بالله- شاعر مغربي مقيم في كندا
محمد الخضيري: تحت جسر ميرابو
1
تتقن الكلمات وصف الحب. مادّيتهُ ترسمُ محيطَ اللغة. يبدأ عند حدود الجسد. يرسم الجسد كل شيء ويحدد كل شيء. تُكتَبُ القُبلة. الشَّعْرُ المتوهج، الملتف ككرات صوف. الشمس، ونجوم عند خاصرة امرأة مستلقية على أريكة. يكون الحب امتلاءً بالآخر. التقاء مجرّات، يُعَجِّل بأن تصير الغُرف غابات. إنه خطوطُ هواتف، شاشات حاسوب، صور، روائح، روائح مرة أخرى، أماكن، ذاكرة بصرية ممتلئة، إلخ... لكن، ماذا عن غياب الحب، كيف يُكتب؟
2
كنا في ساحة الجمهورية. معي تمثال ماريان وبدرٌ وابتسامتكِ. هذه مادية الحب. ماذا عن لا ماديته؟
3
نغرق القبل في كأس أخير، ونودع شارعا إلى آخر، نلتف يمينا ويسارا، ونسقط في مكان تحبينه. تشيرين لي: «من هنا قد ترى نصف المدينة». لا أرى إلاّ سماء ملوثة. هناك ودَّعت قلبكِ. نعود إلى البيت وننام.
نصف المدينة، لا يعنيني في شيء. لكن ماذا عن سرير فارغ؟
4
شاعر عربي يتحدث عن باص يقوده من الحي اللاتيني إلى مونبارناس وإلى حبيبته الشقراء. هكذا!
لا أحب كلمة باص، أفضل كلمة حافلة. الحافلة ممتلئة بالذين شَوَتْهم شمس بلاد أخرى على مهل، وعجائز بيض، وصبايا المدارس. لا أحب الشقراوات أيضا، وتغريني شراستك الوادعة.
لكن ماذا عن غياب شراستك؟
5
سخرنا أنا ورفيقي كثيرا، من الشعراء العرب الذين يرسمون «بطاقات بريدية» للمدينة الضخمة، والمزعجة والمملة. «مخيال بدوي»، نضحك بضراوة. نمشي في الليل، آخر الليل، مترنحين. وأفكر: ماذا عن غياب الحب، ولا ماديته؟ أقف فوق جسر من جسور المدينة الشهيرة أجهل اسمه. إنها الثالثة صباحا. نكاية في الجمهورية أتبول من أعلى الجسر، ساخرا لحيز من السماء النحاسية: «تحت جسر ميرابو يجري نهر السين وحبنا...» أدندن: «تحت الجسر يجري نهر السين... وأشياء أخرى».
قصيدة لغيوم أبولينير
*محمد الخضيري- شاعر ومترجم مغربي مقيم في فرنسا
رشيدة لمرابط: رسالة إلى شاب من حيّنا بالضواحيرشيدة المرابط كاتبة وروائية ومحامية ولدت في المغرب سنة 1970 وانتقلت صحبة أسرتها إلى بلجيكا سنة 1973. اعتبرت ضمن الجيل الجديد من الكتاب البلجيكيين الذين يكتبون باللغة الفلمانية، نالت أعمالها الروائية نجاحا كبيرا خاصة: (مرسيديس 207) و (أرض النساء) و(أبناء الرب).
عزيزي
... نحن لا نعرف حتى بعضنا البعض، على الأقل شخصيا. أجل، نحن نقطن الحي نفسه. نستقل أحيانا الترامواي نفسه، ولذا نشترك في عدة تفاصيل صغيرة. لا يسلم الواحد منّا على الآخر رغم أنّ والدتينا تذهبان معا يوم الجمعة إلى المسجد، وتصادف الواحدة منهما الأخرى أيام السبت في السوق الأسبوعي وهما تبحثان عن طماطم متماسكة، ليمون لذيذ وقيل وقال محمّص بفعل طراوته، وبالمناسبة، كيف حال أمك؟ بلغني أنّ إصابتها بمرض السكري تعم حياتها يوما بعد يوم. حسب والدتي السبب يكمن أساسا في الإجهاد، وهي تعرف جيّدا عمّ تتحدث، إذ ليس هناك أعمق خبرة من والدتي في مجال الإجهاد بسبب تجاربها معه. لكنني لا أريد الكلام عنهما، بل عنك. أرغب في طرح سؤال عليك، سؤال شخصي... ثق بي سؤالي استعاري فقط. سأطرح سؤالي ببساطة... واعذرني إن أسست باقترافي ذنبا إزاءك. أجل، ما أسائل نفسي حوله منذ مدة طويلة. السؤال الذي يؤرقني منذ وقت بعيد هو معرفة هل أنت فعلا من صلب والدك. ذلك أنني لم أعثر على كثير من مواصفاته لديك. والدك يمتلك شيئا ما. وهو في ذلك مثله مثل أبي بالمناسبة. كيف أشرح لك الأمر؟ كانا رائعين. أليس كذلك؟ على الأقل في البداية كيفما كان الحال. ألا تظنهما كانا رائدين مغامرين؟ ما رأيك في أبيك؟ ما رأيك فيه. أستشعر عدم معرفتك به. نعم، أنت تشعر باحترام مقدس له. إنّها التقاليد فحسب. أليس كذلك؟ حتى الأبناء الأكثر إثارة للرثاء يكنّون لآبائهم احتراما جمّا. لا مجال للجدل حول هذا المعطى إطلاقا. سألت نفسي إن كنت ستجرؤ؟ هل في استطاعتك مغادرة مكان تعرفه عن ظهر قلب للذهاب إلى آخر، حيث يعجز الناس عن نطق اسمك بشكل صحيح؟ حيث يتداولون لغة لا أساس لها ولا معنى؟
بالتأكيد لا. لأنني أخال الشعلة التي كانت تحرك والدك قد انطفأت لديك. هل تعرف الفكرة التي كانت تحمس والدك ووالدي؟ ... كانت تحركهما فكرة مفادها أن احتمال حياة أكثر كمالا أمر مرجح. أنه بمقدورهما بفضل أياديهما العارية جعلها تأخذ منحى آخر. وأنت ما فكرتك؟ ما مشروعك؟ لنكن صريحين مع بعضنا البعض ولو مرة واحدة. يجب ألا نحول الأمر إلى قضية سياسية. السياسة تفسد كل حوار صريح. أتدري أنّ أبوينا كانا هما كذلك على بينة من هذا... كانا شابين في تلك السنة الرهيبة. أما أنت وأنا، فلم نكن حتى مجرد فكرة بعد. آنذاك، لم يكن يوجد مكان لك ولي. فهما أيضا كانا طفلين. كانا شابين يرصدان الأفق بحثا عن فرص ووسائل لبعث الحياة في فكرتهما. أظن بصدق أنّهما تسلحا بالجرأة عقب تلك السنة لإعداد خطة. ما تعتقدهما فكّرا فيه أيامها وهما يهزّان كتفيهما؟... هل أنت مثلهما حين تهزّ كتفيك اليوم في مواجهة الحياة؟

















