السينما والأدب في الاتصال والانفصال بين السينما والأدب
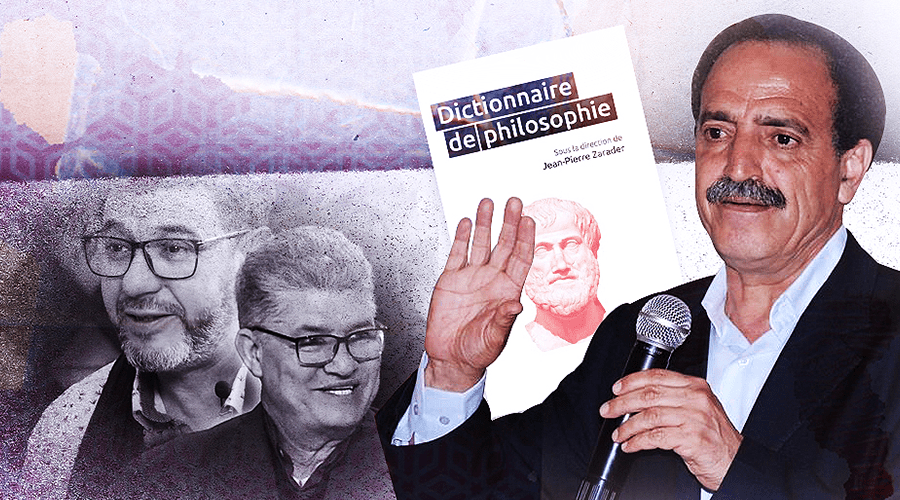
-

Télé Maroc
نشرت في : 19/02/2022حوار مع الناقد السينمائي المختار آيت عمر:
فيلم «شمس الربيع» للطيف لحلو سنة 1969 أول مبادرة في التعامل مع عبد الكريم غلاب
ولد الناقد السينمائي المختار آيت عمر سنة 1951. انخرط في حركة الأندية السينمائية منذ سبعينيات القرن الماضي. فأسندت له مهمة كاتب عام للجامعة الوطنية السينمائية بالمغرب، ثم عين رئيساً لها سنة 1983 إلى سنة 1991. كما عمل مديراً مسؤولاً ورئيس تحرير مجلة «دراسات سينمائية» سنة 1985. ثم كاتباً عاماً لجمعية نقاد السينما بالمغرب سابقاً وعضو تحرير مجلة «سينما». وهو اليوم مدير المهرجان السينمائي للفيلم القصير بالقنيطرة. ونظراً لهذه الخبرة الطويلة في حقل السينما، أجرى معه الملحق الثقافي الحوار الآتي. قراءة ممتعة.
حاوره: محمود عبد الغنيس: مرحبا بك سي المختار آيت عمر في الملحق الثقافي لجريدة "الأخبار". في البداية نريد، من خلال تجربتك في العمل والنقد في حقل السينما، أن تقدم لنا نظرة عن السينما والأدب.
ج: الفن السابع، أو السينما هو الفن الذي استطاع أن يهيمن في القرن العشرين ليصبح الأكثر جماهيرية، إذ استطاعت السينما أن تستوعب كل الأشكال التعبيرية السابقة لها من مسرح وموسيقى ورقص وتشكيل وغيرها، وارتبطت بشكل خاص بالأدب عموما والأعمال الروائية، وخصوصا بعد انتقالها من سينما صامتة إلى سينما ناطقة في الثلاتينيات من القرن الماضي. هذه المرحلة المفصلية فى تاريخ السينما دفعت الإنتاج السينمائي إلى البحث عن معين لا ينضب وهو الأعمال الأدبية.
وذلك بالانتقال من النص المكتوب (سرد روائي) إلى نص مرئي (لغة بصرية)، بما يحمله النص المكتوب من خيالات ومجازات واستعارات لغوية وتحويلها إلى مشاعر وأحاسيس مرئية عن طريق الصورة / اللقطة / زاوية التصوير / حركة الكاميرا / وأداء الممثل، وبذلك خلقت السينما لغتها الخاصة. واستيعاب هذه اللغة والتحكم فيها هو ما يؤثر على مدى نجاح أو فشل الانتقال من المكتوب إلى المرئي ويحكم على عملية الاقتباس بالقوة أو الفشل.
س: وماذا عن العلاقة بين السينما والرواية؟ج: العلاقة بين السينما والأدب عموما والرواية بشكل خاص، من بين القضايا التي شغلت المهتمين بالشأن السينمائي فى المغرب منذ أواخر الستينات. فمع بداية الإنتاجات السينمائية الأولى، تمثلت أول مبادرة في التعامل مع الكاتب عبد الكريم غلاب سنة 1969 فى فيلم "شمس الربيع" للمخرج لطيف لحلو. غير أن هذه المبادرة لم تستمر ولم تجد لها الصدى الإيجابي بين السينمائيين والكتاب المغاربة. من جهة، لأن المخرجين السينمائيين لم يتمكنوا من ربط جسور التواصل مع الأدباء المغاربة والأدب المغربي المكتوب بالعربية. كما أن ظروف الإنتاج السينمائي فى بداياته أعطت الغلبة للمخرج باعتباره منتجا وكاتب سيناريو ومساهما في المونتاج وغيره من العمليات الأخرى. كما أن أغلب المخرجين الأوائل كانوا من خريجي المدرسة الفرنسية وبعضهم من أوروبا الشرقية، فكان هناك نوع من التباعد مع الأعمال الروائية المغربية، وخصوصا المكتوبة بالعربية، على الرغم من قلتها في تلك المرحلة الزمنية، ومن ثم نشأت هذه العلاقة المضطربة منذ البداية.
تجدر الاشارة إلى أن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية سبق لها أن طرحت هذا الموضوع / الإشكال في ملتقى دراسي حول السينما المغربية نظم بمعهد البريد بالرباط في مارس 1983، وأثناء النقاش فوجئنا بالمخرج محمد التازي (بن عبد الواحد) وهو يحمل معه بعض الأعمال الروائية المغربية ليجيب عن هذا الإشكال مؤكداً استحالة نقل هذه الأعمال الى السينما. حينها لم تكن الفيلموغرافيا المغربية من الأفلام
الطويلة قد تجاوزت الأربعين فيلما، بينها عمل واحد هو فيلم «حلاق درب الفقراء»، «الذي تعامل فيه المخرج محمد الركاب مع مسرحية بالعنوان نفسه ليوسف فاضل». وفى هذه السنة كان المخرج إدريس المريني بصدد إنجاز فيلم «بامو» عن قصة للكاتب أحمد زياد. وفى سنة 1984 سينجز الطيب الصديقي فيلم «الزفت» عن مسرحية له بعنوان «سيدي ياسين في الطريق». وفى سنة 1988 سيتعامل المخرج مومن السميحي في فيلم «قفطان الحب» مع عمل أدبي للكاتب الأمريكي بول بولز ومحمد المرابط. كما سيتعامل المخرج حميد بناني سنة 1991 فى فيلم «صلاة الغائب» مع رواية الكاتب الطاهر بنجلون.
س: وما الوضع الآن في الألفية الثالثة، مع فترة دعم الإنتاج السينمائي؟ اذكر لنا النصوص والتواريخ.ج: العلاقة بين الفيلم المغربي والأعمال الروائية لم تتوقف، وكانت هناك محاولات متعددة وخصوصاً فى الألفية الثالثة مع التطورات التي حصلت في دعم الإنتاج السينمائي. ونورد هنا أهم الأعمال التي حققت - ولو بنسب متفاوتة – إضافات للفيلم المغربي في جانبه التقني والجمالي.
- نذكر فيلم «عطش» سنة 2000 للمخرج سعد الشرايبي الذى عاد فيه إلى فترة غاية في الحساسية وهي فترة المقاومة ضد المستعمر، انطلاقاً من عمل بالفرنسية غير معروف لموحى بلعايد.
في سنة 2002 تقتبس المخرجة فريدة بليزيد فيلمها «الدار البيضاء يا الدارالبيضاء»، عن رواية بالفرنسية للكاتب رضى المريني بعنوان «جبابرة الدار البيضاء». وفى هذا الفيلم تقتحم المخرجة بل تتجرأ على منطقة حالكة من التاريخ المعاصر.
في سنة 2003 يتعامل المخرج محمد عبد الرحمن التازي مع رواية «جارات أبي موسى» للكاتب أحمد التوفيق.
فى سنة 2004 يشتغل المخرج حسن بنجلون على رواية «الغرفة السوداء» لجواد مديدش، مقتحماً زمن سنوات الرصاص في فيلم «درب مولاي الشريف». في سنة 2009 يعمل الأخوان سهيل وعماد نوري على اقتباس فيلمهما المشترك من الأدب الروسي من نص قصصي لديستويفسكي بعنوان «قلب رقيق».
سنة 2010 يشتغل المخرج عبد الحي العراقي على رواية بالفرنسية بعنوان «مقاطع مختارة.. غراميات متعلم جزار» للكاتب محمد نيد علي - سنة 2012 المخرج نبيل عيوش يقتبس فيلم «يا خيل الله» من رواية بالفرنسية بعنوان «نجوم سيدي مومن» لماحي بينبين.
في سنة 2013 المخرج حميد الزوغي يتعامل مع رواية «بولنوار» للكاتب عثمان أشقرا. والمخرج الجيلالي فرحاتي يتفاعل مع رواية «سرير الأسرار» للبشير الدمون».
فى سنة 2019 فيلم «دقات القدر» للمخرج محمد اليونسي، مقتبس من روايته «السمفونية الخامسة»، ثم فيلم «سنة عند الفرنسيين» من إخراج عبد الفتاح الروم وهو مقتبس من رواية بالعنوان نفسه للكاتب فؤاد العروي.
س: وماذا عن النقد السينمائي، هل واكب هذه الدينامية السينمائية الجديدة؟ج: لقد واكب النقد السينمائي بالمغرب مسيرة الفيلم المغربي منذ البدايات الأولى، سواء كان نقداً شفوياً في النقاشات الأسبوعية التي كانت الأندية السينمائية تنظمها بعد كل عرض. وانتقل هذا النقاش إلى الصفحات السينمائية بمختلف الجرائد المغربية / العلم لوبنيون / المحرر / الميثاق / البيان / أنوال. وبشكل خاص في مرحلة الثمانينات والتسعينات. حتى أن البعض كان يتحدث عن فائض في النقد بالقياس للإنتاج السينمائي، إذ كان الإنتاج حينها لا يتجاور فيلماً أو فيلمين في السنة، مابين 1958 و199، لم تتجاوز الفيلموغرافيا المغربية 70 فيلماً.
بالنسبة للمجلات السينمائية المتخصصة، يمكن الرجوع إلى سنة 1970 وهي السنة التي ظهرت فيها مجلة «سينما 3» بالفرنسية وأدارها المرحوم نور الدين الصايل وصدرت منها أربعة أعداد. كما أن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية أصدرت ما بين سنة 1985 و1991 مجلة «دراسات سينمائية» (وكنت حينها المدير المسؤول ورئيس التحرير )، وهي مجلة دورية صدر منها 13 عدداً. وكانت تطبع في أعدادها الأولى 5000 نسخة من كل عدد. وتلتها في مرحلة لاحقة مجلة «سينما» من إصدار جمعية نقاد السينما بالمغرب، وذلك في الفترة ما بين سنة 2006 و2009، وهي دورية صدر منها 11عددا، نذكر أيضا مجلة «سينيماك المغرب» (مجلة السينما والفنون البصرية) وصدر منها 15 عدداً مابين 2007 و2012 وهي تجارب حاولت الصمود والبقاء لمرحلة معينة، غير أن تجربة المجلات المتخصصة في مختلف الفنون غالباً ما تعترضها عوائق ومطبات في الطريق. هذا دون أن ننسى التذكير بمجموعة من الإصدارات الخاصة حول مخرجين سينمائيين، أو حول قضايا بعينها تصدرها التظاهرات والمهرجانات السينمائية الموزعة على مختلف المدن المغربية.
الكتابة حول السينما عموما والفيلم المغربي بشكل خاص لم تتوقف، بل هناك مواكبة دائمة إن من طرف العديد من النقاد تبعا لما يحققه الفيلم المغربي من تواجد في المهرجانات العالمية المختلفة، وما يحصل عليه من جوائز، سواء كان فيلماً روائياً طويلاً أو وثائقياً أو فيلماً قصيراً.
س: لكننا نلاحظ، إلى حد ما، تراجع الأنشطة السينمائية مقارنة مع العقود الفارطة.السينما كممارسة جمعوية وكفعل ثقافي، تراجع حضورها بالمقارنة مع سنوات السبعينات والثمانينات التي عرفت حضوراً قويا للأندية السينمائية وانتشارها في أكثر من أربعين مدينة في مختلف أرجاء المغرب، إذ وصل عددها حوالي 60 نادياً سينمائياً. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأندية تجاوز عدد المنتسبين إليها ألف منخرط، مثل النادي السينمائي بالرباط أو نادي الشاشة بمكناس.
س: لماذا، في نظرك، هذا التراجع؟ج: أعتقد أنه من الطبيعي أن يتراجع صوت الأندية ويخفت، كما قلت، لأن التحولات التي عرفتها الوسائط المختلفة للتواصل، وخصوصاً مع بداية الألفية الثالثة، جعلت الصورة والمادة الفيلمية فى متناول الجميع. ومع ذلك استطاعت بعض الأندية أن تحافظ على استمراريتها وأن تجدد من أساليب عملها. فلا زالت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية حية تنظم مجموعة من التظاهرات والمهرجانات السينمائية وإليها يرجع الفضل في الحفاظ على الفرجة الثقافية ومناقشة الأفلام وتنظيم الورشات في مختلف المهن السينمائية.
في الاتصال والانفصال بين السينما والأدب
عبد الجليل بن محمد الأزدي: من حقنا التساؤل عن جدوى السينما وضرورتها؟
عبد الإله الحمدوشي: علاقة الرواية بالسينما تعكس فقر إنتاجنا على مستوى الأدب والسينما معاً
أحمد السيجلماسي: اقتباس بعض الأعمال الأدبية الرائدة أغنى مضامين الكثير من الأفلام
محمد اليونسي: السينما تمكنت من ربط علاقة أمتن بالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية
عبد الإله الجوهري: قراءة اللقطة/ الصورة السينمائية تطرح عدة أسئلةفي موضوع الاتصال والانفصال بين السينما والأدب، قال الناقد والمترجم عبد الجليل بن محمد الأزدي إن الحديث في موضوع الملاقي بين اللغات السينمائية واللغات الأدبية لا ينتهي. ومن حق من تأملها التساؤل عن جدوى السينما وضرورتها إذا كانت تأتي دوما تالية للأدب ولاحقة به؟ إذ إن الفن السابع، منذ بداياته، لم يتوقف عن استلهام الأعمال الأدبية والاستمداد منها والاقتباس عنها. لقد استأثر الاقتباس عن اللغات الروائية، حسب الأزدي، بقسط كبير من الأزمنة الذهبية لهوليود وبوليود كذلك. والعديد من الأشرطة السينمائية غدت أكثر شهرة من النصوص الروائية الأصلية؛ والأمثلة في هذا المضمار لا تعد ولا تحصى...
وأضاف أن ما يصح في حق السينما الأمريكية، ينسحب كذلك على السينما في كافة ربوع العالم. ويتعين هذا الذي ينسحب على كافة تنويعات الاقتباس في فضاء محدد، عنوانه: صناعة الأدب في السينما، أي الاقتصاد الثقافي للتكييف الأدبي المعاصر. والعبارة هذه أطروحة بالمعنى العميق، ترسل فيضا من القضايا والإشكالات، يوائم الاحتفاظ منها باثنتين لا تقفان عند ظاهر الأمور، بل تذهب إلى دُخْلَتِها وعُمْقِها.
تقول القضية الأولى إن ارتهان سؤال الاقتباس في مدار هوس الأمانة يُعَدُّ ضربا من القول النافل؛ وتشير القضية الثانية إلى الجهود التي تطول الأثر الأدبي في عملية تهجيره نحو السينما؛ وهي عملية تستولد منه أثراً آخر له مرجعياته الجمالية والتقنية التي تجعل منه عملا سينمائيا ذا مردود اقتصادي. وتنتمي هذه العملية إلى مدار الإنتاج والاستهلاك: إنتاج عمل تجاري ذي مردودية عالية وفق منطق البحث الدائم عن الربح، أي المنطق الرأسمالي.
وأنهى كلامه أنه سبق تحليل هذا الأمر ضمن الأدبيات الغزيرة لمدرسة فرانكفورت؛ إذ إن الفيلسوف ومؤرخ الفن والتر بنيامين أفاض في الحديث عن العمل الفني في زمن إعادة إنتاجه، ونبَّهَ على غياب الهالة عن الآثار الأدبية بفعل الطباعة وإعادة الإنتاج التقنية للنص الأدبي، التي سحبت من الكتابة والقراءة نخبويتهما، وألقَتْ بهما إلى مدار ما تملكه الطبقة الوسطى. وهو ما نبهنا على الكثير منه ضمن كتاب: الأدب والسينما – إرنست همنجواي: السِكِّير المتمرد والكاتب الثوري (كنوز المعرفة، 2018).
أما الروائي والسيناريست عبد الإله الحمدوشي فأكد في المفتتح أن قلة من الناس يعرفون أن فيلم (كازابلانكا) أشهر فيلم في العالم هو في الأصل نص أدبي مسرحي من تأليف موراي بارنيت وخوان أليسون، وأن أشهر أفلام هيتشكوك (بسيكوج) هو في الأصل رواية أدبية شهيرة من تأليف الكاتب روبير بلوخ، وأن أب العميل السري 007 جيمس بوند، هو الكاتب البريطاني إيليان فلينمك، وأن التحفة السينمائية «العراب» هي في الأصل رواية شهيرة للكاتب ماريو بوزو. إذا استرسلنا في ذكر الأفلام الشهيرة التي أخذت عن نصوص أدبية، سيندهش القارئ للعلاقة الوثيقة التي تجمع بين السينما والأدب والفنون عموما. وفي حالة المغرب قال الحمدوشي إننا إذا عدنا إلى المغرب، سنجد للأسف الشديد أن علاقة الرواية بالسينما علاقة فقيرة جدا وتعكس فقر إنتاجنا على مستوى الأدب والسينما معا، فعقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وإلى حدود منتصف التسعينيات، لم تكن في المغرب سينما بالمفهوم الحقيقي للسينما، بل كانت هناك اجتهادات فردية ومحاولات شبه انتحارية لصناعة فيلم سينمائي، والشيء نفسه على المستوى الأدبي، إذ كانت في بعض الأحيان تمر سنة كاملة أو أكثر دون أن يصدر ولو نص روائي واحد. وأضاف الحمدوشي أن في عز سنوات الرصاص كانت الثقافة والفن عموما يُعتبران من وسائل التحريض على قلب النظام. لكن مع إحداث صندوق الدعم وتراكم الإنتاج السينمائي، ظهرت بعض الأفلام التي أخذت عن روايات ولكن عددها قليل ويحسب على رؤوس الأصابع. وعندما يثار النقاش حول هذا الموضوع يتهم السينمائيون الروائيين بأنهم عند كتابة رواياتهم لا يضعون السينما نصب أعينهم وأن الروايات المغربية فقيرة وتفتقد للحكاية وجافة وذات طبيعة لغوية صرفة، أما الروائيون فيتهمون السينمائيين بأنهم لا يقرأون الروايات المغربية خصوصا المكتوبة بالعربية ويجهلون كل شيء عن الأدب المغربي. لكن المشكل في رأي الحمدوشي يتجاوز السينمائيين والروائيين ويكمن في انعدام وجود كتاب سيناريو محترفين، يعرفون الأدب كما يعرفون السينما، فالحلقة المفقودة في فننا السابع هي الكتابة السينمائية، ليس لدينا كاتب السيناريو الذي يريد أن يبقى كاتب سيناريو ولا يتحول إلى مخرج. فعدد المخرجين ضخم جدا بالمقارنة مع من يكتبون للسينما، والمخرج المغربي في أغلب الأحيان يفضل أن يعدد من اختصاصاته الفنية ويكون الفيلم له وحده من السيناريو إلى الإخراج وحتى التمثيل في بعض الأحيان. والدليل هو عندما نطلع على لائحة الأفلام التي تقدم لنيل الدعم من النادر أن نجد كاتب السيناريو ليس هو المخرج وفي أحسن الأحوال يشترك مع غيره في الكتابة، وربما هذا الخلط في السينما المغربية ناتج كذلك عن مفهوم خاطئ للسيناريو، إذ يعتبرونه عملا سينمائيا صرفا، بينما السيناريو ينقسم إلى قسمين: سيناريو أدبي ينتمي إلى جنس الأدب ويكتبه الكتاب ثم يأتي السيناريو التقني الذي يكتبه المخرج.
أما أحمد السيجلماسي، الناقد والصحفي المتخصص في تاريخ السينما بالمغرب، فقال إن مما لا شك فيه أن أفلاما سينمائية كثيرة استلهمت أفكارها أو مواضيعها أو شخصياتها أو عوالمها وغير ذلك من نصوص أدبية قديمة وحديثة، وهذا يعني أن الاتصال قائم بين الأعمال الدرامية السينمائية (والتلفزيونية أيضا) وبين الأدب بمختلف تشعباته (شعر، رواية، قصة قصيرة، مذكرات، رحلات، سير ذاتية، مسرحيات، خواطر... ). إلا أن هناك فرقا شاسعا في الآليات والتقنيات والأساليب بين العمل السينمائي والعمل الأدبي، فالفيلم له خصوصياته في الكتابة والتناول، والرواية على سبيل المثال لها خصوصيتها في السرد واللغة المستعملة. وإذا كان العمل الأدبي بصفة عامة عملا فرديا، فإن العمل السينمائي عمل جماعي. فالأديب يعبر بلغة الحروف عن أحاسيسه وأفكاره وتطلعاته ومواقفه وغير ذلك، في حين يوظف السينمائي العديد من عناصر التعبير، كالصورة والصوت والحوار والملابس والديكور والماكياج والإنارة والموسيقى... ليترجم أحاسيس الشخصيات وينقل أفكارهم وأفكاره ومواقفهم ومواقفه للمتلقي بأسلوب لا يخلو من متعة أو تشويق أو إثارة أو دعوة إلى التفكير والتساؤل.
وأضاف السيجلماسي قائلاً إن اقتباس بعض الأعمال الأدبية الرائدة إلى السينما، جزئيا أو كليا، أغنى مضامين الكثير من الأفلام. كما أن السينما استطاعت أن تعرف على نطاق واسع بنصوص أدبية مغمورة عندما استلهمتها في كتابة سيناريوهات بعض الأفلام. التفاعل، إذن، ملحوظ بين السينما والأدب منذ عقود، والدليل على ذلك نجاح بعض المخرجين السينمائيين في استقطاب روائيين كبار لكتابة سيناريوهات ناجحة لأفلامهم (حالة التعاون بين المخرج المصري صلاح أبو سيف والروائي العالمي نجيب محفوظ في أكثر من فيلم)، وقد تأثر بعض الروائيين بالسينما لأنهم أصبحوا متملكين لأسلوب الكتابة البصرية، الشيء الذي يجعل القارئ لنصوصهم وكأنه يشاهد فيلما على الشاشة. وعن القاسم المشترك بين الفيلم والرواية، ذكر السيجلماسي الخيال، وكلما كان هذا الخيال خصبا وكان المبدع (مخرجا أم روائيا) متمكنا ومتحكما في أدوات السرد وتقنياته، كان العمل ممتعا للمتلقي. هناك روايات ممتعة وجيدة شكلا ومضمونا، لكنها شوهت عندما حولت إلى أفلام على يد مخرجين غير موهوبين وغير ذواقين ولا يميزون بين النص المكتوب والنص المرئي وخصوصيات كل منهما. وهناك روايات متواضعة القيمة الأدبية حولها مخرجون كبار إلى تحف سينمائية.
وتساءل المخرج محمد اليونسي: هل ولدت السينما من رحم الأدب؟.. وهل استمرارية السينما مرتبطة بالأدب؟.. ليجيب إن السينما حين نشأت لم تكن مرتبطة بالأدب لكونها فناً مستحدثاً ولد من رحم الصورة، ومن زواج العلم بالفن، بل عرفت مراحلها الجنينية بعيدا عن الرواية، وتمكنت من ربط علاقة هي أمتن بالفنون الأخرى كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.. ولاختلاف أدوات التعبير بين الرواية والسينما، يصعب أن نجزم أن العلاقة بينهما علاقة وجودية، «الأفلام التي استوحت من الروايات لا تتعدى الواحد في المئة من الإنتاجات السينمائية»، بل يمكن أن نجزم، يقول صاحب فيلم «وشاحٌ أحمر» أنها علاقة التأثير والتأثر التي تكمن في مرحلة الخيال والتخييل. فكما أثرت الرواية في خيال السينمائيين، فالرواية كذلك تأثرت بأسلوب السينما في أساليبها الجديدة في السرد والتشكيل البصري للأحداث والوقائع. ولأن متخيل الطرفين تحكمه قواعد مختلفة تكاد تتضاد في الزمكان والفضاء وحتى التمثلات، فتصعب، إذن، المقارنة بينهما، وخصوصا عندما يكون العمل السينمائي مستنبطا أو مقتبسا أو حتى مأخوذا من رواية ما بالكامل، فغالباً، يضيف اليونسي، ما نسقط في فخ المقارنة بين الدال والمدلول في سلطة الكلمة وسطوة الصورة، وننسى أنهما جنسان مختلفان ولا تمكن المقارنة بينهما، لأن دلالة الكلمة في أذهان الناس تتغير عندما تنعكس في الصورة وتخضع لشروط هذه الأخيرة.. وبالتالي، يستنتج، فالأعمال التي اعتمدت على الرواية بصفة كبيرة فهي في الأصل لا تعكس العمل الروائي ولا جودته، وإنما تعلن عن ولادة عمل جديد بمواصفات خاصة «سينمائية» كان يمكنه أن يعتمد على كل الألوان الفنية كالفن التشكيلي أو المسرح أو الموسيقى أو الشعر ليعبر عن نفسه، وسلطة «النقد» هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تقيم جودته دون مقارنته، حيث تخضعه للتشريح في مختبر التحليل السينمائي وبمواد نقدية سينمائية محضة..
واعتبر الناقد والمخرج عبد الإله الجوهري أن العلاقة بين السينما والأدب علاقة جد معقدة، ويأتي هذا التعقيد من اختلاف أدوات الكتابة، فالأدب يعتمد على الألفاظ والكلمات كأداة تعبيرية، حيث تصبح الكتابة الأدبية مغامرة مع اللغة في مختلف تركيباتها، ومع المادة التخييلية أو الخيالية من أجل القبض على معنى مسبق أو محتمل، وينتج هذا المعنى بشكل خطي تعاقبي، تبعا لعملية القراءة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، أو من فوق إلى تحت. وتعتمد السينما في لغتها شبكة متداخلة من الأدوات الفنية والصناعية، لا يمكننا الاقتراب منها أكثر، إلا إذا تتبعنا مختلف المراحل التي يقطعها الشريط، انطلاقا من العمل الأدبي (أو القصة السينمائية)، مروراً بالسيناريو، وتقنيات التصوير (حركة الكاميرا)، والتقطيع والتوليف... وصولا إلى الفيلم الكامل الجاهز للاستهلاك من طرف المتفرج/ المشاهد، دون إغفال حجم اللقطات والمشاهد، وتحديد الكادرات، والأبعاد الصورية، ولعبة الضوء والألوان، والمؤثرات الصوتية، والتلوينات الموسيقية... كل هذا وغيره، حسب الجوهري، يساهم في خلق اللغة السينمائية، أو البلاغة السينمائية، المتميزة بشفرتها الاتفاقية، هذه الشفرة التي، بتعددها وتنوعها، تشكل كثافة الصورة الحاملة للمعنى.
وأكد صاحب فيلم «ولولة الروح»، أنه إذا كانت قراءة العمل الأدبي، نسبيا متفقا عليها في شكلها الكلاسيكي تبعا لحركة العين، فإن قراءة اللقطة/ الصورة السينمائية تطرح عدة أسئلة، لعل أكثرها إلحاحا تتلخص في: من أين نبدأ القراءة كمشاهدين؟،، علما أن الصورة تأتي أمام أعيننا بشكل كتلي. وما الأشياء التي ينبغي أن نراها قبل غيرها؟،، بمعنى، هل ننطلق من المحور أم من الهامش؟ أما السؤال الأكبر فهو: كيف يتعامل المخرج السينمائي مع العمل الأدبي؟،، وكيف ينتقل من نص مكتوب إلى ما هو سمعي بصري.. ؟..
الجواب قد يستغرق منا وقتا طويلا وصفحات عديدة للكتابة والتحليل، لكنه لخص القول بشكل أكد على أن بعض السينمائيين، ومعهم بعض الأدباء، يعارضون عملية تحويل نص أدبي إلى عمل سينمائي، وذلك لاعتبارات متعددة، لعل من أهمها صعوبة التحويل، من هؤلاء المخرج المصري توفيق صالح، على الرغم من كونه هو نفسه حول نص «رجال في الشمس» للروائي غسان كنفاني، إلى فيلم سينمائي بعنوان «المخدوعون»، حيث كتب: «إن اختيار نص روائي كأساس لإنجاز فيلم عملية صعبة، وأنا أتمنى، وأدعو الناس ألا يلتجئوا إليها، لأن العمل الأدبي عالم مستقل، ووحدة قائمة بذاتها... ».

















