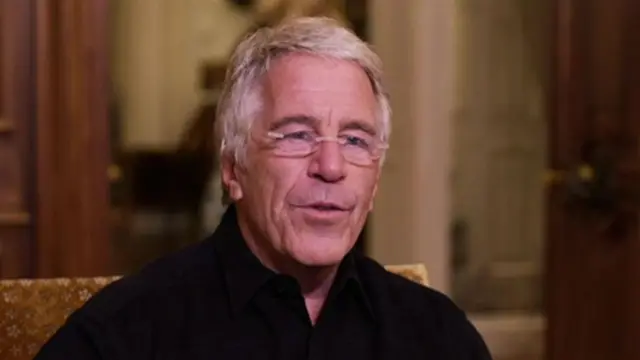ملف - نساء أوروبيات - أحضان مغاربة ملف.. هكذا اختارت نساء أوروبيات العيش في أحضان مغاربة

-

تيلي ماروك
نشرت في : 02/03/2020«كان للملك الحسن الثاني رأي خاص في زواج مدير كتابته الخاصة من أوربية، حيث أخبر موظفه أن زواجه من شابة ألمانية لن يتم إلا إذا وافقت أولا على تغيير اسمها إلى اسم «مسلم» يختاره لها الملك الحسن الثاني بنفسه. اعتنقت بريجيت فرج الإسلام واختار لها الملك الحسن الثاني اسم «غيثة»، وحرص على أن تكون ضيفة عند نساء القصر الملكي حيث كان يتم استدعاؤها إلى جل المناسبات الخاصة والاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية. أما «إيفا» فقد كان وضعها مختلفا رغم أنها جاءت إلى المغرب بعد شريفة وزان بسنتين فقط. ففي سنة 1874، كانت «إيفا نيومان» في زيارة إلى المغرب رفقة والديها، حيث مرا من مدينة طنجة إلى العرائش وهناك تعرفت على موظف مخزني من أصول فاسية، واختارت أن تعيش معه مغامرة عاطفية عنيفة، كانت سببا في قرارها الانفصال عن والديها اللذين اختارا أن يستقرا في طنجة قرابة عشر سنوات، قبل أن يغادراها وحيدين تاركين ابنتهما رفقة زوجها محمد الفاسي بن عمر. هاتان قصتان فقط من قصص أخرى لأوربيات قادهن الحب إلى الزواج من مغاربة في ظروف استثنائية».
الأوربيات و«المخزن».. القصة المثيرة للحرب ضد الحب والجاسوسية
لم يكن القائمون على الأمور في المغرب يرون في قصص الحب التي نشأت بين مغاربة وأجنبيات، أوربيات على الخصوص، قصصا «رومانسية» إنسانية. بل كانوا يتعاملون معها بكثير من الريبة والشك ويعتبرون دائما أن الأوربيات يتقربن من المغاربة في إطار جاسوسي واستعماري محض. كان صعبا خلال تلك السنوات التي كان خلالها المغاربة لا يعرفون أمورا كثيرا عن الأوربيين تقبل زيجة بين مغربي وأجنبية. وهذا ما وقع بالضبط لمولاي عبد السلام شريف وزان خلال نهاية القرن 19. فالرجل الذي كان يحظى بتقدير كبير في أوساط المخزنيين والعوام، بحكم إشرافه على الزاوية في وزان، انقلبت حياته رأسا على عقب عندما التقى إميلي كين، موظفة المفوضية البريطانية التي كانت في مهمة عمل بالمغرب. قصتهما تحولت إلى حديث العام والخاص وأفتى فيها العلماء وكبار الشخصيات الذين اختاروا مقاطعة صديقهم بما أنه قرر الزواج بأوربية «نصرانية»، في عز أزمة المغرب مع الأجانب والنظرة الاستعمارية التي كان ينظر بها المغاربة إليهم.
مدينة طنجة كانت هي المتنفس الوحيد لذلك الزواج. ثم اعتنقت شريفة وزان الإسلام ونُسيت قصة مولاي عبد السلام الذي أصبح صديقا لعدد من الشخصيات الأجنبية بمدينة طنجة خلال القرن الماضي.
بعد ذلك، جاءت قصص أخرى لأجنبيات تزوجن مغاربة، خلال فترة المد الاستعماري على المغرب. أجنبيات إذن قادهن الحب إلى الاستقرار في المغرب. لكن تهم الجاسوسية لاحقت بعضهن، خصوصا اللواتي تزوجن مغاربة في سياق مشحون. ففي وقت كان فيه مجرد العمل لدى الأجانب سببا في التصفية الجسدية وحملات الاغتيالات التي كان يقودها محسوبون على الحركة الوطنية والتنظيمات السرية في بداياتها، كان مُنتظرا أن يعيش المغاربة الذين اختاروا حب سيدات أجنبيات متاعب كثيرة.
بعد الحماية، واعتياد المغاربة على الاحتكاك اليومي بالأجانب، خصوصا الفرنسيين، أصبح موضوع الأجنبيات اللواتي استقررن نهائيا بالمغرب وتزوجن من مغاربة، مألوفا.
سنخصص هذا الملف لبعض قصصهن الشائكة. وسنركز على قصص الحب والصراعات التي جرت أطوارها الحامية في عز الحماية. إذ كان معروفا عن جيل من الشبان المغاربة الذين ارتبطوا بأوربيات بعد 1956، كانوا قد وصلوا إلى قلوبهن أيام الدراسة في فرنسا، واخترن الاستقرار معهم في المغرب. لكن ما يمكن اعتباره أكثر إثارة، هو القصص غير العادية للأوربيات اللواتي كان مجرد دخلوهن تلك التجربة، مغامرة بحد ذاتها، وخروجا عن المألوف، ودخولا في «الغرائبية».
سيسيل أوبري.. نجمة فرنسا التي ربطها الحب بابن الكلاوي
سبق في «الأخبار» أن تناولنا حياة هذه السيدة في إطار سلسلة عالجت موضوع زيجات شخصيات مغربية معروفة، سجلنا خلالها أن أغلب المغاربة المشاهير تزوجوا مغربيات في مقابل قلة فقط قرروا الارتباط بأجنبيات، غالبا بعد قصص حب جارفة قادتهن إلى التخلي عن كل شيء، بما في ذلك الحياة الأوربية المُريحة، والاستقرار النهائي في المغرب.
لم تكن سيسيل تتوقع أن تبلغ شهرتها درجة العالمية عندما وقّعت عقدا مع واحدة من كبريات الشركات العالمية خلال بداية أربعينات القرن الماضي. كما لم تتوقع أن تتزوج من مغربي أيضا. فعندما كان عمرها عشرين سنة، كانت قد وقعت لشركة «فوكس» العملاقة، متجاوزة بذلك بشهرتها حدود فرنسا وأوروبا لتصل إلى العالمية وتصبح من النجمات المطلوبات في هوليود، خصوصا وأنها شاركت في أفلام شهيرة، وحازت على دور البطولة أيضا. لتصبح خلال الأربعينات مفخرة فرنسا.
سيسيل لعبت دور البطولة في الحياة أيضا، فقد كانت سفرياتها كثيرة، واضطرت إلى التحليق فوق المحيط الأطلسي ساعات كثيرة من عمرها، كضريبة على التنقلات الكثيرة بين القارات، لحضور مهرجانات الأفلام وتصوير أخرى..
عندما حلت سنة 1949، توجت سيسيل بواحدة من أضخم جوائز السينما في العالم، وحسب بعض المصادر التي كانت قريبة منها، فإنها كانت تعلم أنها وصلت القمة، وبدأت ترسم لنفسها سيناريوهات الانحدار، خصوصا وأنها خلال تلك الفترة بالذات، قد بدأت تتعرف على الشاب إبراهيم الكلاوي، ابن باشا مراكش الذي كان نافذا جدا خلال تلك الفترة، واشتهر بعلاقاته الوطيدة مع الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين أيضا.
هذا لا يعني أن معرفة ابن الباشا الكلاوي شكل نهاية لمسارها السينمائي الحافل، فقد كانت علاقة تعارفهما السرية في قمة عطائها في الشاشة الكبيرة، لكن زواجها منه وإنجابها لابنهما الأول، سنة 1956، جعلها تفكر في تحقيق طموحها الأكبر، المتمثل في كتابة السيناريو والإنتاج.
زوجها إبراهيم الكلاوي، كان واحدا من أكثر الشبان حظا خلال نهاية الأربعينات، فوالده هو الباشا الذي كان في أوج قوته خصوصا سنة 1953، وبفضل علاقاته الواسعة مع كبار عسكريي العالم وسياسييه، فقد كان الابن يشق طريقه نحو العالمية بسهولة أيضا ويلتقي كبار الشخصيات مع والده، أو بمفرده، خلال زياراته المتكررة إلى أوربا.
لكن إبراهيم الكلاوي ترك كل شيء خلفه عندما تعرف على الممثلة الشهيرة سيسيل، في أحد اللقاءات التي جمعت المشاهير، بحضور سياسيين فرنسيين وأمريكيين، وكان إبراهيم الكلاوي من بينهم، وأثارها هدوءه الكبير، وسحنته العربية التي كانت تختلف تماما عن ملامح الأوروبيين والأمريكيين. لم تكن تعلم أن علاقة حب وطيدة ستتأسس في تلك الليلة بينها وبين الكلاوي، رغم أنها لم تكن تعلم في البداية أنه ابن الباشا الذي سمعت عنه الكثير من خلال أصدقائها الممثلين، وأيضا في بعض الحفلات التي كانت تحضرها في أمريكا، ويشرف عليها جنرالات عسكريون.
ست سنوات من السرية، بطلب من سيسيل ومن إبراهيم الكلاوي أيضا. فهي كانت تريد لمسارها السينمائي أن يكبر، وهو كان يريد أن يحافظ على تقاليد العائلة العريقة والأصول التي لا تتوافق مع التحرر الذي كان يعيشه مع سيسيل. وهكذا توصل الاثنان إلى حل وسط يقتضي بجعل ارتباطهما سرا لفترة، إلى أن يقررا الإعلان عنه في وقت لاحق. لكن الإشاعات سرعان ما لاحقتهما، خصوصا وأن الحياة العاطفية للنجمة العالمية كانت مطلوبة من طرف الصحافة في فرنسا وأمريكا، وهو الأمر الذي عجل بضرورة ترتيب الأمور حتى يعلن إبراهيم الكلاوي عن ارتباطه بالفرنسية الحسناء.
أنجبت له المهدي الكلاوي، وعكفت على الكتابة وتأليف السيناريو، والإنتاج السينمائي، لتجلس خلف الكاميرا بعد أن صنعت اسمها بارزا أمام عدستها. وجعلت من ابنها المهدي الكلاوي أيقونة الشاشة الفرنسية عندما أنتجت فيلم «بيل وسيباستيان»، إذ لم يكن الطفل الأشقر الشهير في تلك السلسلة، إلا ابنها المهدي، حفيد الباشا الكلاوي نفسه!
لم يكن من الصعب على أسرة الباشا أن تتقبل زواج ابنها ابراهيم من فرنسية، ممثلة، ومشهورة، لأن الجو المحيط بالأب، كان يتكون من المشاهير وكبار السياسيين، وبالتالي فإن المشاكل التي توقعها إبراهيم، لم تكن بتلك الحدة أبدا، وسرعان ما كان يشير إليه الأوربيون والأمريكيون بداية الخمسينات، كأحد أكثر الرجال حظا لأنه فاز بقلب الحسناء «سيسيل». لكن الأمور سرعان ما عرفت منعطفا خطيرا، لأن العلاقة بين الزوجين استحالت تماما، خصوصا أمام انشغالات سيسيل، واضطرار إبراهيم الكلاوي إلى تحمل المشاكل وحده، خصوصا بعد أن أصبح والده الباشا الكلاوي غير مرغوب فيه بعد الأحداث التي عرفها المغرب سنة 1955، والتي جعلته يرجع إلى الوراء ويخبو تماما وينتهي حلمه بالوصول إلى قمة السلطة في المغرب.
كان على حياة سيسيل الحافلة أن تنتهي سنة 2010، بعد ثمانية عقود من الجري وراء الحياة واقتحام العالمية. إذ كانت خلال سنواتها الأخيرة متأثرة بالسرطان، لترحل عن الدنيا صيفا، عن سن 81 سنة.
إيميلي كين شريفة وزان و«إيفا».. سيدتان خطفتا قلوب قادة الشمال
لم يكن سهلا على الموظفة الإنجليزية، إيميلي كين القادمة إلى المغرب من بلاد الحضارة وقطب أنظار العالم المتقدم والمتخلف، عندما كان البريطانيون يكتبون في كتبهم وجرائدهم أنهم أسياد الأرض وحكام الاقتصاد والمال، أن تتخلى عن بلد بكل هذه الحمولة وتستقر نهائيا بالمغرب. اختارت لكتابها أن يبدأ حيث بدأ التحول الصارخ في حياتها التي لم تعرف إليها الرتابة طريقا. تقول إن صباح 17 يناير من العام 1873، كان صباحا جميلا، حيث توجه والدها إلى غرفتها ليجلس معها محاولا إقناعها بالتخلي عن فكرة الزواج من شريف وزان. عائلتها كانت ترفض بالقطع أن تزوج ابنتها من رجل مغربي حتى لو كان سيد قومه، ونفوذه يضاهي نفوذ السلطان. أمها عارضت الزواج بشدة، وأرسلت إليها من ينبئها بأنها توشك أن تقترف خطأ العمر، وهي التي جاءت في ريعان شبابها، بداية عقدها الثاني، إلى المغرب. حاولت إيميلي أن تتفهم تخوف أهلها في البداية، لكنها لم تستطع مقاومة رغبتها في الارتباط بشريف وزان. تقول في أحد مقاطع كتابها «My Life Story» إنها عندما رأت شريف وزان أول مرة، لم يكن ليدور بخلدها لوهلة أن الماثل أمامها سيكون زوج المستقبل، وأبا لابنيها الاثنين مولاي أحمد مولاي علي، واللذين يرقدان قربها اليوم بمقرة للعائلة في أعلى مناطق طنجة وأقربها إلى البحر الأبيض المتوسط.
بعض الروايات تقول إن أول لقاء لإيميلي بشريف وزان، كان عندما كادت إيميلي أن تسقط عن صهوة فرسها، حيث كانت تتجول في حقول وزان، ليظهر الشريف وينقذها في آخر لحظة، ليتحول الحادث إلى بداية علاقة كللت بالزواج. لكن كتاب إيميلي كين، وما يرويه المقربون منها، يخالف هذه الرواية تماما. حيث تقول بنفسها إنها قابلت شريف وزان غير ما مرة في اجتماعات وحفلات كانت توجه لها الدعوة لحضورها، شأنها شأن بقية الأجانب.
تقول إيميلي كين في بداية كتابها «إن الزواج من مغربي كان ضربا من الخيال». في العام 1872، جاءت إيميلي إلى المغرب في مهمة عمل عينتها فيها الإدارة البريطانية بالمغرب. مرت من طنجة، والمهمة كانت في وزان..
في ذلك الوقت كانت وزان عبارة عن معقل وقلعة نفوذ كبير لأسرة شريف وزان المولى عبد السلام. ورث عن أجداده زاوية يحج إليها الناس من كل حدب وصوب، من جهات المغرب الأربع، وهو ما جعل أسرته تدخل في معادلة السلطة المعقدة في زمن السيبة وفرض هيبة المخزن. آل شريف وزان، يحشدون القبائل، ومبايعتهم للسلطان تعني مبايعة المغرب له. هذا ما ذكرته بعض المصادر التاريخية، على ما يبدو فيها من تبجيل لدور شرفاء وزان، لكن البحث في أصول العائلة يفضي إلى أن هناك قرابة عائلية تجمعهم بالعلويين، وهو ما جعلهم يكونون سندا دائما لهم. لكن أمورا كثيرة تطورت قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب، والتي وقع عليها المولى عبد الحفيظ، وحتى قبلها عندما بدأت فرنسا توزع صفة «المحميين» على أعيان المغاربة وكان المولى عبد السلام واحدا من المحميين. كيف ساءت علاقته بالقصر، وكيف وجد نفسه في موضع آخر غير ذاك الذي كان فيه.. قصة الحب التي عصفت بقلب شريف وزان.. أو إيميلي التي اختارته واختارت طنجة، كآخر مقام.
هذه المعلومات عن شريفة وزان وقصة اعتناقها الإسلام على يد العالم المغربي عبد الله كنون خلال أربعينيات القرن الماضي، فترة قبل وفاتها، ووفاتها في طنجة وممتلكاتها وأغراضها الشخصية، كانت موضوع ملف سابق بـ «الأخبار» سنة 2014، حيث عرضت لأول مرة معلومات على لسان عائلتها وفتحت أبواب مكتبها للصحافة، بعد ما كان المصدر الوحيد للحديث عن قصتها هو مذكراتها التي تركتها كتأريخ لقصة حياة استثنائية.
أما «إيفا» فقد كان وضعها مختلفا رغم أنها جاءت إلى المغرب بعد شريفة وزان بسنتين فقط. ففي سنة 1874، كانت «إيفا نيومان» في زيارة إلى المغرب رفقة والديها، حيث مرا من مدينة طنجة إلى العرائش وهناك تعرفت على موظف مخزني من أصول فاسية، واختارت أن تعيش معه مغامرة عاطفية عنيفة، كانت سببا في قرارها الانفصال عن والديها اللذين اختارا أن يستقرا في طنجة قرابة عشر سنوات، قبل أن يغادراها وحيدين تاركين ابنتهما رفقة زوجها محمد الفاسي بن عمر.
مصدر هذه القصة هو قصاصة من الصحافة البريطانية الواردة إلى طنجة سنة 1882، وبالضبط يوم 15 شتنبر. يقول الخبر إن والدا «إيفا» راسلا المفوضية البريطانية في مدينة طنجة لكي يحصلا منها على عنوان ابنتهما بعد انقطاع الاتصال معها، ذاكرين إنهما توصلا بمعلومات من أسرة صديقة بمدينة طنجة تقول إن «إيفا» انتقلت مع زوجها إلى مدينة أخرى لا يعرفونها في إطار عمله في المخزن، وقد اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها إلى فاطمة.
لم تتسن معرفة ما إن كانت المفوضية البريطانية قد فتحت تحقيقا في الموضوع لكي تعرف مصير مواطنة بريطانية في المغرب، أن الخيوط انقطعت باختفاء أخبار الابنة التي تبعت قلبها وتركت أوربا خلفها لتستقر نهائيا في المغرب.
«بريجيت» ألمانية وافق الحسن الثاني على زواجها من مدير كتابته الخاصة.. بشروط!
كانت بريجيت فرج، أو غيثة الاسم الذي اختاره لها الملك الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي عندما تزوجها عبد الفتاح فرج، مدير كتابته الخاصة منذ سنة 1964 إلى 1999، حيث كانت غيثة حاضرة إلى جانب زوجها في جل المناسبات الخاصة التي كان الملك الراحل الحسن الثاني ينظمها داخل القصور الملكية.
أما قصتها، فتعود إلى نهاية الخمسينات، حيث التقاها عبد الفتاح فرج عندما كان موظفا بسيطا في وزارة المالية، في زيارة عمل رفقة وفد مغربي إلى ألمانيا، وكانت هي وقتها موظفة في قسم الترجمة بإحدى الوزارات. وعندما أصبح عبد الفتاح فرج، بعد فترة قصيرة مديرا للكتابة الخاصة للملك الحسن الثاني فاتحها في الزواج عبر رسالة بريدية، وطار إلى ألمانيا للقاء والديها لمباركة ذلك الزواج.
كان للملك الحسن الثاني رأي خاص في ذلك الزواج، حيث أخبر موظفه أن زواجه من شابة ألمانية لن يتم إلا إذا وافقت أولا على تغيير اسمها إلى اسم يختاره لها الملك الحسن الثاني.
اعتنقت بريجيت فرج الإسلام واختار لها الملك الحسن الثاني اسم «غيثة»، وحرص على أن تكون ضيفة عند نساء القصر الملكي حيث كان يتم استدعاؤها إلى جل المناسبات الخاصة والاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية.
كان عالم القصور الملكية غريبا تماما على «غيثة» التي ظلت وفية لعائلتها الصغيرة في ألمانيا، حيث كانت تزور أسرتها بانتظام رغم المشاغل الكثيرة وتنقلات زوجها في الكتابة الخاصة للملك.
عاشت غيثة فرج ويلات الحرب العالمية الثانية، وهو ما أثر على شخصيتها كثيرا حيث عاشت طفولة عصيبة فقدت على إثرها جل أفراد عائلتها وإخوتها، وكان انتقالها إلى المغرب، والعناية الكبيرة التي خصها بها الملك الحسن الثاني شخصيا، «تعويضا» نسبيا على الصعوبات التي عاشتها في مراحل مبكرة من حياتها.
لم تكن غيثة فرج إذن مجرد زوجة موظف سام في القصر الملكي عهد إليه الملك الراحل الحسن الثاني بحراسة ممتلكاته، بل كانت منخرطة تماما في البروتوكول الملكي الذي كان الملك الحسن الثاني يحرص بشكل شخصي على أن يحترمه الجميع ويلتزم به. بما في ذلك حضور المقربين من الملك الراحل لتوديعه في كل سفرياته إلى الخارج، الدبلوماسية منها وحتى سفرياته أثناء عطله الخاصة. إذ كان يتم استدعاء كل نساء القصر إلى حفل صغير كان يقيمه الملك الراحل لتوديع محيطه القريب كلما هم بالسفر، وكان يتم استدعاء غيثة فرج لتحضر إلى تلك الاحتفالات، وهو ما كانت تجد صعوبة كبيرة في الاعتياد عليه في سنوات استقرارها الأولى في المغرب، وسرعان ما تشبعت بدورها بالتقاليد المخزنية القديمة.
بالإضافة إلى هذا، كان صعبا على سيدة غربية منفتحة، أن ترى كيف أن الملك الحسن الثاني كان يهتم بكل أخبار مقربيه بما فيها المتعلقة بحياتهم الأسرية، إذ أن الملك الراحل لاحظ أن غيثة فرج وزوجها عبد الفتاح لم يحظيا بأي أبناء بعد زواجهما، وفاتحهما في الموضوع لتخبره غيثة أنه لا يمكنهما الإنجاب بسبب مشاكل طبية ليقرر الملك الحسن الثاني أن يجعلهما يتبنيان ابنين خلال بداية الثمانينيات، لتكون بذلك غيثة فرج التي توفيت سنة 2014، واحدة من الأجنبيات القلائل اللواتي دخلن إلى عمق الحياة المخزنية.
الباشا الكلاوي طرد موظفا من محكمته لأن «ناتالي» خطفت قلبه
في سنة 1949، ذكرت دورية كانت تصدر في الدار البيضاء بعنوان «لو كازابلونكي»، أن موظفا في محكمة الباشا الكلاوي بمراكش، تعرض للتعنيف على يد رجال الباشا، وسُجن لولا أن شابة فرنسية تدخلت لإطلاق سراحه.
اتضح أن الشابة كانت على علاقة عاطفية بموظف محكمة الباشا الكلاوي الذي كان يفرض قوانين صارمة على سكان مدينة مراكش ونواحيها، وصولا إلى حدود نفوذ القياد التابعين له والمنضوين جميعا تحت راية المخزن.
كان الشاب المنحدر من نواحي مدينة ورزازات قد تعرف على «ناتالي» التي كانت ابنة لأسرة فرنسية استقرت بالدار البيضاء منذ عشرينات القرن الماضي، حيث كانت «ناتالي» أول مولودة للأسرة في المغرب. وبعد سنوات من العيش والدراسة في الدار البيضاء، أصبحت ناتالي موظفة في الإدارة التابعة للإقامة العامة الفرنسية وانتقلت إلى مراكش في إطار مهامها الوظيفية، وهناك تعرفت على موظف المحكمة، الذي لم يأت المقال على ذكر اسمه الشخصي ولا العائلي. نشأت قصة حب قوية بين الشابين، ووصل صداها إلى أسماع الباشا الكلاوي، خصوصا بعد أن انتبه بعض الوشاة إلى أن الموظفة الفرنسية الحسناء كانت تأتي إلى أمام محكمة الباشا لانتظار انتهاء الموظف من مهامه بالمحكمة لكي يأمر الباشا فورا بسجنه والتحقيق معه وسجنه في إقامة الباشا لأيام لإقناعه بالتخلي عن تلك العلاقة العاطفية. لكن الشابة انتبهت إلى أن أمرا غير طبيعي وراء اختفاء حبيبها، واستغلت طبيعة عملها الإدارية لكي تطلب من رؤسائها التدخل لدى الباشا الكلاوي شخصيا للاستفسار عن مصير موظف المحكمة الذي كان يتعرض لمضايقات خلال تلك الفترة. وسرعان ما تم إطلاق سراحه، لكي يغادر مراكش في نفس السنة، صوب مدينة الدار البيضاء رفقة «ناتالي» لكي يستقرا بها بشكل نهائي.
إيزابيل إيبرهارت.. أيقونة الرحلات العالمية التي حطّ قلبها بالمغرب
سيكون من المجحف في حق السيدة إيزابيل إيبرهارت أن نقول إنها رحالة ومغامرة استقرت في الحدود المغربية الجزائرية سنة 1901. فالسيدة تشبعت بأفكار الصوفية التقليدية وأحبت بصدق زوجها سليمان الذي قضت معه آخر سنوات حياتها، قبل أن تفارق الحياة بسبب فيضانات 1904 بمنطقة عين صفراء.
عندما تم انتشال جثمانها من أنقاض الفيضان، وجد عمال الإنقاذ أنها كانت تمسك بقبضتيها على أوراق ألفتها بنفسها حكت فيها عن تأملاتها وحياتها وتجاربها واختارت لها عنوان «المتسكع». ومن خلال تلك التأملات المخطوطة، كرمت فرنسا سيرة هذه السيدة بنشر حياتها للعموم.
أصولها متشعبة بحكم أن انحدار والدتها من روسيا، والغموض الذي لف هوية والدها بسبب زيجات أمها الكثيرة، والتي تزوجت سابقا بقس اعتنق الإسلام، وبعده تزوجت من شخصية عسكرية روسية. بينما تقول روايات أخرى إن والد إيزابيل الحقيقي هو الشاعر الفرنسي المعروف «آرثر رامبو».
هذه الرواية الأخيرة كانت مصدر رفع مبيعات عدد من الصحف التي تناولت حياتها سنة 1907 مباشرة بعد وفاة زوجها بعين صفراء الحدودية بين المغرب والجزائر.
عاشت إيزابيل أياما عصيبة في النمسا، بسبب الأزمات الاقتصادية وظروفها الصعبة بسبب عدم معرفتها هوية والدها في سنوات شبابها الأولى وهو ما أثر سلبا على نفسيتها. حتى أن ماضي والدتها كان مصدر شقاء بالنسبة لها، خصوصا بعد وفاة أزواج أمها السابقين. أخوها انتقل إلى الجزائر، وبالضبط إلى سيدي بلعباس، وهو ما جعلها تفكر في الانتقال. لكن ما حسم في قرار انتقالها إلى الجزائر، كان مراسلة بينها وبين جندي فرنسي كان ضمن القوات الاستعمارية في منطقة تلمسان. ونشر الأخير مقالا في جريدة فرنسية يتحدث عن قصته، وكتبت إليه تراسله لكي ينشأ بينهما رابط قوي، وتقرر أن تنتقل إليه لكي يعيشا قصة حب قصيرة سرعان ما تبخرت بعد وصولها إلى الجزائر لأنها لم تجده كما تخيلته.
انجرفت إيزابيل بسرعة إلى الحياة الجزائرية، وارتدت لباس البدو، وتعرفت على الثقافة الجزائرية الحقيقية. وهنا تصاعدت الأصوات التي اتهمتها بالجاسوسية، خصوصا وأنها كانت تضبط اللغة العربية قراءة وكتابة، وهو ما جعل الشكوك حول اشتغالها مخبرة للجيش الفرنسي تتنامى ضدها سنة 1897.
تأثرت بحياة المتصوفة، وأصبحت تعيش إيقاع حياة بدوية يسودها التنقل صوب عدد من المناطق التي تنتشر فيها الزوايا والأضرحة، وهناك سوف تتعرف على زوجها المسلم، الذي سوف يزيد من نسبة اقتناعها بالحضارة الإسلامية واعتناق الدين الإسلامي، حتى أنها ودعت حياة سويسرا والنمسا، واختارت أن تقيم معه في منزل طيني متواضع بالقرب من أضرحة الأولياء الصالحين إلى أن توفيت في فيضان 1904 الطوفاني الذي هدم المنزل الطيني فوق رأسها وقضت غارقة في ركام الطين حاملة معها أسرار حياتها الحافلة بالمغامرات والألغاز أيضا.