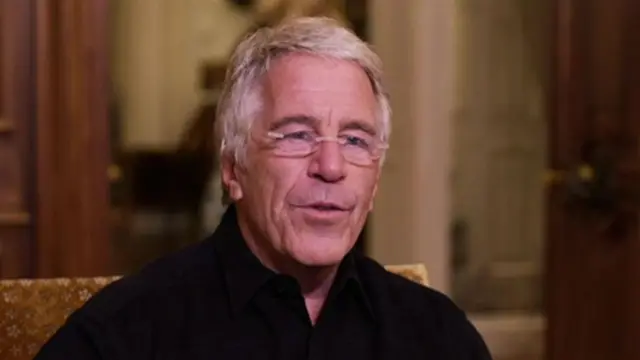ملف - قانون - تجريم الإثراء - أثرياء المغرب ملف.. قصة قانون تجريم الإثراء الذي قض مضجع أثرياء المغرب

-

تيلي ماروك
نشرت في : 09/03/2020«كان الملك الراحل يستعرض عددا من التقارير التي أنجزها الأمريكيون بخصوص الاقتصاد في دول شمال إفريقيا، وكان يعلم أن الأمريكيين يتوفرون على معلومات كثيرة بشأن التحديات الاقتصادية التي يعرفها المغرب. وحسب معطيات رسمية بهذا الخصوص، فإن الأمريكيين حذروا من تبعات توظيف رؤوس الأموال السوداء في عدد من المشاريع، وتأخر أخرى أو تجميدها بسبب رؤوس الأموال غير المشروعة، خصوصا منها التي تم تحصيلها عن طريق التهريب أو حتى عن طريق تجارة المخدرات.
هذا الأمر، خلص إليه المغرب سنة 1996 في إطار الحملة التطهيرية التي أطلقها الملك الراحل، بعد اجتماعات وزارية مع أعضاء الحكومة المغربية وقتها، حيث أعطى الملك تعليمات عاجلة لا تقبل التأخير لفتح تحقيقات بشأن ثروات عدد من رجال الأعمال وموظفي الجمارك وحتى الوزراء، لمعرفة مصادر ثرواتهم ومصادرة الأموال السوداء التي كانت تقبع بطرق غير قانونية خارج الأبناك، أو يتم تجميدها في مشاريع عقارية توقفت الأشغال بها في عدد من المدن بسبب تعقيدات الإدارة أو عدم احترامها للقانون.
هناك محطات كثيرة مر منها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع.. وهذه أبرزها».
قصة مشروع القانون الذي قض مضجع الأثرياء النافذين
خاب أمل الذين تابعوا معركة مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي طالما لوحت به الأغلبية والمعارضة كشرط أساسي لتخليق الحياة السياسية والضرب على يد المفسدين ومستغلي السلطة والمزاوجين بينها وبين المال.
بدا مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، ووزير العدل السابق، محايدا وهو يتحدث عن «أسف» ما على عدم تمرير مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وقال ما معناه إن المغرب ضيع فرصة أخرى في الحرب ضد الفساد.
الإثراء غير المشروع كان موضوعا مثيرا في عدد من المحطات السياسية، وللأمانة فقط، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها تمرير القانون والتصويت عليه في البرلمان. فمنذ تأسيس البرلمان المغربي سنة 1963، وموضوع الإثراء غير المشروع لعدد من السياسيين وفريق من رجال الأعمال المعروفين بقربهم من السلطة.
أقوى هذه المحطات كان سنة 1978 على عهد وزير الداخلية بنهيمة. وكان وقتها المغرب يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وتبعات الحرب في الصحراء، بالإضافة إلى موسم جفاف فلاحي خانق. وكانت المعارضة، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تكتب مقالات نارية عن ضرورة محاسبة المفسدين والتدقيق في مصادر ثروة عدد من النافذين.
وشاع وسط الرأي العام أن الملك الراحل الحسن الثاني بادر إلى عقاب بعض الموظفين السامين بمصادرة الممتلكات التي راكموها بعد توليهم مناصب المسؤولية. لكن تلك المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة، ولم تكن صادرة بشكل رسمي عن مؤسسة دستورية أو سياسية.
قبل مرحلة 1978، كان المغرب يعيش على إيقاع أمل سياسي في التغيير، خصوصا بعد الخطاب الملكي سنة 1972، حيث وعد الملك الراحل بانفراج سياسي عقب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين ومحاكمة الوزراء الفاسدين وتمتيعهم بعفو ملكي، بالإضافة إلى العفو عن المتابعين في محاكمة مراكش الشهيرة، التي انتهت أطوارها وصدرت الأحكام المتعلقة بها في الفترة نفسها.
هذا الأفق السياسي الجديد الذي وُلد في المغرب مع بداية السبعينيات، واجهه تقوي لبعض الأسماء الأمنية بعد رحيل الجنرال أوفقير، وصعود نجم الدليمي كمسؤول أمني رفيع ومسؤول عن ملف الصحراء. وقتها لم يكن الاقتراب من أصدقاء الجنرال ممكنا، خصوصا وأن المعارضة كانت تتذمر دائما من الحظوة التي يتميز بها الأمنيون، ومنهم من أصبحوا من ملاك المشاريع الكبار. لكن الحديث عن ثروة الجنرال أوفقير كان ممكنا، خصوصا بعد مصادرة بعض الممتلكات التي كان يملكها أصدقاء الجنرال المقربون. وسبب المصادرة كان هو الاشتباه في أن تكون تلك الممتلكات قد حازها الجنرال من موقعه وفوتها إلى مقربيه. أو هكذا أُريد للأمر أن يكون.
أما بعد 1978 فقد كان المغرب على موعد مع زمن إدريس البصري، الذي صار عمليا وزيرا للداخلية في نهاية السبعينيات، وبدأ تقوية ركائزه فيها مع بداية الثمانينيات، وشكل وصوله وقتها إلى الداخلية خيبة كبيرة للمعارضة التي كانت تتوسم الكثير في تلك الانتخابات.
هكذا عاقبت الدولة المشتبه في مصادر ثروتهم
سواء بعد الاستقلال سنة 1956، أو قبله بقليل، كان موضوع ثروة عدد من النافذين المغاربة محط مجهر التساؤلات. قبل الاستقلال، لم يكن هناك إطار دستوري لطرح هذه الأسئلة، إلا أنها كانت دائما تُترجم إلى سلوك على الشارع.
وقعت اغتيالات كثيرة قبل الاستقلال، خصوصا سنة 1954، استهدفت قيادا وباشوات، وأعوان سلطة في ضواحي الدار البيضاء، خصوصا في منطقة الغرب، ليس فقط بسبب موقفهم السلبي من نفي الملك الراحل محمد الخامس، ولكن أيضا بسبب اتهامات وجهت إليهم عن طريق منشورات المنظمات السرية والحركة الوطنية، تتهمهم فيها بمراكمة الأموال من مناصبهم وتواطؤهم مع المعمرين الفرنسيين.
هذه الاغتيالات كانت موضوع تقارير أمنية ساخنة، رصدت في بعض حالاتها، خصوصا المؤرخة في يوليوز 1954، أيام 14 و18، والمسجلة تحت رقم 243-54، أن عددا من أعوان السلطة لم يتم الاكتفاء باغتيالهم إما طعنا أو رميا بالرصاص، وتعداه إلى مهاجمة ممتلكاتهم ومصادرتها باسم المقاومين على اعتبار أنها تحصيل من مصادر غير مشروعة وعن طريق استغلال مناصبهم في السلطة لمراكمتها.
بعد الاستقلال، كانت التساؤلات الأكثر شعبية بخصوص نافذين من عائلات كانت تتعامل مع الاستعمار ووصل أبناؤها إلى المناصب. ما مصدرها؟ كيف راكمها أصحابها؟ وهل كانوا يؤدون ضرائب عنها للدولة؟
هذه الأسئلة نُقلت من الصحافة وقتها إلى قبة البرلمان، وكانت موضوعا محرجا لوزراء في الدولة كما سنرى في هذا الملف.
تدخل الملك الراحل محمد الخامس خصوصا في أزمات حكومة 1956 و1958، وأيضا خلال فترة حكومة عبد الله إبراهيم، ليفك بعض المشاحنات الصاخبة التي وصل صداها من مكتب الوزير الأول في المشور، إلى الديوان الملكي.
كان الملك الراحل الحسن الثاني وقتها وليا للعهد، وكان على علم بكواليس تلك الاتهامات التي وجهت إلى أسماء قوية في الدولة، من طرف المعارضة والمقاومين السابقين، بخصوص مصادر ثروتهم وسر تزايد ممتلكاتهم مباشرة بعد الاستقلال والمطالبة بمحاسبتهم.
عندما وضع دستور 1963، كان علال الفاسي ورضا اكديرة وآخرون ينكبون على مناقشة مضامينه مع الملك الراحل الحسن الثاني بشكل مباشر. وكان موضوع محاسبة الجميع، بمن فيهم المسؤولون، عن مصادر ثروتهم وضرورة التصريح بها قبل المناصب وبعدها.
كان هذا المعطى يحتاج إلى تنزيل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء به من مواد الدستور. ورغم أن الدستور الذي تبعه كان، حسب ما كتب عنه، تراجعا كبيرا عن المكتسبات السابقة، وركز على المشاكل الأمنية والظرفية السياسية التي كان يمر بها مغرب الستينيات، بدل تعزيز المكتسبات الحقوقية والمساواة.
اليوم، بعد ستين سنة تقريبا على هذه الوقائع، كانت لدى الحكومة فرصة ثمينة لدخول التاريخ بتمرير مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، لكن التخاذل والارتباك، ثم الصمت، الذي تلى العملية برمتها.. يُضمر أكثر مما كشف عن التقاعس الحكومي في محاربة الفساد.
برلمان 1963.. أول موعد سمع فيه المغاربة بمحاربة الفساد المالي
في سنة 1962، عرف المغرب ميلاد أول دستور في المملكة، بالإضافة إلى أول استحقاقات انتخابية. كانت صحف المعارضة تصف الدستور بـ«الممنوح» والانتخابات بـ«المخدومة». لكن مباشرة بعد تلك الانتخابات، أصبح المغاربة على موعد مع أولى نُسخ البرلمان المغربي الذي انطلق سنة 1963.
كان وقتها عبد الكريم الفيلالي، المؤرخ السابق للمملكة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مرشحا حرا لا يميل إلى أي لون حزبي، رغم أن مواقفه كانت تُحسب على الاتحاديين وصداقاته مع الاستقلاليين كانت متشعبة، لكنه قصفهم من منصة البرلمان عندما نادى بتفعيل ما أسماه «من أين لك هذا؟»، كشعار على ضرورة فتح المحاسبة لتطال المسؤولين الكبار في المؤسسات العمومية والوزارات.
كان نشاط الاتحاديين في البرلمان، باعتبارهم القوة المعارضة الحزبية الوحيدة في المغرب والقوية أيضا على الأرض، يذهب في الاتجاه نفسه، لكن الدكتور عبد الكريم الفيلالي كان له السبق في إثارة الموضوع في البرلمان ونُقل شعاره على لسان ممثلي الأحزاب، حتى أن صحيفة «العلم»، لسان حال حزب الاستقلال، كتبت شعار الفيلالي بالخط العريض على صدر صفحاتها، تنويها بمبدأ الدعوة إلى المحاسبة.
لكن موضوع مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، والذي سوف يكون مقربون من السلطة وقتها على رأس لائحة المستهدفين منه، لم يكتب له أن يوضع بشكل رسمي لكي يتم التصويت عليه. لكنه مورس بطريقة غير مباشرة عندما دعا البرلمانيون الاتحاديون إلى محاسبة عدد من الوزراء، منهم من كانوا أصدقاء الملك الراحل الحسن الثاني مثل رضا اكديرة ومولاي أحمد العلوي، وأيضا الوزير باحنيني. وشنت المعارضة ضد هذه الأسماء موجة هجوم استهدفت مواقفهم الشخصية، بل وذهبت حد التشكيك في وطنيتهم واتهامهم بالخيانة، وهو ما تسبب مرات كثيرة في رفع جلسات الأسئلة الشفهية الموجهة إلى الوزراء الذين كانوا يحضرون للإجابة عن تساؤلات النواب. والمثير أن جل تلك الجلسات كانت تنقل على الهواء مباشرة، ويتابعها جل المغاربة على أمواج الراديو، وتم قطع البث في مناسبات كثيرة، بعد تبادل الاتهامات والملاسنات بين هؤلاء النواب والوزراء.
في خطاب للملك الراحل الحسن الثاني سنة 1965، أشهرا قليلة قبل حل الحكومة والبرلمان وإعلان حالة الاستثناء، كشف لأول مرة عن عدم رضاه عن أداء الحكومة والبرلمان ووصف الجلسات التي يتم فيها تبادل الاتهامات بالسيرك، وأوضح بشكل مباشر أنه غير راض نهائيا عن عمل الحكومة. وكانت تلك المرة الأولى التي يحاسب فيها الملك الراحل الحكومة بشكل مباشر، ويأمر بحلها وإغلاق البرلمان ليشرف بنفسه على سير الوزارات.
كواليس التقارير الأمريكية التي تحدثت عن حرب «الثروة السوداء»
في شتنبر سنة 1972، كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلم أن علاقته بالملك الراحل الحسن الثاني لم تكن على ما يرام. فآخر اتصال رسمي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التاريخ، كان خلال وصول نائب الرئيس إلى الرباط لتقديم التهاني إلى الملك الحسن الثاني، بعد نجاته الأسطورية من المحاولة الانقلابية التي استهدفت الطائرة الملكية وهي تدخل الأجواء المغربية وعلى متنها نخبة المسؤولين المغاربة الكبار، بعد أن رافقوا الملك خلال جولة دبلوماسية في أوربا.
يومها، وحسب ما كشفته التقارير الدبلوماسية التي رُفعت عنها السرية، فإن الملك الحسن الثاني أعرب بشكل مباشر عما كان يخالج صدره من استحالة علم الأمريكيين بكواليس الإعداد للانقلاب عليه، والذي انطلق من القاعدة الأمريكية في القنيطرة. ورغم أن الرئيس الأمريكي في تهنئته الشفهية للملك، حاول التأكيد على أن إدارته لم تكن لديها أي معلومات استخباراتية بذلك الخصوص، إلا أن مخاوف الملك الراحل وانزعاجه ظلت قائمة لفترة، ولم تزل إلا في سنوات الثمانينيات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد من الزعماء العرب بخصوص القضية الفلسطينية.
بالمقابل، كان الملك الراحل يستعرض عددا من التقارير التي أنجزها الأمريكيون بخصوص الاقتصاد في دول شمال إفريقيا، وكان يعلم أن الأمريكيين يتوفرون على معلومات كثيرة بشأن التحديات الاقتصادية التي يعرفها المغرب. وحسب معطيات رسمية بهذا الخصوص، فإن الأمريكيين حذروا من تبعات توظيف رؤوس الأموال السوداء في عدد من المشاريع، وتأخر أخرى أو تجميدها بسبب رؤوس الأموال غير المشروعة، خصوصا منها التي تم تحصيلها عن طريق التهريب أو حتى عن طريق تجارة المخدرات.
هذا الأمر، خلص إليه المغرب سنة 1996 في إطار الحملة التطهيرية التي أطلقها الملك الراحل، بعد اجتماعات وزارية مع أعضاء الحكومة المغربية وقتها، حيث أعطى الملك تعليمات عاجلة لا تقبل التأخير لفتح تحقيقات بشأن ثروات عدد من رجال الأعمال وموظفي الجمارك وحتى الوزراء، لمعرفة مصادر ثرواتهم ومصادرة الأموال السوداء التي كانت تقبع بطرق غير قانونية خارج الأبناك، أو يتم تجميدها في مشاريع عقارية توقفت الأشغال بها في عدد من المدن بسبب تعقيدات الإدارة أو عدم احترامها للقانون.
لقد كان المغرب يقترب من السكتة القلبية ولم تتم الاستجابة للمبادرات الملكية بشأن الاستثمار، وهو ما جعل الملك الراحل يفتح باب المحاسبة على مصراعيه، حيث زُج بعدد من رجال الأعمال وموظفي الإدارات العمومية في السجون بتهمة الفساد، لكن تم اكتشاف تلاعبات بشأن توجيه التهم، حيث كان تيار الوزير القوي إدريس البصري قد استغل هذه الوقائع لتصفية الحسابات مع معارضيه بدل تفعيل مبدأ المحاسبة على الجميع، وهو ما انتهى بإطلاق سراح عدد من الموظفين، الذين ثبت أنهم أقحموا فقط لمعارضتهم سياسة إدريس البصري في الداخلية. وتم الاستماع إلى بعضهم في جلسات الإنصاف والمصالحة، بعد طي مرحلة إدريس البصري نهائيا.
الثروة السوداء، هي إذن ما انتبه إليه الأمريكيون منذ ستينيات القرن الماضي، وحذروا بشأنها مقربين من الملك الحسن الثاني، كما أثبت الوثائق الدبلوماسية التي رفعت عنها السرية. وأقوى مثال على ذلك هو المعلومات التي نقلها الكولونيل المذبوح الذي قال للملك الراحل الحسن الثاني سنة 1970 إن عددا من المسؤولين الكبار متورطون في رشاوى بملايين الدولارات، طلبوها من أمريكيين كانوا ينوون الاستثمار في المغرب. ولاحتواء الوضع ظهرت قضية محاكمة الوزراء سنة 1970 دائما، وتم طي الملف. لكن الأمريكيين بقوا يرصدون وجود الثروات المشبوهة والأموال المهربة، فيما كان المغرب يعرف صعوبات سياسية كبيرة لتفعيل مبدأ المحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع.
سر مشروع لـ«المحاسبة» أطلقه الحسن الثاني وأفشله إدريس البصري
في خريف سنة 1981، توصل الملك الراحل الحسن الثاني بتقرير مالي يتضمن بعض التوصيات الدولية بخصوص القروض الممنوحة للدول السائرة في طور النمو، مع مقترحات لإصلاحات مالية.
أمر الملك الراحل إدريس البصري، الذي كان قد وصل وقتها إلى وزارة الداخلية بثلاث سنوات فقط، بإقامة دراسة يشرف عليها مكتب الشؤون السياسية بوزارة الداخلية. وهذا الأمر يشهد عليه اثنان من موظفي الداخلية كانا قد تمرنا على يد المخضرم «جوريو»، الذي اشتهر بالإشراف على الأمور الإدارية بوزارة الداخلية، فور مغادرة المعمرين الفرنسيين للوظائف العمومية. وحسب المصدر الذي سرب المعلومة لـ«الأخبار»، فإن إدريس البصري عقد اجتماعا في وزارة الداخلية مع عدد من الأطر لوضع تصور بناء على تقارير وضعها الولاة والعمال، للخروج بتقرير شامل عن طرق صرف أموال الدولة في القطاعات التابعة لوزارة الداخلية.
وكان وقتها إدريس البصري قد أشرف على وضع أولى بصماته على الوزارة وعين عددا من أصدقائه في مناصب بالعمالات والأقاليم، ومشروع المحاسبة كان يضرب عكس تطلعات الوزير القوي، الذي كان يرمي إلى تقوية رجاله في رقعة خارطة وزارة الداخلية.
حسب عدد من الشهادات التي تناولت علاقة إدريس البصري، سواء بالسلطة أو الإعلام أو حتى الرياضة، فإن تأكيدات كثيرة بشأن توظيف الرجل لسلطته وزيرا للداخلية ومسؤولا أمنيا سابقا، للتأثير على القرار السياسي كانت واضحة. ولعل قضية صديق الملك الراحل الحسن الثاني، سليل أسرة الشرادي الذي كان عاملا على الناظور، ثم مديرا للخطوط الملكية المغربية، أكبر دليل على أن إدريس البصري كان بمقدوره الضغط حتى لا يصفى ملفه، رغم صدور حكم قضائي لصالح عائلة صديق الملك على إثر نزاعات حول المِلكية.
مثال آخر، تجلى في فرض إدريس البصري لبعض المحسوبين عليه لكي يكونوا مشرفين على الأمور الإدارية في عدد من العمالات الترابية بمختلف الجهات. ورغم بعض الاعتراضات التي قادها برلمانيون من المعارضة وحتى زعماء أحزاب، خصوصا من اليسار، فإن تلك المجهودات لم يكن لها إلا رجع الصدى، ولم يزدد إدريس البصري إلا قوة ضاربا عرض الحائط مشروع قانون المحاسبة، الذي لم يكتب له حتى أن يناقش تحت قبة البرلمان.
كان عبد الرحيم بوعبيد، رمز المعارضة والقطب الاتحادي القوي، يخرج في حوارات صحافية مع منابر من المعارضة وأخرى بالخارج، وأعلن في مرات كثيرة عن وجود قوة داخلية تمنع الإصلاح الذي تنادي به الأحزاب. في الحقيقة كان إدريس البصري يأخذ أعداد تلك الصحف والمجلات ويرمي بها غاضبا فوق مكاتب موظفي ديوانه، رافضا أن تتم الإشارة إليه ولو دون ذكر اسمه. فقد كان يعرف أن عبد الرحيم بوعبيد كان يقصده هو تحديدا، وكثيرا ما كان يرفع تظلمات شفهية للملك الحسن الثاني بذلك الشأن. وهو الموضوع الذي انفجر سنة 1995، عندما نادت الكتلة بشرط إبعاد إدريس البصري عن الحياة السياسية، مقابل تأسيس حكومة وحدة وطنية، في إطار التناوب المُجهض في نسخته الأولى. لقد كان إدريس البصري في الحقيقة ينتصر على تفعيل سياسة المحاسبة ومراقبة ثروات عدد من المسؤولين.
حروب المخزن ضد الفساد.. هذه أسر قادتها المحاسبة إلى النفي من السلطة
على مدى قرن ونصف القرن، عصف الفساد واستغلال النفوذ بعدد من الأسر المغربية التي كانت تعتبر لقرون من خدام «المخزن» الأوفياء. كل هذه الصراعات تقريبا لم تكن الدولة هي التي صفت خلالها هذه العائلات أو أدبتها، بقدر ما كان صراعها في ما بينها هو السلاح الذي كان يبعد الهالك منها عن المسؤولية والحياة السياسية. وخلال تلك الحروب تبادلت هذه العائلات اتهامات باستغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير المشروع. وكان «تجريم الإثراء غير المشروع» جريمة يعاقب المخزنيون بعضهم بعضا بسببها، وتصل العقوبة أحيانا إلى إراقة الدماء أو النفي ومصادرة كافة الممتلكات. تماما كما وقع خلال بداية القرن 19 مع أسرة الجامعي والصدر الأعظم باحماد. هذه الأسرة التي صاهرت القصر الملكي وكان كل أبنائها من أصحاب المناصب الكبرى في الوزارات وداخل القصر الملكي وحتى في الجيش، تعرضت للإبعاد وصودرت ممتلكات أفرادها جميعا وسُجن منهم من سجن على يد أباحماد الذي كان في أواخر سنوات حكم المولى الحسن الأول، من أقوى رجال الدولة. ورغم أنه لم يكن وزيرا ولا موظفا مخزنيا، وإنما حاجبا من خدام دار المخزن، إلا أنه كان أقوى من كل الوزراء واستطاع تأديب أسرة الجامعي بعد أن كان يتهمهم صراحة بمراكمة الأموال عن طريق السيطرة على المناصب المهمة في الدولة وتوريثها إلى أبنائهم.
يقول ذ. بوشتى بوعسرية في كتابه «معلمة المغرب» متحدثا عن آل الجامعي: «أسرة فاسية عريقة تنتسب إلى قبيلة أولاد جامع.. وأصبحوا ينتسبون هكذا: «الجامعي»، بدل «ابن جامع»، منذ أن استوطنوا الجهة»الشرقية الشمالية لمدينة فاس، وربما كان ذلك في عهد الدولة السعدية.. وانضمت هذه القبيلة سنة 1849 إلى الجيش المخزني الذي نظمه السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1859/1822)، على إثر هزيمة القوات المخزنية في معركة إيسلي (غشت 1844). وارتقى أفراد من الجامعيين إلى مستوى كاتب وزير خلال حكم السلطان المذكور، والمقصود هو العربي بن المختار الجامعي، واحتل ابنه محمد المنصب نفسه في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان (1873/1859)، الذي كانت تربطه علاقة مصاهرة مع آل الجامعي، لأن زوجته لالة الطام تنتمي إلى قبيلة أولاد جامع، وهي أم السلطان مولاي الحسن (1894/1873). ونظرا لهذه القرابة، فقد أصدر سيدي محمد بن عبد الرحمان ظهيرا بتاريخ 2 غشت 1866، أسدل به أردية التوقير والاحترام على أصهاره وخاصة منهم محمد بن العربي بن المختار الجامعي، كاتبه – أي وزيره – في حين أسند إليه ابنه مولاي الحسن منصب الصدارة العظمى».
المولى عبد العزيز الذي حكم المغرب سنة 1894، كان له صديق بريطاني هو والتر هاريس، صاحب مؤلف «المغرب الذي كان»، أو «المغرب المنقرض». هذا الصديق البريطاني الذي استقر في المغرب لسنوات في عهد المولى عبد العزيز، وأصبح صديقا للوزراء والأعيان، تحدث عن نكبة الجامعي في إطار العقاب المخزني الذي نزل بهم بسبب الثروة: «بعد أيام من وفود الموكب السلطاني على مكناس، انعقد مجلس الصباح الاعتيادي (للوزراء). ولج الحاج المعطي، الصدر الأعظم، ساحة القصر، محاطا بحاشيته ذات اللباس الأبيض، ولج بينما الخدم ينحنون له والجنود يؤدون له التحية. وعلى التو، أُذِن له بمقابلة السلطان.
حين دخل الحاج المعطي، وجد مولاي عبد العزيز بمعية أبا حماد بمفرده، انحنى وانتظر أن يعطيه السلطان الكلمة. طرح عليه مولاي عبد العزيز سؤالا بنبرة ملؤها الجفاء. لم يعتبر جواب الحاج المعطي مقنعا، فانطلق أبا حماد في إطلاق سيل من الانتقادات ضد الصدر الأعظم، متهما إياه بالخيانة والبخل والابتزاز واقتراف جرائم سياسية.
وفجأة، توسل للسلطان أن يأمر باعتقاله. فطأطأ مولاي عبد العزيز رأسه في إشارة إلى موافقته على طلب حاجبه.
(..) اقتيد الوزيران السابقان (الحاج المعطي ومحمد الصغير) إلى السجن بتطوان، وهناك كانت السلاسل مصيرهما فَغُلاَّ في ضيافة برج الاعتقال. وبعد مرور ثلاث سنوات، وهي مدة بدت للحاج المعطي وكأنها الأبد، توفي هذا الأخير. لم يجرؤ عامل تطوان على دفن الجثة، إذ انتابه الهلع من فرضية اتهامه بمساعدة السجين على الفرار، لم يجد بديلا عن مكاتبة البلاط كي يتم تزويده بتعليمات. كان الوقت صيفا والحرارة مفرطة في حصن الاعتقال، لم يكن بالإمكان التوصل بالجواب قبل مرور 11 يوما، وطوال هذه المدة، ظل سي محمد الصغير مغلولا جنب جثة أخيه».