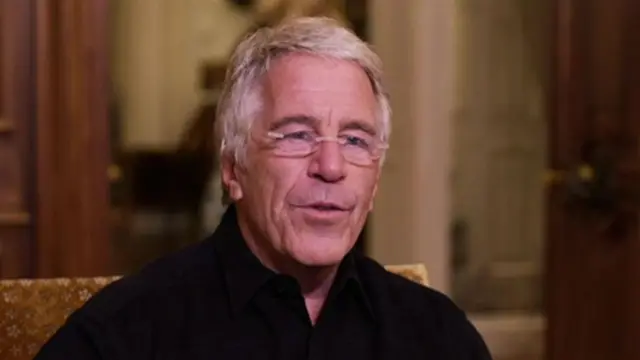خدام الدولة - دفع الأضرار - المغرب ملف.. حين ينخرط خدام الدولة في جهود دفع الأضرار عن العباد والبلاد

-

تيلي ماروك
نشرت في : 23/03/2020لم يمر وقت طويل على مبادرة الملك محمد السادس لخلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل التخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية، وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء، حتى استجاب الأثرياء بدرجة أولى للنداء.
إحداث الصندوق لا يعفي الحكومة من المساهمة في دعمه، حيث إنها رصدت ما مجموعه عشرة ملايير درهم من ميزانية الدولة، تكريسا للروح التضامنية التي أبان عنها مجموعة من خدام الدولة الميسورين وكذا القطاع الخاص، ما سيوفر موارد إضافية للصندوق.
تسابق رجال المال والأعمال من خدام الدولة للانخراط في المبادرة وأبانت فئة منهم عن حس وطني كبير، ومنهم من دعم بشكل شخصي وساهم كرئيس مجلس إدارة مؤسسة اقتصادية. من جهتهم، ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم، بالرغم من التفاوت من حيث الذخيرة المالية بين عضو حكومي وآخر. كما ساهم رؤساء هيئات ومؤسسات دستورية ووطنية براتب شهر واحد لفائدة الصندوق، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات هذا الوباء، فضلا عن انخراط الهيئات القضائية وكل من له صلة بالدولة ككيان.
في هذا الملف سنسلط الضوء على أثرياء المغرب، الذين تبرعوا من مالهم الخاص ولبوا نداء الواجب في الفترات العصيبة التي مرت بها بلادنا من أوبئة، جفاف وزلازل، وقس على ذلك من النكبات التي تطلبت حضور الحس التضامني، وكشفت عن الوجه الآخر لأصحاب الجاه، خاصة خدام الدولة.
كانت الأميرة لالة عائشة التي ولدت بالرباط في 17 يونيو 1930، تتمتع في طفولتها بذكاء ملحوظ وحس تضامني كبير. شهد لها بذلك أساتذتها، وأسند إليها الملك محمد الخامس وهي في شبابها مسؤوليات تمثيل المرأة المغربية، وقامت في هذا المجال بدور فعال بل إنها سجلت حضورا ملفتا سنة 1947، حين زار الملك محمد الخامس مدينة طنجة، وألقت يومها الأميرة لالة عائشة في تلك المناسبة خطابا مهما، بعد خطاب والدها التاريخي الذي أعلن فيه انتماء المغرب للأمة العربية والعالم الإسلامي، وعمرها لم يكن يتجاوز 17 سنة، على حد قول المؤرخ الفرنسي سان برو.
لما نفي الملك محمد الخامس وأسرته عام 1953، انقطعت الأميرة عن الدراسة ولم تتابع تعليمها الجامعي، وبعد عودة الأسرة الملكية من المنفى شاركت في الحياة السياسية، وذلك في السنوات الأولى من الاستقلال، فشغلت عددا من المناصب في ميدان الشباب والطفولة والعمل الاجتماعي وفي المجال الدبلوماسي. كما شاركت في عدد من اللقاءات الوطنية والدولية.
في 27 أبريل 1957 أسندت إليها رئاسة مؤسسة التعاون الوطني، ورافقته في أول مهمة إلى أكادير، وفي اجتماع تحت خيمة بالقرب من تالبورجت المنكوبة، كلف الملك محمد الخامس الأميرة لالة عائشة بجمع التبرعات باعتبارها رئيسة للتعاون الوطني، كما كلفها بالاتصال بالعمال على مستوى أقاليم المملكة، بتنسيق مع وزير الداخلية، من أجل تدبير المساعدات والهبات التي ستعرف طريقها إلى مدينة أكادير، كما دعاها لعقد اجتماع مع الجنرال إدريس بنعمر ومع وزير الخارجية من أجل إحداث خلايا على مستوى البعثات الدبلوماسية لمساندة المدينة المنكوبة، وخلق جسور جوية للإعانات بكل أشكالها.
جاء خطاب الملك محمد الخامس الذي حمل التكليفات السامية وزيارته إلى أكادير رفقة ممثلي السلك الدبلوماسي مؤشرا على تدويل النكبة، وإعطائها بعدا كبيرا يتجاوز كارثة محلية، لكن الأيادي الآثمة ظلت تعبث بهذه الإعانات خاصة العينية منها، ليس في مدينة أكادير بل ابتداء من النقط الحدودية في مطار بنسركاو أو ميناء المدينة ومطار النواصر ومطار سلا ومعبر زوج بغال بالحدود المغربية الجزائرية، التي كانت تحت المراقبة الفرنسية لأن الجزائر لم تنعم حينها بالاستقلال، وهو ما دفع لالة عائشة إلى عقد اجتماعات يومية مع الأجهزة القضائية والأمنية.
أخنوش الأب يتبرع بالغاز مجانا أثناء المسيرة الخضراء
قبل أن يصبح وزيرا وأمينا عاما لحزب سياسي، يرتبط عزيز أخنوش بشجرة أنساب الوجهاء وخدام الدولة، فهو ابن رقية عبد العالي، شقيقة عبد الرحمان بن عبد العالي، أول وزير للأشغال العمومية في حكومة عبد الله إبراهيم في نهاية خمسينات القرن الماضي، وهو أي خاله عبد الرحمان، زوج عائشة الغزاوي، ابنة القيادي الاستقلالي محمد الغزاوي، أول مدير عام للأمن الوطني ومدير سابق لقطاع الفوسفاط وسفير سابق للمملكة بعدة دول، بالإضافة إلى أنه كان صديقا حميما للسلطان محمد الخامس. وتعد عائشة الغزاوي، زوجة خاله مرة أخرى، هي أم مليكة زوجة الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس.
وكان الحاج أحمد بن محمد بن إبراهيم أخنوش، وهو من مواليد سنة 1909، في قرية أكرض أوضاض التابعة لتافراوت بجبال الأطلس الصغير، قد نشأ وترعرع داخل عائلة تسمى آيت براهيم، نسبة إلى جد أقصى اسمه إبراهيم بن إعزا أخنوش، أول من استقر من تلك العائلة في القرية.
في كتابه «العصاميون السوسيون في البيضاء»، أرجع عمر أمرير، الباحث في التراث الأمازيغي، علاقة السوسيين بالثراء بانتقالهم إلى الدار البيضاء سنة 1784. حيث تمكن المهاجرون من تافراوت بعصاميتهم من الانتقال إلى الوجاهة المالية، «غادر الحاج أحمد أولحاج أخنوش دواره أكرض أوضاض بتافراوت، ترك البيت تحت رحمة صخرة قبعة نابليون لينتقل إلى العاصمة الاقتصادية، هناك كان التفراوتيون شرعوا في ترسيخ أقدامهم المالية ففتح أول محل له خاص ببيع المواد البترولية بالتقسيط. تدور الأيام فسارت أشغاله بشكل جيد لتصبح في ملكيته سبعة دكاكين. كانت تلك أولى مؤشرات النجاح الذي يبشر بمستقبل زاهر ينتظر ابن أكرض أوضاض. المستقبل سيتضح أكثر بعد سنوات حينما سيعود إلى أكادير ويؤسس بها مصنعا للرخام».
كانت أول المساعدات المالية من أحمد أولحاج موجهة إلى الحركة الوطنية، التي شرعت في حملت طرق أبواب التجار في درب عمر بالخصوص، وحين علمت السلطات الفرنسية بالأمر اعتقلته، حيث سجن الرجل ودمر مصنعه بالكامل.
سار أخنوش الأب من جديد على الطموح نفسه الذي رسخه والده، وكرر المحاولة بعد خروجه من السجن، رغم أنه وجد أعماله قد انهارت إلا أنه عاد من جديد إلى مجال البترول وأسس صحبة محمد واكريم شركة «إفريقيا». وفي سنة 1974 وبسبب الظروف الدولية سيعيش المغرب أزمة بترولية خانقة، فيصبح أحمد أولحاج رجل المرحلة بامتياز. استدعاه القصر الملكي وطلب منه أن يمد مختلف مرافق الدولة بمخزونه من البترول فوافق على الفور، وخلال المسيرة الخضراء مول المتطوعين بالغاز مجانا. وفي نهاية السبعينات سيتجه إلى عالم السياسة ليؤسس «حزب العمل»، وظهرت معارك بين البورجوازية السوسية ممثلة في الحزب الجديد والبورجوازية الفاسية التي تعيش في كنف حزب الاستقلال.
علاقة السوسيين بالتبرع في المحن ليست وليدة زلزال أكادير أو المسيرة أو الجفاف وكورونا، بل تعود إلى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، الذي استقدم عائلات سوسية لإعمار مدينة الدار البيضاء، على غرار عائلات: اجضاهيم والكنداوي وبراد والصنهاجي وبو الضربات وبو الزرع والكابوس وأناكوف وأبلاط والغزواني، ولعل جامع الشلوح بالمدينة القديمة يعد دليلا على مساهمتهم في بناء المساجد.
جد عثمان بن جلون.. الصندوق الأسود لسلاطين المغرب في القرن 18
ولد عثمان بن جلون عام 1932 في مدينة فاس، وسط أسرة ميسورة الحال، حيث كان والده عياش يملك مقاولة للنسيج، كما أن جده عرف بثرائه حيث كان من أكبر تجار فاس، وأبرز مستوردي الشاي من الصين إلى جوار الحاج عابد وحسن مول أتاي. لكن عثمان اختار سبيلا آخر بعيدا عن الشاي والنسيج، وقرر تنفيذ حلم المهندس المعماري الذي يسكنه. عاش الفتى جزءا من طفولته وشبابه في مدينة الدار البيضاء، إذ حصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية ليوطي، ويعلن هجرته نحو أوربا طلبا للعلم، إلى جانب شقيقه عمر، الذي كان يملك حسا تجاريا استباقيا، ويسعى إلى أن يصبح نسخة من جده الأكبر الخليع بن الطالب بن جلون، التاجر المقرب من سلاطين المملكة والذي كان يعتبر الصندوق الأسود لملوك الدولة العلوية، في القرن الثامن عشر الميلادي.
انخرط الملياردير المغربي عثمان بن جلون في الحملة التضامنية التي دعا إليها ملك البلاد، حيث أكدت جريدة «ليكونوميست» الاقتصادية، أن عثمان هو أول أغنياء المغرب المتبرعين لصندوق مواجهة كورونا، باعتباره أولا ثريا وبصفته المهنية كرئيس لبنك إفريقيا.
لم تقدم الصحيفة القيمة المالية للمبلغ المتبرع به، لكنها قالت: «إنه وبعد مشاوراته مع المساهمين الرئيسيين للبنك، فقد قرر تخصيص الأرباح الموحدة للبنك في الربع الأول من العام الحالي، بعد الخصم الضريبي، للصندوق الذي تم إنشاؤه لدعم الشركات المتضررة».
سطع نجم عثمان خلال نكبة زلزال الحسيمة في فبراير 2004، حين قدم تبرعات كبرى وساهم في بناء كثير من المساكن التي تحولت إلى خراب، لأن علاقة مصاهرة تربط هذا الفاسي بأبناء الريف، إذ يقترن بالدكتورة ليلى أمزيان، نجلة المارشال محمد أمزيان، الذي تعتبره الروايات من القيادات العسكرية الإسبانية التي كان لها دور في قمع انتفاضة الريف، لكن الزوجة الأمازيغية وليدة بني نصار قرب الناظور، ظلت حريصة على الدفع بزوجها نحو الاستثمار الإنساني في دعم الهوية الأمازيغية من خلال تأسيسها لصحيفة «العلم الأمازيغي» ومساهمتها في دعم مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تناضل في جبهة الهوية، كما قدمت بدورها دورا كبيرا في التخفيف من أضرار فاجعة زلزال 2004 الذي ضرب مدينة الحسيمة.
مولاي حفيظ العلمي.. الطفل اليتيم الذي أصبح مليارديرا
ولد مولاي حفيظ العلمي، في 13 يناير من سنة 1960 بمدينة مراكش، فقد والده الذي كان يشتغل آنذاك في وكالة بنكية وهو في سن العاشرة، كان مجبرا على «البلوغ» بسرعة وتحمل دور «رجل» الأسرة إلى جانب والدته، من أجل الحفاظ على سيرورة حياة عائلة مكلومة. هذا الفقد المأساوي والمفاجئ لوالده حفز لديه رغبة قوية في الحياة، حياة لم يخترها هو. حصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية «فيكتور هوغو»، التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية بمراكش، قبل أن ينتقل إلى كندا لمتابعة دراسته الجامعية وينال شهادة الماجستير في المعلوميات من جامعة «شيربروك» جنوب مقاطعة كيبك، حيث كانت أولى تجاربه المهنية هناك ليوازي بين وظيفتي التدريس بجامعة «لافال» الكيبكية والاستشارية بوزارة المالية الكندية، ثم شغل مدير نظم الإعلام في شركة كندية للتأمين.
ولدى عودته إلى المغرب، انضم إلى مجموعة «أونا» متعاونا مباشرة مع رئيسها سنة 1989. وبعد بضع سنوات، أنشأ مجموعته الخاصة «سهام» التي تعمل في التأمينات والتوزيع ومراكز النداء التلفونية وخدمات العقار. كما ساهم في المجال الخيري، من خلال جهوده داخل جمعية لالة سلمى لمحاربة السرطان.
في جهود التضامن الوطني، تبرع مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمبلغ 20 مليار سنتيم من ماله الخاص في صندوق مكافحة وباء كورونا بالمغرب، وكان الوزير قد شدد على ضرورة دعم القطاعات الصناعية المتأثرة بوباء فيروس كورونا المستجد، في مداخلة له خلال اجتماع عقده مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية في القطاع الصناعي، حيث دعا العلمي إلى اليقظة ودعم القطاعات التي تواجه صعوبات، للتغلب على فترة الأزمة التي يمر بها العالم. مشددا على ضرورة «التماسك والاصطفاف» بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين من أجل متابعة عن كثب لصحة المقاولات حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية.
علي بن الغالي الكتاني.. تبرع بمليوني دولار لبناء مسجد الحسن الثاني
بدأت قصة نجاح علي بن الغالي الكتاني حين توفي والده، إذ اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة الجامعية والاشتغال بالتجارة، ففتح متجرا لبيع الأثواب وهو مازال في أول شبابه، وجعله ناديا للطلبة والمثقفين، ورجال الحركة الوطنية.
انتقل الشاب إلى رتبة رجل أعمال من الدرجة الأولى، ووصفته سير رجال الحركة الوطنية بالوطني المجاهد والسياسي المقتدر. ولد بفاس عام 1917، وتربى في كنف والديه، حيث حفظ القرآن الكريم على يد ثلة من علماء العاصمة العلمية، ثم دخل مدرسة عربية حرة بفاس، وتتلمذ على كثير من العلماء الشباب المؤسسين للحركة الوطنية، كابن عمه محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني، ثم انخرط في سلك طلبة جامعة القرويين.
«وفي عام 1947 انتقل للسكن بالدار البيضاء، حيث دخل ميدان التجارة بجانب نشاطه السياسي والوطني، باعتباره عضوا في حزب الشورى والاستقلال، بحيث يعد من الرعيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب، والمتخرجين من مدارسها، حيث كان مجاهدا مناضلا نشطا من أجل استقلال البلاد والحفاظ على هويتها»، كما يقول محمد بلحسن الوزاني.
بعد الاستقلال عين عضوا في المجلس الاستشاري، ونجح في الانتخابات النيابية ليصبح عضوا في البرلمان، وكان أول رئيس لغرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء، ورئيسا مؤسسا للغرفة الاقتصادية الفتية، ومندوبا للبلدان العربية والإفريقية في أشغال الأمم المتحدة المتعلقة بالتجارة الدولية «الكات».
كان عضوا نشطا في العديد من الجمعيات الخيرية، بحيث قام ببناء عدة مساجد ومصالح خيرية في أطراف المغرب، كما قام بعدة تبرعات خيرية أثناء فترات الجفاف، حيث ساهم في بناء مساكن في القرى، واقتنى عربات للمتضررين، وكفل العشرات من الأسر المحرومة والمعوزة، كما طبع نسخة من المصحف الشريف، وتبرع في بناء مسجد الحسن الثاني بما يعادل مليوني دولار.
عبد الرحمان بوفتاس.. الوزير المحسن
يعتبر عبد الرحمان بوفتاس من أعلام سوس وإقليم تيزنيت، رجل دولة وفاعل جمعوي من مؤسسي جمعية إيليغ للتنمية والتعاون، وزير سابق للإسكان في عهد الملك الحسن الثاني، كان حريصا على التواجد في جميع المناسبات المقامة في مختلف قبائل إقليم تيزنيت، مسجلا اسمه في لائحة المحسنين عند كل ضائقة.
قال عنه الدكتور محمد فاروق النبهان، مدير دار الحديث الحسنية: «من أبرز الشخصيات السوسية التي حظيت بالاحترام والتقدير، وهو رجل ثري وابن أسرة ذات مكانة اجتماعية، وله أعمال تجارية واسعة، عرفته لأول مرة عندما أسندت إليه وزارة السكنى، كنا نلتقي في المناسبات الرسمية، وهو سوسي أصيل، وله مكانة بين أبناء سوس، كان الكل يحبه ويثني عليه أولا بسبب أخلاقه السمحة، وثانيا بسبب ما اشتهر به من سخاء، كان بيته يدل على أنه بيت كرم وسخاء. كان من عادته في شهر رمضان أن يقيم حفلات الإفطار ويكرم العلماء الذين يفدون على المغرب في هذا الشهر للمشاركة في الدروس الحسنية، وكان صدره رحبا ونبيل الخصال. ينفق كل مرتبه عندما كان في الوزارة على مرافقيه لم يكن بحاجة إلى مرتبه، ولا أظنه كان يستفيد منه، وأسند إليه الملك الحسن الثاني رئاسة نادي الغولف الملكي في الرباط، وكان صديقا شخصيا لإدريس البصري، وزير الداخلية، وكانا يلعبان الغولف معا، قبل أن يصدر قرار بإعفائه من الوزارة».
خلال فترة إشرافه على النادي الملكي للغولف، كان يجد أمام بوابته العديد من المواطنين الذين ينتظرون مجيئه ليس للانخراط في نادي الغولف، بل أغلبهم يتأبطون ملفات تدعو بوفتاس لدعم مالي، بل منهم من كان يقطع مئات الكيلومترات من سوس إلى الرباط للاستفادة من سخائه.
محمد الغزاوي.. مدير الأمن يؤدي رواتب رجال الشرطة
صنع محمد الغزاوي لنفسه اسما في عالم السياسة، وكان دعم الاستقلاليين له لا يخفى على أحد، خاصة وأن علال الفاسي ظل يلح على الملك ويقنعه بأهمية إسناد منصب مدير عام للأمن إلى الغزاوي، وينقل له أخبار سخائه وكيف كان «يغدق على العاملين، الذين كانت أعدادهم غير كبيرة، بل ثمة من ذهب إلى أنه تعمد بأن يؤدي بعض الرواتب من ماله الخاص بدل خزينة الدولة، خصوصا في السنوات الأولى للاستقلال، التي كان المغرب قد بدأ فيها تنظيم هياكله».
في 22 مارس 1956 أسندت إلى محمد الغزاوي صفة مدير عام الأمن الوطني المغربي. وفي 28 أبريل 1956 تم تنصيب المدير رسميا، وبعد مرور شهر صدر ظهير شريف ينص على تأسيس الإدارة العامة الأمن الوطني المغربي، تحت وصاية وزارة الداخلية.
وبينما كانت أعداد أثرياء المغرب في خمسينات القرن الماضي تحسب على رؤوس الأصابع، كان محمد الغزاوي قد صنع لنفسه اسما ضمن قوائمها التي تذكر في المنتديات السياسية. غير أنه خلال عمله مديرا عاما للأمن، كان يغدق على العاملين، الذين كانت أعدادهم غير كبيرة، بل ثمة من ذهب إلى أنه تعمد أن يؤدي بعض الرواتب من ماله الخاص بدل خزينة الدولة، خصوصا في السنوات الأولى للاستقلال، التي كان المغرب قد بدأ فيها تنظيم هياكله الإدارية والمالية. «ثمة وزراء أو مدراء قلائل لم يكونوا يقبلون صرف رواتبهم من خزانة الدولة، قبل أن يأتي زمن آخر يردد فيه بعض كبار رجال الأعمال أن مصالحهم التجارية تضررت جراء الانصراف إلى العمل الحكومي. غير أن الغزاوي، الذي أقام قصرا فخما في أهم أحياء الرباط، غير بعيد عن إقامات عادية لرجال القصر، سيخطئ التقدير يوما، فقد فضل تنظيم عرس باذخ، في وقت اشتدت فيه الأزمة، ما حدا بالأصابع أن تشير إليه بسهام غير تلك التي كان يتلقاها بصدر رحب»، يقول نعمان الهاشمي.
المختار السوسي.. باع بيته ومكتبته وخصص جزءا من ماله لرعاية الأيتام
وصف رضى الله عبد الوافي، ابن العلامة والأديب والوزير محمد المختار السوسي، والدته صفية بنت إبراهيم التازروالتي، في كتاب تحت عنوان «أم الطلبة»، بالشريفة لالة صفية التي وهبت حياتها لخدمة طلبة العلم، إذ كانت تعتني في مدرسة الرميلة المراكشية «بإكرام طلبتها وضيوف زوجها العلماء والأدباء وغيرهم من الفضلاء».
وأضاف: «أما بيتنا فكان بمثابة زاوية يقصدها طلاب العلم الذين كانوا يمكثون معنا وكأنهم أفراد من الأسرة، وكانت والدتي صفية بنت إبراهيم ترعاهم وتخدمهم طيلة فترة تحصيلهم العلمي ومقامهم بمدرسة بزاوية والده الذي كان يلح على أدق التفاصيل وأبسطها، وفيها إشارة حتى إلى مصاريف البيت واحتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب، وأذكر أنه ختم رسالته بالقول: «وهكذا يا عبد السلام تضبط حسابك»، في إشارة إلى ميزانية البيت»».
لم يكن المختار مهتما بمنصبه الوزاري كوزير للتاج، بل كان همه الأول هو التأليف والعمل الخيري، بعد أن وجد في كتابه «المعسول» أجوبة للعديد من الأسئلة العالقة، سيما وأن كتابته عبرت مراحل عديدة من المعتقل إلى الاستوزار.
وعلى الرغم من بلوغه الوزارة، إلا أنه ظل يرصد راتبه للتأليف والإحسان، يقول ابنه رضى: «أمضى والدنا ما يقرب من الأربع سنين الأخيرة من حياته في طبع مؤلفاته، حيث طبع 35 جزءا منها، ولكي يتمكن من أداء نفقات الطبع، اضطر إلى بيع خزانة كتبه إلى جمعية علماء سوس، وكذلك بيع منزل له بالرباط، ومستعينا أيضا بما يخصصه لذلك من مرتبه الذي كان يتقاضاه عن منصبه في الوزارة وفي القضاء».
ساهم الرجل في وضع اللبنات الأساسية للجمعية الخيرية الإسلامية لمراكش، وحرص على دعم نزلائها والبحث عن سبل تشغيلهم.
الخطيب.. خصص عيادته لعلاج المرضى المعوزين
قال نيلسون مانديلا في خطبة تاريخية: «في سنة 1962 التقيت شخصية فذة في المغرب، وطلبت منه مساعدة الحركة التحررية في جنوب إفريقيا، بالسلاح والمال، لم يتردد في تحديد موعد في اليوم الموالي، بل كان ينتظرني قبل الموعد المتفق عليه، قال لي إذا حددنا موعدا في التاسعة صباحا فستجدني أنتظرك في الثامنة، سلمني 5 آلاف راند، وكانت قيمة الراند الواحد حينها فوق قيمته الحالية، لقد كان يساوي مليون راند، كما اقترح علي تحويل السلاح إلى عاصمة تنزانيا دار السلام فوافقت، لتصلني دفعة من الأسلحة في التاريخ المتفق عليه، هذا الرجل الذي أدعوكم للوقوف تحية احترام له، هو المغربي عبد الكريم الخطيب».
في تلك الحقبة التاريخية التي تحدث عنها مانديلا في خطبته، كان الدكتور الخطيب وزيرا في الحكومة المغربية الثانية مكلفا بدعم الحركات التحررية في إفريقيا، وهو المنصب الذي لم يعد له وجود في ما بعد. خلال فترة مقاومة الاستعمار، ظلت عيادة عبد الكريم الخطيب في درب السلطان بالدار البيضاء، مفتوحة بالمجان لفائدة المقاومين والمعوزين، وشكل لوحده مؤسسة لرعاية أسر الشهداء، في زمن كانت أسرة الخطيب تضم وزيرين، وهما: عبد الرحمان الخطيب الذي لم يعمر طويلا في وزارة الداخلية ولم يقترن اسمه بها كأسماء أخرى، إلا أنه كان وزيرا للداخلية في فترة الستينات ووزيرا للشبيبة والرياضة، وعبد الكريم الخطيب الذي تقلب في مناصب حكومية كبيرة كوزير للصحة وللشؤون الإفريقية ورئيس للبرلمان، ومؤسس حزبين سياسيين، والأكثر من ذلك قربه من القصر، حيث كانت والدة الوزيرين مريم الكباص صديقة للالة عبلة، والدة الملك الحسن الثاني، حيث كانت تدخل القصر دون تأشيرة.
محمد بلعربي العلوي.. رفض المعاش وساهم بماله في معركة لهري
كان شيخ الإسلام، محمد بلعربي العلوي، زاهدا في حياته على الرغم من ميوله السياسية، وحين حصل على أعلى الشهادات من القرويين، ظل يصر على وضع ما علمه الأسلاف للخلف، مؤمنا بالقيم الإنسانية الأكثر نبلا، بل إنه رفض المعاش الذي خصصته له الحكومة واكتفى بما ينتجه من عرق جبينه، في مجال العلم والمعرفة. ويروي رفاق الشيخ الإسلام أن هذا الأخير استغرب لما اقترحوا عليه معاشا بلا عمل، ففي سنة 1962 استقال الشيخ من منصب وزير الدولة وتوجه إلى بيته في درب الميتر، ليشرع الوزير السابق في حلب أربع بقرات وتربية الدجاج ويتعيش ببيع الحليب والبيض، بعد أن اشترى أربع بقرات عاش من ثمن حليبها، كما رفض التحول من مستهلك إلى «كساب»، بعد أن نصحه هواة الاستثمار بتوسيع تجارة الأبقار، بالمقابل ظل يخصص جزءا من محصوله للمعوزين.
رغم أنه عاش في مناصب سامية، إلا أنه كان بسيطا في حياته اليومية، فقد عين في سلك القضاء بمدينة فاس، ثم شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج مع تعيين أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، عايش أربعة سلاطين علويين وهم: مولاي عبد الحفيظ العلوي ومولاي يوسف العلوي، ومحمد الخامس ثم الحسن الثاني، وعلى امتداد قربه من الملوك ظل يرفض الهبات وكل أشكال الريع، انسجاما مع مبادئه. وحين نفي محمد الخامس من طرف المستعمر، رفض الشيخ دعوة الإقامة العامة بتبني نظام محمد بن عرفة إلا أن محمد بلعربي أفتى بقتال المستعمر فكان مصيره النفي إلى تيزنيت، ليعيش حياة الزهد مرة أخرى، ويحكى أن البوليس الاستعماري جاء لاعتقاله سنة 1954 ففاجأهم بظاهرة غريبة، إذ فاجأ أفراد الشرطة بحمل حقيبة فيها حاجياته وكان يحمل في اليد الأخرى ثوبا أبيض اللون، فسأله المراقب الفرنسي عن سر القماش الأبيض، فكان رده: «إنه كفني»، وهناك قال مقولته المشهورة: «إن السجن بالنسبة إلي فرصة للتفكير، والنفي فسحة للسياحة والموت فرصة للاستشهاد». ويحكى أنه شد رحاله للالتحاق بالثائر موحا وحمو الزياني، بعد أن باع متاع بيته.
القاضي ابن إدريس يتكفل برعاية ضحايا الإهمال الأسري
لا يعلم أغلب قاطني درب القاضي ابن إدريس في عين الشق بالدار البيضاء، أن الفضاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كان في عهد الحماية الفرنسية فضاء محاطا بالبساتين الغناء، وقلعة حصينة في ملكية أشهر قاض في تاريخ الدار البيضاء، محمد بن إدريس العلوي، الذي اشتغل طويلا في سلك القضاء والوعظ والإرشاد. بل إن بؤرة التوتر اليوم كانت بالأمس مكانا لكتابة تاريخ المغرب والدار البيضاء، على غرار داره الثانية التي كانت تتوسط درب الأحباس.
حسب «إتحاف المطالع» لابن سودة، وكتاب «العلامة المغربي القاضي سيدي محمد بن إدريس العلوي»، لأحمد إشرخان، فإن محمد بن إدريس العلوي قد دخل القضاء الشرعي عبر بوابة الفقه، وهو مكناسي المولد والنشأة، حيث ولد سنة 1887، وكان والده من أعيان مدينة مكناس ونقيبا للطريقة الناصرية بها، «فحرص على تربيته وتعليمه، وحفظ القرآن الكريم في عقده الأول، ودرس المتون العلمية، على يد مشاهير علماء بلده، ثم رحل إلى مدينة فاس وتابع دراسته بجامعة القرويين، إلى أن تخرج قاضيا».
ساهم مساندة العلامة ابن إدريس ماليا مع فرنسا في الحرب العالمية الثانية، استجابة لنداء السلطان سيدي محمد بن يوسف، حيث لم يبخل الفقيه بعلمه وماله حيث تبرع في اكتتاب لصالح فرنسا، كما ساندها بخطبه في الجمعة ومحاضراته، لحث الشعب المغربي على المشاركة إلى جانب الحلفاء ضد النازية.
واستقباله لبعض العسكريين من قادة قوات الحلف الأطلسي في حفل ضيافة بمنزله بحي الحبوس بالدار البيضاء في 27 يناير 1943، بل إن عدد الذين كانوا يعيشون في كفالته تحت سقف واحد قارب المائتين، وكان منزله العائلي ملاذا ومقرا ومقاما للأرامل والأيتام وللفاقدين للمعيل من الأقارب والأحباب، ومنهم من قادته الظروف لمحكمة الفقيه القاضي فوجدوا أنفسهم بدون كفيل فتكفل بهم الفقيه القاضي.