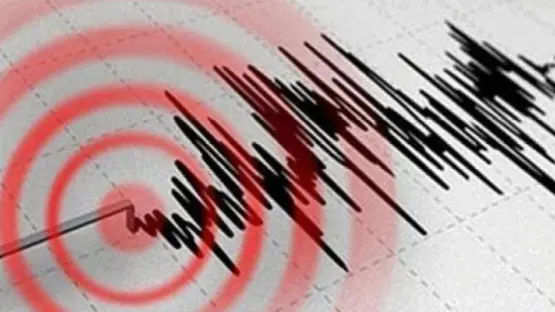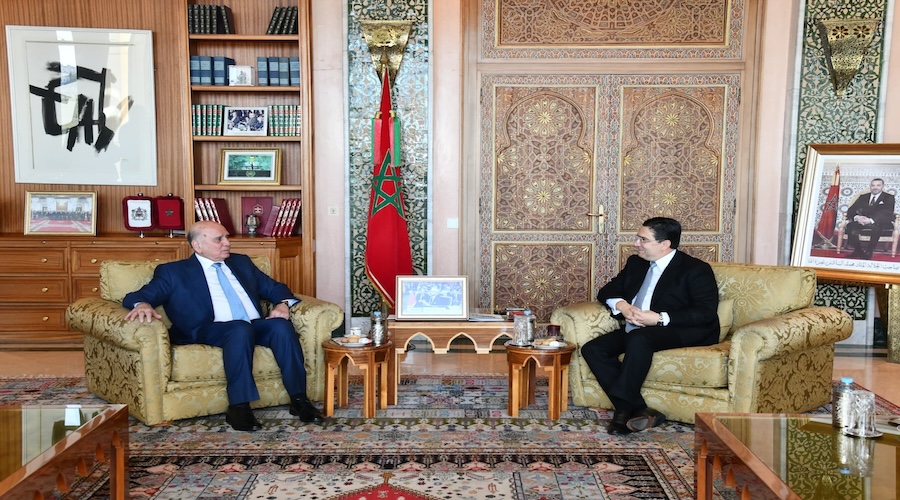مارس8، اليوم العالمي للمرأة عيد المرأة

-

telemaroc
نشرت في : 09/03/2022حل أمس يوم 8 من شهر مارس اليوم العالمي للمرأة، وبدل أن يتحول هذا اليوم الرمزي إلى عيد وطني فعلي لكل نساء المغرب، للأسف ما زال في الحقيقة يوما للحزن على واقع المرأة القروية الذي يصلح ليكون قصة درامية، يوما للتنديد بالانتهاكات التي تتعرض لها الطفلات القاصرات بسبب النزوات الجنسية للرجال أمام مرأى ومسمع من القانون والقضاء، يوما للتذكير بالشعارات الرنانة بالمناصفة التي لم تتحقق بعد، ولربما لن تتحقق أبدا، يوما للتحذير من اجتياح الفقر والبطالة والأمية لهذا الجنس اللطيف دون أن يحرك ساكنا في المسؤولين العموميين.
لا نحاول هنا أن نقدم صورة قاتمة عن أوضاع المرأة، ولا نتغيى تبخيس الجهود الدستورية والسياسية والإعلامية التي تحاول إنقاذ المرأة من براثن الإقصاء والتهميش والدونية، فالكثير من نسائنا في كل مكان يحطمن السقف الزجاجي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإدارة، إلا أن صورهن ظلت غير مرئية وأصواتهن بقيت غير مسموعة ومساهمتهن كثيرا ما تهمش، في فضاءات كثيرة ما زالت النساء يعتبرن غير قادرات على تحمل المسؤولية العمومية والانتخابية في مجالات تعتبر حكرا على الذكور فقط.
والغريب في الأمر أنه حتى مع بروز ظاهرة المرأة المعيلة والتي تتولى بمفردها رعاية نفسها وأسرتها مادياً دون الاستناد إلى رجل سواء كان زوجاً أو أخا أو أبا أو ابنا، فإن البنية الثقافية المحافظة والعقلية الذكورية المريضة ما زالت تنظر إلى المرأة على أنها ناقصة عقل وقاصر تحتاج إلى ولي أمرها.
وحتى لا تتحول مظاهر الظلم الاجتماعي والسياسي للنساء في عيدهن إلى مقطع من قصيدة المتنبي «بأية حال عدت يا عيد؟»، فمن اللازم أن نضع دولة ومجتمعا نقطة النهاية لمسار طويل من التمييز والحط من الكرامة تجاه المرأة وكل أنواع التنكيل النفسي والجسدي الاجتماعي الذي يتعرضن له، ونقلب الصفحة في اتجاه بلوغ التطلعات الدستورية بتحقيق المناصفة الحقة وليس مناصفة الواجهة وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين في تولي المناصب الإدارية والانتخابية، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية التي تجعل المرأة مفعول بها وليس فاعلا.
عيد المرأة يمكن أن يتحقق عن حق وحقيق، ولا يتطلب الأمر سوى أن تتنازل المؤسسات والسياسات والقوانين عن بعض أمراض الأنانية الذكورية، وتفتح لنصف المجتمع ليعبر عن ذاته بكل حرية وجرأة.