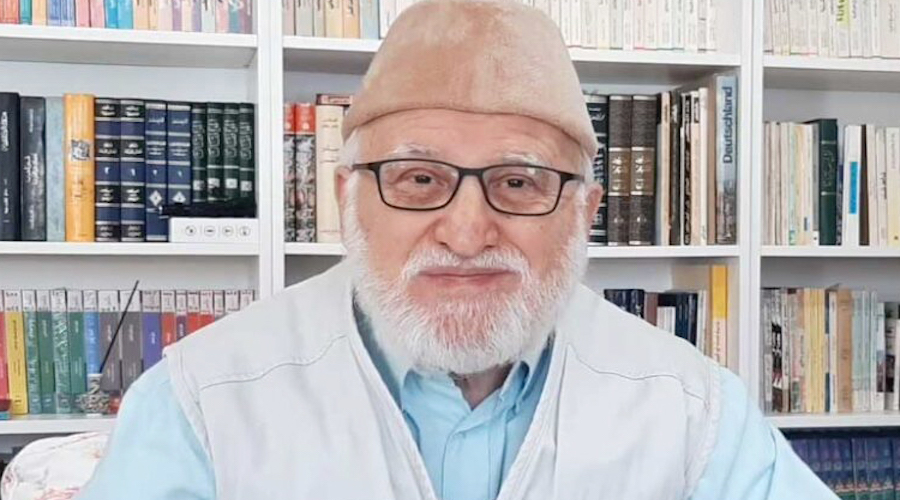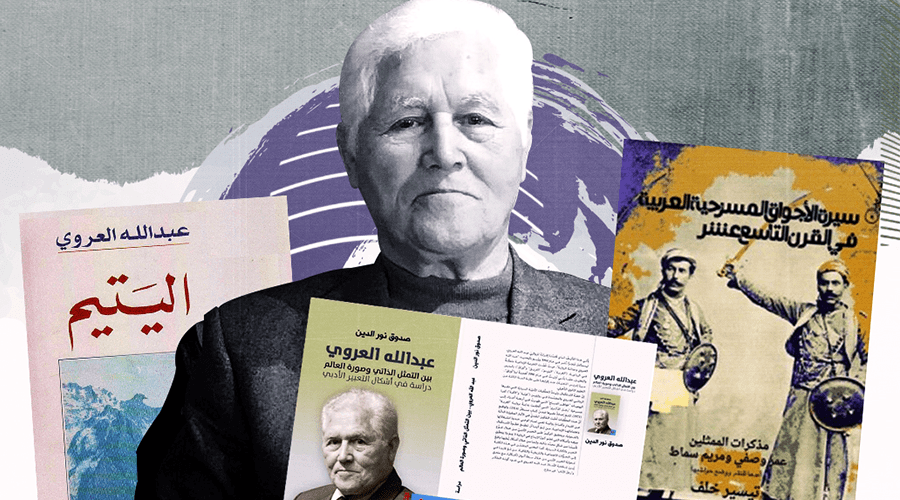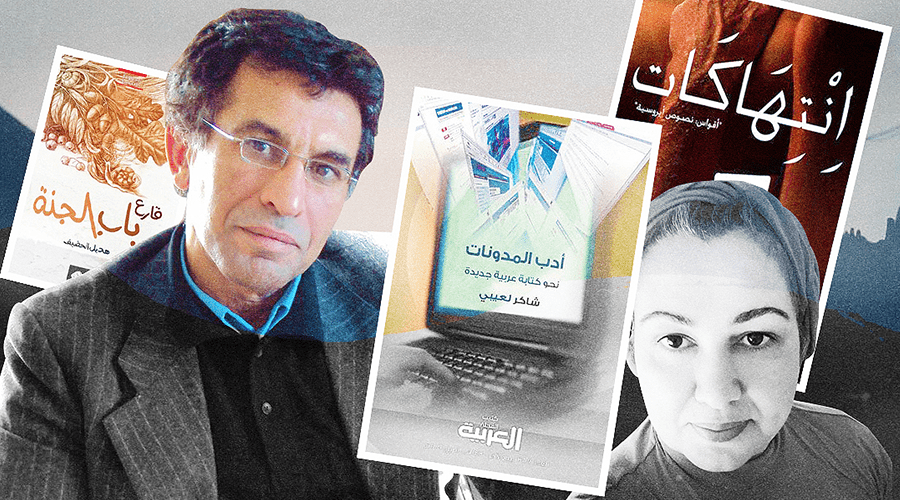فيليب ميريو - حوارات - التربية - متعة التعلم فيليب ميريو.. لا تربية بدون متعة تعلم

-

مراد كراخي
نشرت في : 10/08/2019فيليب ميريو من أكثر علماء التربية تأثيرا في فرنسا اليوم. ميريو يعتقد أن إشكاليّة المضامين الثقافيّة وإشكاليّة القيَم التي يتعيَّن نقلها هما جوهر التحدي الذي تواجهه المدرسة الحديثة. فمن جهة، ثمّة الذين يصرّون على أهمّية اكتساب اللّغات، وإتقان المَعارِف، واكتشاف الأعمال أو الإنتاجات. ومن جهة ثانية، ثمّة مَن يشير إلى أنّ الأساس هو في تملُّك القيَم وتنمية الاستقلاليّة.
تؤكدون دوما أن متعة التعلم هي أساس جميع أنواع التربية. هل هذه المتعة موجودة دائما؟
لا يوجد أي نشاط فكري رفيع المستوى دون متعة. كل أولئك الذين تعلموا، والذين اكتشفوا المعرفة، استمتعوا بالتعلم. وبفضل استمتاعهم طوروا المعرفة ونقلوها إلى الآخرين.
لا يمكن أن يكون هناك تربية دون اكتشاف متعة التعلم. الآن، لماذا هناك مشكلة اليوم؟ يبسُط «مارسيل غوشيه» بشكل جيد هذه المعضلة في كتابه. فنحن نعيش طفرة أنثروبولوجية أساسية: لآلاف السنين، عانى البشر بأجسامهم ولكنهم ارتقوا بعقولهم. في الوقت الحاضر، مكان المتعة هو الجسد. وبالنسبة للعديد من الأطفال والبالغين، يصبح التعلم مصدرًا لصعوبات بل وحتى المعاناة. فنحن نعيش في عصر تمجيد المتع الجسدية، مع كل الإمكانات المتاحة في العالم المادي، والتي تفقد المتعة الفكرية الكثير من أهميتها. ومن هنا تكمن الأهمية الأساسية للمعلمين في وضع «متعة التعلم» في مقدمة اهتماماتهم وجعلها وسيلة أساسية لإرساء الديمقراطية في المدرسة. المؤكد أن هناك كائنات واجهت متعة التعلم. يتعلق الأمر بالمجتمعات التي يُنظر فيها إلى التعلم على أنه شكل من أشكال الارتقاء، فأتاحت لهم فرص الوصول إلى كتب العقل، غير أنه من الواضح أن هذه الإمكانات مخصصة لعدد محدود من الناس، ومع ذلك كانت متعة التعلم شيئا مرغوبا فيه بشكل كبير. اليوم، ما يسميه برنارد ستيجلر «رأسملة الرغبة» تدفع الناس إلى الاستهلاك أكثر وأكثر، وبسرعة أكبر. لذلك، يبدو أن التعلم يمثل عائقًا أمام المتعة الفورية، لدرجة أن الأشخاص الذين لا يجربوا قط المتعة الموجودة في التعلم قد يحاولون الاستغناء عنها.
في بعض المؤسسات، يعتبر التواجد في مقدمة الفصل عائقا، حيث احتقار الذكاء والمعرفة. هل صحيح أن المدرسة كمنتجة للنجاح لم تعد لها قيمة؟
من الوعود الأكاديمية الخاصة بنخبة الجمهورية هي «اعمل وستنجح، وسترتقي اجتماعيا»، هذه الوعود تآكلت مع مرور الوقت، حيث توضح جميع التقييمات والدراسات الاستقصائية مدى سعي المدرسة للحد من عدم المساواة. لكن في ظل هذه الظروف الموجودة حاليا أضحى الجهد الفكري غير ذي قيمة عموما.
لماذا يوسم التلميذ الجيد بأنه «مهرج» وأحيانًا حتى «مخنثين»؟ بدون شك لأنه يخضع لقواعد مؤسسة تعليمية لا تحظى من طرف عموم التلاميذ بالرضا، وأيضًا لأن رفاقه لم يعودوا يؤمنون بقيمة الدراسة والعمل الفكري.
«ليس هناك ما هو أكثر تدميرا من عدم القدرة على أن تكون فخورا بأي شيء! سيكون من المثير للاهتمام، في هذا الصدد، مقارنة سلوك الفتيات والفتيان. فبالنسبة للفتيات نجد أنهن يحصلن على نتائج أفضل لأنهن يقمن بمجهودات أكبر ويأخذن العمل المدرسي بجدية أكبر. أما بالنسبة للفتيان، وخاصة «التلاميذ المتمردين»، فيعتبرون الرضوخ لقواعد المدرسة إهانة لهم: إنهم مستلبون باللعب، وفي نفس الوقت يعتقدون بأن اللعب ليس ضروريا. في بعض الحالات يطورون شكلاً من أشكال العنف، لمنع التفكير والكلام والنقاش فيما بينهم. وهذا مقلق للمدرسة والديمقراطية. هذا هو ما لا يمكن لمدرستنا أن تستسلم له.
تتجه المدرسة الآن نحو نفعية تعليمية. هل أصبح أن أولياء الأمور والتلاميذ أضحوا مستهلكين لـ»خدمة»؟
بالنسبة لي، فالمدرسة ليست خدمة، إنها مؤسسة. ولا تقاس قيمة المؤسسة - أو على الأقل ليس بشكل أحادي- بإرضاء روادها: إن وجودها مرتبط أساسا بقدرتها على تجسيد المبادئ. وبالتالي، فإن ما يمنح القيمة للمدرسة هي قدرتها على تجسيد «الحق في التعليم» للجميع: يجب أن تقدم لكل تلميذ، وبطريقة منصفة، الأدوات والأعمال التي تسمح لهم بفهم العالم وتغييره. يجب أن تسمح للجميع باكتشاف متعة التعلم وبهجة الفهم، والتي بدونها لن يكون هناك نجاح مدرسي حقيقي، ولا يمكن الوصول إلى النقاش العمومي والمواطنة الديمقراطية.
ومع ذلك، فمن الواضح أن التعليم، شأنه شأن الطب والعدالة، خضع لشكل من أشكال إلغاء المؤسسات. فالجميع يعتبر أن أهم شيء هو إرضاء تطلعاتهم الشخصية، حتى لو كان ذلك على حساب المشروع المجتمعي. وهذا صحيح أكثر عندما لا يركز هذا المشروع الجماعي بما فيه الكفاية على المستوى السياسي، عندما لا يوجد مسار تعليمي واضح ولا نتحرك معًا في مستقبل مشترك. لذلك لا فائدة من التنقيص من فرادانية «مستهلكي المدارس»: فمن الأفضل أن نقدم لهم مدرسة تتميز بكون الآمال فيها قوية. مدرسة تمكنهم من الانخراط في المجتمع، ويساعدون في بنائه.
هذه النزعة الاستهلاكية، هل هي خاصة بالأطفال أم بالآباء؟
إنه سلوك مشترك على نطاق واسع. وبتشجيع قوي من قبل نظام التقويم كما هو الحال مع أساليب الانتقاء لدينا. علاوة على ذلك، يقوم بعض المعلمين بتكريس هذه النزعة الاستهلاكية، عندما يتصرفون كما لو كانت النقطة الجيدة أو العقوبة هي الوسيلة الوحيدة لجلب انتباه التلاميذ لبدل مجهود أكبر. أو حتى عندما يجعلون تلامذتهم يفكرون بأن المعارف المدرسية التي يقدمونها تصلح للاستخدام الفوري خارج المدرسة، وذلك بغية إضفاء الشرعية على طريقة تعليمهم. وهكذا، يشرح المعلم للتلميذ في المرحلة الابتدائية أن تعلم عملية الطرح ضرورية ليتحقق من نقوده عندما يذهب للتسوق..هذا صحيح، ولكن هذا لا يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة للتحفيز في الرياضيات، لأنها تلغي أخيرًا السؤال الأساسي المتمثل في متعة التعلم والفهم. إنها تقلص أهمية المعرفة وتحصرها في الاستخدام المادي القصير المدى. هذا هو السبب في أنه من الضروري للغاية «إعادة طرح» مسألة متعة التعلم، ووضعها في صميم الممارسات التربوية.
كيف نفعل ذلك؟
الأمر ليس سهلاً في ظل وجود ضغط قوي. فالتلميذ نفسه غالبا هو من يسأل «ما الفائدة؟ «. لذلك علينا أن نظهر له أن التعلم يفيدنا أولا بأننا أذكياء. إن قيمة المعارف لا يتم الحكم عليها انطلاقا من «وظيفيتها» المباشرة، ولكن من خلال المتعة التي تمنحها لنا، وأيضا من خلال كونها تسمح لنا بأن نرى ذواتنا والعالم بشكل أكثر وضوحا، وأيضا المتعة التي نشعر بها عندما تفيدنا في إقامة روابط بين مجموعة من المعطيات غير المنتظمة، وأنها هي التي تخرجنا من عالمنا النفسي المنغلق لنفكر ونفهم، إنها أيضا تمكننا من الوصول إلى الأدوات والمفاهيم والنماذج والنظريات للاستمتاع بالأعمال الفكرية والأدبية والعلمية التي وصلتنا الآخرين.
إلى أي حد يتأثر نجاح المشروع التربوي بالتطورات التي تعرفها مجتمعاتنا؟
نحن نعيش، لأول مرة، في مجتمع حيث الغالبية العظمى من الأطفال الذين يأتون إلى العالم هم أطفال ولدوا بناء على رغبات آبائهم. وهذا يؤدي إلى انعكاس جذري: ففي السابق، كانت الأسرة «من صنع الأطفال»، واليوم الطفل هو الذي يصنع الأسرة، حيث غيّر الطفل وضعه وأصبح معلما لنا: لا يمكننا أن نرفض له شيئا مخافة أن نصبح «آباء سيئين». وتأثرت علاقتنا بأطفالنا بسبب اكتساح قيم الليبرالية التجارية، حيث يضع المجتمع الاستهلاكي تحت تصرفنا عددا لا حصر له من الأدوات التي نشتريها فقط من تلبية نزوات أطفالنا. فاقتران النمو الديموغرافية بظهور نزوة معولمة في الاقتصاد يجعل دوافع الشراء هي المحدد للسلوك البشري بشكل قوض التكوينات التقليدية للنظام المدرسي.
إلى أي مدى يتأثر الوضع التعليمي من هذا الوضع الجديد؟
قمت مؤخرا بتدريس قسم للتعليم الابتدائي بعد انقطاع دام عدة سنوات، لم أكن مندهشًا بدرجة كبيرة من تدني المستوى بقدر دهشتي من الصعوبة الاستثنائية لاحتواء فصل دراسي أشبه بطنجرة الضغط. فبشكل عام التلاميذ ليسوا عنيفين أو عدوانيين، لكنهم لا يهدؤون في أماكنهم. ويتوجب على المعلم أن يقضي وقته في محاولة تهدئتهم، حيث غالبًا ما يُجبر على ممارسة ما يقوم به نادل المقهى، يركض من تلميذ إلى آخر ليكرر بشكل فردي فكرة تم تقديمها في الأصل بشكل جماعي، ليهدئ البعض، ويعيد آخرين إلى العمل.
إنه مطالب بحوارات فردية دائمة بدل التوجه للمجموعة ككل. إنه يستنزف جهده في تخفيض التوتر ليحصل على الاهتمام. في عالم التكنولوجيا والاتصال تصبح مهام المدرسة صعبة.
بما أن بعض الآباء لم يعودوا يربون أطفالهم من أجل العيش المشترك، ولكن بهدف تحقيق مشاريعهم الشخصية، فهل من المؤسف أن الثقافة لم تعد قيمة مشتركة في أوروبا؟ وكيف يمكن ضمان التأكد من عودتها إلى مكانتها المركزية؟
السلطة في أزمة لأنها فردانية ولم تعد مدعومة بدعم اجتماعي مشترك. فقد فقدَ الأستاذ سلطته من مؤسسته. فاليوم لم يعد يهتم به أحد. فالمدرسة تضمن أن سلطة المعلم هي طريق النجاح لكنه هو من يخضع الآن لسلطة التلاميذ وآباءهم
اليوم، الآمال التي كانت تعد بها المدرسة ما يعد لها معنى. وشعار «اعمل لتنجح» لا تعد وصفة مفيدة. لقد أصبحت المدرسة، التي كانت مؤسسة اجتماعية حقيقية، مجرد مؤسسة تقدم خدمة: تخضع التبادلات لحسابات المصالح قصيرة الأجل. فالثقة بين المؤسسة المدرسية وأولياء الأمور أضحت شبه منعدمة. غالبًا ما يعتبر أولياء أمور التلاميذ المدرسة مجرد سوق يحصلون فيها أفضل الخدمات وبأفضل الأسعار. لذلك فالتحدي القادم الذي ذو شقين. يجب علينا أولا إعادة النظر في بنية المدرسة. إذا كانت المدارس الثانوية النابليونية تعمل بشكل جيد، فذلك لأنها كانت تقع في منتصف الطريق بين الثكنات والدير الذي يجمع بين النظام والتأمل. فإعادة تأسيس المدرسة يتم عبر إعادة الاعتبار لقيمة العمل الفكري. يجب علينا بعد ذلك، أن نعمل ضد المعرفة المباشرة والنفعية، ضد كل الانجرافات في «تربية الأبناء»، أن نستعيد متعة الوصول إلى الكتاب. لا ينبغي اختزال مهمة المدرسة في اكتساب قدر من المهارات، حسب الضرورة، ولكنها الوصول إلى الفكر. ومن خلال وساطة العمل الفني أو العلمي أو التكنولوجي، يُنظَّم الفكر ويكتشف متعة لا تتمثل في الهيمنة، بل التقاسم.
ألا تفرض إعادة تأسيس المدرسة مراجعة نقدية لأدواتنا التعليمية؟
نجاح المدرسة هو تمكين الطفل من متعة فتح الكتاب. وليس إضفاء الطابع الأذاتي على المعرفة والدخول في مغامرة فكرية هدفها الحصول على المعرفة العملية فقط والمباشرة. فأطفال الحداثة تسكنهم إرادة كبيرة للحصول على المعرفة، بل ومعرفة كل شيء. لكنهم لا يريدون حقا أن يتعلموا. لقد ولدوا في عالم من المفترض أن يتيح لهم التقدم التقني معرفة بدون الحاجة للتعلم: اليوم، ولالتقاط صورة واضحة، لا يحتاج أي شخص إلى حسابات دقيقة فآلة التصوير المتطورة تفعل ذلك بمفردها. لذا فإن النظام المدرسي مخصص للتلاميذ الذين يريدون أن يعرفوا ولكنهم لا يرغبون حقًا في التعلم بعد الآن. التلاميذ أضحوا يشكون في أن التعلم يمكن أن يكون فرصة للاستمتاع. فهم يركزون على الفعالية الفورية للمعرفة الآلية المكتسبة وبأقل تكلفة، دون بدل مجهود والاستمتاع به. هذا هو السبب في أن هاجس المهارات يجعلنا في تيه. إنه جزء من «إنتاجية المدرسة» التي تختصر إلى عملية نقل للمعارف، وننسى أن يكون كل التعلم قصة. في الواقع، كانت الثقافة الفرنسية دائمًا مقاومة لنظريات التعلم، مفضّلة نظريات المعرفة: «عرض المعرفة في الحقيقة» يبدو كطريقة التدريس الوحيدة، التي تأخذ بها شكل من أشكال الموسوعية الكلاسيكية أو معايير الكفاءات السلوكية. في هذا المنظور، فإن المعرفة التكنولوجية لها بيداغوجيتها الخاصة، وكل وساطة، أو أي عمل بناء على الرغبة، هو بيداغوجيا محتقرة. أشعر بالأسف الشديد لجهلنا بتاريخ البيدغوجيا في الثقافة الفرنسية: إنه سيساعدنا في العثور على تناقضاتنا وأوجه قصورنا، وإعادة بناء المدرسة.
هل أنتم سعداء بإعادة تعليم الفنون إلى المدرسة؟
إنها بالفعل كالثعبان البحري القديم في الأساطير، ويجب أن نتذكر أن جاك شيراك في وقت سابق كان قد جعله من أولويات ولايته الأولى. هذا لم ينجح كثيرا. وعلى أي حال، ليس من المؤكد أن تعليم الفنون، في شكله الحالي، هو أفضل طريقة لتثقيف الأطفال وجعلهم يتذوقون الفن والإبداع.
لماذا؟
إنها مجزأة لكونها تعتمد نوعا من الطايلورية في التعليم الثانوي الفرنسي. على سبيل المثال، في الإعداديات والثانويات، يتم تقديم ساعة واحدة من تعليم الموسيقى وساعة واحدة من الفنون البصرية أسبوعيًا. يوجد في المتوسط 400 تلميذ في الأسبوع، وهو أمر غير محتمل. لنا في فرنسا، على عكس البلدان الأوروبية الأخرى، تعليم أكاديمي بالكامل، وأحيانًا تنتج عنه نتائج عكسية رغم جهود المعلمين. هذا يمكن أن يكون مصدر إحباط. حيث ينظر إليه الأطفال كترويح عن النفس وليس كتربية، نظرًا لأنه، بالإضافة إلى ذلك، لا يؤخذ بعين الاعتبار في نتائج المدرسة.
بالنسبة لي، يعد الفن والثقافة من العوامل الأساسية في التعلم. لذلك يجب وضع التربية على الذوق الفني في قلب مشروع. في أي حال، هناك نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن تاريخ الفن أضحى إلزاميا في التعليم، غير أن عددا من الشباب اليوم يواجهون صعوبة في تقدير الفن لأنهم لا يعرفون كيفية وضعه في سياق معين. فهم لا يفهمون القضايا، ولا يرون التحولات في تاريخ الفن. إنهم لا يعرفون ما حدث في عصر النهضة أو مع الانطباعيين. مثل هذا التعليم من شأنه أن يعزز رؤية عالمية ويمكن أن يوفق بين بعض الأطفال والثقافة. ومع ذلك، هناك خطر من التحجر عندما يجب على المرء أن يظهر أن الفن حي ومثير. أخشى أن يتم اختصار تاريخ الفن، إذا تم تدريسه بطريقة متحجرة، في نسخة مدرسية على شكل أسئلة المسابقات لا غير.
تنويه:
تمت ترجمة الحوار من جريدة «لوموند» وأجرى الحوار Nicolas Truong ثم من مجلة lyoncapitale وأجراه GUILLAUME TAHNIA.