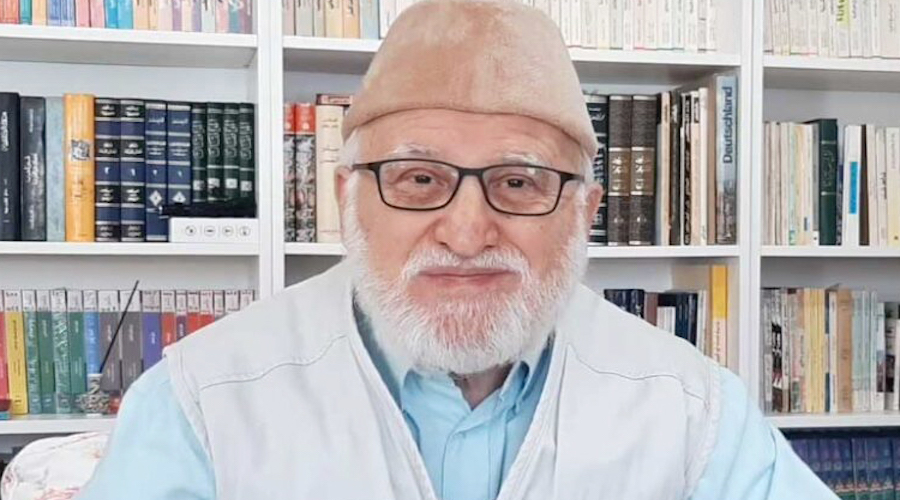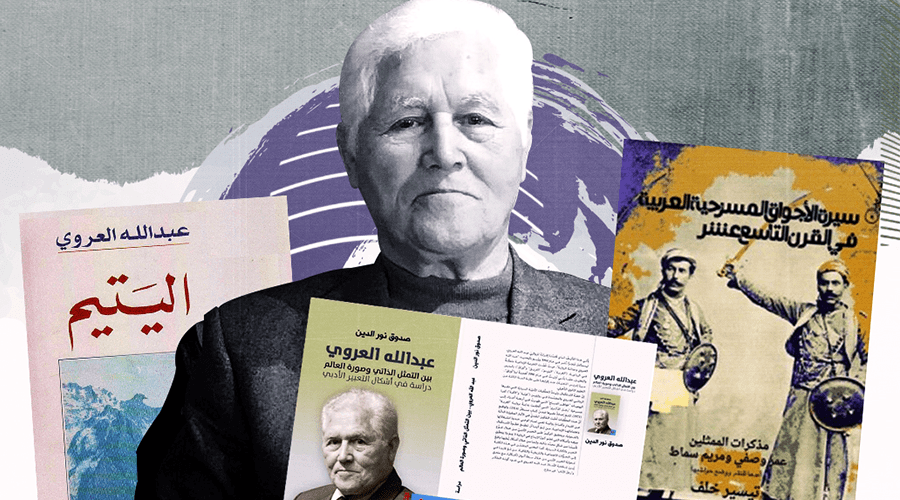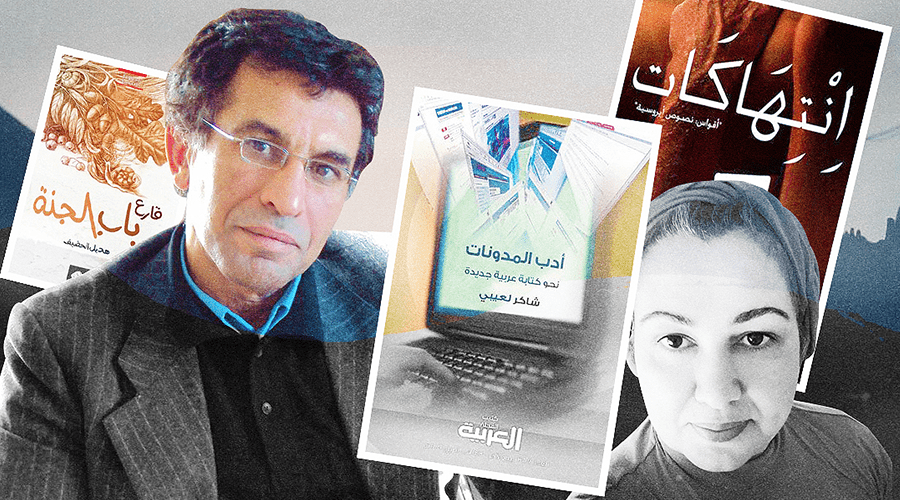الفيلسوف - مارسيل غوشيه - الوباء - هشاشة ديموقراطيتنا - تماسكنا الاجتماعي الفيلسوف مارسيل غوشيه : الوباء كشف هشاشة ديموقراطيتنا وتماسكنا الاجتماعي

-

تيلي ماروك
نشرت في : 04/04/2020مارسيل غوشيه من أكثر الفلاسفة الفرنسيين تأثيرا في فرنسا اليوم. إنه أحد المدافعين الشرسين عن الديموقراطية والحريات الفردية. لم تمنعه حالة الطوارئ التي يمر منها العالم، بسبب وباء كورونا، من أن يجدد إيمانه بالمبادئ نفسها التي دافع عنها. سواء من خلال مجلته الشهيرة «مناقشة»، أو من خلال حضوره المكثف في وسائل الإعلام.
فحسب غوشيه، فهذه الطوارئ التي فرضها الوباء، لا ينبغي أبدا أن تنسينا حقيقة أن الديموقراطية تظل دوما حلا لكل المشكلات، بما في ذلك الطارئة منها، وعودة الحديث عن نجاح النموذج السياسي الصيني، بعد تمكنه من السيطرة على الوباء، هو دعاية محضة. لأن العيوب المتأصلة في هذا النموذج، والمتمثلة في احتكار الحزب الواحد للقرار السياسي، هي سبب الكارثة العالمية الحالية، لكونه حاكم وقمع المواطنين الذي تحدثوا عن الوباء في بداياته الأولى. وعندما بدأ هذا النظام التصرف، فإنه قام بإجراءات قاسية على المواطنين. لذلك فهو لا يتوقف عن ترديد أنه من خلال الديموقراطية كان يمكن السيطرة على الوباء بشكل أكثر فعالية.
كانت فرنسا تعاني من فيروسات الشعبوية والسذاجة والانقسامات. والآن، ها هو فيروس حقيقي يجتاحنا، ورأينا بأعيننا، وبشكل لا يصدق، كم هي هشة ديموقراطيتنا، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون.
جاءت صدمة هذا الوباء لنتمكن من أن نرى بوضوح هذه الهشاشة. لقد رأيناها بشكل خاطف ولفترة وجيزة مع وباء «سارس»، ثم، كما غنى جاك دويترون، «أفكر في الأمر ثم أنساه». وها نحن أمامها مرة أخرى، ولكن الصدمة هذه المرة أعمق بكثير، وسيكون تأثيرها طويل الأمد. إنها صدمة تمنحنا شعورا بأن التوازن في عملنا الجماعي غير ثابت، والتماسك الاجتماعي عندنا هش يمكن الانقلاب عليه بسرعة كبيرة. ما نلاحظه من هلع حقيقي يجعلنا نتساءل، ماذا تبقى من هذا التوازن؟ لذلك فالتحدي الكبير الذي سيواجهنا في السنوات القادمة، ويمكننا أن نتنبأ به من الآن، وهو أن نجد أساسا أكثر صلابة لديموقراطيتنا.
كتب أندري مارلو في كتابه «الأمل» أن الشجاعة تكمن في التنظيم، وفي القدرة على تقديم إجابة. أليست هذه، ويا للمفارقة، أفضل ما عندنا من فرص؟
للديمقراطيات وجهان. نقطة ضعفها كلها هي التراخي ونوع معين من الفوضى، وهذا ما يجعلنا ندرك بسهولة لحظات انحطاطها وموتها. لكن هذا ليس كل خصائصها. لقد أظهرت هذه الديموقراطيات في الماضي قدرات هائلة على استجماع قوتها والنهوض من جديد. ففي البداية كانت ضعيفة في مواجهة الأنظمة الشمولية، لكنها حافظت على قدرتها على النهوض ومواجهتها دون هوادة. والسؤال الذي يجب طرحه الآن، هو ما إذا كانت الديموقراطيات لا تزال تحافظ على هذه الخصائص في الماضي؟ لأنه صحيح أن تطور المجتمعات الغربية، قد نقل التماسك الجماعي من مستوى أقل إلى مستوى أكبر بشكل لم يسبق له مثيل. لقد أعطوا أولوية مطلقة لحرية الأفراد، محدثة انقساما اجتماعيا مذهلا. والسؤال هل ما زلنا قادرين، في ظل هذه الظروف، على استعادة تماسكنا الجماعي ووضعه في الصدارة، في مواجهة تهديد غير متوقع مثل هذا الذي يهاجمنا الآن؟ التجربة فقط هي التي ستجيبنا، لكنني ما زلت ألاحظ وجود بنية أساسية قوية للغاية تسمح بالتوسع غير المنضبط للحريات. علينا أن نتخيل فرنسا حرة وفي الوقت نفسه منظمة للغاية. لماذا إذن، لا يمكن لهذه القوة التنظيمية أن تتولى المسؤولية، إذا اقتضت الظروف ذلك؟
منذ بداية الوباء، ألم تُظهر السلطة ثقة كبيرة في تنظيم الدولة؟
مرة أخرى، هناك مكونان متضمنان. يمكن للحكومة أن تعتمد على جهاز إداري قوي، وآلية رسمية صلبة. فما نجهله يظهر في الجانب المتعلق بتطور المجتمع، ومن مظاهر هذا المجهول الخوف من غياب العقلانية الجماعية. والسؤال هو أي من هذين المكونين ستكون له الكلمة الأخيرة؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن.
هل يمكن لما حدث في الأشهر الثمانية عشر الماضية، من قبيل السترات الصفراء، والمواجهات مع النقابات، أن تثقل كاهل إدارة الوباء؟
ثقيل جدا. وكان يمكن لتقنوقراطيا، مثل تلك التي كانت لدينا في الستينيات، أن تفرض إجراءاتها الصارمة دون أي مشكلة. لم نعد في تلك الأزمنة، لكننا لا نعرف أين نحن الآن. فالعلاقة بين المجتمع والسلطة أصبحت متوترة، لدرجة تتطلب منا الحذر.
عندما تم الانتصار على القيود الموضوعة أمام «سوق المعرفة»، بفضل الإنترنت، أصبح الكلام العلمي فجأة أكثر شرعية ...
في السوق الذي تتحدث عنه، حافظ الطب على ميزة تنافسية معينة. كما احتفظ بسلطة قوية، حتى لو كان محل جدل، من قبيل الجدل حول اللقاحات مثلا، على عكس العلوم التي تمت المحافظة عليها في المختبرات المغلقة بعيدة عن عموم الناس. فالطب هو ممارسة قريبة من الناس، ويمكن للجميع التحقق من فعاليته. الجميع يتعامل معها ويستطيع الحكم على فائدتها المباشرة. ونظام المستشفيات هو إحدى المؤسسات التي يثق بها الفرنسيون أكثر.
هل كان إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية قرارا جيدا؟
هل كان لدى الحكومة خيار آخر؟ لقد كانت حجتها، إذا فهمتُ بشكل صحيح، أنه يتوجب الحفاظ على «الوحدة المقدسة»، إنها حجة جيدة. في هذا السياق، تصبح ممارسة المواطنة أكثر أهمية على الرغم من المخاطر. ثم تخيل أن الحكومة قررت إلغاء الجولة الأولى. فعدم الثقة التي تسيطر على مجتمعنا، ستجعل المواطنين يؤولونه على أنه وسيلة «ماكرون» للتهرب من هزيمة حتمية لحزبه ...
هل يمكننا أن نلوم وسائل الإعلام، كالمعتاد، بكونها تقف وراء انتشار الخوف والقلق؟
ولكن كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تكون مصدر اطمئنان؟ فالإعلاميون أمام معضلة حقيقية، فإذا لم يخصصوا مساحات كبيرة للوباء، فسيتم انتقادهم بكونهم قللوا من خطورة الوضع لأسباب غير معلومة، أي لأسباب قد تدينهم وتجعلهم جزءا من «مؤامرة». أما إذا أعطوا لأخبار الوباء أولوية لهم، فإنهم سيُتهمون أيضا بكونهم يساهمون في تضخيم القلق. وفي حالتنا الراهنة، فالمشكلة معقدة جدا. فالقلق الجماعي يرجع إلى حد كبير لعدم المناسبة بين الطابع الاستثنائي للتدابير المتخذة، والشدة المحدودة للوباء. فبالرغم من كل شيء، فكورونا ليس هو الطاعون الأسود أو حتى الإنفلونزا الإسبانية. هذه الفجوة تُسبب ارتباكا في أذهان الناس. وتجعلهم يتساءلون عن ماذا تغطي هذه الفجوة؟ وهذا لا يمكن لوسائل الإعلام السيطرة عليه.
عندما زار وزير منطقة «روان» بعد انفجار مصنع هناك، قالت له امرأة أراد الاطمئنان عليها: «نحن لا نريد الاطمئنان، بل نريد أن نكون على علم بحقيقة ما يحدث».
يريد المواطنون أن يكونوا قادرين على الفهم والحكم بأنفسهم، هذا هو الطلب الأساسي الآن. نحن بالتأكيد لسنا في مجتمع الوصاية، حينها لم يكن أمام كتلة «الجاهلين»، أي خيار آخر سوى الاعتماد على النخبة المالكة للمعرفة، أو التي يُفترض فيها أن تكون كذلك. فالحكام لم يتخذوا إجراءات مناسبة بشكل كاف، وهذا هو مصدر عدم الثقة حاليا. ويتعين خلق صوت عمومي آخر. فالبساطة التي يتحدث بها المسؤولون عبر وسائل الإعلام تجعل الأمور أسوأ. بحجة «أن التفاصيل تقنية للغاية، ولا نستطيع أن نخبركم بكل شيء لأنكم لن تفهموا»، مثل هذه الحجة تقوي الشعور بأن هناك حقائق مخفية.
ما رأيكم في الخطاب الرئاسي إبان هذه الظرفية، أي فِعل «أريد» الذي يبدأ به إيمانويل ماكرون كلماته الرسمية؟
أعتقد أنه محق في إظهار أنه يتحكم في الأمور بنفسه، ليس الوقت المناسب الآن للتفويض. من الجيد التأكيد على مبدأ المسؤولية، وهذا مطلب أساسي من المواطنين.
أحد الدروس الأولى للوباء، هي انكفاء كل دولة حول نفسها ...
إنها تجعلنا نعيد طرح الأسئلة، هذا إن لم نقل بأنها مراجعة مفجعة، وسيكون تأثيرها حاسما على المدى الطويل. أعتقد أنها ستكون واحدة من أهم آثار هذه الأزمة الصحية. فالعولمة فرضت تأسيس منظور نسبي للسيادة الوطنية، بحيث تخضع للقواعد التي حددتها المنظمات الدولية. فما نلاحظه الآن هو أن كل الدول وجدت نفسها تتعلم من جديد كيف تمارس سيادتها الوطنية، بعد أن تخلت عنها لسنوات لصالح المنظمات الدولية. فقد تمت البرهنة أمام وضعية كالتي تحدث الآن، على أنه عندما نكون أمام حالات مستعجلة فإن القرار الوطني يكون أكثر فعالية. في حين أن «التفويض» يعمل بشكل سيئ للغاية، إذا كان صادرا من خارج الوطن. ونحن الآن نعاود اكتشاف حقيقة أن تفويض صلاحيات الدولة الوطنية لصالح منظمات خارج الوطن، هو أمر سيئ للغاية. نحن نعيد اكتشاف أن السيادة ليست خيالا مجردا، ولكنها تتوافق أولا وقبل كل شيء مع ضرورة وظيفية: منح المواطنين ثقتهم للسلطات، وأيضا معرفة دقيقة بمجالات تطبيق هذه السيادة. وهي أمور تمنعها التقنوقراطيات العابرة للقارات، حتى لو كانت لها فائدتها في تبادل المعلومات ومواءمة القواعد. سيتعين علينا مراجعة قدراتنا الذاتية على سلسلة كاملة من الموضوعات. هل يمكننا التخلي عن إنتاج الأدوية الأساسية لصالح تقلبات الأسواق العالمية؟ وسيتعين على الغربيين أن يتعلموا أن يكونوا أقل سذاجة، عما هم الآن. كسماحهم مثلا للتأثير الصيني بالانتصار على منظمة الصحة العالمية.
فيروس آخر يؤثر على فرنسا ويؤثر عليكم شخصيا بصفتكم، مؤسسا لمجلة «نقاش»، هو اختفاء النقاش على وجه التحديد، كما ظهر ذلك بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية. بعد مرور أربعين عاما على إطلاق مجلتكم، هل ما زال النقاش ممكنا؟
ينبغي أن نشير إلى أنه ما بين 1980 تاريخ ظهور المجلة و2020 ظهر مجتمع آخر، وهو ما لم نتوقعه. لقد استمتعنا بلحظات جميلة في البداية. أطلقنا هذه المجلة في إطار مشروع يروم استغلال ما تمر منه فرنسا حينها، لفتح نقاش حقيقي. ومن هنا اسم المجلة. لقد خرجنا من عهد الفكرة الثورية والإيديولوجية الشمولية، التي كان هدفها إسكات خصومها بكل الوسائل. لنتمكن من مناقشة كل شيء بطريقة هادئة وعقلانية ومحترمة. وكانت هناك بالفعل لحظات رائعة عند إطلاق المجلة. لكن ما لم نستطع استشرافه حينها، هو عودة شغف كبير باللاتسامح داخل فضائنا الديموقراطي. ولا يتعلق الأمر بإحياء للإيديولوجيات الشمولية أو عودة للمشروع الثوري. فالمبادئ الأساسية للديموقراطية تم تريسخها، وليست موضوع تنازع. لكن هذا الإجماع الأساسي لم يمنع ظهور راديكالية انتقامية جديدة. راديكالية تجلب معها الشغف بالوشايات، ورفض الحوار، وتجريم الخصم ومنعه من الكلام، بل وتبرير ذلك. أي إنها العودة إلى المربع الأول بصيغة أخرى.
كيف تتحدثون مع أولئك الذين لم يعودوا يريدون المناقشة؟
هؤلاء ليسوا هم من ينبغي التحدث معهم، فالمجتمع هو الذي أتاح لهذه الأقليات النشطة الجديدة الفرصة لتسيطر وتفرض قانونها. إذا فشلنا في إقناعهم، يمكننا حرمانهم من الأفكار التي تُعرض باسمها هذه المواقف التي لا تطاق. سيتعين علينا استئناف المواجهة، لاستعادة شروط النقاش.
ألا تشعرون إزاء قضايا مثل «بولنسكي» و«هينيل» ومحنة المحامين بأنكم معنيون بتهمة «صمت المثقفين»؟
بادئ ذي بدء، لم يعد للمثقفين أي سلطة داخل المجتمع. لا يتم ذلك لتشجيعهم على التحدث، مع العلم أن فرصهم في أن تكون أصواتهم مسموعة هي فرص ضئيلة. لكن بالموازاة مع هذا، لا نر سوى أنهم يتعرضون لضربات في النزاعات الإعلامية حاليا. هناك عدد قليل فقط من الشخصيات «المصارعة» تخاطر بالدخول إليه. لكن الأغلبية تتجنبه. تم تفريغ الفضاء العمومي. يفضل كثيرون أن يغادروا هذا الفضاء ليقوموا بأعمالهم الخاصة في فضاءاتهم الخاصة، محميين من هذا المناخ الهستيري. كيف تدلي برأي معقول عندما تكون القاعدة هي اللامعقول؟
فكما أن الأجيال الجديدة لا تتحمل مادة «الغلوتين»، نجد أنها أيضا لا تتسامح مع الاختلاف. كيف نفسر هذا؟
نحن أمام حساسيات جديدة تُظهر أننا أمام أنثروبولوجيا ديموقراطية جديدة. يمكن تفسير هذه الحساسية جزئيا من خلال وجود شعور عميق بالضعف الشخصي. لنذكر الطلب على «المساحات الآمنة» على الطراز الأمريكي، المساحات التي تكون فيها بأمان من الآراء المعارضة التي يمكن أن تضر بهويتك. ويرافق هذه الهشاشة استبداد الأنا، كما لو أنها لا يمكن أن توجد إلا من خلال السيطرة المطلقة دون قيد أو شرط. وهذه الاستهانة بوجود آراء معارضة هي تهديد لا يُطاق. فعندما أناقش ما أعتقده من أفكار، أجدني أتساءل عن من أكون؟ إنها علامة على استثمار غير متناسب في الآراء، يأخذ القاعدة الديموقراطية في الاتجاه المعاكس. وقد تم تطوير هذا على نموذج المناقشة العلمية. نقدم فرضية أو نظرية: يتم وضعها لتشريحها، والطعن فيها ودحضها. لكن النظرية التي أطرحها ليست أنا. إنه اقتراح تم التعبير عنه بشكل منطقي وعلى هذا النحو غير شخصي، حتى إذا كانت هناك أسباب شخصية لدعمه. فنقيس المسافة المقطوعة. اليوم على العكس، فرأيي هو أنا. ومن يظهر خلافه معي فهو مهاجم لوجودي الخاص. فالرأي اختلط بالهوية، ومن هنا تأتي الكراهية القاتلة التي تغزو فضاءنا العمومي.