
فرنسا والتجارب النووية في الصحراء الشرقية
مع Télé Maroc
الفرنسيون أنفسهم يرجحون أن تكون فرنسا، في إطار الملفات السرية التي لم يُفرج عنها، قد أجرت تجارب نووية في وقت مبكر جدا.
كيف كانت تتم هذه العمليات إذن؟
في سنة 1958، وبالضبط يوم 11 أبريل، وفي عز النقاش حول جرائم فرنسا في الداخل والخارج، وقع رئيس الوزراء الفرنسي وقتها «جيلارد» الترخيص بإجراء تجربة نووية في الجزائر، لكن الأمر لم يتم بسبب تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، وتسببت في زلزال سياسي حقيقي انهارت خلاله الجمهورية.
أعيد ملف التجربة إلى الواجهة مع بداية 1960، وهو ما يعني أن الإخراج العلني لهذا النوع من العمليات كان يتطلب الكثير من الإعداد وتحفه التعقيدات. وصل شارل ديغول إلى السلطة على أنقاض الجمهورية السابقة، وأعاد التأشير على القرار ليفعله من جديد، وتبدأ فعلا تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر.
يوم 13 فبراير بدأت التجربة فعلا مع تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تقرر إلقاء قنبلة نواحي الصحراء الجزائرية، تحمل كميات كبيرة من مادة «البلوتونيوم»، وتم وضع معدات عسكرية على مسافات متفرقة لدراسة مدى تأثرها بشدة الانفجار.
لكن هل كانت تلك أول تجربة من هذا النوع؟ ربما تكون أول تجربة سُلط عليها الضوء، وهناك معلومات عن اعتراض الملك الراحل محمد الخامس على إجرائها، لتضطر فرنسا إلى تأجيلها، قبل أن تقرر إجراءها بعيدا عن الحدود. لكن المؤكد أن تجارب كثيرة سبقتها، منها ما وصل صداه إلى الرأي العام، ومنها ما بقي حبيس الوثائق السرية، لكن المؤكد أنها كانت خطيرة للغاية.
عرفت العملية التي وقع عليها الرئيس الفرنسي وقتها بعملية الجربوع الأزرق، والمثير أنها لم تكن خطيرة، لذلك ركزت عليها فرنسا لكي تظهر أنها تحترم معايير السلامة، إلا أن الأمر لم يكن قابلا للتبرير، ما دام قد أجري في بلد آخر وليس في فرنسا. العقلية الاستعمارية لم تكن ترى مانعا في تنفيذ تجربة من هذا النوع في المنطقة. فقد نشرت الصحافة الفرنسية وقتها، أن الانفجار تسبب في وميض قوي استمر لثوان وسط الصحراء، ورآه الأهالي فعلا.
وهو ما جعل المعارضة في المغرب، الذي حصل على الاستقلال، تحاول لفت الانتباه إلى إمكانية حدوث تجارب من ذلك النوع في المغرب أيضا.
المعروف أن فرنسا قوة نووية ومن أولى الدول التي استطاعت تطوير هذه القنابل في العالم، لكنها لم تُؤد أبدا ضريبة التجارب الخطيرة التي حققت من خلالها تلك النتائج. بل أدت دول أخرى تلك الضريبة، وهو ما يجعل فرنسا اليوم مطالبة بالاعتذار لهذه الدول على الأقل.
جربت فرنسا أسلحة خطيرة، سيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية، في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، لكنها طمست الأرشيف الخاص بهذه العمليات واعتبرته دائما سرا من أسرار الدولة.
هل جربت فرنسا أسلحة مُحرمة في الصحراء؟
قامت الدنيا في فرنسا عندما نُشرت أخبار في سنة 2005، عن اكتشاف غبار نووي في منطقة كوت ديفوار وبوركينا فاسو. وهو ما يؤكد ما ذهب إليه معارضون فرنسيون لسنوات، وهم يحاولون لفت انتباه الرأي العام الفرنسي إلى وجود عمليات تجارب نووية فرنسية في القارة الإفريقية.
حتى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية نشرت تقريرا أشار إلى أن التداعيات الناجمة عن إسقاط قنابل من هذا النوع على الأرض تمت في عمليات متكررة في نطاق لا يتجاوز كيلومترا مربعا واحدا.
وهو ما يعني أن فرنسا ظلت تجرب لسنوات عمليات تفجير في مساحة ضيقة، لكن التقرير نفسه قال إن فرنسا لم تتجاوز المستوى الذي يصل إلى درجة تتطلب تدخل الوكالة، وإن تلك العملية لا تشكل أي تهديد على سلامة السكان.
لكن في سنة 2009، وافقت الحكومة الفرنسية على تعويض الأهالي المجاورين لمناطق تلك التجارب، في محاولة لطي الملف.
إلا أن المعارضة في فرنسا، خصوصا نشطاء منظمات حقوق الإنسان طالبوا حكومة بلادهم بكشف ملفات التجارب السابقة، والتي سوف تكون بالتأكيد أكثر خطورة من الأخرى التي أثارت الانتباه.
يتعلق الأمر بعمليات أخرى جرى تجريبها في العقود الماضية، بعيدا عن أعين الصحافة والحكومات، وتسببت في رعب كبير للأهالي، رغم أنهم كانوا يبعدون عشرات الكيلومترات عن تلك المواقع التي جربت فيها فرنسا قنابلها.
من شدة الانفجارات، نزح الأهالي في الصحراء الجزائرية، التي عرفت عمليات تجارب واسعة على مدى سنوات طويلة، نحو المنطقة الحدودية مع المغرب، لكن وقتها لم تواجه فرنسا أي مشاكل مع الرأي العام، لتبرير تلك العمليات أو شرح أسبابها.
لكن الأرشيف العسكري الفرنسي، يجعلنا نطرح أسئلة كثيرة عن تلك القنابل التي حُرم استعمالها دوليا، لكن فرنسا لم تجد حرجا في تجربتها في مناطق تعرف وجود سكان لواحات ورعاة يتحركون بحرية في الصحراء بين المغرب والجزائر.
وما جعل هذا الملف شائكا، أن فرنسا حاولت فعلا تكرار تجارب لقنابل خطيرة، في مناطق أخرى، لكنها اصطدمت برفض واسع في أوساط المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا متخوفين من تبعات تلك التجارب، خصوصا في ستينيات القرن الماضي، إذ إن مبرر الحرب العالمية الثانية الذي استغلته فرنسا لتجربة أسلحتها في المغرب أيضا، لم يعد نافعا بعد خمسينيات القرن الماضي. كما أن الصحافة الفرنسية صارت أكثر شراسة وتنقب في ملفات الحكومة، وقد تؤلب الرأي العام الفرنسي ضد حكومة بلاده، في حال ما استمرت التجارب في الصحراء بين المغرب والجزائر.
وهناك معلومات تفيد بأن الملك الراحل محمد الخامس سنة 1959، وصل إلى علمه أن فرنسا تنوي إجراء تجارب نووية واسعة في الصحراء الشرقية على مقربة من المنطقة الحدودية مع المغرب، ورغم أن المنطقة لم تكن مأهولة، إلا أن الملك الراحل أجرى اتصالات واسعة وطلب ألا يتم إجراء تلك التجارب، مخافة تداعيات إلقاء قنابل من ذلك النوع على القبائل والرحل. وهو فعلا ما استجابت له فرنسا، وجنب الجزائر كوارث إضافية.
ورغم أن المغرب لم يكن معنيا بتلك العملية، إلا أن وساطة الملك الراحل محمد الخامس كانت لصالح إغلاق ملف تلك التجارب في الصحراء، لكنها استمرت فعلا، وهو ما يؤكده الأرشيف في مناطق أخرى.
في هذا الملف سوف نتطرق أيضا إلى الأسلحة التي جرى تجريبها في المغرب، وليس فقط الأسلحة النووية.
+++++++++++++++++++++++++
لماذا لا تُفرج فرنسا عن أسرارها العسكرية؟
بعض الملفات التي كانت تدخل في خانة «أسرار الدولة» رُفعت عنها السرية ونوقشت في برلمان فرنسا وأدلى السياسيون والمثقفون برأيهم فيها، بل وحثوا القصر الرئاسي على صياغة اعتذارات رسمية لبعض الدول، التي تضررت من سياسة فرنسا سابقا. لكن لم يسبق أبدا أن كان المغرب معنيا بأي من تلك الملفات، رغم أن جرائم فرنسا عندنا لا تختلف في شيء عن جرائمها في بعض الدول التي اعتذرت لها رسميا ورفعت السرية عن وثائق بعض العمليات، رغم بشاعتها.
باحثون مغاربة منذ سنوات حاولوا الوصول إلى الأرشيف المتعلق ببعض القضايا، لكن ملاحظة واحدة خلصوا إليها جميعا، مفادها أن هناك قطعا ناقصة من «الأحجية». إذ إن آلاف الوثائق التي تؤرخ لعمليات فرنسا في مناطق المغرب الشرقي على وجه الخصوص، تُعتبر ناقصة في ظل غياب وثائق أخرى تتعلق بمجمل العمليات المنفذة هناك، سيما منها تلك التي تتعلق بإبادة القرى، وسجن الرافضين لسياسة الجيش الفرنسي في مناطق المغرب ما بين 1912 و1919، السنة التي وصل فيها جنرالات فرنسا إلى نواحي ورزازات وتنغير.
مقارنة بين الروايات الشفهية التي جمعها باحثون من أبناء المنطقة، على لسان من عاشوا تلك الأحداث الدامية، وبين ما هو مدون في السجلات العسكرية، تؤكد فعلا أن فرنسا لم توثق بالصورة المطلوبة لما وقع فعلا في تلك الأراضي الشاسعة.
وهو ما يفتح الباب على مصراعيه على فرضيات وجود تجارب فعلية لأسلحة خطيرة، في منطقة الصحراء الحدودية مع الجزائر.
إذ إن الجيش الفرنسي لطالما اعتبر مناطق طاطا، صعودا نحو فكيك، باحة خلفية لقواته العسكرية.
وكان سياق الحرب العالمية الأولى وقتها يخيم على الأجواء، ويقلق المؤسسة العسكرية الفرنسية. وهكذا فقد تم تجريب أسلحة استُعملت خلال تلك الحرب، في الصحراء أولا للتأكد من نجاعتها، قبل استعمالها في الميدان.
الجرائم التي مورست في الحرب العالمية الأولى والموثق لها في الصور والفيديو أيضا، مورست أيضا في المناطق القاحلة بين المغرب والجزائر، وجرى الترتيب لها بشكل سري، لكن تفاصيلها تسربت في الأخير إلى سياسيين فرنسيين وصحافيين، وتحدثوا عن أسلحة خطيرة جُربت على سكان القرى، رغم نفي الحكومات الفرنسية في مناسبات كثيرة وقوع أمر مماثل. لكن عسكريين متقاعدين، وفرنسيين استقروا في المغرب تحدثوا فعلا عن ممارسات همجية ومشاريع لتجريب أسلحة فتاكة، توقفت في آخر لحظة بفضل تدخلات سياسيين، جنبت فرنسا الوقوع في «فخ» جرائم ضد الإنسانية.
بعض الأرشيف الفرنسي العسكري سيكون بلا شك محرجا لفرنسا، لذلك رغم سريان قانون رفع السرية عن الوثائق الرسمية، العسكرية منها على وجه الخصوص، على الأرشيف الرسمي للدولة، إلا أنه لم يسر على تلك الوثائق التي سوف تكون محرجة بكل تأكيد.
عبد الله إبراهيم والتحقيق في جرائم الجيش قرب فگيك
عندما كان عبد الله إبراهيم وزيرا أول في حكومة 1959، كان موضوع القواعد العسكرية الأجنبية في المغرب ملفا ساخنا فوق طاولة الحكومة المغربية التي كان أغلب أعضائها، إن لم يكونوا كلهم، يسيرون مع تيار قدماء الحركة الوطنية الداعي إلى ضرورة تحرير البلاد من كل ما هو فرنسي.
ملف تسليم القواعد العسكرية التي بنتها فرنسا، خصوصا قاعدتي مكناس ومراكش العسكريتين، كان يطغى على النقاش العام في المغرب، سيما وأن تيار الوطنيين الشباب كانوا لا يزالون يكنون العداء لكل ما هو فرنسي، رغم توقيع الاستقلال في مارس 1956.
إذ رغم تسليم قاعدتي مكناس ومراكش، إلا أن استكمال عمليات التسليم في 1959 كان لا يزال يعرف عرقلة كبيرة، خصوصا وأن مسؤولين فرنسيين كبارا أخذوا معهم وثائق من الأرشيف لم يتم تسليمها إلى المغرب، سيما في المؤسسة العسكرية والأمنية.
إذ إن وجود بعض المحاضر المتعلقة بجرائم فرنسا في المغرب قد يدين فرنسا مستقبلا، لذلك حرص المسؤولون السابقون، خصوصا المناصرين للعقلية الاستعمارية، على إتلاف وثائق تتعلق بالأرشيف، وهو ما أكده عدد من الوطنيين المغاربة الذين كانوا قريبين من تلك الكواليس أو شهودا عليها.
كان عبد الله إبراهيم، بحكم علاقاته مع قدماء خلايا المقاومة المسلحة، يفتح مكتبه في مقر الوزارة الأولى بالرباط أمام الراغبين في رفع مظالمهم إلى الملك الراحل محمد الخامس، وكثيرا ما كان العاملون في القصر الملكي يشاهدون الوزير الأول وهو يسرع الخطى قاطعا الساحة المفضية إلى جهة القصر الملكي التي كان يوجد فيها مكتب الملك الراحل، مصحوبا بزواره من خلايا المقاومة، لكي يُمكنهم من لقاء الملك لدقائق وتقديم شكاويهم بين يديه. ومن بين قدماء المقاومة الذين سبق لعبد الله إبراهيم الوساطة من أجلهم، بعض القادمين من مناطق فگيك والمنطقة الحدودية مع الجزائر شرقا. وهؤلاء اشتكوا للملك الراحل من أحداث 1953 التي عرفتها المنطقة، ووضعوا بين يدي الملك الراحل مظالم تتعلق بالشطط الذي طالهم، حيث سُلبت منهم أراض شاسعة من الواحات، وأحرقت مزارعهم. وكانت وقتها إشاعات قوية تتناقلها الألسن، بشأن تجريب فرنسا لأسلحة خطيرة جدا في المنطقة المشتركة بين المغرب والجزائر، والتي تحولت لاحقا إلى مناطق متنازع عليها بين البلدين، بسبب عدم وضوح سياسة الترسيم الحدودي التي رعتها فرنسا في المنطقة، بشكل متعمد.
وقتها أعطى الملك الراحل محمد الخامس تعليمات لتوفير عناية خاصة للمقاومين المنحدرين من تلك المناطق، بحكم أنهم عاشوا معاناة من نوع خاص، ضاعت أغلب تفاصيلها بسبب اختفاء الأرشيف المتعلق بها، رغم أن أحداثا أخرى وقعت بعدها، ولم يتعرض أرشيفها للتلف.
لم يقو أي مسؤول مغربي وقتها لكي يتهم فرنسا صراحة بتجريب أسلحة محرمة في تلك المناطق، لكن «روايات» تجريب فرنسا لأسلحة مميتة، كانت تطغى فعلا على النقاش العام وقتها، إلى درجة أن بعض قدماء المقاومة طالبوا بمساءلة فرنسا عن صحة تلك المعلومات، خصوصا وأنها كانت تتعلق بتجريب أسلحة «نووية» في المنطقة الحدودية مع الجزائر، سبق لمعارضين فرنسيين أنفسهم أن طالبوا بفتح تحقيق في تفاصيلها، وما إن كانت فعلا قد جرت فوق تراب المنطقة المشتركة بيننا وبين الجزائر.
الملف السري لتجريب رشاشات على الأبرياء بشوارع المغرب ومداشره
جربت فرنسا أنواعا كثيرة من السلاح في المغرب، بينها رشاشات متطورة، أوتوماتيكية، وحرصت على ألا يصل أي منها إلى أيادي أعضاء الخلايا السرية للمقاومة، الذين بدؤوا أنشطتهم المعادية لفرنسا بعد غشت 1953، تاريخ نفي الملك الراحل محمد الخامس.
من بين تلك الرشاشات التي استعملتها فرنسا، رشاشات متطورة تصيب الأهداف بدقة متناهية، حسمت بها معارك كثيرة خلال الحرب العالمية الثانية. لكنها استعملتها ضد مدنيين مغاربة على خلفية أعمال «شغب»، لا تمت بصلة للحروب ولم تكن تشكل أي تهديد أمني على الفرنسيين.
وحسب وثائق الإدارة الأمنية الفرنسية في الرباط، والتي سبق للمندوبية السامية للمقاومة أن ترجمتها إلى اللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي وأصدرتها في سلسلة منشورات، فإن القوات الفرنسية، ومنها قوات تابعة للجيش وليس للبوليس، نفذت عمليات تطهير واسعة في صفوف السكان بأسلحة جربت مفعولها لأول مرة في المغرب،
ووقعت بسبب ذلك مجازر رهيبة حصدت أرواح الأبرياء.
جاء في وثائق المحاضر الفرنسية، أنه في منتصف شهر غشت 1955، وبالضبط يوم 18 منه، احتفل البوليس الفرنسي باعتقال خلية سرية، كان أعضاؤها يتجاوز عددهم العشرين فردا. تم إلقاء القبض عليهم جميعا، عندما كانوا في اجتماع في منزل مهجور نواحي منطقة فضالة، وصودرت معهم أسلحة ومعدات لصناعة قنابل محلية.
في مثل هذه الحالات، لم يكن المدعي العام الفرنسي في حاجة إلى أدلة إدانة كثيرة، ما دام المحضر الذي أعده البوليس يذكر مصادرة محجوزات، تعتبر في لغة القانون «أدوات الجريمة» وأدلة ضد المُحتجزين.
رغم أن رسالة من الوطنيين أكدت وجود تلاعب في محضر احتجاز الشبان العشرين، إلا أن المدعي العام أثناء المحكمة، عندما أثار دفاع المتهمين الموضوع، أكد أنهم اعترفوا عند بداية التحقيق معهم بالمنسوب إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يخبئون الأسلحة في المنزل الذي تم احتجازهم فيه. وهكذا ضاعت على الدفاع فرصة التشكيك في مصداقية المحاضر لربح الوقت.
هذه الحيلة كان يلجأ إليها الوطنيون أيضا لتأليب الرأي العام ضد الإقامة العامة الفرنسية. هذا لا يعني أنهم كانوا دائما مخطئين، فقد تم فعلا تزوير المحاضر في عدد من القضايا التي أدين فيها مواطنون مغاربة بالسجن المؤبد، وأحيانا أخرى وصل الأمر حد تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مواطنين مغاربة، لم يتأكد القاضي من مصداقية المحاضر المنسوبة إليهم، رغم أن محاميهم أكدوا أن موكليهم يتبرؤون من الكلام المنسوب إليهم في محاضر البوليس.
ربما كان السياق العام الذي ألقي فيه القبض على أولئك الشبان غير مناسب لمراقبة تنزيل النصوص القانونية واحترامها، فقد كانت الأوضاع تعرف غليانا غير مسبوق، تجاوز كثيرا في حدته خطورة الأحداث التي عرفتها بداية السنة.
فقد ازدادت وتيرة قطع أسلاك الهاتف، وهي الحيلة التي بدأ الوطنيون في تنفيذها مع مطلع الخمسينيات، احتجاجا على نفي الملك محمد الخامس، وكانوا يلجؤون إليها لتعطيل التنسيقات الأمنية.
لكن ما لم تتضمنه المحاضر، وكشفته ذاكرة التاريخ الشفهي لقدماء المقاومة، أن الإدارة الفرنسية رأت أنه لم يعد هناك أي مفعول رادع للاعتقالات، والأحكام، فاختارت إطلاق الرصاص على المواطنين في الشوارع والقرى، رغم أنهم لم تكن لديهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالأحداث التي كانت الإدارة الفرنسية تريد كبحها.
محامون فرنسيون أدانوا جرائم بلادهم قبل ستين سنة
بعض المحامين الفرنسيين اكتسبوا شهرة واسعة في فرنسا وخارجها أيضا، بفضل قيادتهم لحملات مناهضة لسياسة بلادهم في بعض الدول، خصوصا في شمال إفريقيا.
إلى درجة أن بعضهم ترافعوا لصالح محكومين مغاربة بالإعدام سنة 1954، على خلفية أعمال اعتبرها الفرنسيون إرهابية، وغامر هؤلاء المحامون بسمعتهم وترافعوا لصالح المتهمين على أساس أنهم مقاومون.
هؤلاء المحامون سلطوا الضوء بقوة على جرائم جيش بلادهم في المغرب، وتنفيذ مجازر باستعمال أسلحة مخصصة للحروب مثل الرشاشات، لمواجهة أعضاء الخلايا السرية للمقاومة الذين كانوا بالكاد يتوفرون على مسدس تقليدي أو مسدسين، قبل أن تزداد حدة المقاومة بعد ارتفاع إيقاع الأحداث وازدياد قساوة القمع الفرنسي.
وحسب أرشيف المحاضر الفرنسية في إدارة الأمن التابعة للإقامة العامة في الرباط، وبناء على المحاضر المتوفرة، والتي تعود إلى سنة 1955، فإن عملية إلقاء القبض على الخلية السرية كانت في تمام الرابعة فجرا من صباح الخامس عشر من غشت. كانت الخلية بصدد اجتماع سري، لمباحثة طريقة آمنة لمغادرة الدار البيضاء، بحكم أن كل أفراد الخلية أصبحوا في عداد المبحوث عنهم.
الأسوأ، أن أحد أعضاء الخلية تعرض للاعتقال والتعذيب، ولم يرد البقية المغامرة بسلامتهم الجسدية، في حال ما إذا انهار صديقهم تحت التعذيب الرهيب، الذي يتعرض له المقاومون في أقبية الكوميسارية على يد الجلادين المغاربة الذين عملوا لصالح البوليس الفرنسي.
كانت لحظة المداهمة غير متوقعة، وحسب المحاضر، فقد حُجزت قنابل في طور الإعداد، واعترف «مولاي» بسهولة بأنه كان يحضرها لعمليات كانت الخلية تخطط لتنفيذها في الدار البيضاء والنواحي، وتستهدف بالأساس أعوان الإدارة الفرنسية.
قُدم الجميع إلى المحاكمة، وتم الاحتفاظ بهم في السجن المركزي بالقنيطرة.
وحسب بعض إفادات قدماء المقاومة، فإن بعض الأسماء لم ينفذ فيها حكم الإعدام، وحدث أن ماتت متأثرة بالمرض، وصعوبة الجو داخل السجن المركزي، وكان هذا هو مصير أغلب أفراد الخلايا السرية. لكن المصادر ذاتها تؤكد أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد من المقاومين، أسابيع قليلة قبل عودة الملك محمد الخامس من المنفى، والتمهيد لحصول المغرب على الاستقلال.
لم يتوقف الأمر عند تنفيذ أحكام الإعدام، والتي يوثقها الأرشيف، بل تجاوز ذلك إلى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المتظاهرين في مناسبات كثيرة، وهو ما يزكي فعلا وقائع إبادات جماعية لسكان القرى، رغم محاولات المؤسسة العسكرية الفرنسية التملص من تلك الاتهامات التي لاحقتها لسنوات طويلة.
هؤلاء المحامون الذين أدانوا حكومات بلادهم، لم يجدوا حرجا في اتهامها صراحة بتلك الجرائم، وطالبوها بالاعتذار للمغاربة عن كل ما حدث. لكن يبدو أن مسألة هذا الاعتذار سوف تبقى مؤجلة لوقت أطول، رغم حالات المد والجزر بين باريس والرباط، بسبب القضايا القديمة والمتراكمة، والأخرى الجديدة أيضا.
فرنسا والتجارب النووية في الصحراء الشرقية
- المغرب الجامعة تنفي تعيين مدرب جديد لـ«أسود الأطلس» وتتشبث بالدفاع عن حقوقها في نهائي الكان
- المغرب “إنوي” تطلق نداء وطنيا للتطوع لتسريع الإدماج الرقمي في الوسط القروي
- رياضة إحالة عميد المنتخب للمحاكمة بتهمة الاغتصاب
- المغرب وكالة التنمية الفلاحية تطلق طلب عروض مشاريع "الشراكات المنتجة"
- المغرب بوليفيا تعلّق اعترافها بـ"البوليساريو" وتفتح صفحة جديدة مع المغرب
- المغرب جلالة الملك يعطي بسلا انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1447" التي سيستفيد منها أزيد من 4,3 ملايين شخص
- المغرب تعليمات من الحموشي بتتبع الحالة الصحية واتخاذ التحفيزات الإدارية لفائدة موظفي الأمن ضحايا حادثة سير بسيدي افني
- المغرب بنسعيد يوضح أسباب سحب مرسوم لجنة تسيير قطاع الصحافة
- المغرب الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة
- رياضة سجن من 3 أشهر إلى سنة.. عقوبات نافذة لمفتعلي شغب نهائي كأس إفريقي
جميع النشرات

الجامعة تنفي تعيين مدرب جديد لـ«أسود الأطلس» وتتشبث بالدفاع عن حقوقها في نهائي الكان

“إنوي” تطلق نداء وطنيا للتطوع لتسريع الإدماج الرقمي في الوسط القروي

وكالة التنمية الفلاحية تطلق طلب عروض مشاريع "الشراكات المنتجة"

بوليفيا تعلّق اعترافها بـ"البوليساريو" وتفتح صفحة جديدة مع المغرب

جلالة الملك يعطي بسلا انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1447" التي سيستفيد منها أزيد من 4,3 ملايين شخص

تعليمات من الحموشي بتتبع الحالة الصحية واتخاذ التحفيزات الإدارية لفائدة موظفي الأمن ضحايا حادثة سير بسيدي افني

بنسعيد يوضح أسباب سحب مرسوم لجنة تسيير قطاع الصحافة

الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة
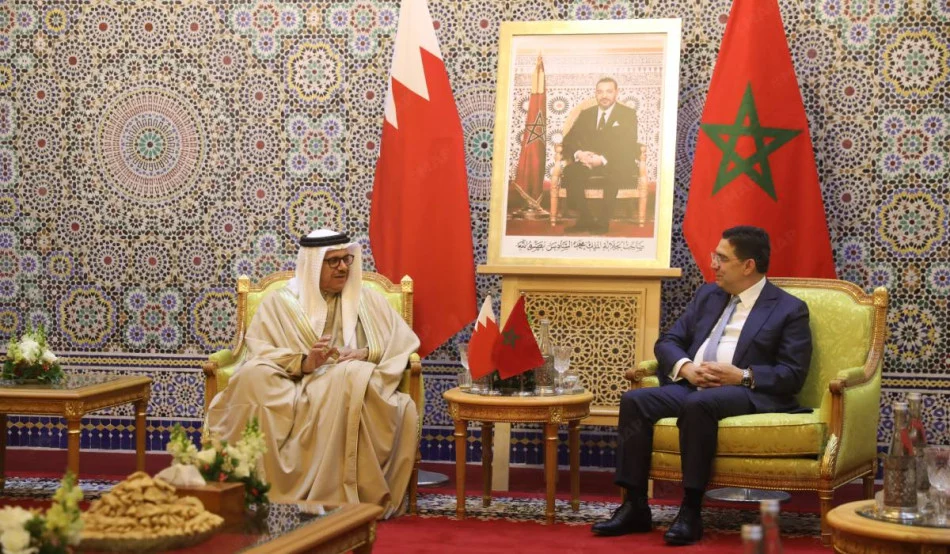
المغرب والبحرين يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما المشترك في شتى المجالات

باريس تحتضن انطلاقة الجولة الدولية "العمران مغاربة العالم 2026"

فضيحة القارورات في القاهرة.. الجيش يطالب الكاف بانزال العقوبة على الأهلي المصري
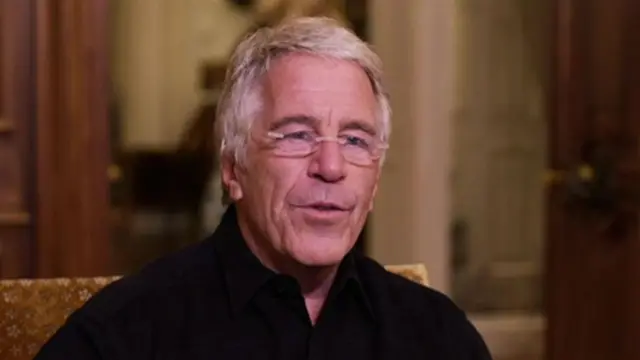
زلزال «إبستين» يهز النخب العالمية... استقالات وتحقيقات واعتذارات وسط دوائر السلطة والمال

جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات تابع لمجموعة “سافران”

استنفار بسبب تبادل لإطلاق نار بين أباطرة المخدرات باكزناية بطنجة

عدد زبناء اتصالات المغرب بلغ 77 مليون زبون في 2025

الإعلان عن أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والعرائش مناطق منكوبة

أخنوش ينهي المواجهة المفتوحة بين وهبي والمحامون
بوريطة يشارك في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

لقجع: المغرب جاهز لتنظيم كأس العالم 2030 والكان كان استثنائيا

أخنوش: المغرب يمر بمرحلة مفصلية تتطلب نموذجاً سياسياً جديداً

أخنوش: السياسة حين تُمارَس بصدق تصبح عملاً إصلاحياً نبيلاً

أخنوش: «مسار الثقة» و«100 يوم 100 مدينة» أعادا الاعتبار للإنصات للمواطن

أخنوش : حزب الأحرار يرفض منطق الزعامات الخالدة وعدم ترشحي لولاية ثالثة احترام للديمقراطية الداخلية

النيابة العامة تنفي إضراب معتقلي الأحداث الشغب نهائي الكان عن الطعام

بوريطة يعرض بواشنطن أهمية المغرب الجيواستراتيجية في مجال المعادن الاستراتيجية

البرلماني والقيادي عبد الرحيم بن الضو يعلن تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة

واردات مائية قياسية ترفع ملء سدود المغرب إلى 61%... وسد واد المخازن يتجاوز سعته الاعتيادية

بناء على النشرات الإنذارية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطر

مجلس المستشارين يختتم دورة أكتوبر بالمصادقة على 17 نصا تشريعيا وتعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني

أمطار طوفانية مرتقبة: الأرصاد ترفع مستوى الخطر إلى الأحمر بعدة أقاليم شمالية

تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

فرنسا تعلن عزمها إبرام معاهدة ثنائية جديدة مع المغرب ذات بعد برلماني قوي

الحاج عبد الهادي بلخياط يغادر "قطار الحياة"

الأمن ينفي تسجيل حالات سرقة ونهب بالقصر الكبير

أمطار قوية ورياح عاصفية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

ابتدائية مراكش تقضي بحبس بلقايد وبنسليمان سنتين بتهم تبديد أموال كوب 22

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ويبرز أهمية المبادرة الملكية للأطلسي

إغلاق مؤقت لمطار سانية الرمل بتطوان

اختتام السنة الدولية للتعاونيات بالرباط

جلالة الملك يترأس بالدار البيضاء اجتماع عمل بخصوص المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط

التوافق يحسم خليفة أخنوش على رأس الأحرار

بنسعيد ينفي علاقته بملف إسكوبار الصحراء ويعلن لجوءه إلى القضاء

حزب التجمع الوطني للأحرار يقدم كتاب "مسار الإنجازات"

المغرب والسنغال يؤكدان متانة الشراكة الثنائية ويعززان التعاون الب

الفرقة الوطنية تحسم الجدل... الحكم جيد بريء من اتهامات التدخل في قرارات "الفار"

عثمان سونكو: العلاقات بين المغرب والسنغال أعمق من أي "انزلاقات رياضية"

أخنوش يستقبل رئيس الوزراء السينغالي بالرباط

حرب الظل بين باريس والجزائر.. اختطافات وتجسس وتجنيد للعملاء بقلب فرنسا

الأمن الوطني يفنّد مزاعم مجلة "لو بوان" الفرنسية

مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تتوج الفائزين بـ "جائزة CDG للأثر الاجتماعي" في دورتها الأولى

الملك محمد السادس بعد نجاح "الكان": المخططات المعادية للمغرب لن تبلغ مرادها

بوريطة يوقع إلى جانب ترامب على الميثاق المؤسس لمجلس السلام

الإدارة العامة للأمن ترد : لا وفيات خلال نهائي كأس إفريقيا

السويد تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي بالصحراء

الملك يرد بالإيجاب على دعوة الرئيس ترامب لينضم كعضو مؤسس لمجلس السلام

الحموشي حرص على متابعة البروتوكول الأمني للنهائي الإفريقي

لهذه الأسباب المغرب مرشح قوي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2028

تعيين نفيسة القصار رئيسة جديدة لهولدينغ "المدى"

الولايات المتحدة تعلق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها المغرب

ولد الرشيد : المغرب يعيش مرحلة الحسم النهائي في ملف الوحدة التراب

التزاما بالنظام الأساسي للأحرار.. أخنوش لن يترشح للولاية الثالثة

أخنوش يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس الأحرار

جلالة الملك يعاني من ألم في أسفل الظهر دون خطورة وصحة جلالته مطمئنة

أخنوش: الاعتراف الأممي بالصحراء مرحلة حاسمة والمغرب انتقل من التدبير إلى التغيير

380 مليار درهم استثمارًا عموميًا في 2026 وأخنوش يتوقع نموًا بـ5.6 في المائة

أخنوش يشيد بتماسك الأغلبية ويعلن توجهًا لتمديد انتداب هياكل الحزب

أخنوش: تعميم الحماية الاجتماعية حق مكفول واستفادة 4 ملايين أجير

الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا

كل ما تجب معرفته قبل السفر إلى الخارج من أجل الأعمال أو الدراسة أو السياحة

نجوم العالم والأفارقة يشيدون بالتنظيم وأرقام تاريخية في الحضور

كأس إفريقيا بالمغرب تفرض استنفارا أمنيا في أوروبا

الحكم على البرلماني الاستقلالي مضيان بستة أشهر حبسا نافذا في قضية رفيعة المنصوري

الفرقة الوطنية تحقق مع 36 مؤثراً بسبب الترويج لمنصات المراهنات غير القانونية

عطلة "المشاهير" في المغرب.. بين أجواء رأس السنة وبريق «الكان»

اعتقالات وتتبع أمني لتجار السوق السوداء مضاربين سحبوا إعلاناتهم

فيديوهات مفبركة وروايات مضللة تتهاوى أمام نجاح التظاهرة

يقظة معلوماتية ترصد الإعلانات المشبوهة وتفكك شبكات رقمية منظمة

مغرب 2025..حفل افتتاح يبهر العام

الأمير مولاي الحسن يترأس حفل افتتاح "الكان"

أخنوش : مع الأغلبية الحالية أعدنا "الروح" للعمل الحكومي .. ووضعنا المصلحة العامة فوق الحسابات الحزبية

مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا لضمان عدالة سريعة وآمنة داخل الفضاءات الرياضية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحقق رقماً قياسياً وتضخ 7,5 مليارات درهم في مالية الدولة

تهنئة ملكية لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الفائز ببطولة كأس العرب قطر 2025

لقاء وطني بالرباط يناقش مقاربات محاربة الأخبار الزائفة

كابل «ميدوزا» يربط المغرب بالعالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات آسفي إلى 37 وفاة

تيميتار – علامات وثقافات : عشرون سنة تجدّد روح الموسيقى الأمازيغية بين الذاكرة والإبداع

المغرب يستعد لصنع أجمل عرس إفريقي

فاجعة في فاس.. مصرع 19 شخصا في انهيار بنايتين وسلطات المدينة تواصل جهود الإنقاذ

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية السنغالية

أنشيلوتي: المغرب بات رقما صعبا بعد مونديال قطر

المغرب يخوض مونديال أمريكا بذكريات كأس العالم 1998

«CDG».. قوة هادئة تعيد رسم خريطة الاقتصاد المغربي

إسبانيا ترسّخ دعمها لمغربية الصحراء وتشيد بالإصلاحات الملكية

إعلان مشترك.... إسبانيا تشيد بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797

أخنوش بالرباط: "مسار الإنجازات" يواصل تنزيل الدولة الاجتماعية ومشاريع الماء والصناعة

بنمبارك: جهة الرباط سلا القنيطرة على مشارف تحول صحي كبير وستصبح وجهة بارزة لـ"السياحة العلاجية"

فتيحة المودني: رؤية ملكية تُلهم الرباط و"الأحرار" يترجم التوجيهات إلى إنجازات عملية

افتتاح الدورة التاسعة لمعرض العمران للعقار 2025

الأنتربول توشح حموشي بوسام "الطبقة العليا"

لفتيت يقصف نواب العدالة والتنمية: أنتم تدافعون عن المفسدين وتقولون ما لا تفعلون

الرئيس الجديد للأنتربول يتعهد من مراكش بتعزيز التعاون الأمني مع المغرب

شراكة استراتيجية تجمع مجموعة العمران و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

أخنوش ينفي الزيادة في ثمن "البوطاغاز" ويعلن رفع مبالغ الدعم المباشر للأسر

توقيف الستريمر إلياس المالكي واقتياده للتحقيق على خلفية شكايات ضده

وزير التربية الوطنية ينفي شبهات خرق القانون ويكشف تفاصيل استقالته من شركاته

حموشي يدعو إلى «إنتربول المستقبل» من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة

المحكمة الإداربة تعزل رئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي بسبب فندق "الشيخات"

توقيف "التيكتوكر "مولينكس" ونقله لطنجة على خلفية قضية "التيكتوكر" بنشقرون ووالدته

ولادة مفاجئة داخل ترامواي الرباط–سلا تنتهي بمأساة

120 ألف طفل مجنّد في إفريقيا.. وبوريطة يطالب بآلية قانونية مشتركة

إدارية الدار البيضاء تقضي بعزل رئيس جماعة برشيد ونوابه

مكتب السياحة يكشف عن فيلم "المغرب، أرض كرة القدم"

حموشي يتوج أبناء وأيتام الأمنيين المتميزين دراسيا بمنح جامعية تمتد لخمس سنوات

تكريم وهدايا مادية لأمنيين متقاعدين تجاوزوا سن الثمانين وجوائز لرياضيين ومبدعين

هدم قصر "الكرملين" يطيح بباشا بوسكورة ولجنة من الداخلية تحل بعمالة النواصر

وزير الداخلية الإسباني يوشح حموشي بأرفع أوسمة الاستحقاق للحرس المدني الإسباني

أخنوش: نظام دعم المقاولات الصغيرة رهان استراتيجي يكرس العدالة المجالية بالمغرب
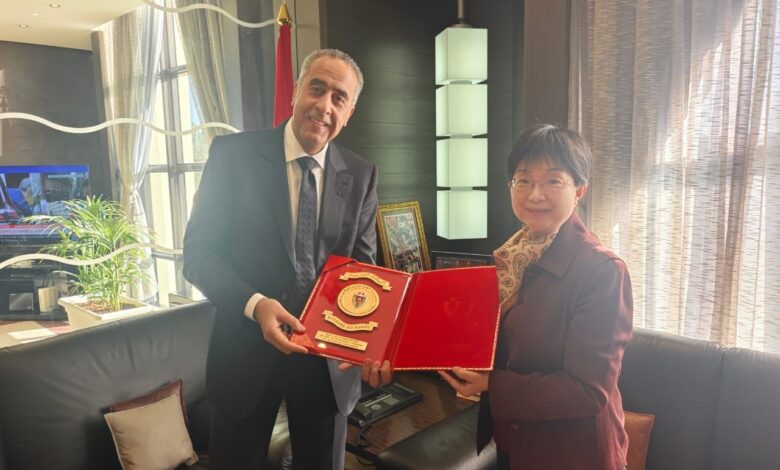
تعزيزا للتعاون الأمني بين بكين والرباط… حموشي يستقبل سفيرة جمهورية الصين الشعبية

أخنوش يكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد الوطني
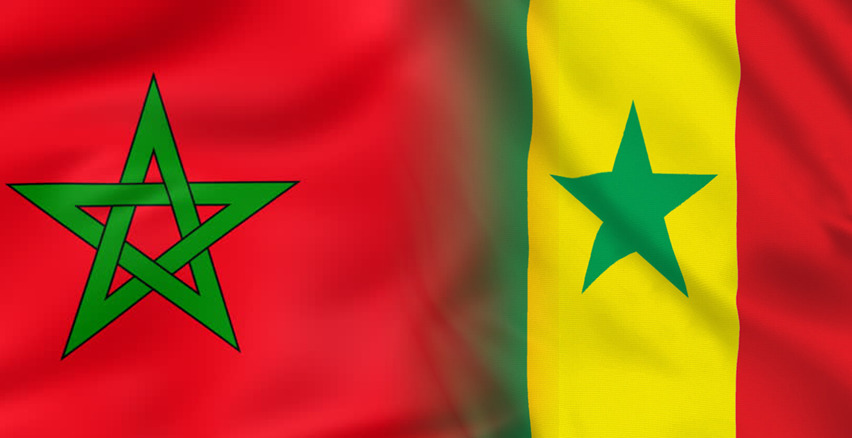
المغرب والسنغال يعززان شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل

مستشارو الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي

اتصالات المغرب تفعل ابتداءً من اليوم شبكة الجيل الخامس

"اورنج المغرب" تطلق رسميا خدمات الجيل الخامس 5G

اتصالات المغرب تكشف عن هويتها البصرية الجديدة

من يكون زهران ممداني أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك ؟

الملك محمد السادس يقرر إحداث "عيد الوحدة" يوماً وطنياً جديداً في 31 أكتوبر من كل سنة

المغرب يقدّم نموذجًا رائدًا عالميًا في رعاية الأطفال الصم بفضل مؤسسة للا أسماء

عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء في ورطة لهذا السبب

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تحل بنيروبي في زيارة عمل لكينيا

حموشي ضمن تشكيلة المجلس الأعلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للمرة الثانية

جلالة الملك يدشن المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط ويعطي تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير

ولد رشيد :"القرار الأممي يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية المغربية"

أخنوش يشيد بدور الدبلوماسية الملكية في تبني القرار الأممي حول الصحراء ويؤكد أن حكومته تنصت وتشتغل بالمعقول

بوريطة يكشف كواليس قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية

أخنوش: الرؤية الملكية السديدة جعلت 2025 سنة الانتقال من منطق التدبير إلى منطق التغيير في ملف الصحراء المغربية

الملك يوجه نداء صادقا لإخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم

الملك محمد السادس: قرار مجلس الأمن فتح جديد في مسار ترسيخ مغربية

الحكم الذاتي أساس حل ملف الصحراء تحت السيادة المغربية

الملك محمد السادس نجح في حشد دعم دولي وازن لمبادرة الحكم الذاتي

الديبلوماسية الملكية تنجح في حشد اعتراف دولي بسيادة المغرب على صحرائه

26 سنة من الدبلوماسية الملكية تحسم ملف الصحراء المغربية

الملك محمد السادس: القرار التاريخي لمجلس الأمن انتصار للدبلوماسية المغربية والحكم الذاتي هو الحل الواقعي للنزاع المفتعل

السرعة والضباب الكثيف يتسببان في حادثة سير مروعة في الطريق السيار بين مدينة الجديدة وأزمور

الفاشر في قبضة الموت… مشاهد تفوق ما يحتمله العقل البشري

الوكيل العام للملك بالرباط يأمر بفتح تحقيق في مزاعم طحن الورق مع

الباراغواي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعلن نيتها فتح قنصلية بالداخلة

النيابة العامة تكشف حصيلة المتابعات القضائية في احتجاجات «جيل Z»

السجن يتهدد مفتعلي الشغب وإجراءات صارمة ورسائل تحذير من خطابات الكراهية

«تدرّج».. برنامج وطني لتأهيل الشباب بقطاع الصناعة التقليدية

البنك الشعبي يحصل على “إيزو 37001” الخاصة بنظام إدارة مكافحة الفس

نتيجة صافية لاتصالات المغرب بأزيد من 5,52 مليارات درهم

كمبوديا تدعم مخطط الحكم الذاتي لحل ملف الصحراء المغربية

المغرب وبولونيا يلتزمان بمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية

لأول مرة في تاريخ المغرب.. ميزانية قطاع التربية والتعليم ترتفع إلى 97 مليار درهم

الملك محمد السادس لـ"الأشبال": لقد شرفتم بلدكم والقارة الإفريقية

الملك محمد السادس يعين ولاة وعمال جدد

المجلس الوزاري يصادق على 14 اتفاقية دولية

المجلس الوزاري يصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالدفع بعدم دستورية القوانين وبالمحكمة الدستورية

المجلس الوزاري يصادق على مرسومين يهمان المجال العسكري

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون لمنع الفاسدين من الولوج إلى البرلمان

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026

بوريطة يتباحث بموسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

روسيا تعتبر المغرب شريكا مهما في القارة الإفريقية

وزارة الداخلية تطالب بفتح بحث قضائي في اتهام العالم شينان بابتزاز

الملك يطلق أشغال مركب "سافران" لصناعة محركات الطائرات بالنواصر

تكريم شخصيات بارزة في الداخلة وإحداث “قطب أفارقة العالم” ضمن منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي

الداخلة تحتضن نقاشاً إفريقياً حول أدوار الجاليات في تنمية القارة

المغرب يرحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة

توقف تصدير الأبقار الإسبانية إلى المغرب بسبب إصابتها بمرض وأسعار اللحوم مرشحة للارتفاع

توقيف الشخص الذي سكب مادة حارقة وأضرم النار في فنان بأحد شوارع الحسيمة

الملك يستقبل مبعوثا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية حاملا رسالة شفوية لجلالته

عضو جماعي بإقليم أسفي يتهم العامل السابق بابتزاز مقاول والداخلية تأمر بفتح تحقيق

اتفاقية شراكة استراتيجية بين إدارة الأمن الوطني والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

السلطات الإسرائيلية تحتفظ بالمغربيين غالي وضراوي وترفض الإفراج

توقيف متزعم الفوضى والتخريب ونهب الممتلكات بمدينة سلا

أمستردام تحتضن المحطة الثالثة من المعرض الدولي "العمران إكسبو – مغاربة العالم

إحالة الموقوفين في أعمال الشغب العنيفة على النيابة العامة بتهم ثقيلة

الفرقة الوطنية تضرب بقوة في القليعة: حملة اعتقالات واسعة تلاحق مقتحمي “لابريݣاد” ومثيري الفوضى

أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا في الذكرى 27 لوفاة الملك الحسن الثاني

الفرقة الوطنية تشرع في اعتقال “الملثمين” من قلب منازلهم بعد تورطهم في الفوضى

ثلاث وفيات وإصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ضمنهم 326 عنصرا من القوات العمومية

إصابة 263 رجل أمن وتخريب وإضرام النار في 142 عربة للقوات العمومية ووضع 409 شخص تحت الحراسة النظرية

إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء

الأغلبية الحكومية تؤكد انخراطها في الإصلاحات الكبرى واستعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية

البريد بنك يحتفل بمرور 15 سنة على تأسيسه بأداء مالي وتجاري غير مسبوق

التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى فئة "درجة الاستثمار"

أكادير تحتضن حفل تسليم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها التاسعة

أكادير تحتضن المعرض الوطني للصناعة التقليدية

أكادير تحتضن المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمشاركة 90 عارضاً

الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية

انتخاب المغرب عضوا في هيئات الاتحاد البريدي العالمي

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة في الدار البيضاء

مباحثات ثنائية بين بوريطة ووزراء خارجية على هامش اجتماع الأمم المتحدة

لجنة من ولاية جهة الرباط تستعين بالقوات العمومية لحجز معدات صباغة بمقر موقع "برلمان.كوم"

MDJS فــي الصفوف الأماميــة فــي مكافحــة اللعــب غيــر القانــوني علــى الصعيــد العالمــي

الملك يدشن ويزور عددا من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء

سباق 10 كيلومترات السنوي بالدارالبيضاء يجمع بين المنافسة والإثارة
تتويج الفارس زهير مديحي بالجائزة الكبرى لإفريقيا لسباقات الخيول

حموشي يستقبل المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي للتباحث حول سبل تدعيم الشراكة الأمنية لمحاربة الإرهاب وإنجاح التظاهرات الرياضية العالمية بالمغرب

الرباط تحتضن خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورومتوسطية

بريد المغرب والبريد السعودي يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين في دبي لدعم التجارة الإلكترونية

الصناعة التقليدية المغربية تحضر بقوة في معرض التصميم والأثاث بالرياض 2025

المملكة المغربية تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الاسرائيلي على سيادة دولة قطر

ممشى أبي رقراق بسلا الذي كلف الملايين يتحول إلى منصة للقفز في النهر

أمير المؤمنين يحيي بمسجد حسان ليلة المولد النبوي الشريف

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط

الملك محمد السادس يعين اللواء عبد الله بوطريك مديرا عاما لأمن نظم المعلومات

الدورة 21 لمهرجان الشواطئ اتصالات المغرب: سهرات استثنائية بمناسبة

تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية وإمهال السائقين عا

قاضي يستدعي زوجة رئيس الوزراء الإسباني في إطار تحقيق في اختلاس أموال

الملك محمد السادس يرسل مساعدات للشعب الفلسطيني

مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب الدورة 21 : أمسيات كبرى في مرتيل،

حركة انتقالية "جزئية" في صفوف الكتاب العامون بالعمالات

توقّف مفاجئ لخطبة الجمعة بمسجد حسان بعد تعرض الخطيب لوعكة صحية

استنفار بعد اقتراب حريق غابوي من السكان بشفشاون

مهرجان شواطئ اتصالات المغرب يواصل جولته ويستعد لافتتاح منصات جديدة بمرتيل والسعيدية والناظور
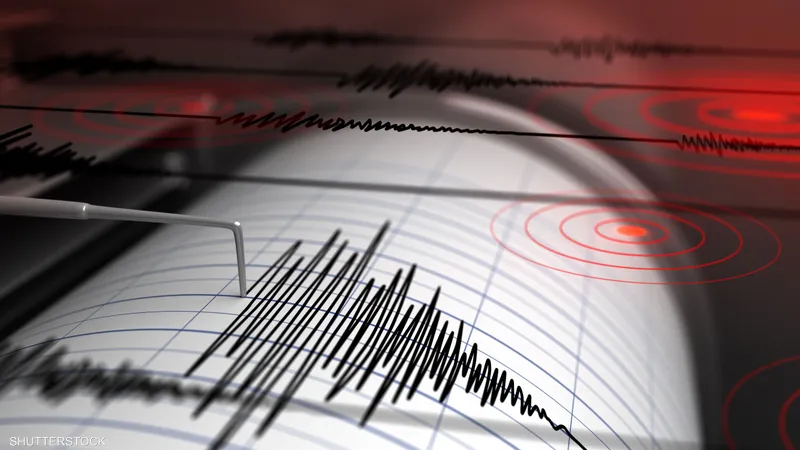
زلزال بقوة 6.19 درجة يهز تركيا

حكيمي: أن تتهم زورا أمر فظيع وأهم شيء في حياتي عائلتي وكرة القدم

أخنوش يدعو الوزارات لـ”التقشف” في نفقات الحفلات والدراسات واقتناء

وفاة الشيخ جمال الدين القادري شيخ الزاوية القادرية البودشيشية

إدارة الجمارك تفعل مذكرة جديدة لضبط تداول الأسلحة والمعدات الدفاعية

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تحتفي بالجالية وتضع مشروع الرقمنة ضمن أولوياتها

المغرب ينفذ تدخلاً إنسانيًا مباشرًا في غزة دون وسطاء

المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب وتؤكد انخراطها في تعزيز دولة القانون والمؤسسات

مستشار ترامب يجدد دعم واشنطن لمغربية الصحراء ويعتبر الحكم الذاتي "الحل الوحيد"

هل توجد أياد خفية تريد تفجير حياة حكيمي

ترامب يُجدد اعتراف بلاده بمغربية الصحراء ويدعم الحكم الذاتي

حكيمي مُهدد بالسجن لمدة قد تصل 15 سنة بتهمة الاغتصاب

أكثر من 300 ألف متفرج في انطلاقة استثنائية لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب احتفالًا بعيد العرش

ترقية الأمير مولاي الحسن إلى كولونيل ماجور خلال مراسم عيد العرش بتطوان

الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

تفاصيل وفاة لاعب مغربي على يد الحرس المدني البحري الجزائري

بتعليمات ملكية ..إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني
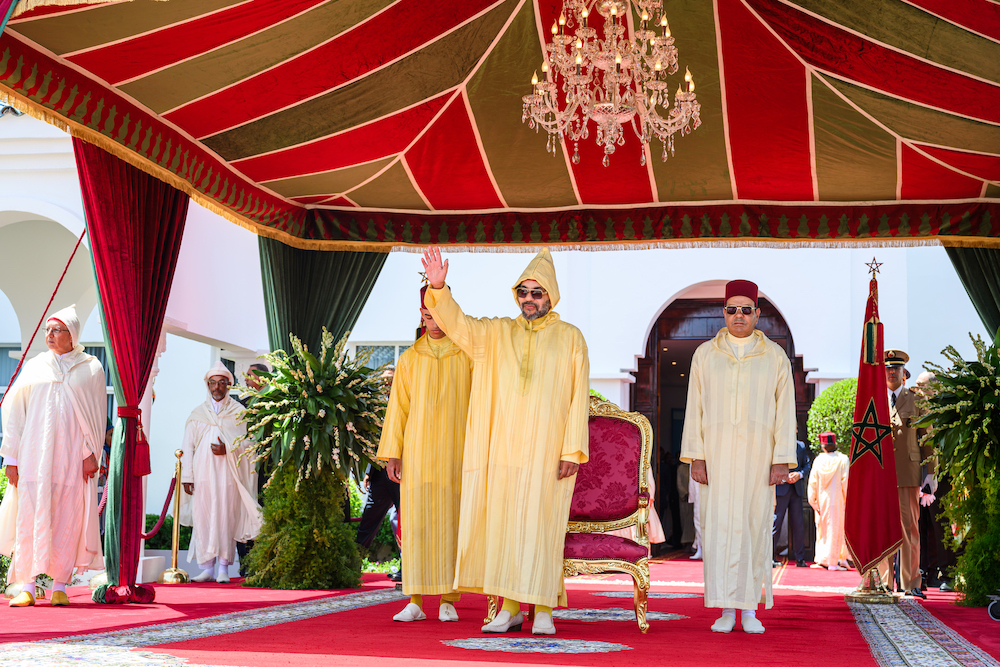
الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد

خطاب العرش : المغرب تجاوز عتبة "التنمية البشرية العالية" وسجل تراجعا لافتا للفقر

الملك يوجه الحكومة لإعداد جيد للانتخابات التشريعية المقبلة

الملك يشيد بمواقف بريطانيا والبرتغال الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي

الملك محمد السادس يجدد الدعوة لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر

الملك محمد السادس يدعو إلى "تغيير شامل" لتدارك الفوارق الاجتماعية

الملك محمد السادس :" مسار بناء مغرب متقدم هو ثمرة رؤية استشرافية بعيدة المدى"

استئنافية البيضاء تقضي بست سنوات في حق البدراوي وسبعة في حق كريمين

جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب

الميداوي يعفي رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بعد حفل "الشيخات"

وسيط المملكة يرصد اختلالات المرافق العمومية ويكشف تفاوت تجاوب الإدارات

18,04 مليار درهم رقم المعاملات الموحد لاتصالات المغرب

مجلس المستشارين يسجل ارتفاعاً في وتيرة مساءلة الحكومة خلال دورة أبريل 2025

مباحثات مغربية-برتغالية لتعزيز الشراكة الثنائية

البرتغال تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الضمان الاجتماعي يمدد آجال التصريح والأداء عبر بوابة "ضمانكم"

البريد بنك وبريد كاش يطلقان "بريد بايمنت موبيل" لتسهيل رقمنة وسائل الدفع
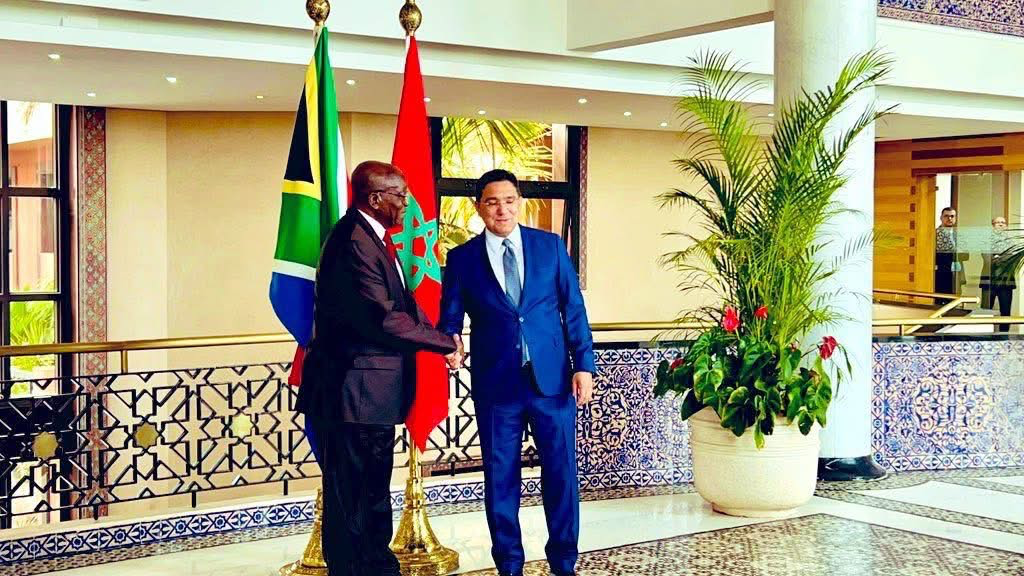
دعم جنوب إفريقي لمبادرة الحكم الذاتي كحل للملف الصحراء

28 تعاونية تنال جائزة "الجيل المتضامن" في نسختها الخامسة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحقق أداءً مالياً قياسياً برسم سنة 2024

حركة تعيينات واسعة في صفوف القناصل

الرباط تحتضن الدورة 16 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج

بنسعيد: معرض الألعاب الإلكترونية بات محطة رئيسية نحو بناء اقتصاد

الحكم على بودريقة بالسجن 5 سنوات نافذة

أخنوش يمثل الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية

حريق مهول ب"لافيراي" السالمية يستنفر السلطات وخسائر كبيرة في المحلات

برلمان دول أمريكا الوسطى يصادق على دعم الوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحراءه

التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية

الأحرار يرد على «كلاشات البام» من قلعة أخنوش

حملة تضامن واسعة مع ضحية سائق سيارة رباعية الدفع دهس رأسها على الشاطئ

اتصالات المغرب تغير نظام حكامتها وتجدد الثقة في بنشعبون

الشركة العامة للأبناك تغير هويتها وتصبح "سهام بنك"

"أفريقيا" النسخة الثالثة من برنامج Fikra 1000 لدعم رواد الأعمال المغاربة

أخنوش يفتتح أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

بنما تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لملف الصحراء المغربية

وزارة العدل تنفي تسريبات بيانات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية

"تريبورتور" يتسبب في مصرع سبعة أشخاص في حادثة سير بقلعة السراغنة

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني

مديرية أمن نظم المعلومات تنفي قرصنة وثائق من الوكالة الوطنية للمح

غانا تعتبر مخطط حكم الذاتي الأساس الواقعي والدائم الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية

غانا تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتطمح إلى تعاون أعمق مع المغرب
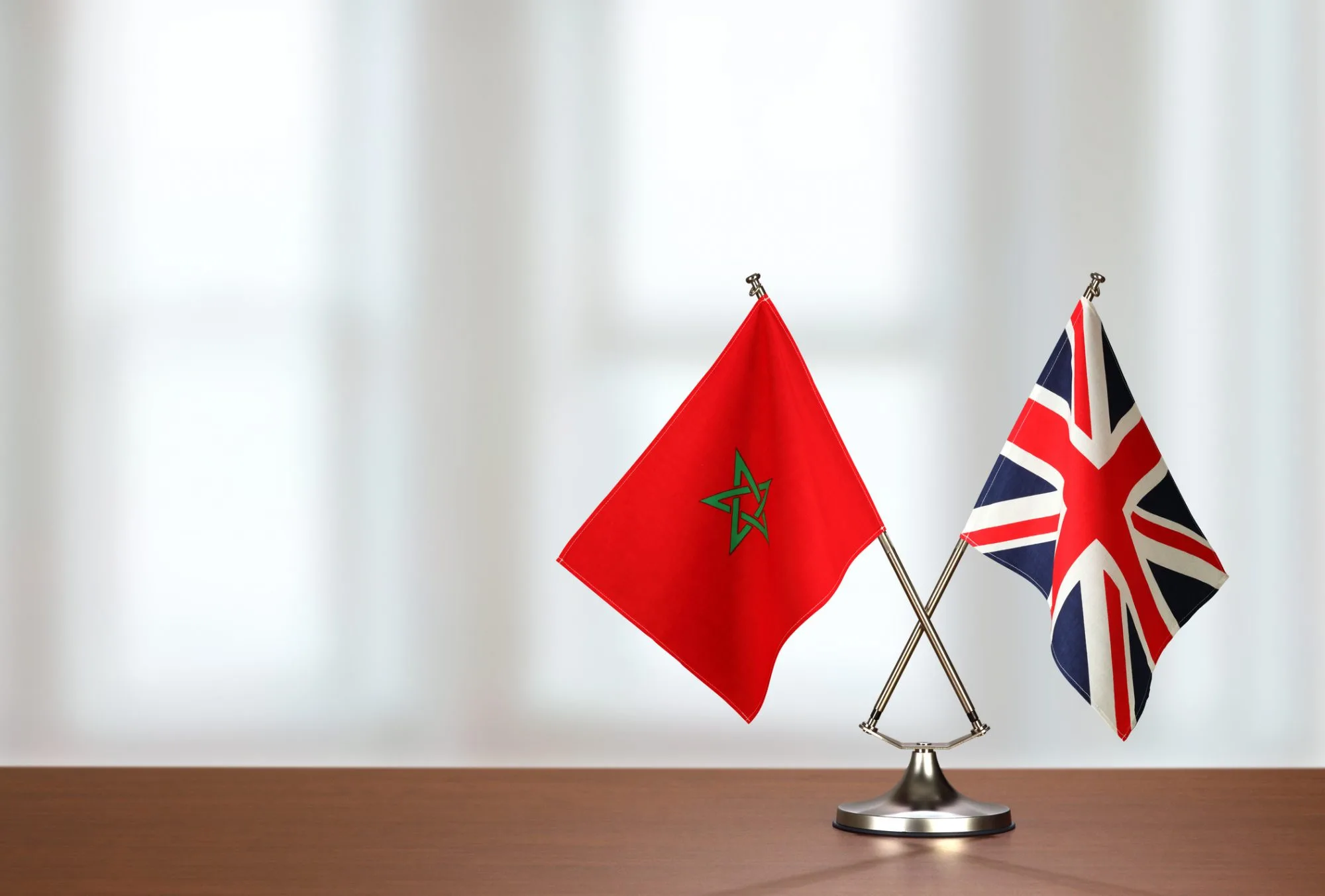
ريطانيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل دائم لقضية الصحراء المغربية

اعتقال مشتبه في تورطه في تسريب امتحانات البكالوريا بالحسيمة

حموشي يشارك في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات

بوريطة ومودافادي يشرفان على تدشين سفارة جمهورية كينيا بالرباط

الجزائر تنهج سياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل

بوريطة يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس الإكوادور

توشيح 353 عنصرا أمنيا بأوسمة ملكية والحموشي يستقبلهم بمعهد الشرط

الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد

قاضي التحقيق يودع بودريقة سجن عكاشة بعد إنهاء البحث التفصيلي ويحيله على المحاكمة

هلال يعرض الأسس التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء باللجنة الـ24 للأمم المتحدة

بوريطة يعرض محاور مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين

الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين

تفاصيل اندلاع حريق مفاجئ بمركب مولاي عبد الله

بوريطة يمثل المغرب في القمة العربية ببغداد

الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة العربية في بغداد

الكشف عن سيارة "أمان" الذكية محلية الصنع

افتتاح النسخة السادسة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة و

الملك محمد السادس يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب

الموثقون يدقون ناقوس الخطر... قانون غسل الأموال يربك الممارسة الم

حريق مهول بمعمل صيني للعجلات بالمدينة الجديدة "طنجة تيك"

بوروندي تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الملك محمد السادس يعين ولاة وعمال بالإدارة المركزية والترابية

الملك محمد السادس يعين سفراء جدد

الملك محمد السادس يعين مسؤولين بمناصب سامية

الملك محمد السادس يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة

الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي و4 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا

المغرب وبوروندي يوقعان 10 اتفاقيات تعاون ويؤكدان التزامهما المشتر

التوقيع على شراكة استراتيجية لرقمنة قطاع الصناعة التقليدية

الملك يطلق أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط

مستشار يتهم رئيس جماعة "أولاد الطيب" بمنحه رشوة إنتخابية بمبلغ 4 ملايين

أخنوش:التشويش تجاوز الحكومة و أصبح يستهدف المغرب

أخنوش : حققنا إنجازات غير مسبوقة والمغاربة باقي باغيين التجمع الو

بتعليمات الملك بوريطة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي مبعوثا إلى جلالته من رئيس الجمهورية

ابتداء من فاتح يوليوز.. الحكومة تعلن عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور الموظفين

الرباط تحتفي بالسينما الإيفوارية في أسبوعها الخامس

الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل

شراكة استراتيجية بين "فيزا" و "اتصالات المغرب"

البرلمان يعلن عن انطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

العثور على ثلاث مغربيات أمريكيات متوفيات في ظروف غامضة بمنتجع في بليز.

عناصر أمنية ألمانية تسلم بورديقة في مطار الدار البيضاء لعناصر الأمن المغربي

الملك يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

توقيع شراكة بين اتصالات المغرب و"فودافون"

اعتقالات بسبب أعمال شغب ورفع لافتات مسيئة و«بلطجة» تخريب ملعب محمد الخامس مباشرة بعد إصلاحه

"المثمر".. نموذج مبتكر لدعم الفلاح المغربي وتحقيق الأمن الغذائي

وكالة الأمن العام باليابان صنفت جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية مرتبطة بالقاعدة

المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما الأمني في مواجهة التحديات المشترك

بعد العثور على أشلاء بشرية قرب مسرح الجريمة.. اشتباه في وجود جثة ثانية بابن أحمد

وزارة التعليم العالي: يتتم المعادلة التلقائية للشهادات المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية

معرض الكتاب..ندوة تناقش الأدب الفلسطيني وسياسة المحو الصهيونية

اطلاق النسخة الاولى من مهرجان الامارات المغربية

حقيقة رغبة الصفريوي في شراء ناد إنجليزي مديون بـ 124 مليارا

الأمير مولاي الحسن يفتتح الدورة 17 من المعرض الدولي للفلاحة

الفخراني يُتوَّج "شخصية العام الثقافية" في معرض الكتاب بالرباط

المعرض الدولي للكتاب يحتفي برموز الثقافة العربية في أمسية شعرية استثنائية

إسبانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي لملف الصحراء

الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

الحكومة الإسبانية تجدد تأكيدها على كون مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لتسوية نزاع الصحراء

شركة Axians المغرب تحصل على اعتماد "CISCO" الذهبي

التوقيع على اتفاقية لتطوير صادرات المغرب في الصناعة التقليدية

المغرب يحذر من ثغرة خطيرة في واتساب ويندوز ويدعو للتحديث الفوري

دي ميستورا يطالب بتفاصيل الحكم الذاتي

وزارة العدل تستعرض التجارب الأوروبية في تعويض العمل المنزلي

بوريطة في زيارة عمل إلى فرنسا لتفعيل الشراكة الاستثنائية

فرنسا تجدّد موقفها "الراسخ" الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

اتصالات المغرب تطلق عرض "iNJOY" الرقمي لتلبية احتياجات الجيل المت

توقيع اتفاقية بمراكش لتعزيز إدماج الأمازيغية في خدمات بريد المغرب

لفتيت يعقد بالرباط اجتماع عمل مع نظيره الفرنسي

سلطنة عُمان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز الشراكة الثن

«ديربي المقاطعة» ينتهي لا غالب ولا مغلوب

وزارة النقل تكشف معطيات جديدة حول تحطم طائرة بمطار فاس سايس

شراكة بين اتصالات المغرب و”زوهو“ لتسريع التحول الرقمي للشركات في

المغرب والفلبين يُطلقان طابعاً بريدياً مشتركاً

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكشف تفاصيل هجوم سيبراني استهدف نظامه المعلوماتي

أمريكا تجدد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه

الولايات المتحدة تجدد تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

CNSS يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتقاعد

"انوي" يعلن مشاركته في الدورة الثالثة من معرض جيتكس افريقيا

الإعلان المشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز

رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الشيلي بمدينة العيون

مراكش تستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول "قانون الشغل والتنوع" بمشاركة أكثر من 58 دولة

جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

الطالبي العلمي يعلن تشكيل لجنة استطلاعية حول دعم استيراد الأغنام

شبكة الجيل الخامس ..اتصالات المغرب وإنوي تعلنان استثمارا مشتركا

تعيينات ملكية لبورقية وبوعياش وبلكوش

الملك محمد السادس يعين مسؤولين على رأس مؤسسات دستورية
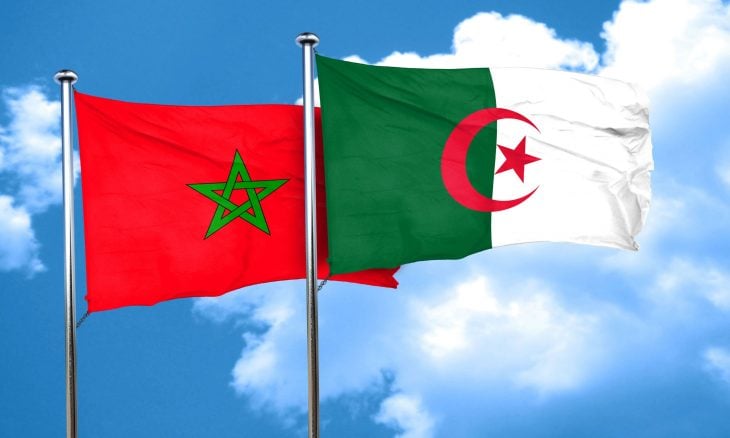
الخارجية الجزائرية تطالب نائب القنصل العام المغربي بوهران بمغادرة

"اتصالات المغرب" المشغل الأسرع لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت

انتخاب طارق غيلان عن "البام" رئيسا جديدا على جماعة أصيلة

مبادرة الحوت بثمن معقول" تستعد لرقمنة بيع الأسماك لخفض الأسعار في الأسواق

إشادة إفريقية برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإ

"مغرب اكسيجين" تحصل على ثلاث شهادات دولية مرموقة

بوريطة يلتقي دي ميستورا بالرباط

جلالة الملك يعين مسؤولين بعدد من المؤسسات الدستورية

برادة يطيح بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية

"ممارسات دخيلة" تحرك مطالب بضبط مزاولة الصحافة وحماية المهنة من التجاوزات

المغرب يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على غزة

المغرب يترأس اجتماعا وزاريا حول الذكاء الاصطناعي والسلم والأمن بإفريقيا

المحكمة الدستورية تقضي بدستورية " قانون الإضراب"

النيابة العامة توضح بشأن اعتقال قاصر وعائلتها على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة رفقة عائلتها تعرضت للتشهير والابتزاز

بتعليمات ملكية الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446”

لحسن السعدي يترأس الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات بسلا

أمير المؤمنين يهيب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة

«الطاس» يصفع الاتحاد الجزائري ويقر بفوز نهضة بركان

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية-الفرنسية

حبوب الشرقاوي يكشف ارتباط الخلية الإرهابية "أسود الخلافة في المغرب الأقصى" بعضو في جبهة البوليساريو

حريق يأتي على يخت سياحي بميناء مارينا سمير بالمضيق

بحضور أخنوش الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف

رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس

حريق مهول بسوق للقرب بطنجة يخلف خسائر مادية كبيرة

ترحيل برلمانيين أوروبيين من مدينة العيون حاولوا اقتحام المطار لتن

انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات

حجز أسلحة نارية وذخيرة حية بنواحي الرشيدية

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

نارسا وبرنامج التقييم الدولي للطرق يوقعان اتفاقية لتكوين الكفاءات

بوريطة يؤكد التزام المغرب بتعزيز التعاون والاستقرار في القارة الإ

الاستقرار والأمن يجمع رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ف

مجلس النواب يستضيف المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية الأفارقة

عادل بلفقير يكشف استراتيجية مكتب المطارات الجديدة

إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب

فرنسا تواصل تنزيل اعترافها بمغربية الصحراء

الرباط تحتضن المؤتمر العربي الثالث للأراضي لمناقشة تحديات الحكامة

أخنوش: المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية لدورها في تحقيق التنمية المستدامة

قيوح : تعبئة والتزام الشباب عاملان أساسيان لإنجاح السياسات العموم

الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية فرصة لتعزيز التزام المغرب

توشيح المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بوسام الأمير

الشرطة توقف مختطفي سيدة بسيدي بنور من أجل السرقة

ارتفاع رقم المعاملات الموحد لاتصالات المغرب الى 36,7 مليار درهم

مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية

الهزة الأرضية التي ضربت إقليم وزان لم تخلف أية أضرار في البنية التحتية الطرقية والمنشآت المائية

السكوري :" قانون الإضراب مكسب للأجراء ونسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 1.4"

"جواز الشباب" يمكن حامليه من الاستفادة من تخفيض 5 % على جميع مشار

أخنوش يعطي انطلاقة الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس"

تلاميذ ينجون من فاجعة بسلا بعد احتراق حافلة للنقل المدرسي

المصادقة نهائيا على قانون الإضراب ...صوت عليه 84 برلمانيا من أصل 395 عضوا بمجلس النواب

. أخنوش: الحكومة خصصت 14 مليار درهم في 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل

الطالبي العلمي يصف المنسحبين من التصويت على قانون الإضراب بالخونة

الملك محمد السادس يبرق إلى أحمد الشرع مهنئا إياه بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية

مجلس المستشارين يصادق رسميا على قانون الإضراب

الشرطة تعتقل بدر هاري بتهمة الاعتداء على طليقته الهولندية

لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين تصوت على مشروع قانون الإضراب

التدخلات الأمنية في مجال محاربة التطرف والإرهاب تخضع لبروتوكول صارم للأمن والسلامة

خطورة خلية حد السوالم تكمن في تنامي “الاستقطاب الأسري” كرافد جارف للتطرف والتجنيد

الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في النهوض بقضايا السلام والأمن

إشهار بيعة لتنظيم داعش يقود "البسيج" لإجهاض مخطط إرهابي خطير بالسوالم

اعتقال شخص وابنه لتورطهما في النصب بالتوظيف في أسلاك الشرطة

عزيز أخنوش يفتتح ملحقة المعهد الوطني للفنون الجميلة لأكادير

أخنوش يترأس مراسم توقيع بروتوكول تفاهم لإنجاز الميناء الجاف

تفاصيل اختفاء أربعة سائقين مغاربة للنقل الدولي بين بوركينافاسو والنيجر

المغرب ينوه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الكوت ديفوار تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية والسيادة المغربية

الحكومة تعلن تشكيل لجنة لصياغة تعديلات مدونة الأسرة

لقجع ينفي وجود أي زيادة في أسعار البوطاغاز حاليا

لقجع: مداخيل ضريبية إضافية بمبلغ 100 مليار درهم ستخصص لتمويل الحم

أخنوش :" ملتزمون بممارسة السياسة بأخلاق وبعيدا عن الانتهازية"

. أخنوش: المجلس الوطني سيكون نقطة تحول كبيرة في أداء حزب الأحرار

أخنوش يندد بمن وصفهم بالمتاجرين سياسيا بموضوع دعم الأرامل

المغرب يبرز تجربته في خدمة التعاون جنوب جنوب بقمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية بكمبالا

اعتقال المدير السابق لشركة "العمران جهة الشرق" بتهمة اختلاس وتبدي

127 مليار درهم مداخيل التسوية الضريبية الطوعية والعملية ترفع أسهم ثقة الملزمين في الإجراءات الحكومية

متابعة كريمين والبدراوي بتهمتي استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية

اعتقال خطيب المحامية الفرنسية التي تتهم أبناء "الفشوش" باحتجازها واغتصابها

وكالة المحافظة العقارية تحقق نتائج قياسية غير مسبوقة

هذه أهم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة

التوفيق يكشف المسائل التي حسمها المجلس العلمي الأعلى بمدونة الأسرة

السجن النافذ لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة

جلالة الملك يقر إصلاحا جوهريا لمدونة الأسرة ويدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة

الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة

روبوتات ذكية توزع الشاي والماء على ضيوف المناظرة الوطنية للجهوية

رؤساء جهات يشتكون غياب الإلتقائية في مواجهة مشكل نذرة المياه

الملك محمد السادس يستقبل الرئيس الموريتاني في أول ظهور رسمي بعد ع

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان يعربان عن شكرهما للمغرب

الملك يدعو إلى المرور السرعة القصوى في تنزيل الجهوية المتقدمة

محكمة النقض تحسم ملف "كازينو السعدي" وأبدوح سيقضي خمس سنوات بالسجن

أخنوش:الحكومة ملتزمة بدفتر تحملات الفيفا والمونديال فرصة للنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين

تفاصيل اجتماع «الكاف» بمراكش.. تطرق إلى مستجدات «الكان»

الحكومة تخصص 14 مليار درهم لإنعاش قطاع التشغيل

العدوي تحيل 16 ملفا على الداكي ومتابعة 253 شخصا أمام المحاكم

بوريطة يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

«الفيفا» يصادق رسميا على تنظيم المغرب لكأس العالم 2030

لقجع: ستسرع وتيرة الاستعداد لـ"المونديال"ومركب مولاي عبد الله سيفتح أبوابه مارس المقبل

المغرب سيصوت لأول مرة على إلغاء عقوبة الإعدام بالأمم المتحدة

الملك يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح على مستوى كتفه الأيسر

الكراوي يتوج بالجائزة الدولية للريادة في مجال الذكاء الاقتصادي

بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتاني

الملك يوجه رسالة للمشاركين في المناظرة الدولية حول "العدالة الإنتقالية"

الملك محمد السادس يعين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا صادق على اتفاقيات دولية

رئيس جهة الشرق يقود زيارة لجهة اترارزة الموريتانية ويوقع على مذكرة تفاهم وتعاون بين الجهتين

مولاي رشيد يترأس حفل عشاء افتتاح "مهرجان مراكش"

اجتماع فرنسي-مغربي غير مسبوق في باريس لتحسين إجراءات الهجرة

هنغاريا تدعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية

أكسل بلعباسي القيادي في حركة تحرير القبائل (الماك) لـ«الأخبار»:

بوريطة :" الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعيش مرحلة مفصلية"

التلفزيون الرسمي الصيني يكشف عن فحوى الحديث الذي دار بين الأمير مولاي الحسن و "شي جين بينغ"

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء

يصل حاليا 69%.. أخنوش: ملتزمون برفع معدل الإدماج المحلي في صناعة السيارات ليصل 80%

تسمم 19 طفل ببرشيد بسبب تناولهم رقائق "شيبس"

الإعلان رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم

بوريطة يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا – إفريقيا

وكالة التنمية الفلاحية تتوج الفائزين بجوائز الابتكار والتطوير الفلاحي "AGRIYOUNG INNOVATE"

التامك: فكرت في تقديم استقالتي لأنني أتعرض للإهانة والاحتقار من طرف الحكومة والبرلمان

انتخاب المغرب نائبا لرئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية

الملك يدعو إلى إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج

الملك محمد السادس يوجه رسائل قوية لأعداء الوحدة الترابية

جلالة الملك يهنئ ترامب بمناسبة انتخابه مجددا

أخنوش: مناخ الأعمال ببلادنا "طبيعي ومناسب" بحسب 72% من المقاولات

مجلس الأمن يجدد ولاية «المينورسو» ويشدد على الحل التوافقي للنزاع حول الصحراء المغربية

افتتاح الملتقى الدولي للتمور بأرفود بمشاركة 230 عارضا ووزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 103 آلاف طن من التمور خلال الموسم الجاري

ماكرون: المجال الوحيد الذي سنتنافس فيه مع المغرب هو كرة القدم
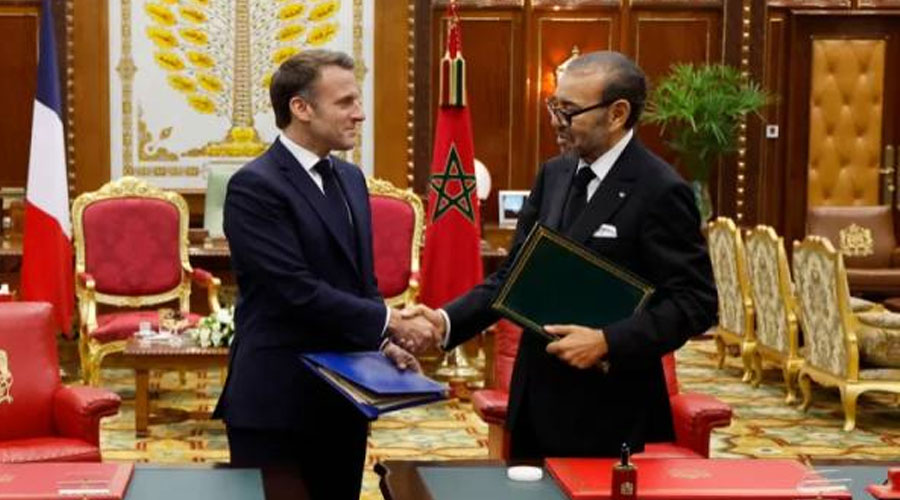
الرئيس الفرنسي ضيفا كبيرا بالرباط

فرنسا تجدد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه

بنك افريقيا يطلق خدمة Google Pay

الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون يوقعان شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا

المغرب وفرنسا يوقعان 22 اتفاقية في مجالات النقل والطاقة والاستثمار

قنصلية المغرب بمورسيا تتفاعل مع تعنيف رجل أمن خاص لمواطن مغربي داخل مقرها

زبناء اتصالات المغرب يصلون 79.7 مليون مشترك خلال الربع الثالث من عام 2024

الملك يستقبل الأعضاء الجدد المعينين بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء حكومة أخنوش المعدلة

الأغلبية تعرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة

وضع زوجة اللاعب السابق يوسف شيبو رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تسببها في حادثة سير مميتة

نقل الممثل الشوبي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

بوريطة يرد على مقترح دي ميستورا لتقسيم الأقاليم الجنوبية... "من أوحى لك بهذا الأمر؟"

ماكرون يزور المغرب رسميا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء

المجلس الوزاري يصادق على تعيينات في المناصب العليا

الملك يعين سفراء جدد في اجتماع المجلس الوزاري

الملك يعين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا للحليمي

المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المجلس الوزاري يصادق على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري

الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025

المجلس الأوروبي يجدد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

"مناسك للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الرباط لجدة السعودية

مجموعة الضحى تنفي علاقتها بتدوينة تضمنت خريطة المغرب مبتورة

الملك يبرز الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية

الملك يخصص خطاب افتتاح البرلمان لتطورات قضية الصحراء المغربية

المملكة المغربية تحصل للسنة الثانية على التوالي على جائزة أحسن تقدم في مؤشر التنمية البريدية على الصعيد العربي

بوريطة يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا تأثير له على قضية الصحراء المغربية

"نداء طاطا" تطالب الحكومة بإعلان الإقليم منطقة منكوبة

ألمانيا تجدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يصادق على لائحة اللجنة التنفيذية

باشا المنصورية يقود عمليات تمشيط واسعة لغابة الصنوبر وواد النفيفيخ استهدفت توقيف مرشحين للهجرة وهدم مساكن عشوائية لتجار المخدرات
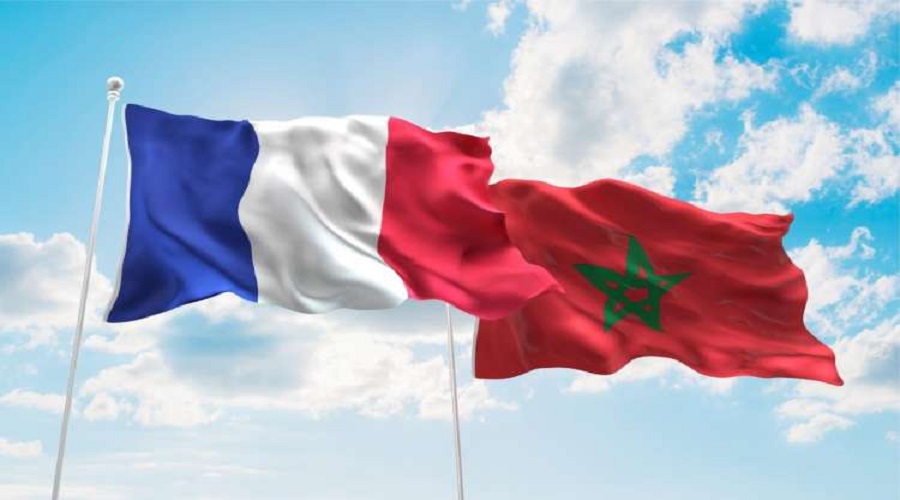
فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب

قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على سيادة المغرب على صحرائه

وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

إسبانيا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوربية

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب

لحليمي يعلن اكتمال عملية الإحصاء العام للسكان والشروع في صياغة المؤشرات

وزارة الخارجية تحدث خلية أزمة وتتخذ تدابير لحماية المغاربة المقيمين بلبنان

أمر قضائي بالحجز على تعويضات أبو الغالي بمجلس النواب
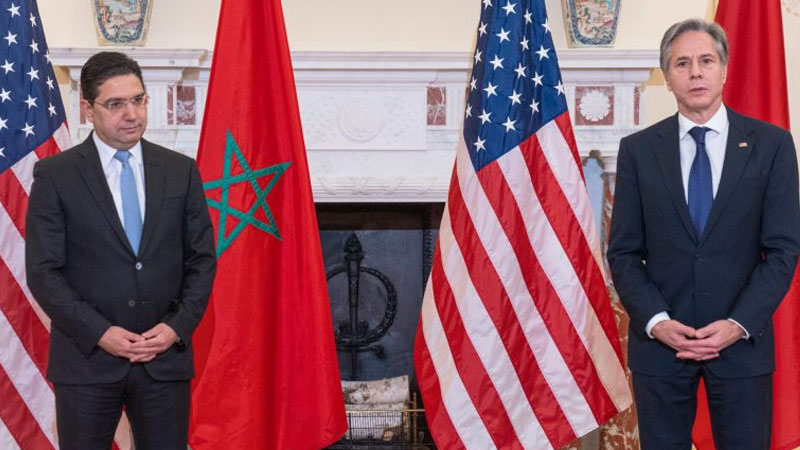
بوريطة يتباحث مع بلينكن والأخير يجدد دعم أمريكا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

بوريطة يلتقي دي ميستورا ويجدد التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية

انقلاب حافلة للنقل الحضري بفاس يخلف 28 إصابة

دول الساحل تشيد بتقدم المبادرة الملكية "الولوج إلى الأطلسي"

وزارة التعليم العالي تلغي نقطة الصفر لطلبة الطب المضربين

التجاري وفا بنك ينظم لقاء حول آلية Cap Hospitality

الدنمارك تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

السلطات العمومية تتدخل لمنع اعتصام لطلبة الطب بالرباط (فيديو)

بوريطة يبرز بالأمم المتحدة دعم الملك للقضية والشعب الفلسطينيين

عبد اللطيف حموشي يزور الإمارات العربية المتحدة

انطلاق خدمات الخط الثالث والرابع من ترامواي بالبيضاء وشبكة النقل الحضري تتجاوز 100 كيلومتر

شاب يضرم النار في جسده قبالة البرلمان وبذلة محامي تنقذه

جرف حافلة ركاب ومقتل شخصين و14 شخصا في عداد المفقودين بطاطا بسبب

دمج صندوق cnops في cnss يستنفر تعاضديات القطاع العام

المنصوري تدق ناقوس الخطر وتحذر من الفساد وتراجع الثقة في الأحزاب والمؤسسات

تأجيل المصادقة على قانون دمج "كنوبس" في الضمان الاجتماعي بعد موجة احتجاجات واسعة ضده

أمير المؤمنين يترأس بمسجد حسان حفلا دينيا إحياء للمولد النبوي الشريف

اعتقال أزيد من 60 فيسبوكيا بسبب التحريض على الحريك وإصدار مذكرات

"أصحاب الهمم" يحققون 15 ميدالية وينالون 2 مليار

صحافية من القناة الثانية تفلت من الموت بأعجوبة بعد رشق سيارتها بالحجارة في الطريق السيار

«الأخبار» تكشف حقيقة إسقاط التهم عن بودريقة بألمانيا

الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 4831 متابعا في قضايا زراعة القنب الهندي

رئيس جمهورية الدومينيكان يبلغ جلالة الملك بدعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها فتح قنصلية بالداخلة

عامل طانطان يفضح طريقة إفشال المشاريع بالإقليم

نزاع حول أرض كنيسة بطنجة يصل القضاء

التحقيق في قرصنة لوحة إشهارية وعرض عبارات مسيئة بمرتيل

تزايد ظاهرة استغلال مياه السدود في سقي الكيف بالشمال

لهيب الأسعار يصل الكتب المدرسية المستوردة

سلطات الرباط تتجه لإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

سلطات الرباط تتجه لإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات

ضبط شحنة أسماك يكشف طريقة تهريب مقنعة

جدل نتائج مباراة الطب يعود من جديد للواجهة

جلالة الملك يستقبل بتطوان البطل الأولمبي سفيان البقالي

نواب عمدة البيضاء يخلفون وعودهم بشأن مواعد تسليم المرافق والمشاري

طمر النفايات يهدد الفرشة المائية بطنجة

حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592

السفير السعودي: السعودية ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب

إفراغ سكان حي صفيحي بجماعة دار بوعزة

أخنوش يدعو الوزراء إلى التقشف و"تزيار السمطة

الموت يغيب الكاتب والصحافي الفلسطيني بلال الحسن

محمد السادس يهنئ الأشبال على الإنجاز الأولمبي

انتقادات لتحويل قصر الفنون بطنجة إلى قاعة حفلات

أسر تطالب بإيجاد سكن بديل مخافة التشرد بطنجة

مهيدية يتفقد البنية التحتية لسيدي مومن لضبط التجاوزات

"شراء" مواعد الفيزا يؤرق مواطنين مغاربة

رحيمي يحطم رقما قياسيا ويدخل تاريخ الألعاب الأولمبية

محمد السادس للبقالي: يمثل إصرارك ونجاحك المتميز نموذجا ملهما للرياضيات والرياضيين الشباب المغاربة

البرلماني "البوعمري" يسائل وزير الصحة عن إغراق برشيد بالمختلين عقليا

ابتدائية تيزنيت تدين صاحب محل أكلات سريعة

عساقس تحتل المركز الأخير في أول مشاركة لها في الألعاب الأولمبية

فنلندا تدعم الحكم الذاتي “أساسا جيدا” لحل النزاع حول الصحراء المغربية

النفايات المنزلية تغرق أحياء جماعة الشراط

المغربي ماتيس يحتج على التحكيم بعد إقصائه من الألعاب الأولمبية

السائقون المهنيون يستنكرون تأخر تجديد رخص سيارات الأجرة الكبيرة

أسعار الدواجن تعود للارتفاع وتتجاوز 20 درهما للكيلوغرام

سكان حي الربيع ببرشيد يشتكون من خطر الكلاب الضالة

الخطاب الملكي يحرك ملفات الماء بجهة الشمال

9 سنوات سجنا لـ3 دركيين في قضية تزوير

لهذا استدعت الفرقة الوطنية ساجد عمدة الدار البيضاء السابق للتحقيق

أزمة الماء تفشل موسم الاصطياف بسيدي إفني

أولمبياد باريس..تفاصيل الحكم على مشجع مغربي متهم بالاعتداء على الأمن الفرنسي

صديقي يعترف بصعوبة محاربة الصيد غير القانوني بجهة الداخلة

الطرق السيارة تغرق في الديون وتحديات كبيرة تواجه المدير الجديد

مارين لوبان : الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة الشريفة وفرنسا تأخر

الملك محمد السادس يشيد بموقف فرنسا من الصحراء المغربية ويدعو ماكرون لزيارة المغرب

أولمبياد باريس.. هذه السيناريوهات المحتملة لتأهل "الأشبال"

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش

فرنسا تعترف رسميا بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم الحكم الذاتي

الملك محمد السادس: الانشغال بالأوضاع الداخلية للبلاد لا ينسينا ما يعيشه الشعب الفلسطيني

الملك يدعو إلى تسريع إنجاز محطات التحلية ومشاريع الربط بين الأحواض

الملك محمد السادس يعرض تصور المغرب لإنهاء الحرب في غزة

الجواهري يطلع الملك على الوضعية الاقتصادية والمالية لسنة 2023

الملك محمد السادس يوصي بسريع إنجاز مشاريع التزود بالماء

جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد

عفو ملكي شمل 2476 شخصا بينهم مدانين في قضايا إرهاب وصحافيين ومدونين محكومين في قضايا حق عام

اللجان الإدارية والتقنية للاتحاد الإفريقي للتعاضد تجتمع بالرباط

"الفيفا" يعلن رسميا تسلمه عرض استضافة مونديال 2030 من يد لقجع

إعفاء نبيلة ارميلي من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات

حملة ضد شناقة "الباراسولات" بشواطئ طنجة

الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية

ولاية أمن طنجة تخصص استقبالا رمزيا لأطفال "زلزال الحوز"

التلفزة المغربية تحظر مقاطع مخلة بالحياء في النقل المباشر لحفل

" بيضاويون" يستنكرون تغير لون وطعم الماء الصالح للشرب

سكان "الحي" متخوفون من الحشرات والحيوانات السامة داخل متنزه

مشروع المسطرة المدنية يشعل مواجهة جديدة بين المحامين ووهبي

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثما

متابعة موظفي شرطة بتهمة سرقة أموال موقوف وتلقي الرشوة

بسبب خروقات في التعمير.. الداخلية توقف رئيس جماعة القنيطرة

تسجيل 21 حالة وفاة في بني ملال بسبب ارتفاع درجة الحرارة

المغرب وكوت ديفوار يشيدان عاليا بشراكتهما الاستراتيجية وتعاونهما

المحافظة العقارية تعقد مجلسها الإداري 8.4 مليار درهم رقم معاملا

بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإفواري والتعاون الثنائي وت

الحكم يلغي "الهدف القاتل" للأرجنتين والأشبال يحققون فوزهم الأول في أولمبياد باريس

15 سجنا نافذا لشاب مغربي هولندي دهس دركي بالهرهورة

طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية

خروقات التراخيص بشواطئ المضيق تستنفر السلطات

مسؤولان أمنيان أمام المحكمة بتهم الارتشاء وإفشاء السر المهني

بوعيدة تميط اللثام عن جدل تمويل إنجاز 10 سدود بالجهة

اتصالات المغرب تحقق نتائج قوية في متم النصف الأول من 2024

آيت الطالب يُوقع محضر اتفاق مع النقابات الصحية

سلطات الشمال تفتح تحقيقا في ظاهرة سرقة الكهرباء العمومي

عودة جدل توسيع مناطق الزراعة تصل وزان والعرائش

بعدما استولى عليها الخواص.. سكان طنجة محرمون من المسابح

متابعة اليوتيوبر "جانيطو" في حالة سراح

اعتقال اليوتيوبر "جانيطو" بتهمة التحريض على الإجرام

سماسرة يستهدفون أرباب محلات الفخار بولجة سلا

برنامج استعجالي لحفر 30 بئرا بسطات لمواجهة الجفاف

رسائل مزيفة تهدد باختراق الحسابات البنكية للمغاربة

إنقاذ 38 شخصا جرفتهم الرياح لعرض البحر

موسم "مولاي عبد الله" يغلق الأسواق الأسبوعية بالجديدة

مراكز صحية مغلقة تعمق معاناة المرضى بالمضيق وتطوان

استدعاء ملياردير بتهمة الاستيلاء على ملك الغير بتطوان

مدرسة للترجمة بطنجة تثير ضجة بسبب الأمازيغية

سكان حي "مسنانة" بطنجة يسخرون من الجماعة بسبب حفر الشوارع

تزايد عدد المختلين عقليا بابن احمد يسائل المسؤولين

جنايات الرباط تدين سارقي معدات طبية بالمستشفى العسكري

زيادة الحاجة إلى الماء تهدد مشاريع فلاحية بحوض اللوكوس

تفاصيل ساعات الجحيم التي قضاها بودريقة بألمانيا قبل تسليمه للمغرب

تساؤلات حول الحالة الميكانيكية لمراكب الصيد بالداخلة بعد إنقاذ مركب على وشك الغرق

النيابة العامة بتطوان تفك شبكة تزويد مخيمات مهاجرين باللوجستيك والمواد الغذائية بالشمال

في الذكرى الـ25 لعيد العرش.. إطلاق مشروع مركز اصطياف لفائدة أسرة

السكوري يقدم مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

العثور على جثتين بشاطئ ضواحي تطوان يحتمل أن تكون للاعبي اتحاد طنج

مرضى السل بطنجة يحتجون بسبب غياب الأطر الطبية

فيديوهات الصراصير بحافلات النقل الحضري تستنفر سلطات تطوان

مدمنون يقطعون طريقا بسبب اختفاء أدوية الإدمان بمركز طبي بطنجة

شاطئ الوداية بالرباط بدون مراحيض عمومية

درب السلطان يهتز على وقع انهيار 4 منازل بشكل مفاجئ

فرنسا تستعين بالأمن المغربي لتأمين أولمبياد باريس

شناقة الباراسولات" يحكمون قبضتهم على شواطئ طنجة

صيف ساخن بالاحتجاجات

المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار يرفض غالبية مطالب كورال القابضة في قضية لاسامير

العثماني يعقد اجتماعا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد

حريق غابوي بالحزام الأخضر يستنفر سلطات تطوان

قابض خزينة سطات أمام القضاء في قضية «غدر»

«RADEEMA» تشرع في تخفيض صبيب ماء الشرب خلال الصيف بحد السوالم

لقجع والركراكي يخططان لإنجاز تاريخي لـ«الأسود» في «مونديال أمريكا

وزير الصحة: تسجيل أزيد من 54 ألف حالة تأثرت بلقاح "أسترازينيكا"

برقية تعاطف وتضامن من جلالة الملك إلى السيد دونالد ترامب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

نهضة بركان يدخل «الميركاتو» الصيفي بقوة

الداخلية تعد خارطة وطنية لإنهاء فوضى أسواق الجملة

وفاة ليلى مزيان زوجة عثمان بنجلون

حريق يتسبب في إتلاف هكتار من أشجار غابات طنجة

تعليمات لفتيت تفضح جمود ملفات تعميرية بتطوان

انطلاق النسخة العشرين من "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب

طلبات تعويض عن الضرر تلاحق جماعة تطوان

انتقادات لجماعة طنجة بسبب تجهيز شواطئ دون مراحيض

رفع صفقة سد للمرة الثانية يسائل مجلس جهة كلميم

ميراوي يصر على تقليص سنوات التكوين في الطب

احتجاج على غياب أجور عاملات محو الأمية بجهة الشمال

منح جائزة التميز للأعمال الإنسانية لوكالة بيت مال القدس وإشادة بجهود الملك محمد السادس

إحالة السيمو و12 متهما على جرائم الأموال بالرباط

أمن الرباط يعتقل سائق "إندرايف" بعد تعريض سيدة للتهديد والسرقة

الاستنطاق التفصيلي في الاعتداء على الملك الغابوي بتطوان

قضاة مجلس الحسابات يحلون بجماعة سيدي سليمان

خمس سنوات سجنا لمدير بنك بتمارة اختلس المليارات وفر إلى كندا واعتقل بإيطاليا

نقابات بدون قانون

صندوق الإيداع والتدبير يشرع في بيع مجموعة من الفنادق المملوكة

سيدي مومن يمثلنا

3 جرحى في حادثة سير خطيرة بتطوان

اشتباكات واتهامات في جلسة مساءلة رئيس الحكومة

إعفاء قائد من مهامه وإلحاقه بالعمالة بسبب البناء العشوائي بالنواصر

تسممات مميتة تحرك مطالب بتقييد تراخيص المطاعم

شاطئ طماريس.. واجهة بحرية تعاني الإهمال وغياب المراقبة

إدارية الدار البيضاء تبث في عزل مستشار جماعي

محمد صديقي لم يتوصل بتفويض من رئيس الحكومة لترؤس المجلس الإداري

بين الرباط وباريس
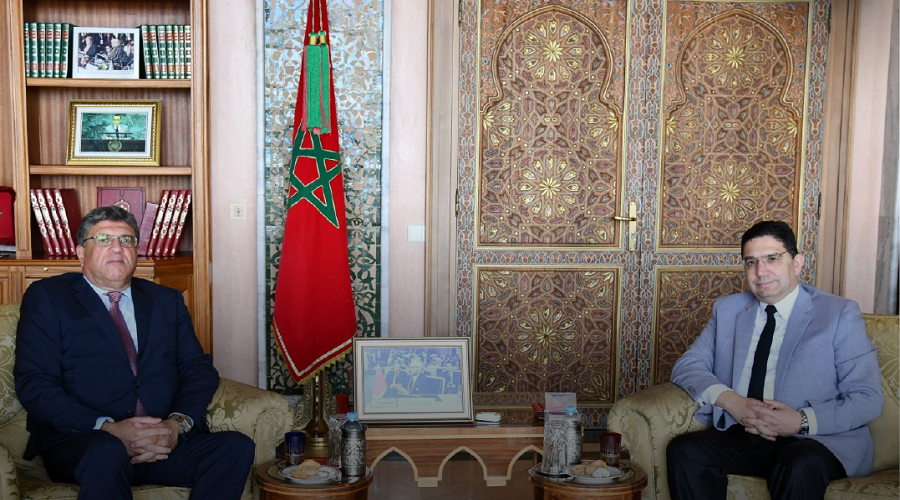
ناصر بوريطة يستقبل الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي

خسائر حوادث بالملايين وأضرار تساءل جماعات بالشمال

إعفاء رئيس دائرة بأصيلة بسبب تقارير سوداء حول التعمير

الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة متلبسا برشوة ببنسليمان

منظمة امريكية تمنح شهادة الجودة للمختبر الوطني للشرطة العلمية

احتجاج سكان بسبب استحواذ فندق على شاطئ بالعرائش

مقاطع مصورة لقرش تثير مخاوف مرتادي شواطئ أكادير

إعفاء رئيس القسم الاقتصادي بعمالة المضيق من مهامه

الملك محمد السادس يعطي تعليماته بافتتاح مستشفيين جديدين

تعثر مشروع مرافق عمومية يسائل مجلس تطوان

كراء مركب اجتماعي بسيدي قاسم في غياب تسوية للعقار

البكوري يفشل في تحريك ملف المحطة الطرقية بتطوان

مطالب بالتحقيق في محاولة إفشال مشروع نفعي للسكان بوزان

« دار أمريكا » تستقطب 200 مدرس جديد رغم برنامج تعميم الإنجليزية

جماعة طنجة ترضخ للداخلية بخصوص الساحات العمومية

البرلماني محمد أبركان سيمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية

تحقيقات ترافق سحب ترخيص انفرادي بجماعة مرتيل

الحموشي يعين كفاءات من الجيل الجديد بمناصب أمنية ممركزة ولامركزية

لقجع وصف الاجتماع باللحظة التاريخية لما ستحققه من استقرار لممتهني

اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بسلا تصل المحكمة الإدارية واتهامات تلاحق رجل سلطة وأمناء التجار
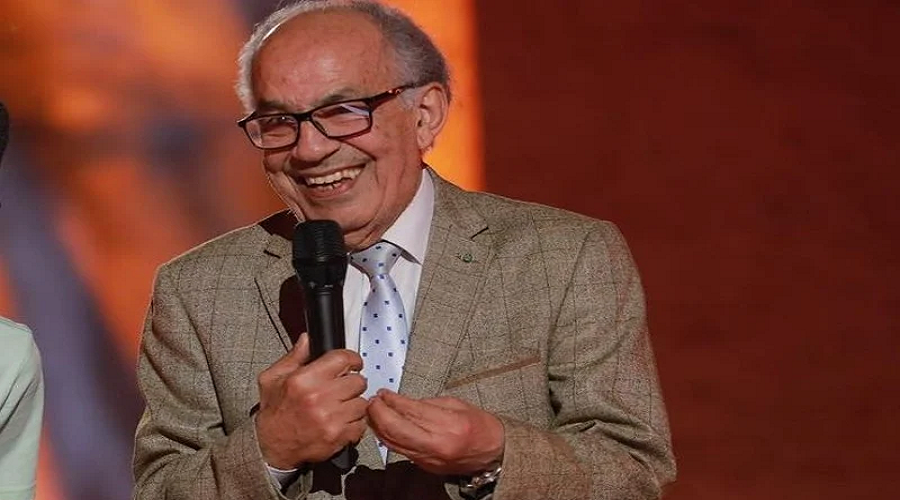
الداسوكين.. موت مكرر

برلمانيون مهددون بالتجريد من مقاعدهم البرلمانية بسبب الفساد

الحموشي يعين كفاءات من الجيل الجديد بمناصب أمنية قاربت 40 منصبا

تحرير 25 مغربيا كانوا محتجزين في ميانمار بتعليمات ملكية للمتدخلين

طنجة تحتضن الدورة الخامسة عشرة للجامعة الصيفية للشباب المغاربة العالم

تكريم شاب مغربي بعد إنقاذه لشرطية في إيطاليا

لقجع يوسع الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية

بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف موظف سيستفدون من الزيادة في الأجور

المغرب يكشف رسميا عن تصميم ملعب الحسن الثاني بالدار البيضاء

لقجع ولفتيت يكشفان عن مشاريع عملاقة لتغيير وجه العاصمة الرباط

انتشال ثلاثة جثث وإنقاذ 21 شخصا في انقلاب قارب للهجرة السرية بسو

والي الرباط سلا القنيطرة يتبرأ من مشاريع وهمية ويحمل المسؤوولية

إيقاف مبحوث عنهم بحوزتهم سيوف ومواد مهلوسة على هامش مباراة الرجاء والجيش

الفرنسيون في المغرب يصوتون بكثافة لليسار ويضعون اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة

ارتفاع أسعار الوقود في المغرب ابتداءً من يوم الاثنين

وزارة القصور الملكية تحذر من استعمال صور كاذبة للأميرة الراحلة للا لطيفة

الرئيس الجزائري يعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة

تواصل جميع الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بشكل عادي

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي يعلن انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته

توشيح عبد اللطيف حموشي بمدالية الشرف الذهبية للشرطة الفرنسية

الملك يستفتي المجلس العلمي الأعلى في مقترحات مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية

الملك محمد السادس يحيل مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي

اعتقال ضابط أمن للاشتباه في تورطه في الارتشاء والابتزاز بتطوان

الوكيل العام يحاصر "مومو" بالأسئلة والمتهم يؤكد أن بوصفيحة لا علم له بالقصة

قيادة الأغلبية تنوه بالمبادرات الملكية وتشيد بتماسك مكوناتها

محكمة الإستئناف بفاس تحكم بـ6 أشهر حبسا في حق عمدة فاس بتهمة الفساد

حموشي يجتمع بمسؤولين أمنيين كبار في زيارة عمل لألمانيا

نسبة النجاح في الباكالوريا تجاوزت 67 في المائة والإناث يتفوقن على الذكور

الملك يرسل مساعدات طبية لسكان غزة وتكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص

فرق المعارضة تنسحب من جلسة مجلس النواب

تفاصيل تحول البرنوصي إلى ساحة حرب دامية بسبب احتفالات بدرع البطولة

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى أخنوش حول تنظيم الإحصاء العام

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان

تخصيص 240 منحة دراسية جديدة لفائدة مغاربة إسبانيا

الانتخابات الأوروبية تعبد الطريق أمام اليمين المتطرف لاكتساح أوروبا

هذه هي الأسباب الحقيقة لرفض منتخب الكونغو الحلول بالمغرب لمواجهة

غلاء الأضاحي «يصدم» سكان طنجة

إيقاف متورطين في عراك بالسيوف بشوارع العرائش

التعاون الأمني على طاولة لقاء الحموشي المدير العام للأمن العام الإيطالي

لقجع يقدم مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم

المجلس الوزاري يصادق على تعديل قانون التعيين في المناصب العليا

المجلس الوزاري برئاسة الملك يصادق على مراسيم تهم المجال العسكري

المجلس الوزاري يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة

أخنوش يفتتح معرض GITEX AFRICA ويعلن قرب إخراج استراتيجية "المغرب

وهبي: قمت ب”حسنة” توظيف رفيقي وإنقاذ وضعيته لأن لديه أبناء

وهبي يثير ضجة بالبرلمان: إن لم يجيبني موكلي والله دين مو ما يدخل لمكتبي

بنعلي تنفي علاقتها بصورة "قبلة باريس" وتؤكد أنها مهددة بالانتقام ومستهدفة من لوبيات

المغرب يدين قصف مخيمات النازحين في رفح

أخنوش يستعرض توصيات المنتخبين التجمعيين لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية

أخنوش : الحصيلة الحكومة أربكت المعارضة ويستغرب أن البعض منهم اعتبرها رشوة

أوجار: الأحرار غادي يمشي من نصر لأخر وأحزاب المعارضة تعيش حالة ارتباك

العلمي يهاجم بنعبد الله :"تاريخكم انتهى مع سقوط جدار برلين وفشلتم الصحة والماء والسكن"

خريطة المغرب تستمر في تحقيق الانتصارات على «كابرانات» الجزائر

لقجع: الأغنياء يستفيدون من دعم "البوطا"

فريق الاتحاد الاشتراكي ينسف جلسة برلمانية

أخنوش يسلم المنظمة الأممية جائزة الحسن الثاني للماء خلال افتتاح المنتدى العالمي للماء بأندونيسيا

زيادة درهمين ونصف في ثمن البوطة الصغيرة وعشرة في ثمن البوطا الكبيرة ابتداء من يوم غد الاثنين

يونس كربيض يشرح في رواق التطبيقات الأمنية كيف توظف الإدارة العامة

حموشي يتباحث مع المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية

الملك محمد السادس يوجه خطابا قويا إلى القمة العربية بالبحرين

الملك يدعو إلى تمكين الشباب العربي من آليات التعليم والتكوين الحديث

الملك محمد السادس يعبر عن إدانته لقتل الأبرياء في فلسطين

الملك يتأسف لعرقلة تنقل الأشخاص والسلع بين دول المغرب العربي

المديرية العامة للأمن الوطني تخلد ذكرى تأسيسها الـ68

منتدى دولي يجمع خبراء الكيمياء بالرباط

رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل الملك في القمة العربية بالبحرين
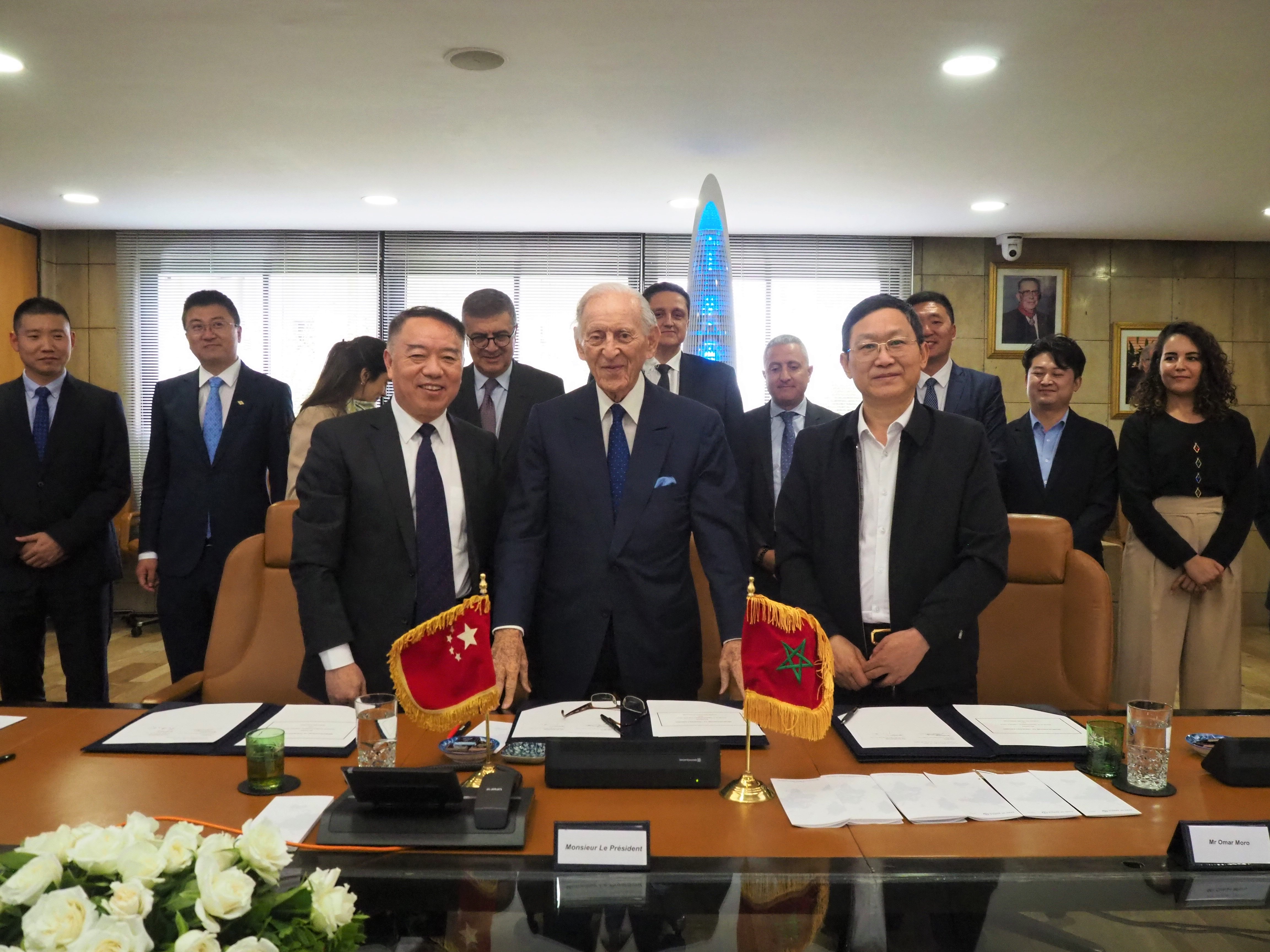
توطين مشروعين لبطاريات السيارات ب"طنجة تيك" ب910 مليون دولار و200

الملك يوجه الأمر اليومي للجيش ويصدر تعليماته من أجل تقييم شامل لمناهج التكوين والتدريب العسكري لكافة الجنود

تفكيك خلية إرهابية بتيزنيت وسيدي سليمان وتوقيف أربعة مشتبه فيهم

افتتاح الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان

بوقنطار والزاهي يتوجان بلقب النسخة العاشرة للسباق الدولي ببسكورة

الحكومة تتجه لتقييد استعمال "تيك توك"

لقجع : «لا أتدخل في تعيينات الحكام والمغرب تضرر من التحكيم»

بعد رفض السراح وكيل الملك يتابع نائب البكوري في حالة اعتقال بتطوا

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لـ "داعش"

إحالة نائب رئيس جماعة تطوان على جرائم الأموال بالرباط

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط

أسترازينيكا تعترف بتسبب لقاحها في جلطات ومتضررون يطالبونها بتعويض

مغربيات يسيطرن على المراكز الثلاثة لنصف ماراتون جاكرتا

رئيس الوزراء الإسباني يتراجع عن الاستقالة ويقرر البقاء في منصبه

الحكومة تقرر زيادة ألف درهم للموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل

رسميا انسحاب اتحاد العاصمة وتأهل بركان للنهائي لمواجهة الزمالك ال

سابقة.... المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يستقطب مليون زائر

أخنوش : الحكومة حققت تقدما كبيرا في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى

وزارة الفلاحة وADA تحتفيان بالمنتجات المجالية في SIAM

1.5 مليار درهم النتيجة الصافية حصة مجموعة اتصالات المغرب

إطلاق حملة تمشيطية واسعة بحثا عن "القط الأنمر" بغابات طنجة

أخنوش: مليون و200 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من الدعم

أخنوش: وقعنا اتفاقية إطار لمضاعفة الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء

فيديو ل"قط الوشق" بغابة بطنجة يثير زوبعة والسلطات تستنفر عناصرها

تفاصيل خطة الأمن المغربي لتأمين الألعاب الأولمبية بباريس ووفد أمني يحل بباريس

الداخلية تمنح مهلة أسبوع لبودريقة قبل عزله

ولي العهد يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة

سيطرة للعداءات المغربية على مارثون الرباط الدولي

رئيس «الفيفا»: المغرب مضياف ويسعدني أن أجد نفسي مع هذا الشعب

عاجل.. الكاف ينتصر لبركان ويطالب بتحرير قمصان النهضة من آيادي الأمن الجزائري

عاجل..بركان يغادر المطار في اتجاه الفندق بعد الحصول على ضمانات من «الكاف»

آخر تطورات فضيحة كابرانات الجزائر في حق بعثة نهضة بركان...

إغلاق الحدود في وجه أرماني بطلة "المواعدة العمياء" إلى حين انتهاء التحقيقات

إخلاء عام لمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط

الرباط تحتضن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"

هذه التشكيلة الرسمية لمكتب مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها غد

"البام" يحسم لائحة مرشحيه لمكتب وهياكل مجلس النواب

إبعاد مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي والزومي من مكتب مجلس النواب

أورنج تدشن المركز الرقمي أزول ديجيتال بأكادير

تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة

الحكومة تواصل جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات للحسم في اتفاق نهائي

الأحرار يقوم بتغيير جذري للمسؤوليات بمجلس النواب ويمنح مقعد بودريقة لبرلماني صحراوي

بلجيكا تدعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية

أخنوش ودي كرة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغرب-بلجيكا

أخنوش يشيد بالتعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا

مليار و600 مليون درهم لتشييد جامعة للطب ومستشفى دولي خاص بالرباط

حفيظ العلمي ينهي عملية شراء SGMB ب 745 مليون أورو

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

إدانة المنشط «مومو» بأربعة أشهر حبسا نافذا

OCP – "Fortescue".. مشروع مشترك لتطوير الطاقة الخضراء بالمغرب

أمير المؤمنين يترأس بمسجد الحسن الثاني حفلا دينيا إحياء لليلة القدر

الملك يترأس إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني

نجاة ركاب في حادث احتراق حافلة بين الحسيمة وتطوان

بوريطة يتباحث مع دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية

أخنوش يمثل الملك في حفل أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية السينغال

أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

استنفار لانقاذ أسر حاصرتها المياه بسبب اعصار تطوان

الحكومة توقع اتفاقية استثمار مع المجموعة الصينية btr وانطلاق بناء مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية

استثمار صيني في السيارات الكهربائية بطنجة بقيمة ثلاثة ملايير درهم

الصناعة المغربية تحقق رقم معاملات جاوز 800 مليار درهم في 2022

السكوري يدعو إلى تقوية النقابات ويكشف أن كلفة الملفات الاجتماعية تجاوزت 27 مليار درهم

الملك يشرف بالدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضاني

اعتقال عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين

المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تؤكد شرعية اتفاقية الفلاحة والصيد البحري

أخنوش يدشن متحف الكرة المغربية

تدشين المركب الصناعي الجديد لمجموعة "موتانديس"

نانا سيحيون 53 حفلا موسيقيا في مهرجان كناوة الصيف المقبل

أخنوش: سنباشر إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024 في إطار مقاربة تشاركية

دراسة تكشف عدم استعداد مهني السمعي البصري للذكاء الصناعي

أمير المؤمنين يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بنسليمان تحتضن ملتقى دولي خاص بالبيئة بمشاركة طلبة من مختلف الدول

أغلالو تستقيل من عمودية الرباط

الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط بيدرو سانشيز

بيدرو سانشيز يحل بالمغرب غدا الأربعاء في زيارة رسمية

موظفو ومستشارو جماعة الرباط يحتجون ضد أغلالو (فيديو )

إدارة السجون تتجه لمتابعة ابن زيان قضائيا بسبب ادعائه وجود كاميرات في زنزانة والده

أخنوش : حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من قيادة المشهد السياسي الوطني في ظرفية صعبة

أخنوش: حصيلة الحكومة تنبني على "شرعية الإنجازات" المحققة لفائدة الأسر المغربية

أخنوش: قيادة المشهد الحزبي لم تأتِ من فراغ وحزب "الأحرار" نجح في خلق جيل جديد من النخب

أخنوش : الحكومة لا تبيع الوهم للمغاربة والتجمع الوطني للأحرار أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية

36.8 مليار درهم رقم المعاملات الموطد لـ"اتصالات المغرب"

بتنسيق مع الديستي... الشرطة تفك لغز جريمة اختفاء زوج الفنانة فكري

بريد المغرب وبريد عمان يطلقان طابعين بريديين مشتركين

الصراع يشتد بين برشلونة ومدريد والدار البيضاء على احتضان نهائي كأس العالم 2030

مصرع عامل بمقاولة بسبب الرياح القوية بشفشاون

رياح قوية في طنجة تتسبب في وفاة شابة بسبب سقوط أجزاء عمارة في طور البناء

تحديات التنمية للبلدان متوسطة الدخل محور مؤتمر وزاري رفيع المستوى بالرباط

توقيف البرلماني محمد كريمين من طرف BNPJ

رئيس النيابة العامة يستقبل رئيس وأعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة

وكالة التنمية الفلاحية تطلق النسخة الثانية من AGRIYOUNG INNOVATE

انقلاب شاحنة ضخمة يقطع مؤقتا طريق طنجة تطوان

الجامعة تكشف عن موقفها من الأحداث المؤسفة في مباراة المغرب والكونغو

لهذا طارد النصيري اللاعب الكونغولي شانسيل مبيمبا لغرفة تبديل الملابس

المغرب وإسبانيا يتفقان على ضرورة تثمين الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية

مراكش تحتضن "يوم بلا سيارات" تزامنا مع نسخة 34 للماراتون

بعد تصريحاته المتهورة في حق المغرب... مثول الجزائري عمروش أمام اللجنة التأديبية لـ"الكاف"

الملك يدعو إلى إقرار مدونة للأخلاقيات والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة

إدارية الرباط تلغي تعديلات أغلالو على النظام الداخلي للجماعة

القصة الكاملة لتدخل لقجع لاحتضان «ميسي المغرب»

ودادية القضاة تنوه بترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان

بنموسى استعان بمفوضين قضائيين لتوثيق تدوينات المحرضين والمشهرين بالأساتذة العائدين إلى الأقسام

لهذا قد لا يرى مرسوم النظام الأساسي النور على صفحات الجريدة الرسمية إلا خلال شهر فبراير المقبل

إجماع على رفض مقترح وهبي بشأن منع البرلمانيين المتابعين من ممارسة مهمتهم وتخفيض عتبة الفريق

زيان يواجه تهما جديدة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية استفاد منها الحزب الليبرالي

رغم أنف الجزائر وجنوب إفريقيا... انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

فتح بحث حول نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار الدولي في المخدرات

نشاط رياضي إسباني بالداخلة يثير سعار «بوليساريو»

خدمات القرب القنصلية... إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج

تفاصيل صفقات بعيوي المعتقل في ملف «إسكوبار الصحراء»

وزارة التربية الوطنية تشهر عصا التوقيفات في وجه الأساتذة المضربين

سكان «دوار بيه» بعين السبع يطالبون بإعادة الإيواء

بنموسى يستدعي النقابات لمواصلة الحوار وتنسيقية تعلن عن "برنامج مخفف" للإضرابات

ملك يصنع السنة..

الداخلية تفكك شبكات «الحريك» بهوامش تطوان ونواحيها

منتوج جيد بتسويق متواضع

مطارا البيضاء ومراكش في قائمة أفضل 10 مطارات إفريقية

هذه أسباب استعانة فرنسا بالتجربة الأمنية المغربية لتأمين «أولمبياد» باريس

محكمة النقض أصدرت قرارا برفض الطعن الذي تقدمت بها المغنية دنيا بطما

ملاجئ فاخرة ومخابئ سرية خوفا من حرب عالمية ثالثة

حريق مهول بأحد أشهر المطاعم في باب الاحد بالرباط (فيديو)

تفاصيل الإتفاق الموقع بين الحكومة ونقابات التعليم

إدانة 4 متهمين بترويج زيوت مغشوشة بالفقيه بن صالح

القانون سيدا

ذبح عتروس وسط الملعب البلدي بالقنيطرة لطرد النحس وجلب الانتصارات لفريق الكاك

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل مراكش للمشاركة في منتدى التعاون العربي الروسي

إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل محور مناظرة وطنية بسلا

سيارة برلماني تحدث فوضى بأحد شوارع تطوان

مالاوي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي

سلطات البيضاء تهدم بنايات منسية للاستفادة من أوعية عقارية إضافية

تخليص الدار البيضاء من «الكرافا» مقابل 14 مليارا

سيدي بنور مذكرة لفتيت حول تنازع المصالح تطارد مستشارة بالجماعة

تساقطات مطرية تكشف عيوبا بطرقات بطنجة

مراكش تحتضن القمة العربية لريادة الأعمال

ملفات التعاون المشترك على طاولة زيارة ألباريس للرباط

النظام الأساسي المثير للجدل كرس الهشاشة الوظيفية لأطر الإدارة

تشديد الخناق على مهربي الأسماك بالعيون

حموشي يستقبل المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية

احتجاجات غلاء الأسعار تستنفر سلطات تطوان

شبح الإفلاس يحوم حول عشرات المقاهي والمطاعم

مخلفات مواد البناء والنفايات تشوه جمالية مدينة برشيد

50 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب لدعم الطاقات الخضراء

دول الخليج تجدد تأكيد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء

جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوقعان بأبوظبي إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة

استقبال رسمي لجلالة الملك من طرف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

حموشي يعزز العرض الأمني بفرق متطورة لإنجاز التدخلات الفورية

تقارير سوداء حول استغلال المياه الجوفية بالشمال

لقجع: الكرة المغربية تعرف تطورا غير مسبوق وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

شرطة برشيد تفكك شبكة للسرقة بالخطف واعتراض المارة

أخنوش: ضرورة تطوير العرض الفندقي وحشد الطاقات استعدادا لكأس العالم

سيدي بنور مديرية التعليم تبعد شركة الحراسة لإخلالها بدفتر التحملات

حموشي يجري محادثات مع المدير العام لمصالح الاستخبارات بجمهورية النمسا

الأغلبية تتمسك بسفريات عمدة ومستشاري جماعة طنجة

أخنوش: تمت معالجة 3.7 مليون ملف خاص بالمستفيدين من “أمو تضامن” بمبلغ 2.38 مليار درهم

الحكومة "تجمد" العمل بالنظام الأساسي والاقتطاع من أجور الأساتذة

اليعقوبي يحقق في «اختلالات» امتحانات بجماعة الرباط

زلزال اعتقالات يضرب المستشفى الإقليمي بتازة

الوقاية المدنية تنقذ مركبا من الغرق بميناء طانطان

تعثر سوق الجديد يغرق جزاري درب البلدية في العشوائية

اعتقال مهاجرين رشقوا القوات العمومية بالحجارة

مجلس المنافسة يغرم شركات المحروقات بمبلغ 184 مليار سنتيم

بنسليمان السلطات الأمنية تتصدى لأصحاب «الكوتشيات»

ولاية البيضاء تحرر الملك العام بعد فشل المقاطعات

زيوت مغشوشة تكتسح الأسواق
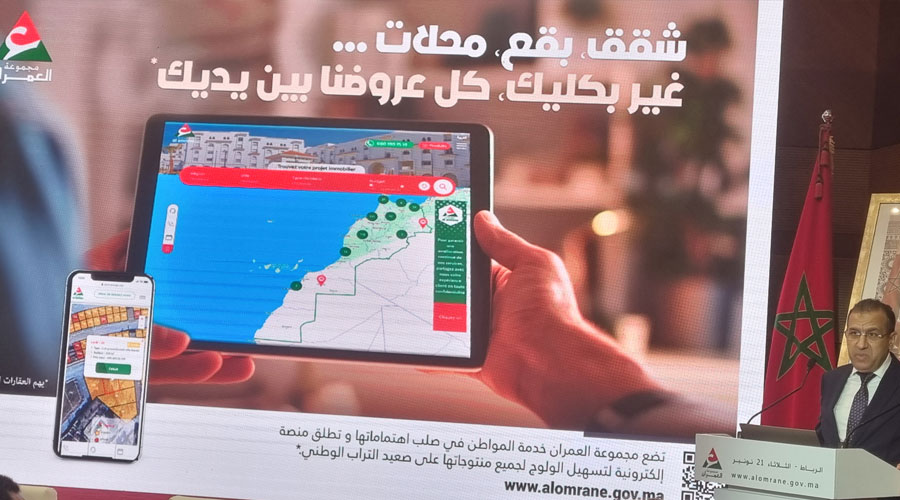
مجموعة العمران تطلق منصة إلكترونية تضم خدمات رقمية لبيع 26 ألف منتوج

بنموسى يشهر عصا الاقتطاعات والأساتذة يلوحون بالتصعيد
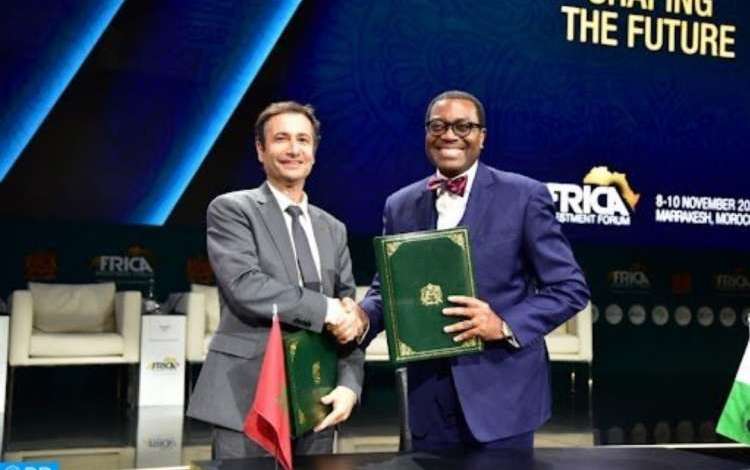
تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية
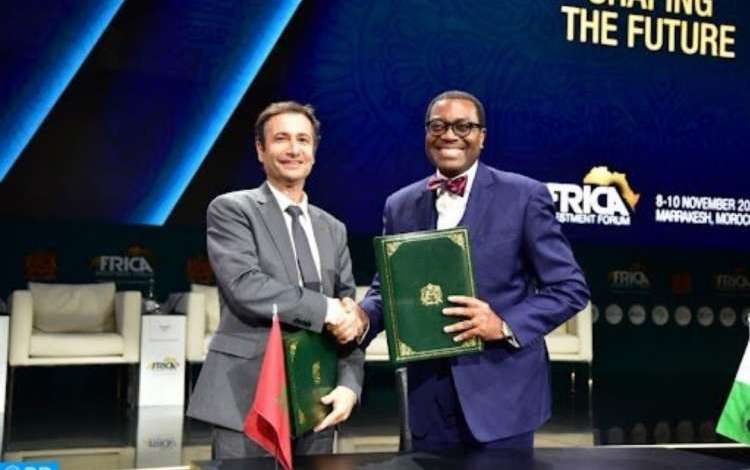
تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية

أخنوش يجري محادثات مع زعيم حزب الشعب الأوروبي

الحموشي ينصف الكوميسير “ميسي” الذي برأته المحكمة ويعيده إلى عمله

حجز 43 طنا من البنزين المهرب بالجرف الأصفر

زلزال في الوداد بعد خسارة لقب «السوبر ليغ»

برلمانيون يطالبون بحضور بنموسى لمناقشة إضرابات التعليم

تفكيك شبكة تستقطب الراغبين في الهجرة السرية بطنجة

الملك محمد السادس يعطي تعليماته لتأهيل الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية

مؤشرات حول مسؤولية "البوليساريو" في تفجيرات السمارة والمغرب يعتبر أمنه خطا أحمر

تحذيرات من أمواج عاتية تضرب سواحل المغرب الأحد المقبل

المغرب يدعو إلى وقف التصعيد الإسرائيلي بغزة وينتقد الصمت الدولي

هل حرم «الفيفا» بونو من جائزة أفضل حارس في العالم

تشييع جثمان ضحية تفجيرات السمارة بسيدي يحيى الغرب

لقجع : الأغنياء يستنزفون 47 مليار درهم من نفقات صندوق المقاصة

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

138 مليون درهم لتزويد طنجة بمياه سد ابن بطوطة

البوليساريو تتبنى استهداف السمارة بمقذوفات متفجرة

استقبال ملكي للولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية

الملك يترأس حفل توقيع اتفاقية تتعلق بإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة لفائدة العالم القرو
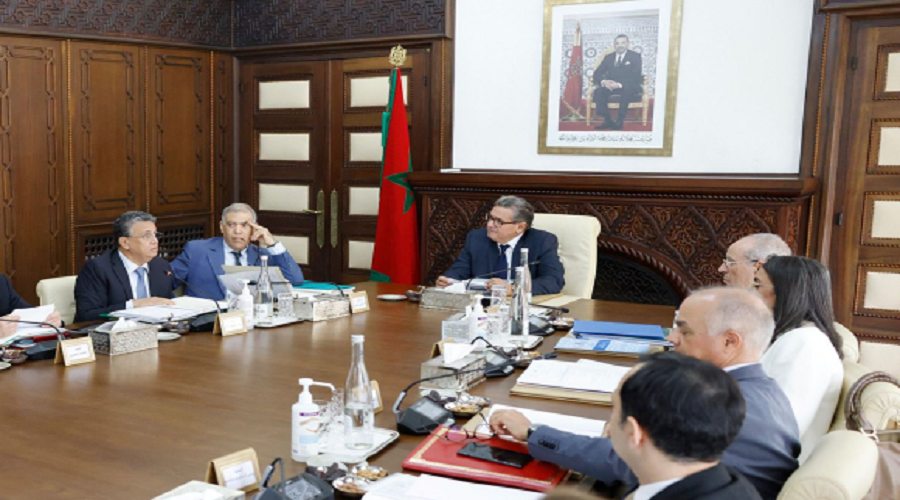
الحكومة تلغي ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تفعيل نظام التأمين لصالح ضحايا زلزال الحوز

أخنوش وبوريطة يتباحثان ببروكسيل أجندة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر المتوسط والوضع في الشرق الأوسط

مواجهة ساخنة بين بنموسى ونقابيون تحت قبة البرلمان

كل ما يجب أن تعرفه حول صرف 40 مليار درهم كدعم اجتماعي مباشر بحلول 2026

طائرتان عسكريتان تغادران القاعدة الجوية بالقنيطرة باتجاه مطار العريش محملتان بمساعدات إنسانية

«لارام» تكشف عن استراتيجيتها وتهدف إلى التموقع كناقل جوي عالمي بحلول سنة 2037

هل منعت الأوقاف خطباء المساجد من ذكر فلسطين حقا ؟

توجهات مالية بنفس إنساني

انهيارات نفسية لمتهمين ضمن شبكة «جاك بوتيي»

الملك يعطي تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين

ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يخرج احتجاجات بالرباط

عاصفة ريحية قوية ونشرة بمستوى يقظة أحمر ومدن الساحل تسجل ارتفاع أمواج البحر

الرياح القوية تطير خيام خضارين بأحد الأسواق الأسبوعية

طقس.. نشرة إنذارية من المستوى الأحمر تهم عدة مناطق مغربية

إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى “المغرب” وتحثهم على مغادرة “الأردن ومصر”

"قمة السلام".. المغرب: الوضع الإنساني أصبح لا يطاق ولابد من إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لحل الدولتين

الملك محمد السادس يعين سفراء جدد ورئيس هيئة مراقبة التأمينات

الملك محمد السادس يعين ولاة وعمال في اجتماع المجلس الوزاري

الملك محمد السادس يترأس مجلس وزاريا صادق على قوانين واتفاقيات دولية

المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024

"البسيج" يوقف أربعة عناصر بشبهة التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية

سيارة أجرة تقتحم الباب الرئيسي للبرلمان

نقل الوزير عبد اللطيف ميراوي للمستشفى العسكري بالرباط بعد تعرضه لحادثة سير

مؤثرون دخلوا قلوب المغاربة

بتعليمات ملكية بوريطة يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الآلاف يخرجون في مسيرة الرباط للتنديد بالعدوان على غزة

الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية

الملك محمد السادس يؤكد تنزيل برامج الدعم الاجتماعي

الملك محمد السادس يشيد بقيم المغاربة بعد فاجعة زلزال الحوز

جورجيفا : على الدول وضع تصورات على المدى المتوسط والبعيد قبل اللجوء إلى الاقتراض

الملك يترأس يوم غد الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية

بوريطة: جلالة الملك ما فتئ يدعو إلى الخروج من منطق العنف والصراع إلى منطق السلام والتعاون

بحضور بوريطة.. أخنوش يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ويجري معها مباحثات

وزان .. جمود الاستثمار والبناء يخلق احتقان في أوساط المستثمرين

حساب "حمزة مونبيبي" يثير ضجة بطنجة

وزارة الصحة تضع نظاما شاملا لمحاربة حشرة "البق"

الصفقات تعري فضائح المكتب الوطني للمطارات وزلزال داخلي يعصف بمسؤولين

كواليس كازا

المغرب قلق من تدهور الأوضاع في قطاع غزة ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة

بوريطة: المغرب فاعل بناء في كافة المساعي الرامية إلى إقامة السلام

ليبيا تختار المغرب تحضيرا لتصفيات "المونديال"

تمديد الحراسة النظرية في حق البرلماني الاتحادي البوصيري ومن معه

عاجل: المحكمة الإدارية تأمر بعزل البرلماني الاتحادي البوصيري

شبكة نصب تستهدف منخرطي cnss

أمير المؤمنين الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الهادي بسلا

"مجموعة العمران" تنخرط في حملة التضامن الوطني مع ضحايا زلزال الحوز وتساهم بـ100 مليون درهم

الناشطة والصحافية الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023

"نهائي كأس العالم 2030 بالمغرب".. الصحافة الإسبانية تتفاعل مع تصريحات لقجع

منتدى دولي يناقش الاستثمار في سلسلة التمور بأرفود

المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة لإنجاز وتجديد البطائق الوطنية لضحايا الزلزال

أغلالو تفشل في عقد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الرباط (فيديو)

الملك يزف للشعب المغربي فرحة تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030

"اولماس" تحتفل بمرور 80 سنة على ادراجها بالبورصة

الانتاج الوطني للتمور يقدر ب 115 الف طن برسم الموسم الفلاحي 2023-

تحركات مهاجرين سريين تستنفر سلطات المضيق
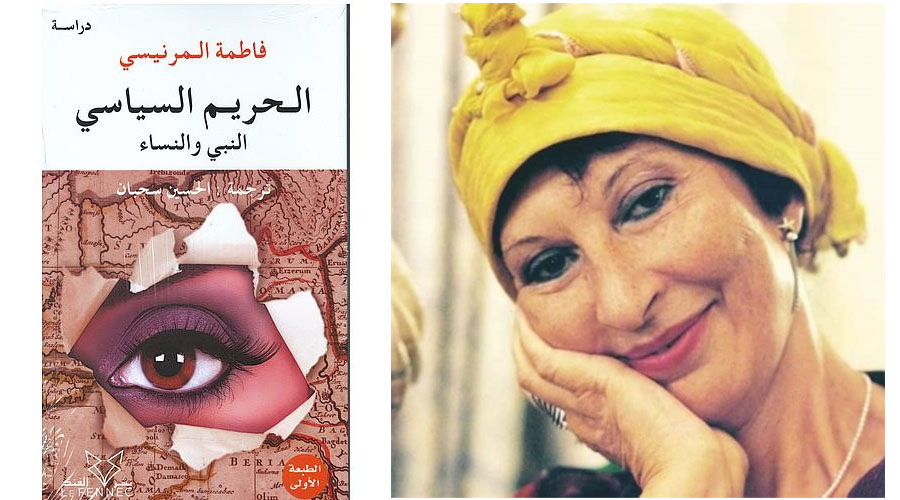
إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب تمنع كتاب "الحريم السياسي" للمرنيسي

تلاعبات في صفقة «الخردة» تحمل بصمات برلماني

إيقاف سائق أردى رجلين بضواحي تامسنا

المدونة... توجيهات ملكية بإصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي وتعديل المقتضيات المتجاوزة

المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية تناقش أزمة الماء والأمن

احتجاج سكان جماعة بتطوان بسبب الماء

سقوط أخطر بارون للمخدرات بتازة

لهذه الأسباب سترتفع أسعار المحروقات يوم فاتح أكتوبر
وزيرة الطاقة البريطاني : مشروع الربط بالكابل البحري بين المغرب وبريطانيا ذو أهمية وطنية

أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم الأربعاء إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط

الملك يراسل رئيس الحكومة بإجراء مشاورات تشاركية حول مدونة الأسرة ورفع مقترحات إليه في غضون ستة أشهر

التجاري وفا بنك ينظم مؤتمرا حول التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين المغرب والصين

السيادة الوطنية لا تقدر بمساعدة

وصفة ملكية

بعد فاجعة الزلزال .. أطفال الحوز وتارودانت يعودون إلى حجرات الدرس

اتصالات المغرب تساهم بمبلغ 700 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز

التحقيق في تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت

ملفات حارقة على طاولة الحكومة

مهلة لوكيل الملك قبل الفصل في قضية اللحوم الفاسدة بتطوان

بناية آيلة للسقوط بحي «لافيليت» تستنفر السلطات

الرئيس الأمريكي بايدن يشيد في اتصال بالملك بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات زلزال الحوز

تحذير من استغلال النساء والأطفال ضحايا الزلزال

النيابة العامة تحقق في 13 ملفا لها علاقة بزلزال الحوز

إجراءات خاصة للطلبة المتضررين من الزلزال بجامعة ابن زهر

شكر ملكي لفرق البحث الإنقاذ

دور أجهزة الرقابة المالية في تعزيز المساءلة والشفافية محور ندوة بمراكش

إحباط محاولة تهريب 3 أطنان من المخدرات بالعرائش

زيارة ماكرون للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة"

مساعدات غذائية عرضة للضياع وسماسرة يتاجرون في الأزمة

جميع المتضررين من زلزال الحوز يستفيدون من الإيواء بما يضمن حمايتهم حتى في حالة سوء الأحوال الجوية

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوضع الصحي في المناطق المتضررة من الزلزال توجد تحت السيطرة

المحافظة العقارية تساهم بمليار درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة عن الزلزال

الملك يترأس جلسة عمل لتخصيص دعم مالي للأسر المتضررة من الزلزال

اعتقال طالب حرض على ارتكاب اعتداءات جنسية بمناطق الزلزال

عدد ضحايا وجرحى زلزال الحوز يواصل الارتفاع والتجهيز تنفي تضرر

الملك محمد السادس يتفقد المصابين في زلزال الحوز ويتبرع بالدم

ترويج نشرة إنذارية كاذبة حول المناطق المنكوبة بالزلزال

قطب مديرية الأمن يخصص 50 مليون درهم لصندوق المساهمات التضامنية

إقامة صلاة الغائب بالمسجد الأقصى المبارك على شهداء زلزال المغرب

زلزال الحوز...وفاة 2200 شخص والحصيلة مرشحة للارتفاع

الملك يترأس جلسة عمل لاتخاذ إجراءات استعجالية بالمناطق المتضررة

ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1037 وفاة و1204 جريحا

حموشي يهيب برجال ونساء الأمن للتبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي

بوريطة يتباحث مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

ممثلو سكان الداخلة الشرعيون يؤكدون لديمستورا تشبتهم بالحكم الذاتي

مواجهة جديدة تعيد بدر هاري إلى الحلبة

الملك يشيد بالعلاقات بين المغرب والبرازيل

كندا تحذر مواطنيها السياح القادمين إلى المغرب من الاقتراب من الحد

"بهارات".. الهند تعيد اسمها القديم بدعوة رسمية
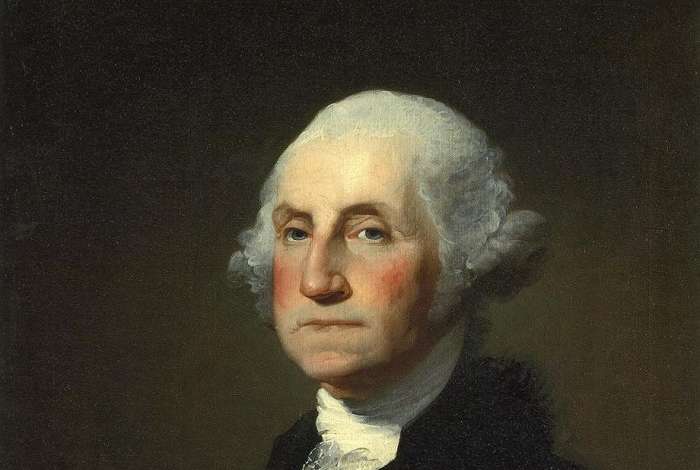
عندما استنجد جورج واشنطن بالمغرب

الحرب على مخدر البوفا : الإدارة العامة للأمن الوطني تنشر الحصيلة

لقجع ينهي عهد «الأوراق» في الصفقات العمومية

التحقيق في حريق مهول بسوق القرب بمرتيل

فيفتي سنت يضرب امرأة على رأسها بالميكروفون

المغرب يتابع عن كثب الأوضاع في الغابون

التحقيق مع مشتبه في سرقتهم اللحوم أثناء توزيعها على جزارة تطوان

الممثل العالمي التغماوي يهاجم مومو ويطالبه بإرجاع حزام سرواله

الخارجية تنفي تقديم المغرب لطلب الانضمام للبريكس

وفاة 9 أشخاص في حادث اصطدام قوي بأولاد عزوز

جدل المرابد والحراس العشوائيين للسيارات بأكادير

برلماني رشح زوجته للإطاحة بأمه في الانتخابات

التحقيق مع أستاذ للفنون التشكيلية بطنجة بسبب عظام بشرية

استدعاء فيسبوكية لأجل الإساءة لنساء تطوان

عودة فوضى الشواطئ تستنفر سلطات المضيق

الفرقة الوطنية للدرك توقف رئيس غرفة مهنية بالداخلة

حجز 11 طنا من الأسماك الفاسدة بطرفاية

حرائق الصيف تهدد غابات المغرب

طلقة "طائشة" تودي بحياة فارس بموسم مولاي عبد الله أمغار

وزارة العدل تفرج عن النتائج الأولية لمباراة المحاماة

"دلاح" غير صالح للإستهلاك بأحد الأسواق الممتازة لأكادير

وزارة الخارجية تحتفي باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج
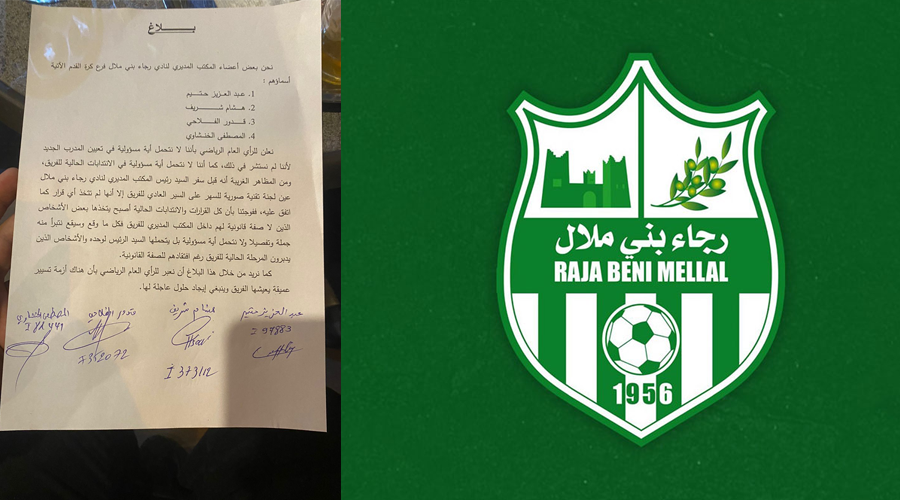
أعضاء بمكتب رجاء بني ملال يتبرؤون من العلالي

تفاصيل استقبال رئيس دولة الإمارات للقجع بأبو ظبي

التامك يدق ناقوس الخطر : ساكنة السجون تتعدى مئة ألف بينما الطاقة

حريق غابوي مهول يوقف السير مؤقتا بين طنجة وتطوان

رسالة خطية من الملك محمد السادس لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن

الحكومة تكشف أولوياتها في مشروع قانون مالية 2024

زيادات جديدة في أسعار المحروقات

مصرع طفلة غرقا بمسبح غير مرخص بسيدي سليمان

الأميرة لالة خديجة تلهب منصات التواصل الاجتماعي

القانون الأساسي الجديد.. الإضراب والاقتطاعات يفجران غضب الأساتذة

«روائح» بمياه الشرب تقض مضجع سكان الرباط وتمارة

أمير المؤمنين يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

مهاجرون مغاربة يطالبون بتدخل رئيس النيابة العامة

النيابة العامة تحقق في حريق حافلة بتطوان

حركية في درك طنجة لضبط الأحزمة الساحلية

أخنوش : خطاب الملك كان قويا وسيفرز تحولات كبيرة

الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بمناسبة عيد العرش بالمضيق

الملك يحث الحكومة على صيانة كرامة المواطنين وعدم التساهل

الملك يدعو إلى التمسك بالقيم الدينية والوطنية والوحدة الترابية

الملك يوجه رسائل إلى الجزائر ويجدد رغبته في إعادة فتح الحدود

الملك يدعو إلى الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية

الملك يوصي الحكومة بتخفيف آثار أزمة الجفاف

الملك محمد السادس يشيد بالإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بمونديال

الملك محمد السادس :"العلاقات مع الجزائر طبيعية ونرجو من الله

الملك يدعو إلى الجدية لتجاوز الصعوبات ورفع التحديات

بعد 10 سنوات من الشراكة مجموعة ويلمار تفوت حصتها من كوسومار

الملك محمد السادس يستقبل الجواهري والي بنك المغرب

احتجاج ومطالبة بالتنمية أمام جماعة بسطات

قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط يحيل نائب الوكيل العام بطنجة

القمة الروسية الإفريقية الثانية تكرس مبدأ اقتصار المشاركة

فوضى بمجلس البيضاء... اتهامات بالفساد ومشادات وإغماء

بوتين يستقبل رئيس الحكومة أخنوش على هامش افتتاح القمة الثانية روس

حجز حوالي 20 ألف وحدة من المفرقعات بالرباط والدار البيضاء

حريق يلتهم حافلة للنقل الحضري بتطوان دون خسائر بشرية

الوكيل العام للملك يحيل اختلالات «دونور» على الفرقة الوطنية للشرط

اعتقال البرلماني الحيداوي في قضية المتاجرة في تذاكر مونديال قطر

زبناء "اتصالات المغرب" يبلغون 75 مليونا ورقم معاملات يصل 18399

شركة بريطانية تعتزم الاستثمار بإنتاج الهيدروجين بالمغرب

جدل محل تجميل قرب مسجد بتطوان يصل القضاء

اختفاء ملايين من خزانة فولاذية بضيعة البرلماني الفايق

بعد المضيق.. «مهرجان الشواطئ» لـ«اتصالات المغرب» يصل الحسيمة

القبض على لص مختص في حقائب السيدات بطنجة

اختلالات رخص كراء المظلات الشمسية بشواطئ تطوان تصل البرلمان

انتشار محلات صنع الخبز والفطائر ببرشيد ينذر بكارثة

الملك محمد السادس لنتانياهو : اعتراف دولة إسرائيل بسيادة المغرب

بوريطة: الجالية المغربية بالخارج خط أحمر

مجلس النواب يرفض بالإجماع اتفاقية تضر بمصالح مغاربة العالم

القرض الفلاحي يطلق خدمة Apple pay للأداء

استئنافية ورزازات تسدل الستار على ملف «عصابة الكنوز»

أزمة عطش تهدد أحياء بالرباط والصخيرات وتمارة

مختل عقليا يتسبب في مصرع سائق سيارة بطنجة

قرار عاملي بإغلاق مطعم مشهور بمرتيل لشهر كامل

«لارام»: نسبة رضا الزبناء بلغت «مستوى إيجابيا»

الاتحاد الأوروبي يتشبث باتفاقية الصيد البحري مع المغرب لتعميق ا

استفزازات ومؤامرات تعرضت لها بعثة المغرب بالجزائر... اقتحام الأمن

رفض 119 ألف طلب «فيزا شنغن»

ثلاث سنوات حبسا نافذا للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي

وضعية المختلين عقليا بشوارع برشيد تسائل المسؤولين

موظفة بنكية تطيح بزميلها وبمدير وكالة بتيفلت

الملك محمد السادس يدعو العلماء للتأثير الإيجابي في الناس

مغربي قضى 15 سنة في السجون الإسبانية ظلما

الحكم ببراءة جميع المتهمين في ملف بيوي وحجيرة بجماعة وجدة

السوق السوداء تلهب أسعار الكراء الموسمي بالشمال

النيابة العامة بتطوان تبحث تورط مالك يخت في الهجرة السرية

المحافظة العقارية تحارب السطو على العقارات بالرقمنة

مونديال 2030.. أخنوش يوقع الضمانات الحكومية لـ«الفيفا»

مجلس النواب ينهي «بلوكاج» مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

لسعات العقارب تطارد ساكنة المناطق القروية بسطات

مرشد سياحي يشكو «تعسفات» مسؤولين بالسياحة بطنجة

المحاسبة تعيد ملف نهب الرمال بتطوان إلى الواجهة

اعتقال المؤثرة ندى حسي ونزار السبتي بسبب إدلائهما بمعطيات مغلوطة

المغرب اسبانيا البرتغال..تعرف على الشروط التي وضعها "الفيفا"

أحيزون يشرف على تتويج الأبطال المغاربة بعد التربع على عرش البطولة

حموشي يبحث مع مسؤولين برتغاليين سبل تطوير التعاون في مجال محاربة

الملك يعين فوزي لقجع على رأس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم

محكمة النقض تؤيد حكما بالحبس في حق البرلماني هشة بشة كشة والعزل

المستشار الملكي محمد معتصم في ذمة الله

الأميرة للا حسناء تستقبل بمراكش السيدة الأولى للولايات المتحدة

مجلس المنافسة يعيد فتح تحقيق بشأن ممارسات منافية للمنافسة في سوق

الملك يشرف على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيط

وهبي يعفي رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين

الحكامة المالية وتنزيل هيكلة جديدة للجان مركزية أهم ملفات المجلس

حوار مع الروائي العماني زهران القاسمي الفائز بجائزة البوكر

اعتقال البرلماني ياسين الراضي

المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض الهوية البصرية الجديدة

الحموشي يُعَرف الوزراء وعدد من الشخصيات السامية على آليات العمل

شاهدوا أقدم سيارة للشرطة المغربية وكيف كان زي رجال الأمن

المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض الفرق الأمنية الخاصة

بنسعيد يكشف مشاركة عارضين من 51 بلدا في الدورة 28 للمعرض الدولي

الملك يعين مسؤولين جدد على رأس العمران والقرض الفلاحي و"لاماب"

الملك يعين مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية

المجلس الوزاري يصادق على اتفاقيات دولية

الملك يصادق على قوانين عسكرية في اجتماع المجلس الوزاري

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

المديرية العامة للأمن الوطني تستغل الذكاء الاصطناعي

الملك يترأس حفل تقديم نموذج أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين

البرتغال تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

أخنوش يستعرض توجه حكومة لتأمين السيادة الغذائية

عزل البرلماني كريمن من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة

الحكومة رصدت 14 مليار درهم لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بالقطاع

ارتفاع رقم معاملات اتصالات المغرب بنسبة 3.7 في المائة

الجزائر تفشل في عرقلة تعيين المغربية سلمان ممثلة اتحاد المغرب

مسؤولون يحذرون من تأثير «التقشف» في التعليم على «خارطة الطريق»

ماذا بعد مشاركاتنا في تقويمات دولية تكلف مليار سنتيم لكل تقويم؟

نحن وحلم تنظيم «المونديال»

6.1 مليار درهم لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق 2026

توقيف موالين ل "داعش" متورطين في جريمة قتل شرطي بالدار البيضاء

القصر يوبخ "العدالة والتنمية" ويذكره أن القضية الفلسطينية أولوية

المجلس الأعلى للحسابات يضع أحزابا في قفص الاتهام

أخنوش من طنجة: يجب تقوية القدرات التدبيرية للمنتخبين..

محامي لمجرد: ما حدث غريب والمحكمة لا تملك أي دليل يورط موكلي وسنو

توقيف مسؤول أمني متقاعد بسبب التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة

رئيس الحكومة يستقبل والي بنك المغرب

حموشي يجري مباحثات مع مدير "FBI"

تمديد ولاية أحيزون على رأس "اتصالات المغرب" وارتفاع في مداخيل

الجيش يضع إمكانياته رهن إشارة المتضررين من البرد والثلج

سلطات تنغير تنقذ الرحل العالقين وسط الثلوج

“حرب” فصائل “الإلترا” تؤدي إلى اعتقال شخصين بالبيضاء

الفنانة الهوني تكسب قضية إسقاط ولاية طليقها الناجي على ابنه

مع اقتراب رمضان.. تعليمات صارمة بمنع تخزين الخضر والفواكه بالشمال

تكفل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بسيدة حامل كانت في منطقة محاصرة

البرلمان الأوروبي يواصل معاداته للمغرب

إنقاذ طاقم سفينة تجارية جانحة بميناء مارينا سمير

جنوح سفينة تجارية بساحل المضيق وسط تخوفات من مشاكل بيئية

السيول تودي بحياة دركي بإقليم زاكورة

محاولة سطو على فيلا مسؤول بسفارة أجنبية بالهرهورة

ضبط 500 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بمحل للجزارة ببرشيد

احتجاجات واعتصام مفتوح لأطر التعاقد بأزيلال

إسبانيا تسلم مسرح «سيرفانتيس» بطنجة لفائدة الدولة المغربية

أخنوش: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع وأي مخالفات أو سلوكات انتهازية

كابوس مخيف يرعب البحارة بإقليم طانطان

السفارة البريطانية تحتفي بثمانية قرون من العلاقات بين الرباط ولند

غيثة زنيبر تفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي إفريقي

تسريع إنجاز مشاريع ينقل بركة إلى جهة طنجة

التخريب يطول ملاعب القرب بسلا

«الديستي» تحبط محاولة تهريب طن من الشيرا بالرشيدية

أخنوش يكشف معطيات جديدة حول تطور صناعات السيارات والطائرات

عندما يسرق الأدباء بعضهم بعضا

مع اقتراب شهر رمضان.. «أزمة اللحوم» تستنفر الحكومة

البرلمان المغربي يقرر مراجعة علاقته بالبرلمان الأوروبي

تفاصيل مؤامرة يتعرض لها المغرب داخل البرلمان الأوروبي
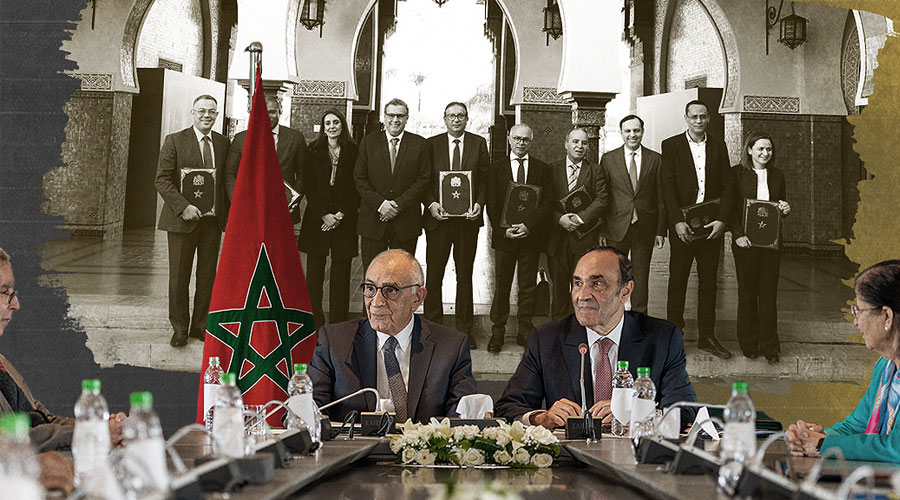
200 مليار «تُقنع» النقابات بالتوقيع دون شروط على النظام الأساسي

توقيف عضو شبكة أغرقت طنجة بالأموال المزيفة

عبد العزيز البوجدايني على رأس المركز السينيمائي المغربي

محمد الشرقاوي.. من ذكريات الاستعمار السوداء إلى وزارتي الدفاع

التحقيق في نجاح طالب بماستر دون ظهوره بلائحة الاستدعاءات بتطوان

اعتقال سائح أجنبي متلبسا باغتصاب طفل في أكادير

الحكومة تقر مرسوما جديدا للصفقات العمومية

التأمين الإجباري عن المرض يفجر خلافا جديدا بين المحامين والحكومة

عقوبات مشددة تنتظر "اليوتوبرز" ومنتحلي صفات صحافيين

قطاع الصيد البحري يعتمد راحة بيولوجية لأسماك السردين

انقطاع أدوية من الصيدليات يهدد صحة مرضى «الغدة الدرقية»

كمين يوقع ببارون مخدرات بإحدى غابات الغرب

منع استيراد وبيع السيارات الملوثة ابتداء من فاتح يناير المقبل

النيابة العامة تكلف BNPJ بالتحقيق في فضيحة المتاجرة في تذاكر

فيديو .. شاهد لحظة انفجار مخزن لغاز البوتان بمنطقة لافاليز
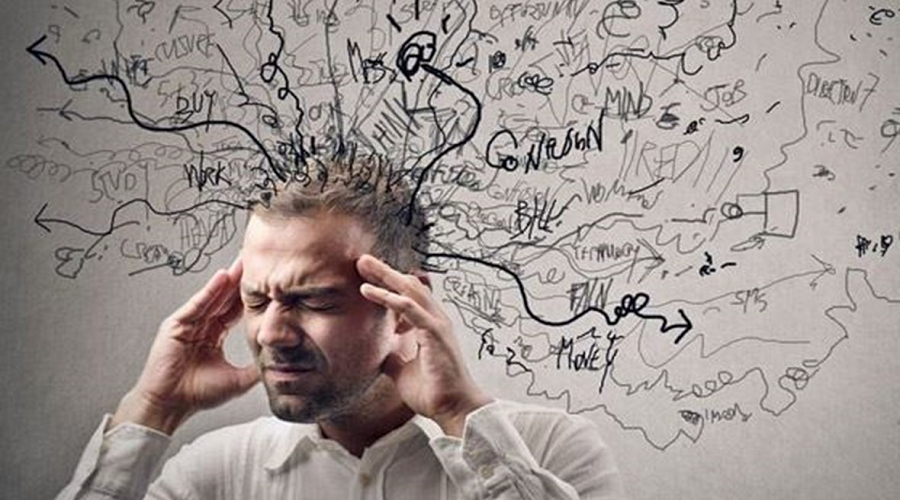
50 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية

مصرع 3 أشخاص في انهيار منزل بالدار البيضاء

هزة أرضية ترعب سكان أكادير

الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف

الملك يستقبل أنطونيو غوتييريش بالقصر الملكي بالرباط

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بابن أحمد

الأمير مولاي الحسن يفتتح بالرباط المعرض والمتحف الدولي

مصرع عاملة بعد سقوطها بالمستشفى الجامعي لطنجة

«سندويش» يتسبب في تسمم 27 شخصا ضواحي سطات

جانح يصيب شرطيا بجروح بقلعة السراغنة

أمن طنجة يستدعي «يوتوبرز» بسبب إزعاج السياح

تفاصيل محاولة انتحار تلميذة بمؤسسة تعليمية بطنجة

التحقيق في ظروف وفاة معتقل تحت الحراسة النظرية بطنجة

إيداع 3 أشخاص السجن بسبب النصب على راغبين في الهجرة

التحقيق في العثور على جثة مهاجر إفريقي بتطوان

اعتقال 4 أشخاص بسبب سرقة 60 مليونا ببرشيد

أمن سلا يطيح بأفراد شبكة سرقة السيارات

الوالي يسقط ميزانية العمدة ومجلس الدار البيضاء يعقد دورة استثنائي

حريق مهول يأتي على مستودع للخشب بطنجة

إطلاق الرصاص ببرشيد لإيقاف تاجر مخدرات مبحوث عنه وطنيا

لفتيت يكشف حقيقة «التلاعب» بمواعد «الفيزا» بتطوان

اعتقال جانح خطير متخصص في سرقة السيارات بالمحمدية

حموشي ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم

الحكومة توافق على 46 تعديلا على مشروع قانون المالية

قاضي التحقيق يستمع للقاصر المشتبه بقتلها لطالب طنجة

اعتقال موظف ببنك المغرب ومقاوللأجل الارتشاء وتبديد أموال عمومية

العدول يخرجون للاحتجاج ضد مشروع قانون مالية 2023

الأمن يوقف بارونا أغرق منطقة أربعاء الغرب بالمخدرات والأقراص

تعاون أمني استخباراتي يطيح بشبكة للهجرة السرية بطنجة

أمن تطوان يحقق في شائعة جثة تلميذ وربطها بجريمة طنجة

لجنة المالية تصادق على صيغة توافقية لضريبة المحامين

الحكومة ترفض فرض الضريبة على مداخيل أصحاب "روتيني" اليومي

الحكومة تفرض ضريبة على استهلاك "الشيشة" والسجائر الإلكترونية

حجز طن ونصف من الأكياس المحظورة ببرشيد

التحقيق في محاولة انتحار من سور بالمدينة العتيقة لتطوان

لقجع ينفي تطبيق رسوم جمركية على هدايا المسافرين عبر النقط الحدودي

بوتفليقة مغربي وهذا أصل العداوة مع المغرب

الملك محمد السادس يؤكد تقدم إنجاز مشروع أنبوب الغاز

الملك محمد السادس يستعرض الحصيلة الإيجابية للبرنامج التنموي

حموشي يشرف على تسليم جوائز لأبناء أسرة الأمن

حموشي يشرف على تسليم جوائز لأبناء أسرة الأمن

الحبس والغرامة والتعويض لخليفة قائد بتارودانت

المغرب مطالب باستثمار 78 مليار دولار لتجنب المخاطر المناخية

إيقاف طبيب بسبب الارتشاء واستغلال النفوذ بخنيفرة

الملك محمد السادس يوجه دعوة للرئيس الجزائري لزيارة المغرب

قرار ملكي في محله

اعتقال زوجين أجنبيين بمطار البيضاء بسبب الاتجار في المخدرات

لخصم يطالب الداخلية بافتحاص مشاريع تأهيل إيموزار كندر

الجزائر تبعد الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش عن القمة

«الديستي» تفكك شبكتين حاولتا إغراق مراكش وسلا بـ«القرقوبي»

مشجعون ولاعبون ومسيرون ماتوا يوم مباراة الوداد والرجاء

اعتقال رئيس جماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة ونائبه

بوريطة: الملك أعطى تعليماته للوفد المغربي بالعمل البناء

الملك محمد السادس لن يحضر القمة العربية بالجزائر

إيداع ثلاثة أعوان سلطة سجن سطات في قضية نصب لأجل التوظيف

إطلاق الرصاص لإيقاف جانح هدد سلامة المارة بالقصر الكبير

مهاجرون أفارقة يقتحمون منزلا بسبب المال بطانطان

الحكومة تربط حذف دعم المقاصة بخروج السجل الاجتماعي الموحد

استئنافية تطوان تستدعي إدعمار في ملف التزوير

اعتقال منفذ جريمة سطو على وكالة مالية بعين عودة

المحامون يهددون بشل مرفق العدالة بسبب الإجراءات الضريبية

المغرب يهدد رسميا باجتياح المنطقة العازلة إذا استعملت «البوليساري

أمن برشيد يوقف مبحوثا عنه في حرب عصابات انتهت بمصرع شخص

مجلس الأمن يصوت على تمديد ولاية المينورسو لمدة عام

«أونسا» يسحب مبيدا خطيرا مضادا للحشرة القرمزية

اعتقال قيادي بـ «البيجيدي» بتادلة بسبب شيكات بدون رصيد

أخنوش يعلن 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش المغاربة

التاريخ المنسي للمجالس البلدية

إيقاف مدون بسبب الابتزاز ونشر ادعاءات مغلوطة بتطوان

إيقاف شخصين متهمين بتنظيم التهجير السري بالحسيمة

كلب مسعور يرسل مواطنين إلى المستعجلات بسلا

مساهمة من يملك لمن لا يملك

اتفاق مغربي- ألماني للتعاون على مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة

فك لغز قتل شابة بكلميم والتمثيل بجثتها

أمن تطوان يفكك شبكة للاتجار في «القرقوبي»

إيداع مسؤول بعمالة زاكورة و7 أشخاص سجن ورزازات

اعتقال موظف أمن بالفنيدق بشبهة اختلاس حوالي 50 مليونا

انتهى زمن الزبدة وثمن الزبدة

الفقيه بن صالح.. افتتاح الوحدة الإدارية التابعة للتعاضدية العامة

تدشين وكالة خدمات القرب التابعة للتعاضدية العامة للموظفين بخريبكة

أيت الطالب ينهي الفراغ بمديرية الصحة بالداخلة

غياب دار للولادة يفاقهم معاناة الحوامل ضواحي تطوان

إيقاف مسؤول مزور بجهاز «ديستي» ببرشيد

انهيار واجهة فندق وسط شارع رئيسي بطنجة

المغرب والسعودية.. مصير مشترك

اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع السنة المقبلة

المجلس الوزاري يصادق على تخصيص دعم مباشر للأسر للحصول على سكن

المجلس الوزاري يصادق على رفع التعويضات العائلية للموظفين المدنيين

المجلس الوزاري يصادق على تغيير قانون التعيين في المناصب العليا

المجلس الوزاري يصادق على قوانين تنظيمية تخص السلطة القضائية

الملك يعين بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

المجلس الوزاري يصادق على قوانين تخص المجال العسكري

المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية

بوريطة ينقل رسالة ملكية إلى العاهل السعودي

وزارة الصحة تعلن زيادة الأسرة لطلبة الطب بطنجة

وزير الصحة يتهم «كنوبس»

الملك يترأس افتتاح السنة التشريعية

وكيل الملك يأمر بالبحث في تعنيف تلميذ بتطوان

الفقر.. عدو المملكة الأول

استئنافية الرباط توزع 660 سنة سجنا على 33 متهما

اتهامات لبرلماني سابق بالتزوير أمام قاضي التحقيق بتطوان

الملك يدعو لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب

الملك أمام البرلمان: موضوع الماء ينبغي ألا يكون موضوع مزايدات سيا

الملك يدعو إلى الإسراع بتنزيل المخطط الوطني للماء

الملك يوجه خطابا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية

إيقاف بناء مشبوه بميناء المضيق بقرار إقليمي

إجراءات من طرف الحكومة لمواجهة أزمة التضخم

إيداع موظفين سابقين بقنصلية برشلونة سجن العرجات

سقوط عصابة بيع لحوم الإبل المسروقة بالعيون

حوادث أعطاب السيارات متواصلة لدى زبناء «طوطال»

القصة الحقيقية لبيع «الزليج» المغربي إلى الخارج

أسلوب ملك

نجاة 30 تلميذا من موت محقق بعد احتراق حافلة تقلهم بطنجة

إيقاف شخصين بسبب النصب الإلكتروني بطنجة

25 سنة سجنا لقاتل ضابط شرطة بإنزكان

سبع سنوات سجنا لراقٍ ستيني بتهمة الشعوذة والاغتصاب

مصالح حموشي تفكك «مافيا» للسطو على العقارات بمراكش

أمير المؤمنين يترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف

البحث في صور تعذيب وشبهات حرب المخدرات بتطوان

65 سنة سجنا لقاتلي حارس سيارات بطنجة

تفاصيل الاجتماع بين رئيس الحكومة ونقابة التعليم العالي

الأمم المتحدة تدعو لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية

ست سنوات سجنا لمتهمين باختلاس وتبديد أموال سوق الجملة بسلا

الحكومة تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد

فضيحة تخريب نقوش أثرية بنواحي زاكورة

تنسيق أمني مغربي-إسباني يطيح بخلية دواعش في الناظور ومليلية

أرسلتهم فرنسا إلى الموت في 1914 و1940 وقضى منهم عشرات الآلاف

«ديستي» تقود إلى تفكيك ورشة سرية لصناعة «قوارب الموت»

قصص أشهر المغاربة الناجين من المشنقة

اختلالات خطيرة بأسواق الجملة ومجازر اللحوم

5 سنوات سجنا لضابط توبع بالاختطاف والاحتجاز بالرباط

مخزون مياه الشرب بطنجة يكفي لثمانية أشهر

فرقة العصابات بطنجة تطيح بمروجين لـ«القرقوبي»

الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور على طاولة لقجع والنقابات

الحكومة تعلق على واقعة "طوطو".. "نرفض هذا النزوح نحو خدش الحياء

تفاصيل حول اختلاس أموال عمومية بالقنصلية العامة للمغرب ببرشلونة

مناورات عسكرية روسية جزائرية بالقرب من الحدود المغربية

إيقاف أب عنف أستاذ ابنه وأرسله إلى المستعجلات بطنجة

اعتقال ثلاثيني في حالة سكر طافح دهس بوابة ميناء البيضاء بشاحنة

غواتيمالا تقرر فتح قنصلية بمدينة الداخلة

وزراء وسياسيون ونجوم المنتخب وفنانون أبناء خادمات
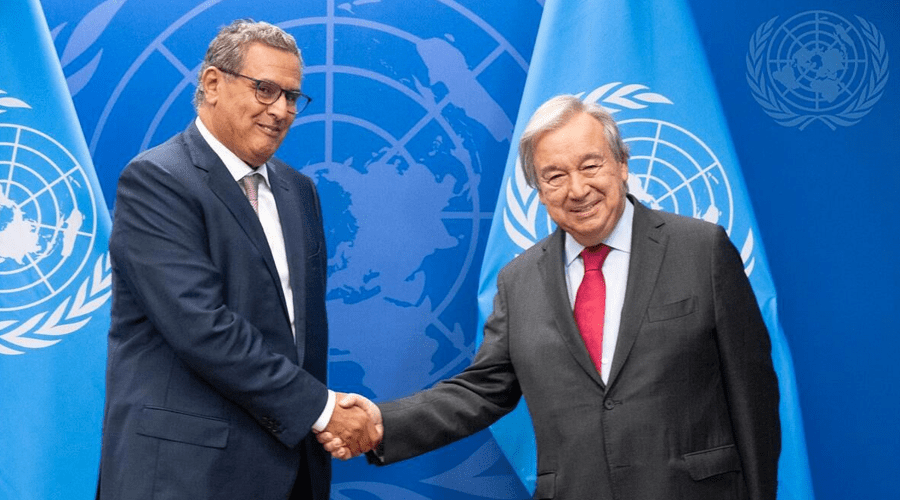
الصحراء المغربية محور مباحثات بين أخنوش وغوتيريس بنيويورك

الأمن يوقف المتورط في اختطاف طفلة بالقنيطرة على متن قارب

الحبس لتلميذ متهم بالاعتداء على أستاذ بالعيون

إيداع نصاب التوظيف المباشر سجن الصومال بتطوان

إيقاف مستشار جماعي بطنجة بسبب «النصب» وشيكات بدون رصيد

ارتفاع قيمة وحجم مفرغات الصيد البحري بموانئ المملكة

أخنوش يشارك في قمة الأمم المتحدة حول تحول التعليم بنيويورك

قطاع طرق يهاجمون السيارات بالطريق السيار ببرشيد

إيقاف بارون رفقة 16 مرشحا للهجرة السرية بالبيضاء

مصرع طفلة نهشتها الكلاب الضالة بضواحي أكادير
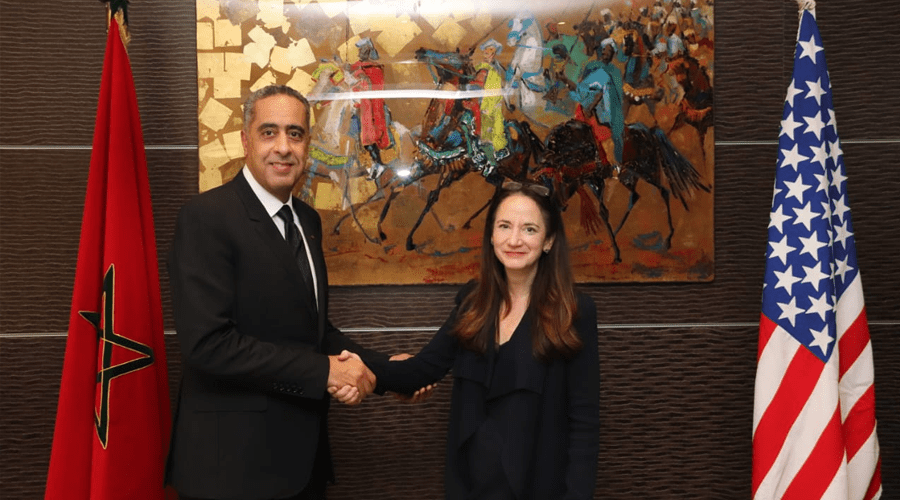
السيد حموشي يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات

علاقات منسية بين ملوك بريطانيا والمغرب
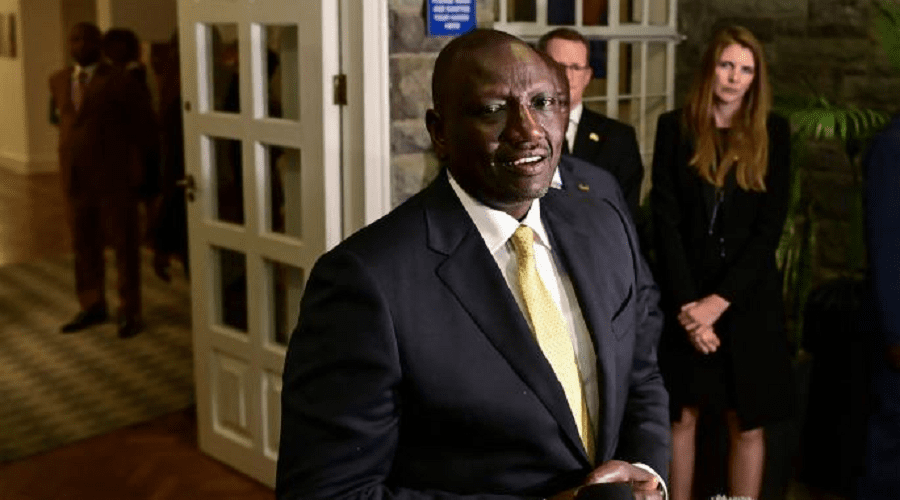
هكذا تراهن كينيا على تطوير علاقتها الاقتصادية مع المغرب

اعتقال 30 جانحا بينهم فتاتان وقاصرون بعين العودة

أرباب محلات غسل السيارات يلوحون بالتصعيد ضد الإغلاق

إيقاف مهرب حاول إغراق الجنوب بالمفرقعات والسجائر

أخنوش : الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم

"الأشغال الشاقة" المؤبدة بالدار البيضاء

برلمانية تكشف خطورة مبيدات الحشرة القرمزية

لارام" تكشف عن زي طاقمها الجديد و منتوجات متنوعة

التحقيق في صور فوضى وعنف بحافلة في تطوان

مطالب بالتحقيق في رفض طبيب تقديم المساعدة بسطات

أمن ميناء طنجة يحبط تهريب 12 كيلوغراما من الشيرا

حريق الحي الجامعي بوجدة يخلف قتيلا وعشرات المصابين

سكان فم الحصن بطاطا يحصون مخلفات الحريق

استياء الأولياء والتلاميذ من تغول جمعيات الآباء وصمت المديرية

شكايات المواطنين من الكلاب الضالة تصل ابتدائية سلا

مداهمة شقة شبكة للدعارة بطنجة

الجفاف يدفعمئات الأسر القروية للهجرة نحو طنجة

عودة زياش وبلهندة.. الركراكي يفرج عن لائحة "الأسود"

إجهاض طفلة بميدلت ينتهي بمصرعها في منزل مغتصبها بحضور والدتها

مواجهات عنيفة بين سكان تفراوت والرعاة

جماعة إنزكان تأمر بهدم مركب تجاري آيل للسقوط

«فيديو»أب يرمي كتبابنته من قنطرة يثير ضجة بطنجة

متهمون في ملفات نصب بالملايير أمام استئنافية تطوان

حريق بواحة ضواحي طاطا يخلف خسائر فادحة
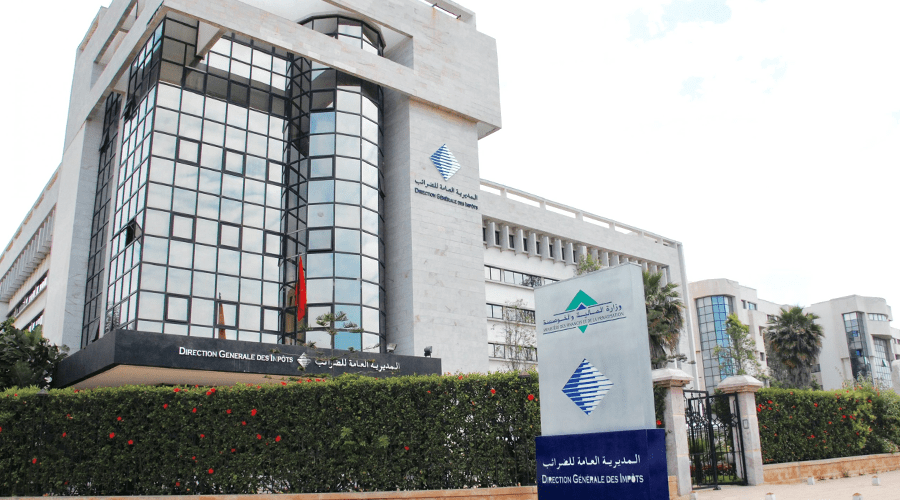
مشروع قانون مالية 2023 سيعطي الأولوية لترسيخ أسس الدولة

إحالة 41 ملف غسل أموال على النيابة العامة

أساتذة التعليم العالي يهددون بمقاطعة الدخول الجامعي

جماعة تطوان تسعى للتخلص من ديون بالملايير

بارون مخدرات وأربعة دركيين وعسكري بالشمال أمام جرائم الأموال

أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط ينتفضون ضد العمدة غلالو

توانسة دفنوا في المغرب
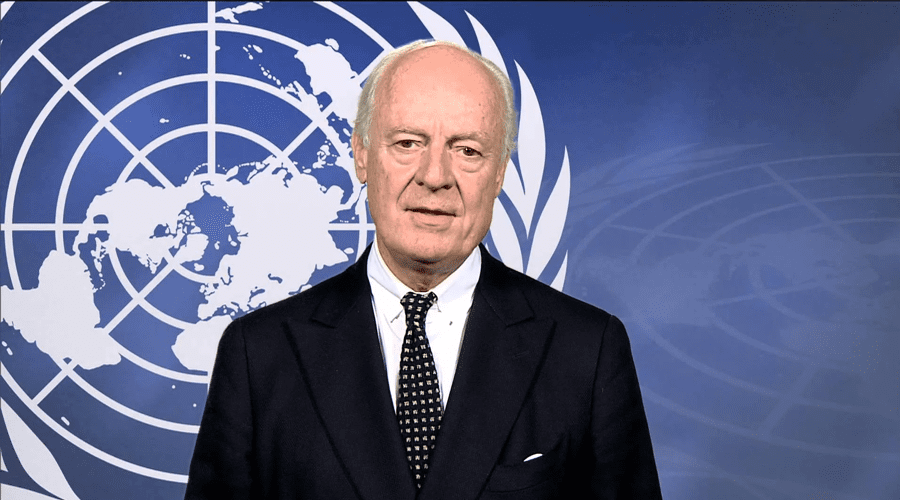
دي ميستورا يبدأ زيارة رسمية للمنطقة من الجزائر

أخنوش يقف على مدى تقدم الحوار القطاعي في التعليم العالي

وزير الصحة يعجز عن فتح مستشفى مغلق ببوسكورة

هذه هي الأجور الدنيا التي سترفعها الحكومة بقطاعات الصناعة والتجار
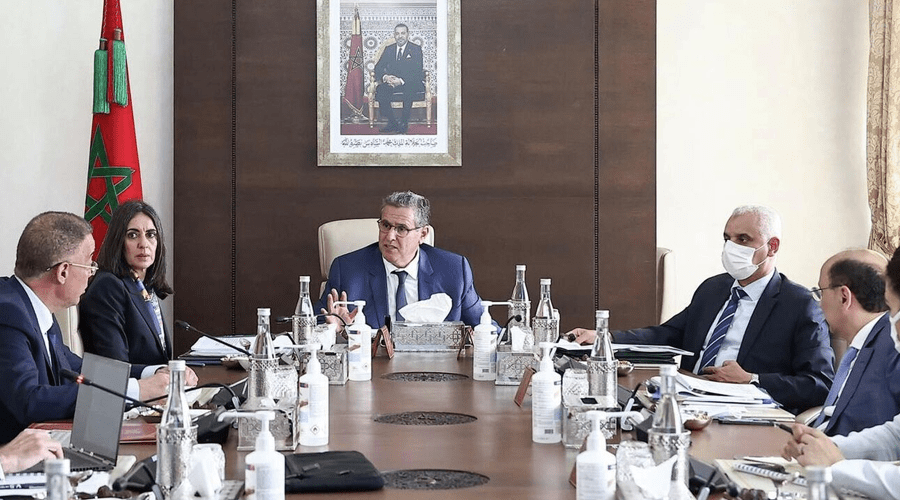
رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة

أقدم وثيقة حقوقية في المغرب
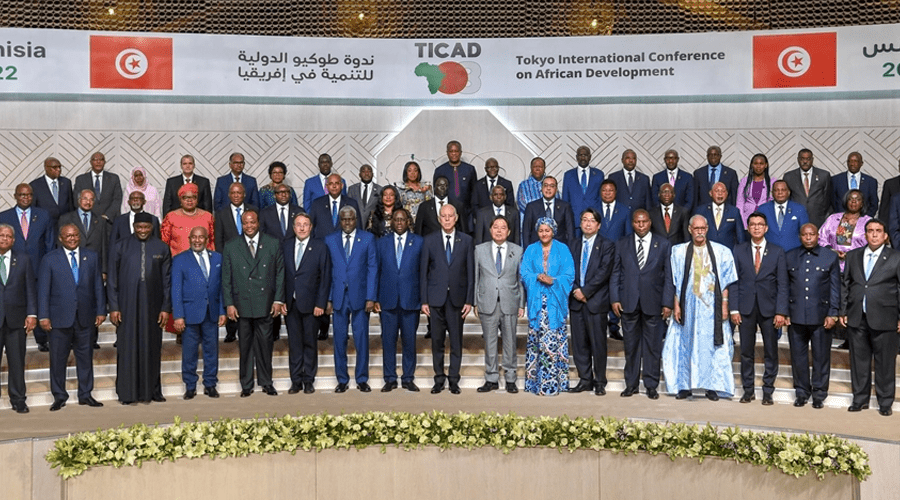
ليبيريا تحتج على حضور "البوليساريو" وتدعو إلى تعليق قمة "تيكاد8"
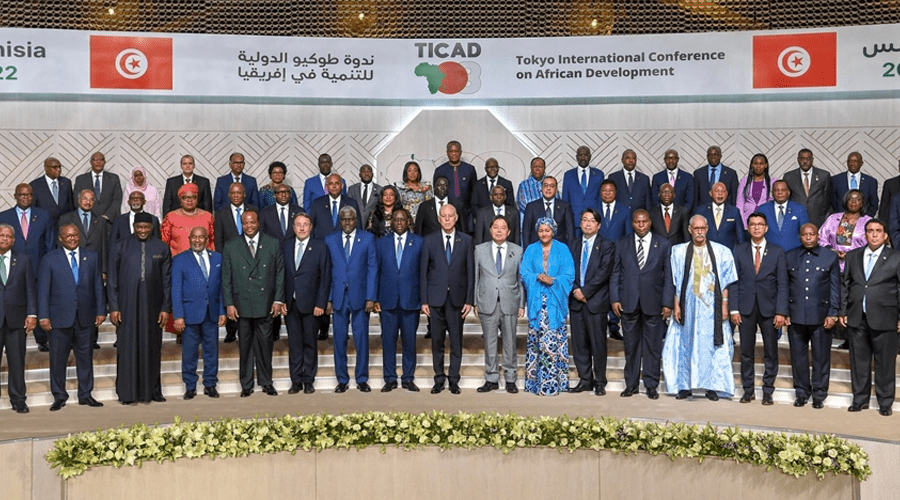
اليابان تفضح كذب تونس وتنفي دعوة "البوليساريو" لحضور قمة "تيكاد"

جزر القمر تعرب عن أسفها لغياب المغرب إحدى "ركائز افريقيا"
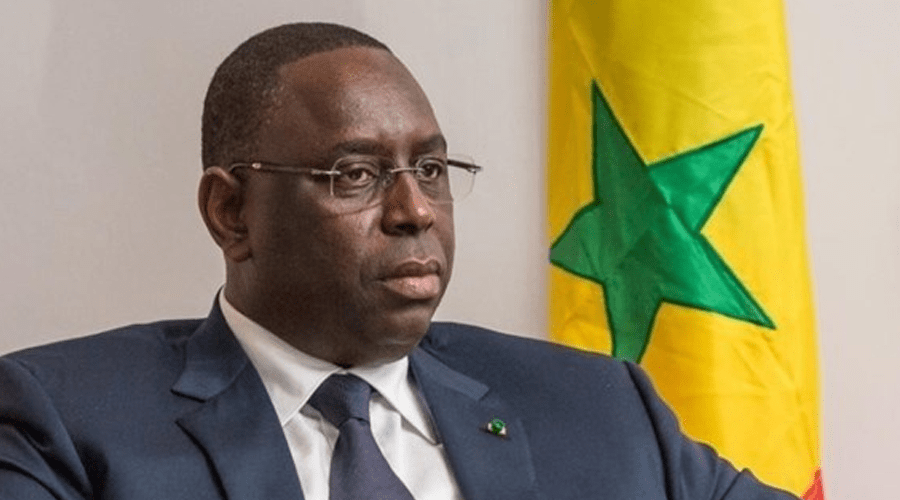
الرئيس السنغالي يأسف لغياب المغرب عن قمة "تيكاد"
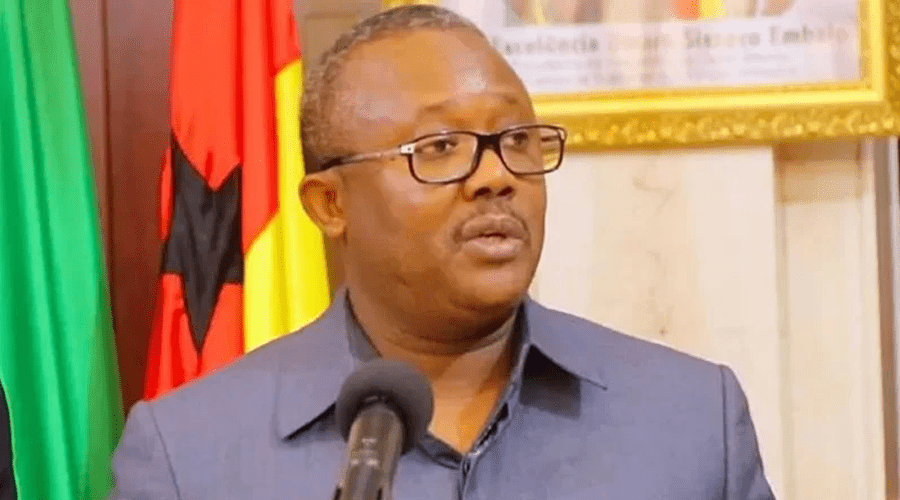
رئيس غينيا بيساو يغادر مؤتمر "تيكاد" بتونس احتجاجا على مشاركة

المغرب يستدعي سفيره بتونس للتشاور ويقرر مقاطعة مؤتمر "تيكاد8"
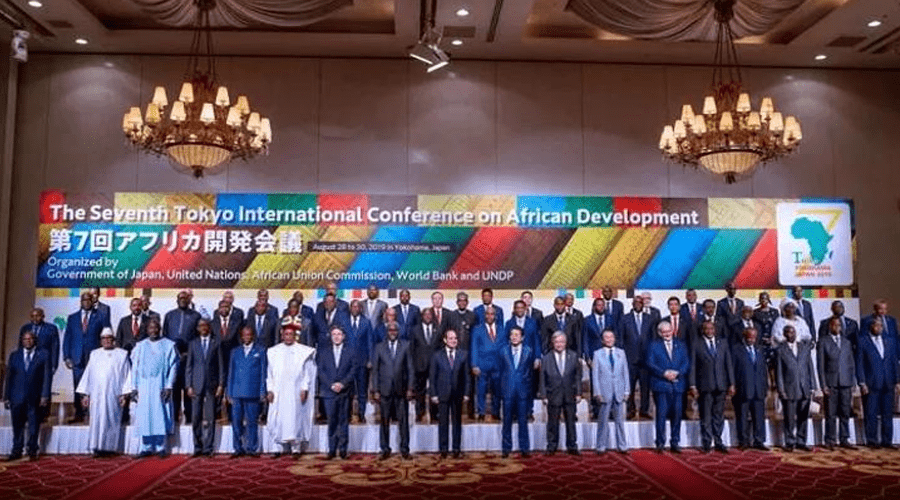
رؤساء دول يقاطعون مؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية بتونس

الملك يشيد بدور مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الترابية

الملك: الصحراء المغربية هي مقياس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات وعل
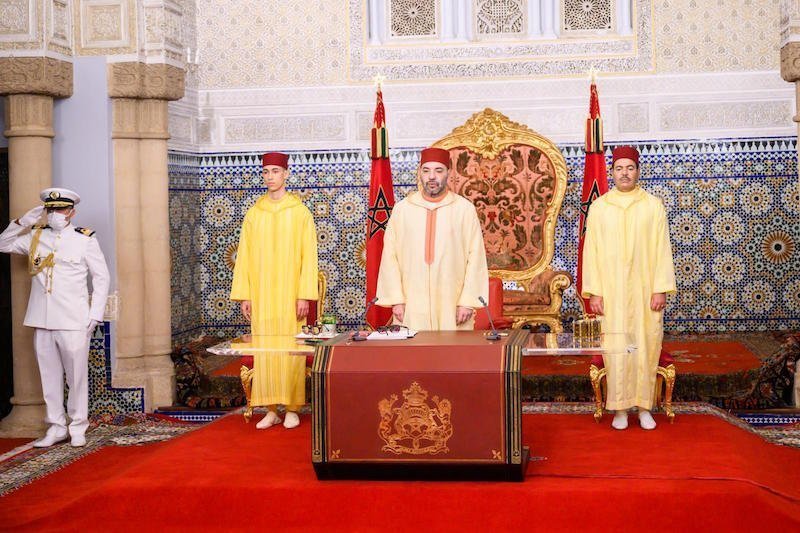
النص الكامل للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب

أمن طنجة يوقف مبحوثا عنه دوليا في قضايا مخدرات

الملك محمد السادس :"الدولة بذلت مجهودات جبارة وأدت تكلفة مهمة

خطاب العرش...الملك يوصي بتعديل مدونة الاسرة

المغرب يتهم "هيومن رايتس ووتش" بالإساءة والتحامل

عيد العرش الـ23 سنة البناء والعطاء

نقابة الصحافة تستنكر تقرير هيومان رايتس ووتش حول أوضاع
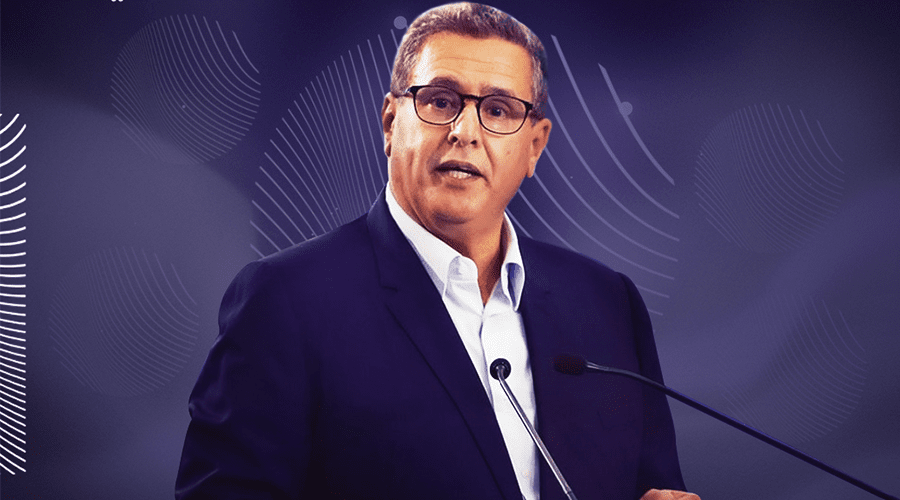
أخنوش : تعميم الحماية الاجتماعية مشروع دولة يستلزم تعبئة شاملة

ارتفاع قاعدة زبناء فروع "اتصالات المغرب" بإفريقيا إلى 75 مليون
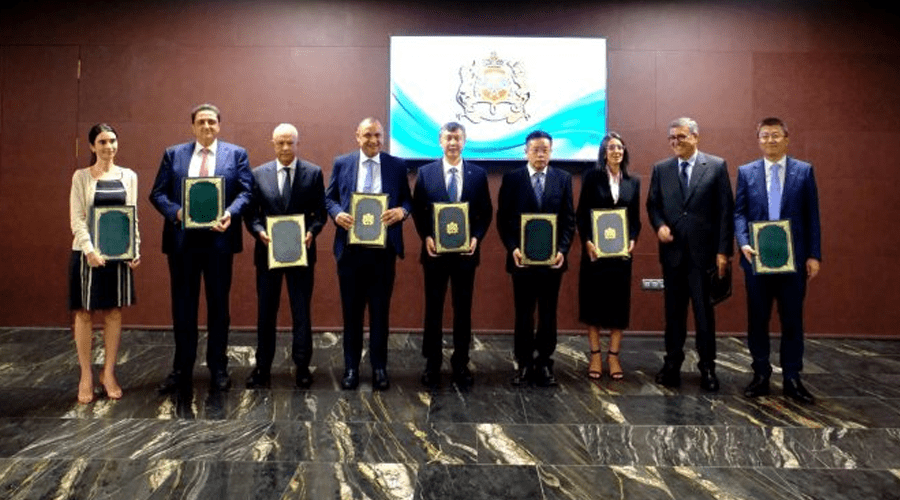
توقيع اتفاقية لإنجاز مشروع مدينة "محمد السادس طنجة – تيك"

اندلاع حريق غابوي جديد بمولاي عبد السلام بالعرائش

الحكومة تخصص 290 مليون درهم لدعم ضحايا حرائق الغابات
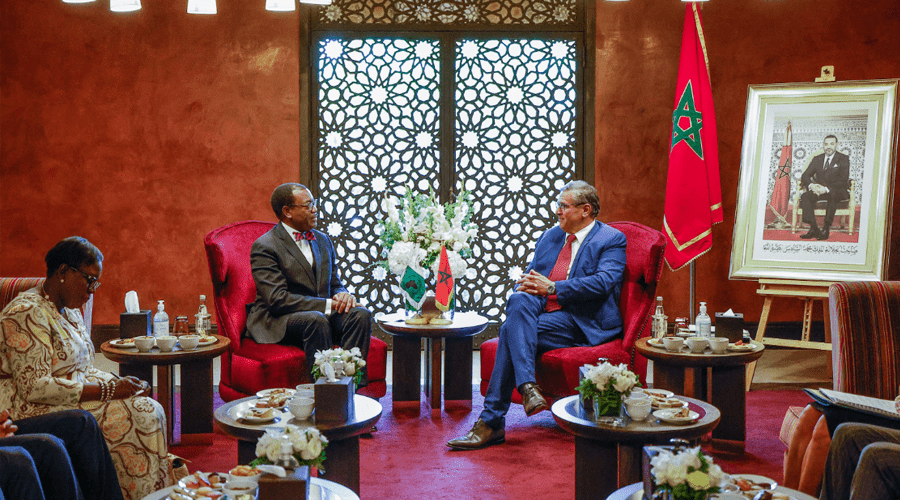
رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
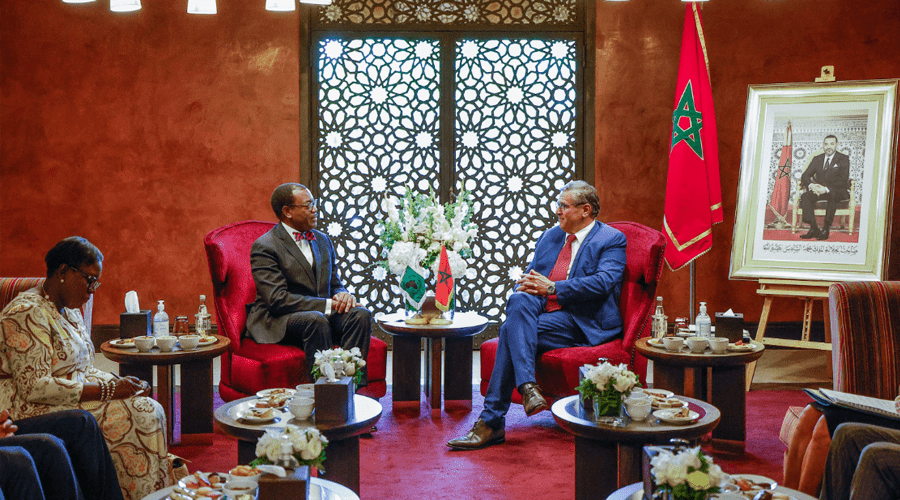
رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
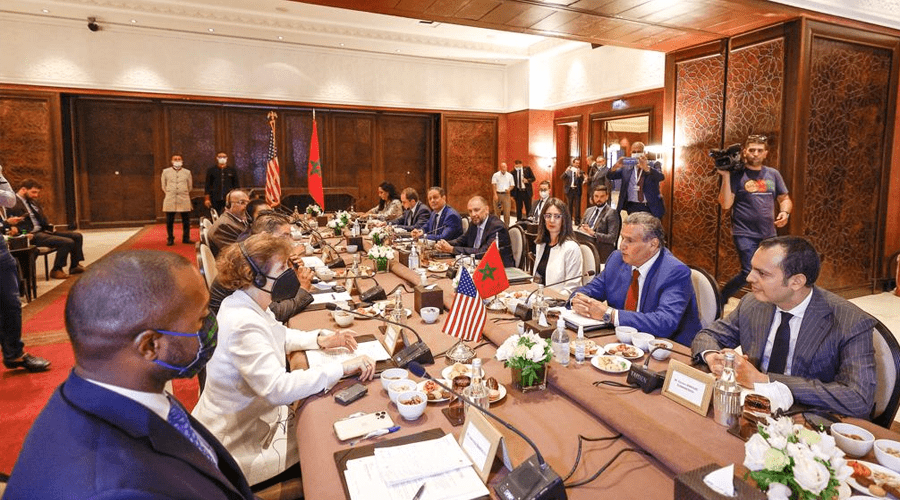
"تحدي الألفية" يجمع أخنوش بأليس أولبرايت في مباحثات مراكش

إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تنفي ادعاءات بشأن حرمان سجين

تلميذ يكسر أنف أستاذ منعه من الغش في الامتحان بالعيون

الحموشي يجري تغييرات في مناصب المسؤولية بولايات أمن فاس وطنجة

تفاصيل مستجدات حرائق غابات الشمال وإنزال مكثف للجيش المغربي
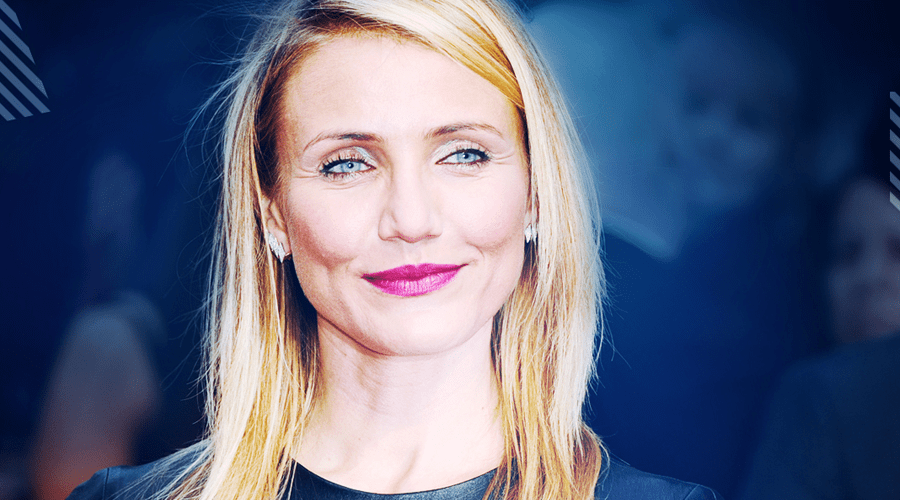
كامرون دياز : هربت حقيبة مخدرات إلى المغرب وكدت أسجن عشر سنوات

السيطرة على حريق غابة لايبيكا بالعرائش

جهود لإخماد حرائق بغابة لايبيكا تسببت في قطع الطريق السيار

حريق العرائش يقترب من منازل السكان ويصل حي الوحدة

حريق يتسبب في خسائر مادية بدواوير القصر الكبير ونفوق حيوانات واحت

إيقاف 25 مهاجرا إفريقيا وحجز معدات للتسلق بطنجة

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون ومراسيم ذات طابع عسكري

الملك يعين سفير مديرا عاما ل CDG وبوطيب رئيسا لمجلس

الملك يترأس مجلسا وزاريا والحماية الاجتماعية والسلاح والاستثمار

الوزير الميراوي يواجه فضيحة "تضارب المصالح"… مطالب بإقالته

اضطراب في التزود بماء الشرب بطانطان

الحكومة تخصص 10 ملايير درهم لصندوق الحماية الاجتماعية

اعتقال ضابط أمن بالعرائش لاتهامه بالرشوة

الأسر المغربية تشتكي الغلاء ومؤشر الثقة وصل لأدنى مستوى
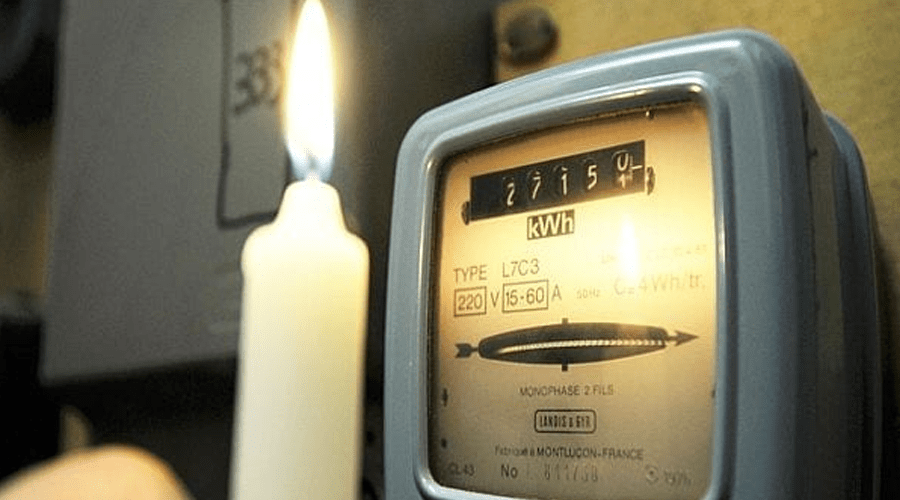
مئات الأسر بسلا بدون كهرباء وانتقادات تلاحق «ريضال»

اعتقال 3 أشخاص بسبب جريمة قتل شاب بطنجة

فعاليات بسطات تدق ناقوس الخطر بسبب لسعات العقارب

إيقاف بارون أربعيني حاول إغراق القنيطرة بـ«القرقوبي»

العمل المشترك التصدي لمافيات الاتجار بالبشر محور لقاء لفتيت

فوضى احتلال الملك العمومي تغزو شوارع سلا

الفواتير الوهمية تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير

تفكيك شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر بالعرائش

سرقة 37 مليونا من وكالة بنكية بسطات

مستخدمو المركب الاجتماعي بسيدي سليمان يطالبون بأجورهم

مدينة سيدي يحيى الغرب تغرق في الأزبال

ارتفاع غرقى السدود والبحيرات يستنفر سلطات الشمال

اعتقال «سمسار» ينصب على ضحاياه بمحيط ابتدائية إنزكان

الوضعية المائية تجمع أخنوش بوزراء

مطالب بزيادة المنقذين بشواطئ طنجة

المؤبد لمهاجر مغربي بإسبانيا قتل طليقته بوحشية

إطلاق الرصاص بسلا لإيقاف جانحين هددا مواطنين ورجال أمن

أمن ميناء طنجة يجهض تهريب 67 كيلوغراما من الكوكايين

نجاة طلبة من حريق بمعهد العمل الاجتماعي بطنجة

اعتقال قاصرمتهم بالضرب والجرح لسرقة مواطن ببرشيد

وزارة الفلاحة تشدد المراقبة على أضاحي العيد

الـ« VAR» يطارد الأجوبة الفايسبوكية أثناء عملية تصحيح أوراق

إصابة 140 فردا من القوات العمومية و مصرع 5 مهاجرين من إفريقيا جنو

ضبط عشرينية متلبسة بسرقة مولود من مستشفى شيشاوة

إدریس شحتان رئيسا جديدا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

سقوط أجسام غريبة من السماء يثير ضجة بطنجة

إيقاف نيجيري مبحوث عنه دوليا بجرائم الاتجار بالبشر

تمديد الموسم الدراسي إلى غاية 20 يوليوز المقبل

صديقي يقسم مصيدة الأخطبوط بالجنوب إلى منطقتين

التحقيق في قضية العثور على جثة شاب بطنجة

أرباب المخابز يتراجعون عن الزيادة في أسعار الخبز

معزوز "يحابي" غلاب بصفقة تفوق 8 مليون درهم

إدارة الضرائب تنفي اختفاء 12 مليار درهم من الخزينة العامة

رسوم جمركية تنهي فوضى التجارة الإلكترونية
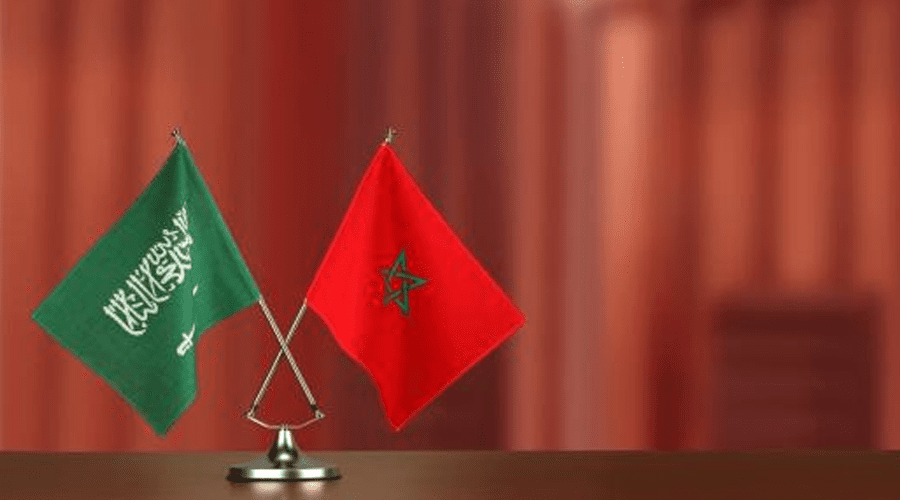
السعودية تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

فوضى واختلالات في تدبير مواقف السيارات ببرشيد

تفاصيل إيقاف مخمور سرق سيارة إسعاف بطنجة

رئيس الحكومة يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية

مستجدات توقيف أطباء بالداخلة وتأجيل المجلس التأديبي

استنفار لإيقاف مروجي مخدرات هددوا شرطيا بالسلاح

لفتيت يعقد اجتماع عمل مع نظيره الإسباني ويتفقان على تعزيز التنسيق

إيقاف ثلاثة طلبة يروجون وسائل الغش بالامتحانات بطنجة

جمارك طنجة تحبط تهريب نحو 54 ألف أورو

اعتقال شرطيين بالرباط بتهمة الارتشاء

سقي ضيعات فلاحية ضواحي مراكش بالمياه العادمة
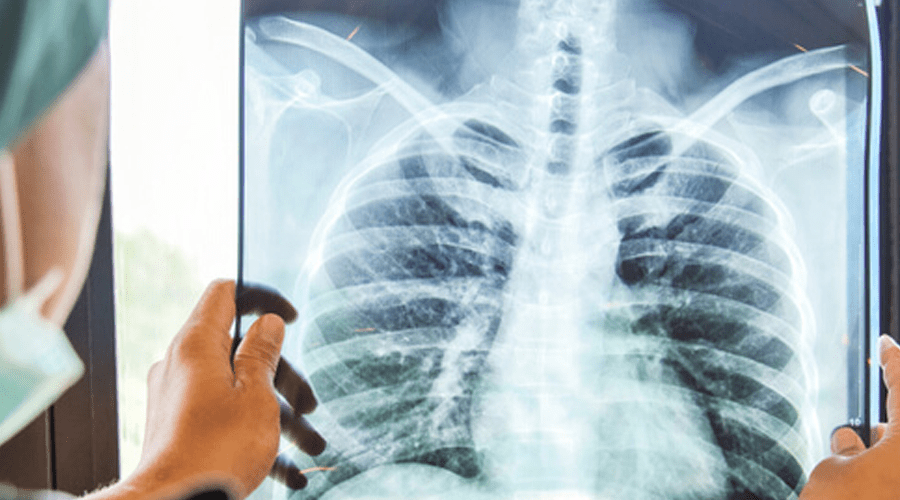
تحذير من ارتفاع حالات السل بسطات

فصل رأس جنين أثناء عملية توليد بابن جرير

الحكومة تخصص 16 مليار درهم إضافية لدعم صندوق المقاصة

للا حسناء تترأس حفل افتتاح مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

الرصاص لمواجهة جانح هدد الأمن ومواطنين بالعرائش
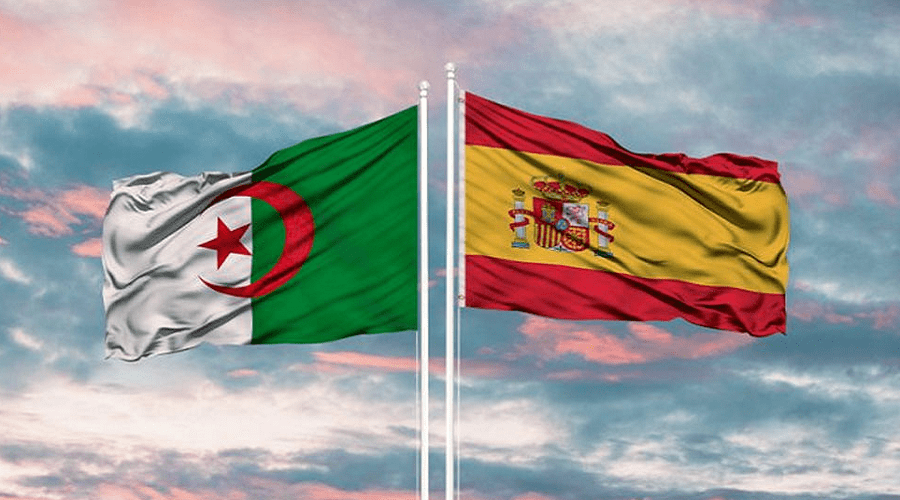
الجزائر توصد بابها في وجه إسبانبا بسبب المغرب

أخنوش يكشف حصيلة مرحلية لبرنامج تنمية العالم القروي

مستشار جماعي يتزعم شبكة للذبيحة السرية بفاس

لفتيت: أشخاص يستغلون صور حالات إنسانية لممارسة النصب والاحتيال

أمن طنجة يطيح بقاصرين متهمين بجريمة «الجيراري»

تقارير نقص الماء بقرى الحسيمة تسائل بركة

تأجيل النطق بالحكم في اتهام إدعمار بالتزوير

عشيقان يقتلان صاحب منزل كراء ويرميان أطرافه بآسفي والنواحي

النيران تلتهم نخيل واحة أسرير بكلميم

مختل عقليا يعتدي على إيطالية بتيزنيت

شكايات ضد مشعوذين بتطوان أمام الحسن الداكي

اعتقال ملثمين اعترضوا سبيل ثلاث فتيات بالشارع بسلا
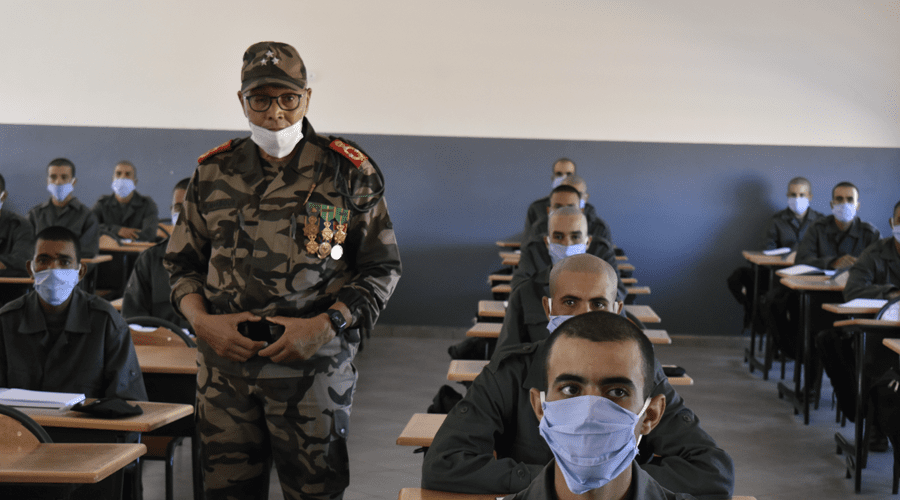
«تيلي ماروك » تنقل تفاصيل ةاليوم الأول للملتحقين بالخدمة العسكري

الداخلية تكشف خطة العمل لاستغلال القنب الهندي

الأسلاك الكهربائية لحافلات مراكش تتسبب في حادث خطير

ارتفاع جديد يلهب أسعار المحروقات

شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لإيقاف مختل عقليا بطاطا

البرلماني الفايق ينهار أمام محكمة جرائم الأموال بفاس

جمعيات حماية المستهلك تدخل على خط أسعار الكتب المدرسية

اعتقال بارونين وحجز طنين من المخدرات بأكادير

ديون «أمانديس» تهدد جماعات بقطع الماء والكهرباء

بنعبد الله يعبد الطريق لولاية رابعة على رأس التقدم والاشتراكية

44 سنة سجنا لعصابة السطو على ناقلة للأموال بطنجة

التحقيق في غرق تلميذ بمنتزه أقشور بشفشاون

أخنوش يرخص بإحداث شركة للفوسفاط بإسبانيا

"أونسا" يلزم الوحدات الإنتاجية بالترخيص الصحي

زيارة الحموشي للدوحة تحظى باهتمام الإعلام القطري

حجز طنين من المخدرات بعد مطاردة هوليودية بسواحل طنجة

شبكة إجرامية روعت حسابات بنكية بالبيضاء وأزمور

لقجع يحسم الجدل بخصوص تعديل قانون المالية

قنديل بحر عملاق يستنفر السلطات بشاطئ الهرهورة

المجلس الحكومي يعين المجاهدي مديرا للتعاون الوطني

حجزطن من المخدرات بالفقيه بن صالح

السطو على 40 مليونا من وكالة للقروض الصغرى بمنطقة الغرب

الأمن يوقف أبطال فيديوهات الرعب بالبيضاء وبرشيد

استياء حقوقي بعد وفاة طفلين غرقا بوزان

اختفاء تلميذة لمدة أسبوع ينتهي بسقوط عصابة إجرامية بتيفلت

نتائج الحالات المشتبه بإصابتها بجذري القرود جاءت سلبية

لفتيت يكشف ديونا استهلاكية تغرق جماعات بالشمال

عميد شرطة متقاعد بخريبكة يصفي زوجته ببندقية صيد

إيقاف خمسيني ادعى النبوة أثناء صلاة الجمعة بمراكش

وزارة الصحة تكشف خطتها لمواجهة إصابات محتملة بجدري القردة

شرطي يشهر السلاح الوظيفي بالخميسات لإيقاف جانح خرب ممتلكات عمومية

جلسة خمرية تنتهي بقتل شاب بكلميم

تحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة قاصر بطنجة

النيران تلتهم مئات الهكتارات وأشجار النخيل بزاكورة
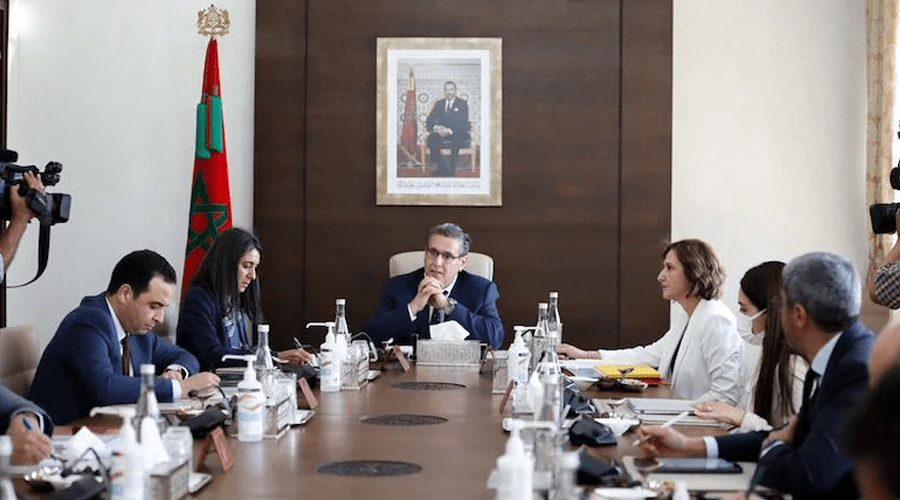
إنعاش القطاع السياحي يجمع وزراء حكومة أخنوش

العثور على جثة مشوهة لطفل بطنجة

اعتقال جانحين روعا طرقات وشوارع الناظور

10 سنوات لجانح حاول قتل شخص رفض تزويجه ابنته بطنجة

هذه هي مستجدات البروتوكول الصحي الوطني للأسفار الدولية

إلغاء شرط فحص PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية

تفكيك عصابة متخصصة في تزوير الأوراق المالية والدبلومات

المغرب يتجه لتعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة

قتيل وجرحى بسبب موقف للسيارات بطنجة

البحث في مصرع أستاذ برحلة صيد ضواحي تطوان

حادثة سير خطيرة داخل نفق بني مكادة بطنجة

الكلاب الضالة تواصل حصد الأرواح بمراكش

انطلاق عملية التجنيد للخدمة العسكرية بعد عامين من التوقف

وزارة التجهيز تقر بالوضعية بعد استمرار حوادث السير المميتة

اعتقال شرطيين وموظفة بولاية مراكش بتهمة التزوير

هيئات الصحافيين المغاربة تدين بشدة جريمة اغتيال شيرين أبوعاقلة

إيداع ستيني بتيفلت السجن لأجل التغرير بقاصر وهتك عرضها

إجهاض محاولة إغراق بني مكادة بطنجة بـ«القرقوبي»

الأمن يشهر السلاح الوظيفي لإيقاف جانحين هددا مواطنين

الملك محمد السادس يدعو إلى تحالف إفريقي لمواجهة الجفاف

تنامي سرقة الأسلاك النحاسية يستنفر درك سيدي سليمان

اعتقال متهمين بتزوير جواز التلقيح لاجتياز مباراة أمنية بطنجة

وزير الخارجية الإسباني :"نحن في حاجة إلى تعاون المغرب

سقوط سيارة في منحدر بكورنيش سلا ونجاة راكبين بأعجوبة

مفتش شرطة بالقنيطرة ينهي حياته بمسدسه الوظيفي

غلاء المواد الغذائية يثقل كاهل الأسر بطنجة

الذبيحة السرية واللحوم الفاسدة تغزو أسواق مراكش

سرقة سائحتين أجنبيتين بمراكش تنتهي بحادثتي سير خطيرتين

اعتقال طلبة بالرشيدية بتهمة احتجاز وتعذيب زميل لهم

الرصاص الحي لإيقاف تاجر مخدرات هدد أمن تاركيست باعتداء خطير

استنفار لإيقاف شقيقين اعتديا على عناصر الوقاية بالهرهورة

إطلاق الرصاص ببرشيد لإيقاف جانح

مطالب بزيادة خطوط جوية بمطار الحسيمة

بنايات آيلة للسقوط تستنفر ولاية جهة الشمال
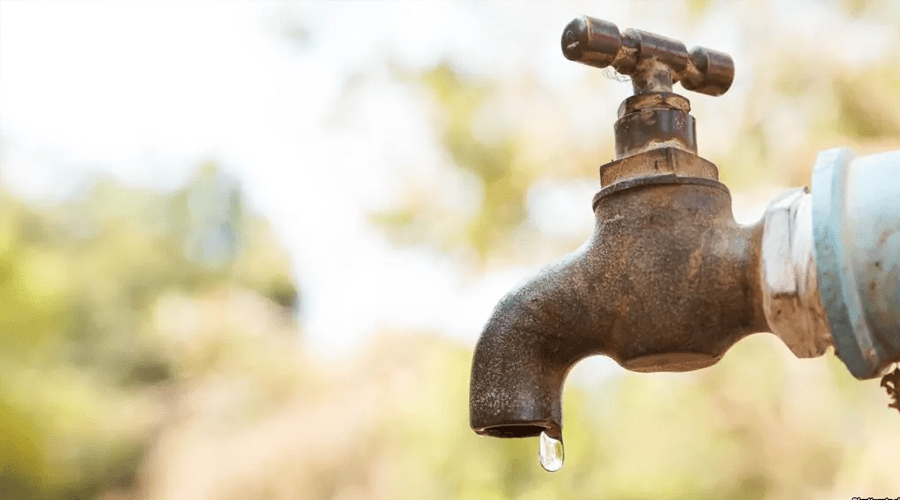
استمرار انقطاع الماء الشروب بطانطان يزعج السكان

مطاردة شرطي لدراجة نارية بالدار البيضاء تنتهي بانقلابها

إيقاف 416 مروجا للمخدرات خلال رمضان بمراكش

مصرع أسرة بحادثة سير مروعة بنواحي شيشاوة
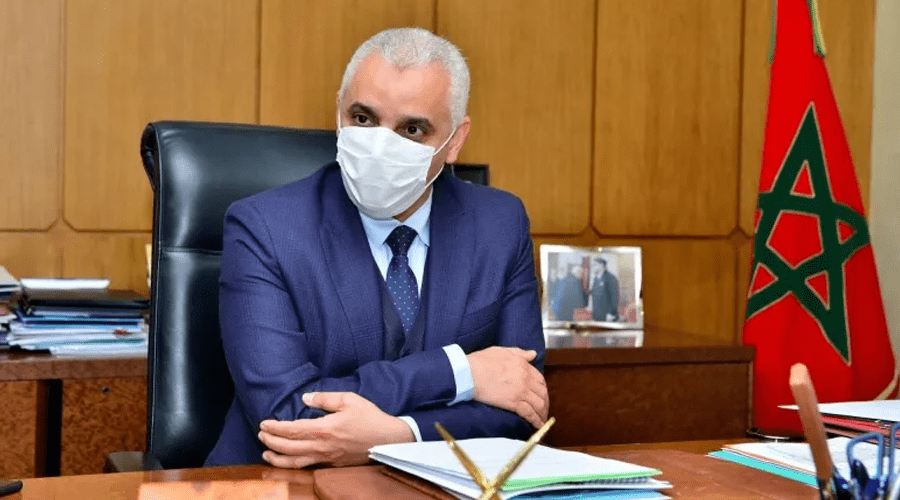
أيت الطالب يضع نهاية لـ«الكريساج» بالمستشفيات العمومية

سكان بمراكش يعانون بسببالعربات المجرورة والباعة المتجولين

جانح يهاجم سياحا ويطعن عنصرا بالقوات المساعدة بسلاح أبيض بتغازوت

اعتصام مطرودين من وحدة فندقية بمراكش

الشيخات بين الأمس واليوم

تفكيك شبكة تستهدف المهاجرين السريين بطنجة

عدد زبناء "اتصالات المغرب" بلغ مايقارب 76 مليون زبون حتى متم مارس

الأساتذة المتعاقدون يعلنون خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام
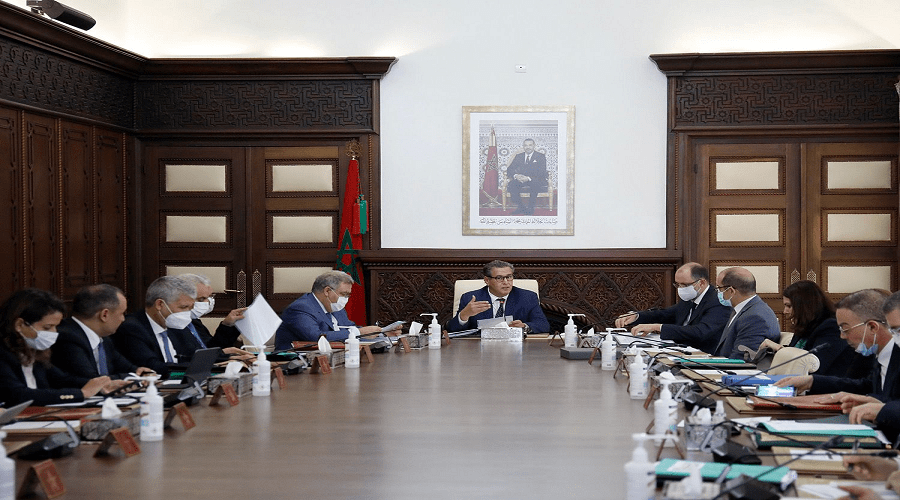
لجنة الاستثمارات تُصادق على 15 مشروعا استثماريا بقيمة 10.8 مليار

المغرب ورؤساء فرنسا
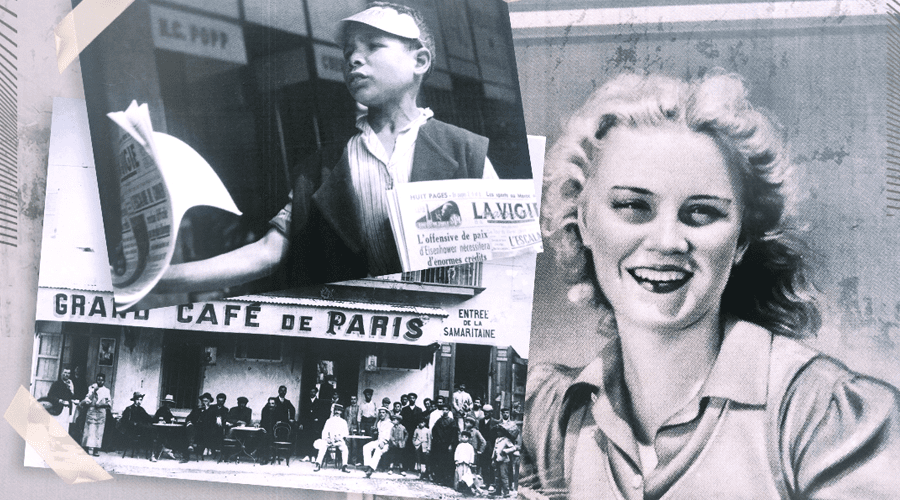
هكذا بدأ سوق الإشهار المغربي.. من اللافتات إلى وصلات التلفزة

أخنوش يتفقد سير أشغال برنامج التنمية الحضرية لأكادير

فضيحة الجنس مقابل النقط تطيح برئيسة جامعة سطات

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

«القاتل الصامت» ينهي حياة خمسة أفراد بسلا

طارق السجلماسي: مجموعة القرض الفلاحي ظلت وفية لمهمة دعم العالم

الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد

بتعليمات ملكية.. تدشين مركز للقيادة والتنسيق لتدبير المهام

موظفة تعترض موكب وزير الصحة بطنجة

أزيد من مليون و641 ألف مستفيد غير أجير من نظام التغطية الصحية

إفطار ملكي على شرف رئيس الحكومة الإسبانية ومدريد تؤكد أن المبادرة

إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدي

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشي

إيداع خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال مندوب شركة دولية سجن العرجات

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية

«تيلي ماروك » تنشر تفاصيل التهم الخطيرة الموجهة للجراح التازي

ارتفاع أسعار المحروقات يربك التنقل بطنجة

المغرب يتهم العفو الدولية بقيادة حملة ممنهجة

اعتقال التازي وزوجته وشقيقه بتهمة النصب والتزوير

تأييد إعدام سفاح الملاح معذب وقاتل حنان

انتحار شرطي سابق داخل فندق بسوق الأربعاء الغرب

الحافظي يتفقد ظروف اشتغال المحطة الحرارية الجديدة بجرادة

غياب أطباء التوليد يربك الولادة بمستشفى طانطان

التحقيق في مصرع شخص بقناة للمياه العادمة بالنواصر

تفتيش محل تجاري ينتهي بقائد وسيدتين بمستعجلات تمارة

حملة ليلية ضد تجار المخدرات بطنجة

هؤلاء موظفي وزارة الصحة المتابعين في فضيحة الصفقات

حملة تحسيس ضد الاعتداء على ممتلكات الجماعة بكلميم
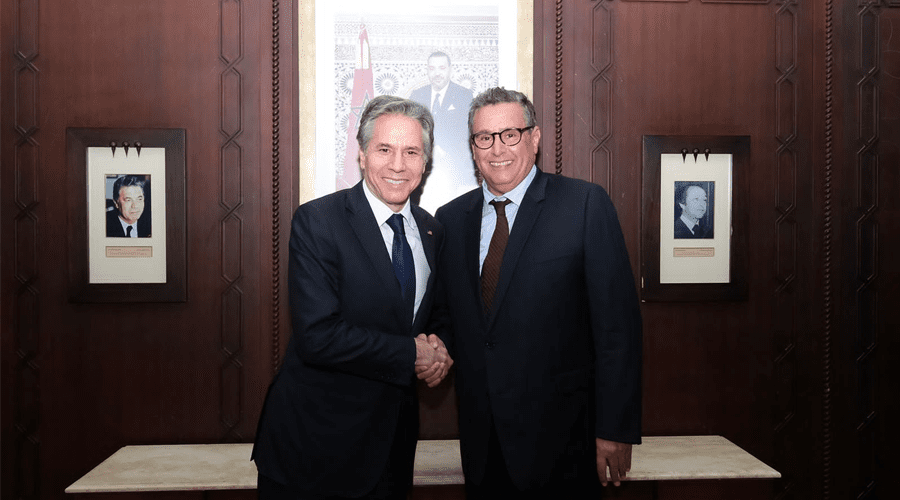
ملفات سياسية واقتصادية على طاولة مباحثات أخنوش وبلينكن

زورق سريع بشاطئ المضيق يستنفر السلطات

إيقاف نصاب خطير يستهدف النساء بمراكش

الإعدام لمتهم بجرائم قتل متسلسل بالريف

مطرح عشوائي للنفايات على بعد أمتار من مطار الرباط سلا

الحبس لمصري انتحل صفة ديبلوماسي بمراكش

الحموشي يعين نور الدين جبران نائبا لمدير الاستعلامات العامة

طعن سائح فرنسي حاول اقتناء مخدرات بمراكش

حجز 300 كيلوغرام من المخدرات واعتقال 9 بارونات بتسلطانت

أمن الناظور يوقف جزائريا متخصصا في تزوير الأوراق المالية

تذمر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمراكش

فوضى الشغب والتخريب تنتقل إلى ملعب «أدرار» بأكادير

أمن طنجة يوقف متهما بقرصنة المكالمات الدولية

دركيون أمام جرائم الأموال لأجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات

أعضاء يثيرون تقارير للحسابات بخصوص مشروع سكني بأصيلة

احتجاج العشرات ضد انفجارات المقالع بضواحي طنجة

اتساع دائرة المتابعين في ملفات التعمير بجماعة بويزكارن

ارتباك بأقسام حفظ الصحة لجماعات ترابية بالشمال

«البسيج» يسقط خمسة «ذئاب منفردة» خططوا لتخريب مؤسسات الدولة

سقوط مروجين ومهربين لـ «القرقوبي» والكوكايين بطنجة

غياب البنيات التحتية يجمد تراخيص البناء بالشمال

الأمطار تعري اختلالات صفقة السوق الأسبوعي ببرشيد

مشاريع متعثرة وأخرى يطولها النسيان بالدروة

الرسوم الجبائية بسوق الجملة تغضب تجار الطماطم بمراكش

سقوط أجزاء بمحكمة برشيد يهدد المرتفقين والموظفين

مئات الكيلوغرامات من المواد الفاسدة بأسواق طنجة

عودة الملاهي ومقاهي الشيشة للاشتغال بكورنيش طنجة

المتعاقدون يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بسطات

الحموشي يحدث فرقا جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G»

أسطول السيارات يلتهم ميزانيات الجماعات بالشمال

تعليمات بتجميد البناء بمنطقة الهرارش بطنجة

ضبط حارس ومتزوجة متلبسين بممارسة الجنس بابتدائية مراكش

قاضي التحقيق يودع ضابطا وعنصرين من فرقة مكافحة العصابات السجن

التحقيق في صفقات جماعة الساحل يصل استئنافية سطات

التحقيق في قضية جنس مقابل النقط داخل ثانوية بتطوان

اعتقال جانحين بسبب اعتداء دموي على مواطن بسلا

احتجاج مهنيي النقل السياحي للأسبوع السادس بمراكش

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس توقع إتفاقية شراكة

أفران مملوكة لبرلماني تسمم حياة السكان في محيط الولجة بسلا

مكتب الكهرباء يطالب جماعة سيدي سليمان بـ800 مليون

522 مليون درهم لإنقاذ جهة مراكش آسفي من العطش

الحموشي يواصل سياسية الأيادي البيضاء بجهاز الشرطة

موثق يحتال على أزيد من 40 ضحية في حوالي 3 ملايير

مطالب بالتحقيق في طمس قضية انتخابات بسيدي رحال

تسعيرة نقل أموات المسلمين بمراكش تصل سقف 4500 درهم

أسطول النقل المدرسي يسائل ميزانيات جهة طنجة

تنقيل مستوصف حيوي بمراكش يثير غضب السكان

احتجاجات ضد جماعة أولاد سعيد الواد ببني ملال

لفتيت يحذر من عرقلة مبادرة التنمية بالشمال

الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار تتجدد بعدة مدن

رئيس جماعة يحرم 200 تلميذ من النقل المدرسي بالحوز

مصرع مسن بسبب حريق منزل في تطوان

مطالب بإصلاح أعطاب خطوط الكهرباء بضواحي طنجة
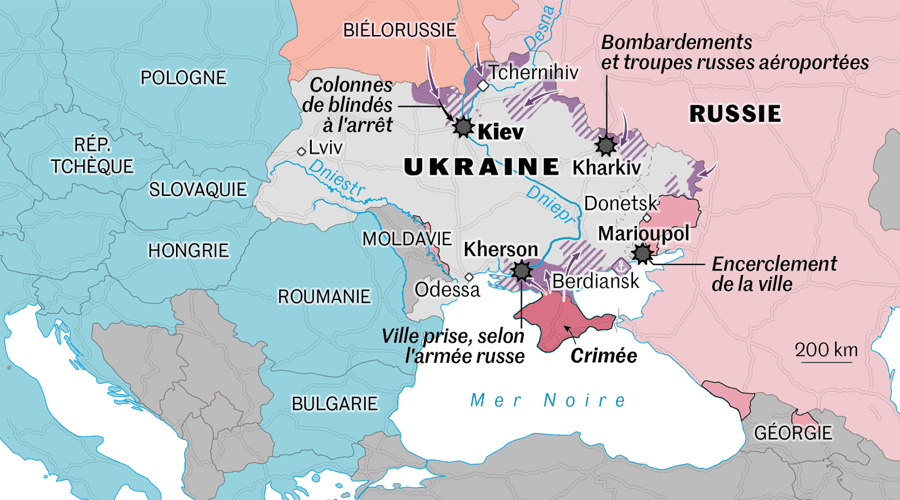
روسيا تقصف وتسيطر على أكبر محطة نووية بأوروبا
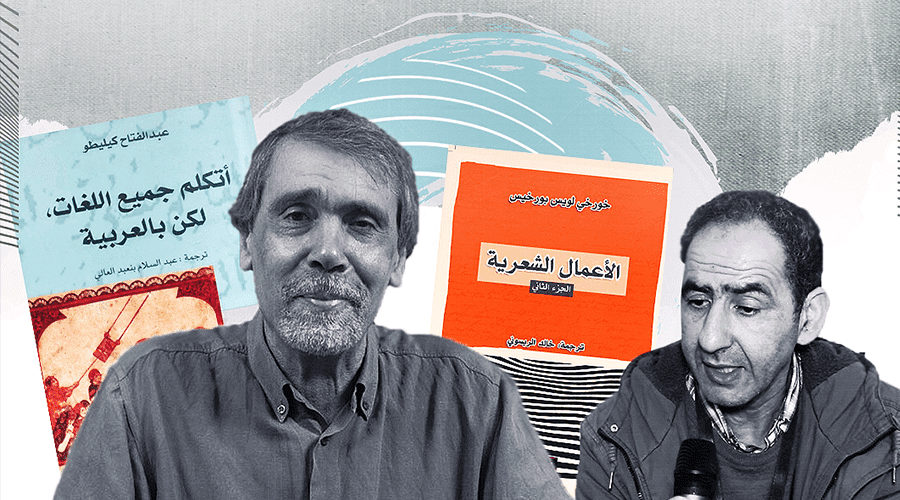
الترجمة.. تذكرة ذهاب وإياب

تفاصيل التحقيق في سرقة مستندات بجماعة مرتيل

اقتحام أربعة ملثمين لبنك يستنفر أمن برشيد

الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع التعليم والتكوين ومحاربة الأمية

قاصرون يكسرون زجاج أزيد من 30 سيارة بالدروة

جثة متحللة ببيت مهجور تستنفر أمن سلا

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الهواتف بمراكش

مخاوف من عودة فوضى سيارات الأجرة بطنجة

مختل يهاجم المنطقة الصناعية بالقنيطرة ويرسل أربعة أشخاص

المغرب يأسف للتصعيد العسكري ويقرر عدم المشاركة في قرار اعتمدته

اعتقال شابين اختطفا قاصرين إحداهما حامل بمراكش

زيادات عشوائية في أسعار الطاكسيات بجهة الغرب

الحبس لأفراد شبكة للاتجار في المخدرات بتطوان
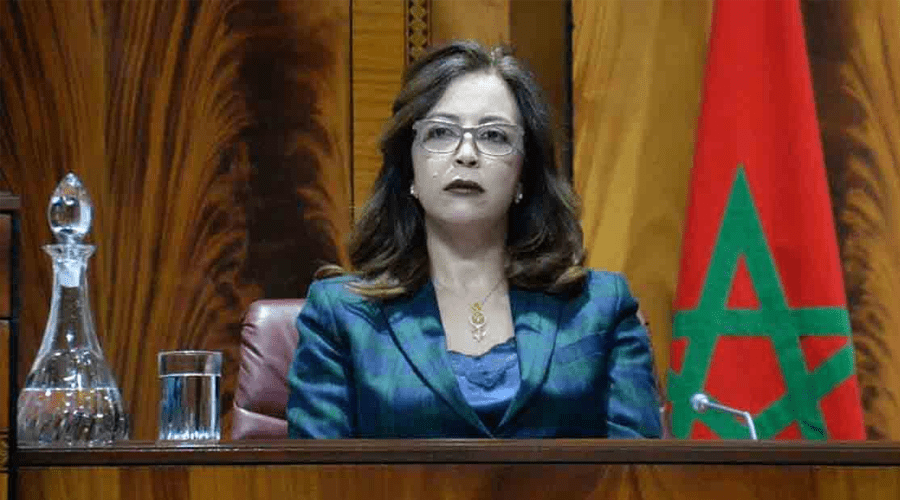
عمدة الرباط تهدد مقاهي ومطاعم بالإغلاق

التحقيق في سرقة حافلة فريق رياضي ببرشيد وإحراقها

المغرب يعلن عن انتهاء موجة "أوميكرون"

العثور على تلميذ مقتولا بغابة ضواحي سيدي قاسم

محامون مغاربة مثيرون للجدل

مصالح الحموشي تنجح في التصدي لجرائم تزوير وثائق ومعدات «كورونا»

درسان في الديبلوماسية المغربية

إيقاف مسؤول بنكي متلبسا بالبحث عن كنز بطنجة

المغرب يوافق على إجلاء الطلبة الموريتانيين مع المغاربة من أوكراني

وضع نائب رئيس جماعة بسجن كلميم

«الديستي» تجهض تهريب 9 أطنان من المخدرات إلى أوروبا وتطيح ببارون

الـCNSS : تمديد الاستفادة من التعويض الجزافي لدعم القطاع السياحي
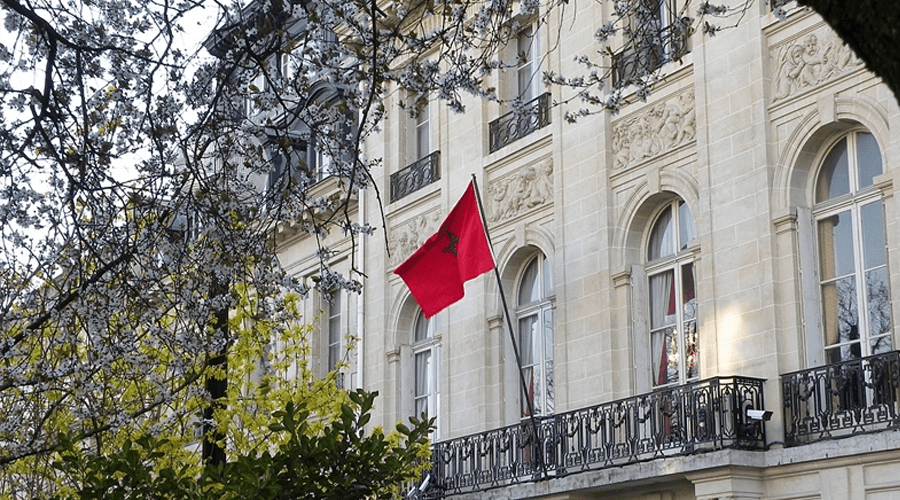
سفارة المغرب بأوكرانيا تخصص أرقاما مجانية جديدة في الدول المجاورة

حجز أزيد من 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع بسطات

بنعلي يشرع في تصفية تيار شباط بالجبهة
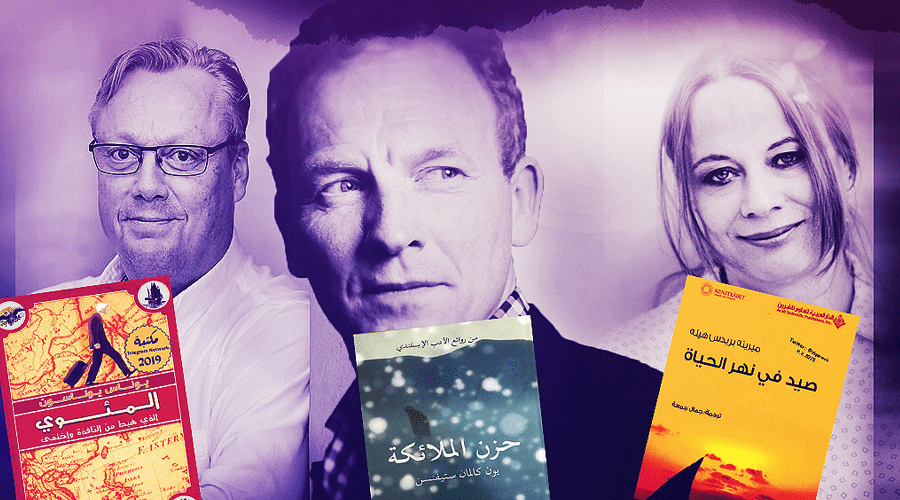
أحفاد الفايكنغ.. أدباء إسكندنافيون

سفارة المملكة بأوكرانيا تدعو المواطنين العالقين بأوكرانيا
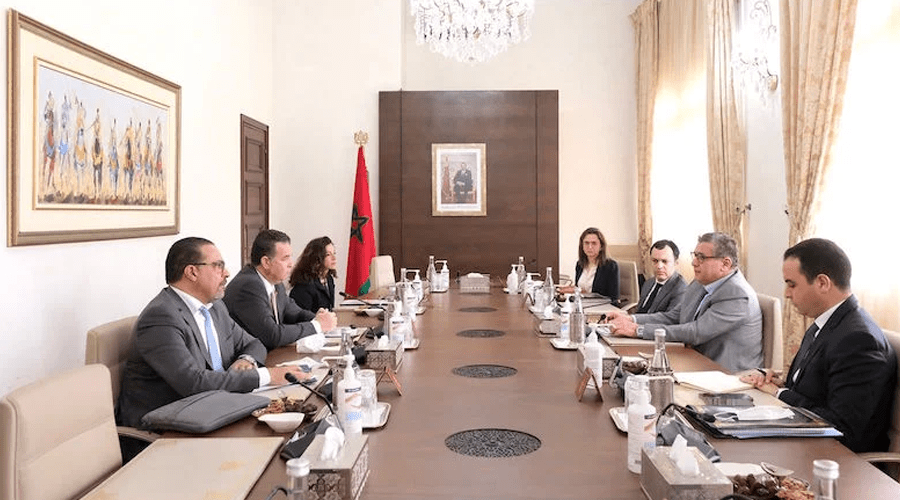
هذه هي مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

هذه تفاصيل توقيع اتفاق بين الحكومة و النقابات الممثلة في قطاع
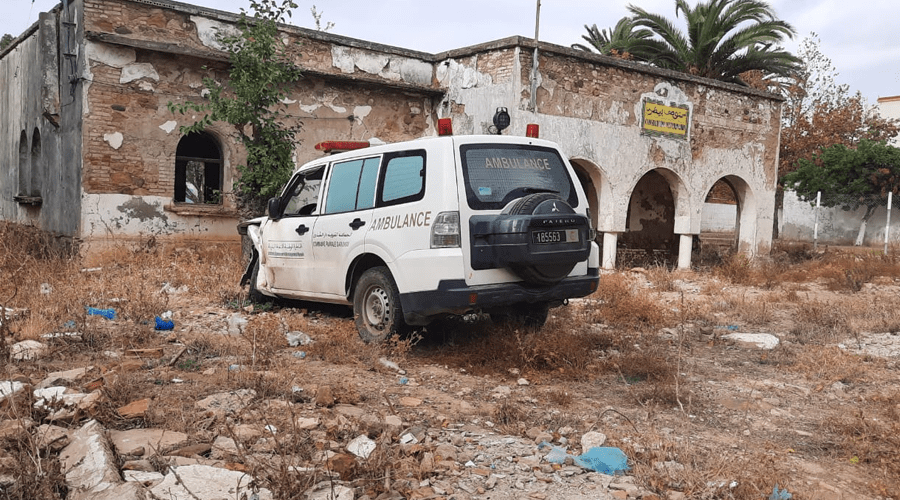
سكان يطالبون بإصلاح سيارة إسعاف بطنجة

جلسة شاي تنتهي بإحراق مساحة خضراء بكلميم

الحكومة تقرر فتح الملاعب الرياضية أمام الجماهير
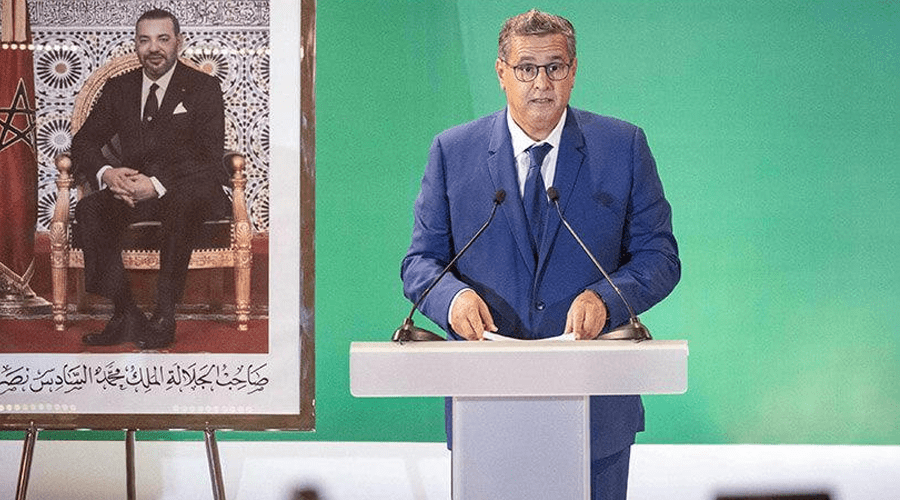
أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري حول ميثاق الاستثمار

إيقاف متهم بطعن مالك مقهى بالعرائش بالسلاح الأبيض

الماء والسلم الاجتماعي

بنعلي يجهض حلم شباط للإطاحة به من الجبهة

مطرح عشوائي يحول حياة سكان حي الرحمة بسلا إلى جحيم

الحكم على زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا

حادثة سير تفضح شبكة لـ«القرقوبي» بطنجة

حريق جديد بغابة الرميلات بطنجة يثير الشكوك
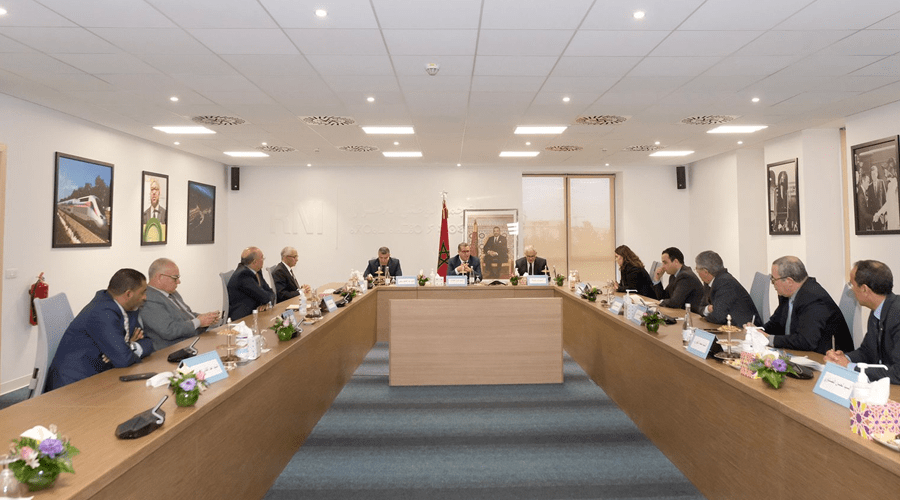
الأغلبية الحكومية تؤكد التفعيل السريع لبرنامج دعم الفلاحين
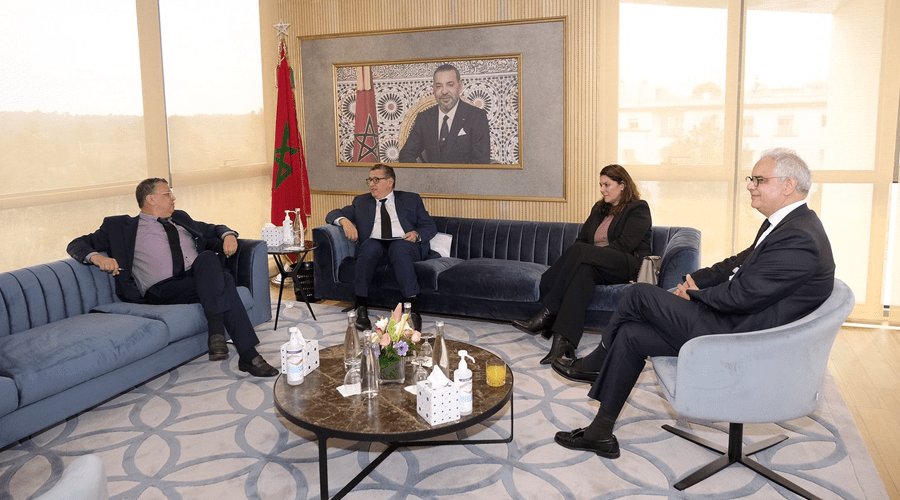
الأغلبية الحكومية تؤكد استمرار دعم المواد الاستهلاكية الأساسية
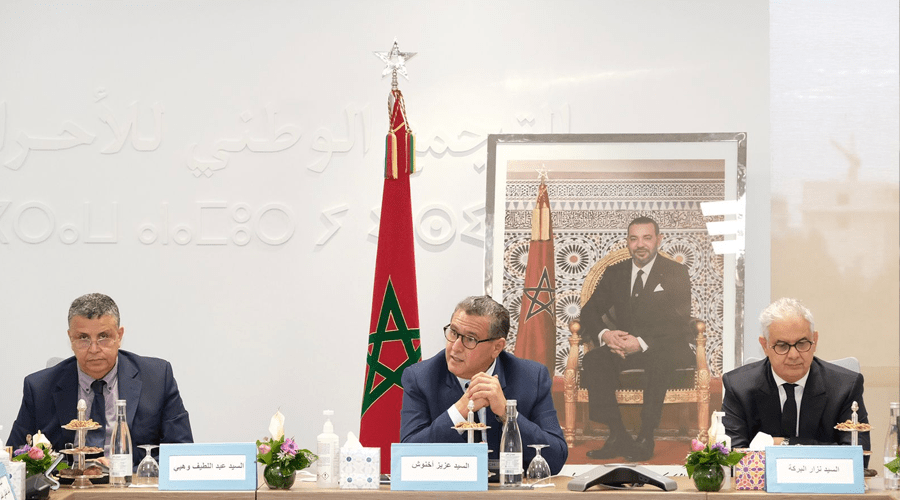
الأغلبية الحكومية تتخذ إجراءات لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائي

النصب على زبناء وكالة للقروض الصغرى بسيدي سليمان

استنفار بسبب وفاة ممرض عشريني بحديقة بمراكش

تفاصيل جديدة بخصوص التاجر المقتول بالداخلة

إيقاف متهم بإطلاق الرصاص على أربع ضحايا بوزان

الحرب المنسية في الريف
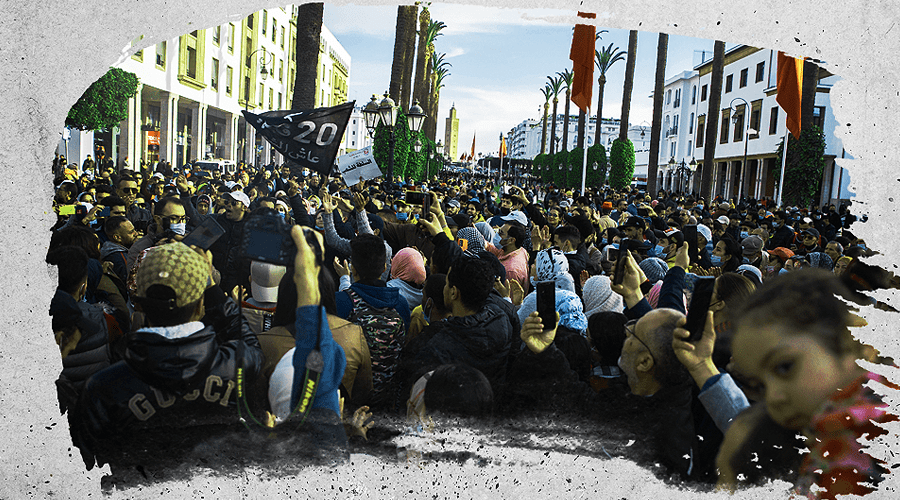
بلا تهويل وبلا تهوين

سقوط لوحات جبسية بابتدائية طنجة يثير الفزع

الديستي تطيح بشبكة لتزوير التأشيرات بمطار محمد الخامس

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدين هجوم بنكيران على الأحداث

أطباء القطاع الخاص يطالبون برفع أسعار العلاج

السلطات تنقذ عائلة ريان من نصاب من جزر القمر

لفتيت يدخل على خط مقتل تاجر بالداخلة
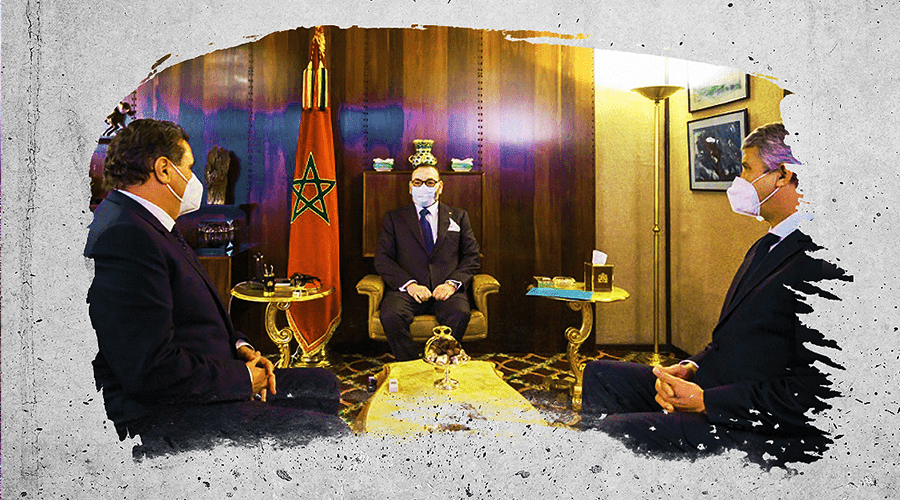
ألف مليار لإنقاذ الفلاحة
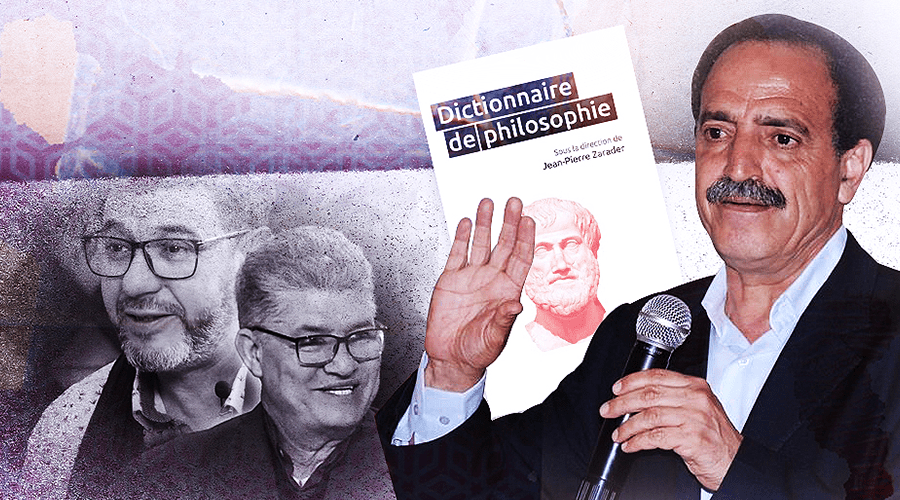
في الاتصال والانفصال بين السينما والأدب
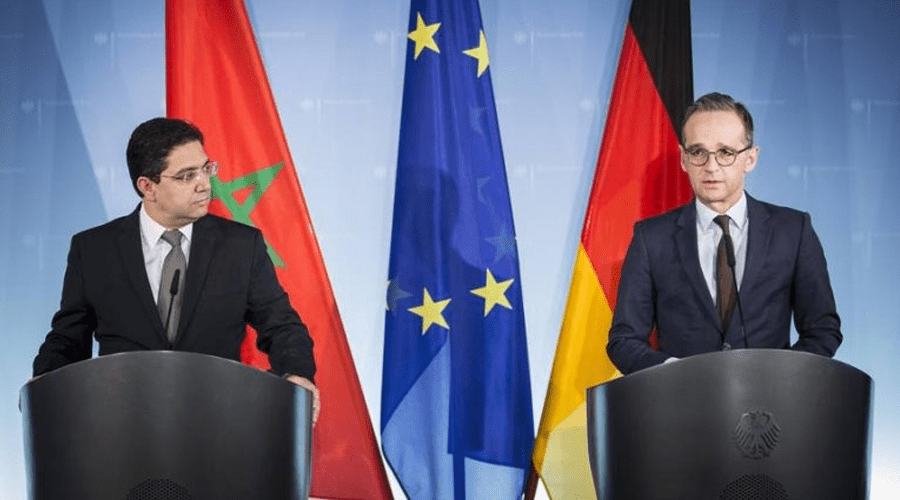
المغرب يطوي رسميا صفحة الخلاف مع ألمانيا

الملك محمد السادس يوجه رسالة قوية لقادة الإتحاد الأوروبي

أبحاث أمنية تطارد مجهولا أغرق محلات تدليك بأكدال بالدولار المزيف

بوريطة يترأس الوفد المغربي في القمة الأوروبية الإفريقية

موت المقاولات

اعتقال موظفين بإدارة الضرائب بمراكش بتهمتي النصب والتزوير

عدد زبناء اتصالات المغرب يقفز إلى أكثر من 74 مليونا
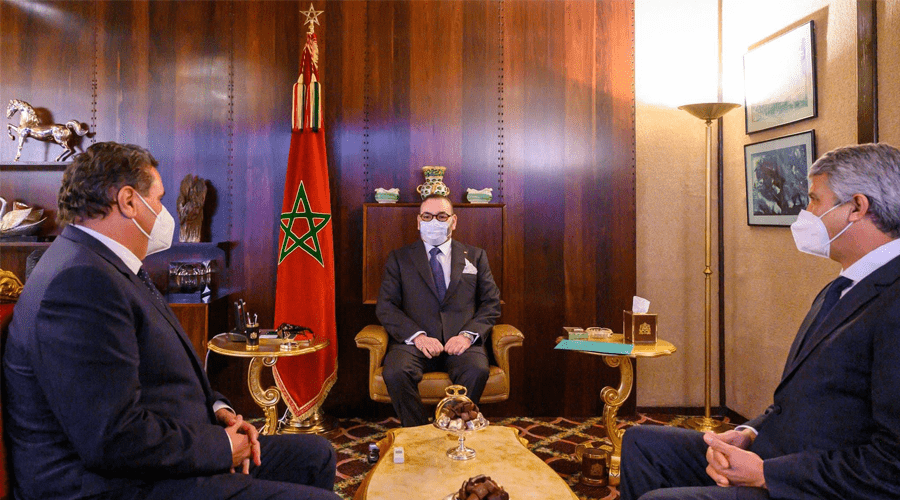
الملك يصدر أوامره بتخصيص 10 ملايير درهما لحماية المياه والثروات

إيقاف مشتبه في اعتدائهما على تلميذات بالمضيق

تدخل استباقي للديستي ينتهي بحجز 24 ألف قرص مهلوس بالناظور والبيضا

الداخلية تتهم رؤساء جماعات بارتكاب جرائم التعمير

سقوط عصابة لمستخرجي الكنوز بشيشاوة

إيقاف لص عرض سيدة للسرقة بطنجة

اعتقال أربعيني بسبب التزوير بوادي زم
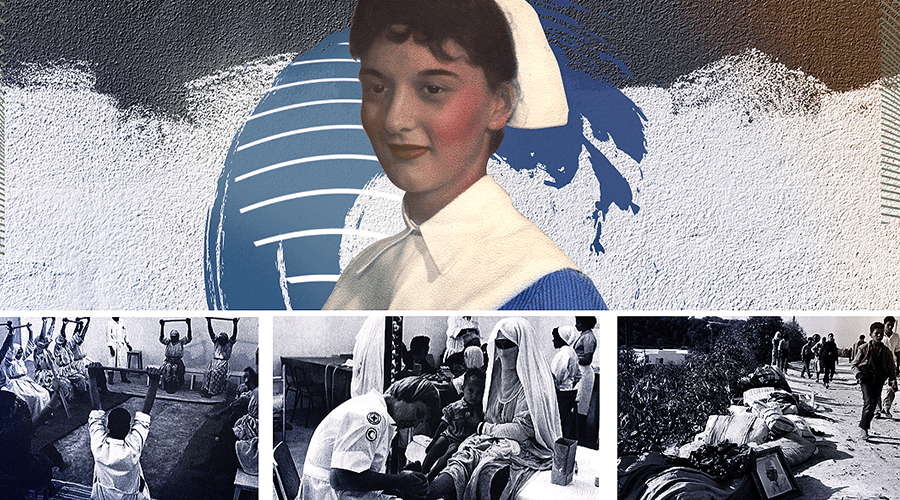
هكذا وُلدت فرق الإنقاذ المغربية

هكذا تسبب فشل مجالس بالشمال في إغراق أحياء بـ«الواد الحار»

سقوط أكبر لص للمنازل بمراكش في قبضة الأمن

استئنافية طنجة تؤيد السجن للمتهمين بقتل شقيق الريسوني

الحموشي يرسل لجنة تفتيش إلى ولاية أمن مراكش

غلاء الأسعار يخرج سكان مراكش وآسفي للاحتجاج

اعتقال تسعة أشخاص بعد قتل تاجر ورمي جثته بضواحي برشيد
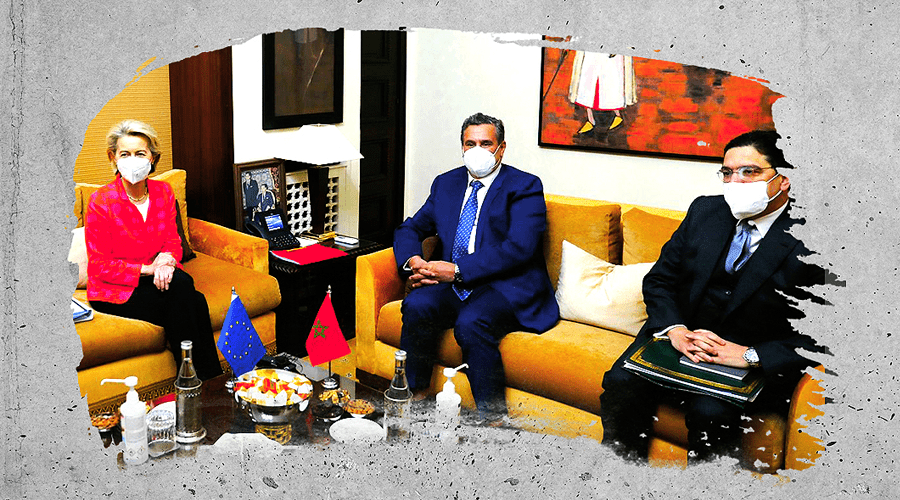
ديبلوماسية السيادة والشراكة

3 ملايين رشوة توقع عون سلطة بمراكش
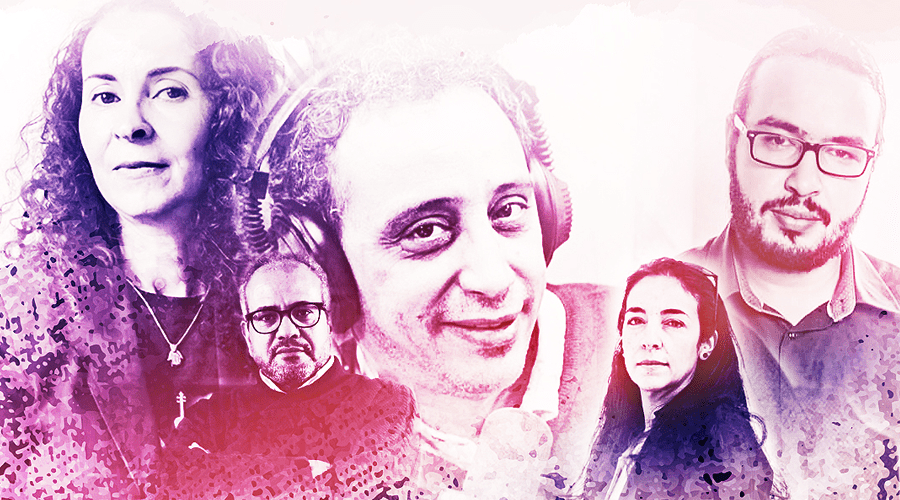
في الأدب المغربي المُهاجر

الأزبال تغرق أحياء سيدي سليمان

أمن مراكش يحبط محاولة سطو على وكالة مالية

آبارتستنفر سلطات آسفي بعد فاجعة ريان

تفكيك شبكة للهجرة السرية وترويج المؤثرات العقلية بتطوان

تفكيك شبكة للهجرة السرية وترويج المؤثرات العقلية بتطوان

استعمال السلاح لإيقاف مبحوث عنه خطير بفاس

عمال النظافة يحتجون خلال انعقاد المجلس الجماعي لمراكش

اغتصاب فتاة بالتناوب بسلا يجر عوني سلطة وقاصرا للسجن

الإتحاد الأوربي يعلن استثمار 1.6 مليار يورو في الطاقة الخضراء

حملة واسعة ضد الآبار العشوائية بالشمال

متابعة الملياردير الدرهم ونائبين له بتهم تبديد واختلاس أموال عموم

رشيد نيني رئيسا جديدا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين
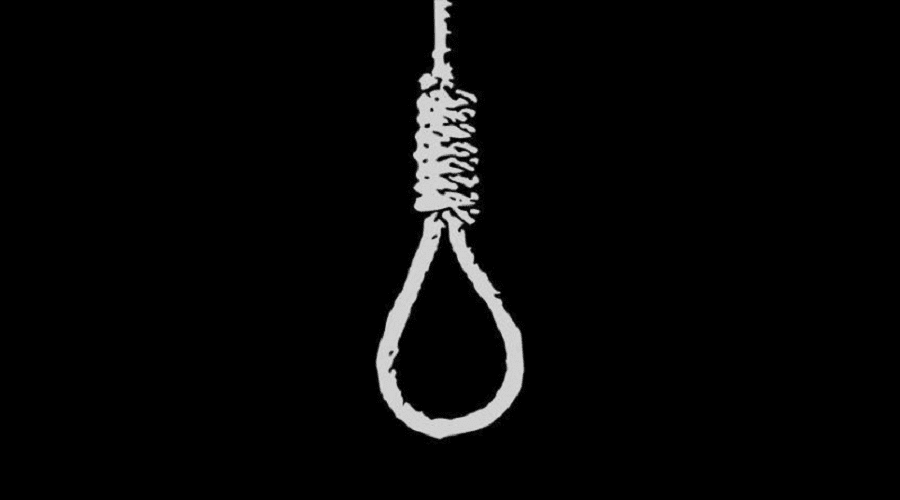
انتحار مستخدم داخل أحد أشهر فنادق مراكش

جثة متحللة لستيني تستنفر الدرك بتسلطانت

درك السوالم يحجز مليون سيجارة ونصف طن من المعسل

أمير دولة قطر يستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش

تفكيك شبكة للاتجار بالبشر أوهمت فتيات بالهجرة إلى الخليج

تشييع جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير

استعدادات على قدم وساق لجنازة الطفل "ريان" ومشيعون يحجون
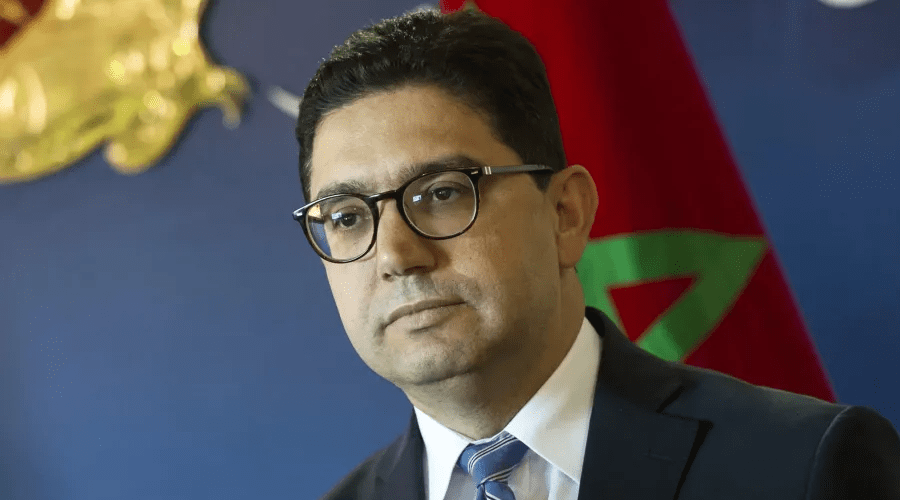
بوريطة : المغرب توقف عن متابعة التصريحات الأحادية للدبلوماسية

مذكرة دولية تلاحق تونسيا بسبب النصب ببرشيد

اعتقال محتجزي أصحاب شركة للتجارة الإلكترونية داخل «فيلا» بالصخيرا

مسؤول التواصل يؤكد أن الوقاية المدنية بينها وبين ريان أقل من 80 س

فريق الحفر ينتهي من عمله ودخول فريق مختص لإخراج ريان

تطويق أمني لمكان الحفر لقرب إخراج ريان

نجاح فرقة الإنقاذ في التعامل مع الصخور وكاميرا تظهر وريان مستلق

درك الفقيه بن صالح يفك لغز جثة قرب مستودع

إحضار حواجز حديدية لتنظيم الحشود والمزيد من القنوات

إدخال الأنابيب لحماية فرقة الإنقاذ وقرب الوصول لمكان ريان

حادثة سير خطيرة بمكان إنقاذ ريان

توقف الآلات عن الحفر ودخول فرق الإنقاذ النفق لإنقاذ ريان

عملية إنقاذ ريان من البئر تدخل يومها الرابع

استياء من انتشار الكلاب الضالة بأحياء بوسكورة

شاب يقتل صديقه القاصر بآسفي ويخفي جثته

إحباط محاولة تهريب نصف طن من المخدرات بطنجة

تخريب مشروع للمبادرة بوزان يسائل الجهات الوصية

أخنوش يستنفر الإدارات والمؤسسات العمومية للالتزام بجميع الإجراءات

تفكيك عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية والسيارات بمراكش

احتجاج عاملات «الكامبا» بطنجة يصل البرلمان

وزارة الصحة تكشف أسباب نقص الوسائل الطبية بطنجة

أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لمقتحم حمام النساء بمراكش

مضطرب نفسيا يذبح رضيعة أخيه بشفشاون

حريق بمستودع لـ«الحفاضات» بضواحي برشيد

جريمة الاغتصاب الجماعي لأم وبناتها بضواحي سلا أمام جنايات الرباط

اندلاع حريق مجهول بغابة الرميلات بطنجة

تبخر مشروع لملاعب القرب بضواحي طنجة

المؤبد لقاتل طبيب عام بطنجة

تخريب موقعين أثريين بمدينة طانطان

انفجار خزان للبنزين يفضح محطة سرية بطنجة

الكتب المغربية الأكثر مبيعاً

وكيل الملك ببرشيد يحذر من الجريمة الجمركية

الملك يترأس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع لقاح كوفيد-19

اعتقال قاصرين نفذا عملية سطو خطيرة بمقر جماعة تمارة
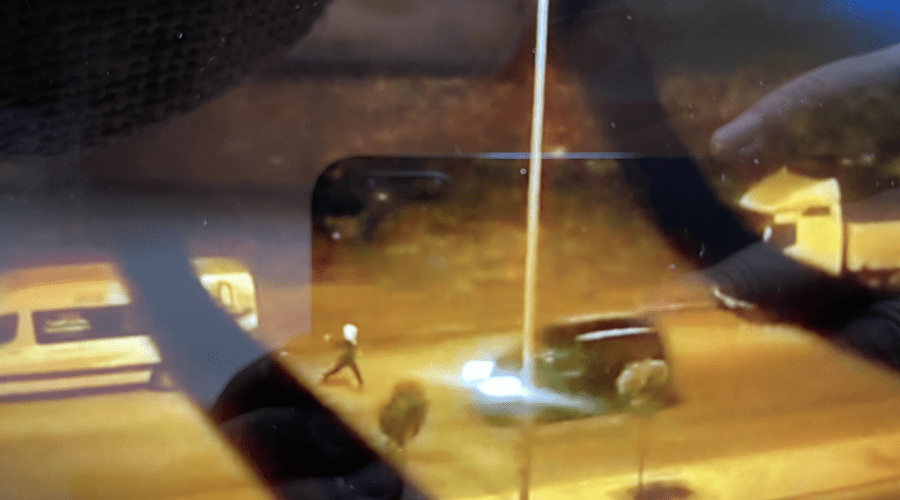
ملابسات هجوم عصابة على المواطنين ليلا بالبيضاء

جدل إغلاق الحدود يصل البرلمان وبوريطة يكشف التفاصيل

موجة البرد تفاقم معاناة المتشردين بالقنيطرة

تأجيل محاكمة راعمتهم باغتصاب قاصر بتارودانت

استنفار بعد دهس دركي بنقطة مراقبة ببرشيد

إيقاف منتحل صفة عامل بوزارة الداخلية بالقنيطرة

فضيحة زنا محارم غير مسبوقة تتفجر بالخميسات

إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة بطنجة

احتجاج عمال شركة «أوزون» بسيدي رحال

تراكم الأزبال بعدد من شوارع طانطان

سنة حبسا لمستخدم اتهمه برلماني بسرقة البيض

الصندوق الأسود للأحداث الدامية للمقاومة وجيش التحرير

انطلاق جلسات قضية "الجنس مقابل النقط" بطنجة

التحقيق في مصرع شخص بمنطقة الشلال بتطوان

أمن الفنيدق يفك لغز اختفاء تلميذة قاصر

إيقاف مالك مقهى حاول إرشاء عميد شرطة بالدار البيضاء

إيقاف نصاب يحمل 30 جواز سفر مزورا بمراكش
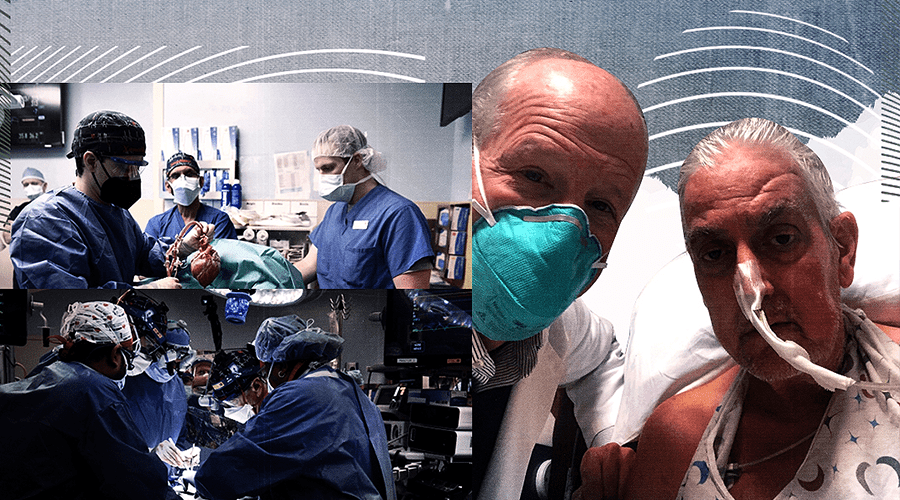
هكذا تمت أول عملية زراعة قلب خنزير بجسد إنسان

التحقيق في اختفاء غامض لتلميذة بتطوان

مربو التعليم الأولي يحتجون ببني ملال

اعتقال موظفة نصبت على 60 مهاجرا بمراكش

مواجهة ساخنة بين المنصوري وبرلمانية الحركة
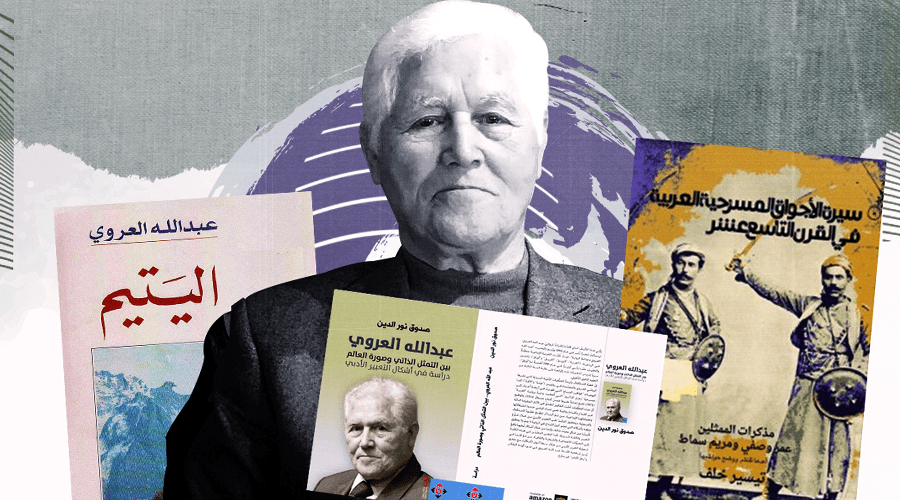
الكتابة الروائية عند العروي اختيار وضرورة
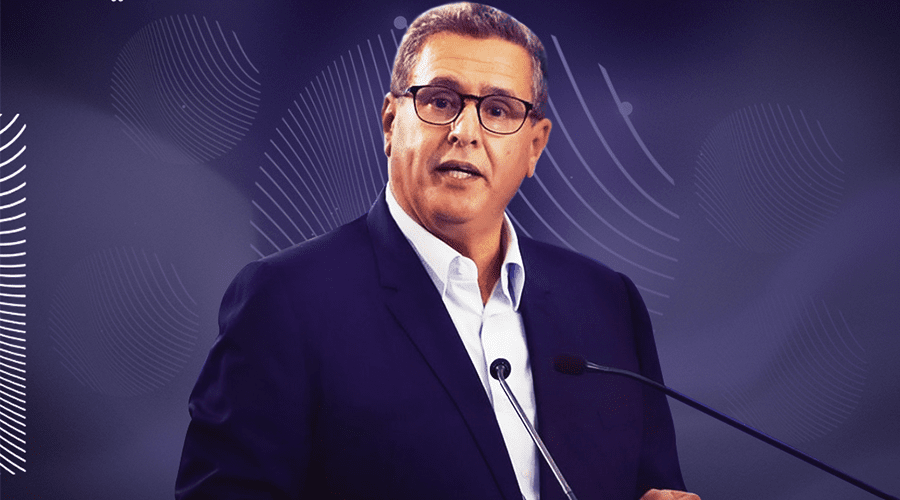
أخنوش وحصيلة 100 يوم

اعتقال أربعيني روع المنشآت العامة بسلا الجديدة بالسرقات

أمن طنجة يكثف من حملاته بحي بوخالف
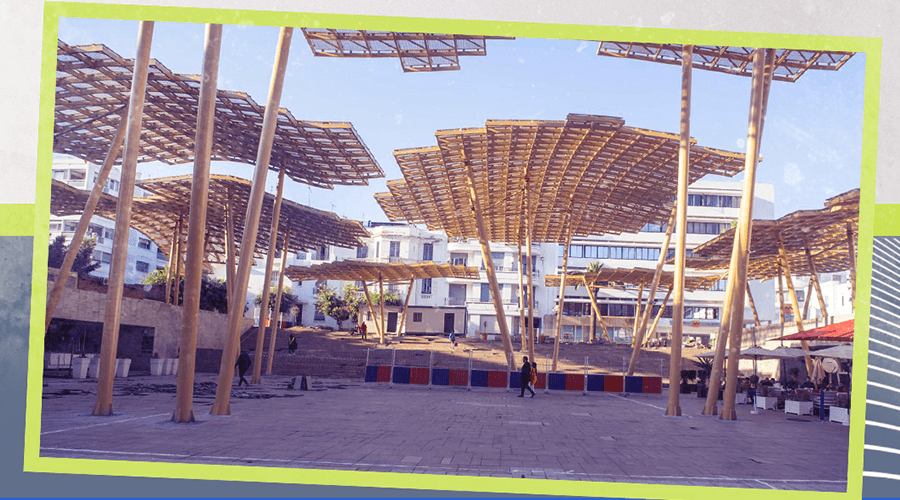
تأخر تأهيل «بلاص بيتري» بالرباط يكبد «سيديجي» خسائر بالملايين

مقتل تلميذ على يد زميله بسيدي قاسم

استدعاء المتهمين في ملف متابعة إدعمار بالتزوير

اعتقال موثقة متهمة بالسطو على ودائع زبنائها بمراكش

دراسة أمريكية: القنب يمكن أن يحمي من كورونا

سقوط عصابة متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة

مطالب بزيادة عدد حافلات النقل الحضري بالقنيطرة

نقص الأدوية يشعل الخلاف بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة

التحقيق في اتهام زوج بإحراق بيت زوجته بتطوان

جزار مسلح بسكين يقتحم حماما للنساء بمراكش
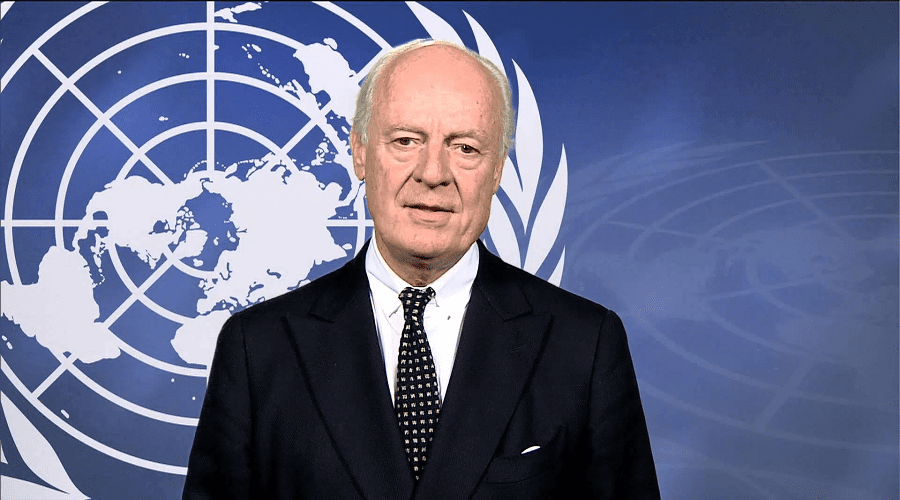
دي ميستورا يواصل جولته بالمنطقة بدعم وإشادة أمريكيين

حبس مستشارة ومزودها بالمخدرات بتطوان

اعتقال جانحين اعتديا على شرطي بسيف في سلا

حجز 15 طنا من الأكياس البلاستيكية ببرشيد

اتفاق للمجهزين والمصنعين يرفع ثمن السردين الصناعي

5 سنوات سجنا للمتهم باغتصاب «معاقة» بطنجة
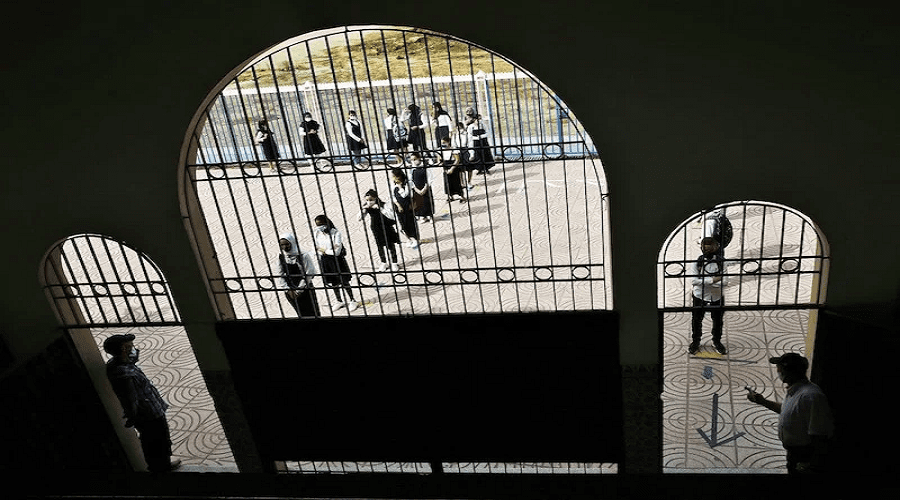
إغلاق مؤسسات تعليمية بطنجة بسبب كورونا و «أوميكرون»
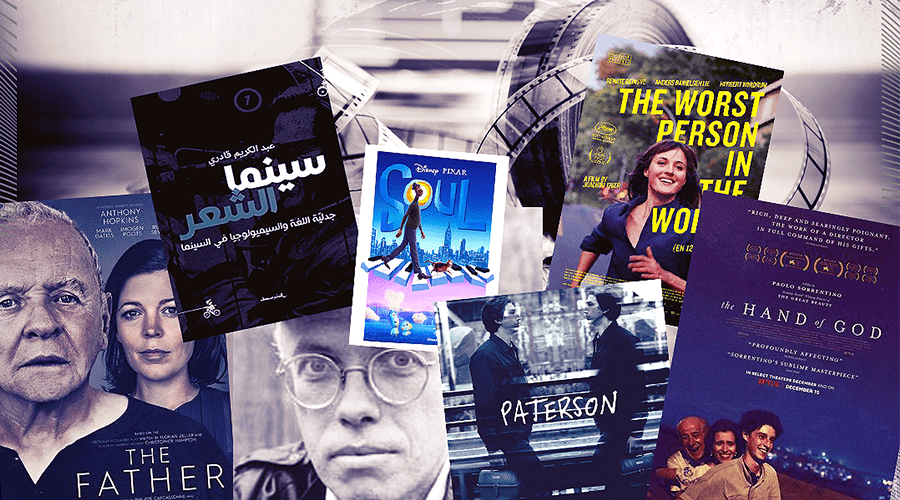
السينما في الضفاف الأدبية

أخنوش يعلن التزام الحكومة باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية
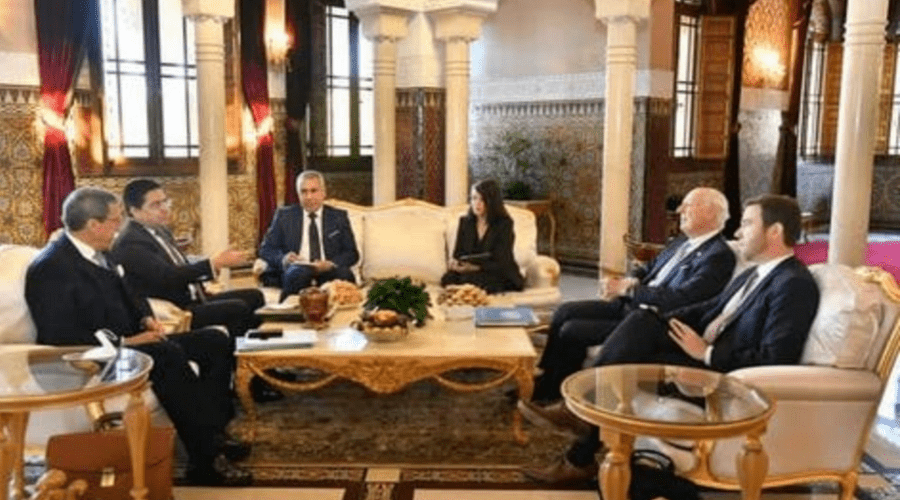
بوريطة وهلال يلتقيان دي ميستورا بالرباط

الإطاحة بأخطر محترف للنصب والاحتيال بمراكش

اعتقال مستشارة جماعية بتطوان في قضية مخدرات

الأمن ينجح في إيقاف كل المتورطين في أحداث السبت الأسود بالرباط
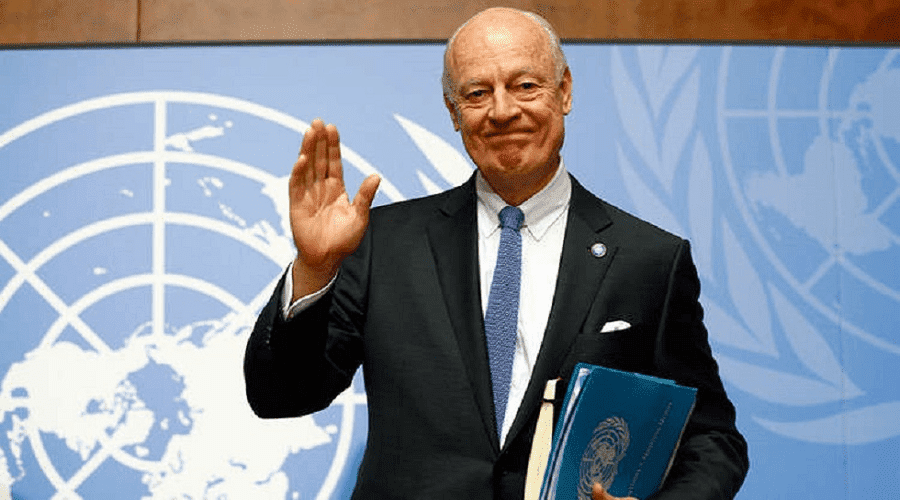
دي ميستورا يفتح ملف الصحراء بجولة للمنطقة

الحكم بتعويض خليجي ضحية ابتزاز جنسي

سنتان حبسا نافذا لمسؤول مالي بالتعاضدية العامة للموظفين

متابعة مستشار سابق عن «البيجيدي» بالتشهير بتطوان

توقيف مؤقت للزيارة العائلية للسجناء بسبب كورونا

20 سنة سجنا لقاتل مسؤول ترابي بطنجة
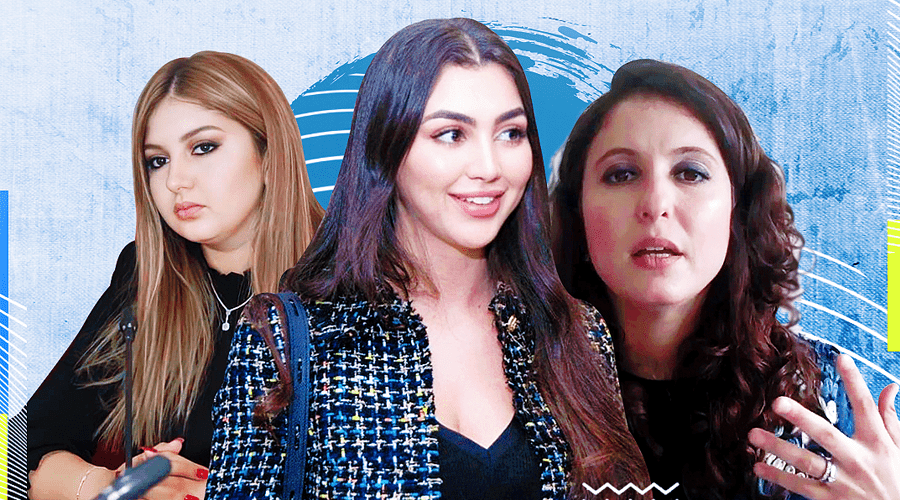
حسناوات السياسة

حراس يستخلصون بالقوة واجبات ركن السيارات بأكادير

أربعة أشهر حبسا لشرطي بتهمة السرقة بالرباط

الحبس النافذ لمتهمين بتزوير شهادات طبية بسطات

مداهمات أمنية لمقاهي «الشيشة» بطنجة

تفكيك شبكة حوادث السير الوهمية بالبيضاء

100 درهم رشوة تطيح بموظفة بآسفي

شرطي وممرض ضمن شبكة للمخدرات والتزوير بالقنيطرة

5 سنوات سجنا لصاحب حانة بسبب الاتجار بالبشر

مجلس المنافسة يرفض قانون حكومة العثماني بشأن الغاز

حجز لحوم فاسدة في شاحنة بين مراكش والرحامنة

اعتقال مهرب وحجز 70 كيلوغراما من المخدرات بمراكش

استنفار بسبب بؤرة لكورونا بمدرسة «ENSA» ببرشيد

الديستي والأمن يفكان لغز جرائم سرقة بالبيضاء والمحمدية

اعتقال موظفة بتهمة اختلاس أموال بنك بسلا

أخنوش يكشف بالأرقام نجاح مخطط المغرب الأخضر وبرنامج تقليص الفوارق

اعتقال متورطين في نبش قبر ميت بالقنيطرة

محاولة جديدة للسطو على وكالة بنكية بطنجة

استئنافية تطوان تنظر في ملف شبكة للابتزاز

تساقطات دجنبر تنعش سدود جهة طنجة

العثور على جثة مسؤول بنكي بمرحاض منزله بطنجة

إحباط محاولة إغراق مراكش بـ«القرقوبي»

حريق يلتهم مئات النخيل بواحة تمنارت بطاطا

إيقاف بارونات حاولوا تهريب نصف طن من المخدرات بالعيون

أشخاص عاديون نجوم في 2021

17 شهرا لمتهمين بالابتزاز بصور إباحية فاضحة

إيقاف مستشار جماعي بتطوان متهم بتزوير تنازلات بالملايير

تجار سوق الصالحين بسلا يطالبون بالترحيل
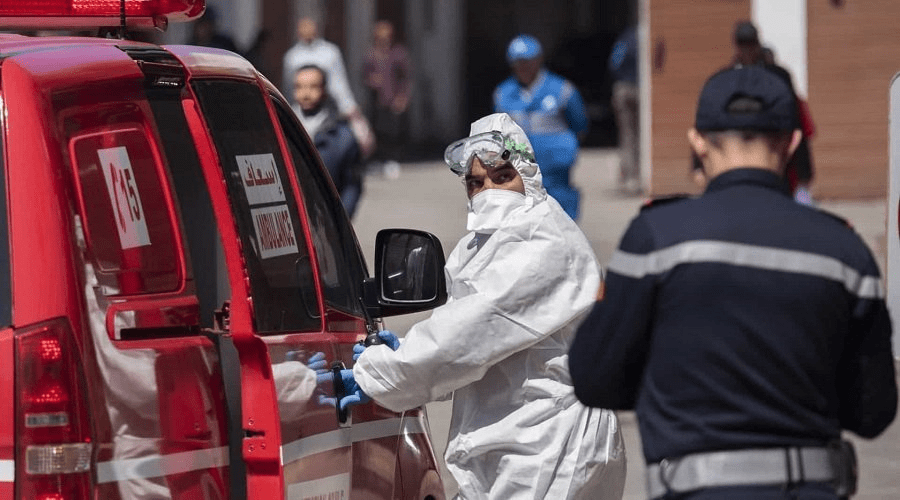
تسجيل 65 إصابة ببؤر مهنية يستنفر سلطات تمارة

التجمع الوطني للأحرار يشيد بالمواقف الخليجية من الوحدة الترابية

حريق سوق الناظور يسائل شروط السلامة بأسواق الشمال
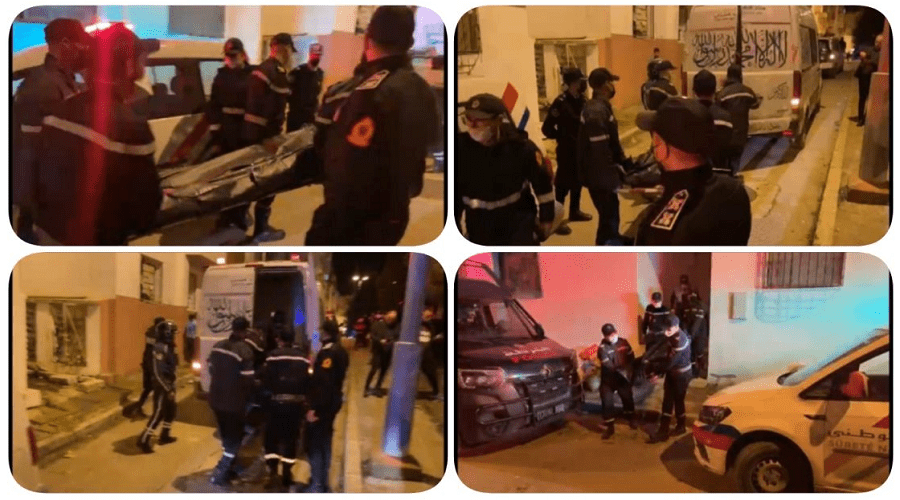
غاز البوتان يودي بحياة أربعة أشخاص بطنجة

تفكيك شبكة تتزعمها فتاة تستهدف رجال الأعمال بمراكش

الإطاحة بزعيم شبكة الاتجار بالبشر بسيدي سليمان

عجز مائي كبير بسدود جهة سوس ماسة

إيقاف منتحل صفة محام بابتدائية برشيد

كلب مسعور يتسبب في وفاة طفلة بالحوز

استمرار احتجاج المحامين بطنجة على جواز التلقيح

عائلة بن بركة ترد على "الغارديان" وتدحض رواية "الجاسوسية"

الحموشي يصرف 170 مليونا لموظفين بالشرطة وذويهم

ابتزاز خليجي بصور إباحية يجر شبانا إلى القضاء

مندوبية السجون تستعد لإغلاق سجن طنجة

الدرك يكشف حصيلة تدخلات 2021 بجهة مراكش

هل كان بنبركة جاسوسا؟

تأخر الأمطار بجهة مراكش يستنفر الحكومة

أول متهم بـ"شبكة بارونات طنجة "أمام ابتدائية أصيلة

الإطاحة بشبكة خطيرة لترويج الكوكايين بمراكش

الشذوذ وراء قتل تاجر ونقل جثته في برميل إلى تارودانت

عودة ظاهرة البناء العشوائي بضواحي مراكش
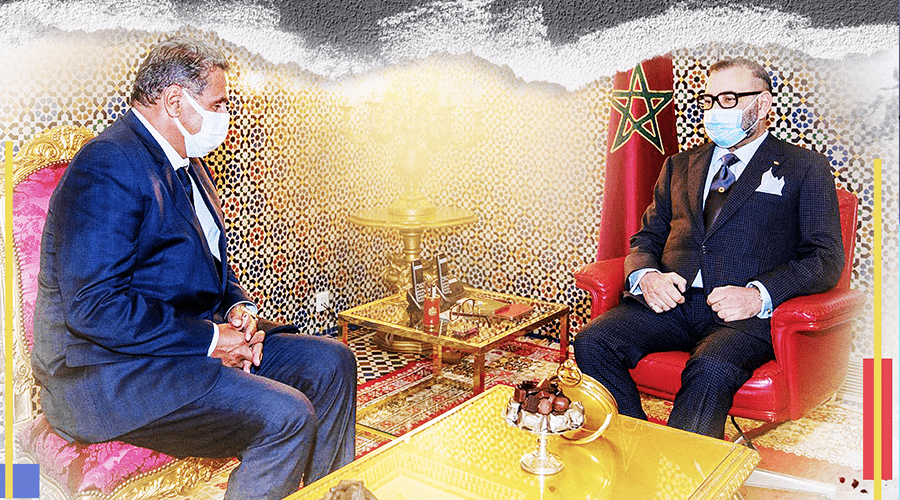
هل ستربح الحكومة رهان تنزيل الحماية الاجتماعية؟
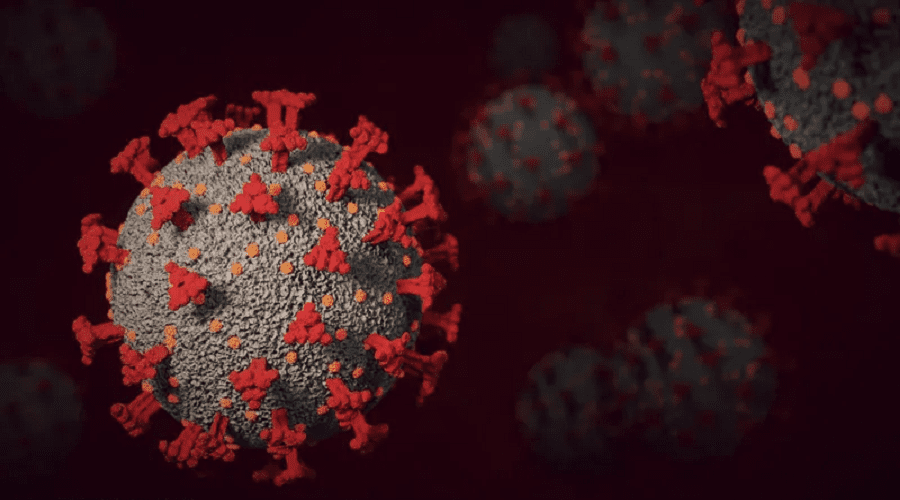
«أوميكرون» يستنفر سلطات مدينة العيون

الحكومة تخرج قانونا جديدا حول تحديد آجال الأداء لفائدة المقاولات

إيداع ثلاثيني السجن بتهمة اغتصاب تلميذة معاقة

عملية نصب ضخمة بعقود وهمية بطنجة
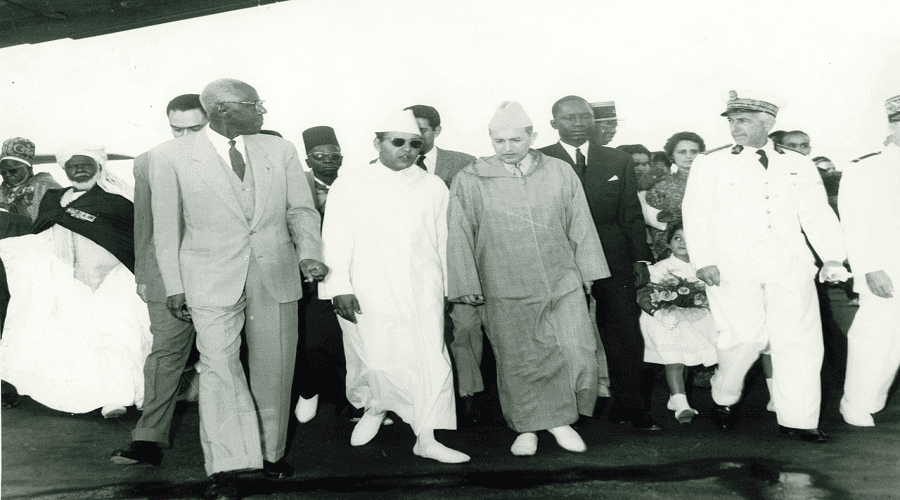
التاريخ المنسي للعلاقات بين الرباط وداكار منذ 70 عاما

تفاصيل قتل مسن بالبيضاء ونقل جثته في برميل إلى تارودانت

الابتزاز الجنسي يطيح بخمسة أشخاص بطنجة

حملة أمنية ضد تجار المخدرات بمراكش

المجلس الأعلى للتعليم يكشف عيوب نظام البكالوريوس

ولاية أمن طنجة تتعزز بفرقة للمتفجرات

اعتقال متهم بنهب الرمال خلال جلسة المحاكمة ببرشيد

الإفلاس يهدد المطاعم السياحية بمراكش والصويرة

انطلاق عملية هدم دور صفيح بالقنيطرة

«تيلي ماروك » تقتحم سجون المملكة وترصد منتوجات صنعت داخلها

تفكيك عصابة متخصصة في التزوير بالنواصر

ضبط 300 كيلوغرام من الشيرا بطنجة

احتجاجات المحامين تؤجل محاكمة بلقايد

مطالب بتتبع تدبير النقل الحضري بتطوان

إحباط تهريب حوالي طن من المخدرات بالصويرة

تفاصيل النصب على مواطنين في مليارين بسيدي سليمان

إيقاف جانحين بسبب اقتتال بالسيوف بطنجة

26 زيارة تفقدية لقضاة النيابة العامة للسجناء بمراكش

تكثيف التحقيقات في «مخدرات وأموال طنجة»

لهذااختارالمغرب البرتغال لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا

كلب مسعور يتسبب في وفاة شاب بمراكش

إلغاء نتيجة مباراة لتوظيف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس

تفكيك عصابة متخصصة في تزوير جوازات التلقيح
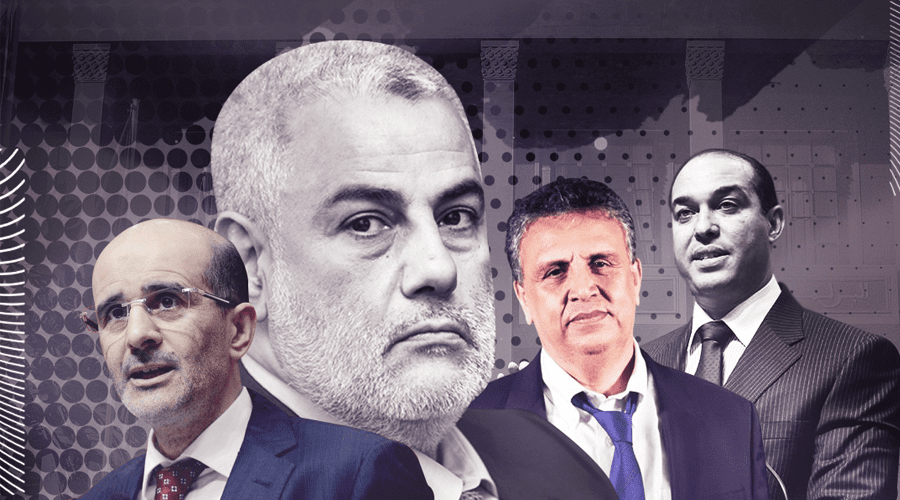
زلات لسان مسؤولين حكوميين

إحالة المتهمين بالسطو على ناقلة الأموال على سجن طنجة

السجن للمتهمين بالتزوير للسطو على عقارات فرنسي راحل بالهرهورة

الأمن يفكك عصابات متخصصة في السرقات المسلحة بالخميسات

الخارجية الأمريكية تشيد بجهود المغرب لمحاربة الإرهاب

احتجاجات عمال النظافة تهدد بإغراق مراكش في الأزبال

سلطات سلا تتدخل لوقف خروقات مطاعم مارينا

الملك يبعث برقية شكر وامتنان إلى زعماء دول الخليج على الدعم

استمرار أزمة الماء يقلق السكان بضواحي أكادير

الحبس للمتهم بالتحرش بفتاة وسط الشارع بطنجة

بوريطة: اتفاق التبادل الحر مع تركيا كان خاطئا وقمنا بمعركة
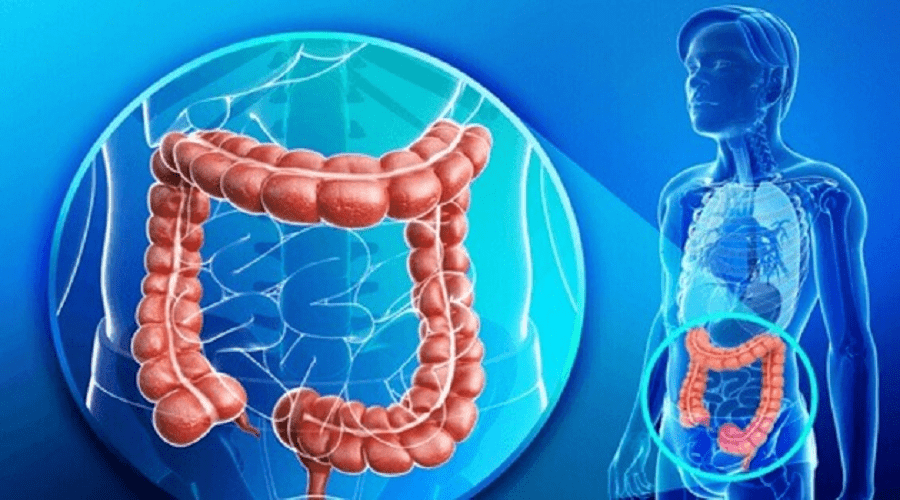
طريقة بسيطة لتنظيف الأمعاء من السموم

الحبس النافذ لرئيس جماعة وبرلماني عن الـ«PPS» بخريبكة

رئيس جماعة إنزكان الأسبق أمام المحكمة المالية بمراكش

هذه مخاطر الإفراط في تناول الشاي

ماء العينين تحصل على انتقال بسرعة قياسية من مديرية التعليم بتزنيت

قاضي التحقيق يعتقل مديرا جهويا للبنك الشعبي بطنجة بتهمة الاختلاس

تأجيل ملف «الجنس مقابل النقط» لجلسة 28 دجنبر
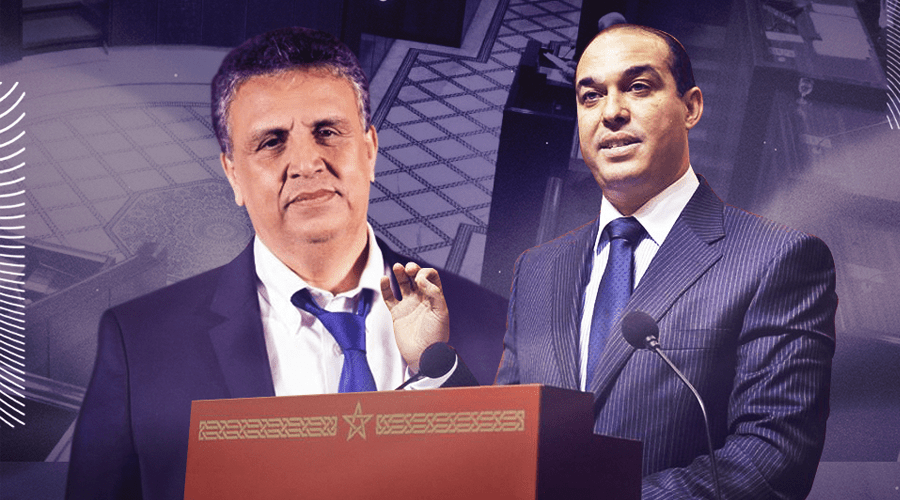
رائحة "التقاشر" تفوح داخل البرلمان

أزمة الأسواق النموذجية بسلا تسائل المجلس السابق

الحكومة تراهن على الرقمنة لمكافحة الفساد الإداري

استئنافية خريبكة تنظر في قضية حجز تحفظي على عقارات

مطلقة تختطف ثريا وتقطع إحدى أذنيه داخل غارمن أجل الزواج بها

إحباط توزيع 5 أطنان من الأكياس البلاستيكية بمراكش

مطالب بإحداث مستشفى قرب ميناء طنجة المتوسطي

ابتدائية تطوان تنظر في اتهام إدعمار بالتزوير

التحقيق في العثور على جثتين داخل غرفة بسطات
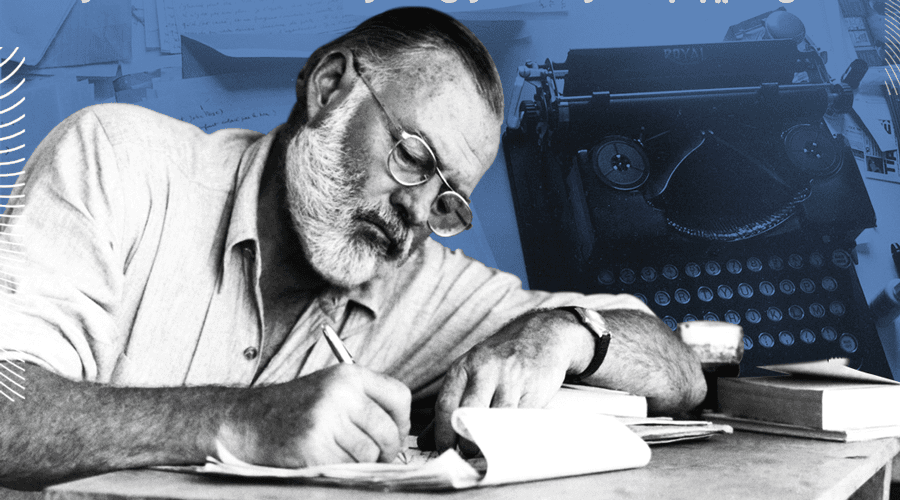
كيف يتصرف الكاتب مع الناشر

إيقاف شرطي بآسفي لأجل السكر والقتل غير العمد

تهريب المخدرات عبر موانئ الصيد يستنفر أمن تطوان

الإطاحة بمتورطين جدد في شبكة الاتجار بالبشر بسيدي سليمان
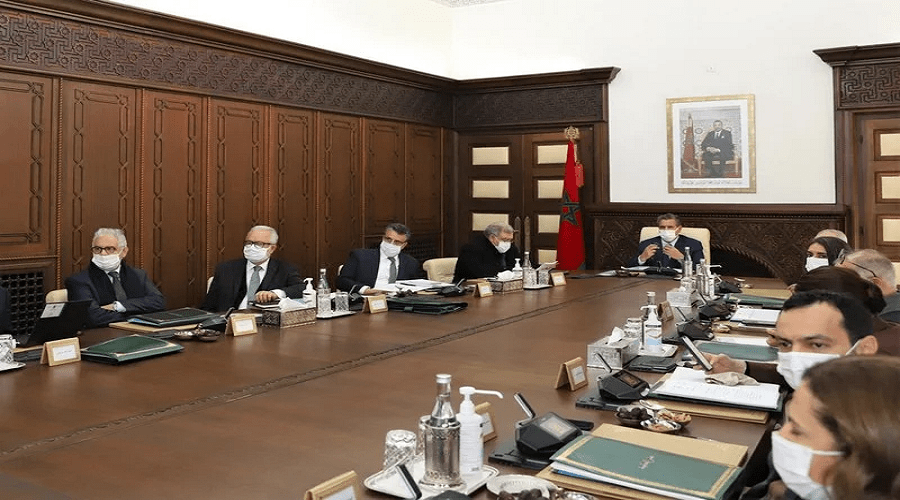
المصادقة على مشروع منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

فتح تحقيق في خروقات انتقاء طلبة الماستر والدكتوراه بجامعة مراكش
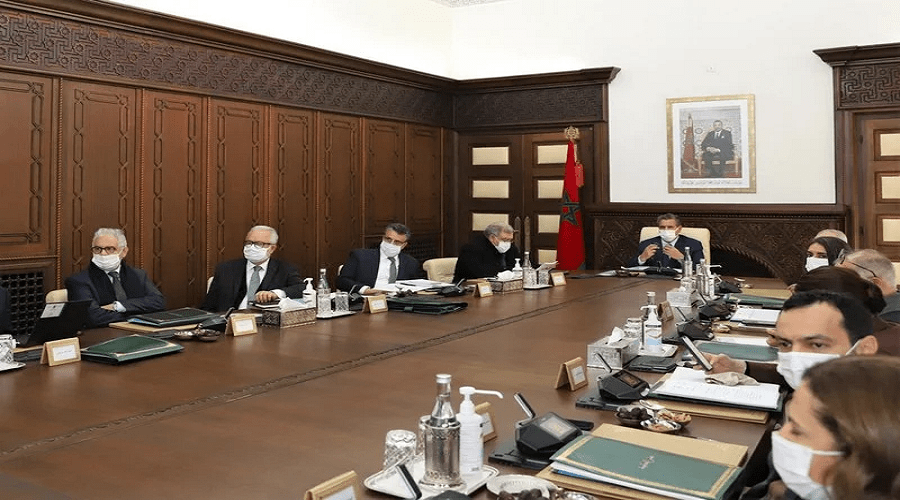
الحكومة توسع نسبة المستفيدين من التغطية الاجتماعية

المؤبد لقاتل جارته بعدما هجرته زوجته بتمارة

عملية سطو فاشلة جديدة على ناقلة للأموال بطنجة

اعتقال مسير وكالة أسفار بمراكش أوهم شبابا بالهجرة إلى الخارج

إيقاف مجوهراتي وحجز 20 ألف أورو بسيدي سليمان

18 شهرا حبسا نافذا لصاحب معمل «فاجعة طنجة»

استئنافية مراكش تنتصر لمستشار جماعي ضد «البام»

جدل بين اللجنة العلمية والحكومة بسبب الإغلاق الجوي

غياب التجهيزات يربك خدمات الصحة العمومية بسلا

استياء من انتشار الأزبال بطرقات سيدي سليمان

إيقاف أربعينية حاولت نقل الكوكايين من الشمال إلى البيضاء

التحقيق في وفاة مولودة أمام مركز صحي بشفشاون

إيقاف قاصرين كسروا زجاج أزيد من 20 سيارة ببرشيد

خطر الموت يحوم فوق رؤوس سكان بالمضيق

جرائم أموال الرباط تحاكم شرطيا بسبب تجاوزات مهنية خطيرة بالميناء

اعتقال الحارس الليلي بطل الأشرطة الجنسية بسلا

جمارك الداخلة تتلف حوالي53 ألف علبة مهيجات جنسية
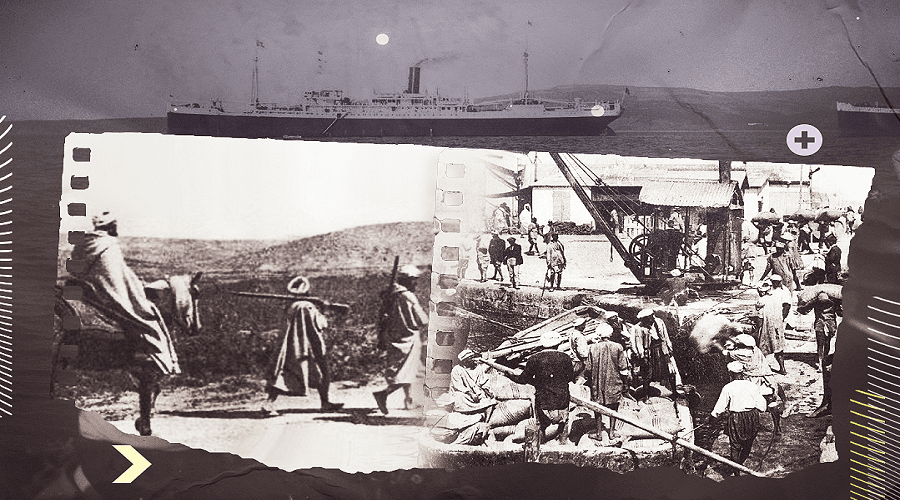
التاريخ المنسي لحرب الموانئ
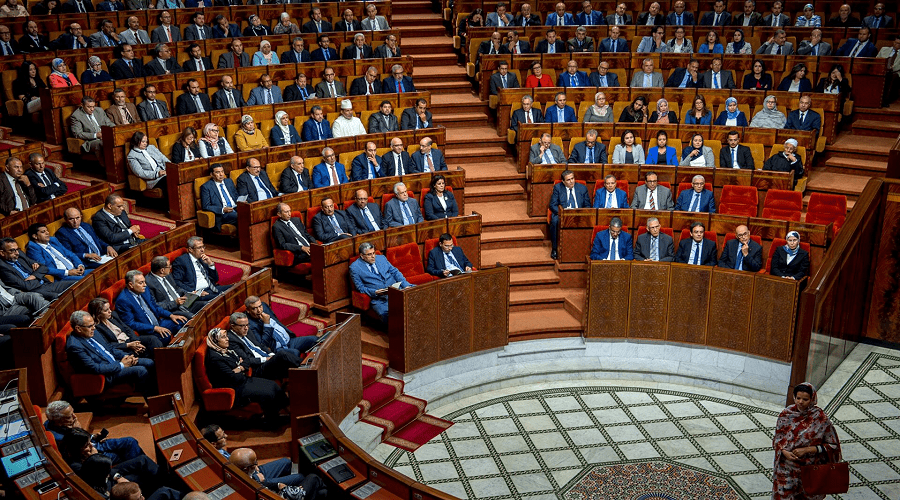
البرلمان يصادق نهائيا على أول قانون مالية للحكومة

العثور على جثة مستثمر فرنسي داخل شقته بطنجة

تعثر «قطب الجذب» يسائل سلطات سيدي سليمان

90 سنة سجنا لشبكة لتهريب المخدرات بالجنوب

احتجاجات على نقل سوق الجملة للخضر بسلا إلى الرباط

أخنوش يعطي انطلاقة بناء ممرين تحت أرضيين بأكادير
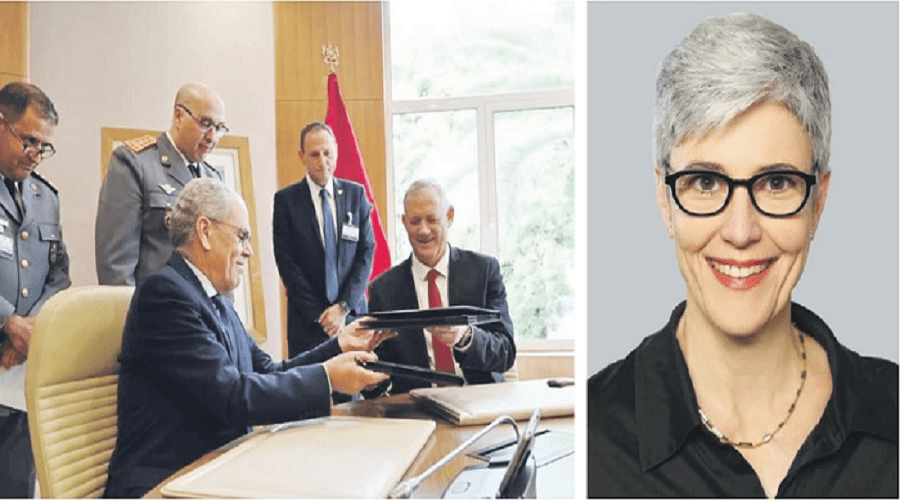
ألمانيا منزعجة من تطور العلاقات بين المغرب وإسرائيل

أمن القنيطرة يبحث في ملف الاتجار بالبشر بسيدي سليمان

تسامح السلطات يشجع مقاهي الشيشة بسلا

ملف فاجعة طنجة يدخل المداولة بالمحكمة الابتدائية

يقظة أمنية تجهض محاولة تهريب 9 أطنان من الشيرا بالبيضاء

مصرع صياد وإنقاذ اثنين في انهيار صخري بآسفي

هكذا تسبب النقص في القهوة في أزمة عالمية
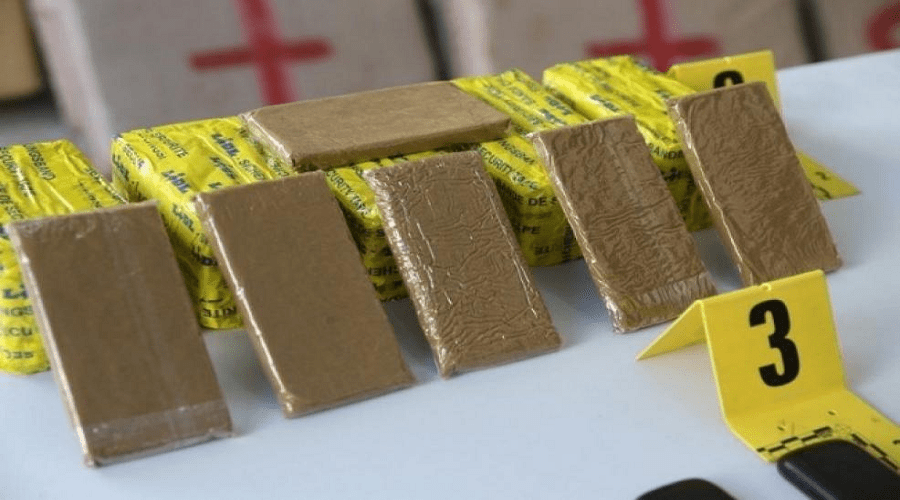
ضبط 17 صفيحة مخدرات بحوزة ضابط بالوقاية المدنية بآسفي

إضراب الممرضين يشل مراكز التلقيح ضد «كورونا»

المغرب ينبه المجتمع الدولي إلى تنامي التهديدات الإرهابية بإفريقيا

الداخلية تشرع في إحصاء المجندين للخدمة العسكرية

كل ما تجب معرفته حول المتحور الجديد الأشد فتكا بجنوب إفريقيا

التحقيق في تحريض ستة أشخاص على الاحتجاج بتطوان

احتجاج بضواحي سطات بسبب تردي الوضع الصحي

اعتقال تاجر هدد بذبح قائد بمراكش

سقوط ممرض آخر ضمن شبكة «الاتجار بجوازات التلقيح» بطنجة

«تيلي ماروك » تكشف تفاصيل سرقات استهدفت وكالات تحويل أموال بتطوان

تقارير تكشف مساهمة احتلال الملك العمومي في حوادث السير بطنجة

الحكومة تتجه نحو تشديد الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

جريمة هتك عرض شاب وقتله تهز حيا صفيحيا بتمارة

تطورات فضيحة الجنس مقابل النقط تدفع عميد كلية سطات إلى الاستقالة

تفاصيل فك لغز سرقة وكالات تحويل أموال بتطوان

أخنوش يصرح بكل شيء في أول جلسة لمساءلته بمجلس النواب
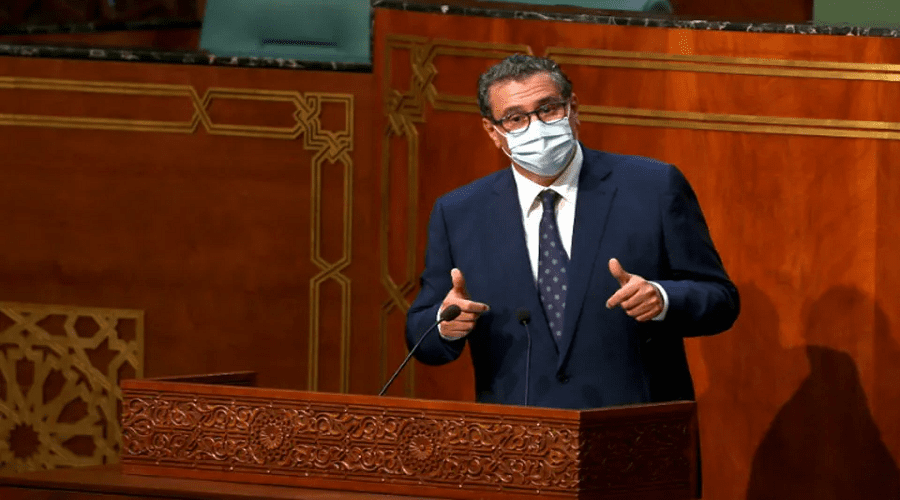
أخنوش : بناء الدولة الاجتماعية هدف ملكي أصيل

الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة أمام القضاء

صراع بين جمعيتين للدراجات النارية الكبيرة ينتهي بإصابة ثلاثة

الإطاحة بممرض ووسيطة يتاجران في جوازات التلقيح بطنجة

الوكيل العام يأمر بالتحقيق في تعرض طفلة لحروق خطيرة بسطات

تفاصيل الحكم بسجن رجال أعمال ومحاسب بتهمة سرقة أموال قطرية

جماعة طنجة تفقد المئات من الموظفين خلال فترة «البيجيدي»

استنفار أمني بتطوان بعد سرقة وكالة ثانية لتحويل أموال

الحكومة تصادق على مراسيم لتنزيل الحماية الاجتماعية

مطالب بتنظيف أودية تنبعث منها روائح كريهة بطنجة

الأمطار تفضح عيوب البنية التحتية ببرشيد

تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الثاني أثناء إجراء الامتحان بمراكش

غضب عارم بعين العودة بعد قتل جانحين لحارس ليلي

ابتدائية تطوان تشرع في محاكمة أطباء مصحة خاصة بتهم ثقيلة

التحقيق في العثور على مسدس بالمقبرة الإسلامية بتطوان

أمن تطوان ينهي نشاط مقنعين يستعملان دراجة نارية للسرقة بالنشل

سوق الصالحين بسلا.. من لعنة الحرائق إلى جحيم الإهمال

إيقاف شخصين وحجز قارب بساحل سيدي رحال الشاطئ

السطو على مبلغ مالي كبير من ناقلة للأموال بطنجة

هكذا شوهت مشاريع متعثرة صورة الرباط عاصمة الثقافة العربية

أخنوش يرث تركة ثقيلة من بنكيران والعثماني

الـ CNSS يعلن موعد بدء استفادة العمال غير الأجراء من التغطية

مضامين من مذكرات منقرضة تنشر لأول مرة

ملف تفويت أملاك الدولة لنافذين أمام الوكيل العام بمراكش

عمدة آسفي يطلق حملة لإعدام المئات من أشجار الأوكاليبتوس

خمس سنوات سجنا لمستشار سابق للبيجيدي ومقاول في ملف جوطية القنيطرة

بوريطة يقدم المقاربة الملكية لتسوية الأزمة الليبية في "مؤتمر باري

عندما تنبأ الملك الحسن الثاني بسقوط الشاه

المحافظة العقارية تنجح في رقمنة مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي

الأمن يعتقل زيان ويحيله أمام وكيل الملك

اعتقال موظفة إطار لكمت ضابطا وأرسلته لمستعجلات المستشفى العسكري

ضبط أزيد من 40 طنا من الدقيق الفاسد بشيشاوة

درك برشيد يتسلم أربع سيارات نفعية لتعزيز تدخلاته

قاضي التحقيق بتطوان يتسلم ملف سرقة سكانير مستشفى الفنيدق

مطالب بالتحقيق في فشل مشروع سياحي بضواحي طنجة

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تبعد خيار الاستفتاء في الصحراء

بوريطة يؤكد عزم المغرب الطي النهائي للنزاع المفتعل لملف الصحراء

خطاب المسيرة ... مغربية الصحراء ليس على طاولة المفاوضات

نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضرا

الملك محمد السادس :"المغرب لا يتفاوض حول صحرائه"
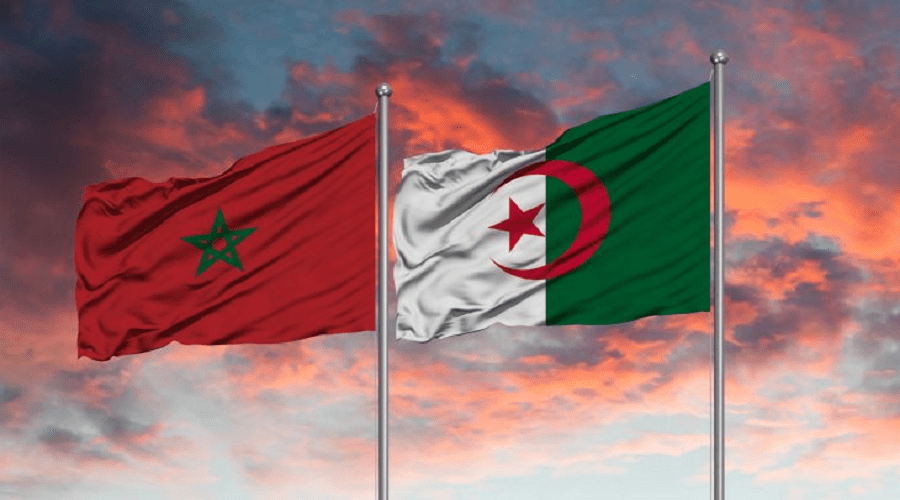
مصدر مغربي يؤكد أن المغرب لن يجر إلى حرب مع الجزائر ولن ينساق

المعارضة بجماعة سيدي سليمان تفضح عيوب مشروع ميزانية 2022

آيت الطالب أمام امتحان وقف مشاكل التوجيه بقطاع الصحة بالشمال

أخنوش يتفقد سير الأشغال بعدة مشاريع بمدينة أكادير
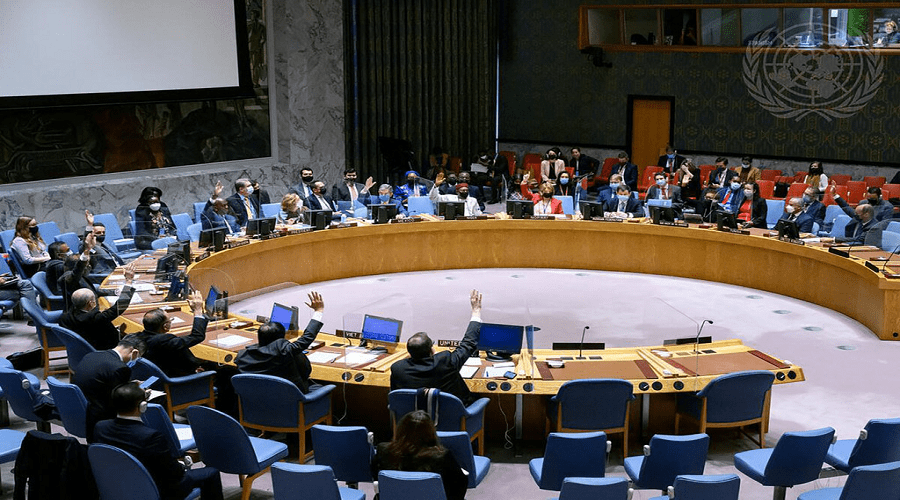
بسبب الصحراء المغربية ..الخارجية الجزائرية تهاجم مجلس الأمن
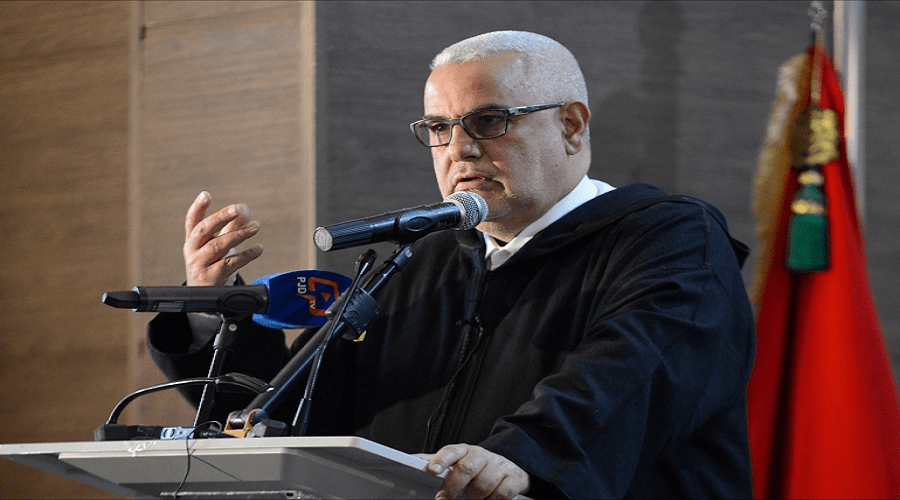
انتخاب بنكيران أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية
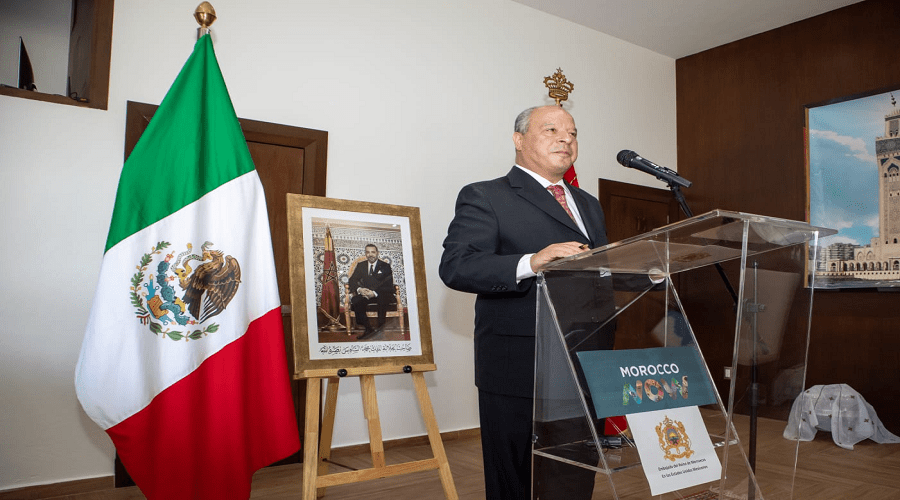
المكسيك تنوب عن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لدعم سيادة

ضبط طن من الحشيش ممزوج بالحناء للتمويه بميناء طنجة المتوسط

تأخير ملف «القاضي المزيف» زعيم شبكة الدعارة بمراكش

ايت الطالب يدافع عن إلزامية جواز التلقيح ويحذر من انتكاسة وبائية

نقل 15 شخصا للمستعجلات بعد تسرب غاز "الأمونياك" بالمركب الصناعي

بوريطة يمثل المغرب في الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الأفريقي

OCP يكشف تفاصيل تسرب غاز الأمنياك بميناء الجرف الاصفر

عدد زبناء "اتصالات المغرب" بلغ ما يقارب 73 مليون زبون

الفرقة الوطنية توقف 11 متهما روعوا مدينة فاس

لماذا أًقبرت روايات المخزنيين عن توقيع معاهدة الحماية؟

تحيين دول اللائحة "ب" التي يسمح لمواطنيها بدخول المغرب بشروط

كندا تستأنف رحلاتها مع المغرب وفق شروط إضافية

هذه تفاصيل تطبيق إلزامية "جواز التلقيح" في الاماكن العامة
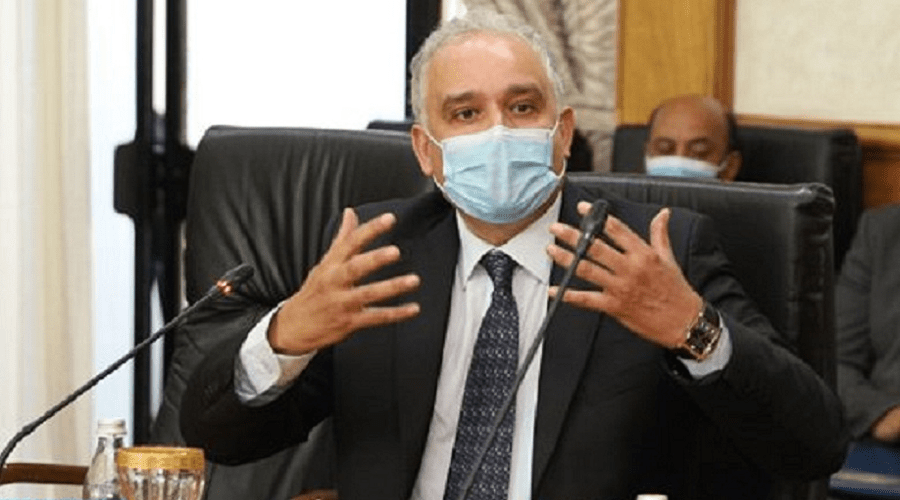
حمضي :"جواز التلقيح خطوة للرفع شبه الكامل للقيود"
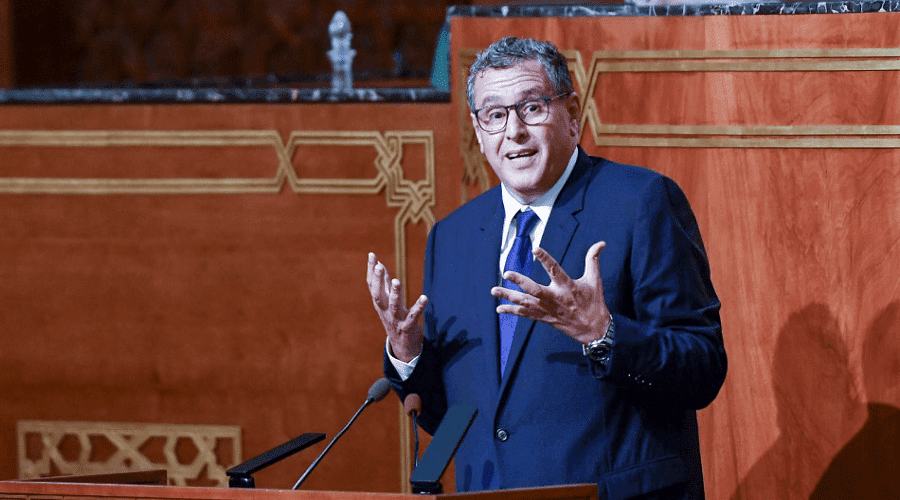
مشروع قانون المالية 2022.. توقع إحداث 250 ألف منصب شغل

حياة ما بعد الوزارة .. الانشغالات الجديدة لوزراء سقطوا من التشكيل

السليمي: وكالة المغرب العربي للأنباء ارتكبت خطأ مهنيا كبيرا

المجلس الوزاري يصادق على سبع اتفاقيات دولية

المجلس الوزاري يصادق على تعديل قانون التعيين في المناصب العليا

تعيين محمد بنشعبون سفيرا بفرنسا ويوسف العمراني سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون المالية

20 طبيبا ممارسا فقط بالمستعجلات في المغرب
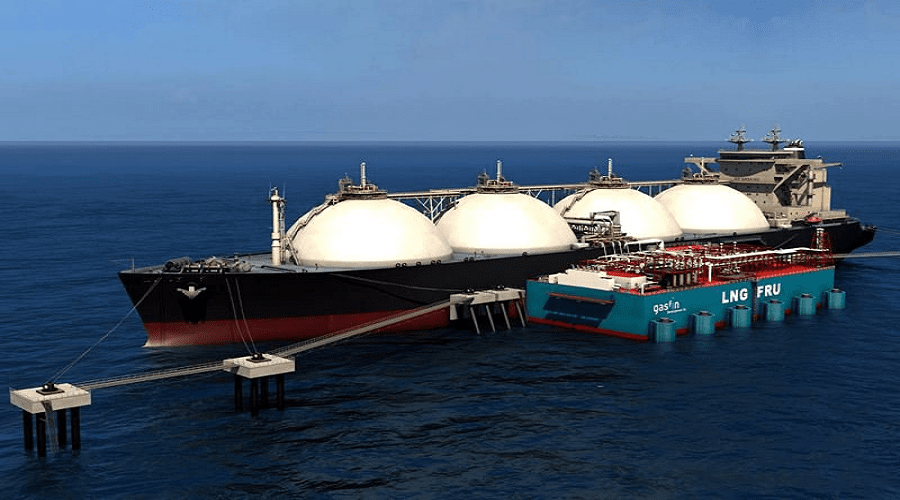
المغرب يمدد فترة العروض لبناء وتشغيل وحدة عائمة لتخزين
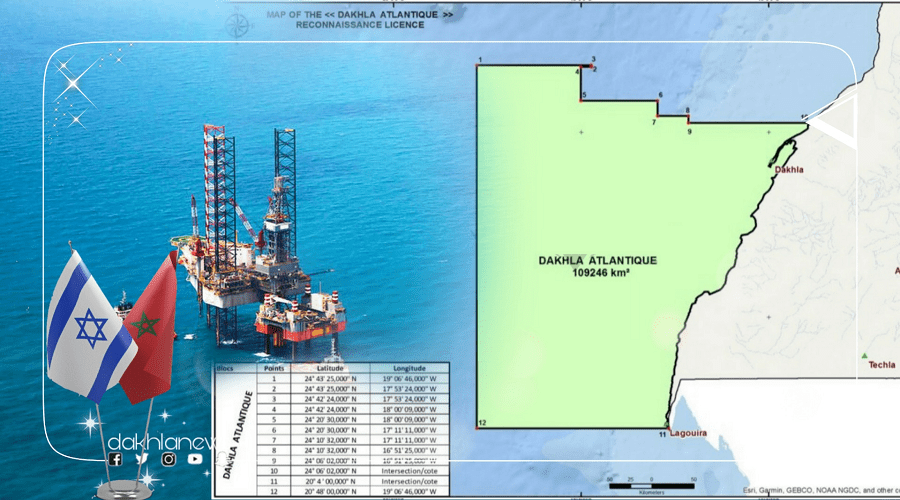
المغرب يوقع اتفاقية مع شركة " Ratio Petroleum " الإسرائيلية

المنصوري تفتح ملف اختلالات الوكالة الحضرية لتطوان

عزل الزفزافي والحاكي داخل سجن طنجة عقب إصابتهما بفيروس "كورونا"

مشادات خلال دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط

الملك يعين آيت الطالب على رأس وزارة الصحة مكان نبيلة الرميلي

ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة الأساتذة المتعاقدين

بنموسى يلتقي نقابات التعليم وملفات شائكة على طاولة الحوار

الأغلبية بمجلس النواب تشيد بالبرنامج الحكومي وتصوت لصالحه

استقالة برلمانيين من مجلس النواب لهذا السبب

ابتدائية فاس تصدر حكمها في " بلانات الشينوا"

الاتحاد الدستوري يقرر رسميا طرد إدريس الراضي من كافة هياكل الحزب

أخنوش يقدم للمغاربة عشر التزامات حكومية
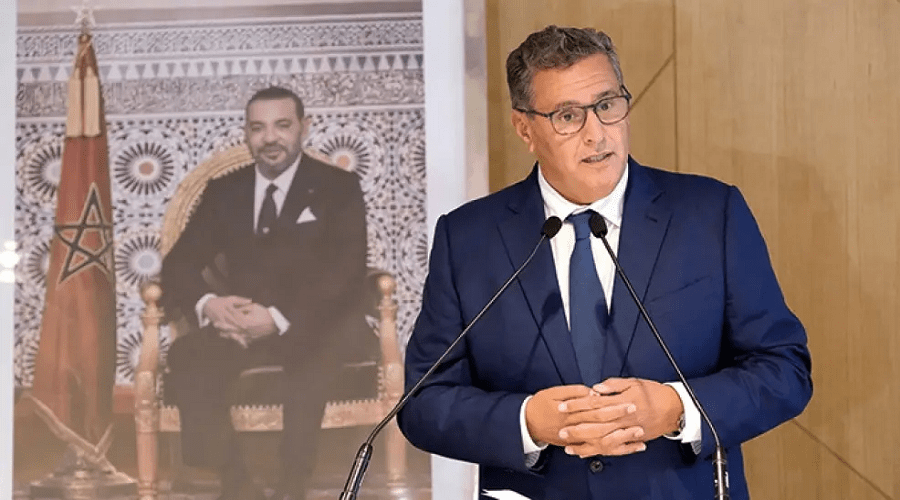
بحضور بنموسى والجزولي ... قيادة الأحرار تشيد بمسار تشكيل حكومة

المغرب يعرب عن ثقته في السلطات المالية من أجل إيجاد حلول ملائمة

وزير الخارجية المالي : مالي ملتزمة بالعثور على المسؤولين عن قتل

الحكومة تكشف الخطوط العريضة لبرنامجها

إغلاق ممرات قنطرة الحسن الثاني يخنق حركة المرور بين الرباط وسلا
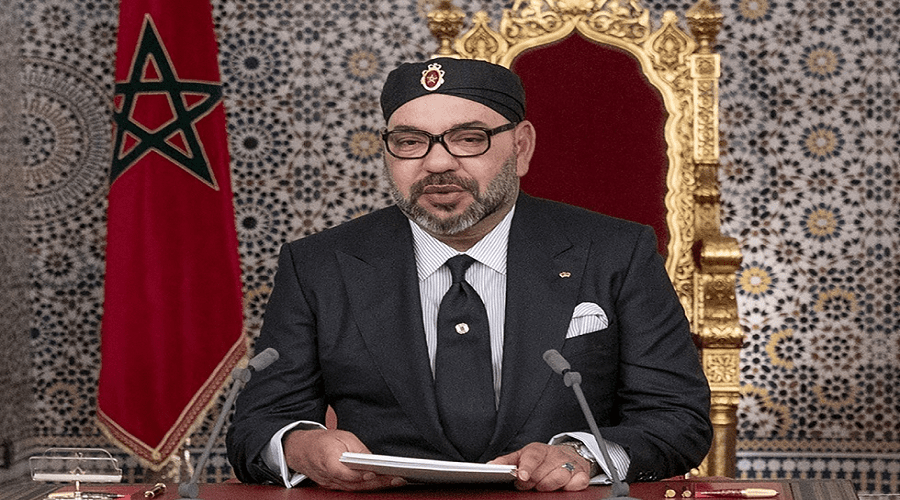
الملك يوصي الحكومة والبرلمان بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي

الملك يدعو إلى إحداث منظومة وطنية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي
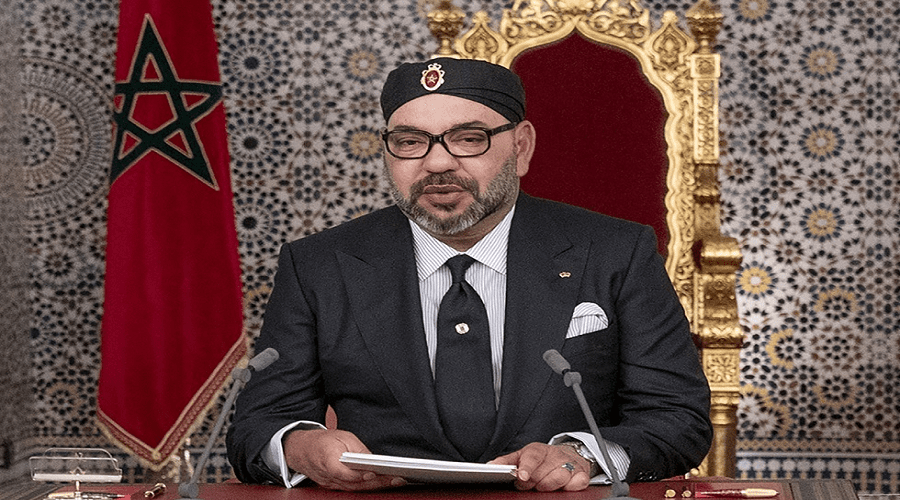
خطاب الملك في افتتاح البرلمان أمام البرلمانيين والوزراء الجدد
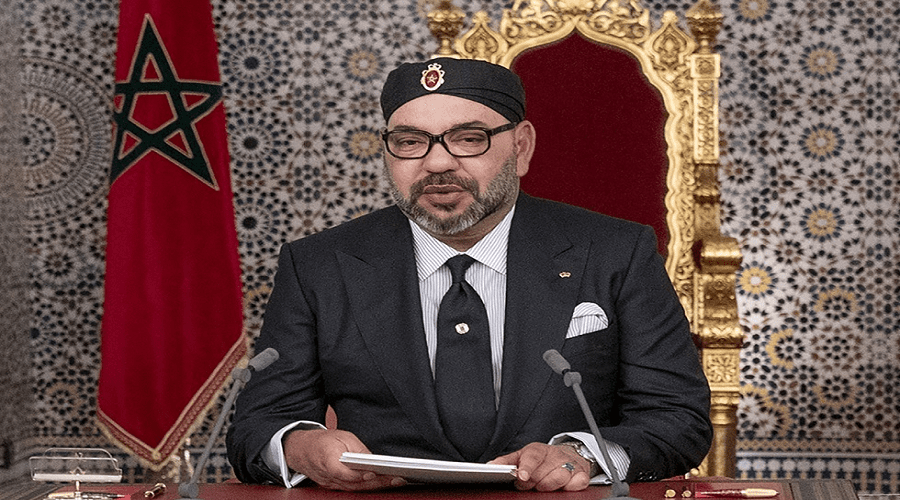
الملك يشيد بنسبة المشاركة في الانتخابات ويوصي الحكومة بتنزيل
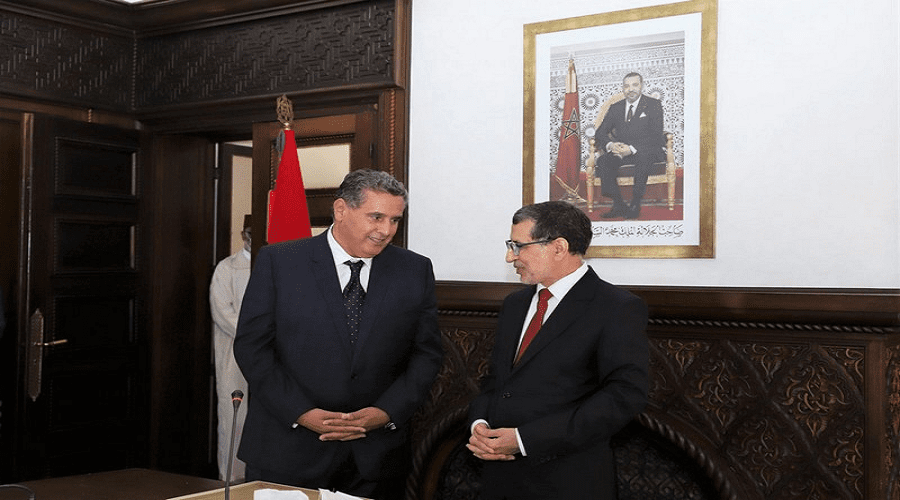
أخنوش يتسلم مفاتيح رئاسة الحكومة من العثماني

أخنوش : الحكومة تزخر بكفاءات وهي واعية بالانتظارات الهامة للمواطن

الملك يترأس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وهذه تشكيلتها

الملك يفتتح دورة البرلمان عن بعد

"البسيج" يفكك خلية إرهابية موالية لداعش في عمليات أمنية بطنجة

تحالف الأحرار والبام والاستقلال يكتسح انتخابات مجلس المستشارين
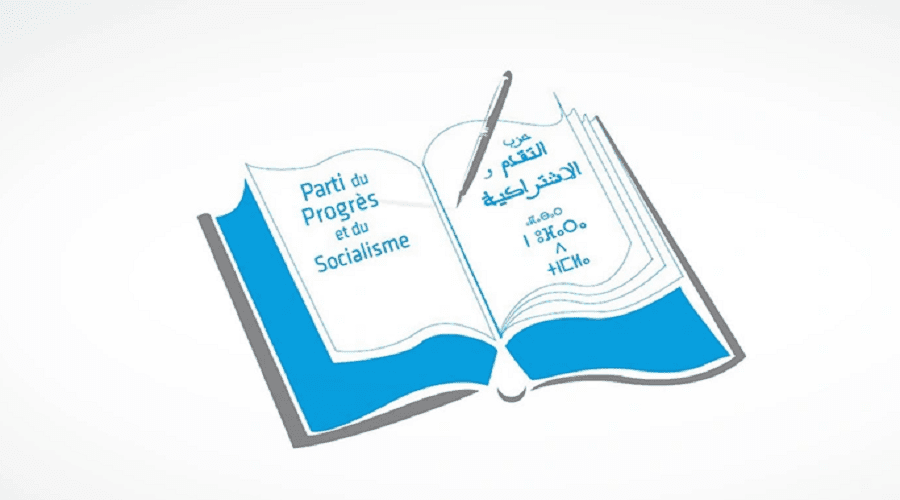
بعد طرد 11 عضوا....الخلاف الداخلي بالتقدم والاشتراكية يحتدم

توقيف متهمين جدد في الهجوم المسلح على حي سيدي بموسى بسلا

انطلاق عملية التصويت في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين

الأمن يهتدي إلى واضع الطرد مشبوه بالقرب من ثانوية ديكارت بالرباط

إنذار خاطئ بوجود قنبلة داخل ثانوية ديكارت بالرباط

غوتيريش يعرض تطورات ملف الصحراء أمام مجلس الأمن

نواب أوروبيون يجددون التأكيد على دعمهم للشراكة "الاستراتيجية"

حكومة تصريف الأعمال تُعِد لتخفيف إجراءات الحجر الصحي

ثلث البرلمانيين لا يتوفرون على الباكالوريا

مصدر رسمي يؤكد : المغرب والاتحاد الأوربي يوجدان في خندق واحد
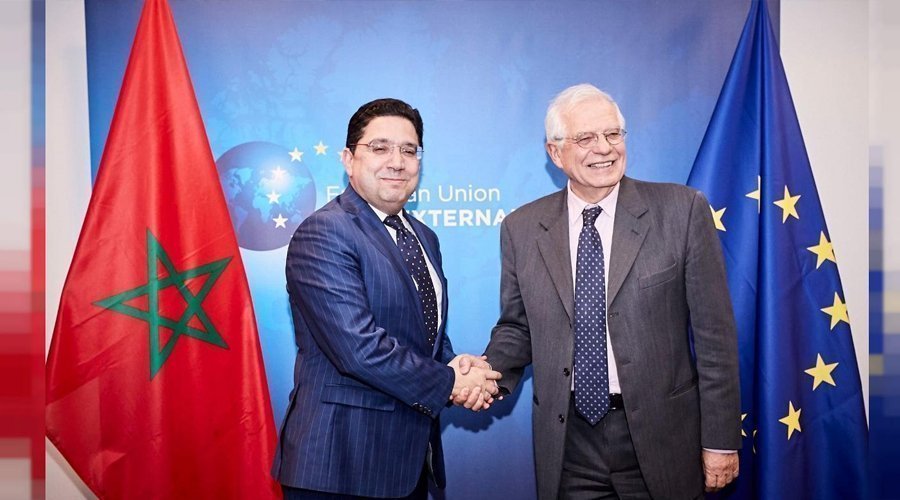
بوريطة وجوزيف بوريل يؤكدان اتخاذ إجراءات لاستمرار العلاقات التجار

بوريطة يرد على القرار الفرنسي تخفيض عدد التأشيرات للمغاربة

بوريطة يدعو الجزائر إلى "تحمل مسؤوليتها" في النزاع المفتعل

تشديد فرنسا لشروط "الفيزا" يهدد مستقبل آلاف الطلبة المغاربة

هذه تفاصيل الأصوات التي حصل عليها قادة الأحزاب الكبرى

كشف تفاصيل حول فيديو تضمن ادعاءات بالاختطاف بطنجة

مقتل ممرضة طعنا داخل مستشفى 20 غشت بالدارالبيضاء

قضاء وجدة يجرد أصغر رئيسة جماعة بالمغرب من منصبها

OCP يراسل التلفزيون الفرنسي بسبب "ادعاءات مغلوطة"

مشاريع كبرى متوقفة على طاولة العمدة الجديد لسلا

الوكيل العام للملك بكلميم يكشف تفاصيل وفاة البرلماني عبد الوهاب

إحباط تهريب 22 كيلوغراما من الكوكايين بطنجة

تنسيق أمني استخباراتي يفك لغز سرقة 40 مليونا من فرنسية بتطوان

بعد العمدة أغلالو ..الأحرار والبام والاستقلال يقتسمون مناصب

«نكافة» تفوز برئاسة أغنى جماعة بمراكش

مسؤول مالي بتعاضدية الموظفين أمام محكمة جرائم الأموال

"البسيج" توقف 4 متهمين جدد مرتبطين بالخلية الموالية لـ "داعش"

وهبي : التحالف الثلاثي جاء بهدف الوصول إلى حكومة قوية ومنسجمة

أخنوش : سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة

بركة : التحالف الحكومي الجديد يشكل البديل السياسي والديمقراطي

رسميا: أخنوش يعلن عن أغلبية حكومية بين الأحرار والاستقلال والبام

الحبس لمستشار الوزير رباح السابق وتعويض مستثمر إيطالي بـ85 مليونا

انتفاضة جماعية داخل التقدم والاشتراكية ضد نبيل بنعبد الله

العثماني ووزراؤه يكلفون خزينة الدولة مليارا و400 مليون

الاستقلال يطالب بتأجيل جلسة انتخاب رئيس جماعة سيدي سليمان

أحزاب الاستقلال والأحرار والبام ترشح مباركة بوعيدة لرئاسة جهة كلم

"الأحرار والبام والاستقلال" تعلن تحالفها لتشكيل المجالس الجهوية

الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادات اللقاح ضد فيروس كورونا الصادرة

أخنوش: سنعلن عن الأغلبية الحكومية خلال الأسبوع المقبل

وهبي يسحب تزكية الترشح من بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون

المحافظة العقارية...نهاية الإيداع اليدوي لملفات التوثيق والإجراء

عرشان : المشاورات في بدايتها ونتمنى في المستقبل القريب أن تتشكل

بنعبد الله : أتمنى النجاح والتوفيق لأخنوش وأن يشكل الحكومة

أخنوش يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة باستقبال بنعبد الله

الرشيدية.. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفكك خلية إرهابية

وزير خارجية مالي يدين الاعتداء الإرهابي على شاحنتين مغربيتين
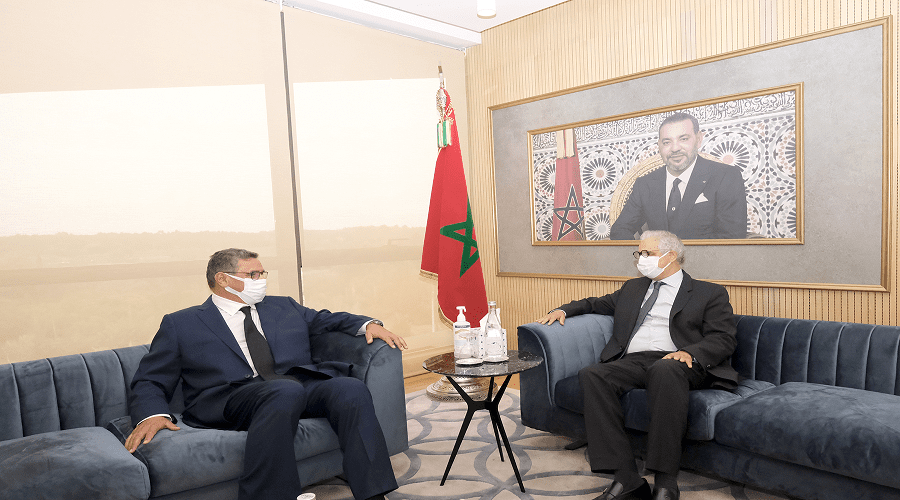
بركة : عرض رئيس الحكومة ستتم مناقشته داخل الدواليب التقريرية

زلزال استقالات يهز فرع حزب منيب بفرنسا

وهبي : تلقينا إشارات إيجابية من أخنوش وسنعمل على بناء تصور مشترك

أخنوش يعلن تخليه عن جميع الأنشطة المهنية والتجارية

الملك يستقبل أخنوش ويعينه رئيسا للحكومة

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بشفافية ونزاهة انتخابات

البرلمان العربي يؤكد إجراء الانتخابات بكل حيادية وشفافية ونزاهة
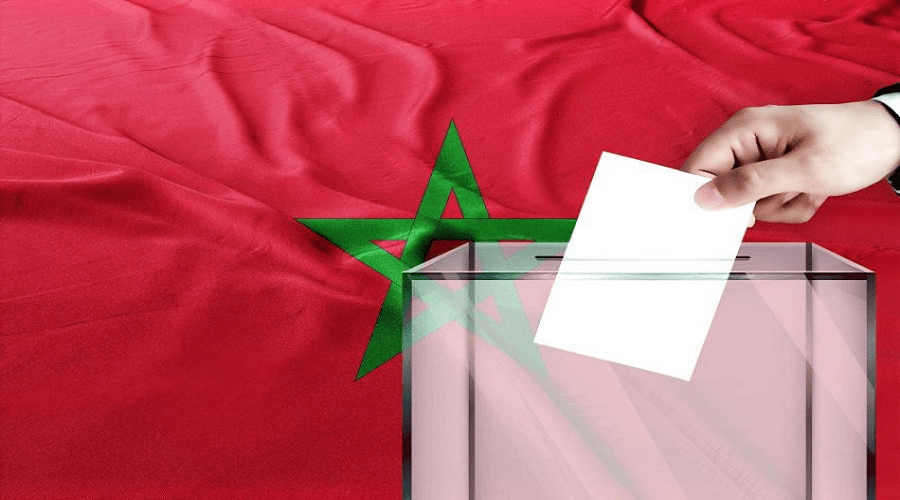
مراقبون دوليون يشيدون بنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية

التجمع الوطني للأحرار يكتسح الانتخابات التشريعية والجهوية

العثماني وجميع أعضاء الأمانة العامة يقدمون استقالتهم

أخنوش: الخيط الناظم لمشروع الأحرار هو تقديم البديل التي يتوق إليه

ماء العينين : المغاربة عاقبوا البيجيدي والعثماني عليه أن يستقيل
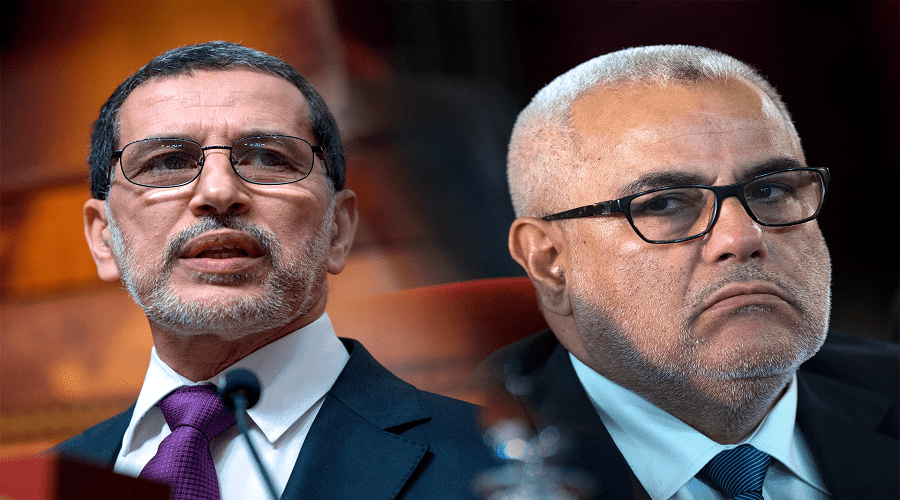
بنكيران يدعو العثماني إلى تقديم استقالته من رئاسة حزب "البيجيدي"

التجمع الوطني للأحرار يتصدر الانتخابات التشريعية

البيجيدي يودع مراكش خاوي الوفاض

الأحرار بتطوان يسير إلى حسم مقعد برلماني بفارق كبير عن "البيجيدي"

بعد فرز 90 في المائة من الأصوات في طنجة البيجيدي يحصل على صفر

محمد الغراس أول وزير "يتكردع" في الانتخابات

تراجع كبير لمرشحي العدالة والتنمية بمراكش والنتائج الأولية تؤكد

إبراهيم مجاهد يهزم العدالة والتنمية بإقليم أزيلال ويضمن مقعدين

إكتساح للأحرار والبام على مستوى جهة مراكش_ آسفي في نتائج أولية

نسبة المشاركة في الانتخابات تفوق 50 في المائة

الأحرار يكتسح نتائج الانتخابات بالقنيطرة ويفوز بأول مقعد برلماني
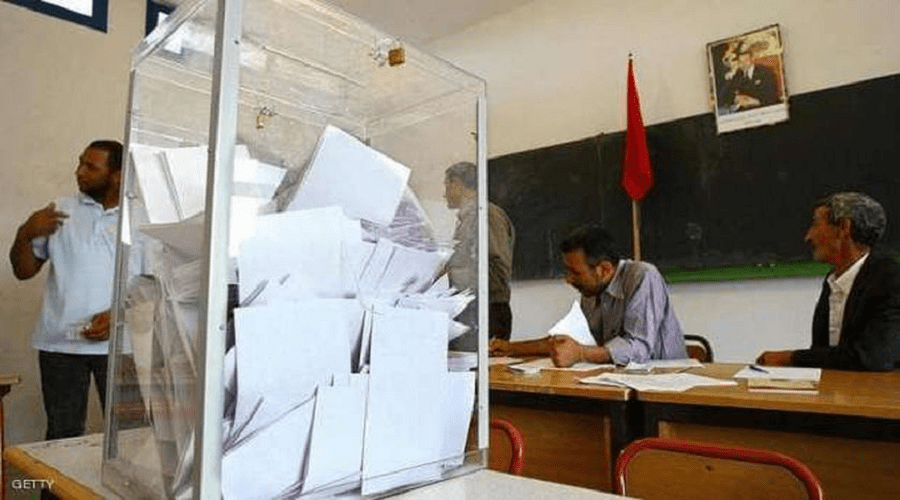
إغلاق مكاتب التصويت وانطلاق عملية فرز الأصوات

مراكش : ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة وسط مرور الانتخابات

نسبة التصويت بلغت 36 في المائة قبل ساعتين على إغلاق مكاتب التصويت

الأحرار يكشف تعرض مرشح له لاعتداء غير مفهوم بطنجة

نقل بنكيران إلى مصحة خاصة لإجراء تدخل طبي مستعجل

ارتفاع الإقبال على التصويت بتطوان وتوقع نسبة مشاركة أكثر من 50 %

قادة الأحزاب أول المصوتين والنسبة الأولية للمشاركة سجلت 12

الداخلية ترد على مغالطات "البيجيدي" وتؤكد أن التصويت سيكون

أمزازي ل"تيلي ماروك ": سيتم إعفاء الأسر من أداء واجبات شتنبر

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يتوقع تصدر الأحرار للانتخابات وقيادة

اعتداء دموي على برلماني خلال الحملة الانتخابية بالبئر الجديد

تفاصيل إطلاق مجموعة «Stellantis» منظومتها الصناعية بالمغرب

منظومة الإسعاف الاجتماعي «تتبخر» بعد مغادرة المصلي

"البيجيدي" يصف مواطنين طالبوا العثماني بالرحيل بـ"البلطجية"

وهبي يعلن عن تحالف «البام» مع جميع الأحزاب

الأزمي يجوب الشوارع لسب وشتم منافسه في الانتخابات بفاس

الأحرار يرد بقوة على الاتهامات الخطيرة لوهبي

شباب سيدي بنور ينتفضون في وجه الخلفي بعد غيابه 5 سنوات عن الإقليم

الخلفي يقتحم مقهى بسيدي بنور ويزعج الزبناء بصراخه مما جعلهم ينسحب

شباب يطردون مترشحي "البيجيدي" بالبيضاء ويصفونهم ب"المرايقية"

حصيلة وأثار مخطط المغرب الأخضر خلال عقد من الزمن

أخنوش يتهم أحزابا بالتشويش على الأحرار بعد فشلها في التسيير

أخنوش ينزل بمنطقة الغرب لدعم مرشحي «الحمامة»

الأمن يوقف المتهمين باختطاف ممرضة من داخل مستشفى بالدار البيضاء

السفير هلال يعلن إغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي

التجمع الوطني للأحرار يشتكي من تجاوزات قانونية لبعض رجال السلطة

شبكة تزوير الوثائق الطبية... اعتقال طبيبين وحجز وثائق ومعدات

الأحرار يتصدرون عدد الترشيحات بفارق أزيد من 4000 مرشح عن البام

الاستقلال يراهن على محمد زيدوح للظفر بجهة الرباط

برلماني يرشح زوجته لمنافسة والدته على مقعد انتخابي

إحداث شركة عمومية ستتولى نقل وتخزين الغاز الطبيعي بالمغرب

النيابة العامة تفتح تحقيقا حول ترويج إشاعة ذبح مرشح للانتخابات
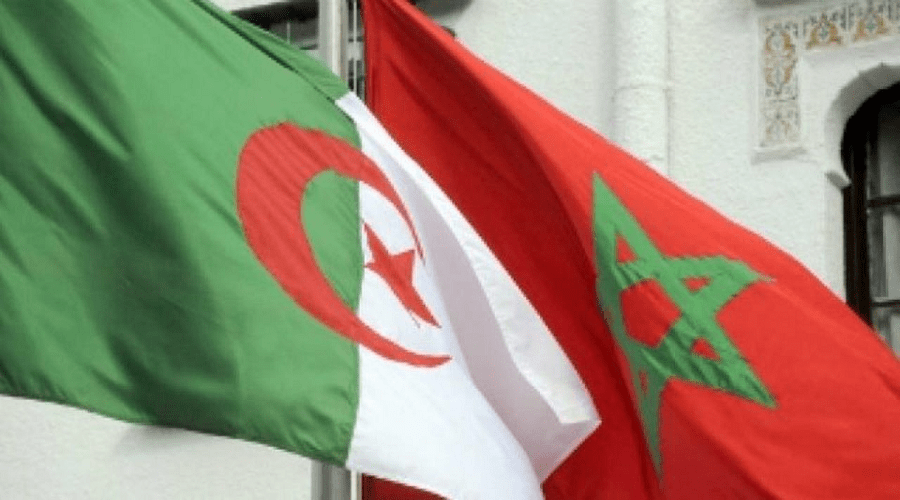
الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم

الملك يشير إلى عودة الدفء في العلاقات المغربية الاسبانية

خطاب الملك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب

الملك: عشنا أزمة غير مسبوقة مع إسبانيا واشتغلنا معها بكامل الهدوء
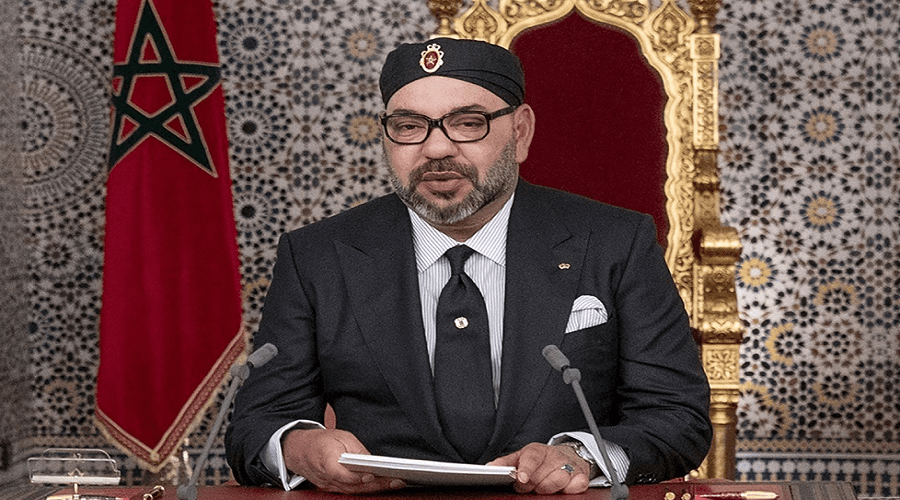
الملك : المغرب يتعرض لهجمات مدروسة من طرف بعض الدول والمنظمات

الملك محمد السادس "المغرب تغيير فعلا ولكن ليس كما يريد البعض"

الأزبال والنفايات تغزو أزقة مارينا سلا

الملك معزيا الحموشي في وفاة والدته : خير عزاء في رحيل الفقيدة

المغرب و إسرائيل يوقعان على 3 اتفاقيات تهم تعزيز التعاون الثنائي

المغرب يضع طائرتين من نوع كنادير رهن إشارة الجزائر لمساعدتها

التجمع الوطني للأحرار يكتسح انتخابات الغرف المهنية

الأحرار يغطى87 % من المقاعد المتنافس حولها في انتخابات الغرف

الحكومة تقرر إغلاق المدن وحظر التنقل بداية من التاسعة ليلاً

الملك محمد السادس يدعو الجزائر إلى فتح حدودها مع المغرب

الملك محمد السادس : "المرحلة صعبة والأزمة الوبائية مستمرة"

خطاب العرش : "المغرب والجزائر توأمان متكاملان"
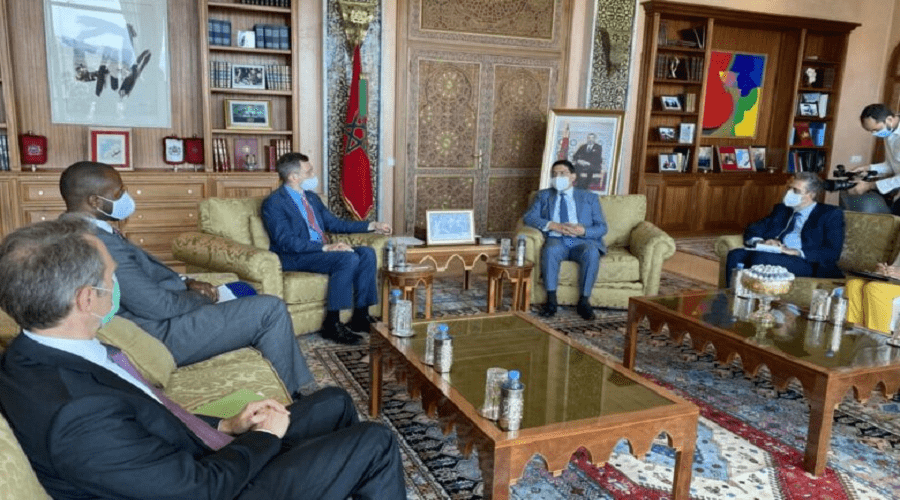
مسؤول أمريكي يشيد بقوة الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والمغرب
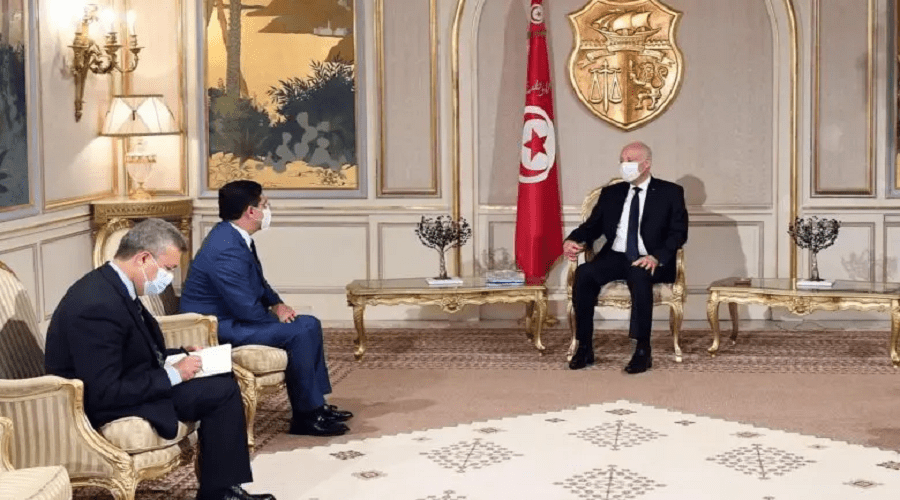
بوريطة ينقل رسالة شفوية من الملك إلى قيس والنيابة العامة التونسية
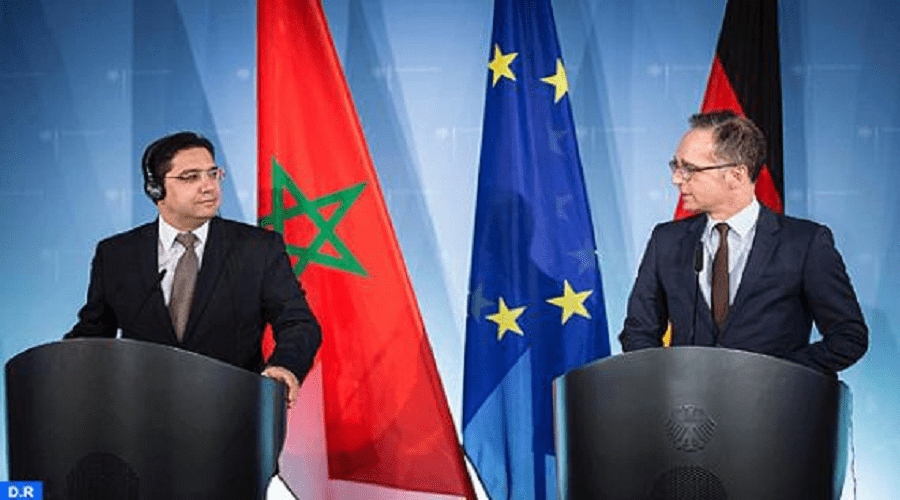
دراسة ألمانية توصي أوروبا بتقليص دعمها للمغرب للحد من تفوقه

عدد زبناء اتصالات المغرب ناهز 74 مليون ومجلس الرقابة يجدد الثقة

الأحرار يندد بإقحام المغرب في ملف بيغاسوس

أكذوبة بيغاسوس ...هكذا يتعرض المغرب لحملة إعلامية ممنهجة

التشطيب على حامي الدين والسكال من اللوائح الانتخابية

المغرب يقاضي أمنستي وفوربيدين ستوريز بتهمة التشهير بشأن بيغاسوس

بوريطة: "كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب عليها تقديم الدليل"

الحكومة المغربية تنفي التجسّس على الصحافيين وتتحدى "فوربيدن ستوري

نبيل عيوش يخرج خاوي الوفاض من مهرجان «كان»

منظمة صحافيو "قصص ممنوعة" يشن حملة إعلامية ضد المغرب

زعيم القبايليين يشيد بموقف المغرب بخصوص حق القبايل في تقرير مصير

السفير هلال يرد على وزير الخارجية الجزائري : "شعب القبائل أحق

اللجنة العلمية توافق على إلغاء الحجر الصحي في الفنادق وتعوضه

تمديد الاستفادة من الدعم المالي للعاملين في قطاع السياحة و الصناع

كل ما يجب معرفته حول سلالتي إبسيلون ولامبدا الأكثر عدوى ومقاومة

بركة يكشف سبب خلاف القيادة مع شباط ويقول إن حزب الاستقلال

101 عضوا من المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يتهمون منيب

الملك محمد السادس يطلق استثمارا ضخما لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد

لا تغيير في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء

المجلس الوزاري يصادق على قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات

الملك يصادق في اجتماع المجلس الوزاري على قوانين تخص المجال العسكر

المجلس الوزاري يصادق على 11 اتفاقية دولية

الملك يعين مسؤولين على رأس مؤسسات استراتيجية في اجتماع المجلس

توقيع اتفاقية ب100 مليون دولار بين OCP ومؤسسة التمويل الدولية

الحكومة تصادق على إلحاق أطر الأكاديميات بنظام المعاشات المدنية

التجمع يرد على الجواهري بعد وصفه الأحزاب بـ"الباكور والزعتر"

محمد صالح التامك يقصف الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود
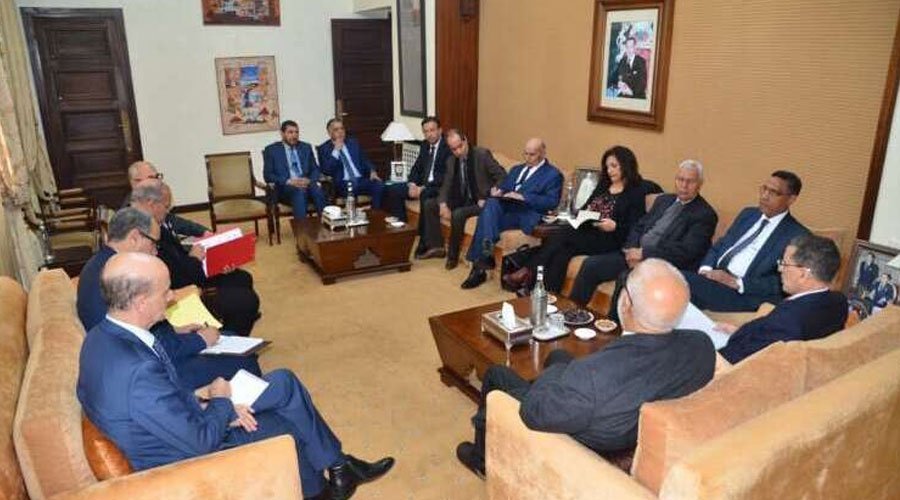
انتخابات ممثلي المأجورين.. هل ستتغير الخريطة النقابية؟

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" وتوقيف أربعة أشخاص

هنية: علاقة المغرب بفلسطين ليست مصلحية أو طارئة وزيارتنا تحظى

ONCF يمنح الجالية تخفيضا بـ%50 بكافة القطارات

هذه أهم خمسة مخاطر طبيعية تهدد المغرب حسب البنك الدولي

عملية مرحبا 2021: إضافة خطوط بحرية جديدة في اتجاه الموانئ المغربي

الملك يعطي تعليماته لوضع ترتيبات خاصة لاستقبال أفراد الجالية

المشاركة في مؤتمر برلين 2 تجمع بوريطة بالمبعوث الأممي الخاص لليب

الجامعة العربية: قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب تسييس غير مطلوب
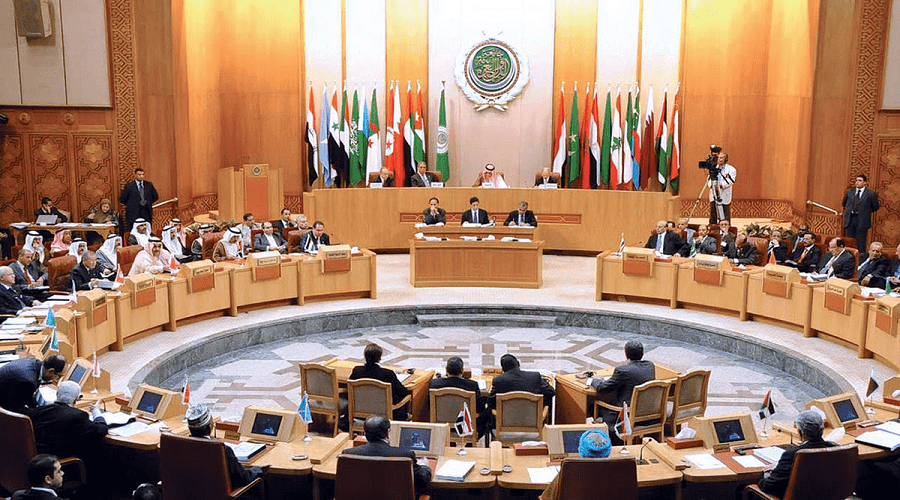
جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأورو

البرلمان الأوروبي يصب الزيت على نار الأزمة الدبلوماسية

بركة يعرض الخطوط العريضة لبرنامج حزب الاستقلال
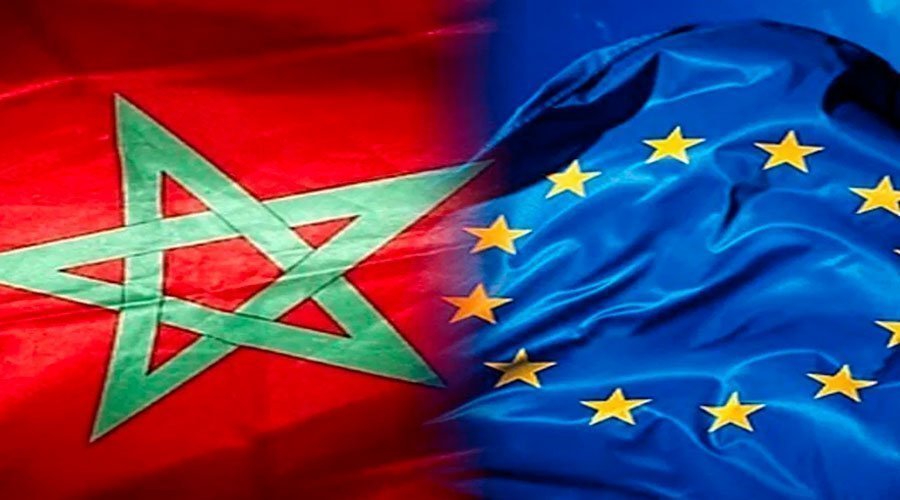
المغرب يرد بقوة على قرار البرلمان الأوروبي

ADA تعطي انطلاقة الكشك التعاوني لتسويق المنتوجات المحلية بأكادير

المسافرون سيتحملون تكاليف الحجر وجميع شركات الطيران مرخص لها بنقل

الرشوة تطيح بعميد شرطة ممتاز بالرباط والنيابة العامة تفتح تحقيقا

رئيس مجلس النواب الليبي يشيد بدور المغرب تحت قيادة الملك

أخنوش يقترح إحداث صندوق الزكاة لتمويل قطاع الصحة

إحداث الجواز التلقيحي للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح

الدار البيضاء.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في تصوير فيديو كليب

CNSS .. التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهندسين المعماريين العام

الدويري يستحوذ على مجموعة أمريكية متخصصة في بيع السردين المعلب

أخنوش يعد بخلق مليون منصب شغل

الملك يأمر بمنع الوزراء من الظهور في قنوات الإعلام العمومي

الملك محمد السادس يأمر بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير القانوني
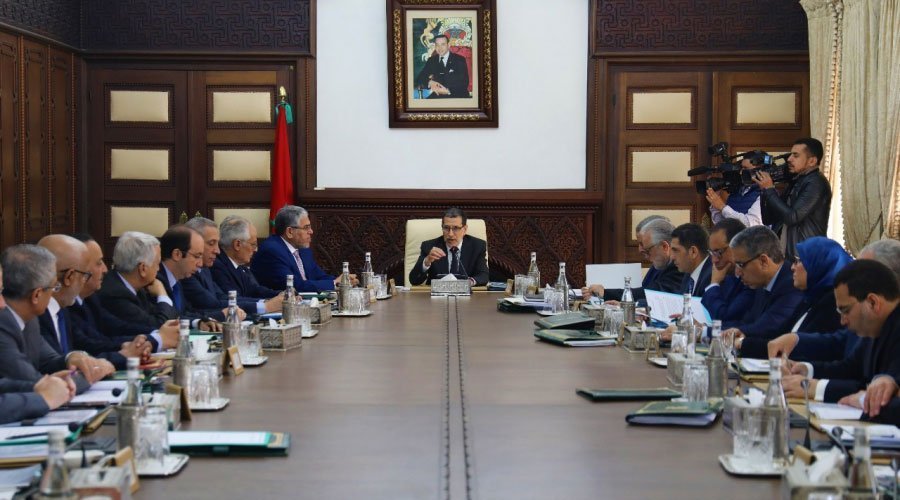
الحكومة تقرر السماح بتنظيم الحفلات والأفراح والتنقل وفتح المسابح

وزارة الخارجية.. مثول غالي أمام القضاء لا يشكل جوهر الأزمة

المغرب يشترط "البطاقة الصحية"لاستقبال القادمين إليه..وهذا محتواها

ثاباتيرو : العلاقة مع المغرب أساسية لأمن واستقرار إسبانيا
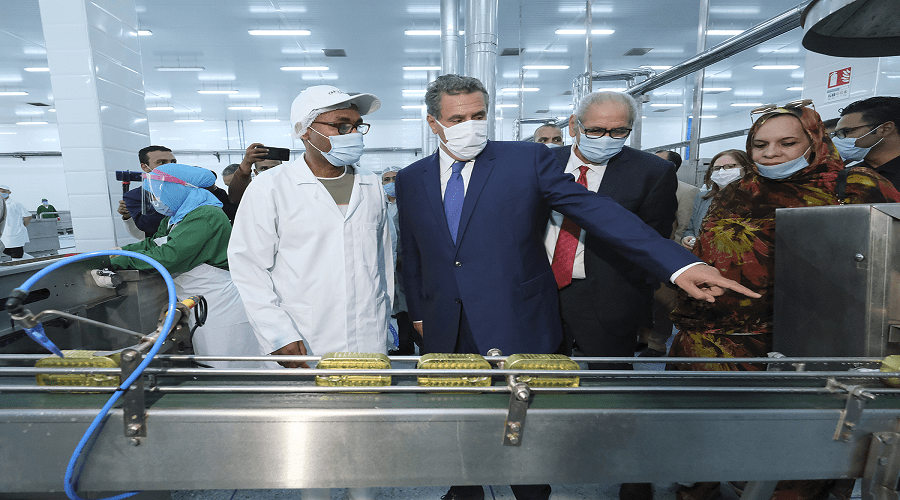
أخنوش يدشن أربع وحدات صناعية لتثمين المنتجات البحرية بالداخلة

التقرير الخاص بالنموذج التنموي يرتكز على الهوية المغربية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق وحدة حفظ الذاكرة

الملك محمد السادس يترأس مراسيم تقديم تقرير لجنة النموذج التنموي

الـ"BCIJ" يتمكن من إيقاف "داعشيين" ينشطان بأيت ملول

تحديد بداية شهر يونيو المقبل للبث في ملف صاحب معمل "فاجعة طنجة"

إجهاض محاولة تهريب 361 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط

هيلين لوغال : المغرب بلد موثوق به وعلى الاتحاد الأوروبي دعمه
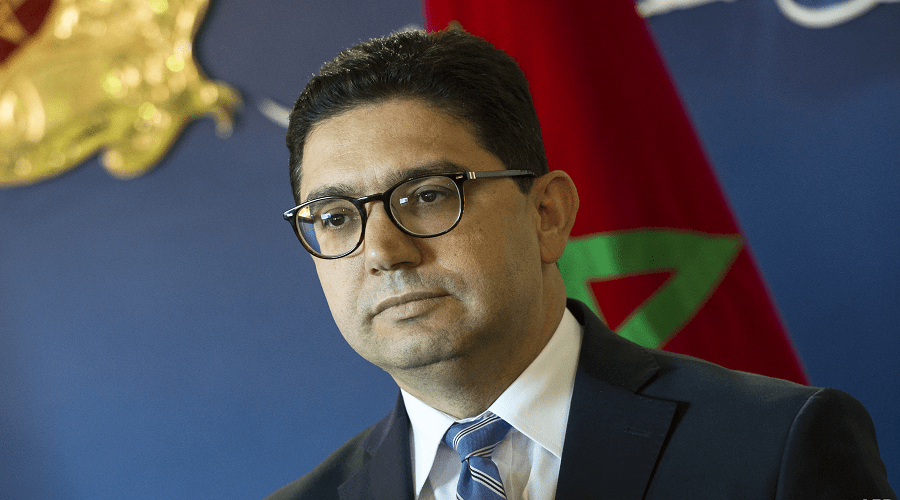
بوريطة يكشف سبب الأزمة مع اسبانيا ويتهمها بـ "ازدواجية الخطاب"

الأمن يطلق النار لإيقاف شبان جانحين على متن سيارتين بالبيضاء

العلماء المغاربة المنسيون ...بينهم أول من ألف رواية مغربية

صناع مجد الألمان المغاربة .. سياسيون ورياضيون ومفكرون مغاربة

القضاء يؤيد قرار إغلاق مقلع للرخام يستغله لبرلماني بنواحي خنيفرة

هل سيتخلى المغرب نهائيا عن استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر؟

مندوب المغرب بالجامعة العربية يشدد على الدعم المادي للفلسطينيين

المديرية العامة للأمن الوطني تفتتح المقر الجديد للفرقة الوطنية

الملك يوجه أوامره السامية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيي

الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية

عفو ملكي يشمل عددا من معتقلي "حراك الريف"

نزار بركة لبابلو كاسادو: استضافة زعيم "البوليساريو" يسيئ بشكل جدي

أخنوش لصحيفة إلموندو: استقبال زعيم البوليساريو يهدد بفقدان الثقة

هل بدأت المخابرات الألمانية تفقد مصداقيتها ؟

Cnss يعطي انطلاقة التسجيل عبر مكاتب القرب للمعنيين بالمساهمة

ONSSA: فاكهة البطيخ الأحمر سليمة وخالية من الملوثات

المحكمة الابتدائية بخنيفرة توزع أحكامها في حق متهمين بصنع وترويج
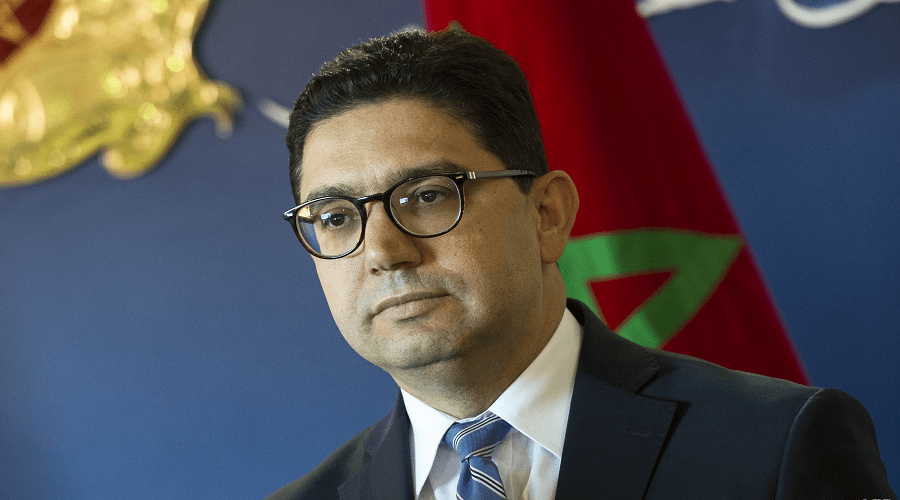
بوريطة يتهم إيران بتسليح "البوليساريو" واستخدامها كأداة لزعزعة

الإضرابات عن الطعام داخل السجون

وزارة الصحة تعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية

الجنرال حرمو يعفي القائد الجهوي للدرك بطنجة بعد فضيحة التهريب

الجمعية الوطنية للإعلام تناقش مع الفردوس وضعية المقاولات الصحافي

ولاية أمن البيضاء تحقق في مشروع سكني ببوسكورة

"الهاكا "تحسم الجدل في الشكايات المطالبة بوقف بث بعض الأعمال

إحالة مخازني على السجن في ملف اعتدائه على شخص بشاطىء الفنيدق

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إدارة بايدن لن تتراجع عن الإعتراف

جهة فاس-مكناس.. التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التأهيل

جمعيات بشفشاون تستنكر تصريحات برلماني "البيجيدي" حول الكيف

وزير الخارجية الأمريكي يكذب مانشرته الجزائر عن مناقشتهما لقضية

تمديد استفادة العاملين بقطاعات الحفلات وفضاءات الترفيه من التعويض

تفاصيل إيقاف المتهم الرابع في شبكة الابتزاز بتطوان

4.34 مليار درهم استثمارات العمران خلال 2021

37 مليار درهم غرامة القضاء لمدير لاسامير السابق

تفاصيل قضية السطو على محل للمجوهرات بطنجة

توقيف مخازنية وإحالتهم على البحث لاعتدائهم على شخص بالفنيدق

هل ستستمر إجراءات الإغلاق وحظر التنقل بعد شهر رمضان؟
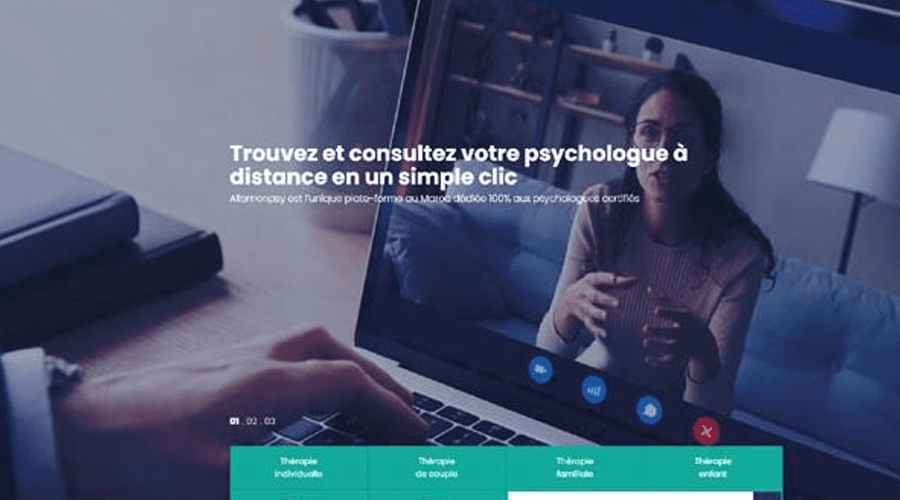
إطلاق أول منصة رقمية مفتوحة بالمغرب خاصة بالأطباء النفسيين

العثماني يتهرب من اجتماع الأغلبية والمعارضة

خبايا الخلاف بين الوالي يعقوبي ومدير " الرباط للتهيئة"

إدانة برلماني من «البام» في مراكش بسنتين حبسا

متابعة 5 متهمين في ملف فوضى باشوية الفنيدق
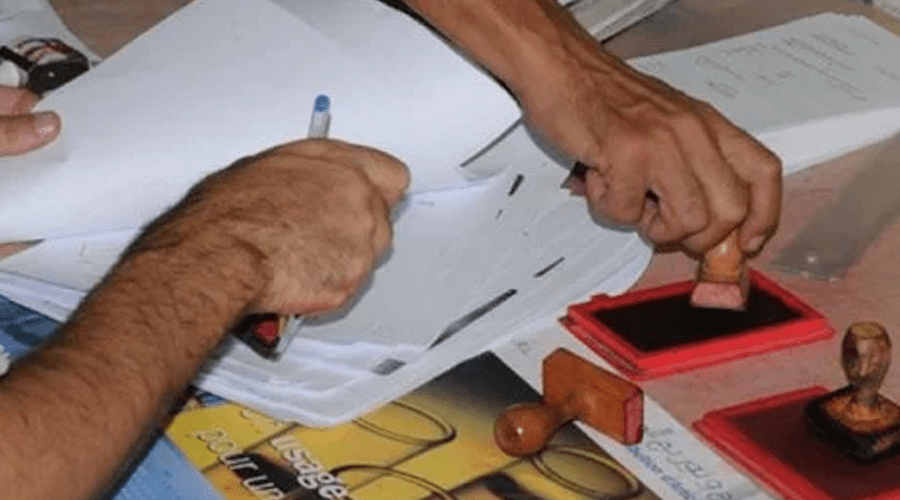
تصحيح الإمضاء وشهادة الحياة... هذه هي الوثائق التي لن تحتاجها

رسميا إعفاء الباكوري من الإشراف على جناح المغرب بمعرض "إكسبو دبي"

اعتقال المتهم الرئيسي في جريمة قتل ستة أفراد بسلا

الخارجية تستدعي السفير الإسباني بسبب استقبال زعيم البوليساريو

التامك يكتب : الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والموقف الأمريكي المخيب

فيروس كورونا.. أمريكا تستثني المغرب من قائمة الدول التي توصي بعدم

الزفزافي يعلن تخليه عن صفة " قائد حراك الريف"

لفتيت يستعرض أمام البرلمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتقنين

تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول تفويت رؤساء "البيجيدي" لصفقات

أمكراز يعفي المدني من إدارة "أنابيك" قبل صدور تقرير أسود للمجلس

مندوبية السجون ترد على سؤال برلمانيي البيجيدي حول وضعية الراضي

13 دركيا في شبكة مخدرات القصر الصغير

رحيل الأمير فيليب.. الزوجان الملكيان البريطانيان والمغرب

الـ cnss : انطلاق عملية تسجيل الأشخاص المعنيين بالمساهمة المهنية

توقيف مراهقين بسبب رشق دوريات أمنية بالحجارة وخرق الطوارئ

متابعة رجل أعمال ومدون بتطوان بتهم ثقيلة وايداعهما سجن الصومال

دراسة حديثة.. دواء شائع للربو فعال جدا ضد كورونا

الملك يترأس بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية

بنكيران يرفض استقبال امكراز واعضاء من حزبه في بيته

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة توزيع الدعم الغذائي "رمضان 1442"

الريسوني والراضي غير ممنوعين من الحديث في الهاتف

الحكومة تنقض وعدها...هذه المشاريع لم تفلح الحكومة في انجازها

متابعة رئيس جماعة بالحسيمة في حالة سراح لتحريضه ضد قانون الطوارىء

وضع رئيس جماعة بالحسيمة تحت الحراسة النظرية
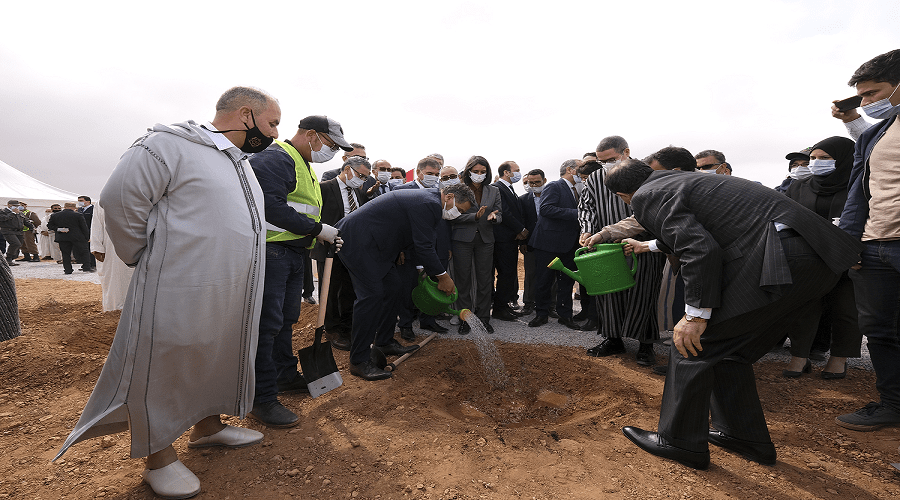
أخنوش يدشن بتزنيت غرس آلاف الهكتارات من شجر الأركان واللوزوالخروب

المحكمة الدستورية تقر بدستورية احتساب القاسم الانتخابي بعدد المسج

الفرقة الوطنية توقف مقدم شرطة بطنجة بسبب تجاوزات مهنية
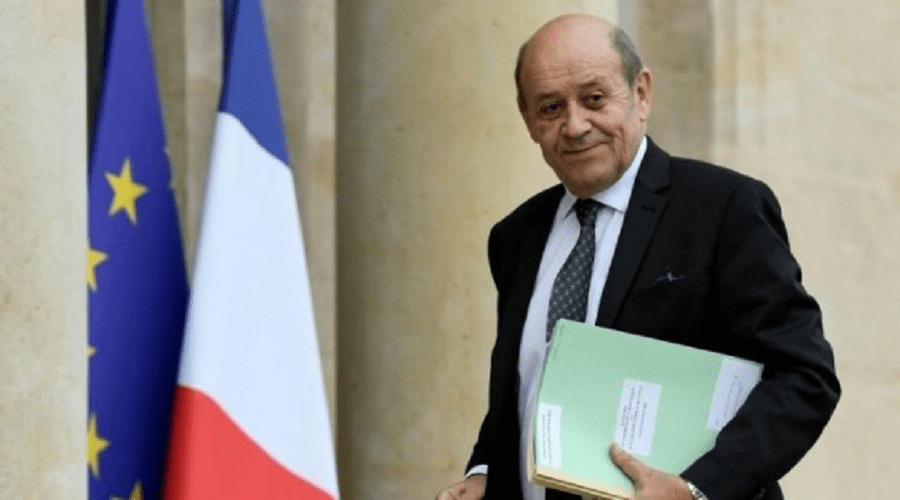
فرنسا تشيد بجودة التعاون الأمني بين باريس والرباط

النيابة العامة بالحسيمة تحقق في تدوينة لرئيس جماعة يحرض على خرق

زينب العدوي تعقد سلسلة اجتماعات وتعد مخططا استراتيجيا

التحقيق في شريط فيديو يتضمن اتهامات للقضاء والدرك بمكناس

العدوي تعتزم افتحاص القطاعات الحكومية قبيل الانتخابات

اتهامات بتبديد المال العام تلاحق الشركة الوطنية للطرق السيارة

"شوديرة" ترسل عاملات بالحي الصناعي بالبرنوصي إلى المستعجلات

مسلسل انهيارات البنايات الكولونيالية بالدار البيضاء مستمر

توقيف أربعيني بطنجة ظهر في شريط فيديو يعتدي بشكل خطير على متشرد

الأساتذة المتعاقدون يتحدون ولاية الرباط والأمن يفرق المحتجين

المخابرات المغربية تنقذ فرنسا من عمل إرهابي كان يستهدف كنيسة
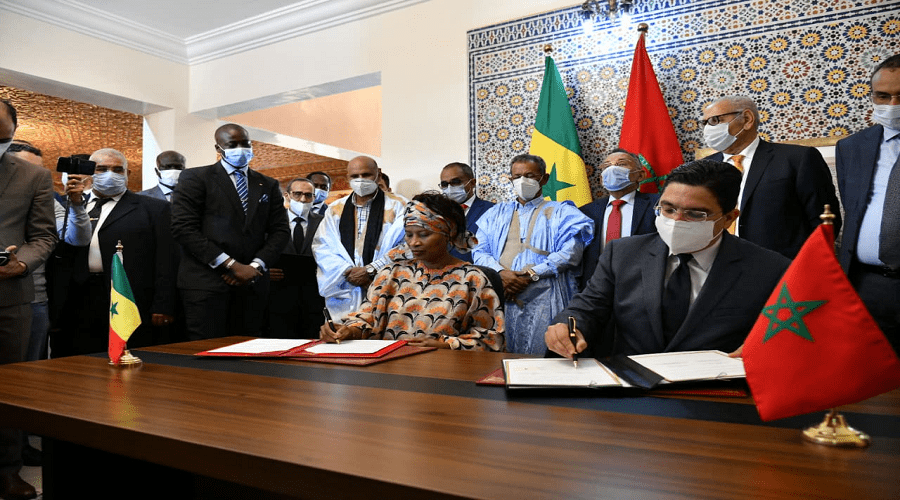
بوريطة ونظيرته السنغالية يوقعان بالداخلة على اتفاقيات تعاون

ست سنوات سجنا لمسؤول بارز بولاية مراكش

قنابل العثماني الاجتماعية للحكومة المقبلة
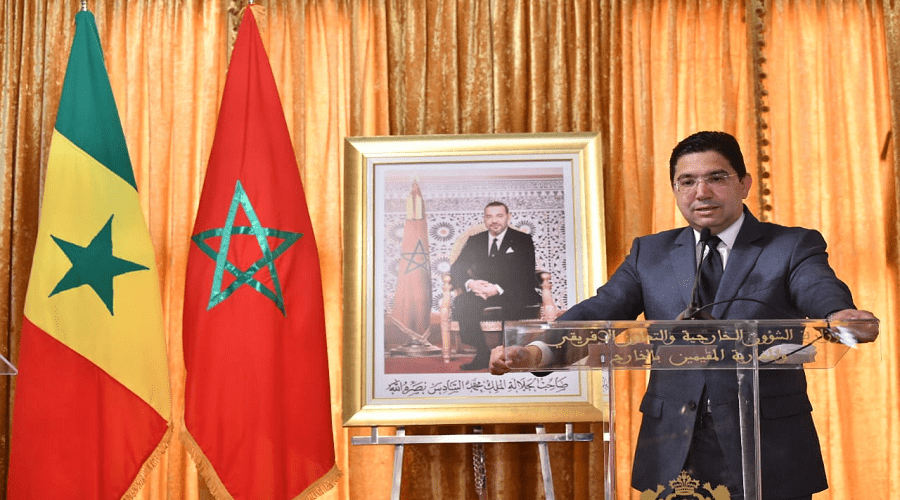
بوريطة يقصف الجزائر من الداخلة ويتهمها بعرقلة تعيين مبعوث أممي
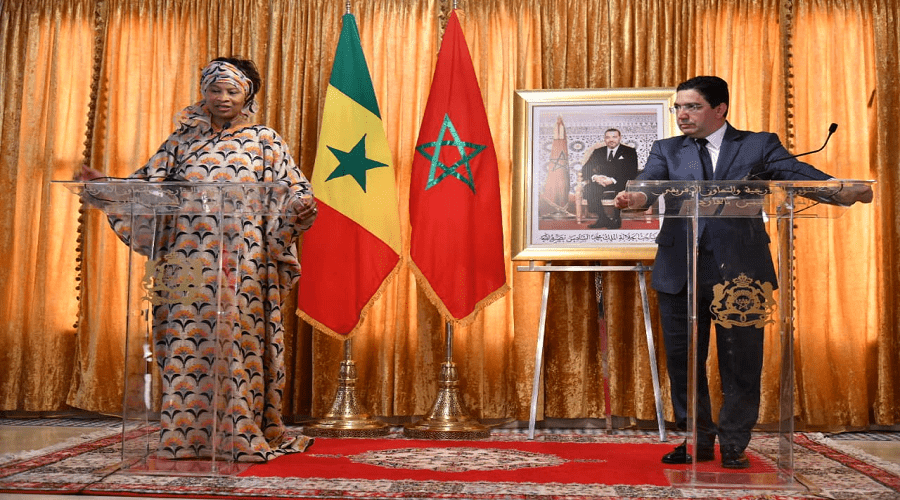
بوريطة: الجزائر هي الطرف الرئيسي والحقيقي في نزاع الصحراء

الممتلكات والحسابات البنكية المفتوحة خارج المغرب

أطباء وخبراء مغاربة يحذرون من خطر انتشار سرطان الرئة

افتتاح قنصلية عامة لجمهورية السنغال بالداخلة

توقيف مقدم شرطة بتطوان للاشتباه في تورطه في النصب للتوظيف بالأمن

سلطات الرباط تمنع أي تجمهر او تجمع بالشارع العام

أخنوش يستقبل الناصري برلماني "البيجيدي" الملتحق بالتجمع الوطني

ثانوية ليوطي تغلق أبوابها لعدم احترام الإجراءات الاحترازية

مهنيو القطاع السياحي يستفيدون من تعويضات صندوق كورونا إلى غاية

30 سنة سجنا في حق "فقيه الزميج" بطنجة المتورط في الاعتداء الجنسي

قضية اغتصاب تطيح بشبكة «سمسرة» في محكمة العرائش

تزييف العملات والخيانة يجر فرنسي وعشيقته بتيفلت للاعتقال
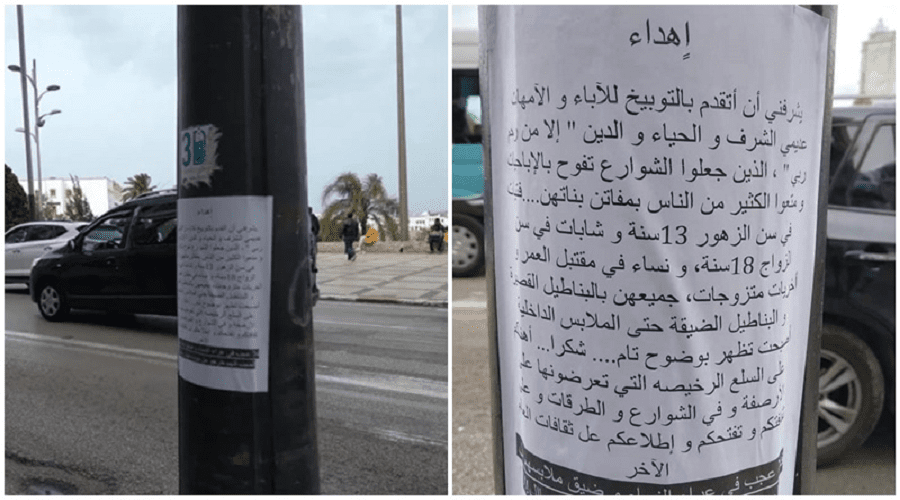
لجنة حقوق الإنسان تدخل على خط منشورات "التبرج"

السكال يعجز في إنعاش منطقة عين جوهرة

تداعيات ملف «الأخبار» حول فضيحة سطو على عقار لأجانب

إدارية الرباط تعزل رئيس جماعة اكزناية رفقة نوابه الستة
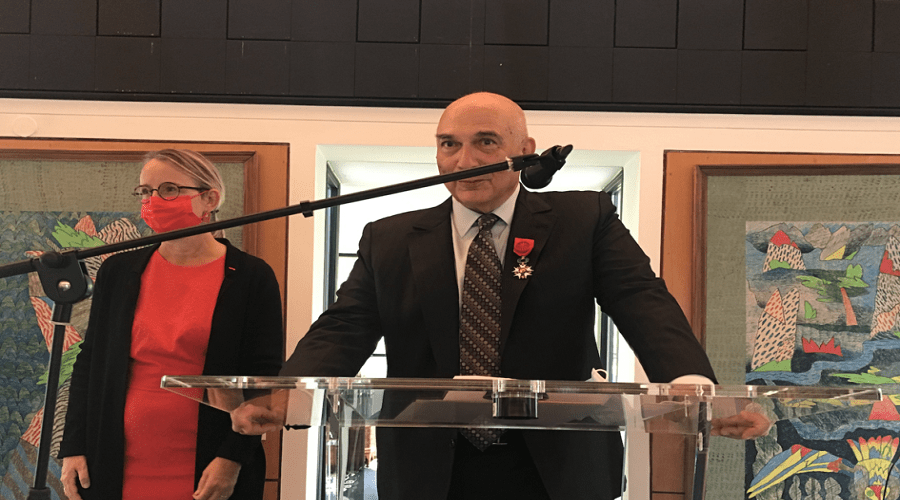
توشيح فرنسي لمصطفى التراب بشارة ضابط من جوقة الشرف تكريما لمساره
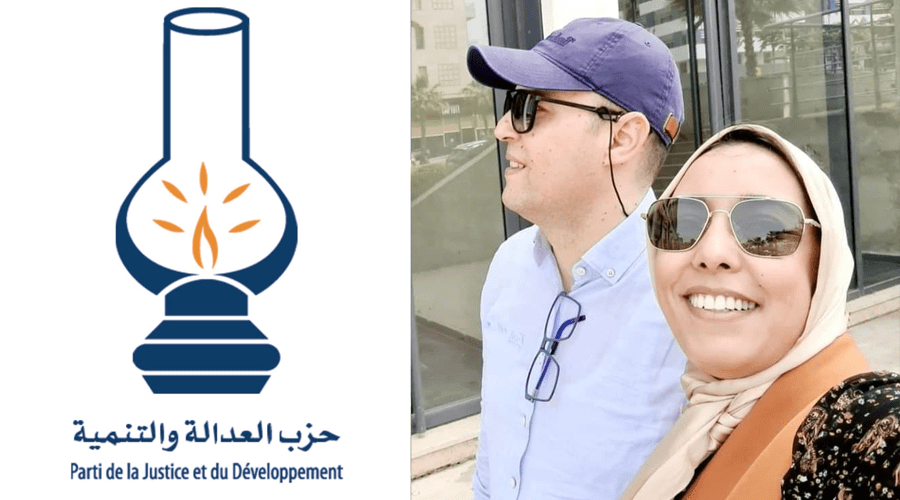
قيادية "البيجيدي" المثيرة للجدل ماء العينين تعلن زواجها للمرة

تحويل مدرسة إلى مرعى للبهائم ببرشيد

ستة أشهر حبسا نافذا للمتسولة الغنية بأكادير

اكتشاف قنينات من القرن 14 بسطح مبنى قديم بطنجة

فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا في قبضة أمن طنجة

تجميد نظام مجلس المستشارين

تزكية لشكر الإبن تضع الاتحاد الاشتراكي على صفيح ساخن

أدخنة مطرح نفايات عشوائي تؤرق بال سكان تزنيت

احتجاج فلاحين بسبب ارتفاع أثمان القنب ببرشيد

التبذير الغذائي يكبد خزينة الدولة خسائر بملايير الدراهم

التحقيق في عراقيل أمام الاستثمار بالشمال

خروقات جنائية بمقاطعة أكدال- الرياض

لعنة صندوق الايداع والتدبير تطارد مدراء سابقين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع نسبة إصابات كورونا وهذه آخر المعطيات

هذا هو موعد رجوع الساعة القانونية بالمغرب

أمن طنجة يدخل على خط منشورات تهاجم «ملابس الفتيات»

عماري يرفض تسوية ملفات حجز تناهز قيمتها 3 ملايير

الخلاف بين ساجد والراضي يربك حسابات حزب «الحصان»

مباريات اختيار مديري المقاطعات تحت أعين ولاية طنجة

عرقلة ورش ملكي تضع نقابيا في مواجهة القضاء

احتجاز نتائج مباراة دكتوراه بكلية عين الشق بعد شهرين من إجراءها

خوفا على شعبية حزبه...العثماني يرفض التشاور حول إصلاح التقاعد

إعادة انتشار واسعة بالمجلس الأعلى للحسابات
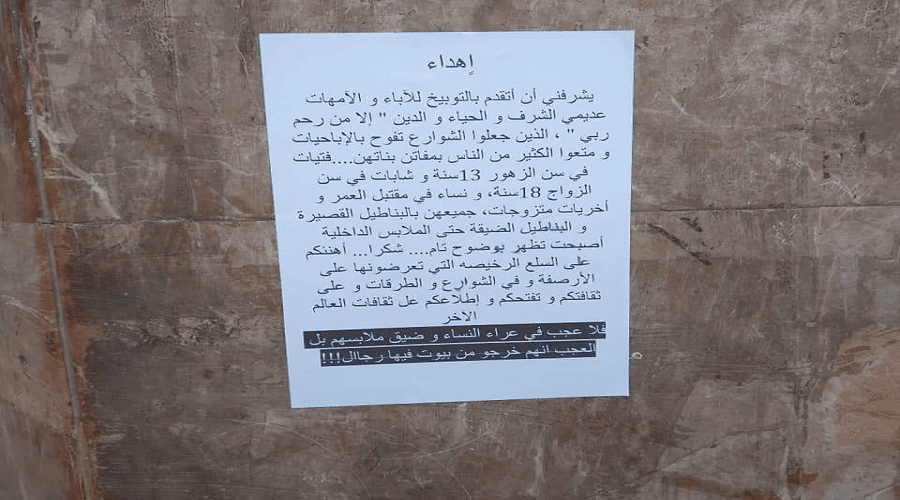
أمن طنجة يحقق في هوية صاحب منشورات بالشوارع تهاجم ملابس الفتيات
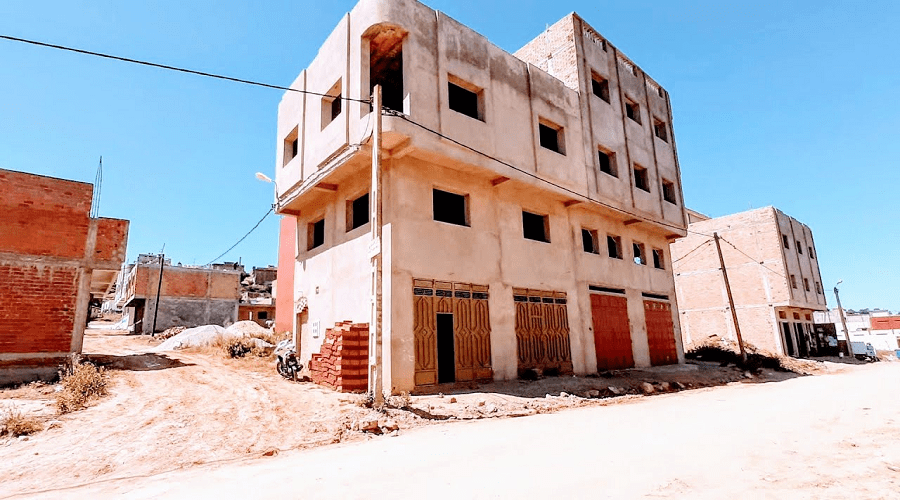
زوج يذبح زوجته بطنجة بسبب المخدرات والاضطرابات النفسية
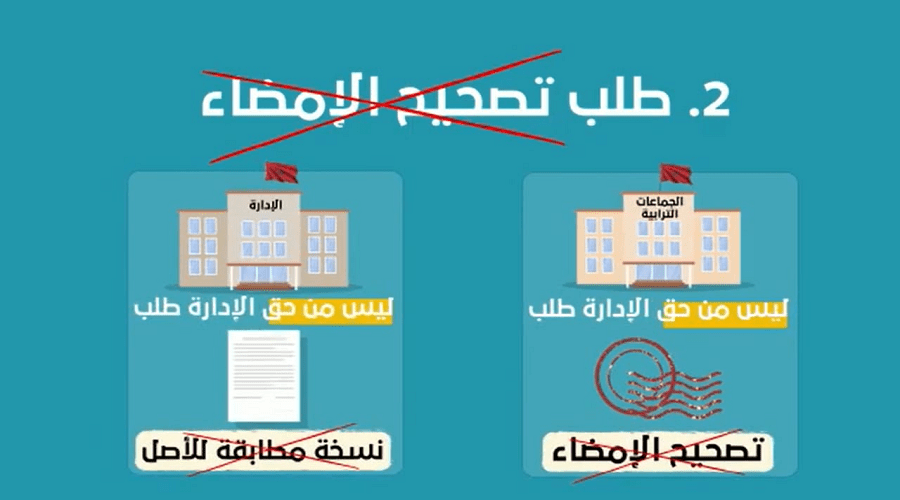
بنشعبون ينهي متاعب المواطنين مع تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق

توقيف شخصين يعرضان المواطنين للنصب عبر إعلانات فيسبوكية وهمية

المديرية العامة للأمن الوطني تكذب مغالطات مؤسسة "ميدل ايست اي"

بتنسيق بين DST وأجهزة الاستخبارات الأمريكية "البسيج" يفكك خلية

الداخلية تتهم منجب بتضليل الرأي العام واستغلال جنسيته الأجنبية

لا وجود لالتزام مغربي لتبادل المعلومات حول حسابات مغاربة العالم

جماعة طنجة تصادق على اعتماد شركتين جديدتين لتدبير النظافة

تعليمات صارمة للولاة والعمال لمراقبة الأسعار وتموين السوق

الملك يعين عبد النباوي رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الملك محمد السادس يستقبل زينب العدوي ويعينها رئيسة للمجلس الأعلى

الملك يعين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة ويحيل ملف المحروقات

وزارة الصناعة تمنع "جوطون" الصباغة
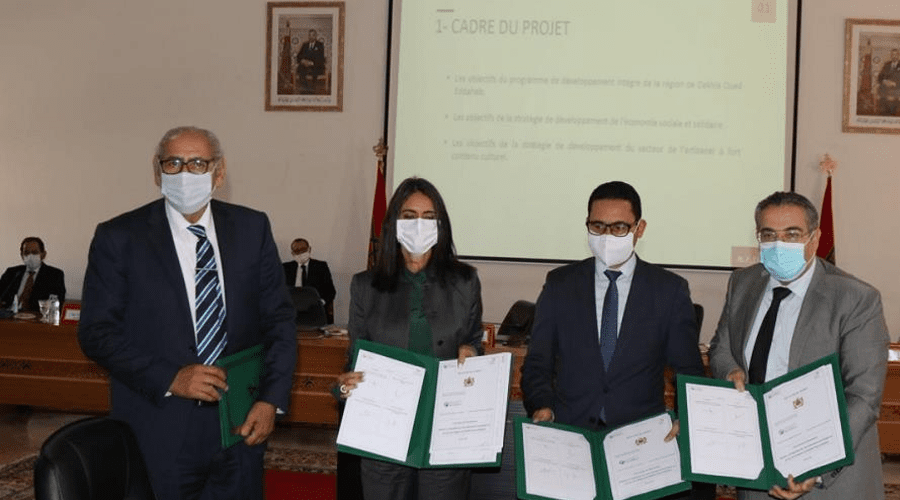
العلوي توقع اتفاقية شراكة جذب استثمار سياحي من مستوى عال

القرض الفلاحي للمغرب سيطلق عرض "اقتناء مزرعة" لسكان المدن

"المشكل فالشرعية والانتخابات مسرحية"، "تبون مزور جابو العسكر"

تفاصيل توقيف الشرطي السابق هشام ملولي بطنجة بسبب خرق حالة الطوارئ
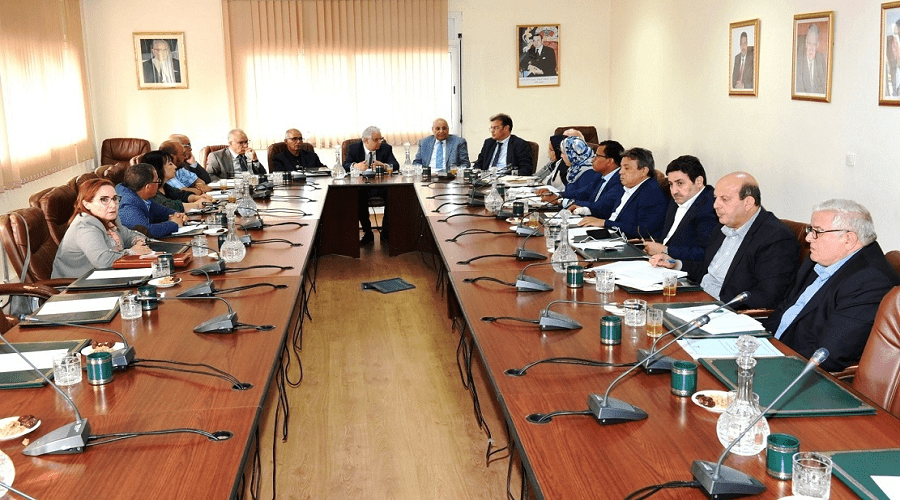
الاستقلال يتحدى الحكومة تقديم حصيلتها للمواطنين

متابعة 53 مسؤولا بمؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة

النيابة العامة تفتح تحقيقا في تعنيف الأساتذة من طرف شخص بزي مدني

اخنوش يستقبل البرلمانية السابقة الزاهيدي التي قادت هجرة جماعية

الداخلية تفتح تحقيقا حول هوية شخص بلباس مدني قام بتعنيف الأساتذة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ضخت 3,5 مليار درهم في خزينة
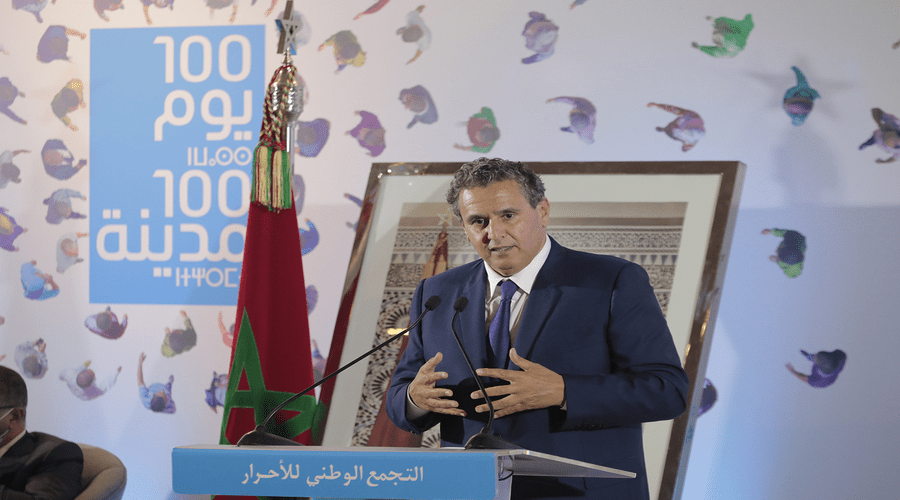
أخنوش يكشف خلاصات برنامج "100 يوم 100 مدينة"
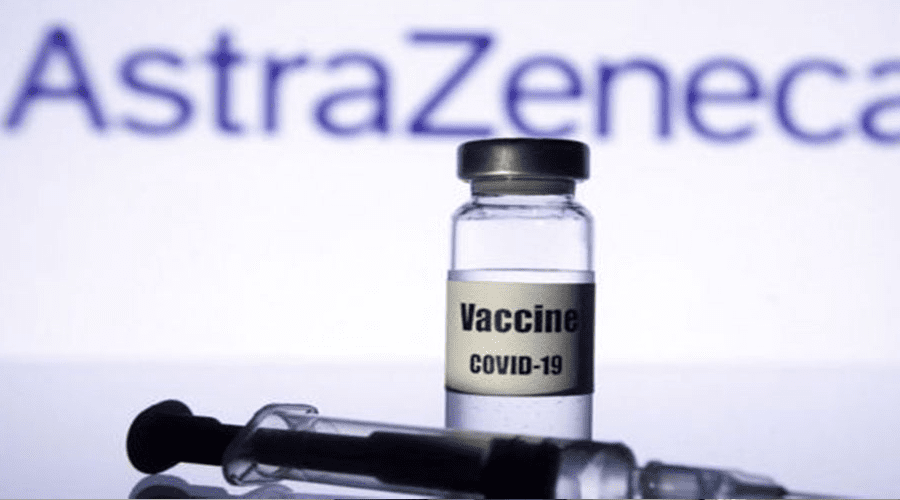
وزارة الصحة توصي رسميا بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

عبد الله العروي يرد على إشاعة وفاته بصورة مع قطته

سار.. الحمامات تعود لاستئناف أنشطتها بالبيضاء بعد أشهر من الإغلاق

عجز الميزانية بلغ 10,2 مليارات درهم حتى متم فبراير الماضي

البنك الشعبي يطلق «باروميتر» خاص بمغاربة العالم

انخفاض صافي حصة مجموعة «طاقة المغرب» بـ 16.5 بالمائة
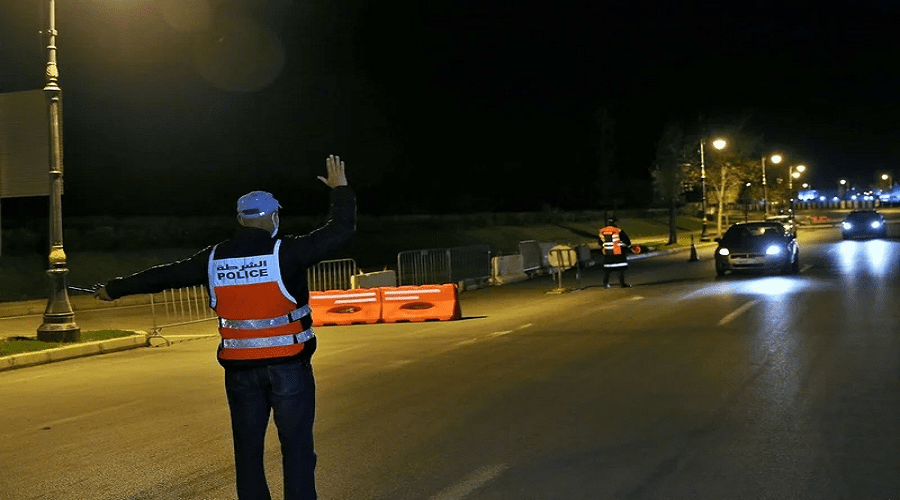
بعد تمديد الإجراءات الاحترازية.. هل سيستمر الإغلاق والحظر الليلي

عامل فجيج يعقد اجتماعا مع الفلاحين الذين منعتهم السلطات الجزائرية

البنك الافريقي للاستيراد والتصدير يوقع اتفاقية قرض ب 350 مليون

العثماني يعزى سبب تمديد الإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين

صحافيون يستنكرون عدم إخبارهم بقرارعائلة بوعشرين إعدام أخبار اليوم

بعد 12 عاما...القضاء يحسم أشهر ملفات السطو على العقارات بكورنيش

استئنافية مراكش تأجل محاكمة عمدة آسفي

شبكات نصب تعرض هبات دولية وهمية على الأشخاص

المغرب يقرر تسليم مواطن سعودي مبحوث عنه من طرف الإنتربول

إيغل هيلز تغطي عيوب بنايات مارينا سلا استعدادا لزيارة وفد إماراتي

فيديو مخل بالحياء يجر ممرضتين متدربتين للتحقيق بطنجة

بعد أشهر من اختفائه أمن طنجة يهتدي للمتورط الثالث في مقتل دركي

دركي خمسيني ينتحر بمسدسه الوظيف بالهرهورة بعد انتهاء فترةالمداومة
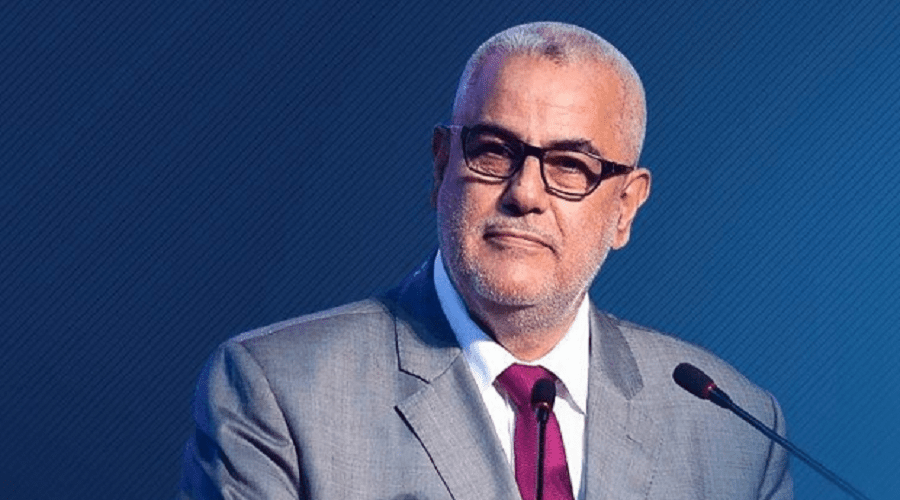
بنكيران يعلن تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية

مسؤولون بمهرجان فاس للموسيقى الروحية أمام القضاء بتهم الاختلاس

توقيف ممرض متقاعد يشتبه في تورطه في ممارسة مهنة الطب بشكل غير مشر

زيان مهدد بالافراغ من شقة تابعة للأوقاف

متابعة مستشارة جماعية بالصويرة بتهمة التحرش الجنسي برجل متزوج

مهيدية يؤكد على متابعة جميع من يثبت تورطه في تجميد التعمير
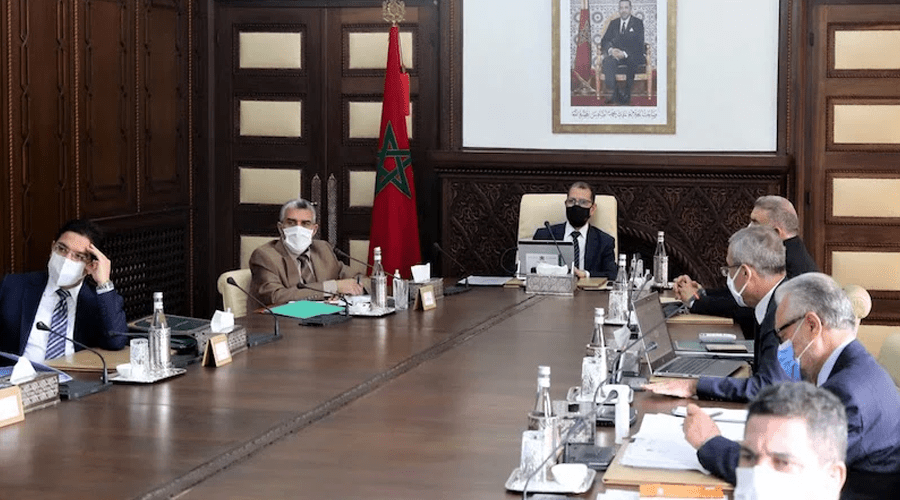
عاجل ..مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون "القنب الهندي"

التلويح بالاستقالة من الـPAM يفجر صراعات بالمكتب الجهوي للحزب

الباطرونا تشدد قيودها على "رحل" السياسة

الداخلية تنهي تعديلات قوانين الجماعات الترابية

احتقان اجتماعي واحتجاجات بالتعاون الوطني

هكذا تحول السوق المركزي بسلا من معلمة أثرية إلى مكب للنفايات

خطوة استباقية..رؤساء جماعات بالعرائش يطالبون بزراعة «الكيف»

هذه اجراءات المغرب لسد الطريق على التهرب الضريبي
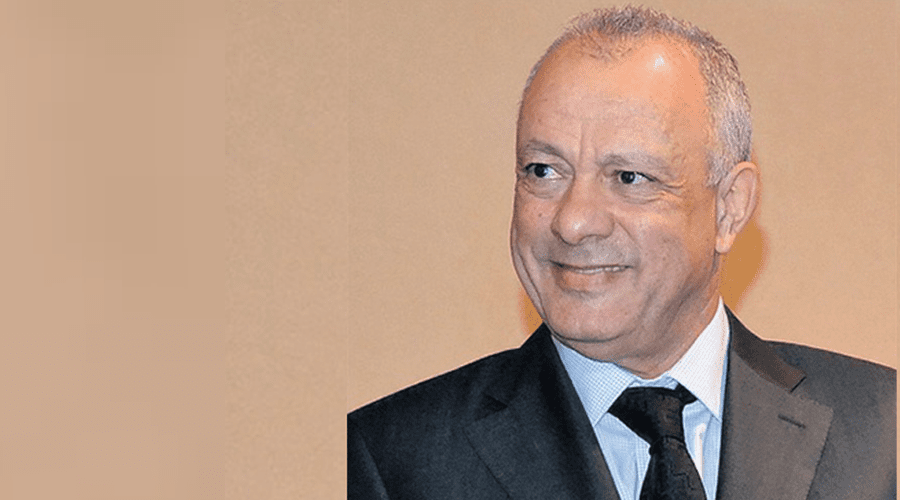
والي طنجة يأمر بالتحقيق في أسباب الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق

أطباء يكشفون المستور عن ظروف التكوين بمستشفى أكادير

تكوين الاطر يجمع المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجامعة "هارفارد"

مشاريع لانقاذ الجماعات السلالية بشفشاون من قبضة اللوبيات العقارية

احتجاجات ضد إدارة مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية

ايت الطالب يرفض افتحاص صفقات " كوفيد 19"

وزراء البيجيدي يطيحيون بمسؤولين كبار في وزاراتهم

بمناسبة 8 مارس ..ضحية الراضي تحتج ضد جمعية حقوقية

المصير المجهول يلاحق ملفات لاستثمارات ضخمة على طاولة العثماني

الرميد يدير ظهره لبنكيران ويدعم تقنين "الكيف"

أزمة كورونا تخرج أرباب المقاهي للاحتجاج على وزارة التشغيل

الداخلية تصفع بوانو وتعترض على بيع ممتلكات جماعة مكناس

الودادية الحسنية للقضاة تشجب بشدة مغالطات لهئية دفاع المتهم

كوميسير مزور روع أحياء راقية بالرباط وسلا والقنيطرة في قبضة الأمن

صرف تعويض الضمان الاجتماعي لأطر الحضانات والصناعة الثقافية

هذه أسباب عزل رئيس جماعة اكزناية

الاشتغال خارج الضوابط القانونية يضع مطعم ABEL في دائرة الاتهام

8 ملايين جرعة لقاح لكورونا تضع المغرب في صدارة القارة

أولى جلسات محاكمة عمدة مراكش ونائبه في محكمة جرائم الأموال

كورونا تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمغرب

مجلس المستشارين يواجه أكبر عملية استقالة جماعية في تاريخه

رفاق منيب يتغيبون عن تقديم تعديلات قوانين الانتخابات

مسدس بجانب القمامة يستنفر درك الصخيرات

السلطات تفكك مخيم المهاجرين الأفارقة بشارع أولاد زيان وتحجز أسلحة

الأمن يوقف جانحا ظهر في فيديو بالجديدة يهدد تلميذة بالسلاح الأبيض

فيضانات بمدن الشمال تعلق الدراسة وتستنفر لجان الانقاذ واليقظة

فيضانات قوية تغرق منازل مجاورة لواد القصر الصغير بضواحي طنجة

إحالة 32 قضية سرقة للرمال بسواحل العرائش على القضاء

المديرية العامة للأمن الوطني تكشف إجهاض عملية تهريب سبعة أطنان

"بلوكاج" في جلسة التصويت على القوانين الانتخابية

انتشال جثة شخص ونجاة ثلاثة اخرين في انهيار جزئي لبناية ببني ملال

المغرب ضيف شرف الدورة السابعة لمنتدى إفريقيا الفلاحي بياوندي
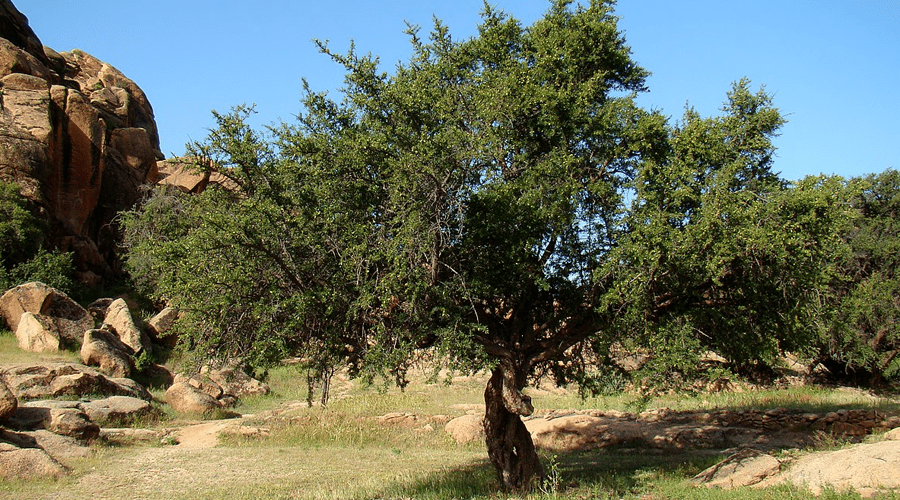
الأمم المتحدة تعتمد 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان

ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 6,23 بالمئة متم فبراير

التوقيع على اتفاقية بين وزارة السياحة و "التجاري وفا بنك"

انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 53,9

وزارة التربية الوطنية تطلق النسخة المحمولة من نظام المعلومات مسار

أخنوش يدشن سوقا للسمك بباب برد بشفشاون

العمدة صديقي يحرم الرباط من الميزانية للعام الثاني

الأمطار تعري اختلالات صفقة كلفت 3 ملايير و500 مليون بتازة

رئيس مقاطعة اليوسفية أمام قاضي التحقيق بالرباط

«بيدوفيل» متهم بالتغرير بقاصر في قبضة الدرك بالهرهورة

تقرير جطو يرعب رؤساء الجماعات وعمداء المدن

إدانة رئيس جماعة وبرلماني ب9 سنوات سجنا نافذا

العزل لرؤساء جماعات ومنتخبين قبل الانتخابات

توالي الاستقالات يخلق أزمة بـ«البيجيدي» قبيل الانتخابات

عمدة آسفي يصطدم بالداخلية ويواجه استقالات

رئيس الباطرونا أمام لجنة استطلاعية حول البنوك

لجنة برلمانية تستنطق رباح حول مكتب الماء والكهرباء

أمزازي يطلق حملة تفتيش واسعة بالكليات والمعاهد العليا

استئنافية مراكش تؤيد متابعة محاسب مجلس المستشارين
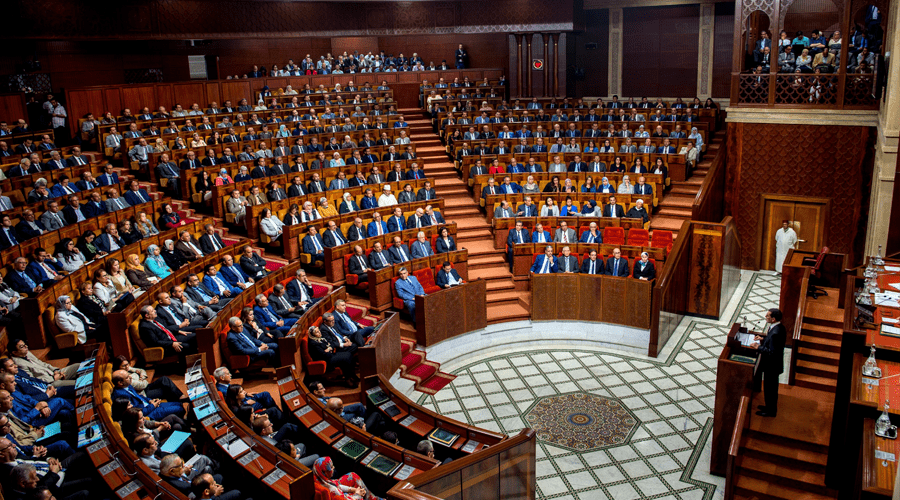
البرلمان يدخل على خط التحقيق المالي في صفقات وكالة محو الأمية
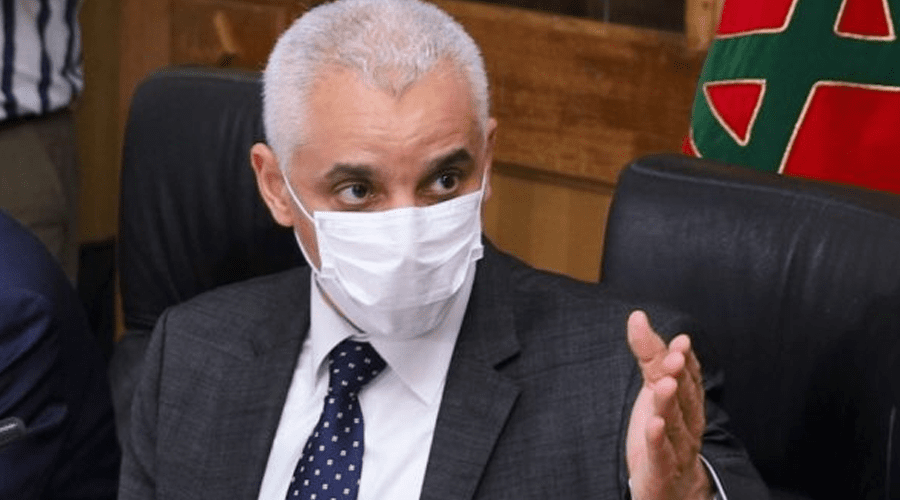
الغموض يلف رفض أيت الطلب التحقيق في صفقات كوفيد 19

الرميد يكشف حيثيات استقالته من الحكومة ورفضها من طرف الملك

تطوان تتنفس تحت الماء
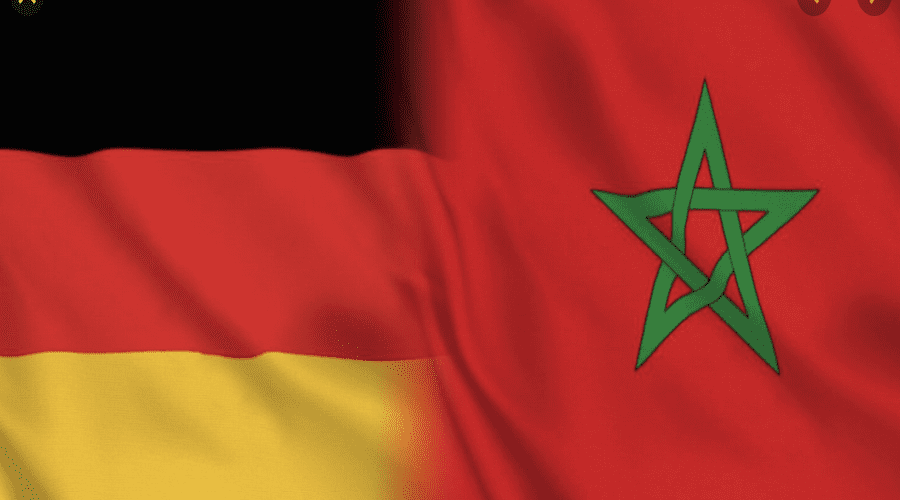
المغرب يقرر تعليق جميع العلاقات وآليات التواصل مع سفارة ألمانيا

اختفاء تجهيزات بمستودع جماعة اكزناية يستنفر درك طنجة

صراعات ببيت منيب بأوطاط الحاج

الداخلية ترفض اتفاقيات صادق عليها رباح بالقنيطرة

تساؤلات عن مصير ملايير الحماية من الفيضانات بطنجة

مصرع مستشار جماعي حرقا في حادثة سير ببرشيد

سقوط عصابة تستهدف هواة الرياضة بغابات سلا

بمساعدة من "الديستي"..اعتقال أجانب حولوا فيلا في مراكش إلى كازينو

هذه نتائج الحملة الوطنية للكشف عن كورونا في المؤسسات التعليمية

"أونسا" تنهي الجدل في قضية خليع الحمير بفاس

انفجار "قناة" قرب محطة القطار البيضاء الميناء يربك حركة السير

الرميد يقدم استقالته من الحكومة

الأزمي يقدم استقالته من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة لحزب

دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية

تفكيك شبكة للتهجير السري والنصب تستدرج ضحاياها عن طريق "الفيسبوك"

وفاة ثالث قاضي بدائرة محاكم طنجة بسبب فيروس "كورونا"

فيدرالية الصناعات الغذائية تحذر من تداعيات الارتفاع المستمر لأثمن
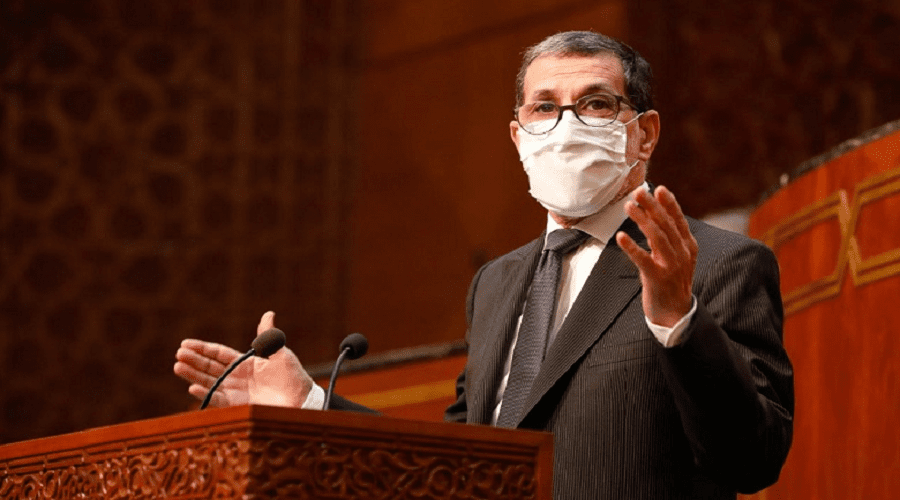
العثماني يؤجل الحسم في مصادقة الحكومة على مشروع قانون "الكيف"

تزكيات" الرباط تفجر اجتماع المكتب السياسي لـ"البام"

التهديد بسلاح ناري يتسبب في إيقاف نجل رئيس جماعة

انهيار جزء من شقة يربك حركة السير بشارع محمد الخامس بالبيضاء

الترامواي يقطع الماء عن البيضاويين نهاية الأسبوع

الصراع يحتدم بين «البيجيدي» ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بسلا

اعمارة يواصل التعيين في مناصب عليا بالوزارة

بعد حكم الإعدام.. قاتل عدنان أمام محكمة الاستئناف بطنجة

24 مليارا لتمديد خطوط «ترامواي» البيضاء

وفد السفارة الأمريكية بالرباط يزور مقر المينورسو في العيون

تعديلات جديدة في نظام التصريح بالممتلكات

تدهور الوضعية المالية للنساء خلال فترة الحجر الصحي

محطة "نور" للطاقة الشمسية تزود نحو مليوني مغربي بالكهرباء

35 مليار أورو من المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

المنتجون الوطنيون لزيت المائدة يلتزمون بالحد من أثر ارتفاع

"سهام للتأمين" تحقق رقم معاملات بلغ 5126 مليون درهم

مصباح واحد يكلف جماعة طنجة 600 درهم

13 رئيس مدينة ممنوعون من الترشح للانتخابات البرلمانية

عودة شباط تشعل الصراع الانتخابي بفاس

الداخلية تنهي أزمة المتضررات من إغلاق باب سبتة

هيرفي رونارد يسقط ضحية الابتزاز الجنسية

هذه أسباب ارتفاع أسعار "لوسيور كريسطال"

3 سنوات سجنا نافذا في حق مخرب حافلات البيضاء الجديدة

عصابة للسرقة وترويع المواطنين تستنفر أمن طنجة

ثلاثيني يحاول إحراق زوجته وطفليه انتقاما لعشيقته بتمارة

منصة رقمية لمعالجة الملفات تثير حفيظة صناع أدوية

بلوكاج يهدد بحل مجلس جهة درعة تافيلالت

الحجز على أموال وكالة محاربة الأمية

فتح تحقيق في تهديدات بقتل قيادية بشبيبة «البيجيدي»

8 جماجم بشرية تستنفر الأمن بالدار البيضاء

البام يحسم مرشحيه للانتخابات القادمة

استمرار معاناة التوأم السيامي الملتصقتين بقلب واحد

المغاربة هم الاكثر انخراطا في صندوق الضمان الاجتماعي بإسبانيا

الاتحاد الأوروبي يسحب المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

إقبار الحي الصناعي يورط «البيجيدي» في سلا ويعمق أزمة شباب المدينة

توقيف أشغال البناء وسط المحكمة الإدارية بأكادير

بالوثائق... تلاعبات واختلالات خطيرة بمديرية الأدوية والصيدلة

وزارة العدل تحيل "غشاشين" في مبارياتها على الضابطة القضائية

حريق مهول يفضح مستودعا سريا جديدا للنسيج بطنجة

اختفاء 192 مليونا لودادية سكنية بخريبكة

21 فيروسا متحورا إنجليزيا من كورونا في المغرب ولا أثر للجنوب

النيران تلتهم مصنعا ومنزلا بالبيضاء

استمرار احتجاجات الفنيدق ورفع شعارات تنادي برحيل سياسيين
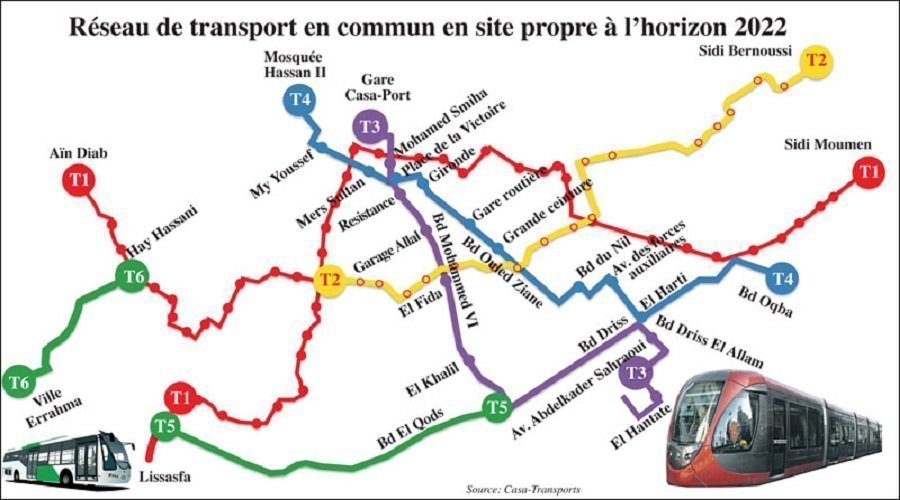
حافلات الـBHNS تفجر صراعات بين نواب العمدة ومدير "البيضاء للنقل"

بتنسيق مع DEAالأمريكي ضبط 500 ألف قرص مخدر بين ميناء طنجة والمطار

"اتصالات المغرب" تحقق رقم معاملات بقيمة 36.7 مليار درهم

ادارية الرباط تؤيد حكما ضد شركة «صابو» بطنجة

ملف عزل رئيس جماعة اكزناية أمام المحكمة الإدارية بالرباط

54 في المائة النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة

جمعية شركات اللوحات الإشهارية تنفي علاقتها بالاعلانات اللاأخلاقية

رئيس مقاطعة اليوسفية ونائبه وموظفون أمام القضاء بالرباط

تضييع أموال العاصمة يورط العمدة صديقي

مؤسسة ورزازات الكبرى تدين تطاول الإعلام الجزائري على المغرب

قاضي التحقيق يقرر إيداع مالك معمل "فاجعة طنجة" بالسجن

غياب الموارد البشرية يعمق معاناة مرضى السرطان بمدن الشمال

احتراق سيارة يستنفر الساكنة بالجديدة

شاب سوري يقتل عشيقته المغربية باسطنبول في عيد الحب

«cnss» يرفع من الحد الأقصى للمعاشات

هذه تفاصيل قانون الحماية الاجتماعية المصادق عليه بالمجلس الوزاري

حرب «التزكيات الانتخابية» تستعر وسط «البام» بالرباط

خسائر مادية بعد تساقط حجارة من عمارة السعادة وسط الرباط

أربع سنوات سجنا لمستشار سابق بـ"البيجيدي" ومقاول بالقنيطرة

إدعمار أمام ابتدائية تطوان بسبب التزوير بالمنطقة الصناعية

تفكيك عصابة بالصخيرات هاجمت قاضية وسرقت هاتفها

تفكيك عصابة بالصخيرات هاجمت قاضية وسرقت هاتفها

الفرقة الوطنية تواصل تحقيقها في فاجعة ذبح أسرة بسلا

استئنافية مراكش الإدارية تؤيد عزل رئيس جماعة آيت ملول

مكاسب سياسية وراء طعن وهبي في توزيع أموال صندوق معاشات

مطالب للحساني بتدارك فشل جهة الشمال في التنمية

عدوى الاستقالات تصيب «بيجيدي» القصر الكبير

مجلس رباح يصوت يسقط عريضة لتخفيض تسعيرة النقل الحضري بالقنيطرة

تطورات مثيرة في ملف البرلماني بلفقيه المتابع أمام محكمة جرائم

جريمة قتل تعيد البارون الزعيمي إلى قاعات المحكمة

طلبة ببني ملال يقرصنون حسابات بنكية عبر الإنترنيت

وزارة التربية الوطنيةتحقق في ريع نقابي لـ «البيجيدي» بسيدي قاسم

نقل صاحب معمل "فاجعة طنجة "لولاية الأمن لاستكمال التحقيق معه

اعتقال متهم بالنصب والاحتيال على ضابط بالدرك في 37 مليون بسطات

متاعب الوزير السابق مبديع مع القضاء لا تنتهي

الصديقي يضيع ملايين الدراهم على خزينة العاصمة يسبب المحجز البلدي

منتخبو «البيجيدي» يصوتون على القرارات خفاءا ويعاضونها علنا

البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ممنوع من مغادرة التراب الوطني

إخوان العثماني يفشلون في وقف نزيف الاستقالات بالشمال

مطالب بوقف تفويت مستشفى القرطبي بطنجة

الملك يبارك حفل عقد قران الأميرة لالة نهيلة كريمة الأميرة لالة

تعرض إحدى حافلات ألزا للتخريب ساعات قليلة بعد دخولها حيز الخدمة

حزب التجمع الوطني للأحرار يدين الاستفزازات الإعلامية الجزائرية

أبوزيد:سيكون المغاربة قد فقدوا الذاكرة إن صوتوا للعدالة والتنمية

مندوبية السجون هي من أقنعت معتقلي الريف برفع إضرابهم عن الطعام

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تستنكر إساءة قناة جزائرية للملك

متطوعون بتطوان ينقذون أسرة من موت محقق بسبب حريق منزل

الداخلية تدرس مطالب المحتجين بتوفير الشغل بالفنيدق

الملك يحسم قرار توفير التغطية الاجتماعية والصحية لجميع المغاربة

اتفاق لتبادل الوفود الطلابية بين المغرب وإسرائيل

توأمان في جسد ملتصق وقلب واحد حالة إنسانية نادرة بإقليم سيدي قاسم

وزارة الأوقاف تقاضي زيان لهذا السبب

العثماني يخوض حربا باردة ضد أمزازي

فريق مستشاري البيجيدي يطمع في الفوائد البنكية لمعاشته

سوق الشغل يخسر آلاف الوظائف

دخان الفحم يخنق أنفاس سكان سيدي سليمان

فاجعة طنجة تجر اتهامات برلمانية لحكومة العثماني

برحو رئيسا للأمن الجهوي بالداخلة

التجاري وفا بنك يطلق بوابتين رقميتين جديدتين

مجموعة (LPF) الفرنسية تفتتح مصنعا جديدا لها بالدار البيضاء

ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5 بالمائة

"إنوي" تحصل على شهادة الإعتماد PCI-DSS

المديرية العامة للضرائب توفر خدمة إلكترونية لتقديم الشكايات

عرقلة نقابي لمشروع ملكي ينذر بغضبة تقترب من ولاية الرباط

البرلماني بلفقيه و10 متهمين أمام غرفة الجنايات بالرباط

مرضى القصور الكلوي بجهة طنجة امام مشكل خصاص الأطر

وحش آدمي متهم باغتصاب طفلة عمرها ثلاث سنوات بالصخيرات

قيادي يعترف بركوب «البام» أمواج «الكيف» بالشمال

حكم قضائي يكلف جماعة أصيلة 18 مليون درهم ويثير جدلا

الكلفة المالية تعطل الهيلكة الجديدة لمجلس المستشارين

بلوكاج داخل اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول صفقات وزارة الصحة

FBI و CIA "يشيدات بالتعاون مع " الديستي

رسوم جديدة على مقالع جهة طنجة

الأشغال تفجر سخط أصحاب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة

الاستماع لرئيسة جماعة في ملف مجزرة أولاد زيان

سوء التسيير يدفع مستشارين من «البيجيدي» بإقليم المضيق للاستقالة

اتهامات للعثماني بعرقلة مشروع للاستثمار العقاري

الأمطار تحاصر وتغرق 24 عاملا في وحدة صناعية سرية بطنجة

إقصاء جمعيات من منح جهة كلميم يجر الغضب على مجلس الجهة

درك برشيد يفك لغز سرقة محلات بيع الهواتف النقالة بالدروة
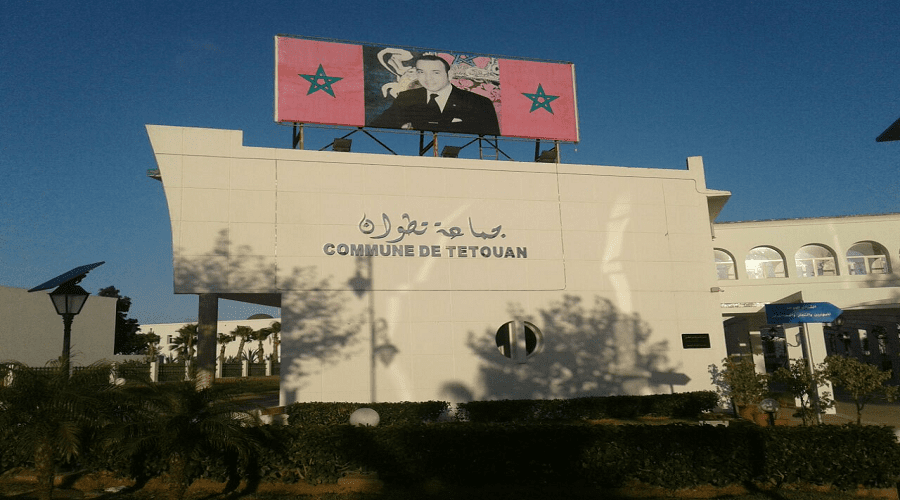
اتهامات لجماعة تطوان بالتكؤ في معالج أخطار مصلحة الإنارة

ملف خصاص الأطباء ببولمان يصل آيت الطالب

إيقاف مسافريْن بمطار العيون أدليا بشهادتين مزورتين لتحاليل كورونا

«البيجيدي» يواري استقالات وغضب قيادييه في الشمال

عمدة البيضاء ينسب تأخر تسليم مشاريع المدينة للجائحة
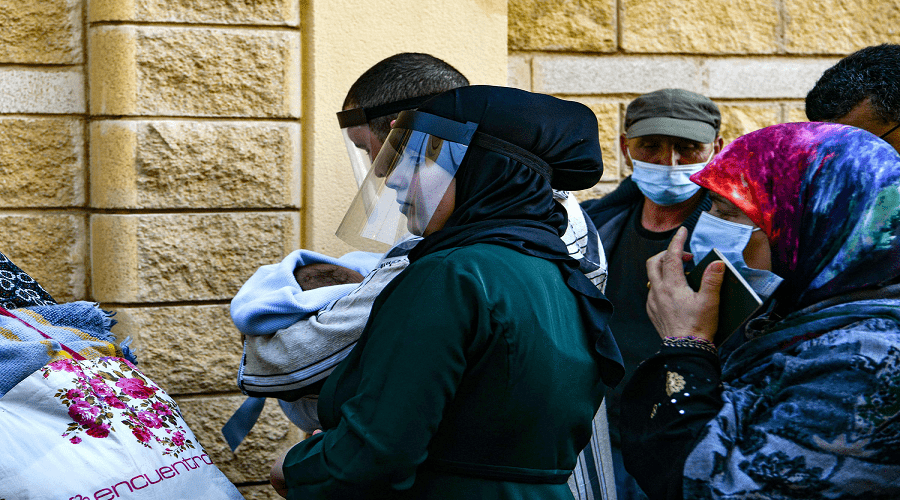
غياب ثقة المواطنين يورط الأحزاب السياسية

لفتيت يرفض مقترحا للأحزاب بزيادة 15 مقعدا برلمانيا

أمن كلميم يعثر على 10 أطنان من الشيرا مدفونة تحت التراب

جريمة نحر أسرة بسلا ...الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا

جريمة نحر أسرة من ستة أفراد تهز مدينة سلا

برلمان الأحرار يفوض لأخنوش تدبير التحالفات

رسالة مجهولة تستنفر إدارة «لانابيك» والمدني يجمع التوقيعات

ملف التشغيل بوزان يشعل الخلاف بين المحرشي وأمكراز

الدور الآيلة للسقوط تصل البرلمان

شاب يفقأ عين عشيقته تم ينتحر بمكناس

جرائم جنسية بحق قاصرين تجر أستاذا بقلعة السراغنة للتحقيق

الحموشي يحدث تغييرات بنيوية لدعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوب

فوضى مواقف السيارات تكشف فشل رئيس جماعة سطات

10 سنوات سجنا لبرلماني يتزعم مافيا العقار

بعد معاناتها مع «كورونا».. لطيفة رأفت تشجع على اللقاح

8 ملايين من لقاح ضد كورونا في طريقها نحو المغرب قريبا
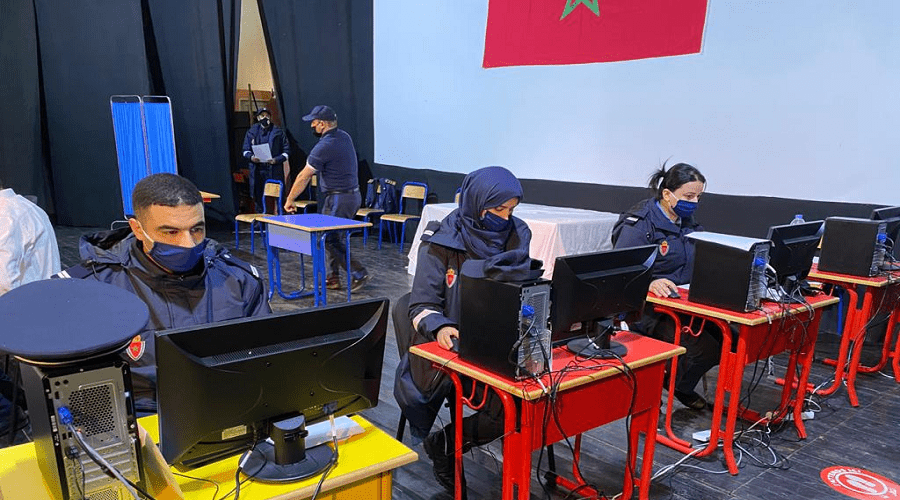
تلقيح موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بنشعبون يتوقع تعافي الاقتصاد المغربي في النصف الثاني من 2021

العثماني يرفض الغاء الجمع بين المنصب الوزاري ورئاسة الجماعات
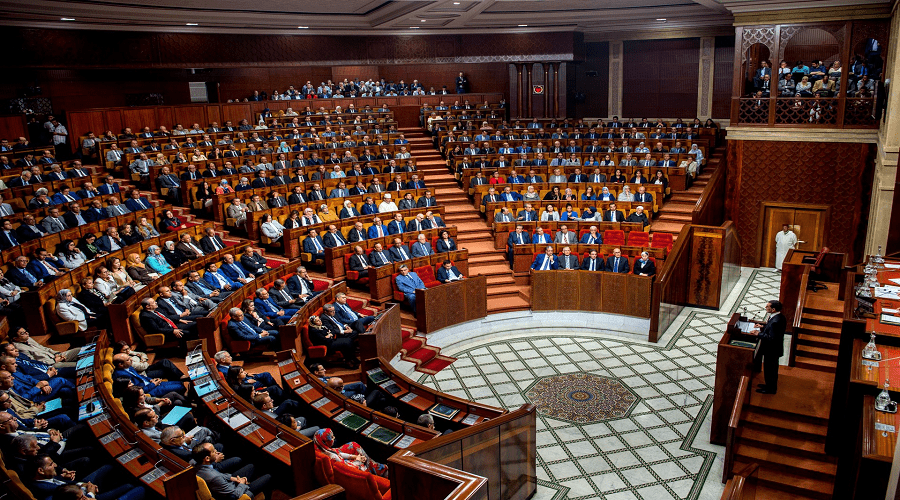
مجلس النواب يتراجع عن تصفية معاشات المستشارين

«التكوين عن بعد» يشل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

المحكمة الإدارية بالرباط تفتح ملف رئيس جماعة اكزناية و6 من نوابه

هكذا تحولت مقاهي المنتزه البحري بالبيضاء إلى مراحيض

النيابة العامة بتطوان تدخل على خط الاعتداء على مقابر

سيارات الكوكايين تستنفر أمن طنجة

الداخلية توقف رخصة بناء لبلدية البئر الجديد

المتابعة لرئيسة تعاونية وأمين مالها ببرشيد

مروجة أدوية مهربة تستعمل في الإجهاض بالقنيطرة في قبضة الأمن

الاستفادة من لقاح كورونا يجر رئيس مجلس عمالة الصخيرات – تمارة
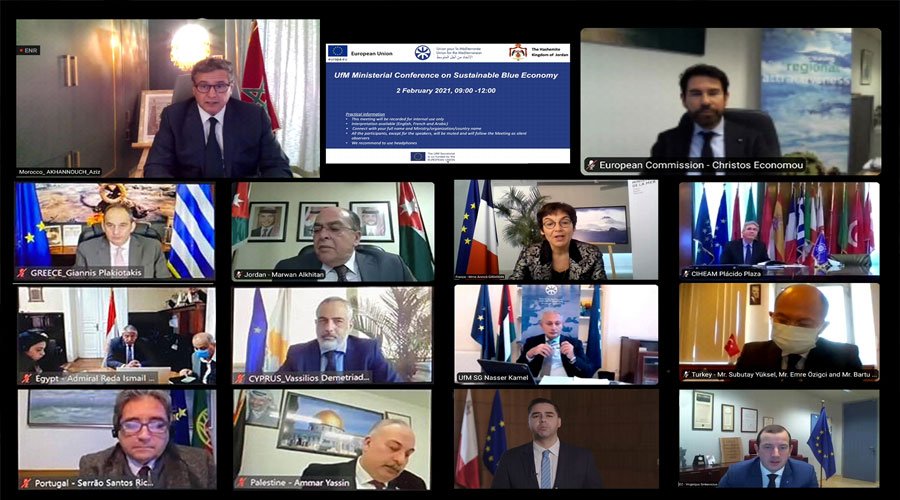
اخنوش يؤكد التزام المغرب الراسخ بالاقتصاد الأزرق

الأمن يفك لغز جريمتي قتل بالرباط

الداخلية تحقق في استفادة شخص بعمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان

لجنة برلمانية تحقق في صفقة أدوية بوزارة الصحة

وزارة الصحة تلتزم الصمت حول خطورة الخبز

كشوفات كورونا المزورة تجر مندوب الصحة بسيدي قاسم للتحقيق
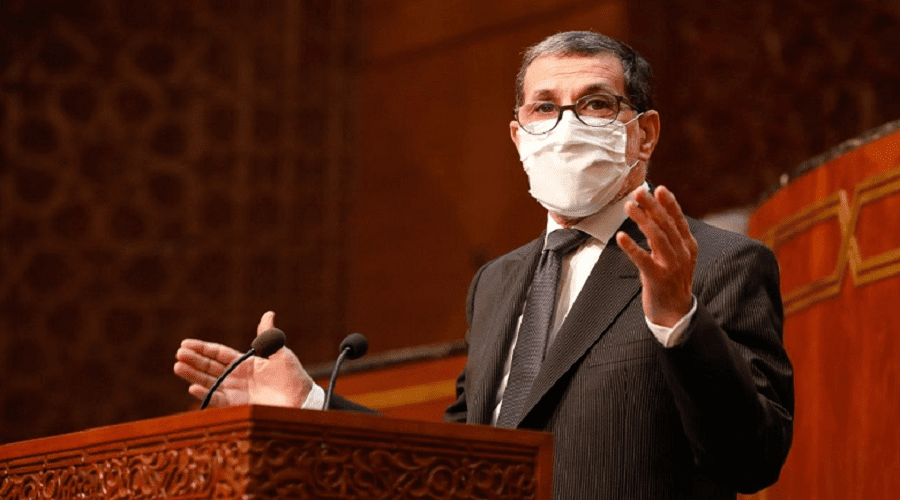
حكومة العثماني أمام مأزق إنقاذ 1.7 مليون شاب بدون تعليم أو تدريب

شبهات حول صفقات صيانة الموانئ

استراتيجية المنازل الآيلة للسقوط تحت مجهر قضاة جطو

الاستقلال يكشف سوء تدبير «البيجيدي» لمدينة القنيطرة

العثماني يستعد لتمرير 100 تعيين في مناصب عليا

توقف نهائي أو مؤقت لأكثر من 16 في المائة من المقاولات

هكذا أفشلت المخابرات المغربية حمامات دم في دول كبرى

المحكمة تدين مفجر قضية «حمزة مون بيبي»

القرض الفلاحي للمغرب يدعم الفيدراليات البيمهنية الفلاحية

رئيس جماعة بضواحي طنجة أمام التحقيق بسبب ملف عقاري

توقيف شرطي بعد محاولة تهريب طن من المخدرات بالحسيمة

القضاء يحسم ملف السطو على عقار مهاجرة بـ4 ملايير بسطات

رؤساء جماعات مهددين بالعزل قبل الانتخابات

شبهات حول اعتماد شركتين لتدبير النظافة والنفايات المنزلية بطنجة

مؤتمر استثنائي يطيح بزيان من قيادة الحزب المغربي الحر

اختلالات خطيرة في صفقات المعهد العالي للقضاء

قضاة جطو يدققون في صفقات مشبوهة بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية

العثماني يتهرب من عقد اجتماع رئاسة الأغلبية

بنشماش يرفض لقاء القيادات الشبابية

1.7 مليون شاب مغربي خارج التعليم والعمل

التهميش يخرج موظفين بجماعة تطوان للاحتجاج

الداخلية تعيد فتح نقاش إصلاح القوانين الانتخابية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض تسييس قضية المعطي منجب

مجلس المنافسة يحقق في خروقات بقطاع التأمينات

التجمع الوطني للأحرار يفتتح دورات "أكاديمية الأحرار" لتكوين قادته

تزوير تحاليل كورونا يسقط موظفا وعسكريا في الرشيدية

حملة استقطاب تتحول إلى محاسبة لـ «البيجيدي» بالقنيطرة

شركات المناولة بالشمال تضع أمكراز في ورطة جديدة

إحالة ملف عمدة مراكش ونائبه بنسليمان على غرفة جرائم الأموال

مباريات التخصص تفجر احتقانا في قطاع الأطباء المقيمين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينجز دراسة حول التداعيات الاقتصادية

الإفلاس يهدد عشرات الشركات في قطاع النقل السياحي

زلزال سياسي بحزب العدالة والتنمية بإقليم برشيد

شكاية بالاغتصاب تجر موظفين بالإذاعة والتلفزة وشرطيين للتحقيق

احتجاجات أمام استئنافية البيضاء تعيد رئيس ودادية سكنية إلى السجن

إضرابات القطاع الصحي بتطوان تعمق الخصاص

التحقيق في محاولة تهريب 400 كيلوغرام من الشيرا بطنجة

ولاية جهة طنجة توفد لجنة للتحقيق في اختلالات بمغوغة
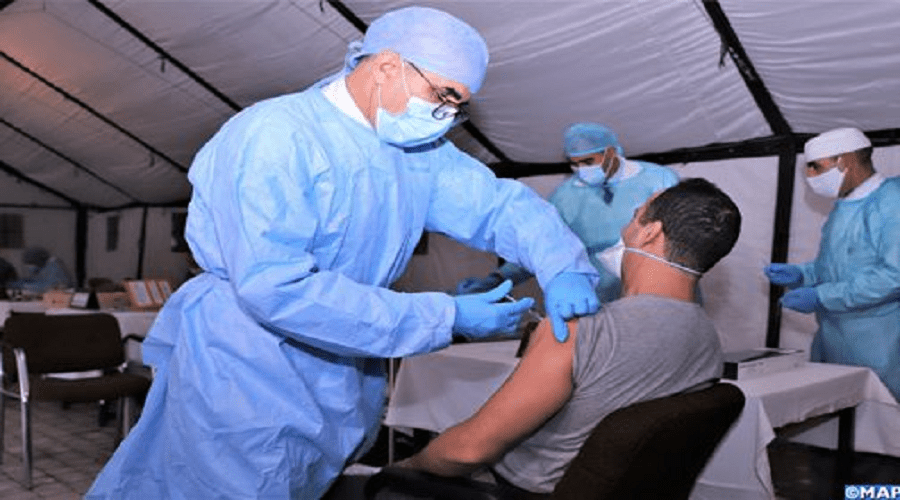
تازة .. ضبط استفادة 8 أشخاص من الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

فرقة أمنية خاصة ألقت القبض على 7 متهمين بتطوان

النيابة العامة بطنجة تحيل ستة أشخاص على قاضي التحقيق

تقرير أسود يكشف خروقات خطيرة بتسيير «البيجيدي» لجماعة خريبكة

رباح يخطط لبيع ما تبقى من عقارات جماعة القنيطرة

مطالب بالتحقيق في مصير 10 ملايير تخصصها "لانابيك" لصفقات التكوين

متهمون باختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية في قبضة أمن بمراكش

المجلس الإقليمي لطانطان يحابي جماعات قروية على حساب أخرى

مواد مسرطنة في خبز المغاربة

عمدة الرباط يرفض تسليم قرارات استغلال محلات السوق المركزي للتجار

الملك يعطي انطلاقة حملة التلقيح ضد كورونا ويتلقى أول جرعة

فتاح العلوي تزور فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأزيلال

توقيع شراكة استراتيجية لإنعاش الاستثمار السياحي بمراكش آسفي
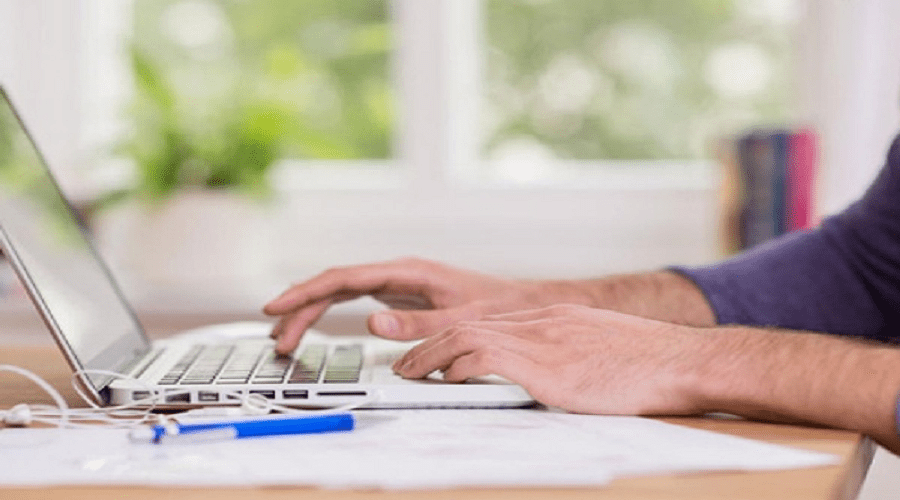
أكثر من 16 في المئة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت

الداخلية تلزم جماعة بطنجة بدورة استثنائية

المداولة في ملف عزل مستشار عن «البيجيدي» بالقصر الكبير

«البيجيدي» يدشن حربه على الولاة والعمال قبل الانتخابات

أمكراز يحيل قانون النقابات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي

كورونا يخطف قاضيا ثانيا بمحكمة الاستئناف بطنجة

عصابات تستغل فتيات لاصطياد ضحايا وطلب فدية

عرس في منتجع يتسبب في اعتقال محاسبة ورجل أعمال بضواحي شفشاون

انسحاب جماعي لموظفي التعاون الوطني من نقابة «البيجيدي»

الملك يعطي انطلاقة حملة التلقيح المجاني ضد كورونا غدا الخميس

استقالات تهز «البيجيدي» وهجرة جماعية نحو التجمع الوطني للأحرار

مدن مغربية بماض من ذهب وحاضر من تراب

القرض الفلاحي للمغرب يدعم الفيدراليات البيمهنية

الهدر الجامعي ...الأزمة التي تهدد الكليات المغربية

فضائح عقارية وشكايات وملفات تزوير أمام استئنافية تطوان

وعود بالتحقيق في عيوب تقنية بسد دشنته أفيلال تطوق عنق اعمارة

تنصيب مدير محطة تطوان يفجر احتجاجات

المغرب أول بلد إفريقي يبدأ حملة التلقيح ضد كورونا
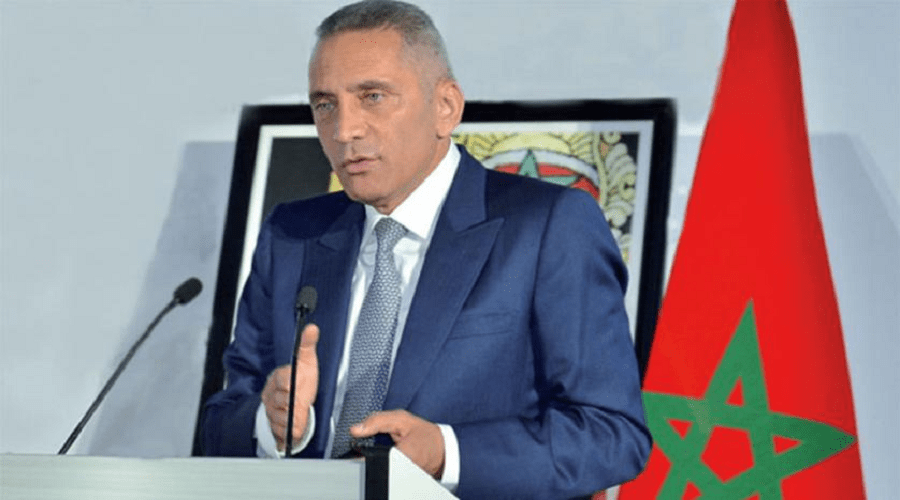
وزارة الصناعة تطلق برنامج "تطوير-نمو أخضر"

إدارة السجون تكشف حيثيات ترحيل معتقلي الحسيمة

التحقيق في غرق شابة بميناء العرائش

إصابة 35 شخصا في حادثة سير بين سطات والبروج

أمر قضائي بالحجز التحفظي على عقارات تعاونية ببرشيد

محاسب مجلس المستشارين أمام جرائم الأموال بمراكش

الحموشي يرسل لجنة تفتيش إلى ميناء طنجة المتوسطي

اتفاقات «مهمة» تختم جولة جديدة من الحوار الليبي في بوزنيقة

صفقة مشبوهة تجر اتهامات الاستقلال للبيجيدي بالقنيطرة

لفتيت يرفض لقاء القيادات الشبابية قبيل الانتخابات

التعاون الوطني يحمل الحكومة مسؤولية عدم صرف منح موظفيه

النساء تطمحن لرفع مقاعهدهن في الانتخابات القادمة

الاتحاد الدستوري مهدد بالانشقاقات قبيل الانتخابات

السلطات تشرع في توزيع لقاح كورونا على الجهات

12 جريحا وخسائر مادية كبيرة ..حصيلة أولية للحادث

تحقيقات البناء العشوائي تطارد مسؤولين وسياسيين بالشمال

أمن سلا يطيح بعصابات إجرامية روعت السكان

تفاصيل جديدة في ملف تزوير شهادات مغادرة التراب الوطني بالقنيطرة

تعبيد الطرق يجر انتقادات لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم

بعد بلوكاج سنوات ..قانون هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة يرى النور

وكيل الملك يفتح ملف غياب طبيبة بمستشفى الطب النفسي ببرشيد

الوضع في الكركرات هادئ وحركة المرور عادية بين المغرب وموريتانيا

تراجع المداخيل السياحية بأزيد من 57 في المائة

أخنوش يكشف مشاريع المغرب لمواجهة التغيرات المناخية

سفارة إسبانيا بالمغرب تنظم معرض “الدراسة في الجامعات الإسبانية”

شاب بتمارة يسرق سيارات الكراء ويبيعها ببيانات مزورة

قرار جديد للحكومة يستهدف أجور الموظفين

وزارة الصحة:هذه تفاصيل التلقيح ضدكوفيد التي ستنطلق الأسبوع القادم

التحقيق في صفقة تزويد أقاليم الشمال بحافلات للنقل المدرسي

الزاهدي تستقيل من مجلس جماعة تمارة

المغرب يتهم جنوب إفريقيا بممارسة التضليل وتحريف قرارات الاتحاد

رئيس جماعة أمام جرائم الأموال بسبب تخصيص 7 ملايين للستاتي

الاستقلال يحمل الحكومة مسؤولية الارتباك في ملف التلقيح ضد كورونا

الارتجال يطبع "فاس باركينغ"

جماعات بتطوان تفشل في أداء مصاريف إجبارية

الواد الحار بالشمال يصل البرلمان

تلميذ أمام ابتدائية برشيد بعد اعتدائه على أستاذه

هل يتسبب فشل الحكومة في تأمين اللقاح في سقوطها؟

لجنة تفتيش مركزية تحل بالمستشفى الجهوي بالعيون

أمزازي يعلن عن أكبر حركة تنقيلات وإعفاءات بالمديريات الإقليمية

كناش التحملات للنقل الحضري بالقنيطرة يحرك دعوى قضائية ضد رباح
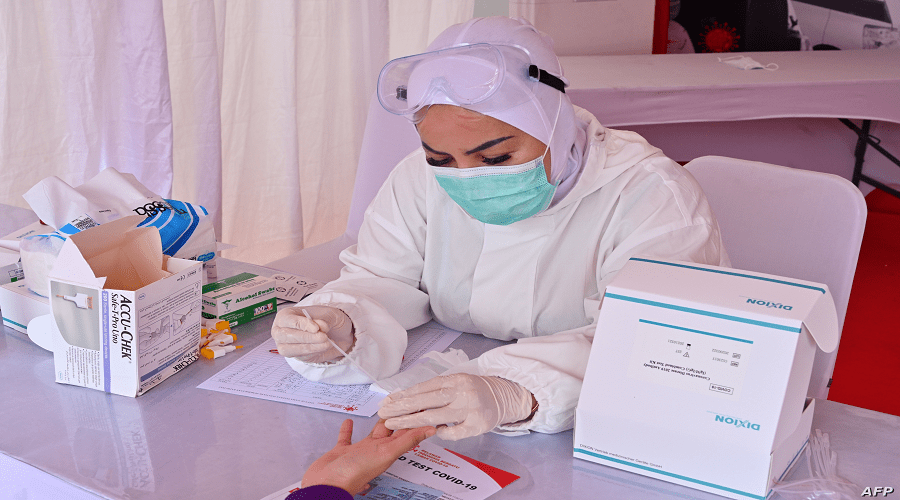
خصاص مهول في الأطباء المختصين بعلاج كورونا في تطوان

"وزيعة" مشاريع الماء بالشمال تشعل صراعات بـ«البام»

إدارة السجون تقرر ترحيل معتقلي الحسيمة بسبب "رسائل مشفرة"
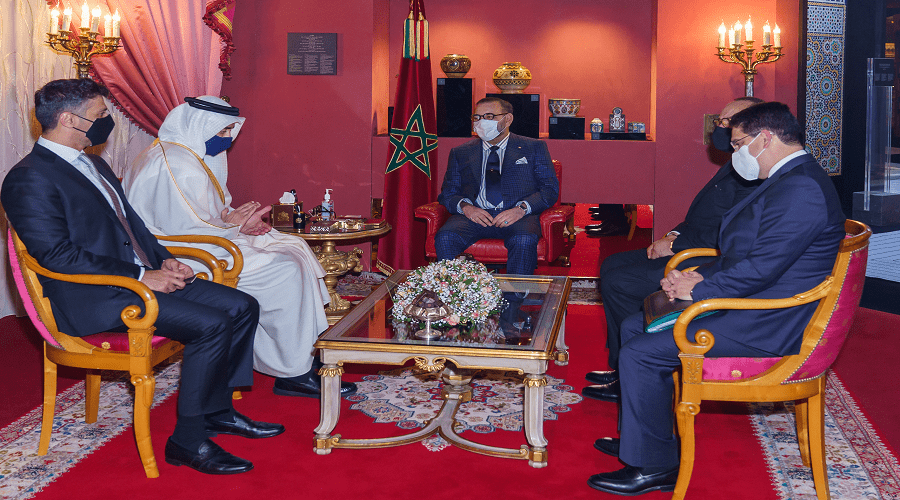
الملك محمد السادس يستقبل وزير الخارجية الإماراتي بفاس

زلزال الاستقالات يضرب "البيجيدي" بإنزكان

متابعة رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

«منحة كوفيد» تثير استياء أطر الصحة بإفران

المجمع الشريف للفوسفاط في نهائيات جائزة «فرانز ايدلمان» المرموقة

«جي-لو» تلقن متابعا درسا في عدم التنمر
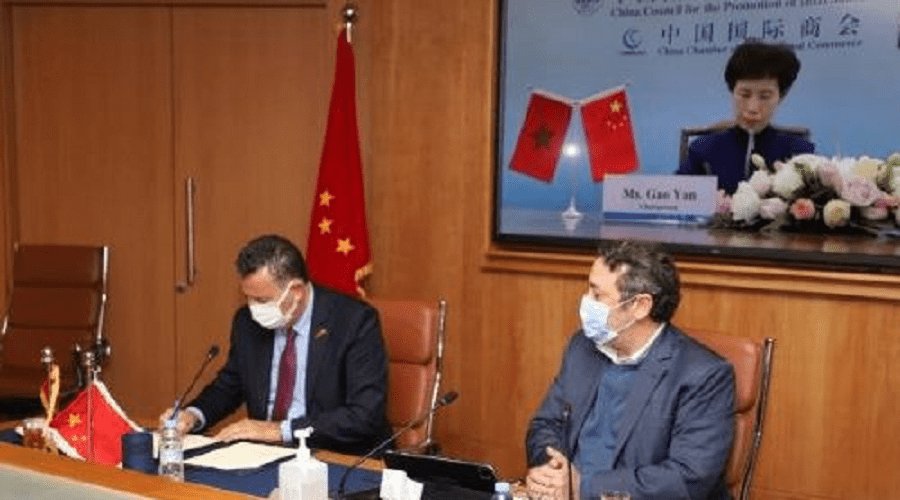
الاستثمار وفرص الأعمال تجمع «الباطرونا» والمجلس الصيني

قتلى في انفجار يهز وسط العاصمة الاسبانية مدريد

البنك الدولي : تعافي الاقتصاد العالمي لن يتم قبل عشر سنوات

التجمع الوطني للأحرار ينتقد تأخر قوانين الانتخابات

التحقيق في اختناق أسرة بالغاز بالعرائش

مباني آيلة للسقوط تورط مجلس مدينة الرباط

تغيير معالم بناية تاريخية بالقنيطرة..أشغال تهدد التراث المعماري

تفاصيل ملف تزوير نتائج تحاليل «كورونا» بسيدي قاسم

بوادر نهاية بلوكاج قانون الهيئة الوطنية للنزاهة

أمزازي يفرج عن نتائج الحركة الانتقالية للمديرين الإقليميين

مطالب بكشف مصير 15 مليارا لدعم الرياضة بطنجة

وزارة الصحة بدون كاتب عام لأزيد من عام

الحكومة تدرس شروط إتلاف الأرشيف

صفقات المستلزمات الطبية تورط مديرية الادوية

إبطال حكم لاستئنافية أكادير في قضية أختام «مزورة»

الدرهم أمام قاضي التحقيق بتهم اختلاس أموال عمومية

مجموعة Nexans تفتتح مصنعا جديدا للألياف البصرية بالنواصر

أمن مراكش يفك خيوط سرقة 100 مليون سنتيم

مؤسسة البنك الشعبي تزود تلاميذ الأحياء المعوزة للدار البيضاء

التجمع الوطني للأحرار يطلق أكاديمية لتكوين منتخبي المستقبل

ما حقيقة انتقال العدوى من عديمي أعراض الإصابة بـكورونا

بنعبد القادر ينفي مسؤوليته عن "بلوكاج" القانون الجنائي

الراضي يقود انقلابا على ساجد وسط صقور الاتحاد الدستوري

تفاصيل فيديو طفل أزيلال الذي حرك أطنان المساعدات نحو دواوير معزول

دورة استثنائية تتحول إلى صراع بين إدعمار ومستشارة

نائب عمدة سلا يتملص من انتقادات المواطنين لحالة الطرق

تعويضات نجلة بنكيران تفجر دورة مجلس مقاطعة حسان

بنكيران يتسبب في خسران الاقتصاد الوطني 360 مليارا

انتخاب العثماني رئيسا للتعاضدية العامة للموظفين

40 دولة تدعم سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية

تجدد مطالب عقد مؤتمر استثنائي لـ"البيجيدي" في ظل موجة الاستقالات

سلطات طنجة تداهم حفلا صاخبا..حضره فنانون ضمنهم ابتسام تسكت

محاكمة رئيس فريق بتطوان يتزعم شبكة للمخدرات

امتحانات الكفاءة المهنية تفجر سخطا ببلدية القنيطرة

رفع «البلوكاج» عن صفقة 4 ملايير لتنمية جهة طنجة

معاشات الوزراء تجر المساءلة على العثماني

درك الخميسات يعتقل 17 شخصا داخل مقهى لخرقهم الطوارئ

مراقب عام ورئيس مصلحة أمام قسم جرائم أموال الرباط

موظفون بمديرية الصحة بأكادير في ضيافة جرائم الأموال بمراكش

وزير العدل يعلن إقبار مشروع القانون الجنائي من طرف البرلمان

الأمن يوقف رجل مخدرات اغتصب طفلا عمره 12 سنة بمراكش

آيت الطالب: يمكن بلوغ المناعة الجماعية ضد كوفيد19 مطلع ماي المقبل

حرمان موظفي جماعة تطوان من التعويضات والترقيات

شكاوى حول أراض سلالية تحرك تحقيقات ولاية طنجة

شبهات "السرقة العلمية" تلاحق مرشحا للعمادة بكلية الحقوق بوجدة

أمريكية تتهم طبيبا باختطافها واحتجازها واغتصابها

مطالب بافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني

إحالة ملف الشوباني ومن معه على محكمة جرائم الأموال بفاس

امتيازات بنكيران لشركات الدواء تضاعف خسائر مالية الدولة

"لارام" تعلن عن إطلاق خط مباشر بين الداخلة وباريس

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة حقيقية للمقاولات

صندوق الايداع والتدبير يطرح خدمة "أمانتي"

تمويل 45 مشروعا في اطار برنامج دعم وتشجيع مشاريع البحث العلمي

المكتب الوطني للصيد يواصل تحسين وعصرنة عملية التسويق

توقع تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو ب 4,6 في المائة سنة 2021

كل ما تجب معرفته عن كيفية الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث

حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق في المغرب الأسبوع القادم

الصحراء وتعميق التعاون الثنائي يجمع بوريطة بوزيرة خارجية السويد

تيلي ماروك تنشر لائحة الإعفاءات والتعيينات الجديدة بالقوات المساعدة

"بلاص بيتري" يفجر الخلاف بين المعارضة وعمدة الرباط

فضائح عقارية تحوم حول موثق بتطوان

الفيضانات تستنفر سلطات الغرب

سهم "ليديك" يهوي ببورصة البيضاء بسبب الفيضانات

تمديد الإجراءات الليلية بالمغرب بسبب السلالة الجديدة لوباء كورونا

اتهامات خطيرة في حق مؤسسة وطنية تدفع الداخلية لوضع شكاية ضد زيان

أمزازي ينهي تدخلات «البيجيدي» بوزارة التربية الوطنية

التسمم بأول أوكسيد الكربون الخطر الداهم في الشتاء

تذويب الإسفلت يفجر احتجاجات بإقليم برشيد

تعويضات «كورونا» تفجر احتقانا بمستشفيات الشمال

تصميم التهيئة بالقصر الكبير يشعل حرب مراسلات أمام الداخلية

مصرع تلميذة جرفتها السيول بوزان

اعتقال ومتابعة موظفين وأساتذة جامعيين بجامعة عبد المالك السعدي

السيول تجرف أسرة داخل سيارة خفيفة بكلميم

الباكوري يغيب عن تسيير مجلس جهة الدارالبيضاء

ست سنوات سجنا للرئيس السابق لبلدية مريرت بتهم الاختلاس

ضياع مداخيل بجماعة بتطوان يفجر جدلا سياسيا

معاقون «وهميون» يستفيدون من المال العام بطانطان

أمزازي «يُحيي» مديرية تم حلها قبل 22 سنة

تفاصيل زيارة مقر القنصلية الأمريكية بالداخلة

"بوريطة : "المغرب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وسيرد بحزم في حالة استهداف استقراره

الداخلة .. إطلاق منصة "الداخلة كونيكت.كوم" بحضور ديفيد شينكر

بعد سنتين من الانتظار .. جهة الرباط سلا القنيطرة تستغل كورونا وتتنصل من تمكين حاملي المشاريع من الدعم

بوريطة: العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تتطور بإيقاع "غير مسبوق"

مساعد كاتب الدولة الأمريكي :" المغرب شريك محوري للاستقرار الإقليم

الأمطار تفضح هشاشة البنيات التحتية بمدن الشمال

شينكر : العلاقات بين أمريكا والمغرب أصبحت قوية أكثر من السابق

نائب وزير الخارجية الأمريكي يحل بالعيون في أول زيارة لمسؤول رفيع

التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والإتجار فيها يجر أساتذة جامعيين للقضاء

ولاية جهة الدار البيضاء تصدر بلاغا باردا حول الفيضانات وتعد إجراءات عملية لتجاوز آثارها

ثلوج وأمطار رعدية ورياح قوية من الجمعة إلى الإثنين بعدد من مناطق المغرب

عمدة البيضاء يغيب عن اجتماع "محاسبة ليديك" واستهجان في صفوف المعارضة داخل قاعة الجلسات

مساعد وزير الخارجية الأمريكية يكذب الصحافة الجزائرية وينفي إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء المغربية

شبهة غسل الأموال تلاحق كولونيلات وعمداء أمن متابعين في قضايا مخدرات

مساعد كاتب الدولة الأمريكي من قلب الجزائر : " المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي"

العثماني: قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تعكس حرص الحكومة على معالجة آثار جائحة كورونا

اضطراب في حركة سير القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

لجنة المالية تصادق على قانون إلغاء تقاعد أعضاء مجلس المستشارين

الأمطار الغزيرة تغلق عدداً من الطرق ووزارة التجهيز والنقل تحذر من السفر

اضطراب كبير في الحركة على مستوى شبكة طرامواي الدار البيضاء بسبب الأمطار الغزيرة

الخطوط الملكية المغربية تعلن عن خط جوي جديد يربط الدار البيضاء بدبي

رسميا.. المغرب يرخص لاستخدام لقاح “أسترازينيكا”

لجنة اليقظة الاقتصادية تقرر تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش “Relance”

عثمان الفردوس: " تمت المصادقة على أربعة عقود برامج تهم الصناعات الثقافية والإبداعية وقاعات الرياضة "

نشرة خاصة: أمطار قوية محليا رعدية ورياح قوية مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

المغرب يتوصل بالدفعات الأولى من جرعات اللقاح الصيني

السلطات المغربية تطلق مشروعا استراتيجيا لمحاربة جرائم غسل الأموال

ملف توزيع الأراضي بسلا .. أسر ترفض القطع المشتركة و مطالبات بتدخل الوالي

وزارة الفلاحة والصيد البحري تفرج عن قرار يحدد القوارب المسموح لها

طنجة .. اقتحام شابة تعاني خللا عقليا لمسجد يستنفر الأمن

تعليمات عليا وجهت لمختلف سفراء المغرب بدول العالم بالتزام مقراتهم الدبلوماسية

حكومة العثماني اقترضت 680 مليار سنتيم من مؤسسات أجنبية لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تنفي صلتها بصفحة مزورة على فايسبوك وتؤكد أن التواصل بشأن عملية التلقيح يتم من خلال القنوات الرسمية

هذه هي الفئات التي ستستفيد من التغطية الصحية

بسبب انتحال صفة صحافي .. ابتدائية برشيد تدين رئيس جمعية بالحبس النافذ

أقاليم الشمال .. السلطات الإقليمية تطلق مشاريع جديدة لتعوض فشل السياسيين في تنمية المنطقة

قاضي جرائم الأموال يتابع برلمانيا بسبب التلاعب في تفويت أراض سلالية

القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يدخل حيز التنفيذ

الأمانة العامة للحكومة تحيل قانون تنظيم الصيد البحري على المجلس الحكومي

تواطؤات بين الحكومة والمعارضة والأغلبية تقبر قانون الإثراء

لجنة التحقيق البرلماني تحل بمديرية الأدوية للاستفسار حول الفوضى التي تعرفها المديرية

سنة 2020 ... مبادرات ملكية غيرت تاريخ المغرب الحديث

نهايات مأساوية لأعيان حكموا المغرب

إدراج 165 دواء جديد ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تطوان .. قضايا متعلقة بخروقات تعميرية وتزوير ورخص انفرادية تقلق راحة برلمانيين ورؤساء جماعات

مجلس الحكومة يتدارس سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

نشرة خاصة: رياح قوية وأمطار رعدية مرتقبة من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

وفاة البروفيسور عبد الله بنسليمان المدير السابق لمعهد باستور

وفاة سيدة بكورونا بسبب الإهمال تستنفر ولاية طنجة وتدفع مندوبية الصحة للتحقيق في الواقعة

المغرب.. اجتماع للجنة الوطنية المختصة بالترخيص للقاح "أسترازينيكا"

معهد المستقبل والأمن في أوروبا : المغرب حلقة قوية في محاربة الإرهاب وشريك محوري لأوروبا

العثماني يعلن استكمال ترسيم الحدود البحرية لفرض السيادة الوطنية الكاملة للمملكة

سلا .. منتخبو البيجيدي متهمون باستغلال مشاريع اجتماعية لأغراض انتخابية

الداخلية تصدر تقريرا يفضح تستر عمدة فاس على جرائم التعمير

مصالح الأمن الوطني تنفي صحة تدوينة حول وفاة ضابط شرطة جراء القصف الوهمي بالصحراء المغربية

متابعة المعطي منجب بتهمة غسل الأموال في حالة اعتقال

نهاية عهد الشتائم العابرة للقارات.. المؤسسات الأمنية الثلاث تتقدم بشكاية في مواجهة أشخاص يقطنون بالخارج

أدباء وصحافيين ورياضيين فلسطينيين ويهود عاشوا أحداثا مثيرة في المملكة

غياب تام للأدوية المستعملة في علاج فيروس التهاب الكبد ... والمرضى في خطر

أعضاء العدالة والتنمية المنقلبون على العثماني يكشفون تفاصيل تصويتهم على مرشحة الأحرار لرئاسة المجلس الجماعي بالمحمدية

القنيطرة .. نقابات تتهم الرباح بالتنقيلات التعسفية وحرمانهم من التعويضات المستحقة

برشيد .. إصابة 22 شخصا بكورونا بمستشفى الطب النفسي تدق ناقوس الخط

فاس .. فرض ضرورة التوفر على هواتف ذكية لركن السيارات يدفع السكان للانتفاضة ضد العمدة الأزمي

تطوان .. السلطات الإقليمية تدخل على خط اقتطاعات عمال النظافة

طريق مميت يتسبب في جدل بين المجلس الإقليمي لإفني ومجلس جهة كلميم

غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط تمنح دبلومات مشبوهة وتستغل اسم الوزارة الوصية

العثماني يستنكر حملة الإعلام الجزائري ضد المغرب لنشر الأخبار الزائفة

سكان تطوان والفنيدق يشتكون انعدام مجاري الصرف الصحي والبنيات التحتية

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية لأسرة المرحوم محمد الوفا
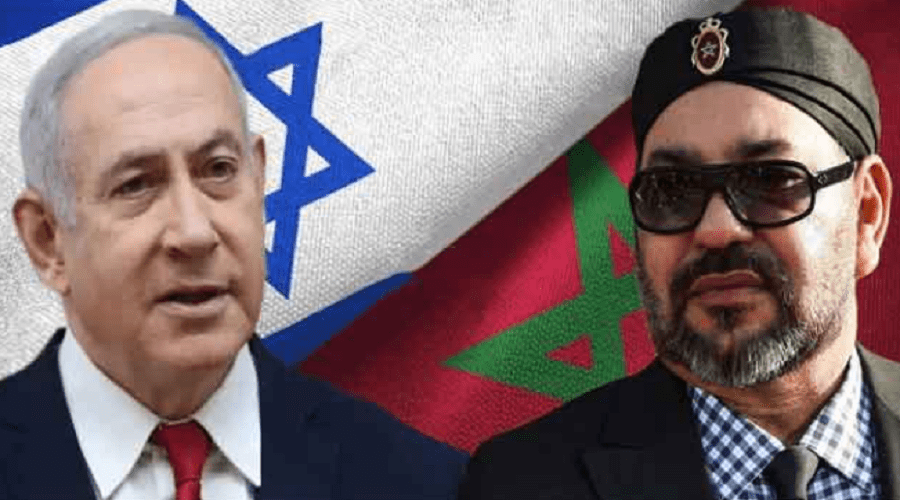
الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع بنيامين نتنياهو

مطعم مغربي يفوز بجائزة أجمل مطعم في العالم

الصويرة.. تعبئة 68 مركزا في إطار عملية التلقيح ضد كوفيد-19

العيون.. توقيف شخص للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

الرباط تستنكر بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش النيل من النجاحات التي حققها المغرب لتعزيز وحدته الترابية

وصول دفعة من اللقاح الصيني إلى المغرب... هذا رد الوزارة

الأمن الوطني .. مواصلة للانفتاح على وسائل الإعلام والمجتمع المدني

أمريكا تعلن عن استثمارات بقيمة 5 ملايير دولار بالمغرب والمنطقة

وزارة التربية الوطنية تكذب بلاغا زائفا بشأن إلغاء عملية صرف الدفعة الأولى للمنحة الدراسية للطلبة

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب ب169 مليون أورو لمكافحة وباء كورونا

الملك محمد السادس يؤكد على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية
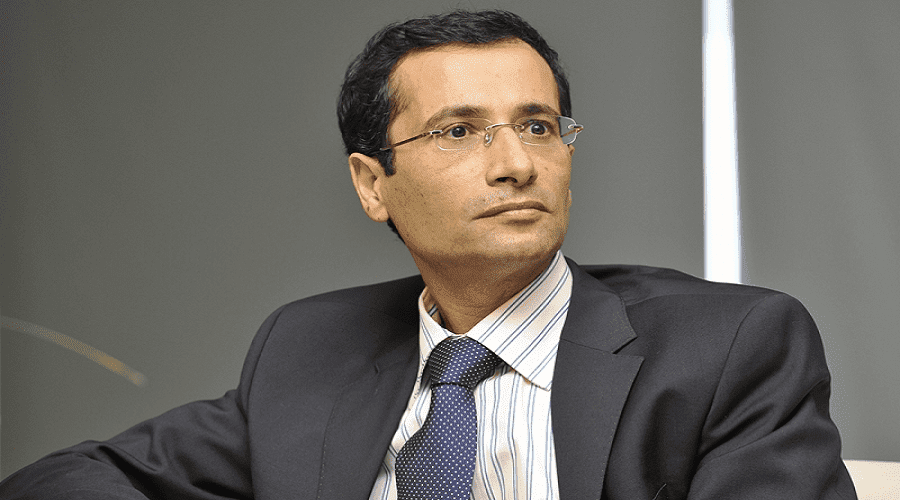
المغرب يسدد مليار دولار لصندوق النقد الدولي

هكذا سيستفيد وزراء وبرلمانيون من تعويضات بالملايين بعد إلغاء التقاعد

التوقيع على اتفاقيات تمويل بين المغرب والبنك العالمي بـ 800 مليون دولار

السلاوي يكشف رأيه في السلالة الجديدة لكورونا
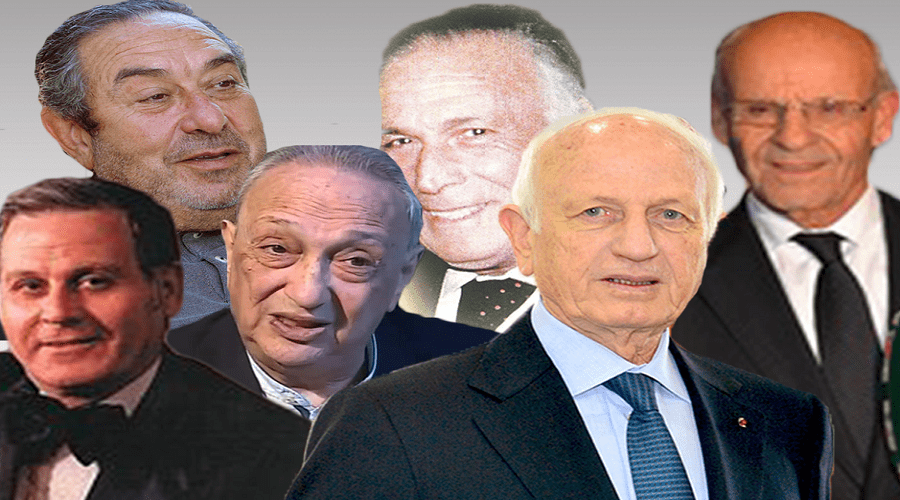
قصص مثيرة ليهود خدموا ملوك المغرب عبر التاريخ

انتشار السلالة الجديدة من كورونا يدفع الحكومة "لحجر صحي جزئي"

بايدن يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا أمام الكاميرات

المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

انهيار فندق لينكولن يربك حركة ترامواي البيضاء

تفاصيل جديدة حول خطة التلقيح ضد كورونا بالمغرب

مجلس النواب يحقق في فضيحة الدقيق الفاسد

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض مواطنين لاعتداء خطير بطنجة

السلطات المغربية تتجه إلى منع احتفالات رأس السنة

هذه خطة المغرب للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة

زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

كورونا ينهي حياة نور الدين الصايل المدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي

سبعينية تقتل ابنها بسكين في العرائش

موقف نقابة الصحافة من إسرائيل يقسم أعضاءها

بعد اكتشاف تلاعبات.. الداخلية تحث الولاة والعمال على مراجعة لوائح السلاليين

آيت الطالب: التلقيح واجب وطني والسلطات جاهزة لانطلاق العملية

وزير الصحة: المغرب لم يستلم أي جرعة من لقاح كورونا إلى حدود اليوم

مجلس النواب يصادق بالإجماع على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار

الحموشي يقود حملة تطهير بمفوضية سيدي يحيى الغرب

اعتقال مستخدم بمستشفى يزوّر تحاليل كورونا مقابل 500 درهم

هكذا تحدى نافذون بالبيضاء الطوارئ وحولوا فيلاتهم لعلب ليلية

دعوة أكثر من 13 ألف أستاذ جامعي للشروع في عملية التلقيح ضد كورونا

جمهورية هايتي تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

هكذا يضغط إطار نافذ لإحداث مصحة بسيدي سليمان

هكذا استفاد البرلمانيون الأشباح من كورونا

افتتاحية الأخبار.. تطاول

عندما طردت الجزائر 350 ألف مغربي ردا على المسيرة الخضراء

اختلالات مالية بمستشفى المحمدية والنيابة العامة تدخل على الخط

الداخلية تشرع في افتحاص ملفات دعم جماعة ومقاطعات طنجة للجمعيات

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تشيد بالمجهودات الملكية في قضية الصحراء والقضية الفلسطينية

السفير الأمريكي بالمغرب يقدم خريطة المغرب الكاملة بعد اعتمادها رسميا

الداخلية تشترط الإقامة للاستفادة من تمليك الأراضي السلالية

الديستي تطيح بعشرينية وظفت عصابة لتصفية شخص بالرباط

هكذا سيتولى الجيش حماية المعاملات الإلكترونية بين المغاربة

بالصور.. حادث سير خطير يتسبب في انفجار شاحنة لنقل البنزين ومصرع سائقها

الثلوج تُدخل مناطق مهمشة بالمغرب في عزلة شبه تامة

الداخلية تستنفر 50 ألفا من رجال السلطة والأعوان استعدادا لوصول لقاح كورونا

ساكنة الصحراء المغربية تشيد بمضامين القرار الأمريكي

وفاة الصحافي صلاح الدين الغماري

المجسم المعدني الغامض يظهر بنواحي الدار البيضاء

أمريكا تقترب من بيع 4 طائرات من طراز إم كيو 9 للمغرب

الأحرار يتفوق على البيجيدي في رئاسة جماعة قروية بسيدي قاسم
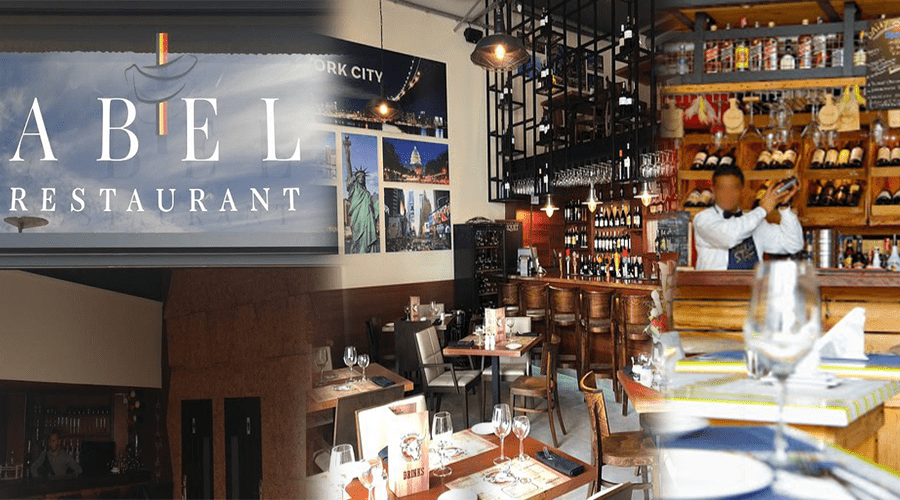
مطاعم تتحدى القانون بمارينا سلا وتحذيرات من تسببها في كارثة

هكذا ستمنح الحكومة هدايا للعنصر بـ 1100 مليار قبل الانتخابات

الأمطار تكشف المستور... نصف الطرق في حالة سيئة و500 قنطرة مهددة بالانهيار

استقالات بالجملة تهز الحزب المغربي الحر بسبب بلاغ زيان

هكذا يسعى المغرب إلى تلقيح 20 مليون شخص ضد كورونا خلال 3 أشهر

أوعويشة يكشف كيف سيتم تنزيل نظام الباكالوريوس وتدريس اللغات الأجنبية بالتعليم العالي

بعد ظهور أعراض جانبية.. بريطانيا تحذر هذه الفئة من لقاح كورونا

جماعة طنجة تغرّم شركة عقارية 90 مليونا

ألمانيا تشرع في بناء سفارة جديدة لها بالمغرب

هكذا يخسر المغرب أزيد من 520 مليار سنويا جراء التملص الضريبي

هذه خطة أمزازي لتوفير ثلث تكلفة التعليم على الأسر

صادم... مسؤول كبير سابق يؤكد تواصل الكائنات الفضائية مع البشر ويؤكد علم ترامب بذلك

كورونا يودي بحياة الصحافي حكيم عنكر
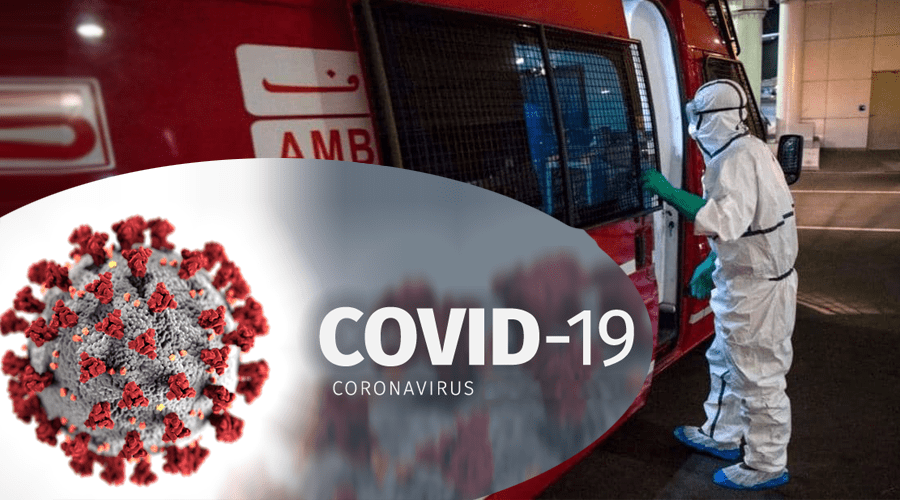
وزارة الصحة تعلن انخفاض مؤشر تكاثر فيروس كورونا

الإمارات تعلن تسجيل لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة كورونا

إحباط محاولة تهجير بالقنيطرة واختفاء بارون تسلم من المرشحين 150 مليونا

هكذا تكتسح الأسواق العشوائية مدينة سلا في غياب العمدة

المنعشون العقاريون يشتكون من عراقيل رخص البناء بالدار البيضاء

الملك يأمر باعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لجميع المغاربة

لماذا تتخلف الأحزاب عن الدفاع عن المؤسسات الدستورية ؟

توقيف جندي سابق و3 دركيين بتهمة محاولة اغتصاب فتاتين

تفاصيل تفكيك عصابة متخصصة في تزوير ورقة 200 درهم
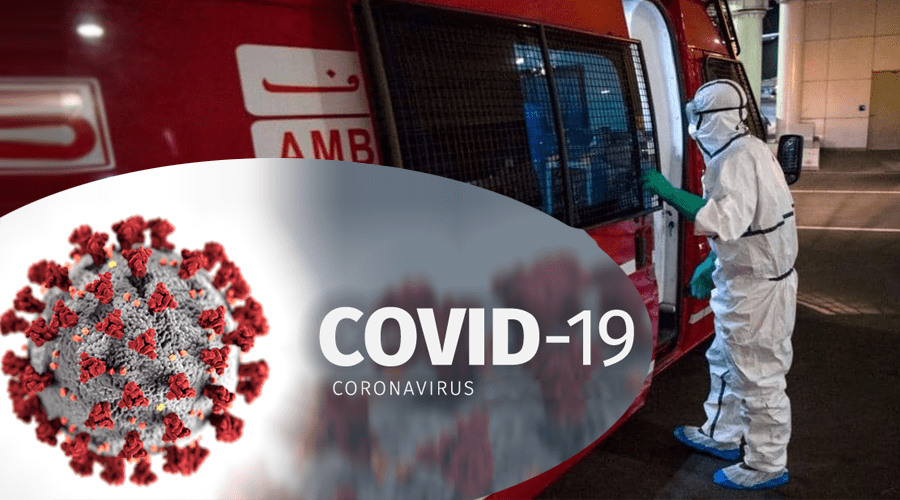
هكذا سقط 60 طبيبا في المعركة ضد كورونا بالمغرب

مجلس جطو يشرع في افتحاص المستشفيات الجامعية

محاكمة الأكابر.. هكذا أطاحت اختلالات مالية وإدارية بمليارديرات وسياسيين مغاربة

الإنتربول يحذر من تزييف وسرقة لقاحات فيروس كورونا

أمن سلا يطيح بعصابة اختطفت شخصا وسرقت سيارته
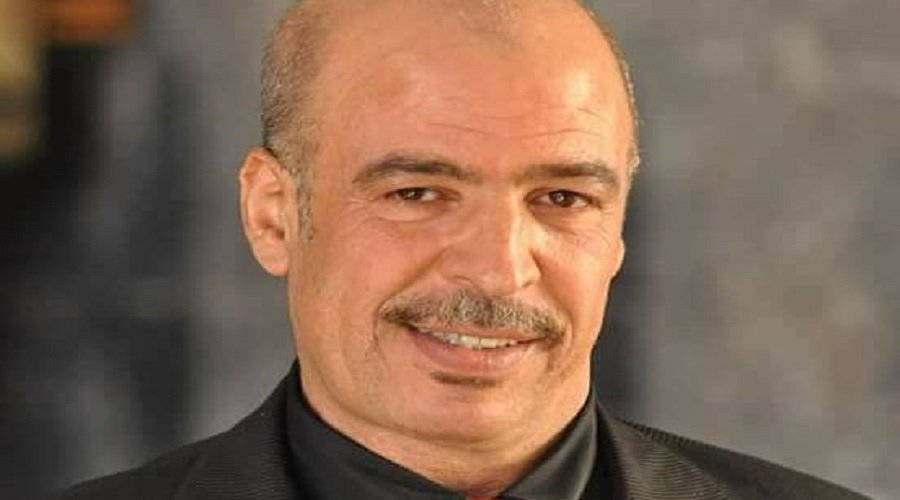
تقرير للمفتشية العامة يدفع الداخلية لتوقف رئيس جماعة دار بوعزة

إصابة 8 شرطيين واعتقال 64 متظاهرا في احتجاجات قانون الأمن الشامل بفرنسا

الاستقلال يدين استمرار الحكومة في حماية الريع وتطبيعها مع الفساد

بالفيديو.. وضعية كارثية بعد انفجار مجاري الصرف الصحي بسوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة

الدخيسي : ملف الضابطة وهيبة مر بجميع مراحل التقاضي والفيديو الذي ظهرت فيه مع محاميها زيان أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنه

دولة أفريقية تعلن هزم فيروس كورونا

وزير الصحة يدعو المغاربة إلى الإقبال بكثافة على التلقيح لتحقيق مناعة جماعية

جواز سفر كورونا.. هكذا سيصبح اللقاح شرطا لصعود أي طائرة

محلات في المدينة العتيقة بالرباط تسيل لعاب حيتان العقار

الحجز على باخرة بميناء طنجة بعد تهربها من أداء ذعيرة بـ18 مليار

النقابة الوطنية للصحافة تندد بتصريحات زيان وتعتبرها إساءة للجميع

البام يطالب بالسماح لأصحاب السوابق القضائية بالترشح للانتخابات

هكذا استطاع الحموشي قهر الإرهابيين وبارونات المخدرات والاتجار بالبشر

استخفاف آيت الطالب بالإعلام المغربي يخلق الجدل

بالصور.. هذه تفاصيل تفكيك خلية موالية لداعش بتطوان خططت لاستهداف أمن المملكة

تفكيك خلية إرهابية بتطوان واعتقال 3 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

مواطنون يلقون بالأزبال أمام جماعة تطوان لفشلها في وقف الإضراب

قانون تجريم الإثراء غير المشروع يهدد بأزمة جديدة داخل الحكومة

استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض

الداخلية تندد باستهداف مؤسسات أمنية وطنية وتتوعد باللجوء للقضاء

هكذا تستعد المستشفيات والمراكز الصحية لتلقيح 20 مليون مغربي ضد كورونا

إيقاف متزعمين شبكة للهجرة السرية وإخضاع 20 مرشحا للبحث بالعرائش

تدابير استثنائية لفائدة العاملين بقطاعي تموين الحفلات والترفيه والألعاب

واشنطن تشيد قنصلية عامة بالدار البيضاء بغلاف مالي يصل 300 مليون دولار

انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي

الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين ترد على ادعاءات زيان وتقرر مقاضاته

تساقطات ثلجية وموجة برد مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق المملكة

تحذير... أمواج عاتية سيصل علوها إلى 6 أمتار ستضرب هذه الشواطئ المغربية

حريق مهول يودي بحياة شخصين كانا تحت تدابير العزل الصحي بسبب كورونا داخل شقة بطنجة

لارام توفر لزبنائها تغطية صحية لكورونا تصل إلى 150000 أورو

ابن سياسي بارزة يرتكب حادثة سير خطيرة ويلوذ بالفرار

تفاصيل الإطاحة بعشريني نصب على راغبين في ولوج مدرسة الشرطة

ألمانيا تدعم المغرب بأكثر من 10 مليارات درهم لتجاوز أزمة كورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا ليس إلزاميا لكنه سيكون أساسيا للسفر أو العمل

الحكومة تمنع إعدام الكلاب الضالة بالرصاص والمواد السامة

هذا ما قررته المحكمة في قضية قتل الطفل عدنان

هكذا دعم المغرب الثورة الجزائرية وساندها في مواجهة الاستعمار الفرنسي

أول شحنة من اللقاح الصيني ضد كورونا تصل المغرب
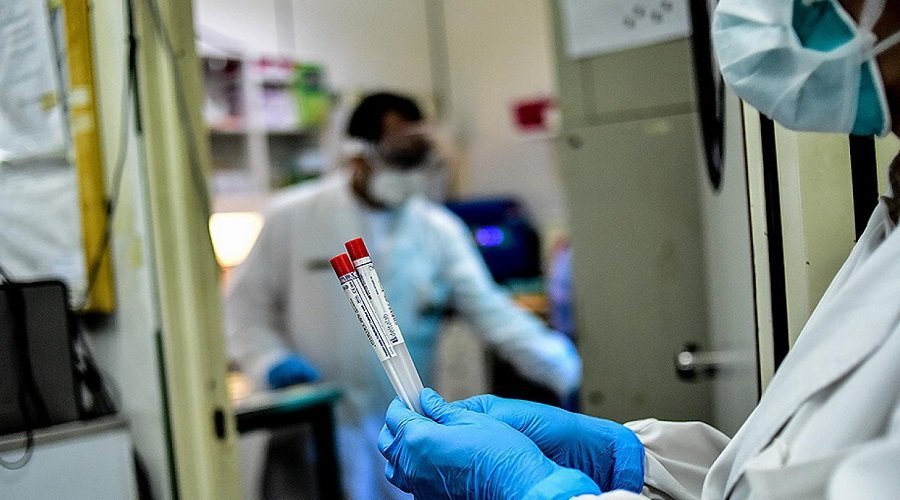
تفاصيل الإطاحة بطبيبين يتاجران في تحاليل كورونا بفاس

أمن الرباط يطيح بمتهمين بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال

هكذا أنقذت حملات التلقيح المغاربة من الأوبئة

اعتقال أطباء يتاجرون في تحاليل كورونا بفاس

صورة التلقيح الإجباري.. مديرية الأمن توضح

بريطانيا تعدم أكثر من 10 آلاف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور

جرحى خلال مظاهرة ضد قيود كورونا في بلجيكا

سلطات خنيفرة تخفُف تدابير كورونا بعد تحسن الوضعية الوبائية

هكذا مكنت تدابير المحافظة العقارية من حماية 4 آلاف عقار من السطو

تفاصيل التحقيق مع سياسي نافذ وابنه وحارس ضيعته في جريمة قتل

طقس بارد وزخات رعدية قوية إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى في سفاراتها بعد تهديدات إيران

وفد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يزور الكركرات

ولاية أمن البيضاء تكشف حقيقة الاعتداء على إمام مسجد خلال صلاة الجمعة

بعد منعه من السفر.. التحقيق مع وزير سابق لـ 10 ساعات في تهم ثقيلة

هكذا فشلت حكومة العثماني في تحقيق خططها واستراتيجياتها

المؤبد لشرطي قتل شخصين بالدار البيضاء

تخفيض أثمنة اختبار الكشف عن كورونا بالمغرب

نشرة خاصة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية وطقس بارد بعدد من مناطق المملكة

هذا موعد انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا بالمغرب

النيابة العامة تقرر متابعة الأم المتورطة في تعنيف طفلتها بالعرائش

جريمة قتل واغتصاب بشعة تهز مدينة أوطاط الحاج

تساقطات ثلجية وطقس بارد وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة

درك القنيطرة يطيح بعصابة هاجمت راغبين في الهجرة بالسيوف وسلبتهم أموالهم

متابعة الملياردير حسن الدرهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير

وزير الصحة يكشف الدول التي سيزودها المغرب بلقاح كورونا

جثمان الأسطورة مارادونا يصل إلى القصر الرئاسي لإلقاء النظرة الأخيرة

مقالع تخرق دفاتر التحملات وتهدد البيئة تتحدى وزارة التجهيز

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي توقف 3 مصحات بسبب تجاوزات
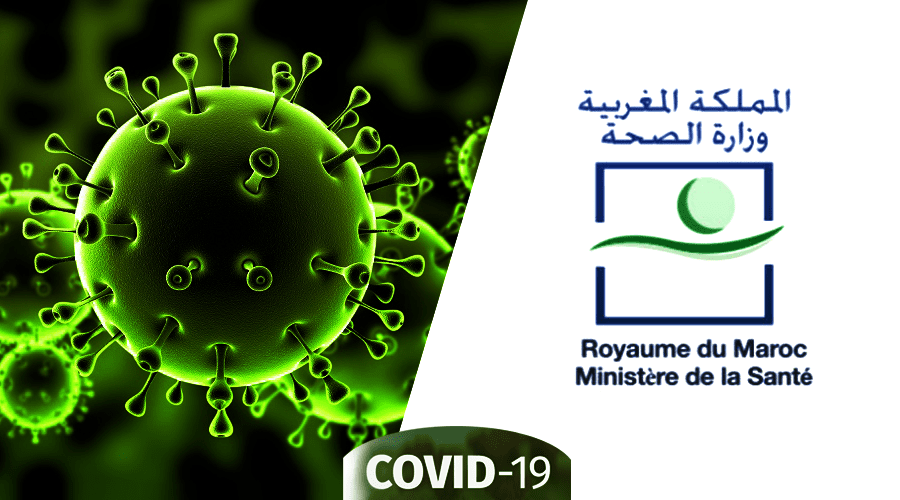
5220 حالة شفاء من كورونا و4979 إصابة و 70 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

وفاة قاض في ظروف غامضة ضواحي بنسليمان يستنفر السلطات

تساقطات ثلجية وزخات رعدية وانخفاض درجة الحرارة إلى ناقص 7 درجات بهذه المناطق

التحرش بمواطنة والشطط في استعمال السلطة يقود شرطيا للسجن

المحكمة تصدر قرارها في المواجهة بين لارام والربابنة

عمدة آسفي يرفع النفقات بمليار سنتيم ويصرف أزيد من 27 مليارا خلال سنة

المغرب يكمل أشغال تعبيد الطريق بالكركرات

أسواق نموذجية بالقنيطرة تحولت إلى خراب

ماكرون يعلن موعد رفع الإغلاق الشامل بفرنسا

اندلاع حريق مهول بسوق الصالحين بسلا

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعم الإجراءات التي اتخذها المغرب بالكركرات

مبادلة عقارية مشبوهة تجر رباح أمام محكمة جرائم الأموال

كورونا بالمغرب.. 3999 إصابة و4118 حالة شفاء و73 وفاة خلال 24 ساعة

شركات تتلاعب بالفواتير للتملص من الضرائب ووزارة بنشعبون تدخل على الخط

لجنة برلمانية تحقق في التدبير المالي لمكتب الماء والكهرباء وارتفاع الفواتير

تساقطات ثلجية وطقس بارد ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة

تفاصيل الإطاحة بكوميسير ضمن شبكة للاتجار بالبشر والنصب

اعتقال شخص أخفى جثة والدته لسنوات للحصول على معاشها التقاعدي

هذه خطة المغرب لحسم ملف الصحراء وإسقاط وهم الانفصاليين

وزير الصحة يعلن الشروع في تجهيز 2888 محطة لتلقيح المغاربة ضد كورونا

هكذا أحبط اتصال الملك بالرئيس الموريتاني مخططات البوليساريو

التوفيق يعلن إصابة 287 قيما دينيا بفيروس كورونا

4701 حالة شفاء من كورونا و2587 إصابة و80 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

تفاصيل انتحار قنصل وكوميسير وطبيبة وموظف بوزارة العدل خلال يومين

سلطات تارودانت تغلق الحمامات والساحات العمومية وتعود للحجر الجزئي

منهم من أعلن توبته ومنهم من انتهى في قبر مغترب... جوانب خفية من حياة قادة بالبوليساريو

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 دواعش بمدينتي إنزكان وأيت ملول

هكذا يستعد المغرب لإنتاج وتسويق لقاح كورونا
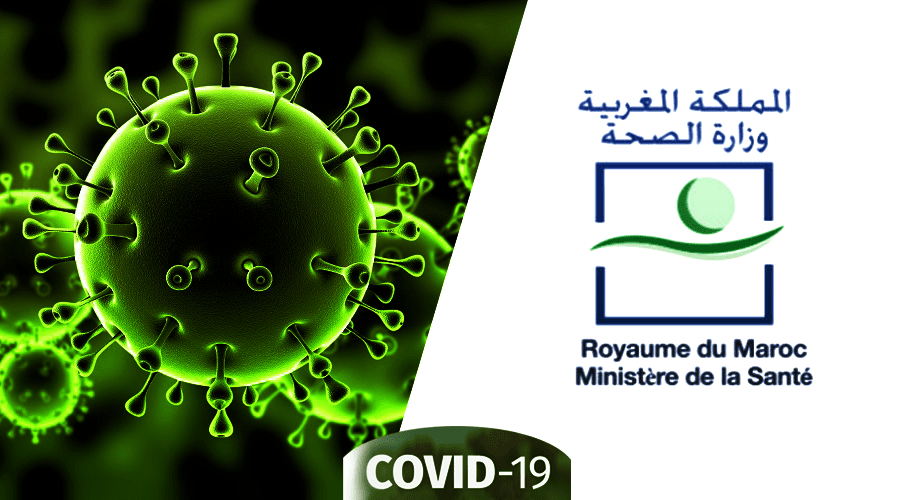
كورونا بالمغرب.. 3979 إصابة و3746 حالة شفاء و60 وفاة خلال 24 ساعة

الجيش المغربي يُسقط طائرات درون تابعة لمرتزقة البوليساريو

أمن البيضاء ينجح في تحييد الخطر الصادر عن محسوبين على فصيلين لمشجعي كرة القدم

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تزور الكركرات وتقف على مجهودات القوات المسلحة الملكية

الجيش المغربي يتصدى لهجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حساسة

صحفي يخترق اجتماعا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي
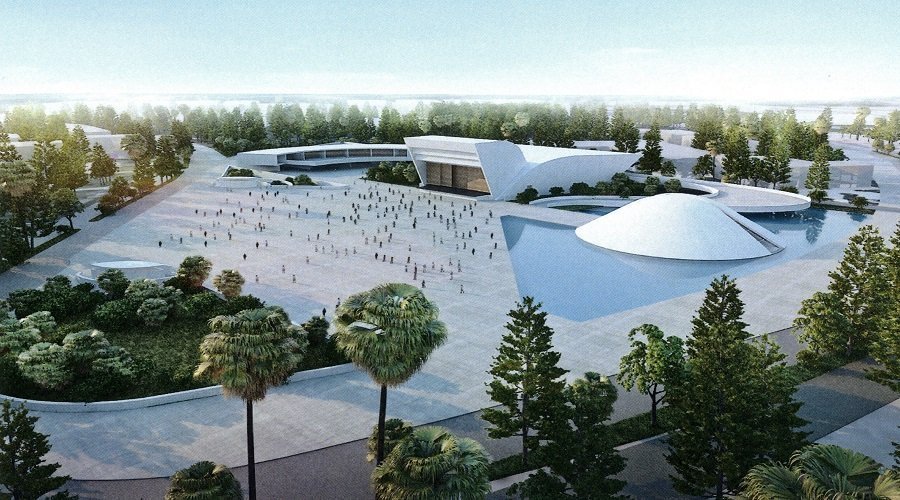
تعثر مشروع جامعي دولي بـ 200 مليار بالصويرة والداخلية تدخل على الخط

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أول فريق إعلامي مغربي يصل للكركرات

4702 إصابة بكورونا و4499 حالة شفاء و74 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

اعتماد إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار كورونا بإقليم وزان

سلطات أكادير تغلق الشواطئ وتعود للحجر الجزئي للحد من تفشي كورونا

المغرب يستعد لاستقبال شحنة من اللقاح الروسي ضد كورونا

الملك محمد السادس يعبر عن استعداده للقيام بزيارة رسمية لموريتانيا

ملف التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص في طريقه للحل

تسجيل أكثر من 80 إصابة بكورونا بمجلسي النواب والمستشارين

القبايل ترفض الاستمرار في العيش تحت الحكم الاستعماري الجزائري

المنصف المرزوقي يقصف الجزائر: لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربي لأجل مائتي ألف صحراوي

إحباط محاولة لتهريب طنين و360 كيلوغراما من المخدرات بميناء الدار البيضاء

رخص بناء غير قانونية تجر رئيس جماعة وموظفين للتحقيق

تزوير وثائق لممارسة مهنة الصيدلة يجر نافذين أمام القضاء

وزارة الصحة تحدث لجنة لمراقبة التكفل بمرضى كورونا بالمصحات الخاصة

ملك الأردن يهنئ الملك محمد السادس على فتح معبر الكركارات ويخبره عزم بلاده فتح قنصلية بالعيون

سقط عليه نيزك من السماء وسط بيته فتحول فجأة إلى مليونير
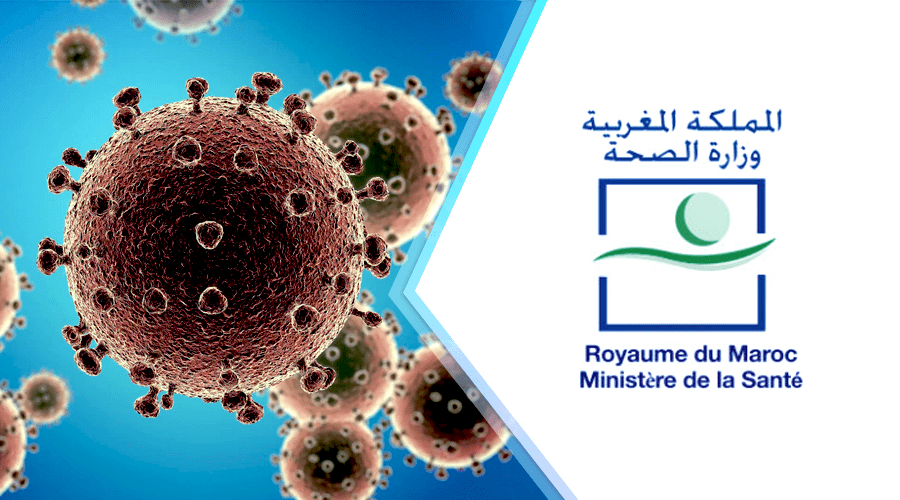
كورونا بالمغرب.. 4559 إصابة و4641 حالة شفاء و77 وفاة خلال 24 ساعة

أحزاب المعارضة توجه رسالة شديدة اللهجة للعثماني بسبب القوانين الانتخابية

تحقيقات قضائية للكشف عن تفاصيل سقوط طبيبة من عمارة سكنية بطنجة

هل يستعين الجيش المغربي بطائرات بيرقدار التركية في الكركرات ؟

هكذا يلجأ مهربون لحيلة المآثر التقليدية لتهريب المخدرات بطنجة

قنصل فرنسا ينتحر شنقا بطنجة

تفاصيل تدخل درك برشيد لتحرير قاصر تعرضت للاختطاف

قضية نصب بـ300 مليون تجر زعيم حزب سابق للتحقيق

كورونا يخطف الكولونيل ماجور لسان الدين الزمزمي

لارام تكشف تفاصيل منع الانفصالية أميناتو حيدر من السفر إلى لاس بالماس

منع الانفصالية أميناتو حيدر من السفر إلى جزر الكناري بسبب إصابتها بفيروس كورونا

5757 حالة شفاء من كورونا و5391 إصابة و81 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

خبراء: نتائج تجارب لقاح كورونا بالمغرب مطمئنة وتبعث على التفاؤل

الفرنسيون يحتكرون صناعة القطارات بالمغرب ومجلس المنافسة يدخل على الخط

آيت الطالب يكشف أسباب ارتفاع وفيات كورونا بالمغرب

وزير الصحة: طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني

جبهة العمل السياسي الأمازيغي تلتحق بحزب الأحرار

هذه خطة وزارة الخارجية لوضع حل نهائي لقضية الصحراء المغربية
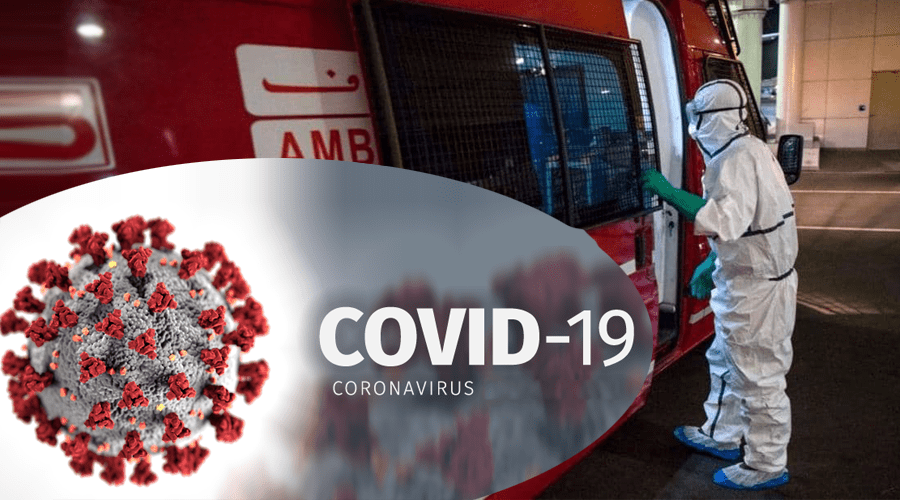
كورونا بالمغرب.. 5415 إصابة و4235 حالة شفاء و82 وفاة خلال 24 ساعة

الاتحاد البرلماني العربي يؤيد الإجراءات التي اتخذها المغرب بالكركرات

هكذا يستعد المغرب لإنتاج وتسويق لقاح كورونا

اعتقال 27 شخصا بعد أحداث عنف وتخريب بالدار البيضاء

وفاة زوجين بكورونا في يوم واحد بآسفي و5 من عائلة بالصويرة

هكذا تمكنت القوات المسلحة الملكية من حسم الوضع في الكركرات خلال 30 دقيقة
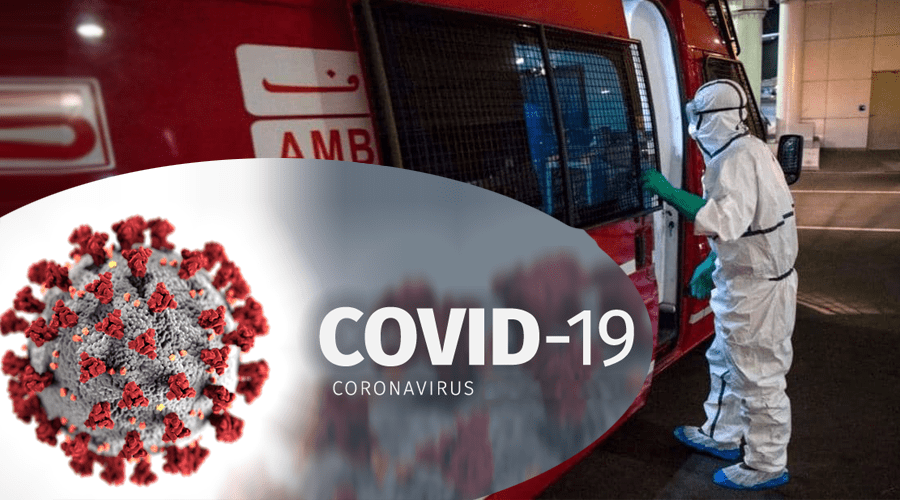
4761 حالة شفاء من كورونا و3012 إصابة و71 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع غوتيريش حول الوضع بالكركرات

التغرير بأطفال واغتصابهم يطيح بعون سلطة في تيزنيت

مجلس جطو يشرع في افتحاص قنصليات مغربية بالخارج

افتتاحية الأخبار.. عزلة الجزائر

بعد فايزر.. موديرنا تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94,5%

دعم إفريقي واسع لتحرك الجيش المغربي بالكركرات

بايدن يحتفل بعيد ميلاده بمراكش وترامب يلتقي الحسن الثاني حول مائدة كسكس.. قصص لقاءات ملوك المغرب مع رؤساء أمريكا

المغرب يدين أعمال التخريب والعنف التي استهدفت قنصليته في فالنسيا

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدعو إلى التعبئة لفضح افتراءات البوليساريو

كورونا بالمغرب.. 4966 إصابة و3690 حالة شفاء و82 وفاة خلال 24 ساعة

الإعلام الجزائري يصاب بالسعار ويروج أكاذيب حول فتح معبر الكركرات (صورة)

الجيش المغربي يدمر مركبة عسكرية للبوليساريو بالمحبس

هل يستعد بايدن لتعيين هيلاري كلينتون سفيرة لدى الأمم المتحدة؟

القوات المسلحة الملكية تعرض حصيلة 60 سنة من مشاركات تجريداتها العسكرية في حفظ الأمن والعمل الإنساني دوليا

5 مفقودين في غرق قارب للهجرة السرية ببوزنيقة

قتيلان وجريح في هجوم بفرنسا
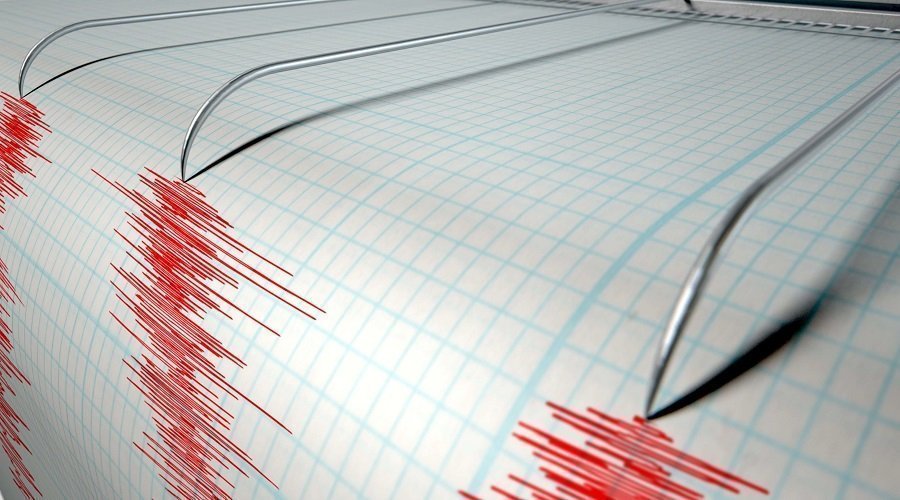
تسجيل هزة أرضية بالمحيط الأطلسي قبالة الدار البيضاء

منظمة التعاون الإسلامي تعزل الجزائر وتؤيد طرد المغرب لمليشيات البوليساريو

دول الخليج تدعم الإجراءات التي اتخذها المغرب بالكركرات

رسميا.. إعادة فتح معبر الكركرات

كورونا بالمغرب.. 5875 إصابة و5744 حالة شفاء و66 وفاة خلال 24 ساعة

الأحرار يثمن العملية التي باشرتها القوات المسلحة الملكية في الكركرات

تضامن وتأييد عربي واسع للمغرب في تحركه لحماية أراضيه
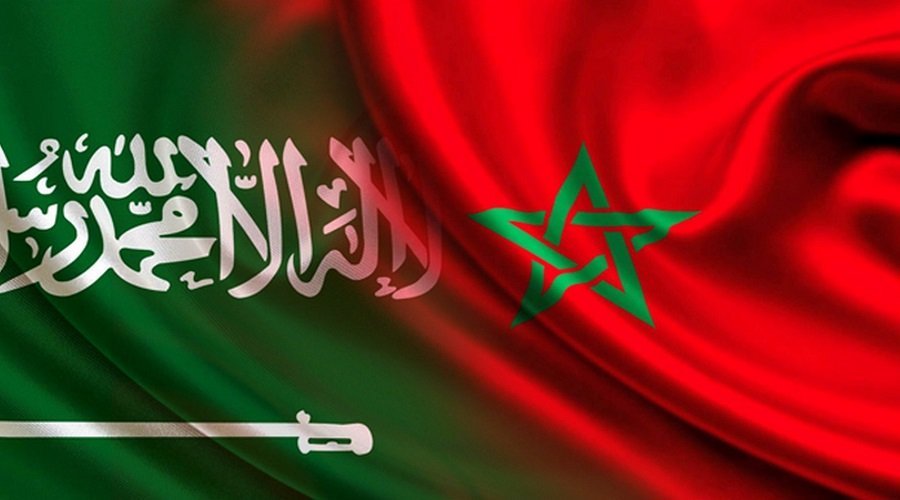
السعودية تؤيد الإجراءات التي اتخذها المغرب بالكركرات

تفاصيل الإطاحة بشبكة "صحافيين" تخصصت في ابتزاز رجال أعمال بمئات الملايين

هذا ما كشف عنه السلاوي أمام ترمب بشأن لقاح كورونا

الاستقلال يشيد بالتدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية لتحرير معبر الكركرات

بعد الإمارات قطر تعبر عن تأييدها لتدخل الجيش المغربي في معبر الكركرات

قيادة الجيش المغربي تؤكد أن معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل

وزارة الخارجية تكشف تفاصيل تدخل الجيش المغربي بالكركرات

جماعة العيون تشيد بتدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات

الجيش المغربي يدمر آليات عسكرية للبوليساريو بمنطقة المحبس
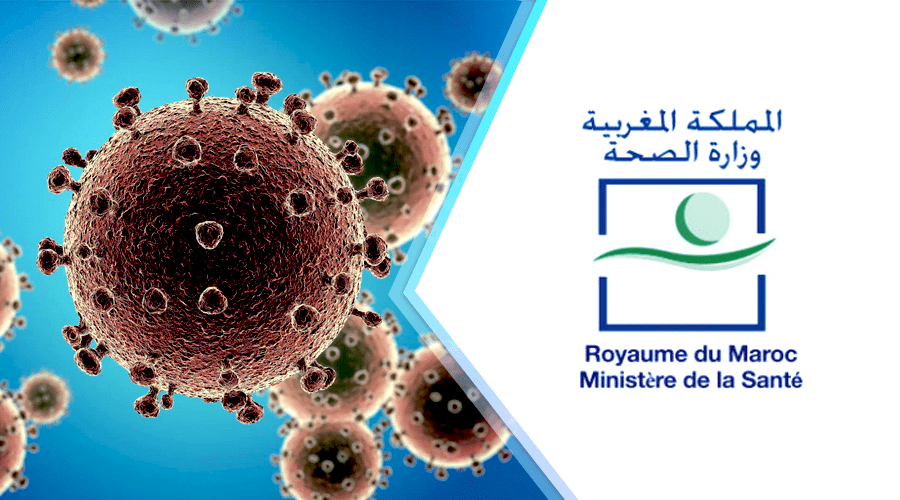
5515 إصابة بكورونا و3120 حالة شفاء و61 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

هكذا سطت مافيا العقار على 47 ألف هكتار من الأراضي السلالية
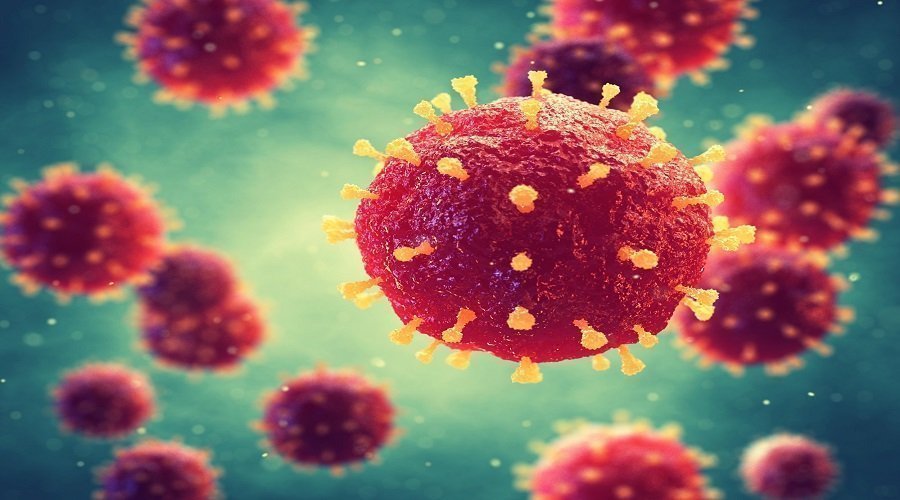
إندونيسيا تعتمد الاختيار المغربي وتقرر تطعيم مواطنيها باللقاح الصيني

بعد اللقاح الصيني المغرب في طريقه للحصول على اللقاح الأمريكي ضد كورونا

عاجل بالصور... مرتزقة البوليساريو يحرقون خيامهم ويفرون دون مقاومة بعد تدخل عناصر الجيش المغربي

الجيش المغربي يطرد ميليشيات البوليساريو من الكركارات ويفرض سيطرته على المنقطة العازلة

عاجل... المغرب يقرر التحرك لوضح حد لاستفزازات ميليشيات البوليساريو بالكركرات

اختفاء أدوية كورونا وفقدان لقاح الأنفلونزا في عز حملة التلقيح ضد المرض

أخنوش يكشف خلال ندوة للبنك الدولي أسباب نجاح الفلاحة المغربية في مواجهة أزمة كورونا

مجلس جطو يشرع في افتحاص ANAPEC

49 مليار سنتيم لميزانية مجلس النواب منها 20 مليارا للتعويضات والسفريات

العثماني يؤكد اختيار المغرب للقاح آمن وفعال ويطالب بعدم التراخي في مواجهة الوباء

قاصر يضرم النار في عشريني حاول اغتصابه في سلا

300 سرير إضافي لاستقبال حالات كورونا الحرجة بالمستشفى الميداني بالدار البيضاء

الأحرار يشيد بدور الملك في توفير لقاح كورونا وينشئ لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية

هذه حقيقة فرض إجبارية التلقيح ضد كورونا على المغاربة

المحكمة تبطل قرار وهبي بإعفاء أبودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب

مقترح بتمويل المغاربة المتزوجين حديثا بـ 150 مليون سنتيم

لودريان: المغرب فاعل محوري في إفريقيا بمجال المتاحف والتراث

العثماني يخصص مليار و200 مليون لإمداد برلمانيين ببونات المازوط

الاتجار العشوائي يستنزف مخزون أدوية كورونا بالشمال ومطالب لوزير الصحة بالتدخل

نفاذ أكياس الدم ينذر بكارثة صحية في الدارالبيضاء

تنبيهات مهمة للوقاية من كورونا قبل التطعيم ضد الفيروس

جمعيات مغربية تلقت تمويلات من جهات أجنبية بلغت 31 مليار سنتيم

هذه أسباب ارتفاع الوفيات في صفوف المصابين بكورونا بجهة الشرق

5214 إصابة بكورونا و3946 حالة شفاء و69 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

مصحات خاصة تلزم عائلات مرضى كورونا بتقديم شيكات ضمان بمبالغ خيالية

68 مؤسسة تعليمية خاصة أفلست و140 ألف تلميذ انتقلوا من الخصوصي إلى العمومي

لارام تُلزم زبائنها باختبار كورونا لا تتجاوز مدته 72 ساعة لدخول المغرب

مجلس جطو يشرع في افتحاص الجامعات وأكاديميات التربية والتكوين

الرصاص ينهي حياة جانح هاجم الشرطة بسيفين بتمارة

تفاصيل إيقاف 50 مطلوبا للعدالة بتامسنا في يوم واحد واعتقال 30 متهما بالصخيرات

وفاة صائب عريقات في مستشفى إسرائيلي بعد صراع مع كورونا

ملفات مجالس جهات وجماعات بيد القضاء ومجلس الحسابات

إجراءات مشددة بأحياء سلا بعد تزايد إصابات كورونا

وأخيرا بشرى سارة للمغاربة... الملك يعطي تعليماته بإطلاق عملية تلقيح واسعة ضد كورونا وهؤلاء هم أول من ستشملهم العملية

لارام تعلن عن تدابير جديدة للراغبين في السفر إلى فرنسا
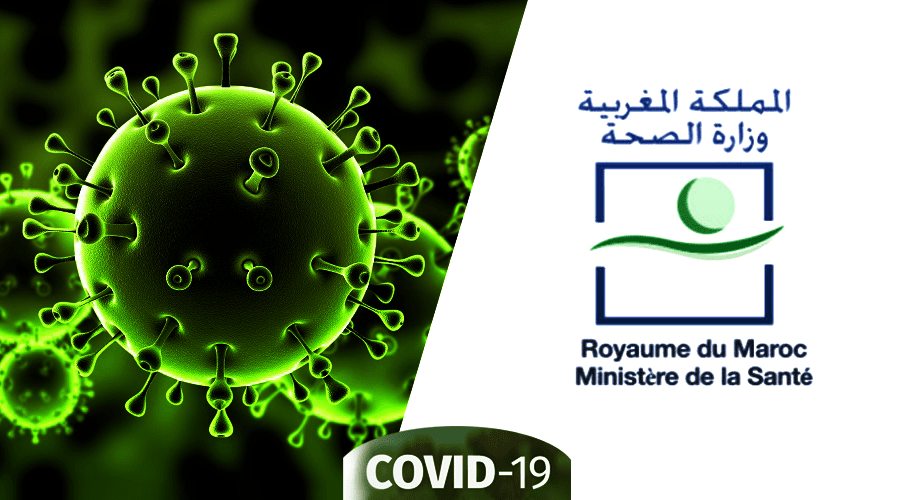
كورونا بالمغرب.. 3170 إصابة و3104 حالات شفاء و84 وفاة خلال 24 ساعة

مجلس جطو يشرع في افتحاص أموال جمعيات الأعمال الاجتماعية للوزارات

افتتاحية الأخبار.. خطاب الثقة والتحدي والأمل

جطو يبعث إنذارات إلى حوالي 4000 مسؤول لم يصرحوا بممتلكاتهم
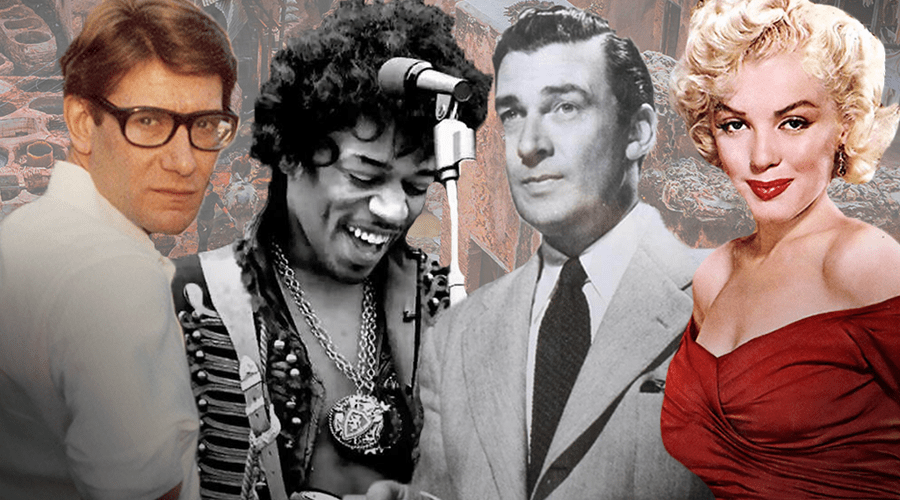
شون كونري وهاندريكس وكاثرين دونهام.. قصص غير مروية لنجوم عالميين زاروا المغرب في قمة مجدهم

تهم الفساد وإسقاط مشروع الميزانية تلاحق رئيس جماعة عن البيجيدي

أمن طنجة يدخل على خط الشابين المتهورين اللذين قطعا الطريق في طنجة أمام حركة المرور من أجل تناول الشيشة
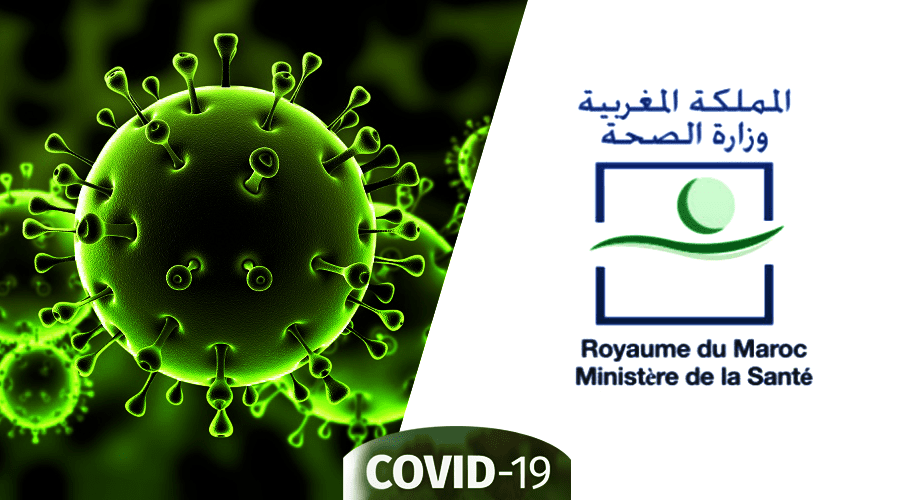
4596 إصابة بكورونا و4245 حالة شفاء و75 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

وسائل تقنية متطورة بالمعابر الحدودية بعد تحذيرات الداخلية من تسلل مقاتلين أجانب

ترامب مستعد للاعتراف بهزيمته أمام بايدن بشرط

الملك: الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة ستكون واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي

الملك : 85% من الدول لا تعترف بالكيان الوهمي والمغرب لن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة

الملك يؤكد أن المغرب سيتصدى بكل قوة وحزم لتجاوزات أعداء الوحدة الترابية

كورونا بالمغرب.. 5836 إصابة و4602 حالة شفاء و70 وفاة خلال 24 ساعة
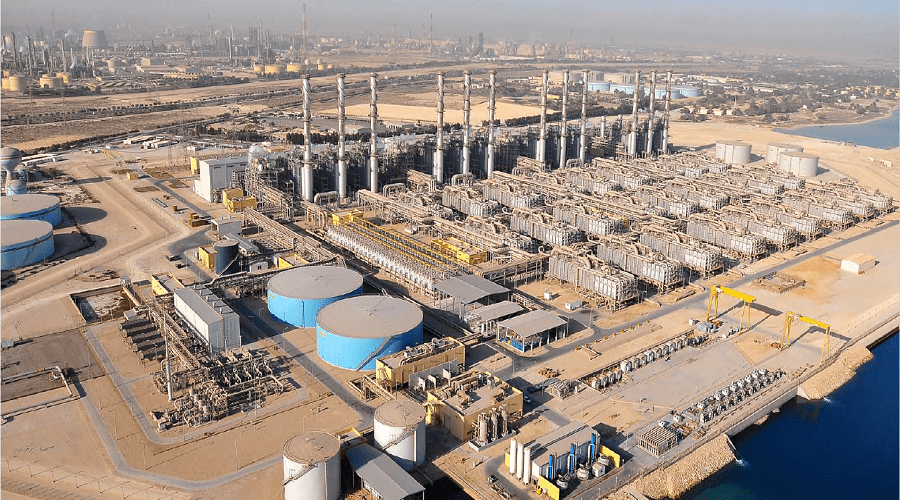
أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الإفريقي ستكون في الدار البيضاء

صديقي: ترشيد مياه السقي في صلب استراتيجيات التنمية الفلاحية بالمغرب
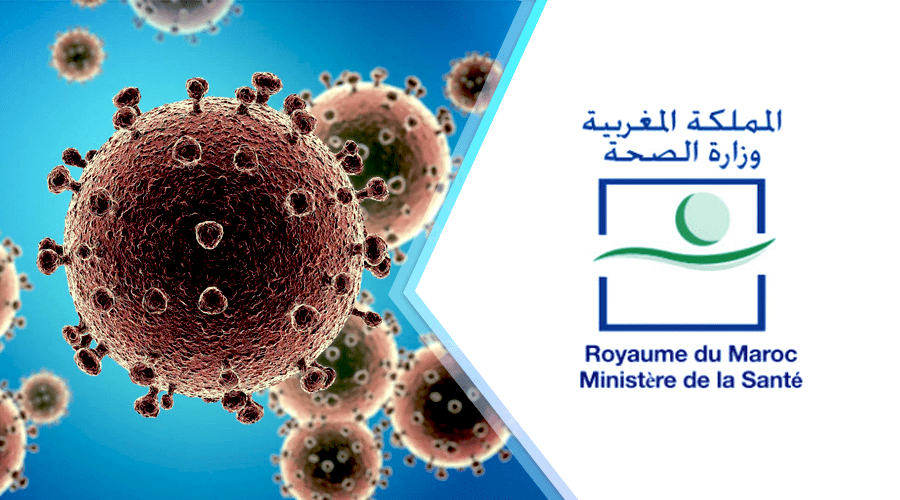
5398 إصابة بكورونا و3739 حالة شفاء و68 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

تأجيل الخطاب الملكي إلى يوم غد السبت بسبب كورونا

الداخلية تكشف خروقات مالية وإدارية خطيرة في تدبير الجماعات

التحقيق في قتل فتاة بالعرائش بطلق ناري

هذه شروط الدخول إلى فرنسا بالنسبة للقادمين إليها من المغرب

إطلاق النار لتوقيف 3 أشخاص عرضوا عناصر الشرطة لاعتداء خطير بالبيضاء

التحقيق مع ستيني متهم باغتصاب كفيفة بتطوان

حقيقة إغلاق سلطات الرباط لمؤسسة "وسيط المملكة" بسبب كورونا

المجلس الأعلى للتقييس يطلق العمل بسياسة الجودة الوطنية

أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات ليومين في عز أزمة كورونا

الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء

عبد الحق نجيب الصحافي وبطل المغرب السابق في كمال الأجسام يدخل المستشفى بسبب كورونا

كورونا بالمغرب.. 5641 إصابة و3329 حالة شفاء و77 وفاة خلال 24 ساعة

أمن تطوان يحقق في حجز شاحنتين محملتين برمال مسروقة

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 10 دجنبر

اتهامات للعمدة صديقي بتمرير ميزانية الرباط خارج القانون

قرض إسباني للمغرب بـ5 ملايين أورو للمساهمة في بناء محطتين لتحلية مياه البحر

لفتيت : الحالة الوبائية مقلقة ومواطنو هذه الجهات لا يتعاونون

بالفيديو.. عاصفة رعدية تنهي حياة دركي بسيدي قاسم

المغرب يسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا بـ 5745 حالة خلال 24 ساعة

الداخلية تشرع في محاسبة رؤساء الجماعات وأحكام بمتابعة 58 منتخبا وعزل 138

أمطار رعدية قوية الأربعاء والخميس بهذه المناطق من المملكة

متابعة البرلماني بلفقيه و10 متهمين في ملف السطو على أراضي الغير بكلميم

تزوير وثائق يجر مسؤول نقابي وموظف تصحيح الإمضاءات ببنسليمان إلى القضاء

تحويلات مشبوهة وشركات للبيع الهرمي ودعارة إلكترونية... النيابة العامة تدخل على الخط
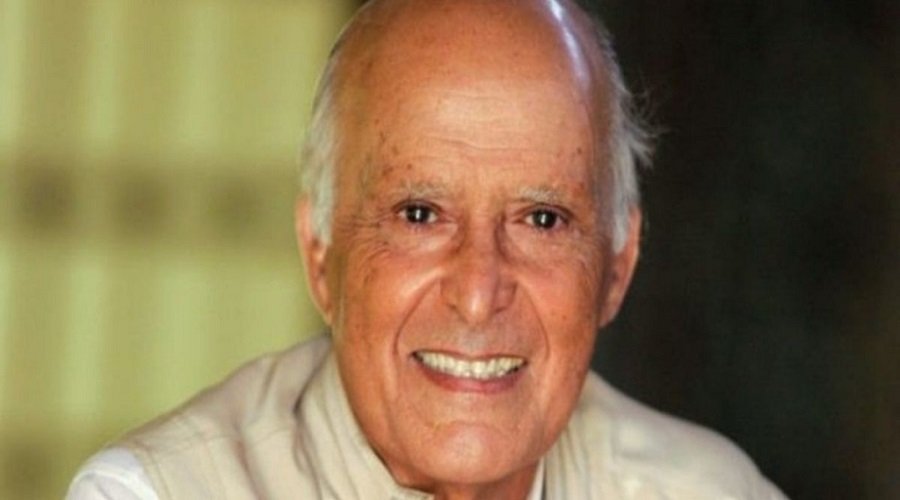
وفاة مولاي أحمد العراقي رئيس وزراء المغرب الأسبق

المجلس الأعلى للقضاء يصدر رأيه في قانون هيئة محاربة الرشوة

العثماني : العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون إصلاح القرض الشعبي للمغرب
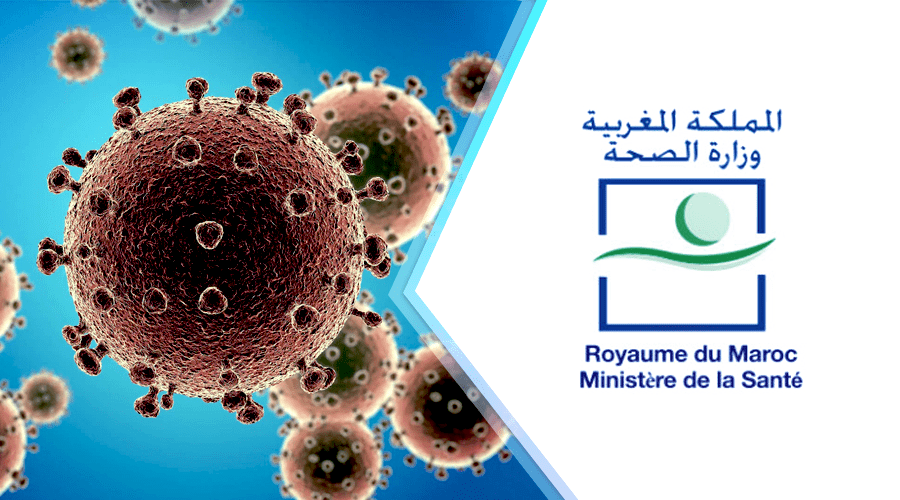
كورونا بالمغرب.. 4495 إصابة و2808 حالة شفاء و74 وفاة خلال 24 ساعة

هكذا تستغل لوبيات الأدوية أزمة كورونا لمراكمة الأرباح

لفتيت: إنجاح الانتخابات المقبلة يشكل تحديا للداخلية وللفاعلين السياسيين

التامك يؤكد ضرورة خلق موارد مالية إضافية لتمويل قطاع إدارة السجون

الفردوس يكشف موعد المناظرة الوطنية للصحافة

منفذ هجوم أفينيون بفرنسا ليس إرهابيا ولم يصرخ الله أكبر (فيديو)

ابن مسؤول سابق ينصب على شركات معروفة بالبيضاء في المليارات

التكفل بالعلاجات من كورونا واسترجاع مصاريفها... الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تنشر البروتوكول العلاجي

2526 إصابة بكورونا و2788 حالة شفاء و64 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

وفاة مرضى كورونا في طنجة بسبب نقص الأوكسيجين.. وزارة الصحة توضح

إصابة تقنيين في انفجار بمركب إداري تابع للقوات المسلحة الملكية

مغاربة رفضوا إغراء فرنسا واستطاعوا تحقيق الحلم الأمريكي

وزارة الصحة تعلن إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

لقاح صيني جديد ضد كورونا جاهز للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الاستقلال يسائل وزير الصحة حول التأخر في توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بالصيدليات
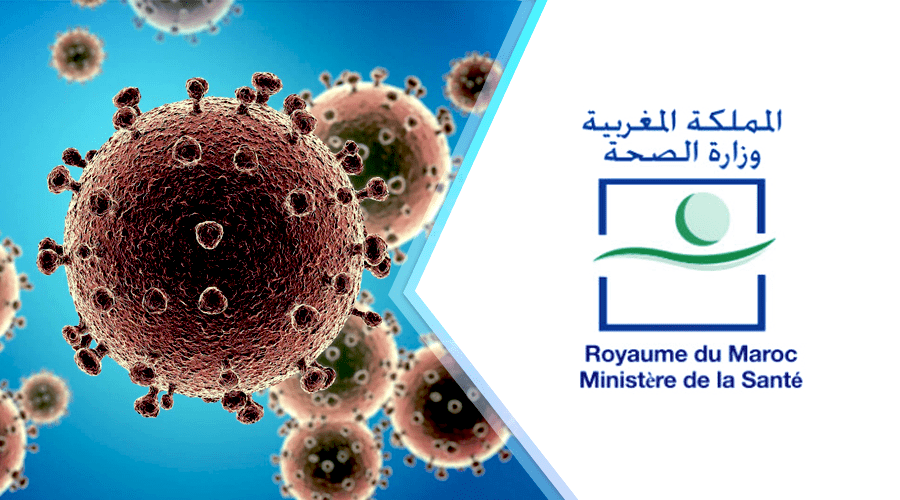
كورونا بالمغرب.. 3460 إصابة و3038 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الوكيل العام يكلف الفرقة الوطنية بالتحقيق في بلاغ العودة للحجر الصحي المزور

هذه حقيقة عودة المغرب للحجر الصحي الشامل
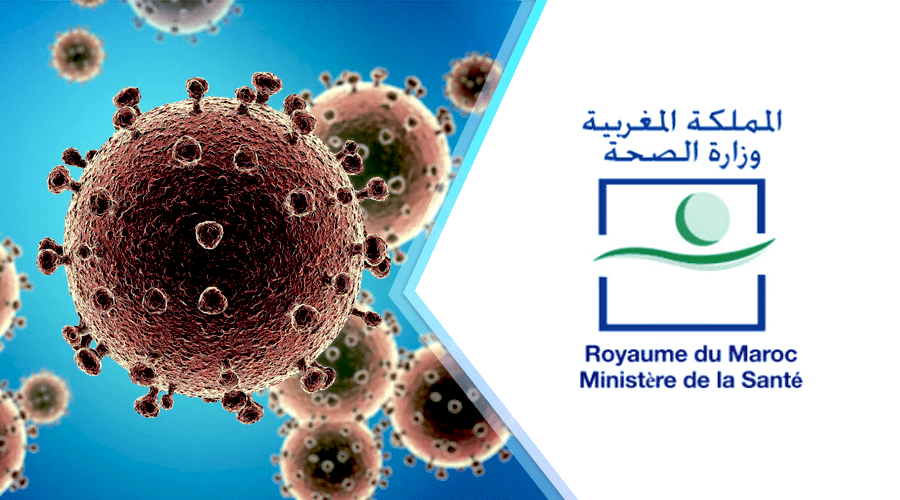
كورونا بالمغرب.. 3790 إصابة و3350 حالة شفاء و70 وفاة خلال 24 ساعة

هذه خطة وزارة الصحة لتطعيم المغاربة ضد الإنفلونزا الموسمية

بعد قرار العودة للحجر.. هذا مصير الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا

أمن الرباط يطيح بـ4 متورطين في سرقة السيارات والتزوير

3256 إصابة بكورونا و3014 حالة شفاء و53 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

درك تطوان يحقق في اتهام دجال باغتصاب ستينية كفيفة

بالفيديو.. مد عالي يخلّف خسائر فادحة بكورنيش عين الذئاب

بالفيديو . . ميني تسونامي يضرب أحياء سيدي موسى بسلا والمحيط والفتح بالرباط ويخلف خسائر مادية

مفتشو الداخلية يكشفون تلاعبات خطيرة في صفقات مجلس القنيطرة

المغاربة حطموا الرقم القياسي لاستهلاك بوطاغاز والسكر خلال الحجر الصحي
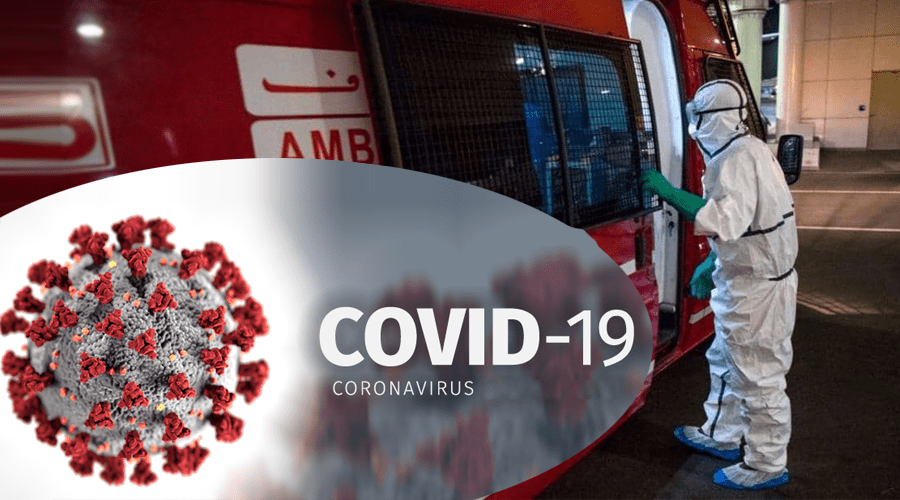
إصابة باشا مدينة سيدي سليمان بكورونا

كورونا يخطف الصحافي إدريس أوهاب

الملك محمد السادس يحيي ليلة المولد النبوي الشريف

مندوبية التامك تخصص ترقية استثنائية لشهيد الواجب والموظفين المصابين وتؤمِّن السكن والعيش الكريم لأسرة الفقيد

الملك يصدر عفوه على 931 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي

بالفيديو.. شاهد لحظة تنفيذ الهيش إرهابي خلية تمارة لجريمته في حق حارس سجن تيفلت

مكونات مجلس المستشارين تدين المس بالمقدسات الإسلامية

بيم تتحدى سلطات برشيد وتفتح محلا تجاريا بدون رخصة

هذه تفاصيل التعيينات والتنقيلات الجديدة التي أفرج عنها الحموشي بالمناطق الأمنية

المغرب يستعد للتوصل بـ10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الصيني خلال دجنبر

مقتل موظف بسجن تيفلت على يد معتقل ضمن خلية إرهابية

الحكومة تعرض مؤسسات عمومية للبيع وتوقعات بتحصيل 400 مليار سنتيم

السجن لرئيس ناد رياضي ببرشيد بتهمة اغتصاب قاصر
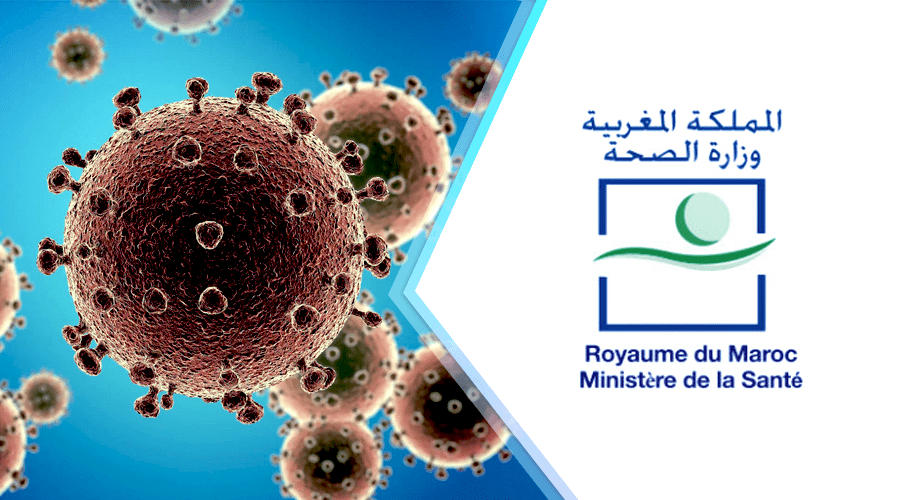
3988 إصابة بكورونا و2784 حالة شفاء و72 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

افتتاحية الأخبار.. وضعية عالية المخاطر

مقتل رجل من أصول إفريقية برصاص الشرطة الأمريكية يشعل الاحتجاجات

مختبر خاص أجرى أزيد من 20 ألف اختبار كورونا دون رخصة

هذه هي المبالغ التي طالبت المحكمة المدانين في ملف CNSS بإعادتها وهذه أسماؤهم

كورونا بالمغرب.. 2226 إصابة و2727 حالة شفاء و72 وفاة خلال 24 ساعة

وثائق سرية تكشف كواليس أول تعديل وزاري في تاريخ المغرب

موتى بلا قبور... بن بركة والمانوزي وآخرون.. قصص اختفاء مغاربة ظلوا بلا قبور أو شهادة وفاة

بعد قرار المنع.. جهة الرباط تسمح للقاعات الرياضية باستئناف العمل

المغرب يدين بشدة الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللنبي محمد (ص)
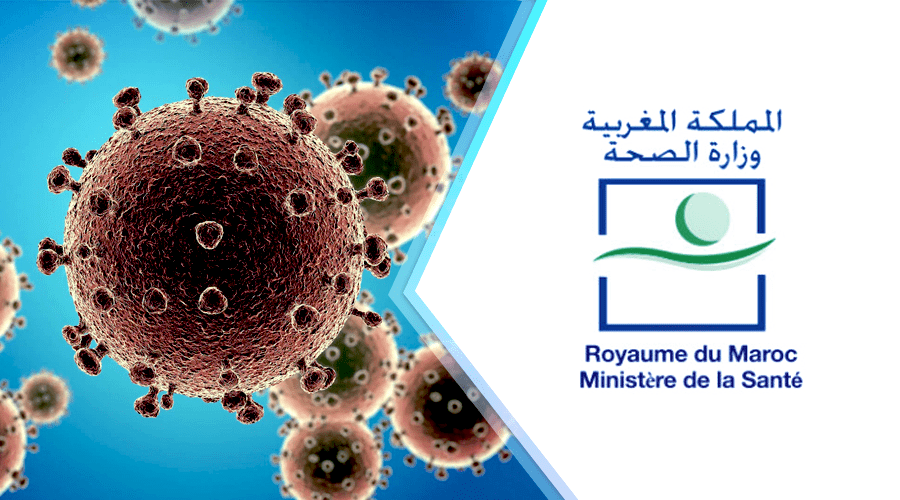
3020 إصابة بكورونا و2823 حالة شفاء و46 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

ريان إير تستأنف أنشطتها في المغرب بـ 58 رحلة أسبوعية على 45 خطا

اعتقال عون خدمة حاول اغتصاب مريضة بمستشفى السويسي

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات توظيف في هذه التخصصات

أمن وجدة يفك لغز جريمة قتل سيدة بمنزلها
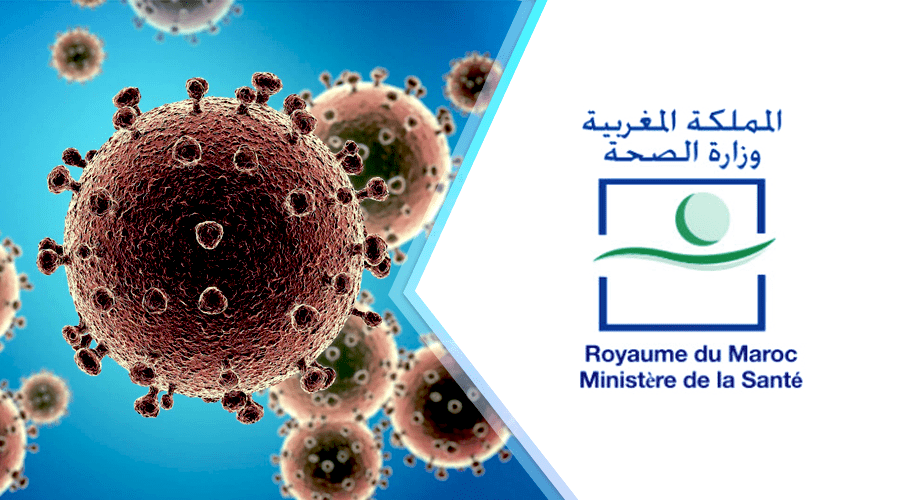
كورونا بالمغرب.. 4045 إصابة و3197 حالة شفاء و50 وفاة خلال 24 ساعة

3685 إصابة بكورونا و2694 حالة شفاء و73 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

الحكومة تمنع التنقل الليلي بالدار البيضاء الكبرى وتتخذ تدابير جديدة لمكافحة كورونا

هذه كواليس ازدياد استفزازات البوليساري للنقاط العسكرية المغربية

تفاصيل استنطاق 20 متهما في ملف بلانات الشينوا بفاس

إعفاء رئيس المجلس العلمي ببنسليمان.. بعد عزل أحد الأعضاء الذي وصف المغرب ببلد السحر والشعوذة

سلطات البيضاء تمنع من لا يتوفر على رخصة استثنائية من دخولها

محكمة النقض تنهي مهام رئيسة بلدية المحمدية ومؤسسة التعاون البيضاء

الكوكايين يطيح بـ 7 أشخاص بينهم سياح أجانب بالصويرة

ادعمار يواجه عاصفة انتقادات بخصوص تدبير إصابة موظفين بكورونا

رباح يواصل إغراق بلدية القنيطرة بالديون باقتراض 14 مليارا

بيع تجهيزات رونو طنجة في السوق السوداء يطيح بـ 60 مستخدما

الملك ينبه إلى التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة

العثماني يمنح هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين بـ 2900 مليار سنتيم

عمالة المضيق تعود لفرض حجر جزئي وحظر التجوال الليلي

أمن العرائش يشهر السلاح لايقاف جانح هدد سلامة المارة

سلطات سيدي سليمان تقرر العودة للحجر الصحي بعد إصابة عدد من أئمة المساجد وأساتذة التعليم العمومي

هذا مستقبل مشاريع البنيات التحتية الكبرى في ظل مشروع قانون المالية 2021

مفتشو الداخلية يكشفون اختلالات في تفويت رباح لعقارات القنيطرة

أخطاء ارتكبها موظفون كلفت الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية تعويضات بمئات الملايين

ضبط طن من اللحوم الفاسدة كانت في طريقها لموائد الطنجاويين

توقيف شرطيين يشتبه تورطهما في قضية ابتزاز بالرباط

بعد انتهاء التجارب السريرية.. المغرب يفاوض الصين لإنتاج لقاح كورونا

أمن الرباط يطيح بأفارقة متهمين بسرقة واجهات تجارية كبرى

العثور على طفل اختفى في ظروف مشكوك فيها بطنجة

هكذا تتصدى عناصر الأمن والدرك لشبكات الهجرة السرية في زمن كورونا

تحذير.. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

تقرير أسود لمفتشي الداخلية حول تدبير المال العام ببلدية القنيطرة

السجن 10 سنوات لحلاق تسبب في مقتل 20 مرشحا للهجرة السرية

الرياح القوية تتسبب في انهيار منزلين بالدار البيضاء

مقالع الرمال تجر رباح للمساءلة أمام البرلمان

مجلس النواب الإسباني يصادق على اتفاقية مع المغرب لمكافحة الجريمة

الرميلي: الوضع الصحي بجهة البيضاء مقلق والأطر الصحية أصابها الإنهاك واستهتار المواطنين غير مقبول

مجلس الحسابات يعري اختلالات عقود جمع النفايات والتنظيف بجهة الرباط
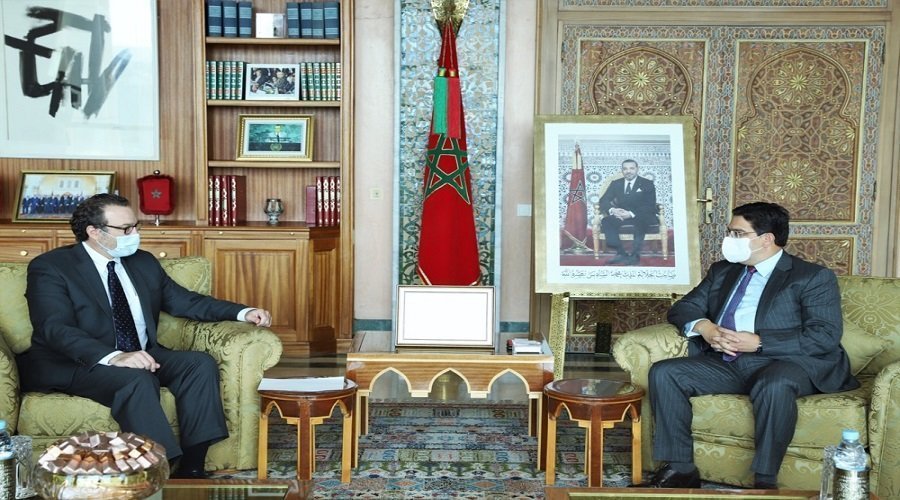
أمريكا تقدر دعم الملك محمد السادس في القضايا ذات الاهتمام المشترك

المغرب يتفاوض مع 3 شركات أخرى لتوفير لقاح ضد كورونا

كورونا بالمغرب.. 2449 حالة شفاء و2117 إصابة و48 وفاة خلال 24 ساعة

اختلاس الملايين يقود مدير بنك وموظفين إلى السجن بالصويرة

الحكومة تمدد فترة العمل بتدابير كورونا لمدة 14 يوما بالدار البيضاء

مديرية الأرصاد تحذر من هبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة

تعرف على أبرز زلات البرلمانيين والوزراء المغاربة عبر التاريخ

لوديي يتباحث بالرباط مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاني
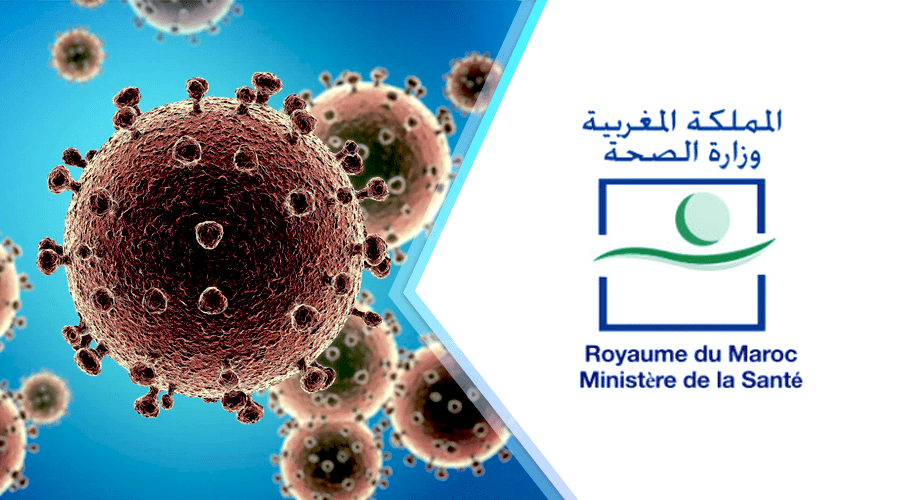
2721 إصابة بكورونا و2591 حالة شفاء و50 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

أكادير تستقبل أول مجموعة من السياح بعد أشهر من الإغلاق

كورونا بالمغرب.. 3763 إصابة و2392 حالة شفاء و60 وفاة خلال 24 ساعة

هكذا تستعد وزارة الصحة لتلقيح المغاربة ضد كورونا

وزارة التعليم تفتح باب الترشيح لمباريات الأساتذة أطر الأكاديميات

المغرب وفرنسا يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون الأمني

بالصور..هكذا كانت العودة لصلاة الجمعة بمساجد المغرب بعد انقطاع دام 7 أشهر

3498 إصابة بكورونا و2953 حالة شفاء و46 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020

التحقيق في اتهام برلماني بالتزوير في تطوان

أشجار مسروقة من فيلا مسؤول سياسي تقود أمن الرباط لاكتشاف جريمة قتل بشعة

المغرب يستعيد 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة من فرنسا

بالصور.. افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بالعرائش ووجدة

صفقة مراحيض عمومية بتكلفة 60 مليونا للواحد تخلق الجدل بالبيضاء
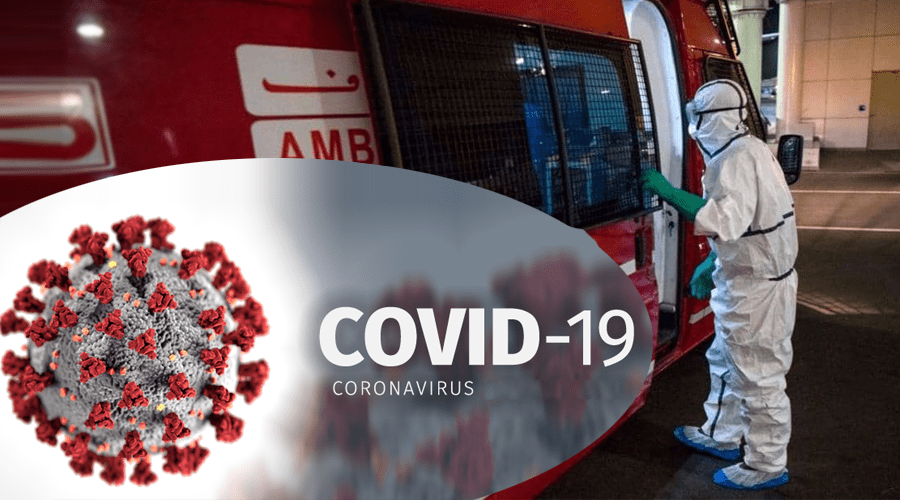
كورونا بالمغرب.. 3317 إصابة و2077 حالة شفاء و46 وفاة خلال 24 ساعة
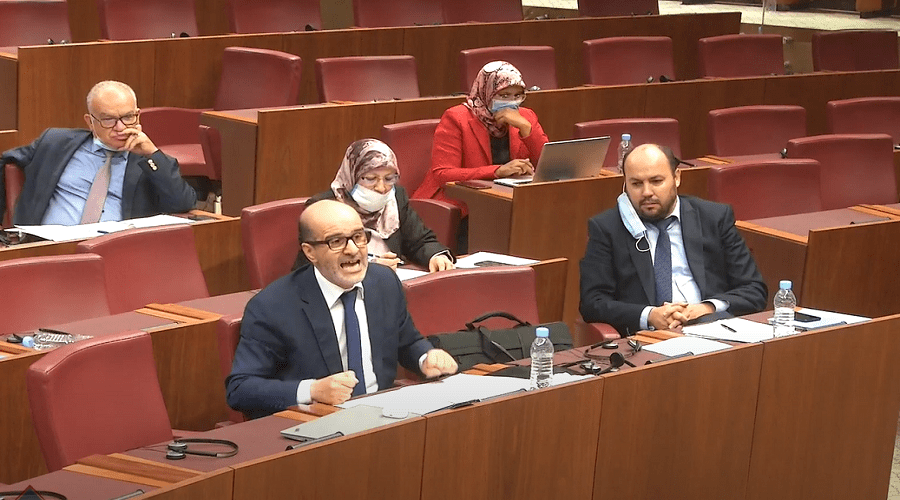
هده خطة البيجيدي لمواجهة منتقديه على مواقع التواصل

هل تم توزيع كمامات سامة مجانًا على الأساتذة

400 حافلة جديدة ستشرع في تعويض حافلات لافيراي المؤقتة نهاية الأسبوع الجاري بالدار البيضاء

لارام تطالب القضاء بحل جمعية الربابنة

إيهام فتيات بالزواج وانتحال صفة يقود دركيا سابقا إلى السجن

المجلس الوزاري يصادق على مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا و3 قوانين بالمجال العسكري

الملك يترأس مجلسا وزاريا ويستفسر وزير الصحة عن لقاح كورونا

سلطات أكادير تعيد فتح الشواطئ وتمدد ساعات عمل المطاعم وسوق الأحد

الأمم المتحدة تعترف بنجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب

مقترح لتصفية معاشات البرلمانيين تقدم به البيجيدي سيكلف 20 مليارا

الفرقة الوطنية للدرك تفك لغز سطو مسلح على مصنع ضواحي الرباط

تعليمات عليا بهدم السور الذي شيدته السلطات لإغلاق طريقين تربطان مدينة تمارة بشاطئ الهرهورة وعودة حركة المرور لطبيعتها

حكم قضائي يُعوّض إعلاميا بـ 5 مليون سنتيم بسبب تأخر القطار بساعة و15 دقيقة عن موعده
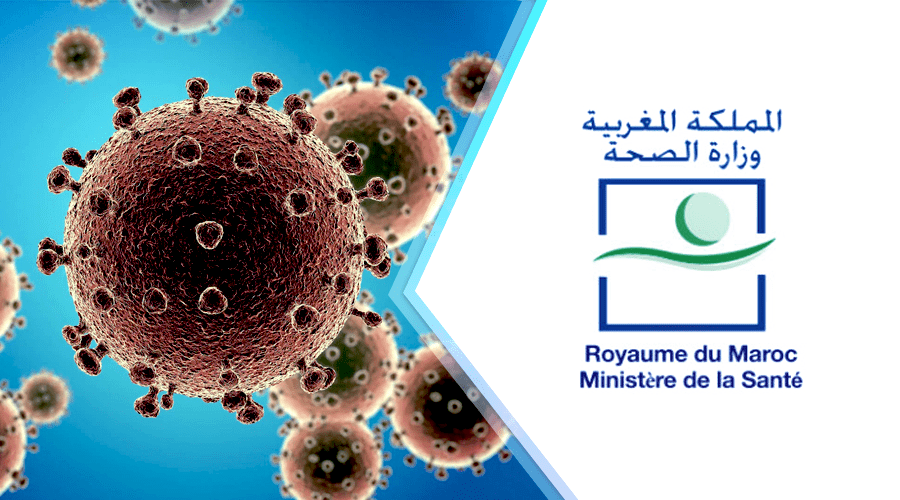
كورونا بالمغرب.. 3185 إصابة و1964 حالة شفاء و49 وفاة خلال 24 ساعة

العثماني يواصل إغراق المغرب في الديون الخارجية

وزارة الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بمساجد المغرب

تغريم أستاذين مليونيين عن كل ساعة تأخير في تسليم نقط الطلبة

مقتل تلميذ طعنا على يد لص حاول سرقة هاتفه بالبيضاء

تفاصيل التحقيق مع منتخبين ودركي بسبب الكوكايين في سطات

تفويت بقعة بالملك البحري لابن نائب العمدة

تطورات مثيرة في قضية رمي دركي لمواطن بالرصاص في برشيد

هيئة المهندسين الطبوغرافيين تشجب الادعاءات الكاذبة في حقها وفي حق شركائها

لأول مرة في المغرب حالات التعافي من كورونا تضاعف حالات الإصابة
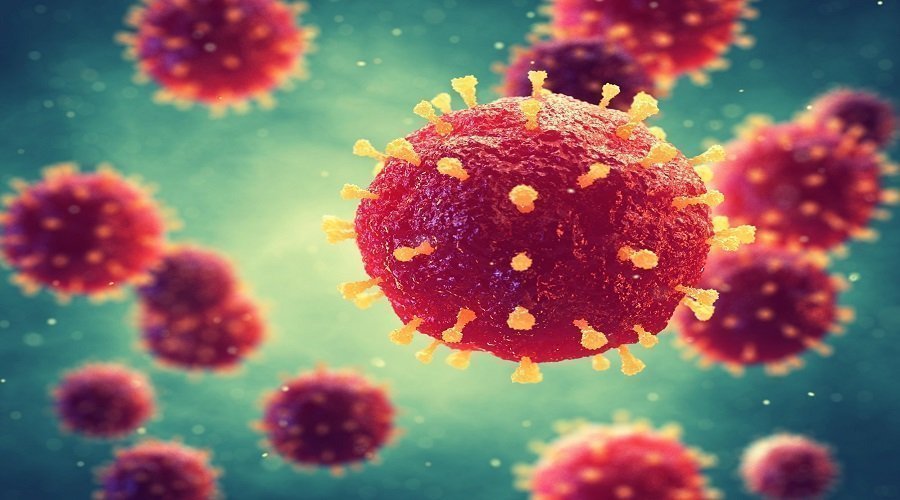
دواء لقرحة المعدة يظهر نتائج إيجابية في علاج مرضى كورونا

التحقيق في صفقات تجهيز المستشفيات العمومية وفحوص كورونا

افتتاحية الأخبار.. أن نكون أو لا نكون

تطورات في قضية خروقات التعمير ببوزنيقة وكريمين يواجه اتهامات ثقيلة

بوريطة: الملك حريص على دعم حوار ليبي ليبي دون فرض حلول

ضباط مغاربة قهروا البوليساريو وعاشوا بعيدا عن الأضواء لا يعرفهم أحد

شركة طيران رايان إير تستأنف رحلاتها إلى المغرب

كورونا بالمغرب.. 2563 إصابة و2553 حالة شفاء و33 وفاة خلال 24 ساعة

صور ومقاطع فيديو خليعة بمجموعة واتساب لبيجيديي تابريكت سلا

العثور على جثتين إحداهما مقطعة ومخبأة داخل أكياس بأكادير

مراكش تستقبل أول فوج سياحي بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

هل أصيب العثماني بفيروس كورونا... رئيس الحكومة يقطع الشك باليقين

أعضاء بـ AMDH يقاطعون اجتماع اللجنة الإدارية بسبب التسيير اللا ديمقراطي
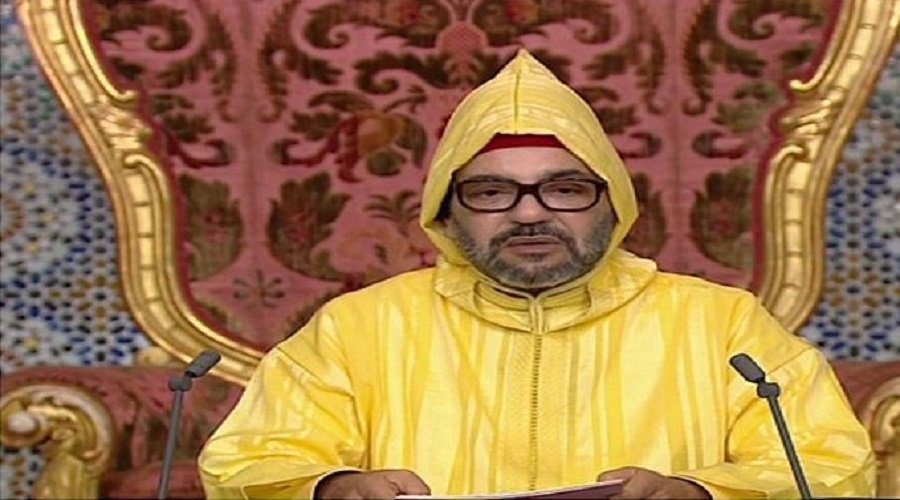
الملك محمد السادس يرسم الخطوط العريضة لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا

اختلاس 95 مليونا من المحجز البلدي بالرباط

الملك: الظروف الحالية تفرض تسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية

افتتاحية الأخبار: الأرقام العنيدة

مدرسة خاصة بطنجة تُلزم مواطنا بأداء 62 مليونا لتسجيل ابنته

الملك: أزمة كورونا كشفت مجموعة من الاختلالات وإنعاش الاقتصاد أولوية

هذه لائحة الجنرالات والكولونيلات المحالين على التقاعد بجهازي الجيش والدرك
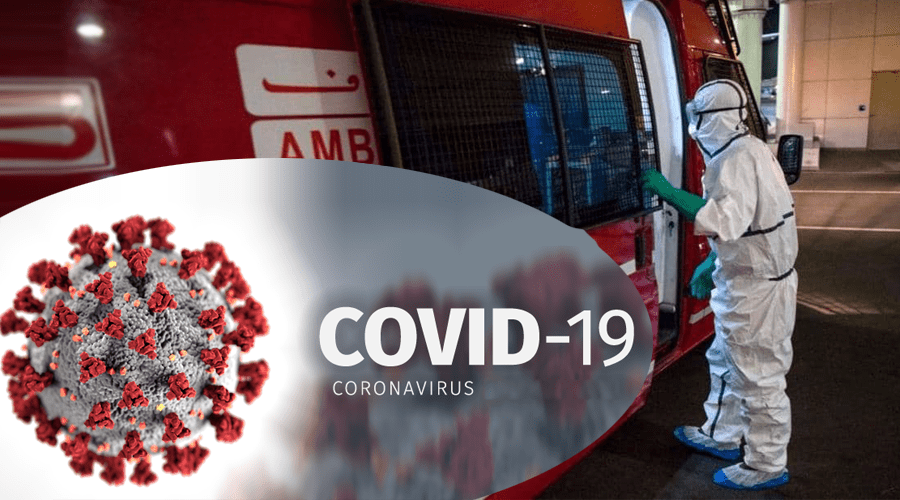
تلقيح المغاربة ضد كورونا.. وزارة الصحة توضح

اتهامات لرباح بحرمان أحياء هامشية بالقنيطرة من مشاريع اجتماعية

الـCNSS يعفي مقاولات من ذعائر التأخير والغرامات بهذه الشروط

تهريب قطع غيار السيارات يطيح بأطر في شركة رونو بطنجة

وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة وطنية لتلقيح المغاربة ضد كورونا

اعتقال جباص بسيدي سليمان اتهم رجال الأمن بالإرتشاء

الجمارك تطالب الزهراوي صاحب ملهى ليلي بـ 20 مليون درهم كتعويض بسبب الغش في الخمور

اختلالات بالمدرسة الوطنية للكهرباء والشرطة القضائية تدخل على الخط

ما هي أسباب عدم استقرار المنظومة الانتخابية بالمغرب ؟

الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

القرض الفلاحي للمغرب يحقق أداء ماليا جيدا رغم الأزمة

تنسيق أمني ببنسليمان ومراكش يطيح بمزور شيكات شرطي

معلومات الديستي تقود لحجز أزيد من 11 طنا من المخدرات بميناء طنجة
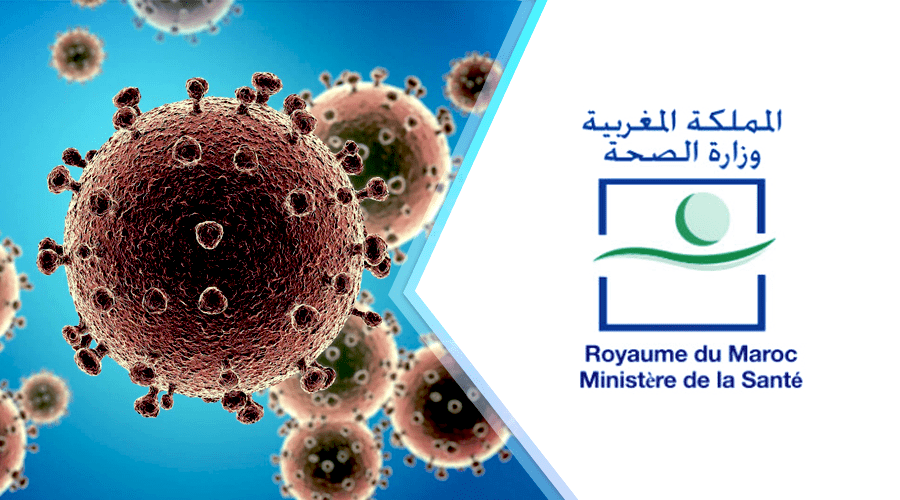
كورونا بالمغرب.. 2788 حالة شفاء و2776 إصابة و28 وفاة خلال 24 ساعة

السجن لشرطي متهم بإخفاء 22 مليونا سلمتها له عصابة إجرامية

التحقيق مع المعطي منجب وأفراد من عائلته حول اتهامات بغسل الأموال

اقتراح الأحزاب بزيادة عدد البرلمانيين يخلق الجدل
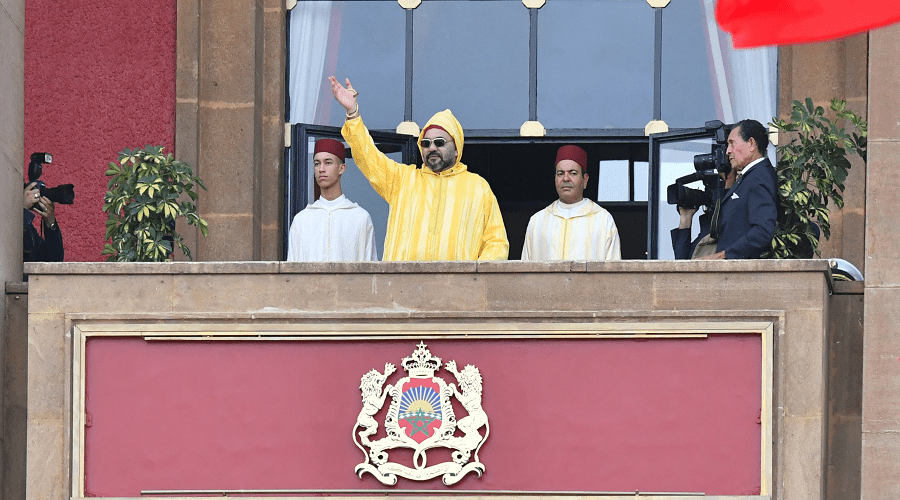
الملك يوجه خطاب افتتاح البرلمان من القصر الملكي بالرباط

بدعم مغربي .. الفرقاء الليبيون يصلون إلى تفاهمات مهمة حول توزيع المناصب السيادية

مديرية الصحة بأكادير صرفت 34 مليونا على الأقلام والأوراق

مسؤول بالبيجيدي استغل برنامج انطلاقة للنصب على تجار بالقنيطرة
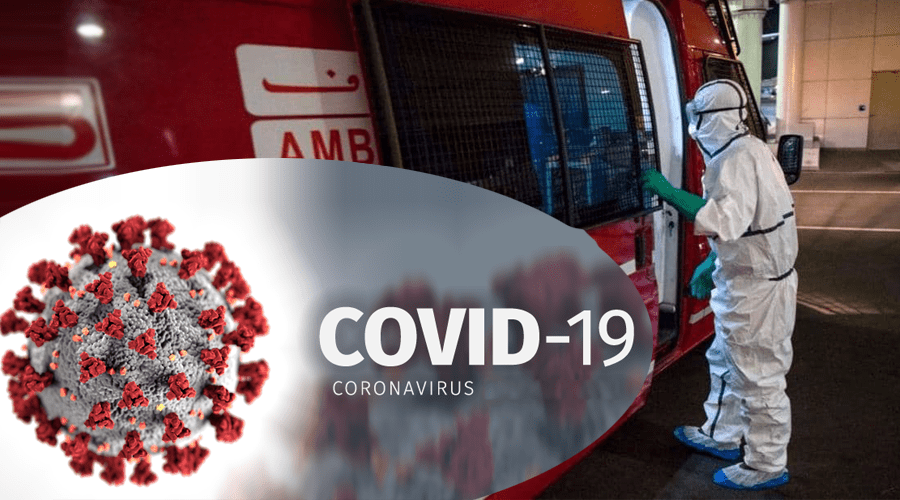
2553 إصابة بكورونا و2018 حالة شفاء و41 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

تفاصيل اتهام أستاذ بهتك عرض تلميذته بسيدي قاسم

السجن 3 سنوات في حق نجل زيان في قضية الكمامات المزورة

الداخلية تعيد تحديد النطاق الترابي لحوالي 500 جماعة

انهيار أرصدة صندوق التقاعد يزيد من نسبة اقتطاعات الموظفين

توقيف فرنسي ضمن شبكة للترويج الدولي للمخدرات بمراكش

16.2 مليون تهديد تعرض له المغرب عبر البريد الإلكتروني خلال 2020

الحكومة تقرر صرف 2000 درهم شهريا للطريطورات وفضاءات الترفيه ومنظمي التظاهرات
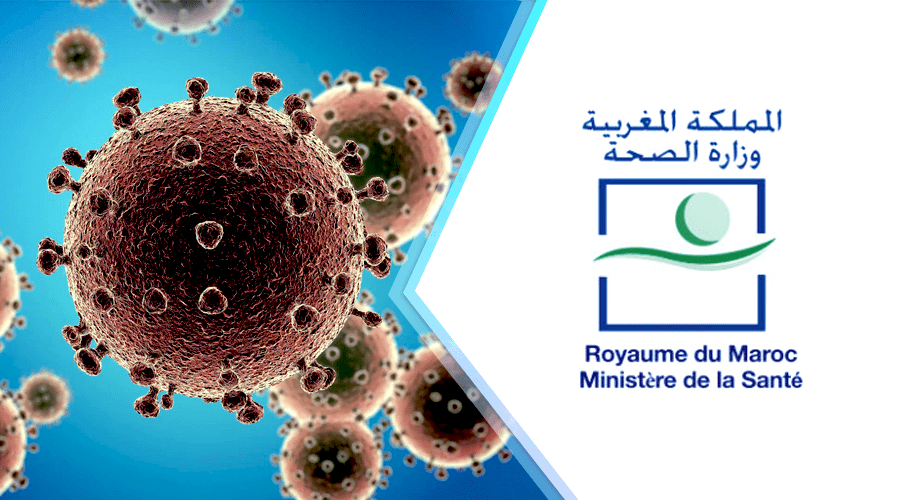
كورونا بالمغرب.. 1423 إصابة و2300 حالة شفاء و39 وفاة خلال 24 ساعة

في عز الأزمة.. مدير لاماب يخصص 87 مليونا لكراء سيارات

افتتاحية الأخبار.. نحن أو لا أحد

الداخلية تنفي الترخيص لتنظيم مسيرة السلام من الرباط نحو الكركارات

إطلاق النار لتفكيك خلية إرهابية واعتقال 4 دواعش بطنجة

طرد تلميذة بسبب النقاب.. مسؤول بوزارة التعليم يوضح
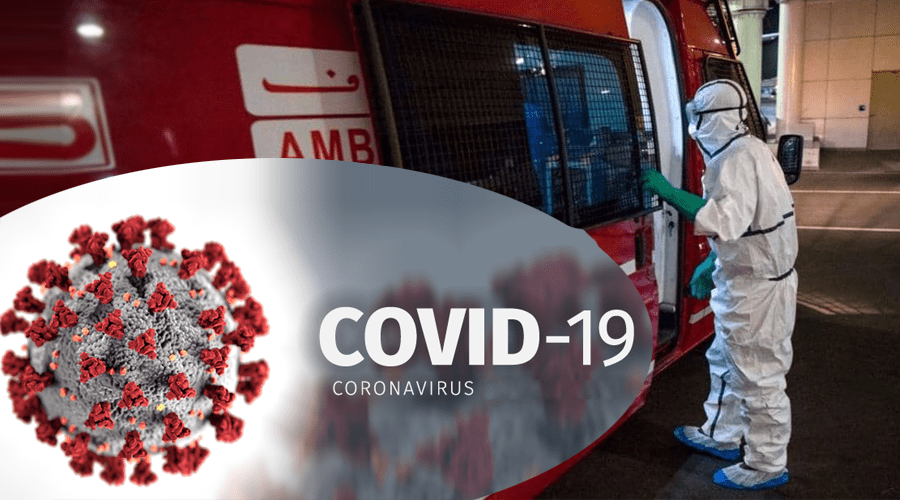
كورونا يودي بحياة 3 من كبار أساتذة الطب بالمغرب في يوم واحد
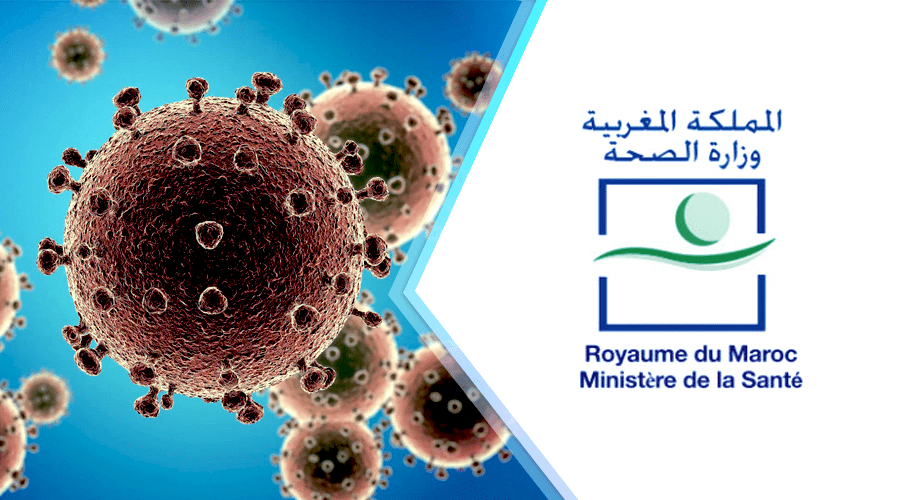
2349 حالة شفاء من كورونا و2044 إصابة و37 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

معلومات الديسي تقود أمن أكادير لإجهاض تهريب طن و100 كلغ من المخدرات

كواليس الحفلات السرية وأعراس الأثرياء بالمغرب في زمن كورونا

حجز 3 أطنان و729 كلغ من المخدرات ضواحي الدريوش

كورونا بالمغرب.. 2663 إصابة و2643 حالة شفاء و30 وفاة خلال 24 ساعة

الملك يعبر عن متمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته

تسجيل هزة أرضية بإقليم الحسيمة
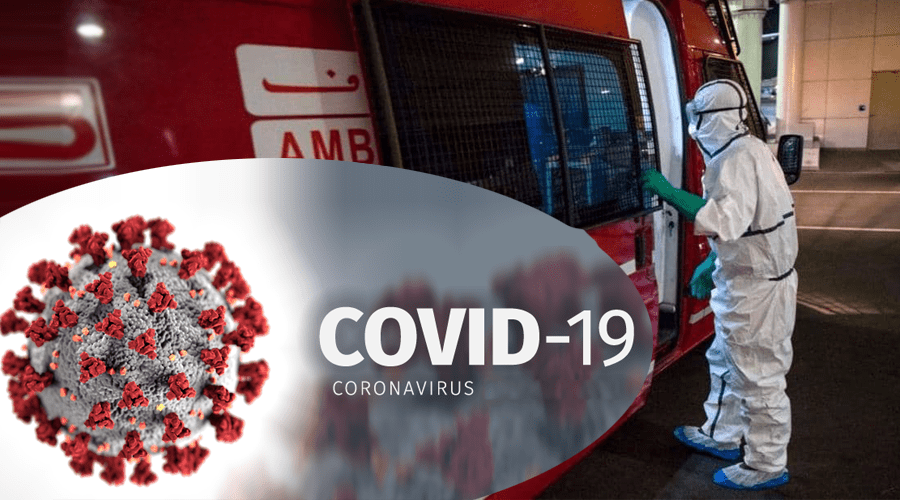
2521 إصابة بكورونا و 1908 حالة شفاء و34 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

هكذا تتابع فرق أمنية خاصة اختفاء الأطفال

أزيد من 4500 مليون درهم لتنفيذ خطة عمل OFPPT سنة 2020
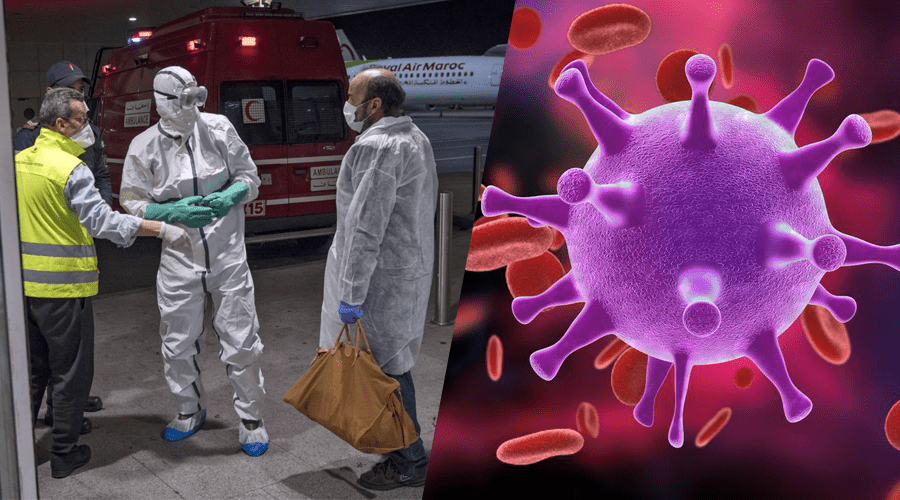
المغرب يحذف الاختبار السيرولوجي ويمدد صلاحية اختبار PCR ل72 ساعة لدخول أراضيه

المحكمة الإدارية بفاس تغرم وزارة العدل لصالح مواطن أكره بدنيا رغم صدور عفو ملكي لصالحه

مهرجان للفروسية يقود 19 مشتبها أمام جرائم الأموال بينهم رئيس بلدية ابن سليمان وزوجته

إصابة موظفة مقربة من وزير في حكومة العثماني بكورونا يثير هلع الموظفين

النيابة العامة تلتمس التحقيق مع الصحافي عماد ستيتو في قضية المشاركة في اغتصاب صحافية

تمديد تدابير كورونا بالبيضاء لـ 14 يوما وعودة التعليم الحضوري يوم الاثنين

كورونا بالمغرب.. 2391 إصابة و1421 حالة شفاء و35 وفاة خلال 24 ساعة

ناشطون ينتقدون رفض فنانين لِدعمٍ طلبوه كتابة حفاظا على شعبيتهم والفردوس يوضح

شركات متعددة الجنسيات متهمة بالتلاعب في أسعار الأدوية بالمغرب

مدير CNSS: أزيد من 700 ألف أجير لم تشملهم التغطية الصحية

38 تلميذًا مصابًا بكورونا يجتازون الامتحان الجهوي

حاليلوزيتش يكشف لائحة المنتخب لمباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية

لا تستهينوا بالقمل... وفاة تلميذة بسكتة قلبية بسبب قمل ظل يتغذى على جسدها لثلاث سنوات

قرار هدم يجر عامل سطات وقائد أمام القضاء
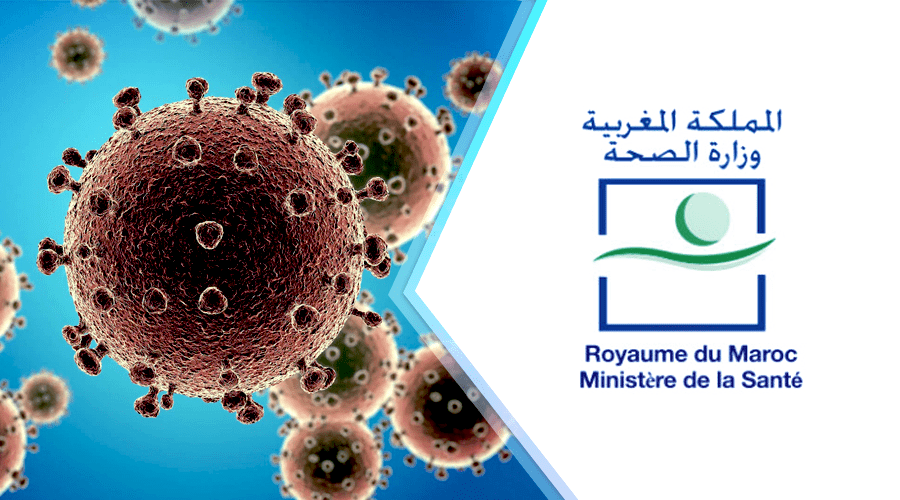
2470 إصابة بكورونا و2462 حالة شفاء و42 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

589 ألف منصب شغل تبخرت في أقل من شهرين بالمغرب

إطلاق النار لتوقيف شخص قام باختطاف رضيع بالدروة

تفاصيل فضيحة جنسية هزت البيجيدي بالقنيطرة

العيون.. فتح بحث قضائي بشأن مؤتمر تأسيسي لهيئة انفصالية

المغرب يتجه لحذف الاختبار السيرولوجي وتمديد اختبار PCR لدخول المملكة

استئنافية طنجة تحكم بإعدام زوجين متهمين بقتل طفلهما بالعرائش

كورونا بالمغرب.. 2785 حالة شفاء و2076 إصابة و39 وفاة خلال 24 ساعة
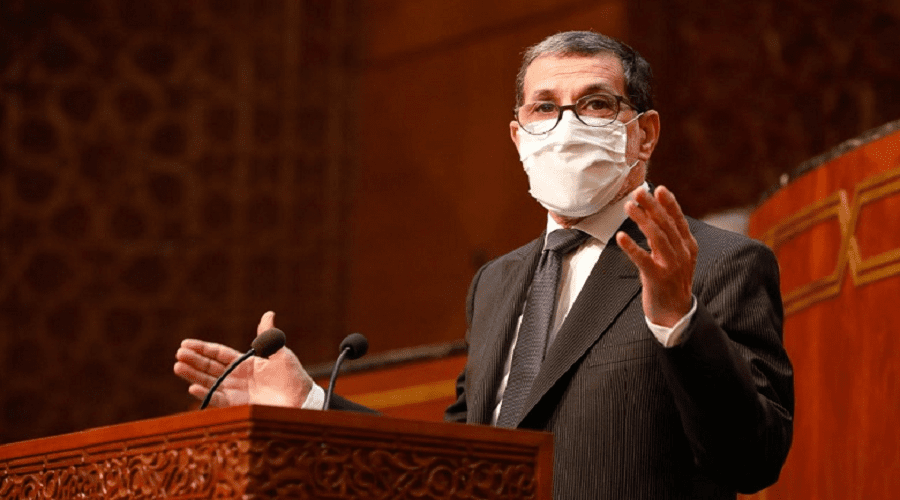
العثماني يشهر الفيتو في وجه القاسم الانتخابي

تسجيل 390 قضية غسيل أموال وتمويل للإرهاب بالمغرب سنتي 2019 و2020

خطير... تقرير سري يكشف مخاطر المقالع البحرية على الثروة السمكية ويتهم الوزير رباح

وزارة الصحة تسمح لجميع المختبرات بإجراء تحاليل كورون بهذه الشروط

تفاصيل انتقال المغرب إلى المرحلة الثانية من تجارب لقاح كورونا

3000 درهم رشوة تطيح بدركيين بمركز دار بوعزة
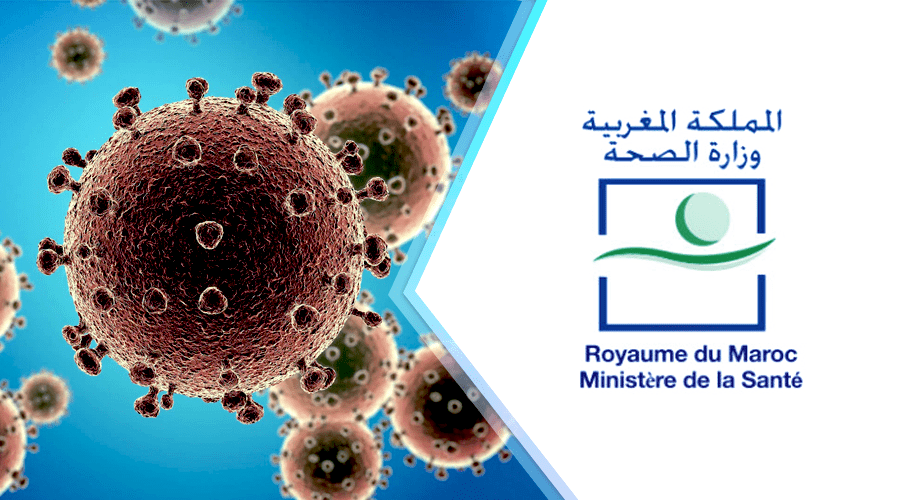
1422 إصابة بكورونا و1877 حالة شفاء و44 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

تفاصيل تعرّض تلميذة ورجل خمسيني لهتك العرض في يوم واحد

وداعا لنفقات كراء سيارات وتعويضات السفريات والفندقة والإيواء

بنشعبون يعلن تخصيص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم

مصالح الحموشي وحرمو تواصل حربها على شبكات تهريب البشر والمخدرات

المغرب يفعّل كليا قانون الحق في الحصول على المعلومات

بنعبد القادر يعفي المدير الإقليمي لوزارة العدل بالدار البيضاء

مصرع 4 عمال داخل وحدة صناعية بأكادير

تعرف على قصص مخازنية دخلوا التاريخ من باب المصاهرة ونافسوا الكبار على السلطة

إطلاق طلب عروض لتمويل مشاريع أبحاث تنموية بـ 170 مليون درهم

مدارس خاصة تلزم التلاميذ باقتناء حاسوب بـ 6 آلاف درهم

إحداث خسائر بملك الغير والسرقة يطيح بـ 15 شخصا بمراكش

كورونا بالمغرب.. 2444 إصابة و1441 حالة شفاء و28 وفاة خلال 24 ساعة

النيابة العامة بورزازات تحقق في أسباب وفاة الطفلة نعيمة

هكذا تسلل كورونا إلى مكاتب مسؤولين حكوميين

رجال الحموشي يحبطون تهريب طنين ونصف من مخدر الشيرا بشاطئ اشليحات ضواحي القنيطرة
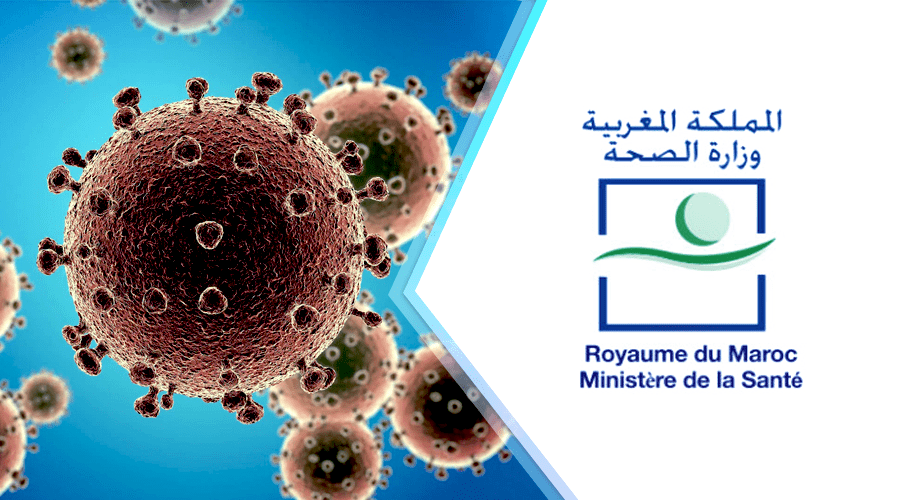
2218 حالة شفاء من كورونا و2719 إصابة و43 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

شكايات تجر صاحب مشروع فيلات فاخرة ببوسكورة أمام القضاء

كورونا تهدد معاشات متقاعدي القطاع الخاص في سنة 2023

2423 إصابة بكورونا و 1746 حالة شفاء و42 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

لفتيت يعيد رسم حدود مئات الجماعات الترابية

مكناس تعيد فتح 23 مدرسة في أحياء كانت مصنفة كبؤر وبائية

العثماني: المغاربة سيستفيدون من لقاح كورونا بمجرد انتهاء التجارب السريرية

أمكراز يفشل في امتصاص غضب النقابات من مشروع قانون الإضراب
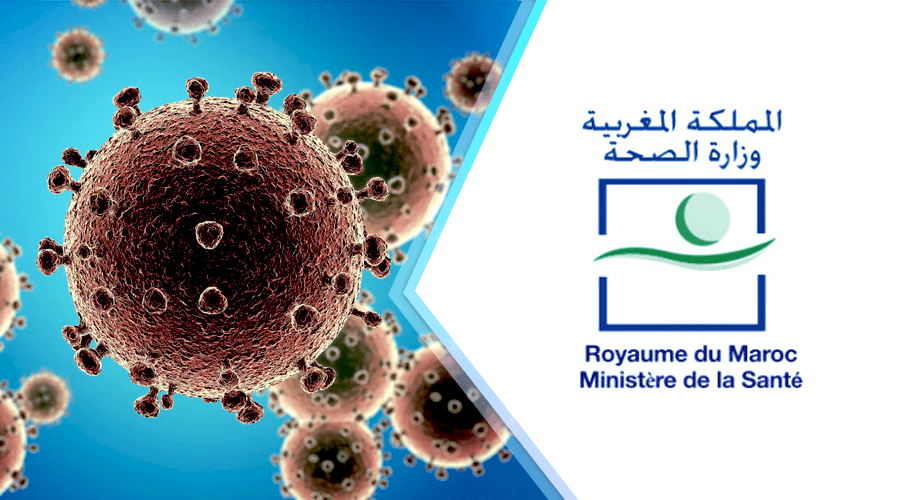
كورونا بالمغرب.. 2356 إصابة و1942 حالة شفاء و38 وفاة خلال 24 ساعة
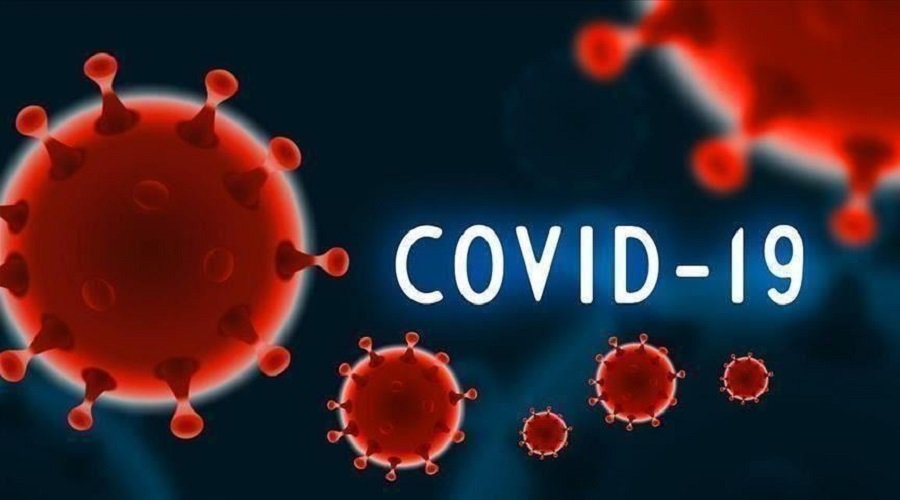
المغرب أبرم اتفاقيتين مع شركة صينية وأخرى بريطانية سويدية للحصول على لقاح كورونا

حموشي يستقبل بالرباط سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب

بنك المغرب يتوقع عجزا في الميزانية والحكومة تستعد لاقتراض 46 مليار درهم

الحموشي يقود حملة واسعة لمحاربة الجريمة

دعوة الداخلية للتقشف تكشف النقاب عن صفقات الجماعات الترابية

مخزنيين انتحلا صفة دركيين لابتزاز بارونات مخدرات

حجز طن من المخدرات بضيعة فلاحية ضواحي الرشيدية

فقيه طنجة يعترف بهوسه بالأطفال ويكشف تفاصيل صادمة

الاستقلال: الحكومة فشلت في تدبير أزمة كورونا وقانون مالية 2021 آخر فرصة

كورونا يحرم حوالي 12 ألف أستاذ جامعي من الترقية

2397 إصابة بكورونا و2361 حالة شفاء و29 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

معلومات الديستي تقود أمن سلا لتوقيف 4 متهمين بالاتجار بالبشر
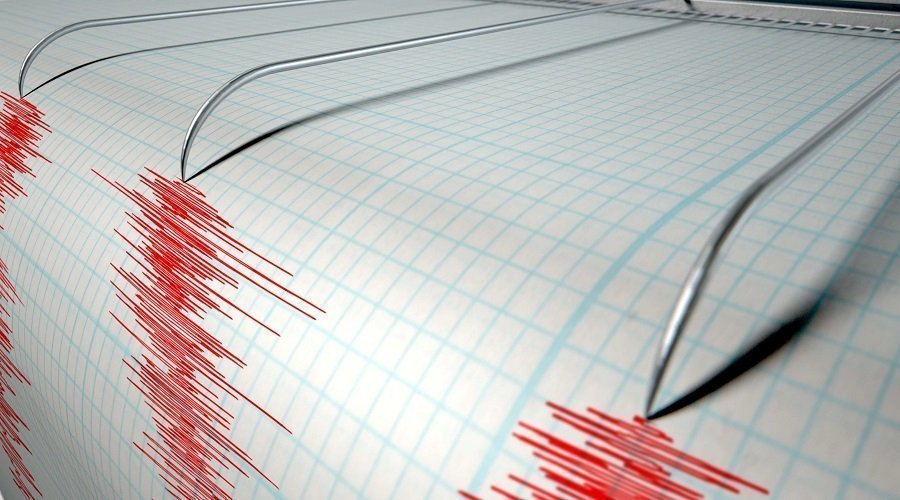
عاجل... هزة أرضية بإقليم العرائش

مدارس تُلزم الأسر بأداء مصاريف التعقيم

تهجير فتيات إلى الخليج يطيح بشقيقتين في سلا
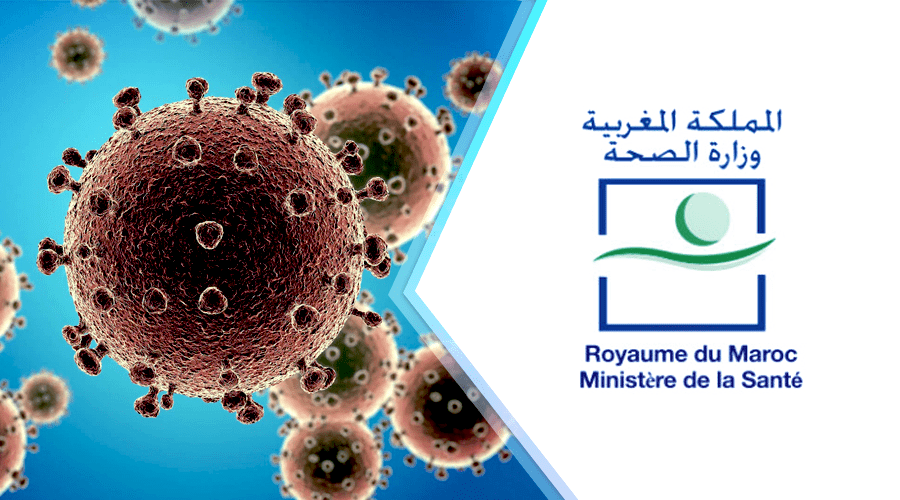
كورون بالمغرب.. 2227 إصابة و 1725 حالة شفاء و34 وفاة خلال 24 ساعة

النيابة العامة تتشبث بمتابعة البرلماني بلفقيه في ملف السطو على عقارات

محاولة تسميم مغربية سويسرية يستنفر سلطات الصويرة

الهوية البصرية الجديدة لأكادير تخلق الجدل

إصابات كورونا بالمغرب تنسف توقعات وزير الصحة

متابعة حفيد جنرال سابق دهس قاصرا بدراجة رباعية العجلات

كورونا يتفشى بين نواب الوزير رباح بجماعة القنيطرة

إتلاف 20 ألف قنينة من المشروبات الكحولية بجماعة حد السوالم (صور)

لهذا السبب ارتفعت أسعار لحوم الدجاج في المغرب

حريق ضخم وانفجارات داخل مصنع بالبيضاء

القصة الكاملة لمجسم المهدية الذي وصل إلى العالمية

تقارير أمنية أطاحت بأزيد من 100 مرشح لمناصب عليا

المغرب يسجل رقما قياسيا لحالات الشفاء من كورونا بـ 3426 حالة

إغلاق مدينة المحمدية واعتماد إجراءات استثنائية لمحاصرة كورونا

جطو يوافق على إرسال فريق لافتحاص صفقات وزارة الصحة

انتخاب المغرب رئيسا للدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

كمامات مزيفة تطيح بشخص بالبيضاء

مدارس بالرباط تعيد التدريس بالتناوب بعد تحسن الوضعية الوبائية

المغرب يشدد المراقبة على الكازينوها والشركات الأجنبية وقرار بتجميد ممتلكات المطلوبين دوليا

إجراءات استثنائية لفائدة المقاولات المغربية
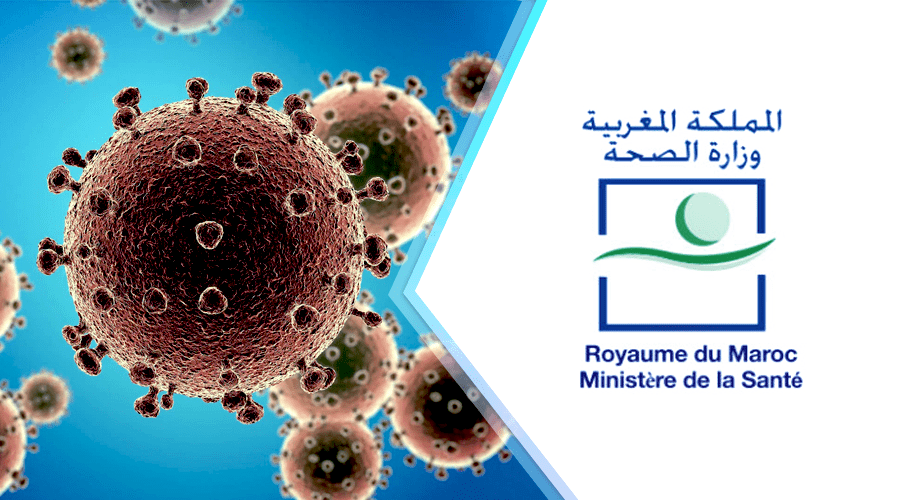
1927 إصابة بكورونا و1724 حالة شفاء و35 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

قصص

إيداع الفقيه المتهم بهتكم عرض قاصرات السجن المحلي بطنجة
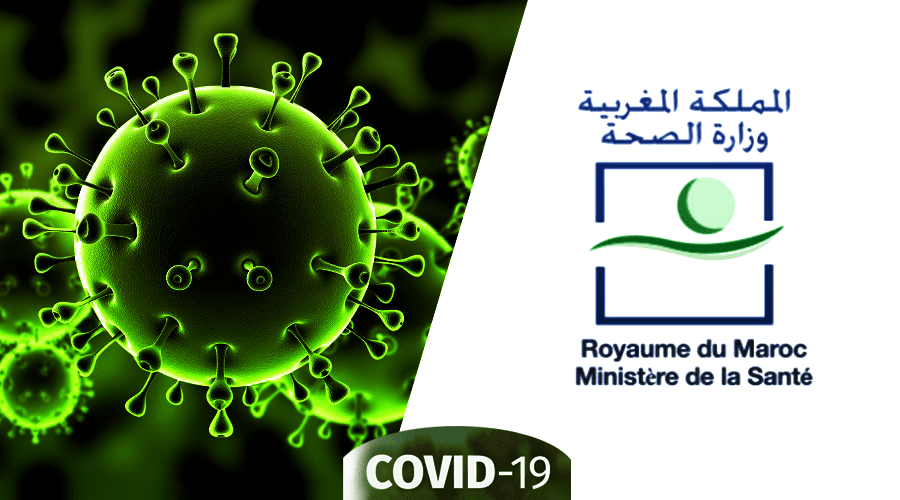
كورونا بالمغرب.. 2552 إصابة و2318 حالة شفاء و40 وفاة خلال 24 ساعة

لارام تستعد لإطلاق 5 خطوط جوية جديدة إلى دول أوروبية انطلاقا من مراكش

السلطات الإسبانية تشدد القيود بجهة مدريد لمحاصرة كورونا

الحكومة تمدّد التدابير المشددة ضد كورونا بالدار البيضاء لفترة إضافية

المغرب يوقع مذكرة لاقتناء لقاحات كورونا
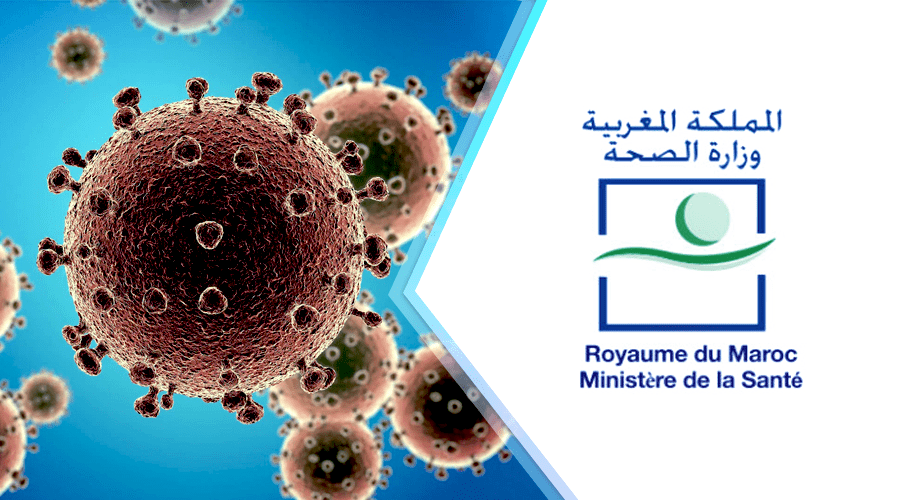
المغرب يسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بـ 2760 حالة خلال 24 ساعة

قروض وهمية بـ 120 مليون تطيح بالكاتب المحلي لـ البيجيدي بأربعاء الغرب

تفاصيل اتهام برلماني باغتصاب فتاة بفاس

مدير المكتب الوطني للسياحة يعد الفرنسيين بالتخلي عن شرط التوفر على PCR لدخول المغرب

كواليس اجتماع مفاجئ لقادة أحزاب الأغلبية

بالصور.. الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تناقش وضعية الصحافة بالمغرب

إغلاق مقر المكتب الوطني المغربي للسياحة بالرباط بعد تسجيل إصابات بكورونا

أمن مراكش يعثر على الرضيعة المصرح باختطافها من الدار البيضاء

الدرك يوقف فقيها بضواحي طنجة متورط في اغتصاب قاصر والاعتداء جنسيا على ثلاث أخريات

كورونا تصيب رباح وعائلته في تجمع عائلي بمناسبة وضع ابنته لمولود بمصحة خاصة

آيت الطالب: الوضع الوبائي مقلق لكنه لم يصل لدرجة الانفلات
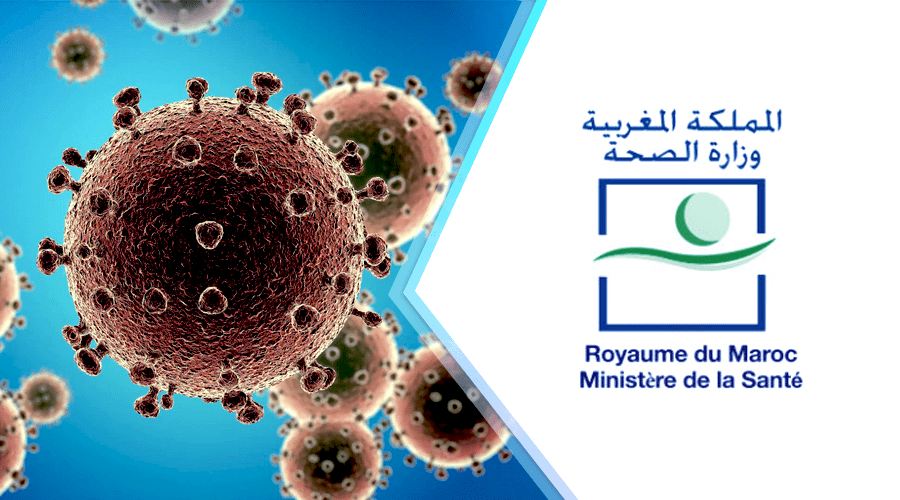
كورونا بالمغرب.. 2488 إصابة و1962 حالة شفاء و28 وفاة خلال 24 ساعة

المصادقة على استفادة مهنيي السياحة والمفوضين القضائيين من التغطية الصحية والتقاعد

تفاصيل استنطاق مستشار جماعي وابنه في قضية مقتل شاب بضيعة فلاحية

الحكومة تسن تدابير لتمديد تعويض مهنيي قطاع السياحة حتى متم 2020

الداخلية تشرع في التحضير للانتخابات

تحذيرات من انهيار قنطرة بقصبة تادلة والوزارة خارج التغطية

وزارة الصحة : احتياطي أدوية علاج كوفيد-19 وافر لتغطية شهور

مديرية الأرصاد تحذّر من زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

ارتفاع حركة النقل التجاري بميناء آسفي بـ31,6 بالمئة متم غشت الماضي

المغرب في الرتبة الثالثة للوجهات المفضلة للمتقاعدين الفرنسيين

وزارة النقل تحدد مدة تجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات

مرجان يكشف حصيلة خسائر حريق مركزه بحي الرياض

ارتداء الكمامة داخل السيارة.. مديرية الأمن تحسم الجدل

تفكيك خلية متهمة بالإرهاب يقود البسيج للعثور على متفجرات بتمارة

توزيع المقاعد البرلمانية يحدث أزمة بين البيجيدي وباقي الأحزاب

لفظ شواطئ الصخيرات وبوزنيقة لطنين من المخدرات يستنفر السلطات

كورونا بالمغرب.. 1921 حالة شفاء و1692 إصابة و38 وفاة خلال 24 ساعة

مضيفة طيران تقدم فتاة لشقيقها في عيد ميلاده لاغتصابها

التدريس في قطر يشعل حربا في صفوف أساتذة جامعة الحسن الثاني

بعد الإمارات والبحرين.. ترامب يؤكد اقتراب دول أخرى من التطبيع مع إسرائيل

هذه حقيقة دخول مبيدات زراعية غير مرخصة إلى المغرب

الـCNSS يمدد أجل طلب الاستفادة من دعم القطاع السياحي

هذه لائحة المختبرات الخاصة المرخص لها بإجراء اختبارات كورونا
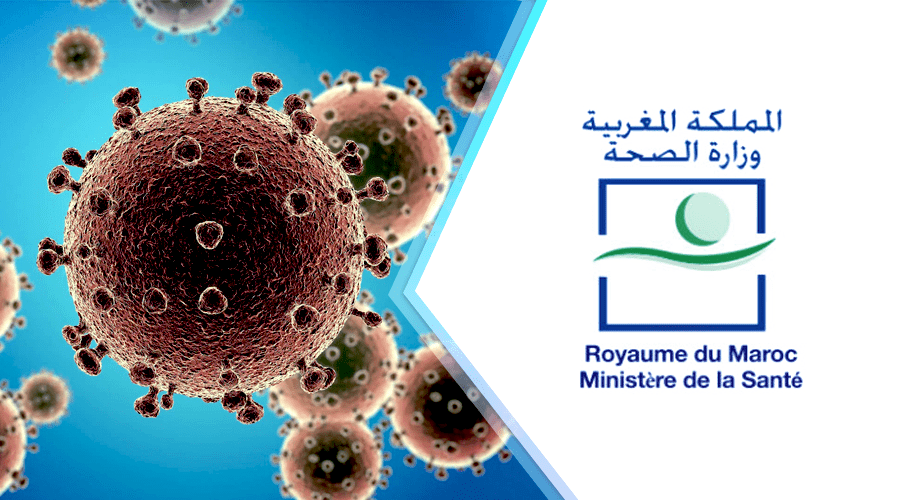
2077 حالة شفاء من كورونا و2121 إصابة و34 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

صفقات الملايير بوزارة الصحة تجر آيت الطالب للمساءلة

اغتصاب أم وبناتها ضواحي سلا والفرقة الوطنية للدرك تدخل على الخط

احتواء لعب أطفال ومواد تجميل تباع في المغرب على مواد سامة

مسؤولان بنكيان بتمارة والرباط أمام جرائم الأموال بتهم الاختلاس والتزوير

وزارة التعليم تكشف تواريخ امتحانات الأولى بكالوريا

حوالي 60 ألف متدرب يجتازون امتحانات نهاية التكوين المؤجلة

اعتقال دركي قتل زميله دهسا بنقطة مراقبة قرب أكادير

سلطات فاس تغلق مدرسة أمريكية سجلت 200 تلميذ بدون ترخيص

توقيف 6 أشخاص بفاس بينهم موظف شرطة بتهمة خرق الطوارئ

المجلس الأعلى للقضاء يرد على "تحرك أمنستي العاجل" في قضية عمر الراضي

الملك يعزي عائلة الطفل عدنان

تفاصيل تفكيك شبكة تبتز سياسيين وبرلمانيين بأشرطة جنسية

كورونا بالمغرب.. 1517 إصابة و1442 حالة شفاء و36 وفاة خلال 24 ساعة

توقيف شخص متهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بآسفي

إحالة قاتل الطفل عدنان و3 متابعين في القضية على النيابة العامة

فاجعة الطفل عدنان تعيد جرائم اغتصاب وقتل الأطفال إلى الواجهة

بعد ديكارت.. كورونا يواصل اجتياح المدارس الفرنسية بالمغرب
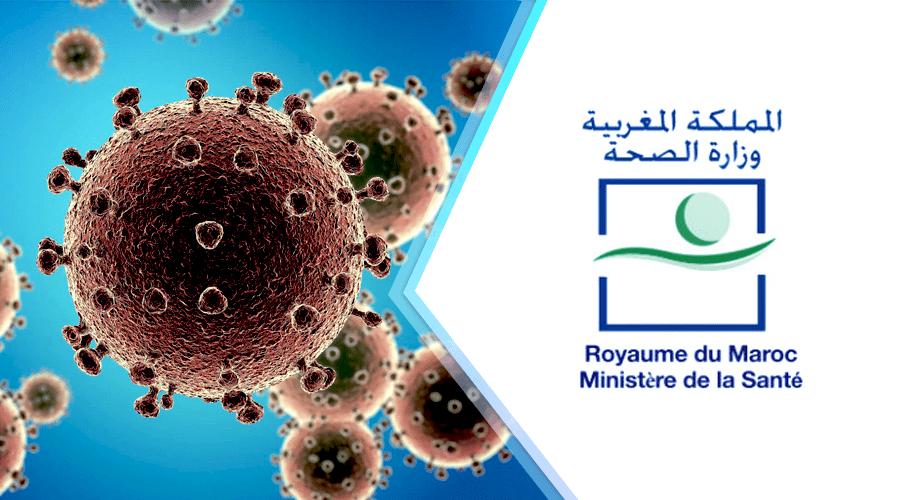
2251 إصابة بكورونا و1661 حالة شفاء و25 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

دراسة تؤكد ثقة المغاربة في الأمن والجمعيات أكثر من رئاسة الحكومة

توقيف شخص متهم بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بفاس

إصابات جديدة بكورونا لأطر بمؤسسة ديكارت بالرباط

حكاية أول إذاعة استعملت لإجبار المغاربة على التلقيح والتمدرس ولماذا اعتبر الوطنيون العاملين فيه خونة

بعد فاجعة عدنان.. أمن طنجة يطيح بشخص استدرج طفلا لاستغلاله جنسيا

تطورات جديدة في قضية الطفل عدنان والأمن يعتقل 3 أشخاص

سلطات البيضاء تغلق 3 أحياء بعين السبع بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا
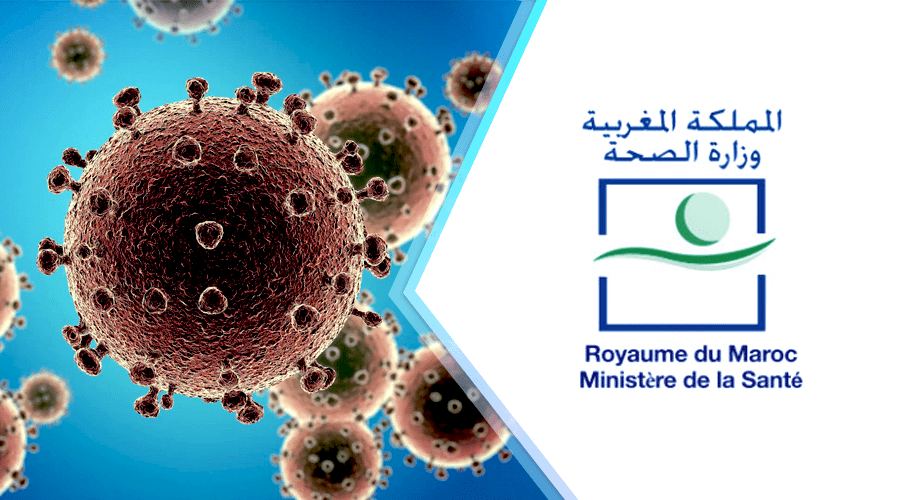
كورونا بالمغرب.. 2344 حالة شفاء و2430 إصابة و33 وفاة خلال 24 ساعة

برلمانيون يطالبون بوضع صفقات وزارة الصحة حول كورونا تحت المجهر

الخيام : الخلية الإرهابية المفككة خططت لتنفيذ عمليات انتحارية

إصابة أستاذ بثانوية ديكارت بالرباط بكورونا

بالفيديو.. انفجار يهز مصحة الأندلس بالدار البيضاء

كورونا بالمغرب.. 2127 حالة شفاء 1889 إصابة و38 وفاة خلال 24 ساعة

هكذا تستر العثماني على 41 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم

أمزازي ينهي الفراغ القانوني المتعلق بالتعليم عن بعد

بالصور.. تفاصيل تفكيك خلية إرهابية لها ارتباطات في عدة مدن مغربية

تجهيز القاعة المغطاة بالمعدات الطبية لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا بالبيضاء

تفكيك خلية إرهابية تنشط بـ3 مدن بحضور الحموشي

الحموشي يأمر بإعادة النظر في مدارس تكوين الشرطة

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 10 أكتوبر
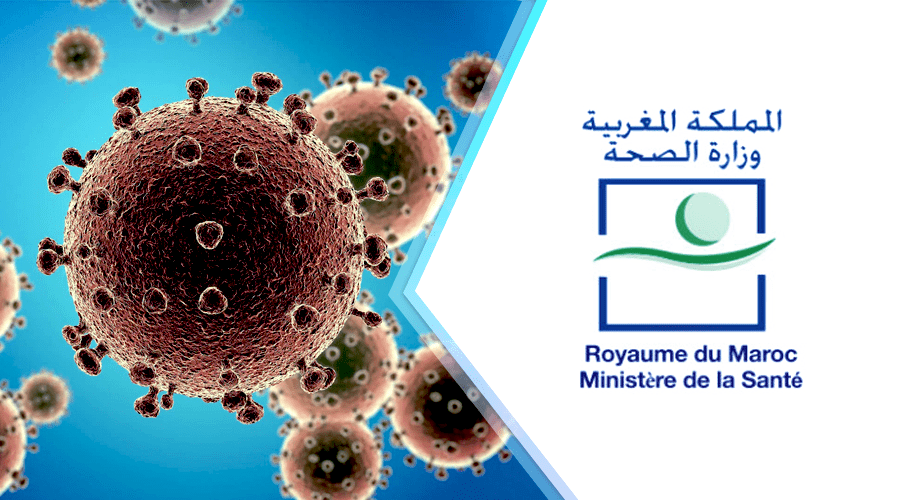
كورونا بالمغرب.. 2484 حالة شفاء و2157 إصابة و26 وفاة خلال 24 ساعة

محكمة تقضي بإيقاف استخلاص أقساط قرض بسبب تضرر مواطن من كورونا

شبهة الارتشاء وراء فتح تحقيق مع 3 أشخاص بينهم موظفا شرطة ببني ملال

حقيقة صورة "القسم المكتظ"... أكاديمية مكناس تكشف كل شيء

قرارات آخر ساعة تربك المغاربة

مجلس جطو يحقق في "صفقات التعقيم"
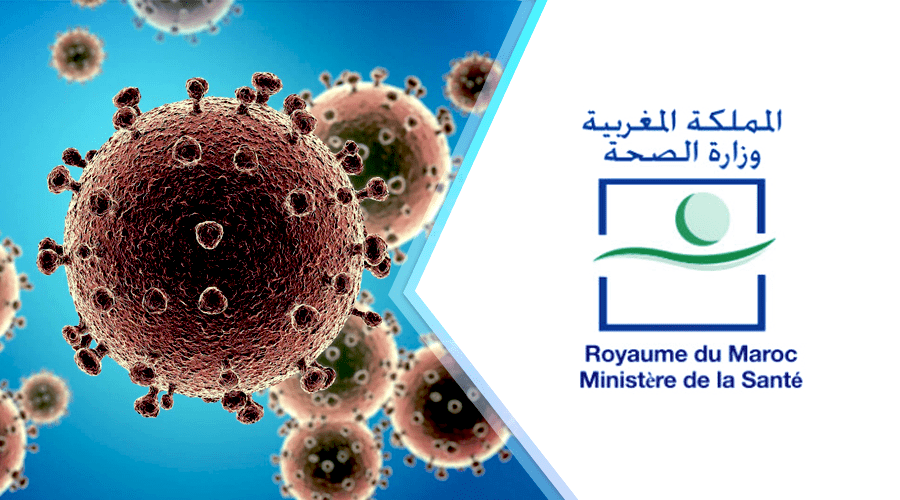
1143 حالة شفاء من كورونا و 1941 إصابة و33 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز وتدبير قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية
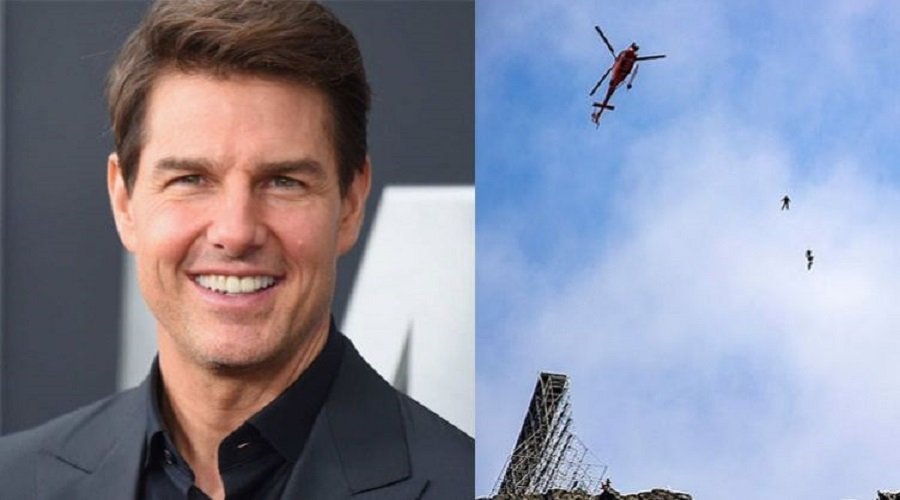
بالفيديو... طوم كروز يصر على القيام بقفزة خطيرة في الفراغ خلال تصويره لفيلم المهمة المستحيلة

المغرب يفتح حدوده للأجانب من 17 دولة وفق هذه الشروط

إصابات كورونا بإسبانيا تتجاوز حاجز 500 ألف حالة
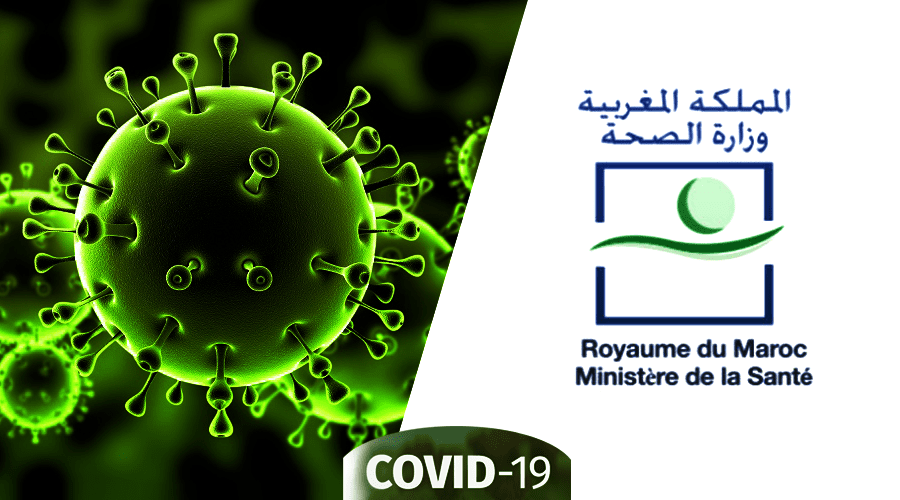
كورونا بالمغرب.. 1386 إصابة و822 حالة شفاء و33 وفاة خلال 24 ساعة

مكتب يفوز بصفقة تقارب 275 مليون لإنجاز دراسة حول الفساد

فضيحة تمرير صفقة تهيئة مطرحين بسيدي سليمان وسيدي يحيى بقيمة ثلاثة ملايير

فضيحة تمرير صفقة تهيئة مطرحين بسيدي سليمان وسيدي يحيى بقيمة ثلاثة

صورة العثماني مع الشلواطي بدون كمامة داخل منتجع سياحي تثير الجدل

هذه أسماء المدارس التي ستعتمد التعليم عن بعد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

هذه أغرب مواسم الدخول المدرسي التي عاشها المغرب

آيت الطالب يكشف تفاصيل التدابير المتخذة بمدينة الدار البيضاء

هزة أرضية بتطوان بقوة 4 درجات على سلم ريشتر

المغرب يسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا بـ 2234 حالة خلال 24 ساعة

بعدما طالب ربابنة بتعويضات مقابل المغادرة تصل 700 مليون ... هذه قصص ربابنة مغاربة منهم من مات فقيرا وآخرون يعيشون بتقاعد بسيط

تحذير.. زخات رعدية قوية وطقس حار بعدد من مناطق المملكة

لتقليص آجال العلاج.. وزارة الصحة تعدل البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

عمالات تقرر تأجيل التعليم الحضوري بسبب الوضعية الوبائية

ربابنة لارام مستعدون لتخفيض كتلة أجورهم بقيمة 400 مليون درهم
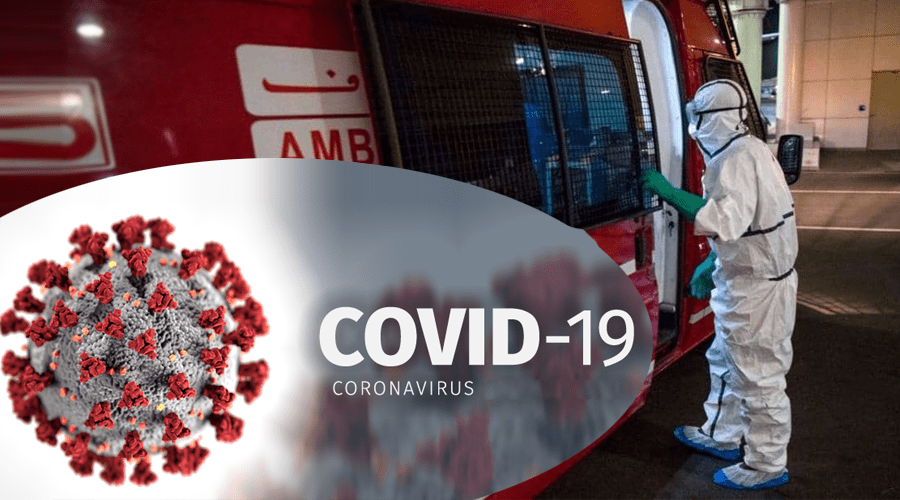
1446 حالة شفاء من كورونا و1555 إصابة و37 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

الـCNSS يحدث بوابة خاصة بمهنيي السياحة للاستفادة من دعم صندوق كورونا
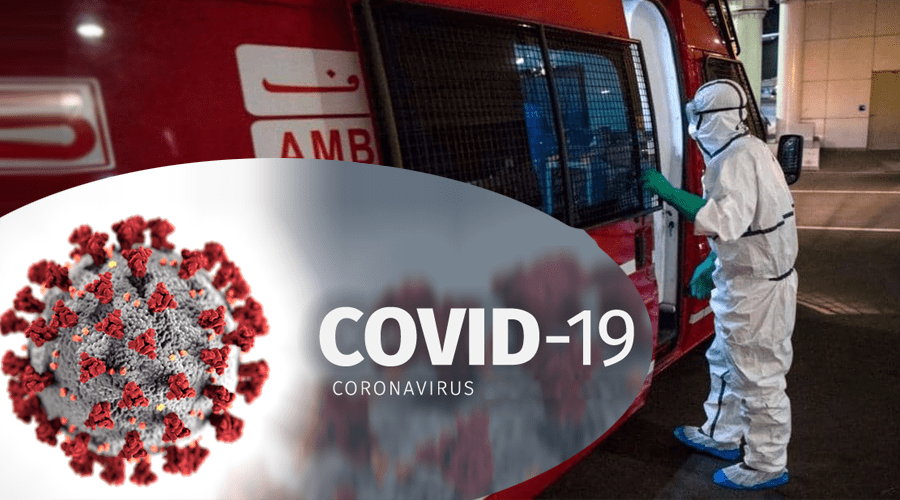
نسبة التعافي من كورونا بجهة طنجة تفوق 91 بالمائة

المغرب يحصل على مروحيات "أباتشي AH-64" مزودة برادارات "Longbow"

اتهامات لرئيسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض بالتستر على إصابة موظف بكورونا

كورونا بالمغرب.. 1260 حالة شفاء و 1750 إصابة و39 وفاة خلال 24ساعة

أمن البيضاء يطيح بفرنسي مبحوث عنه دوليا في جريمة قتل

منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من الأحد

بنعبد القادر يؤكد استمرار تجربة المحاكمة عن بعد خلال المرحلة المقبلة

الأسر المغربية تختار بأزيد من 80 بالمائة التعليم الحضوري
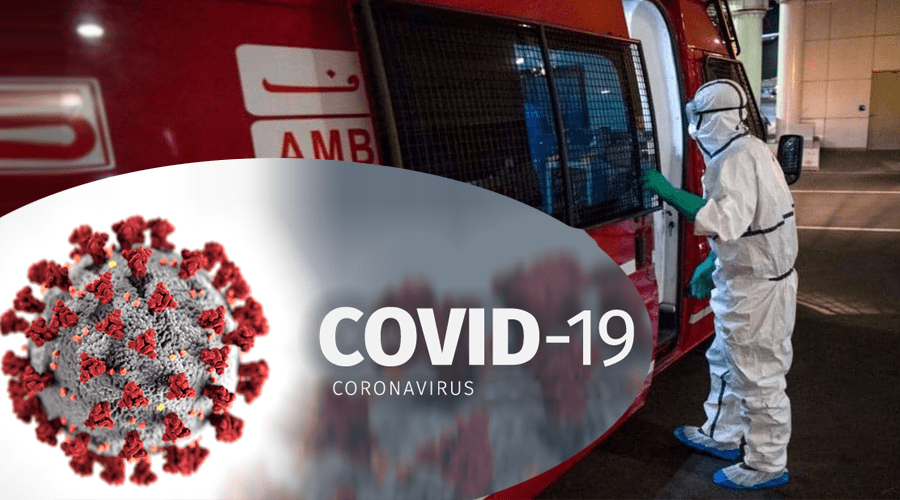
1402 إصابة بكورونا و866 حالة شفاء و37 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

بنكيران يظهر في مراسيم دفن الصحافي الفلسطيني محمود معروف

الحكومة تصادق على إعادة تنظيم عمل لجنة الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

محتجون باوطاط الحاج يطالبون آيت الطالب بالحد الأدنى للحق في الصحة

المغرب يحتل المركز 46 عالميا في الإصابات والوفيات بكورونا

سلطات الجديدة تغلق مرافق بـ7 أحياء لمنع تفشي كورونا

أمزازي يؤكد أن 80 بالمائة من الأسر المغربية اختارت التعليم الحضوري
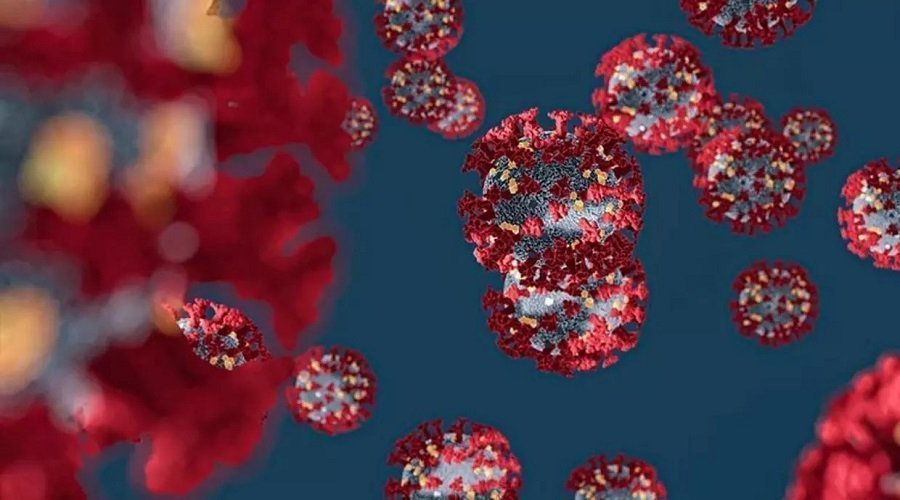
السلطات الأمريكية تستعد لتوزيع لقاح كورونا بحلول نونبر

صور لأطفال يسبحون في بحيرة ملوثة بالبيضاء تخلق الجدل
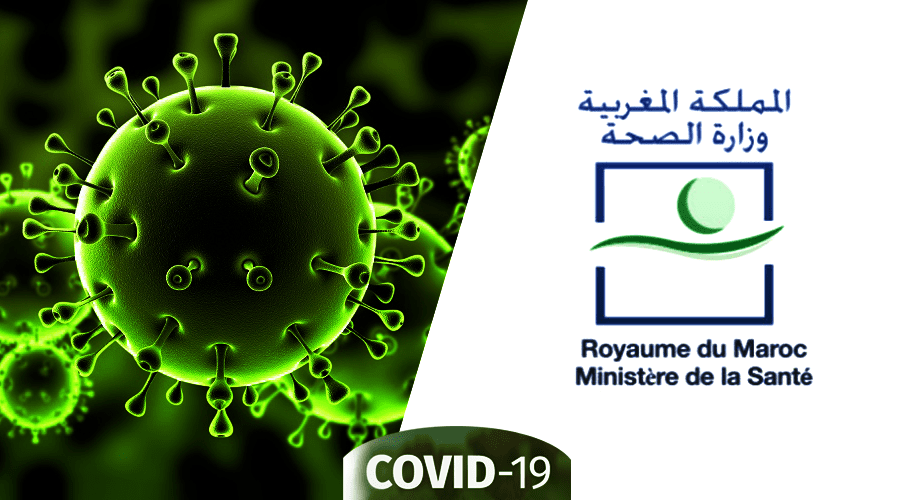
1435 حالة شفاء من كورونا بالمغرب و1672 إصابة و32 وفاة خلال 24 ساعة

وزارة التعليم تكشف ضوابط تأمين التلاميذ بالمدارس الخاصة

خلاف بين الداخلية والأحزاب بسبب ثلاثة ملايير

توقيف 14 متورطا في خرق الطوارئ والتخريب بالرباط وسلا

وزارة الصحة توقف بث النشرة الإخبارية الخاصة بكورونا

براتب يصل 1500 أورو شركة فرنسية تبحث عن عمال فلاحيين مغاربة

مسؤول التواصل بشركة "لارام" يقاضي رئيس جمعية الربابنة بسبب رسالة هاتفية تتضمن عبارات سب وإهانة للصحافيين

كورونا.. المغرب يودع أسوأ شهر بعد تراجع مؤشر توالد الفيروس
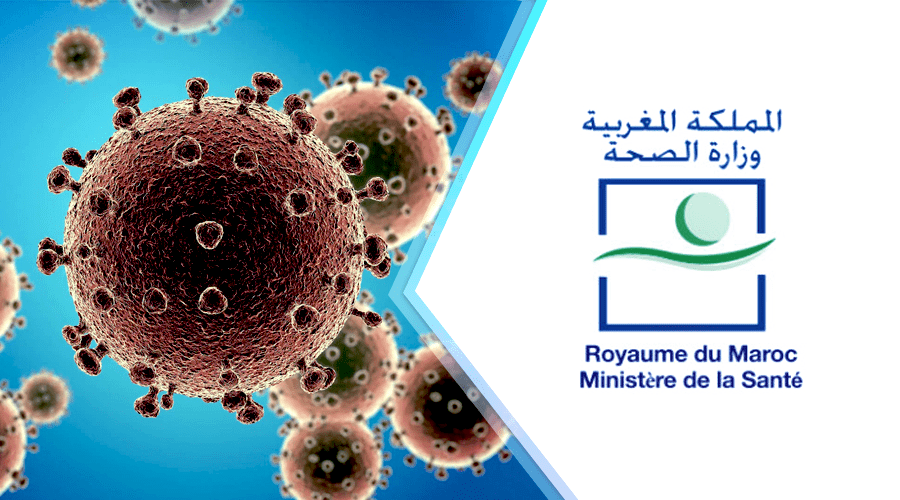
1327 حالة شفاء من كورونا و1191 إصابة و43 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

هكذا عاقب الأزمي "وكيلا" فضح الفساد بسوق الجملة للسمك بفاس

ضبط 4 جزائريين وحجز مشروبات كحولية مغشوشة داخل فندق بالبيضاء

أمن طنجة يطيح بمحامي مزور يتاجر في السيليسيون

زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة

كورونا بالمغرب.. 1240 حالة شفاء و1191 إصابة و30 وفاة خلال 24 ساعة

البنك الأوروبي للاستثمار يخصص بشكل عاجل 100 مليون أورو لدعم المغرب في مواجهة كورونا

استنفار بابتدائية فاس بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 23

الديستي والشرطة القضائية يحبطان محاولة تهريب 470 كيلوغرام من المخدرات وتهجير سبعة شبان من شاطئ انزا باكادير

وزارة التعليم توضح بخصوص استمارة "التعليم الحضوري"

مديرية الأرصاد تحذّر من زخات رعدية قوية بهذه المناطق من المملكة

المستشفى العسكري المغربي ببيروت يقدم 15 ألف و 900 خدمة طبية
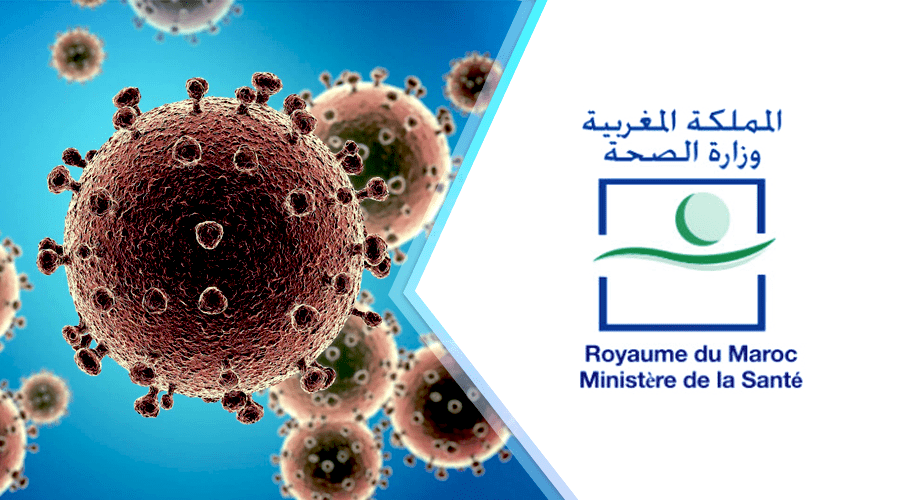
هذه خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

شغب ليلة عاشوراء ينتهي باعتقال العشرات وجروح في صفوف قوات الأمن
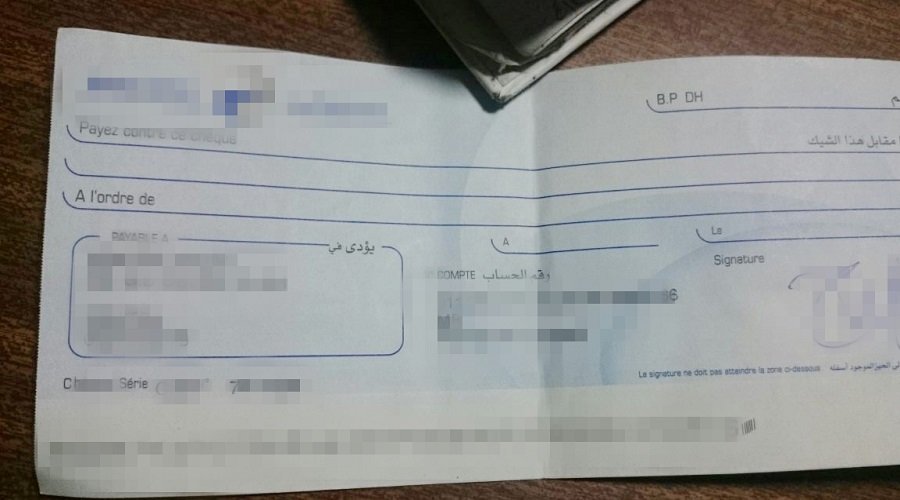
شيكات مزورة تسقط عصابة في السطو على العقارات

ترويج معلومات زائفة تشكك في إجراءات مكافحة "كوفيد 19" يجر ستيني إلى الاعتقال بفاس

رشوة تورط موظفا أمنيا بأكادير وتقوده إلى الاعتقال

الدار البيضاء.. إغلاق هذه المقاهي والمطاعم والمنتجعات بأنفا حتى إشعار لاحق

توقيف شخصين بالعيون بسبب الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

تسجيل أول وفاة بمرض كورونا يستنفر سلطات سيدي سليمان

2078 ناجح في امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2020
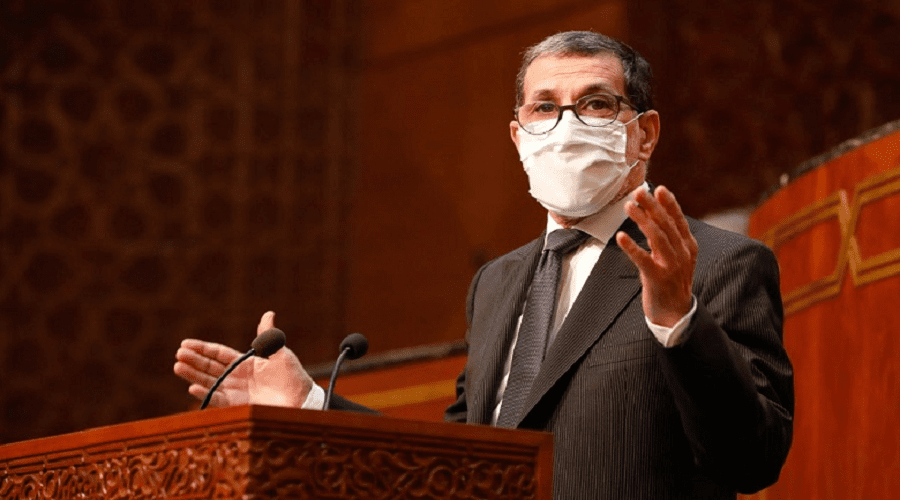
العثماني : المغرب محسود واستهداف ثوابته دليل على ذلك

العثماني: كورونا يكبد الاقتصاد المغربي خسائر جسيمة والحجر الصحي الشامل لا يمكن أن يستمر

حفل عن بعد احتفاء بـ52 طالب يمني حصلوا على شهادة الدكتوراه من الجامعات المغربية

المئات يتوافدون إلى الراشيدية بحثا عن بقايا نيزك

وزير الخارجية اللبناني يعبر عن تقدير بلاده للمبادرة الملكية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية

مطالب بإيجاد حل لمنعرج الموت بضواحي طنجة

المدارس الفرنسية بالمغرب تضع نمط تعليم اختياري رهن إشارة أولياء الأمور والانطلاق الدروس في 7 شتنبر المقبل

رشوة تقود ضابط شرطة بفرقة مكافحة العصابات إلى الاعتقال بسلا

"كورونا" تعيد أزمة رُخص النقل الدولي بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة

سكان بشفشاون يتطوعون لاخماد حرائق غابوية أتت على أكثر من 300 هكتار

التحقيق مع مفتش شرطة ممتاز كسر نافذة سيارة مواطن بتارودانت
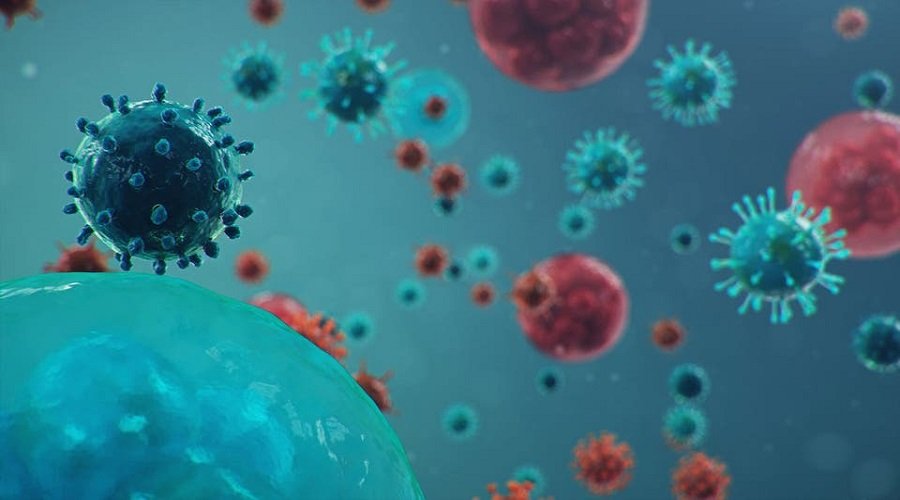
بعد عودتهم من الإجازة الصيفية.. "فحص كورونا" لقضاة وموظفي العدل

CIH Bank : عمليات افتراضية اختلاسية طالت الحسابات البنكية للزبناء وشكاياتهم قابلة للتعويض

عدم ارتداء كمامة داخل مطعم شهير بعين الذئاب يكلف زبائن غرامة 300

الداخلية تقاضي برلمانيا من "البيجيدي" أحدث تجزئة عقارية مخالفة للقانون فوق أرض تابعة لأملاك الدولة
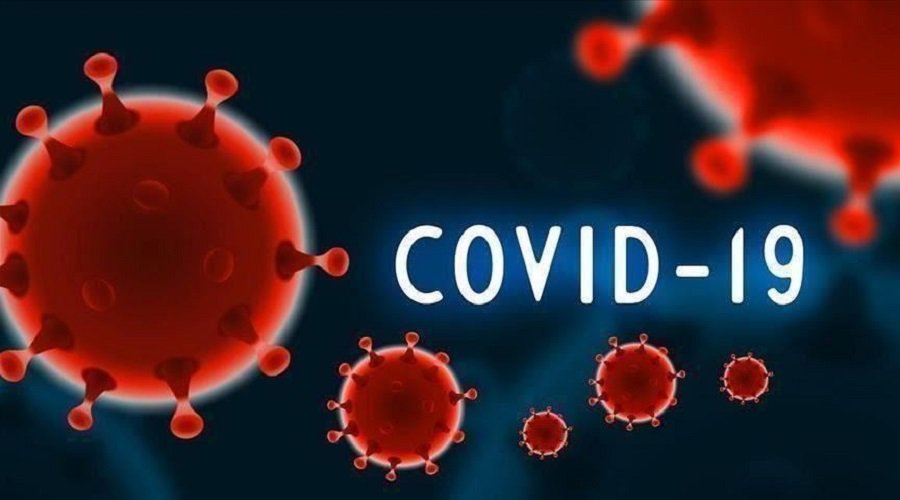
أطباء يطالبون برفع اختبارات الكشف عن كورونا إلى 100 ألف يوميا لمحاربة تفشي الفيروس

ضربة موجعة لمافيا التهريب الدولي.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بساحل العرائش

الدخول المدرسي الجديد.. مطالب بتكافؤ الفرص ومشاكل التعليم في العالم القروي تصل البرلمان

المغرب يعيد تنشيط ملف انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية في جنيف

اختفاء مقاول متهم بالنصب يجمد سير مشروع كلف الملايين لاستفادة أطفال مصابين بالسكري بتطوان
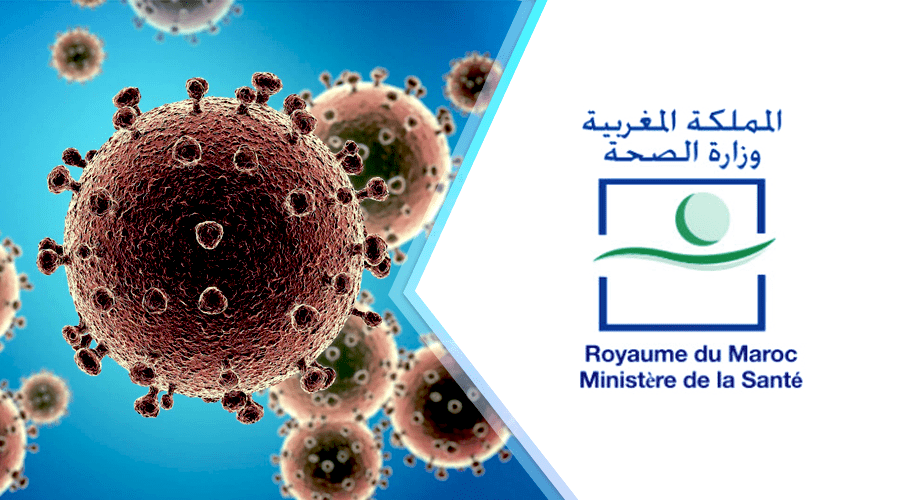
1221 إصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يقفز إلى الـ1011 وفاة

اعتقال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع

إدارة مستشفى محمد الخامس بالبيضاء تحيل محتوى شريط حول عملية ارتشاء على القضاء

"السياحة" تراكم خسائرها بالمغرب بسبب الجائحة

ارتفاع حركة النقل التجاري بميناء آسفي بأزيد من 25 بالمائة متم يوليوز الماضي

صيف 2020..انخفاض انتاج واستهلاك الكهرباء بالمغرب بنسبة 2.2 في المائة

تمديد التدابير الاستثنائية لمواجهة الجائحة أسبوعا إضافيا باليوسفية

هذه مقترحات جمعيات طبية لضمان تحصيل دراسي دون انقطاع في ظل جائحة "كوفيد 19"

تفكيك شبكة للإتجار في البشر حاول أفرادها تهجير تسعة شبان إلى إسبانيا مقابل 20 مليونا

"كورونا" يوقف الزيارات العائلية بالسجون

الحكومة تقرر إعدام مكتب التسويق والتصدير ومسؤولون استفادوا من الملايير دون إرجاعها للمكتب

الداخلية تبحث تراخيص سكن وقعها رؤساء جماعات بتطوان

الحجز على الممتلكات العقارية لـ"اخريبيقة" أخطر تاجر مخدرات بالغرب

إغلاق الشواطئ التابعة لإقليم الفحص أنجرة

أمزازي: إلغاء الامتحان الجهوي "ضرب لمصداقية شهادة البكالوريا"

استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من "التعليم الحضوري" رهن إشارة التلاميذ عبر منظومة "مسار"

مصير مجهول ينتظر موظفي وزارة الأسرة والتضامن بعد خطة دمج مؤسسات تابعة للوزارة
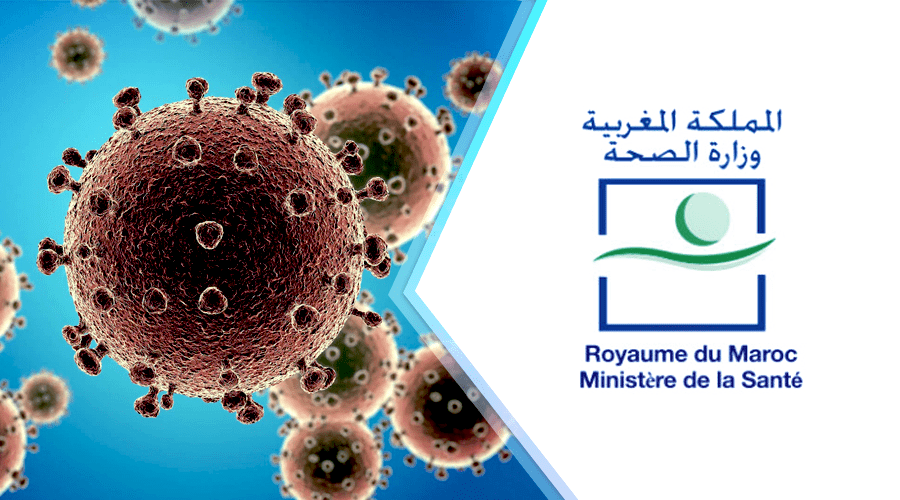
1336 إصابة بفيروس كورونا و2293 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أمزازي: الوضعية الوبائية لا تسمح بفتح الأحياء الجامعية ولا تأجيل للدخول المدرسي والجامعي

وفاة مهندس بمستشفى "كوفيد 19" بطنجة يجر وزير الصحة إلى المسائلة

إيقاف مشتبه به حاول تصفية فاعل حقوقي بتطوان والبحث جار في علاقاته

كورونا يؤجل مباريات في القسم الوطني الثاني للبطولة الاحترافية

مجلس الفنيدق يواصل منح تراخيص للبناء في غياب قنوات الصرف الصحي والطرق والكهرباء

توبيخ من الداخلية إلى عمدة الرباط بسبب تعيينات خارج القانون بتعوضيات تصل إلى 10 ملايين شهريًا

نتائج الحركة الانتقالية تُغضب أطر مؤسسة التعاون الوطني

الصويرة.. بؤر فندقية ترفع إصابات "كورونا" إلى المائة في أيام معدودة

سقوط عصابة توظف حسناء عشرينية لاستدراج الضحايا عبر "الأطوسطوب"

تورط شاحنة للأزبال في تهريب المخدرات بطنجة

توقف خدمات صيدليات بطنجة يفاقم أزمة المرضى

ملايين الدراهم لاقتناء مواد تعقيم فاسدة بالرباط

الخيمة الاستشفائية بمراكش جاهزة لاستقبال مرضى "كوفيد 19" اليوم الأربعاء بطاقة استيعابية تصل إلى مائة سرير

حريق باب برد على مشارف المدينة

مهنيو كراء السيارات يعتصمون بالرباط ضد مؤسسات القروض

البحث في قضية تزوير بملف حجوزات بالملايير بتطوان

تقاذف المسؤوليات بسبب أشغال عشوائية بمنطقة سياحية بشفشاون

برلمانيون من العدالة والتنمية يؤكدون إصابتهم بكورونا

رفض فتح الحدود لأردني في قضية «سرقة الساعات الفاخرة»

استمارة رهن إشارة التلاميذ الراغبين في التعليم الحضوري ابتداء من فاتح شتنبر

صاحبة رائعة نركبو الهبال ثريا جبران تترجل عن مسرح الحياة عن عمر يناهز 68 سنة
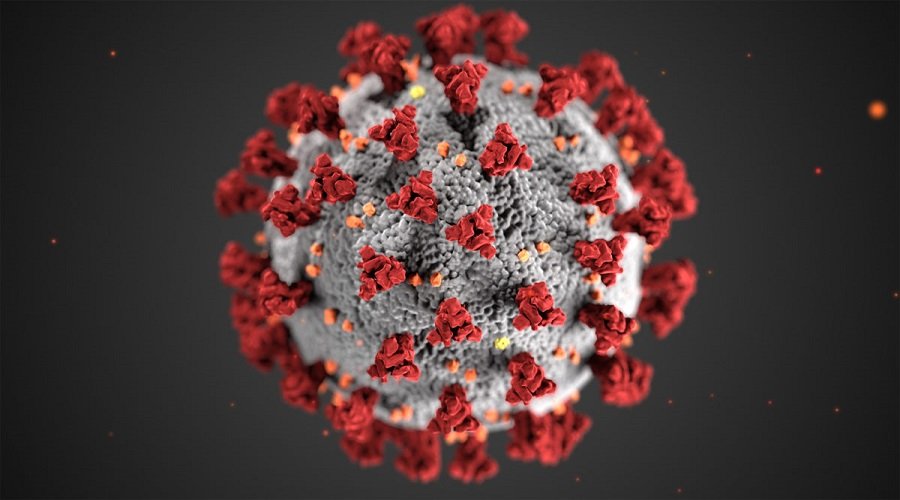
903 إصابة بفيروس كورونا 1135 حالة شفاء خلال الـ24 الماضية

بؤر عائلية بمرتيل تستنفر عمالة المضيق لتأهيل مستشفى الحسن الثاني

تدابير جديدة لمواكبة إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي المقبل

إجراءات صارمة تمكن طنجة من تجاوز الوضع الصحي المخيف

تسرب المياه "يُفسد" ملفات بابتدائية تطوان والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق

رئيس الحكومة غاضب من الإساءة إليه عبر تعليقات الفيسبوك
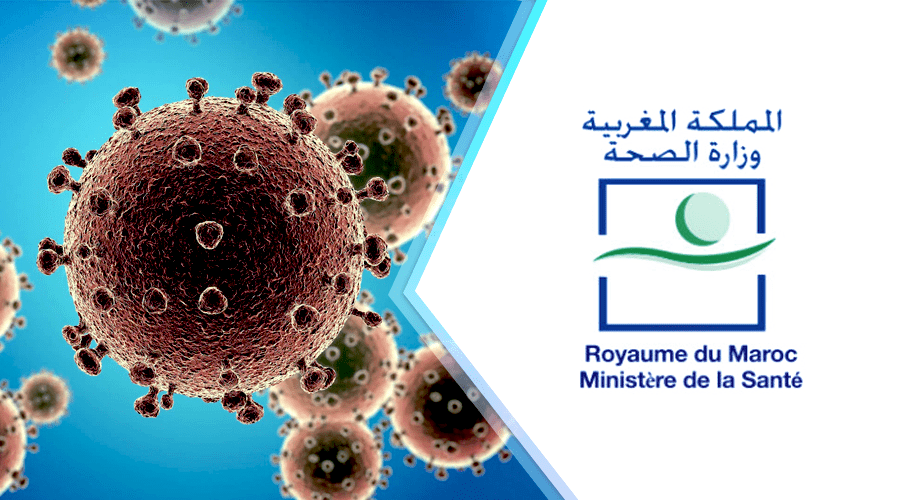
5000 متطوع مغربي يخضعون للتجارب السريرية هذا الأسبوع

المستشفى العسكري المغربي ببيروت يجري أزيد من 9400 خدمة طبية لمتضررين
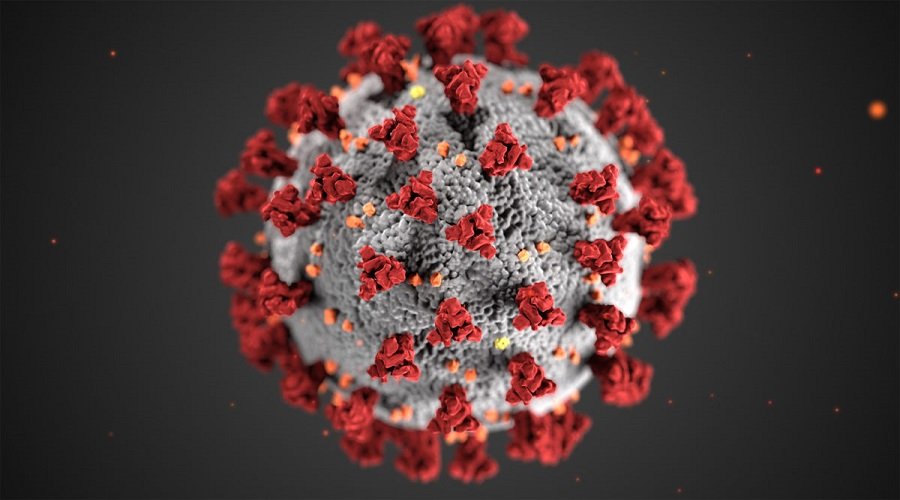
600 مغربي تطوعوا لإجراء التجارب السريرية الأسبوع المقبل حول لقاح كورونا

مستشفيات ميدانية بالمراكز الاستشفائية الإقليمية للدار البيضاء تدخل الخدمة غدا الإثنين

أمزازي يضع ثلاث فرضيات لاستئناف الموسم الدراسي المقبل

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم : هذه ثلاثة سيناريوهات لإنجاح الموسم الدراسي المقبل

هام لأصحاب دراجات الجيت سكي... خدمة جديدة لتسجيل المركبات

إغلاق متجرَين لمرجان بمراكش لظهور حالات مرضية بين المستخدمين

رسميا.. المغرب يعتمد التعليم عن بعد برسم الموسم الدراسي 2020-2021

كورونا يغيب الفنان الأمازيغي احمد بادوج بعد مضاعفات صحية

المحمدية تغلق شواطئها في وجه المصطافين

مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني يفتح تحقيقا بشأن حادث سقوط طائرة خفيفة بالقنيطرة

مجلس المنافسة: قرارات بنكيران الاستعجالية تسببت في اختلالات تنافسية في قطاع المحروقات

لجنة اليقظة تسجل تطورا في عدد حالات الإصابة بكورونا بأكادير

بعثة إسبانية تزور المغرب أكتوبر المقبل لهذا السبب
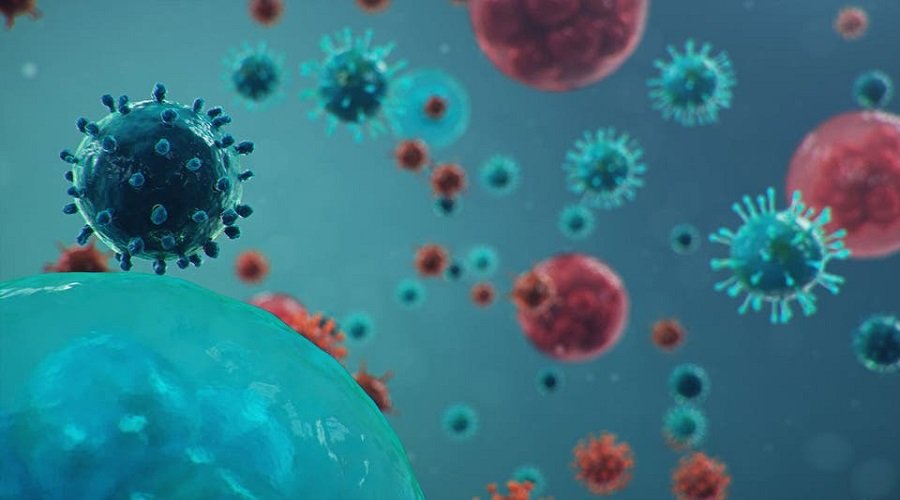
1609 إصابة جديدة و1393 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق الشواطئ بإقليم بن سليمان ابتداء من منتصف ليلة الجمعة

رؤساء جماعات ببرشيد متخوفون من افتحاص مصاريف "كوفيد"

الداخلية تتحفظ على تخصيص "كوطا" لشيوخ الأحزاب بالبرلمان

الجامعات المغربية تعتمد مراكز القرب لإجراء امتحانات الدورة الربيعية 2019-2020

الملك يحذر من الانعكاسات الاقتصادية على الأسر في حال فرض حجر صحي

الملك محمد السادس :"يمكن العودة للحجر الصحي الشامل والوضع الوبائي لا يدعو للتفاؤل"

الملك محمد السادس : عودة الحجر الصحي رهين بتطورات الحالة الوبائية

هذه هوية الطائرة التي تحطمت بضواحي القنيطرة

عاجل... سقوط طائرة سياحية يخلف مصرع شخصان بمدخل مدينة القنيطرة

اتفاقيتا تعاون بين المغرب وسينوفارم الصيني بخصوص التجارب السريرية

اتفاقيتا تعاون بين المغرب وسينوفارم الصيني بخصوص التجارب السريرية

إغلاق الشواطئ والحمامات ومحلات التجميل ابتداء من يوم غد الجمعة بهذه المدن

"توي فلاي" ستؤمن رحلات خاصة بين بلجيكا والمغرب ابتداء من الأسبوع

وزير الصحة : هذه تدابير لمواجهة كورونا بمستشفيات بمراكش

جماعة طنجة تسقط من لائحة الجماعات الممنوحة من الداخلية حول النجاع

حرارة تحقيقات الداخلية بالشمال تصل اقسام التعمير بالجماعات

سيارة "مشبوهة" تستنفر أمن طنجة

منح التراخيص لمختبرات القطاع الخاص للكشف عن كورونا

الداخلية تدخل على خط مشروع سكن للموظفين بتطوان

الجمعة فاتح محرم لعام 1442..كل عام وأنتم بخير
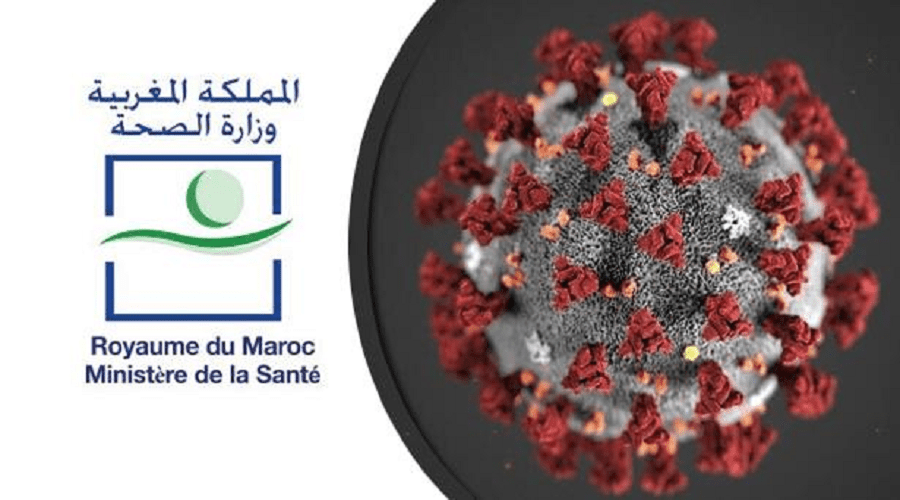
1510 إصابة بفيروس كورونا و574 حالة شفاء خلال الـ24 الماضية

سكان أصيلة يطالبون بإيجاد حل للمطرح العمومي

اختفاء شيك بمبلغ 408 ملايين سنتيم في ظروف غامضة بجماعة القنيطرة

أرباب المقاهي و المطاعم يدعوون لإضراب وطني

حرارة مفرطة إبتداء من الخميس في هذه المناطق

ملف عزل رئيس مجلس المضيق بيد المفوض الملكي والداخلية تبحث في رخص تصاميم التهيئة

أزمة تعيينات "ضباط الكهرباء" تنتقل إلى مجلس المستشارين

عودة الحجر الصحي لسكان حي الرشاد والتقدم بالرباط

كل ما تجب معرفته عن كيفية مشاركة المغاربة في إنتاج لقاح كورونا

الرئيس المالي في قبضة متمردين و"الخارجية" المغربية تدعو للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية

رباح يدافع عن مشروع إحداث مركز تحويل النفايات بسيدي يحيى ومطالب بفتح تحقيق في صفقة الثلاثة ملايير الخاصة بتهيئة مطرحين

السلطات تغلق أحياء بالدار البيضاء لتطويق بؤر عائلية

بنعبد القادر : إشادات دولية بتجربة المغرب في التصدي للإرهاب

تقرير "إشكاليات الصحة" بمراكش بين يدي وزارة الداخلية

قيادي بـ "البام" أمام ابتدائية تطوان

قضايا رشوة بقطاع الصحة تستنفر وكيل الملك والضابطة القضائية بتطوان

إطلاق نداء للتبرع بالدم بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش

إقبار تحقيق في إهدار المال العام بالفنيدق

إغلاق الشواطئ و تعليق الأنشطة التجارية بالصخيرات

اتفاق ينهي أزمة الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية بعد "بلوكاج" لأزيد من ثماني سنوات

تذمر في أوساط الجالية من تأخر نتائج التحاليل المخبرية

1069 إصابة بفيروس كورونا و597 حالة شفاء خلال الـ24 الماضية

استدعاء 19 متهما في فضيحة عقارية بالملايير بتطوان

إعفاء مدير مصحة الضمان الاجتماعي بطنجة بسبب أزمة "كوفيد 19"

إطلاق أشغال بناء مدينتي المهن والكفاءات بطنجة وبني ملال

آيت الطالب: المغرب سيشارك في التجارب السريرية للحصول على كمية كافية من لقاح كورونا في آجال مناسبة

وزير الطاقة يوافق على استيراد نفايات ومواد سامة للمغرب (وثائق)

مناصب بـ7 ملايين شهريا.. تعيينات "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء" تثير أزمة برلمانية

حركة الممرضين وتقنيي الصحة تحتج على هزالة منحة كوفيد 19

ضحايا رئيس هيئة الموثقين السابق يخرجون للعلن بالقنيطرة

"كورونا" يقتحم مديرية الأدوية والجامعة الوطنية للصحة تطالب بفتح تحقيق

1472 إصابة بكورونا و778 حالة شفاء و26 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

سلطات مراكش تغلق أحياء بشكل كلي لمنع تفشي كورونا

أعضاء مكتب النواب يطالبون المالكي بعقد اجتماع عاجل بعد فضيحة تعيينات هيئة الكهرباء

مرضى كورونا بمستشفى سيدي يحيى قضوا 9 أيام والإدارة تتماطل في إخضاعهم للتحاليل

فضيحة ترويج مستلزمات طبية غير مرخصة تهز وزارة الصحة
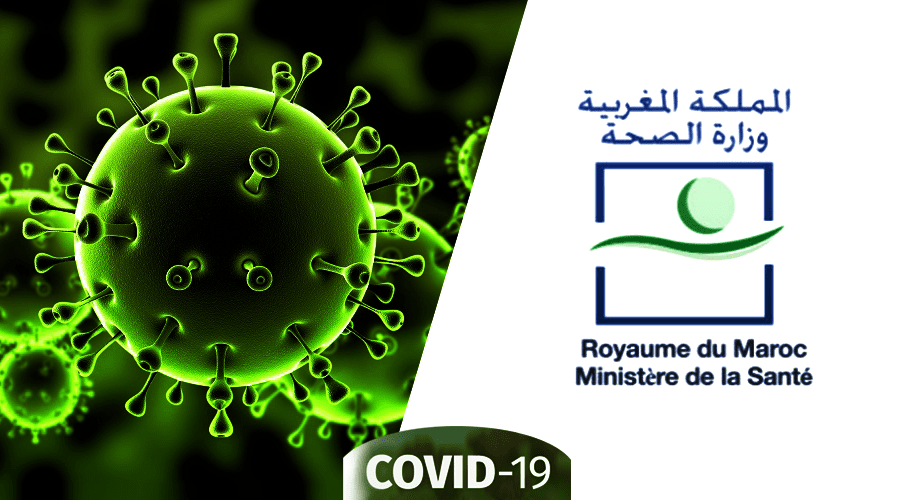
957 حالة شفاء من كورونا و1306 إصابات و27 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

قيادي حزبي بالشمال تحت الحراسة النظرية لارتكابه حادثة سير في حالة سكر

اعتماد مراكز صحية في الأحياء للكشف عن المصابين بكورونا في المغرب

1010 حالات شفاء من كورونا و1241 إصابة و28 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

هجرة جماعية لمنتخبين تهز التقدم والاشتراكية

تفاصيل الإطاحة بقاصر سطا على الملايين بفيلا مسؤول كبير ضواحي الرباط

بعد هولندا.. السويد تغلق حدودها في وجه القادمين من المغرب

المغرب يترأس أول ندوة حول الطوارئ النووية أو الإشعاعية باللغة العربية

الخارجية الأمريكية تقدم المغرب كنموذج في مجال تمكين المرأة

هكذا سيتم استخلاص الغرامات من مخالفي ارتداء الكمامات

كورونا يدخل البرلمان والمالكي يُلزم البرلمانيين والموظفين بشهادة الاختبار السلبي

الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
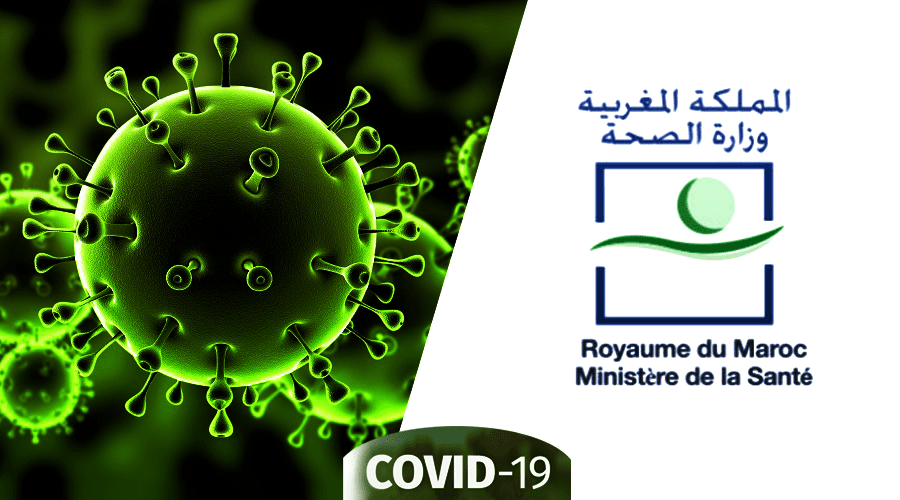
وزارة الصحة: الممارسة الجنسية تنقل عدوى كورونا والكحول لا يحمي من الفيروس

الاتحاد الأوروبي يسمح للطلبة والجالية المغربية بدخول أراضيه بهذه الشروط

سلطات البيضاء تغلق حيا بأكمله لمنع تفشي كورونا

بنشعبون يعلن إلغاء "راميد" وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض

الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 7ر3 مليار درهم

إصابة عمدة مراكش محمد العربي بلقايد بكورونا

861 حالة شفاء من كورونا و1132 إصابة و19 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب
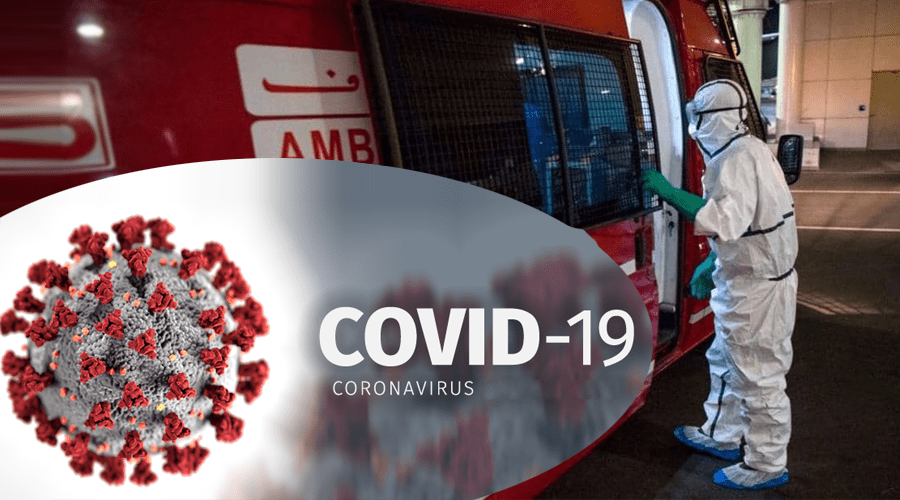
عضوة بمجلس التعليم تكشف حقائق صادمة عن مرضى كورونا بمستشفى سيدي يحيى

تفاصيل إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من ضريبة المشروبات

خرق الطوارئ يطيح بمسؤولين عن تسيير وحدة صناعية بآسفي

وزير الصحة يتراجع عن قرار تعليق العطل السنوية

تحذير من رعود قوية اليوم بهذه المناطق من المملكة

بنعبد القادر: وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لقضايا مغاربة العالم

1177 حالة شفاء من كورونا و826 إصابة و18 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

لارام تمدّد العمل بالرحلات الخاصة إلى غاية 10 شتنبر بهذه الشروط

استنفار داخل مجلس النواب بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا

مطالب بإشراك المصحات والمستشفيات الخاصة في الحرب على كورونا

سلطات تازة تغلق 6 مقاهي بسبب مخالفة تدابير كورونا

إطلاق النار في طنجة لتوقيف شخص عرّض سلامة المواطنين لاعتداء خطير

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين في هجوم مسلح بالنيجر

الأرصاد تحذر من زخات رعدية قوية اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة

هكذا تحولت مغربيات إلى بطلات روايات ومذكرات أجنبية

بوصوف : 500 مغربي بالخارج توفوا بكورونا

1157 حالة شفاء و18 وفاة بسبب كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة

وزارة التعليم توضح طبيعة النموذج التربوي المعتمد خلال الدخول الدراسي المقبل

ولاية أمن الرباط تكشف حقيقة صور لطفلة تعرضت لاعتداء شنيع

سلطات العيون تُخضع البحارة لفحوصات كورونا قبل عودتهم لمزاولة عملهم

منح 2000 درهم شهريا لأجراء القطاع السياحي بهذه الشروط

بسبب كورونا.. وزارة الخارجية تجري انتقالات محدودة في صفوف أطرها
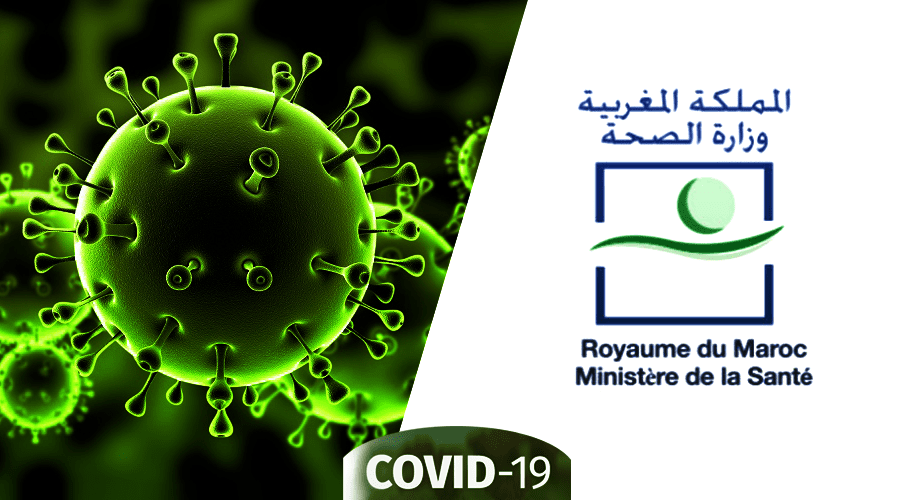
كورونا بالمغرب.. 1345 إصابة و642 حالة شفاء و19 وفاة خلال 24 ساعة

باستثناء الرحلات الخاصة.. المغرب يقرر مواصلة إغلاق مجاله الجوي

بعد فيديو تخييم مواطنين في مجرى الوادي الداخلية تمنع التنقل بين مراكش وأوريكة

خبير بالأمراض المعدية يحذر بخصوص فعالية لقاح كورونا

سلطات مراكش تشدد الإجراءات الوقائية وتغلق الحدائق العمومية

إصابة راهبة في كنيسة فاس بفيروس كورونا

حجز 20 كيلوغراما من صفائح الذهب وأزيد من مليوني أورو بوجدة

الحكومة تمنح الولاة والعمال صلاحيات واسعة لإغلاق المدن حسب الحالة الوبائية

الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الآمنة للسفر

هذه تفاصيل القوانين العسكرية الهامة التي دخلت حيّز التنفيذ بالمغرب
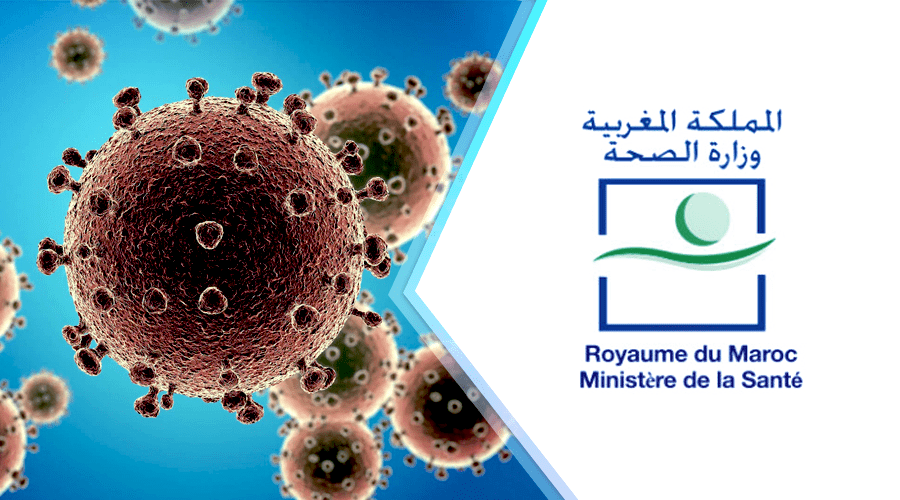
قرابة ألف حالة شفاء من كورونا سجلها المغرب اليوم

هكذا أجهضت المنطقة التجارية بالفنيدق أنشطة التهريب وتبييض الأموال

هكذا تهدد التوابل صحة المغاربة

عندما تختلط مزامير وطبول الفرح مع صوت صافرات إنذار سيارات الأمن

الحكومة اللبنانية تعبر عن امتنانها للمبادرة الملكية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية

تحذير من طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة

استنفار داخل مجلس النواب بعد إصابة مخزني بكورونا

المغرب يخصص رحلتين لمواطنيه الراغبين في العودة من لبنان بهذه الشروط

تساؤلات حول استثناء مرضى سيدي يحيى من البروتوكول العلاجي بالمنازل

سلطات طنجة تغلق المنطقة الصناعية بشكل كامل

زيادة جديدة في أسعار السجائر تلهب جيوب المدخنين

هيئتان للتعليم الخصوصي تطالبان باعتماد التعليم الحضوري خلال السنة المقبلة

الداخلية تصدر تعليمات للعمالات والأقاليم لمراقبة مخازن الغاز والوقود والمواد القابلة للانفجار

وقفة احتجاجية حاشدة لأطر الصحة بسوس للمطالبة بإقالة المدير الجهوي

الملك يأمر بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة وإقامة مستشفى عسكري ميداني بلبنان

بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى من ثلاثة طوابق خلف مقتل شخص بالبيضاء

وزارة التربية الوطنية تكشف موعد انطلاق الموسم الدراسي

رسميا .. الجيش يحل بطنجة لدعم الجهود الأمنية لوقف نزيف الاستهتار بالوضع الصحي

1144 إصابة بكورونا و559 حالة شفاء و14 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

تفاصيل استنطاق طبيب اغتصب عشرات الأطفال من سلا بمساعدة وسيط

هذا ما قررته المحكمة في ملف تصاميم البناء المزورة بفاس

تمديد الطوارئ بالمغرب لمدة شهر وغرامة 300 درهم في انتظار مخالفي ارتداء الكمامة

المغرب يرسل 8 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى لبنان

نقل ألف مصاب بكورونا بطنجة من المستشفى إلى منازلهم لاستكمال العلاج

غرامة 300 درهم على مخالفي ارتداء الكمامة بالمغرب ؟

بالصور.. مصرع شخص في انهيار منزل بحي سباتة بالدار البيضاء
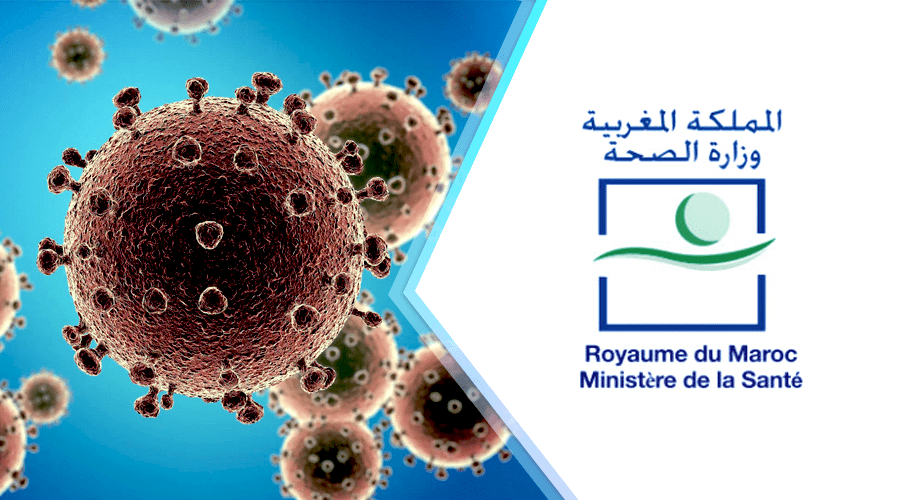
كورونا بالمغرب.. 1283 إصابة و365 حالة شفاء و18 وفاة خلال 24 ساعة

وزارة الصحة تختبر قوة مناعة المغاربة ضد كورونا

هذه كواليس إعفاء مدير وكالة التنمية الاجتماعية من طرف الوزيرة المصلي

انطلاق التكفل المنزلي بمرضى كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض قبل يومين وبشروط صارمة
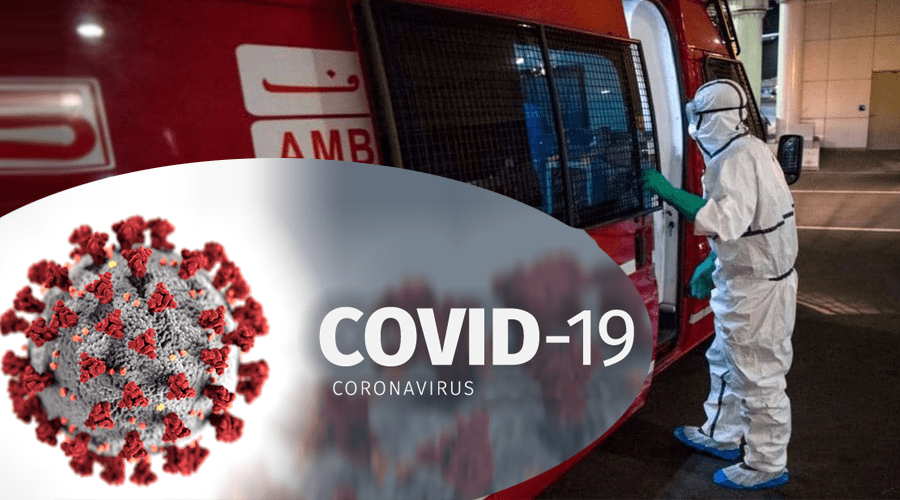
وزارة الصحة: المغرب لا زال يصنف في المرحلة الثانية لوباء كورونا

رغم الجائحة أونسا تسجل 242 ألف ضيعة لتسمين الأغنام والماعز وترقم أزيد من 8.2 مليون وتنجز 1500 خرجة ميدانية وتخضع 842 عينة من اللحوم للتحاليل

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة للرئيس اللبناني

1021 إصابة بكورونا و661 حالة شفاء و16 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

العودة إلى الحجر الصحي الشامل ... الحقيقة من الكذب

رؤساء جماعات مهددون بالسجن بعد رصد مفتشية الداخلية لخروقات خطيرة

تفاصيل الإطاحة بمقاول احتجز خطيبته وعذبها بتامسنا

الأطر الصحية تخرج للاحتجاج على قرار الوزارة بإلغاء العطل

النيران تأتي على 600 هكتار من غابة الملاليين بالمضيق

بسبب فضلات الدجاج أونسا تحيل 25 كسابا على النيابة العامة

تجهيز مركز استشفائي ميداني بفاس طاقته 1200 سرير لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة ضواحي أكادير

هذه هي الشواطئ المغربية التي صدر قرار إغلاقها بسبب كورونا
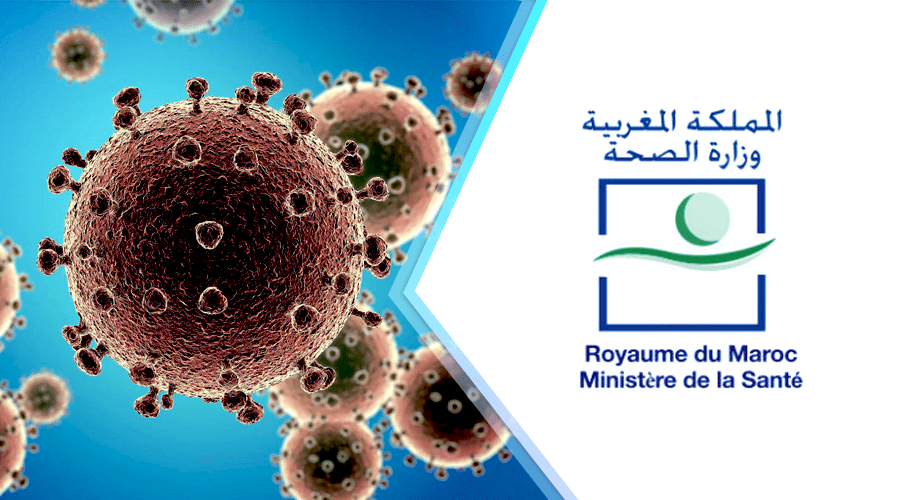
659 إصابة بكورونا و533 حالة شفاء و19 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

السكك الحديدية يكشف أن محطة الرباط مفتوحة والمسافرون عليهم التوفر على رخصة التنقل

وزارة الصحة تعلّق الرخص السنوية وتطالب الأطباء بالعودة خلال 48 ساعة

عقار جديد يقضي على كورونا لدى الحالات الخطرة في 3 أيام

إغلاق محطة القطار الرباط المدينة بشكل مفاجئ في وجه المسافرين يخلق الجدل

بعد امتلاء مخيم الغابة والملعب الكبير.. سلطات طنحة تستعين بالحي الجامعي لاستقبال مرضى "كورونا"

وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته احتجاجا على فشل الحكومة

كورونا يصيب 30 طبيبا خلال أسبوعٍ واحد بمستشفى فاس

سياقة الدراجات ثلاثية العجلات دون رخصة يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون

التحقيق في ملابسات محاولة سيدة إضرام النار في نفسها بمطار مراكش

475 حالة شفاء و15 وفاة و522 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب

الاستعانة بطائرات لإخماد حريق بغابة حوز الملاليين بعمالة المضيق-الفنيدق

المئات يخرقون الطوارئ للاحتفال بـ"بوجلود" في أكادير

تحذير من زخات رعدية قوية وبرَد بعدد من مناطق المملكة
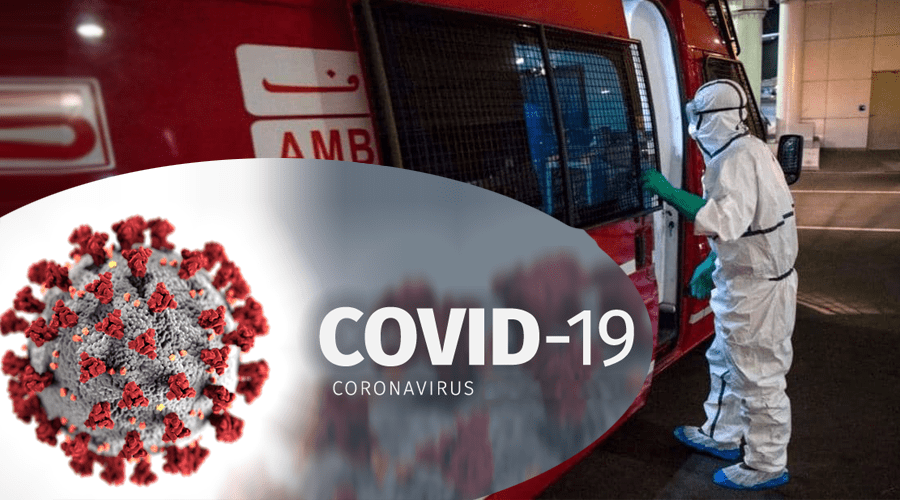
المغرب يعتمد بروتوكولا جديد في علاج مرضى كورونا بعزلهم وعلاجهم داخل بيوتهم

قتيل و4 مصابين في حادث دهس بآسفي والشرطة تحقق

الأمن المغربي يجهض محاولة لتهريب حوالي 16 كيلوغراما من الكوكايين

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 40 و46 درجة بهذه المناطق من المملكة

من دبي مرورًا بكندا إلى بوغوتا... معالم سياحية عالمية تخلد عيد العرش بألوان العلم المغربي

1063 إصابة بكورونا و 347 حالة شفاء و 7وفيات خلال 24 ساعة بالمغرب

شجار صبيحة عيد الأضحى ينتهي بطعن الزوج لأصهاره ووضع حد لحياته

هذه حصيلة تدابير وإرشادات "أونسا" خلال عيد الأضحى

الملك يصدر عفوه عن 752 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

أمن البيضاء يطيح بـ 20 متورطا في أعمال عنف وسرقة شهدها سوق لبيع الأغنام

لارام تؤكد الوفاء بالتزاماتها بنقل زبنائها بين المغرب وفرنسا

المغرب يسجل رقما قياسيا لإصابات كورنا بـ1046 حالة خلال 24 ساعة

لارام تعلن تعليق رحلاتها من المغرب إلى فرنسا لهذا السبب

رسميا.. الكاف يعلن إقامة مباريات الكونفدرالية في المغرب بنظام المباراة الواحدة

الربابنة يجمعون مساهمات مالية بالملايين لملاحقة "لارام" أمام القضاء

الملك يدعو إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة

الملك محمد السادس : "عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية ويجب التحلي باليقظة"

الملك يؤكد ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات كورونا ويأمر بإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي

الملك محمد السادس :" العناية بصحة المواطن هي نفس العناية التي اعطيها لاسرتي"

826 إصابة بكورونا و59 حالة شفاء و7 وفيات خلال 24 ساعة بالمغرب

الملك يصدر عفوه عن 1446 شخصا بينهم معتقلون على خلفية أحداث الحسيمة

إيقاف 14 من أبناء أثرياء بالقنيطرة داخل فيلا مشبوهة

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنبّه الأحزاب

متابعة عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم الاغتصاب والمس بسلامة الدولة

رصد إصابات بكورونا في صفوف جزارين قُبيل عيد الأضحى

وزارة النقل تعتبر وفاة 15 شخصا وإصابة 313 خلال ليلة الهروب الكبير حصيلة عادية

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض سلامة المواطنين لاعتداء خطير بالبيضاء

العثماني: أتحمل مسؤولية قرار منع التنقل من وإلى 8 مدن

إغلاق 7 أسواق للماشية لعدم التزامها بالإجراءات الصحية المطلوبة

الملك يتوصل بتقارير متضاربة حول العقوبات المفروضة على شركات المحروقات ويأمر بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في مدى احترام الشكليات في قرار مجلس المنافسة

مسؤول: يُسمح للحاصلين على حجز سياحي قبل المنع بالحصول على رخصة التنقل
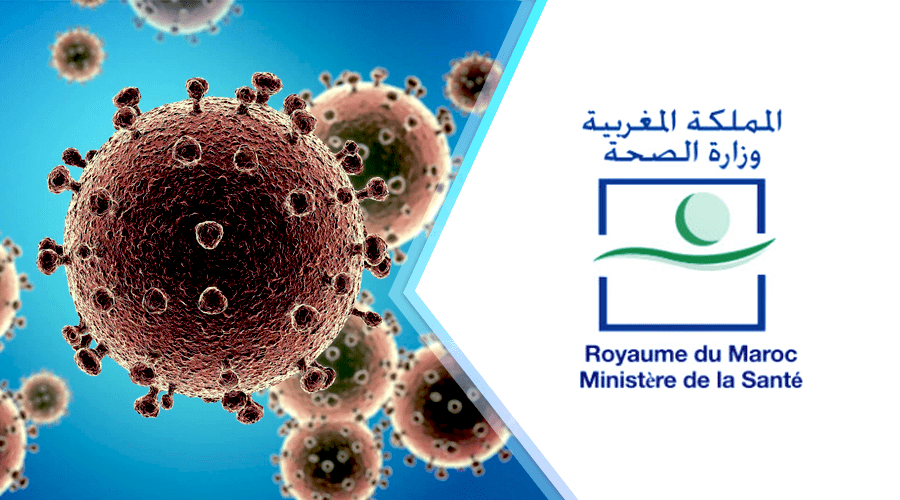
500 إصابة بكورونا و513 حالة شفاء و11 وفاة خلال 24 ساعة بالمغرب

آلاف المغاربة يموتون سنويا بسبب التهاب الكبد الفيروسي وجمعية تدق ناقوس الخطر

قرار ولائي لإغلاق جميع معامل ومصانع طنجة حتى 12 غشت المقبل بسبب الانتشار "المخيف" للفيروس
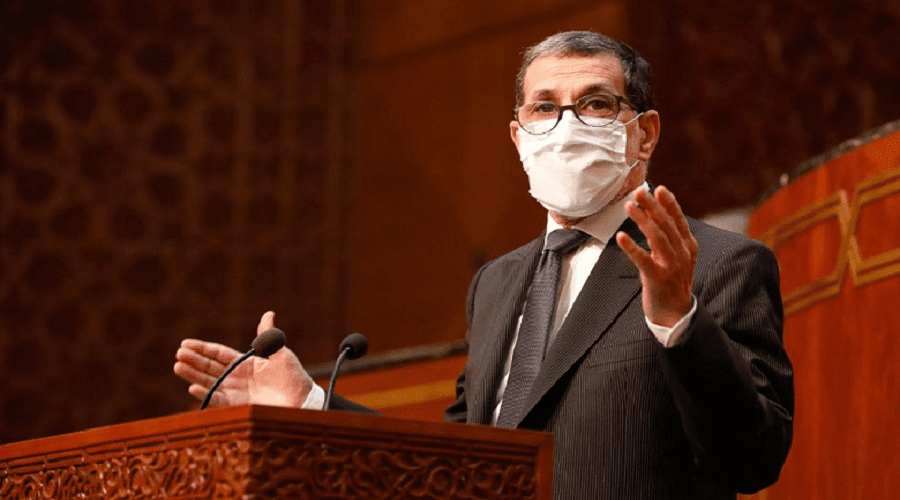
العثماني : كل منطقة ستعرف تطورا وبائيا مقلقا سيطبق عليها الحجر

فوضى بمديرية الصيدلة والأدوية والشرطة القضائية تحقق

ليلة الهروب الكبير.. قرار ارتجالي كشف أزمة تواصل لدى الحكومة

الداخلية تشرع في إعداد ومراجعة المنظومة القانونية للانتخابات

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تشكر الملك وتشيد بوفاء الدولة بالتزامها اتجاه قطاع الصحافة

إصابة مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا

هذه هي المستشفيات التي يمكن إجراء اختبارات كوفيد داخلها بالمغرب

عقد 4403 جلسة محاكمة عن بعد بالمغرب خلال 3 أشهر

ندوة وزير الصحة تخلق الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي

لقاح صيني ضد كورونا يظهر نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات

ولاية أمن البيضاء تنفي المزاعم بوجود عصابات تستهدف الركاب بمحطة ولاد زيان

هذه حقيقة مطالبة لارام للمسافرين بوثيقة التنقل الاستثنائية

كورونا بالمغرب.. 609 إصابات و115 حالة شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة

وزير الصحة: الحالة الوبائية بالمغرب مقلقة وأتفهم أن الجميع مقلق وغضبان لكن الحالة الوبائية لم تترك لنا خيار

تطورات مثيرة في قضية اتهام كولونيل متقاعد باغتصاب حفيده بالصخيرات
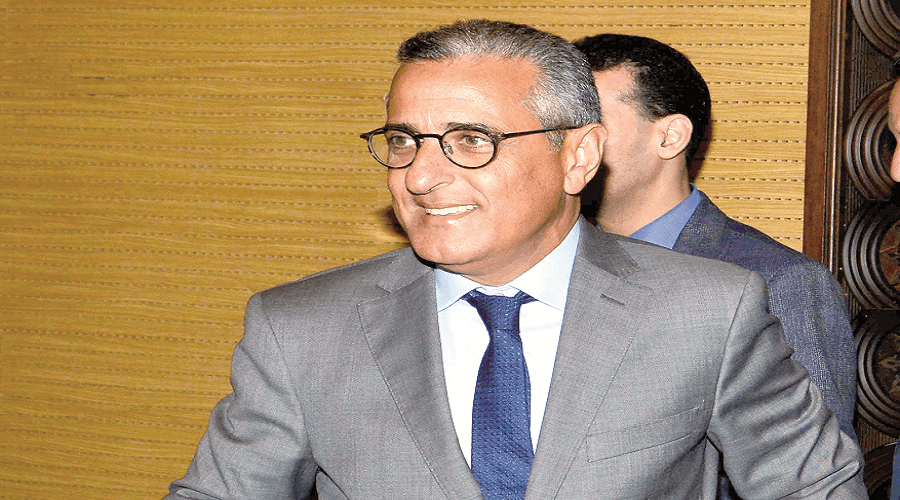
التاجموعتي يكشف تفاصيل الحرب ضد مافيا العقار واستراتيجية السياسة العقارية

تفاصيل عملية ترحيل المغاربة العالقين بالخارج

فوضى واحتيال بمحطات البيضاء ليلة البحث عن السفر بأي وسيلة

ظهور بؤر جديدة لكورونا بالصين والسلطات تلغي مئات الرحلات الجوية

زعماء مغاربة ولدوا في دواوير منسية وانتهى بهم المطاف في دائرة الوجاهة

فوضى وحوادث سير بعد القرار المفاجئ بوقف التنقل إلى عدد من المدن بالمغرب

بنعبدالقادر يرافق جثمان الفقيد محمد الحلوي إلى مثواه الأخير

وزارة التربية الوطنية تعفي الأساتذة والموظفين من محاضر الخروج
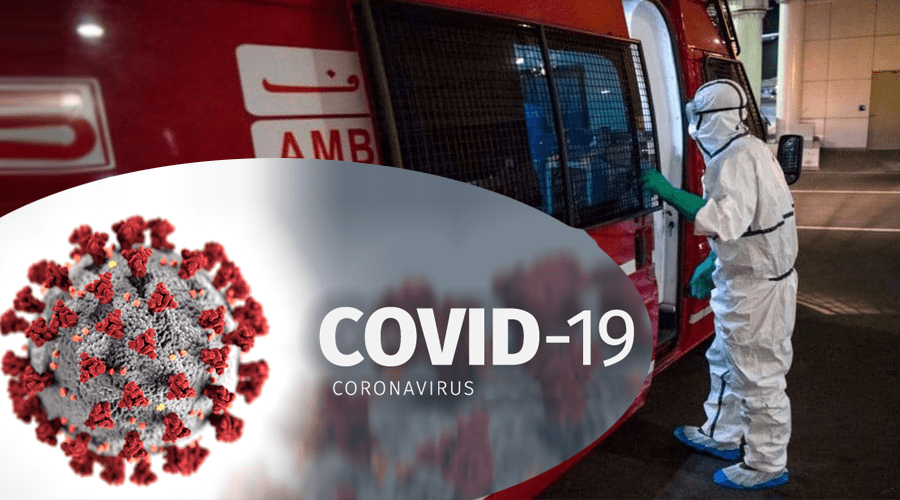
8 وفيات بكورونا و633 إصابة و156 حالة شفاء خلال 24 ساعة بالمغرب

رسميا.. السلطات المغربية تمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه 8 مدن

نقابة تكشف معاناة شغيلة التعليم الخصوصي وتطالب الحكومة بالتدخل
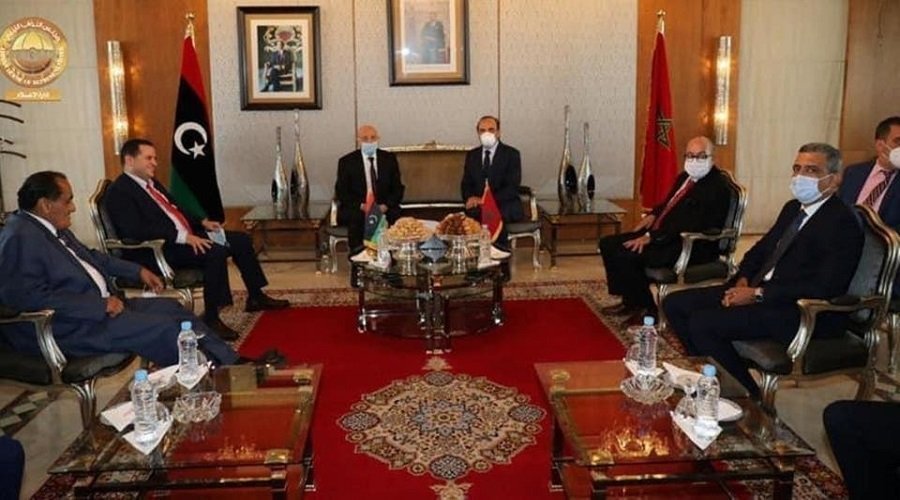
رئيس مجلس النواب الليبي يحل بالمغرب للتشاور بشأن الأزمة في بلاده

حفل زفاف بالقصر الكبير ينتهي في مخفر الشرطة

وزير الصحة يؤكد أن العودة لتطبيق الحجر أمر وارد في كل لحظة

وزارة الصحة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا وإمكانية العودة للحجر
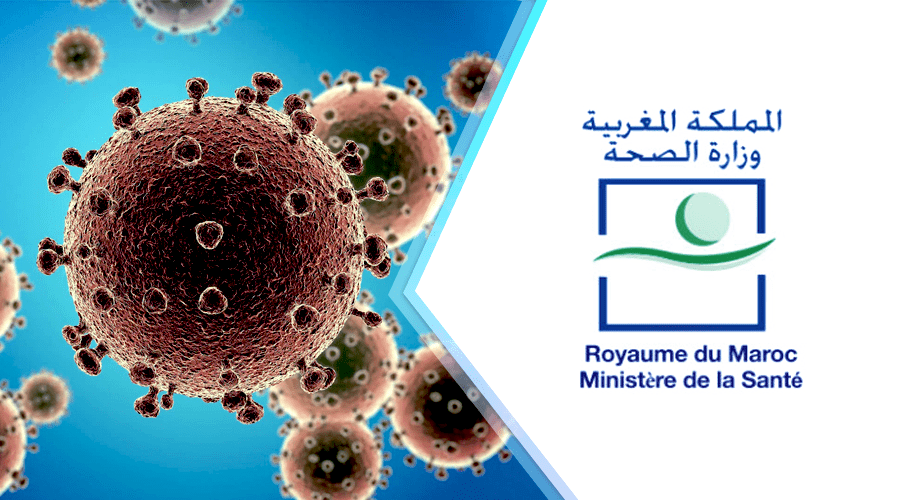
كورونا بالمغرب.. 811 إصابة و182 حالة شفاء و6 وفيات خلال 24 ساعة

ابتكار جهاز يُظهر قدرة الجسم على مواجهة كورونا
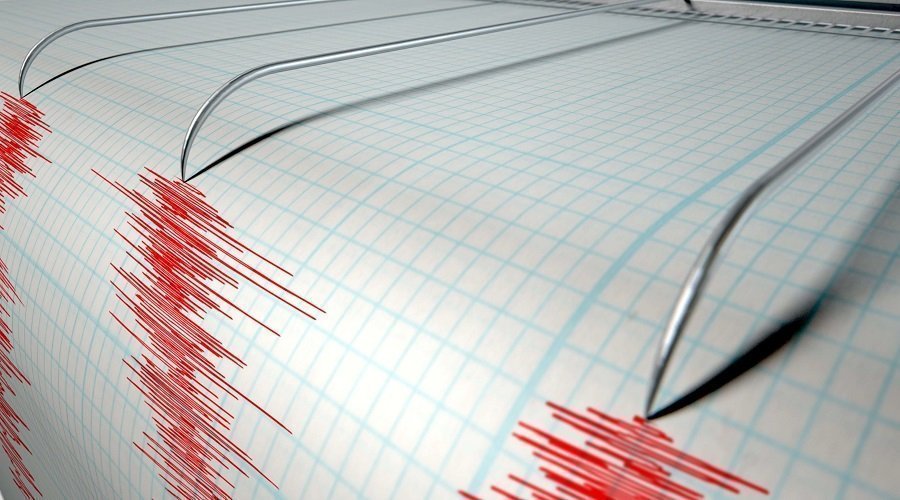
تسجيل هزة أرضية بالدريوش

مجلس المنافسة يكشف حقيقة اتخاذ عقوبات في حق شركات للمحروقات

لارام تعزز برنامج رحلاتها الداخلية

ضبط 12 طنا من فضلات الدواجن تستعمل كعلف للأغنام بإقليم الرحامنة

اعتقال مصور الفيديو الذي يعرض سيدة تتعرض للضرب وهي مكبلة

الداخلية تشدد على إجبارية وضع الكمامة والسجن والغرامة في انتظار المخالفين

السجن والغرامة في انتظار من يخالف إجبارية ارتداء الكمامة بالمغرب

صور لمرضى يفترشون الأرض بمستشفى في طنجة تخلق الجدل

كورونا بالمغرب.. 570 إصابة و228 حالة شفاء و7 وفيات خلال 24 ساعة

هذا ما قضت به المحكمة بحق المتهمين في ملف أشهر جراح للقلب بالمغرب

وزير الصحة يوضح أسباب تزايد عدد الوفيات بكورونا في المغرب

السجن لشرطي انتحل صفة عضو في لجنة اختبارات الولوج لأسلاك الأمن

وزارة الأوقاف تمنع إقامة صلاة العيد بالمصليات والمساجد

مالك الكابيسطون: نقبل دخول صاحبات الجلابيب ونستعين بعون قضائي لتحرير محاضر بأعداد الزبائن
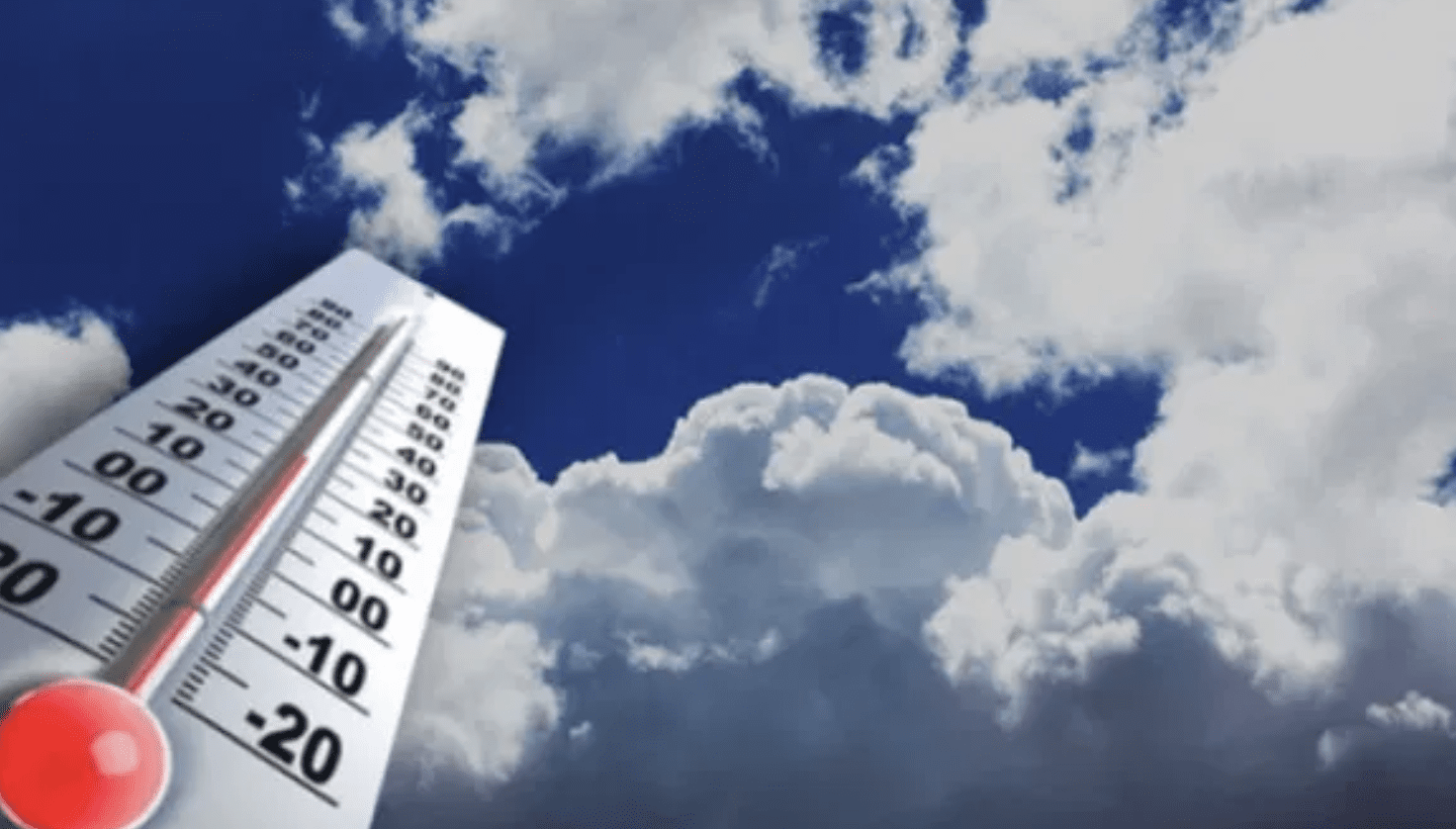
نشرة خاصة: طقس حار في المغرب إبتداء من الجمعة

القبض على شبكة إجرامية تنشط في التجارة الدولية للمخدرات

سلطات البيضاء تغلق مركب تاهيتي بيتش كلوب بسبب خرق تدابير الطوارئ

تنقيلات وإعفاءات همت عشرات المسؤولين بالدرك

الحكم على مسؤول بإدارة الجمارك بـ12 سنة سجنا و5 ملايين درهم كتعويض مدني

هذه برمجة سير القطارات بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية

رأي... رياضة وطنية اسمها التضامن

كورونا بالمغرب.. 302 إصابات و236 حالة شفاء و7 وفيات خلال 24 ساعة

رأي... من أجل دعم عمومي عادل للصحافة

أحياء سلا تغرق في الأزبال والعمدة المعتصم في قفص الاتهام و5 ملايير لجمع النفايات بمقاطعتي بطانة وأحصين

سلطات طنجة تمنع مغادرة المدينة وتُلغي وثائق التنقل الاستثنائية

كلاب خطيرة تجتاح الشواطئ وتروع المصطافين وكلب شرس يهاجم دورية للدرك بالهرهورة ويصيب دركيا بجروح خطيرة

كورونا بالمغرب.. 220 إصابة و247 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة

تفاصيل الإطاحة بموظف ومدير وكالة تنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت

بؤرة لالة ميمونة تجر مسؤولين في وحدات إنتاجية ومكلفين بالنقل نحو المتابعة القضائية

التحقيق مع كولونيل متقاعد يشتبه في هتكه عرض حفيده

سلطات مدينة فاس تغلق 6 مقاهي لعدم احترامها لتدابير الإحترازية ضد كوفيد 19
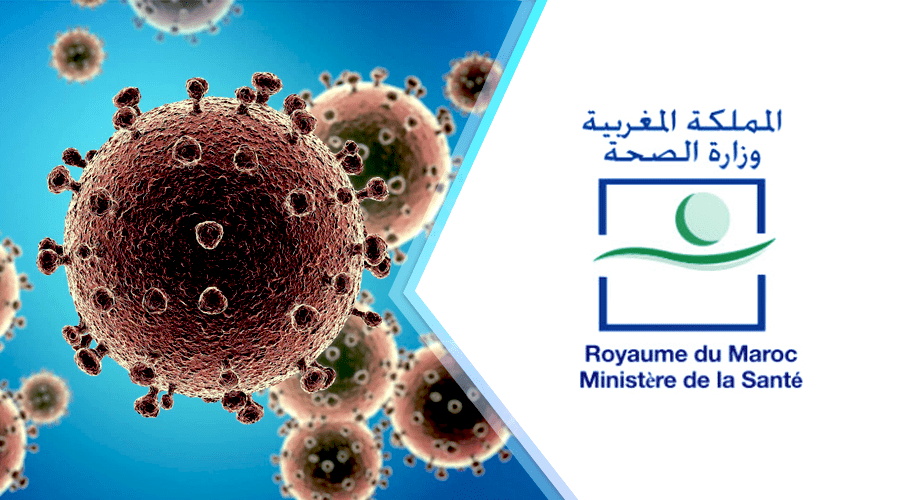
كورونا بالمغرب.. 180 إصابة و257 حالة شفاء و4 وفيات خلال 24 ساعة

أزمة نظافة تلوح في الرباط سببها صراع منتخبين

مجازر البيضاء تكشف ثمن خدمة ذبح أضحية العيد في زمن كورونا

السيطرة على حريق أتى على 36 هكتارا من الغابة الدبلوماسية بطنجة

كورونا بالمغرب.. 326 إصابة و211 حالة شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة

اندلاع حريق كبير بالغابة الديبلوماسية بطنجة غير بعيد عن المستشفى الميداني المخصص لعلاج المصابين بـ"كورونا"

الاستقلال يقترح توزيع شيكات العطل لتشجيع السياحة الداخلية

طوابير أمام الشيخ زايد لإجراء تحاليل كورونا قبل السفر للخارج

في زمن كورنا . . نسبة التمدرس بالتعليم الأولي تسجل تقدما ملموسا

باحثون مغاربة يدرسون قدرة أحد مكونات الحبة السوداء على محاربة كورونا

مسؤولون يكترون 1875 فيلا وعمارة في ملكية الدولة بـ300 درهم

العثماني يكشف كواليس المرور للمرحلة الثالثة من الحجر وهذه رسالته بخصوص عيد الأضحى

العثماني: المغرب من أكثر البلدان أمنا بخصوص كورونا ولم نقرر فتح الحدود
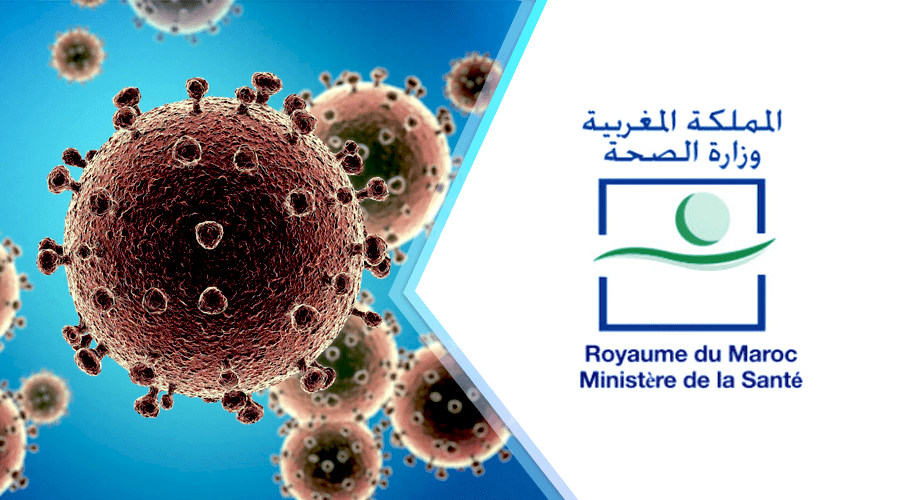
كورونا بالمغرب.. 221 إصابة و301 حالة شفاء و4 وفيات خلال 24 ساعة

اصطدام شاحنة لنقل البضائع بقطار ضواحي البيضاء

عصاميون دخلوا القصر الملكي

المغرب يمر رسميا للمرحلة الثالثة من تخفيف الحجر بهذه الشروط

توقيف 4 أشخاص ضمن شبكة لترويج الكوكايين

وفاة الكريمي تميط اللثام عن عالم صناع الفرجة الشعبية بالمغرب

رصد إصابات بكورونا بين ركاب سفينة قادمة من إيطاليا يستنفر سلطات طنجة

ولاية نيجيرية تعرض بقرتين مقابل كل قطعة سلاح على قطاع طرق

كورونا بالمغرب.. 289 إصابة و260 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة

أمن البيضاء يوقف 5 محسوبين على مشجعي فريقين بتهم العنف والتخريب

انطلاق عملية إعادة المغاربة والأجانب المقيمين القادمين من الموانئ المرخص لها

شركات طيران دولية تبيع تذاكر سفر نحو المغرب لرحلات بتاريخ بداية غشت

موارد صندوق تدبير جائحة كورونا تبلغ 33.3 مليار درهم

ما يجب معرفته حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه البحر والمسابح

كورونا بالمغرب.. 181 إصابة و395 حالة شفاء خلال 24 ساعة

صاحبة أعلى معدل وطني تكشف سر تربعها على عرش الباكالوريا بالمغرب

الوضع الصحي بطنجة يثير المخاوف وآيت الطالب زار المدينة مرتين في أقل من أسبوع

الجمعية الوطنية للمجازر الوطنية للدواجن تطلق نداء استغاثة لإنقاذ القطاع

إدارة الجمارك تمدد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

مستشفى بطنجة يعيش وضعا كارثيا والأطر الطيبة تدق ناقوس الخطر

تحذير.. زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة
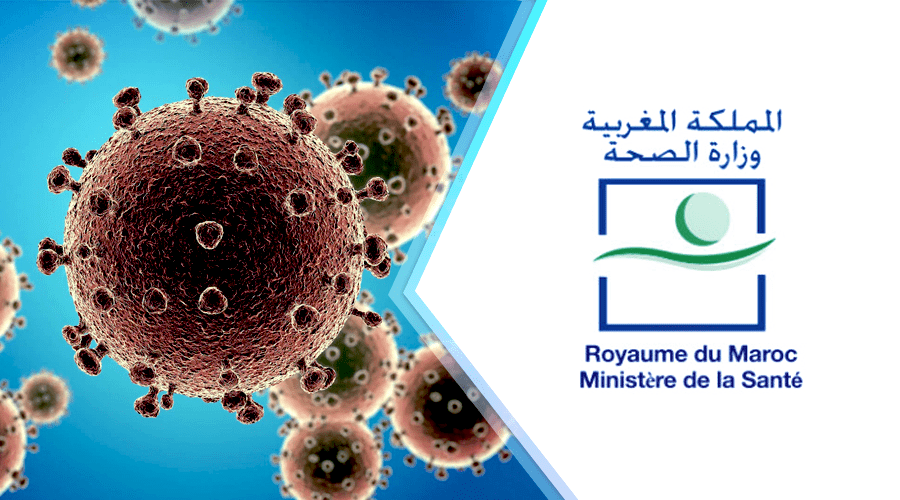
93 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و210 حالات شفاء

احتجاجات مغاربة عالقين بإسطنبول.. القنصلية المغربية توضح

ابن الوزير السابق خالد الناصري يحكي كواليس رحلة عودة مغاربة من إيطاليا باتجاه طنجة عبر الباخرة

7 متهمين بالاختطاف والمطالبة بفدية مالية بكلميم في قبضة الأمن

الانتقال إلى الثانية باكالوريا بنقط المراقبة فقط وهذا موعد الجهوي

كورونا بالمغرب.. 283 إصابة و144 حالة شفاء و4 وفيات خلال 24 ساعة

المحكمة تصدم وزير الصحة وتلغي قرار إعفاء مندوبه الإقليمي بقلعة السراغنة

يهم المتقاعدين... أداء مسبق لمعاشات شهر يوليوز بمناسبة عيد الأضحى

وجبة غداء ترسل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستعجلات بتطوان

اتفاق مغربي-سويسري من أجل تطوير شروط سياحة مستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة

هذه خطة المغرب لاقتحام مجال الصناعة العسكرية

نزع حلقات العيد عن 58 خروفا في ملكية كساب بسبب فضلات الدجاج

وزارة التعليم تفتح باب إيداع الشكايات حول تصحيح أخطاء الباكالوريا

سفارة المغرب بمدريد تكشف تاريخ إعادة 7100 عاملة فراولة مغربية

رباح: سيتم مراجعة الاستهلاكات التقديرية المفوترة من قبل مكتب الكهرماء
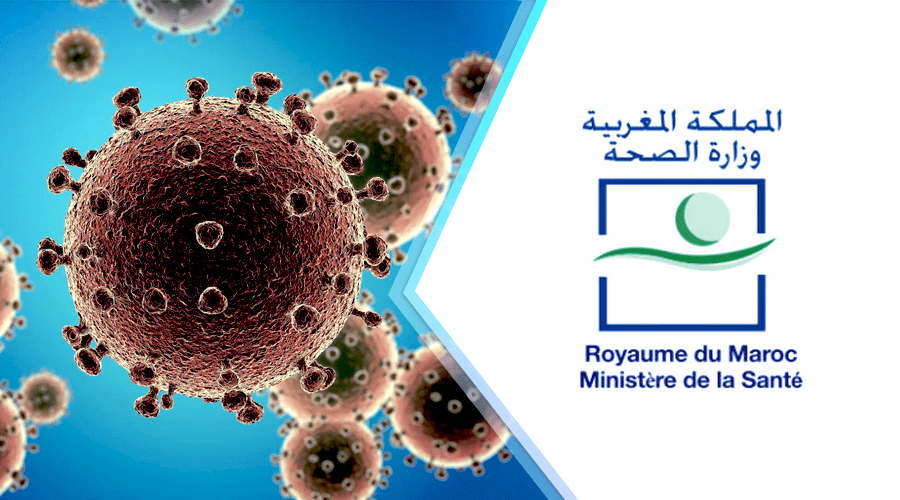
162 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و75 حالة شفاء

بوعياش تهنأ الديلمي على انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين

تعيين المغربي الخمار المرابط عضوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

السجن والغرامة لبرلماني عن البام بتهمة الارتشاء

هكذا يخطط 24 حزبا لعزل البيجيدي

التاجموعتي يقدم تقريرا حول وضعية تقدم أشغال الاستراتيجية العقارية للدولة أمام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية

كورونا بالمغرب.. 165 إصابة و379 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

الإعلان عن موعد إعادة عاملات الفراولة المغربيات العالقات بإسبانيا

هذه نسب النجاح في الدورة العادية للباكالوريا لهذه السنة

هذه أبرز محاور تقرير مجلس المنافسة الذي رفعه الكراوي إلى الملك

السجن للمتهمة الرئيسية في ملف التوظيفات المزورة بالوقاية المدنية

قرارات صارمة من الداخلية لتطويق كورونا وحديث عن احتمال العودة للحجر الشامل
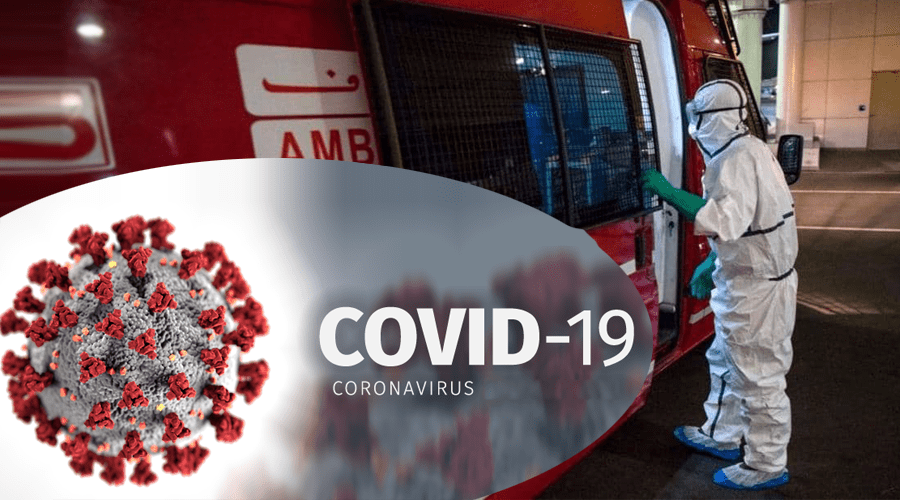
عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا بالمغرب يعاود الانخفاض

اكتشاف أجسام مضادة قادرة على تحييد فيروس كورونا

اكتظاظ بشواطئ البيضاء وغياب للتدابير الاحترازية

84 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و 224 حالة شفاء

المغرب يجهز سفينتين بمختبرات للكشف عن كورونا في صفوف المغاربة العائدين

مندوبية السجون تكشف حقيقة منع عائلات من زيارة ذويهم بسجن عكاشة

المكتب الوطني للمطارات يضع مخططا لاستقبال آمن وصحي للمواطنين

الأوقاف تشرع في الفتح التدريجي لـ5000 مسجد بالمغرب

مقتل 10 أشخاص في حادث سير مروع ببوجدور

وزير الصحة يؤكد خروج الوضع عن السيطرة ببعض المناطق ويحذر من التراخي

باشا سابق يضع حدا لحياته شنقا بخريبكة

لفتيت يؤكد إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بسبب كورونا ويتوعد بمتابعة المسؤولين

هذا سبب إقصاء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية العبور الاستثنائية

تأجيل جميع الاحتفالات المتعلقة بعيد العرش والملك يوجه خطابا للأمة مساء 29 يوليوز

161 إصابة بكورونا و508 حالات شفاء وحالتي وفاة بالمغرب خلال 24 ساعة

العزل والمتابعة القضائية في انتظار رؤساء جماعات ونواب

300 ملف أمام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية

هكذا أطاحت فرقة مكافحة العصابات في الرباط بفتاة تتزعم عصابة الأطوسطوب

نشرة خاصة.. طقس حار ابتداء من غد الأربعاء بعدد من مناطق المملكة

هذا ما أسفر عنه لقاء رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالوزير الفردوس

تحذيرات من موجة كورونا ثانية قد تودي بحياة 120 ألف شخص في بريطانيا
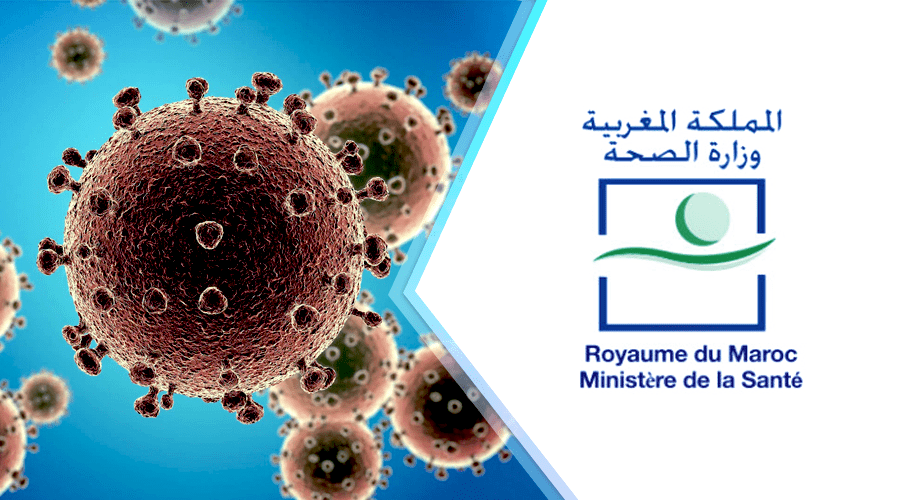
469 حالة شفاء و 111 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الـONCF يكشف موعد استئناف رحلات القطارات من وإلى طنجة

على غرار طنجة.. الداخلية تؤكد اللجوء لإغلاق الأحياء التي قد تشكل بؤرا وبائية

العفو الدولية تخسر قضية الراضي أمام القضاء لغياب الأدلة

إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا من مهامه

رئيس مجلس المنافسة يرفع تقريره إلى الملك

توقيف صحافيين يعمق أزمة ميدي 1 تيفي

كورونا بالمغرب.. 191 إصابة و651 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة

تعليق رحلات القطارات من وإلى طنجة ابتداء من اليوم الاثنين

عيد الأضحى.. ترقيم أزيد من 2ر7 مليون رأس من الأغنام والماعز

لارام تعلن توسيع عملية بيع تذاكر الرحلات الخاصة

83 مليونيرا عبر العالم يوقعون نداء للمطالبة بفرض ضرائب أكثر عليهم

رسميا.. هذا تاريخ أداء الدفعة الثالثة من الإعانات المقدمة للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل

فرض الإغلاق الكامل بطنجة ابتداء من اليوم بعد ظهور بؤر كورونا جديدة

زيارات مفاجئة للسلطة لمطاعم راقية بكورنيش البيضاء تكشف عدم احترام شروط السلامة الصحية
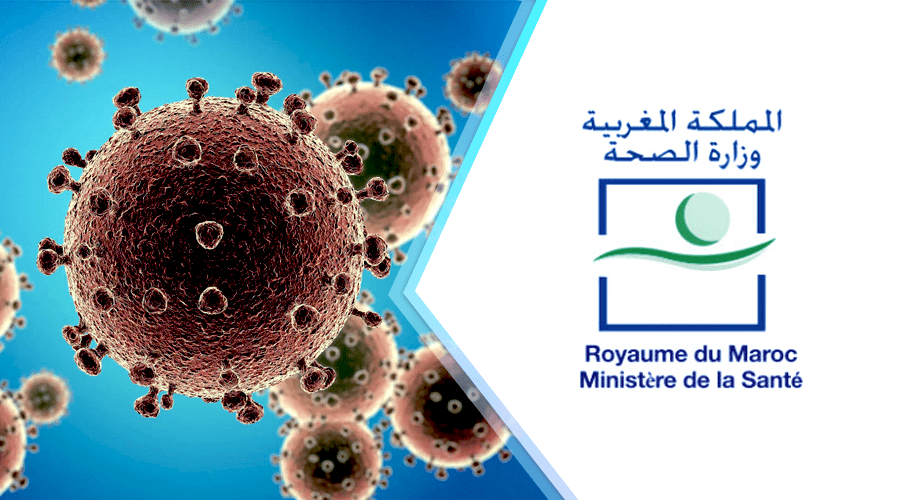
تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و393 حالة شفاء

بؤر وبائية تعيد أحياء بطنجة للحجر من جديد ومغادرة سكانها بيوتهم يتطلب استصدار رخصة

كورونا بالمغرب.. 203 إصابات و218 حالة شفاء و5 وفيات خلال 24 ساعة

تقرير أممي يحمّل الجزائر مسؤولية ما يقع في تندوف وهكذا تأسست البوليساريو

التحقيق في وفاة سيدة كانت رفقة شرطي في ظروف مشكوك فيها

طرائف الباك بالمغرب.. من السخرية إلى المحاكم وقبة البرلمان

نشرة خاصة.. طقس حار يومي الأحد والاثنين بهذه المناطق من المملكة

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بفاس
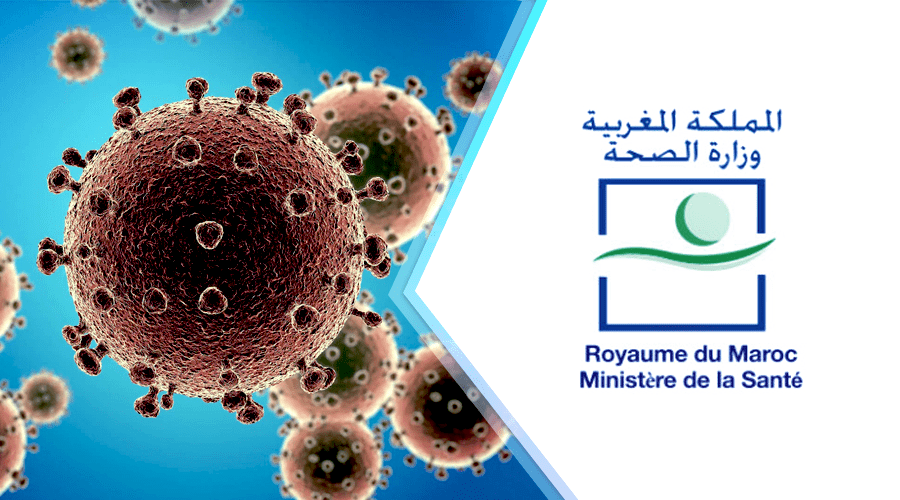
تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و147 حالة شفاء

إطلاق النار لإيقاف مجرم بالقصر الكبير هدد الشرطة بسيف

استقالات بالجملة تضرب المجلس الوطني لهيئة الأطباء

هذه توجيهات لارام للمعنيين بالرحلات الخاصة

دراسة تكشف العلاقة بين لقاح السل والمناعة ضد كورونا

وزارة الخارجية تكشف شروط الولوج إلى التراب الوطني
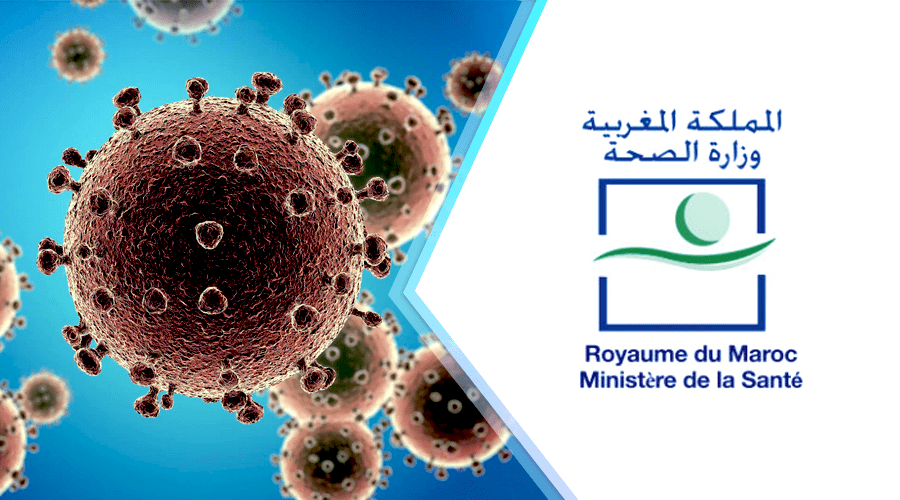
136 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و68 حالة شفاء

مختبر جديد لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان

الإطاحة بشبكة متخصصة في إعداد الأجوبة لغشاشي البكالوريا

كورونا بالمغرب.. 249 إصابة و380 حالة شفاء ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

صفوف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتعزز بملتحقين جدد وتحضر لاجتماع مع وزير الاتصال

الحكومة تمنح هدية للمنعشين العقاريين

فضيحة صفقة اقتناء أجهزة للكشف عن كورونا بـ20 مليار تهز وزارة الصحة

تفاصيل الإطاحة ببارون مخدرات أطلق النار على الجمارك قبل 5 سنوات

لفتيت: إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للسلطات العمومية

العثماني يعلن دخول المغرب المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر

ضبط 736 حالة غش خلال المحطة الثانية من امتحانات الباكالوريا

نشرة خاصة.. طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة

لفتيت: عودة مغاربة الخارج ستنعش السياحة وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق
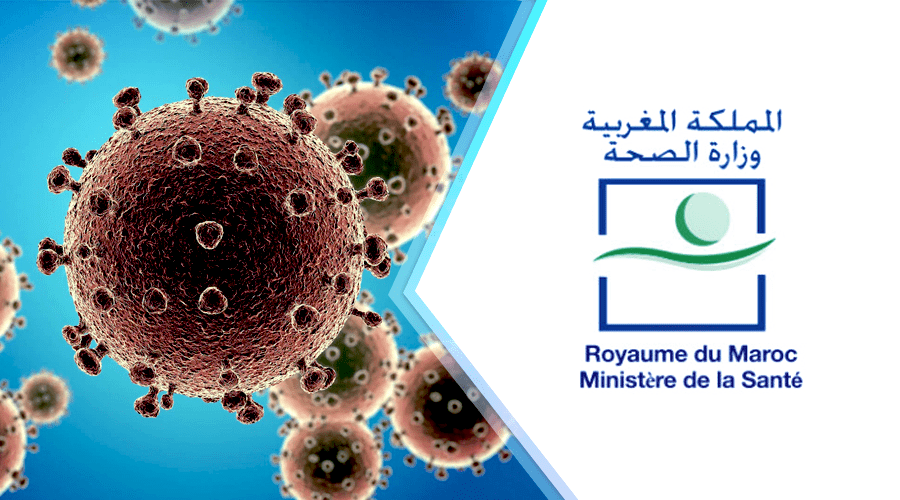
تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و258 حالة شفاء

السلطات الأمريكية تخطط لتطعيم لقاح كورونا للسود واللاتينيين قبل الجميع

غضب بالقنيطرة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء و4000 نسمة تسائل رباح

هذا ما اتفقت عليه لارام مع ممثلي المهنيين المعنيين بالمغادرة الطوعية

308 إصابات بكورونا في المغرب و131 حالة شفاء خلال 24 ساعة

هذه هي الفئات المعنية بالولوج أو مغادرة المغرب ابتداء من 14 يوليوز

توضيحات لارام بخصوص برنامج رحلاتها الاستثنائية

الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لشهر إضافي

243 مليون درهم خسائر المقاولات الصحافية خلال الثلاث أشهر الأخيرة بسبب كوفيد

إصابة حوالي 20 عاملة زراعية في حادث انقلاب بيكوب ضواحي أكادير

فقدان 12 بحارا بعد غرق مركب للصيد بسواحل أكادير

هكذا تمكنت السلطات من إجهاض محاولات تسريب امتحانات الباك عبر واتساب
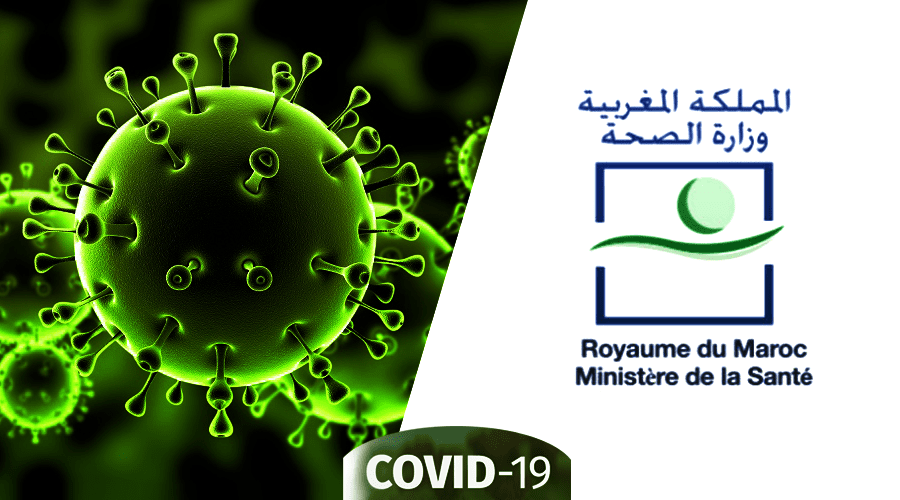
تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و56 حالة شفاء

هذه تدابير عيد الأضحى بالمغرب في زمن كورونا

السياح الأجانب غير معنيين بقرار فتح الحدود المغربية يوم 14 يوليوز

الداخلية تحقق في أسباب انقطاع الكهرباء على أحياء بالدار البيضاء

المغرب يفتح حدوده البحرية والجوية اعتبارا من 14 يوليوز

مجلس جهة فاس مكناس يصادق على قرض بقيمة 30 مليون دولار

بعد فضيحة الرميد وأمكراز.. لجنة تابعة لـCNSS تحل بمكتب لشكر

المحكمة تستدعي الجمارك في ملف كوكايين الهرهورة

164 إصابة بكورونا و677 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرة خاصة.. الحرارة تصل إلى 49 درجة بهذه المناطق من المملكة

الـONEE ينفي مسؤوليته عن انقطاع التيار الكهربائي بالبيضاء

انقطاع في التيار الكهربائي يتسبب في توقف ترامواي البيضاء
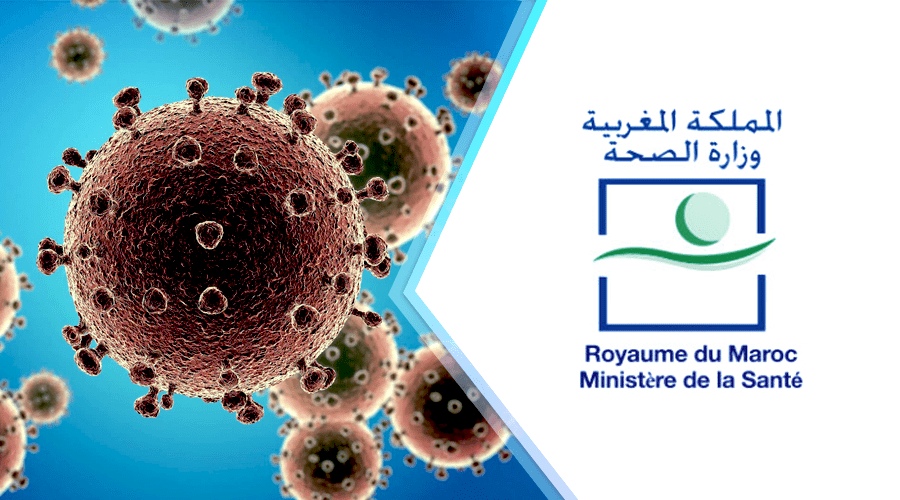
تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و209 حالات شفاء

58 محطة طرقية و113 مقاولة للنقل الطرقي استأنفت عملها

الولايات المتحدة تسجل أزيد من 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
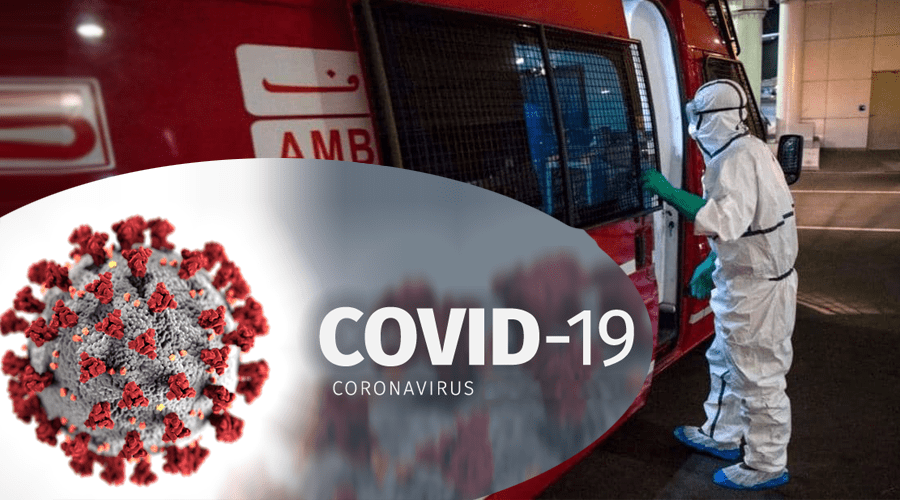
وزارة الصحة تكتفي بالحجر الصحي المنزلي للمصابين الجدد بكورونا

كورونا بالمغرب.. 228 إصابة و466 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

مصالح الحموشي تطيح بـ5 متهمين بقتل عشريني بعد تعذيبه

إغلاق مقاهي لم تحترم الإجراءات الاحترازية بالقنيطرة

إعادة تطبيق الحجر الصحي على موظفي 3 مؤسسات سجنية

رسميا.. إعادة فتح المساجد بالمغرب في هذا التاريخ

الأمير مولاي الحسن ينال شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا

الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء

تكثيف التحقيقات في سرقة الرمال بتطوان تؤرق سياسيين بالمنطقة

الإطاحة برجل أعمال تزعم عصابة لسرقة فيلا صديقه

هذه ظروف ترحيل عائلة أبو عبد الله التي كانت عالقة بالفلبين

تحذير... درجات الحرارة ستتراوح اليوم ما بين 47 و 49 درجة

وزير الصحة يدعو لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي موجة كورونا ثانية

إدارة الدفاع الوطني ستتكلف بتكوين ربابنة لارام
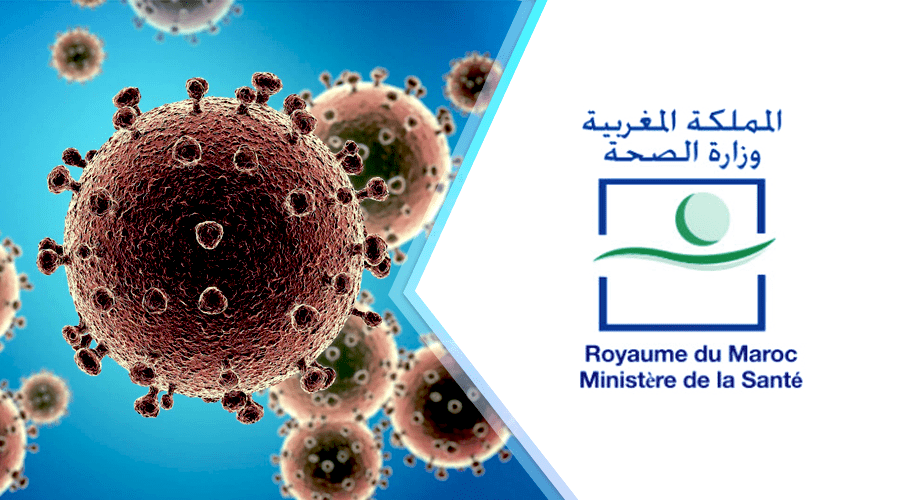
تسجيل 186 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و108 حالات شفاء

تفكيك خلية إرهابية وتوقيف 4 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة
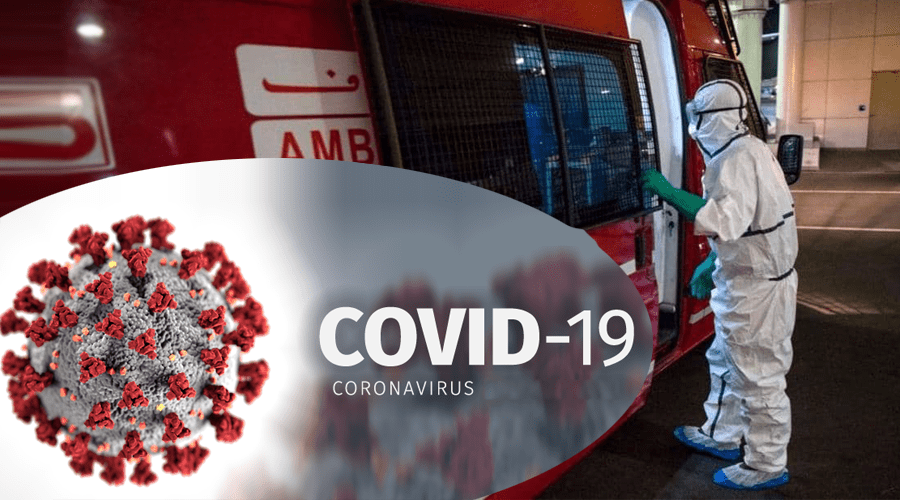
إعادة التحليلات المخبرية تكشف ظهور إصابات جديدة بكورونا بسيدي سليمان

المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين عسكرية واتفاقيات دولية

الملك سأل وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية بعد تخفيف الحجر الصحي

كورونا بالمغرب.. 164 إصابة و448 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

السجل الاجتماعي الموحد للسكان يدخل حيز التطبيق في هذا التاريخ

السجن لطبيب متدرب بتهمة اختطاف أمريكية واحتجازها بالعنف واغتصابها

رئيس مجلس وزان يتهم مفتشية الداخلية بنشر الإشاعات واستهدافه

هذه نسبة مطابقة مياه الشواطئ المغربية لمعايير الجودة

امتحانات الباكالوريا.. تعقيم 400 ألف إنجاز قبل تسليمها لـ4000 أستاذ مصحح

الشروع في إعادة 278 من المغاربة العالقين في سلطنة عمان وقطر والأردن

الاتحاد المغربي للشغل يدخل على خط أزمة ميدي 1 تيفي وهذه رسالته لخيار

تسجيل إصابات جديدة بكورونا بالسجن المحلي لطنجة

تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و112 حالة شفاء

مفكرون وسياسيون ورياضيون مغاربة اختاروا الرجوع إلى الوطن

تسجيل صوتي لمريض بكورونا يكشف حقائق مثيرة عن انتشار الوباء بسيدي سليمان

كورونا بالمغرب.. 393 إصابة و396 حالة شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة

هذه قصة محاولة تفجير تمثال ليوطي بقنبلة في المغرب

وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية أثناء نقله للمستشفى بالبيضاء

ضبط 1107 حالات غش خلال المحطة الأولى من امتحانات الباكالوريا

إغلاق أسواق ومصانع ومنع التنقل.. هذه تدابير سلطات آسفي للسيطرة على كورونا

وصول 303 من المغاربة العالقين بكندا إلى مطار أكادير

نشرة خاصة.. موجة حر شديدة بالعديد من مناطق المملكة

الداخلية تفرض الإغلاق الكامل بمدينة آسفي بعد ظهور بؤرة وبائية
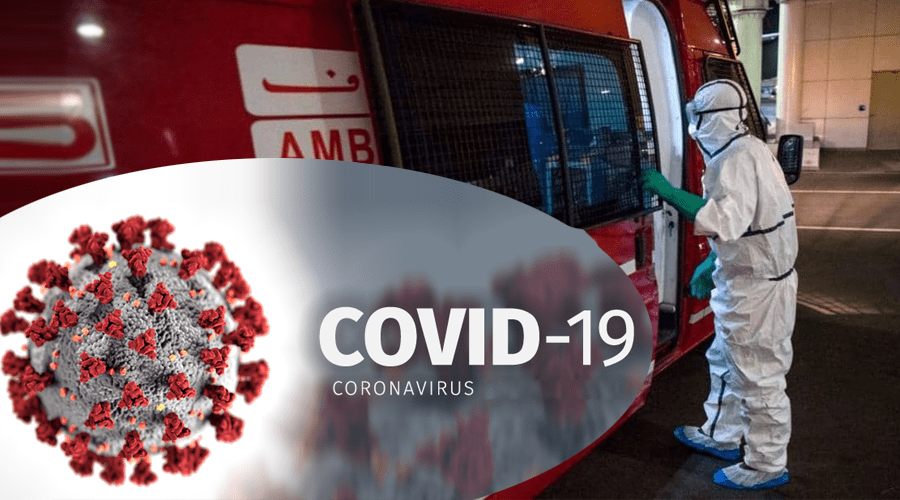
هذا هو التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة بالمغرب

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بالقنيطرة

إصابة الدولي المغربي أمرابط بفيروس كورونا
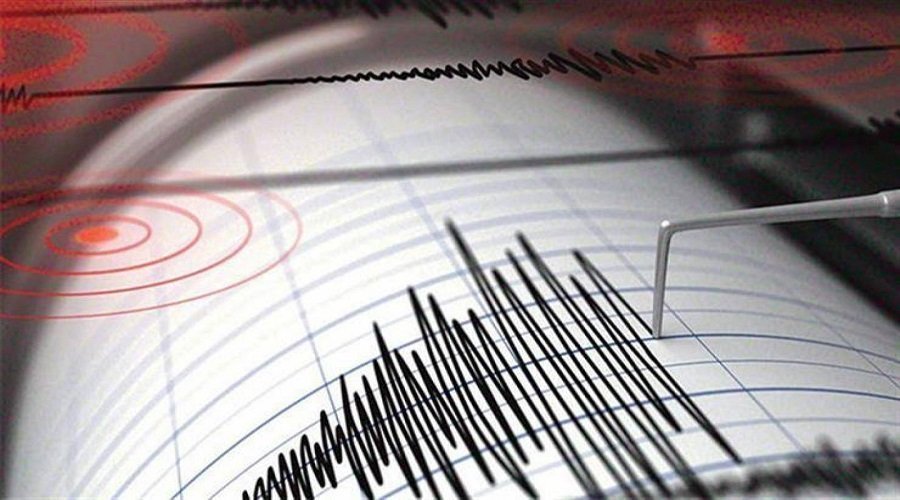
تسجيل هزة أرضية بإقليم تاونات
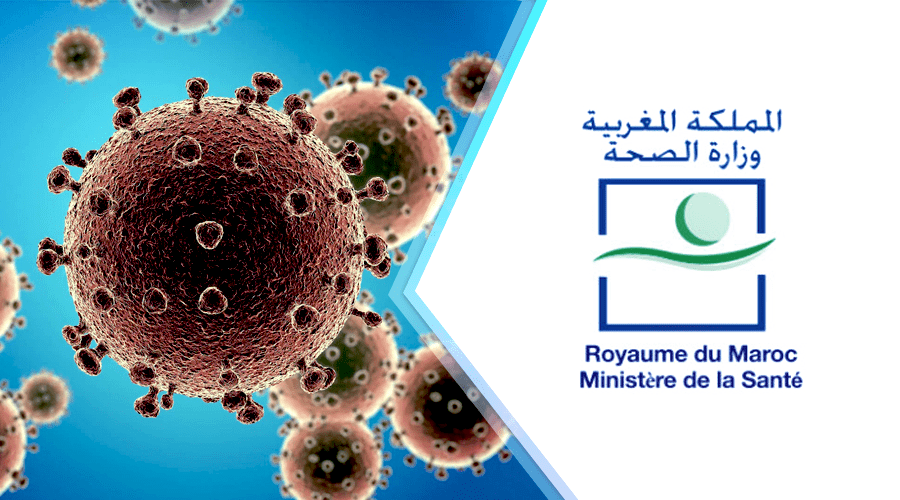
310 إصابات جديدة بكورونا بالمغرب و81 حالة شفاء

إحالة موظف شرطة على النيابة العامة بتهمة التوظيف الوهمي

مديرية الأمن تكشف حقيقة فيديو تعرض مستعملي طريق سيار للسرقة

أكثر من 200 عالم يشككون في روايات منظمة الصحة حول انتشار كورونا

كورونا بالمغرب.. 534 إصابة و169 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة
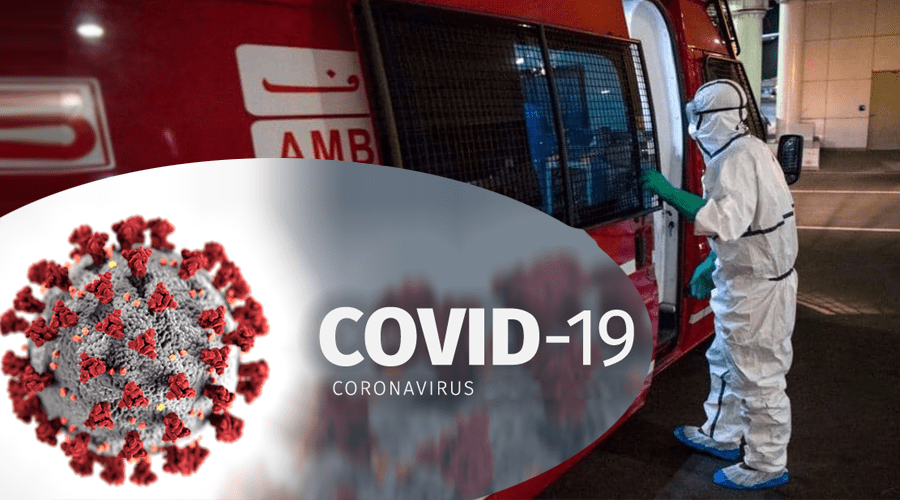
هذا هو التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة بالمغرب

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض سلامة عناصر الشرطة للخطر بالمحمدية
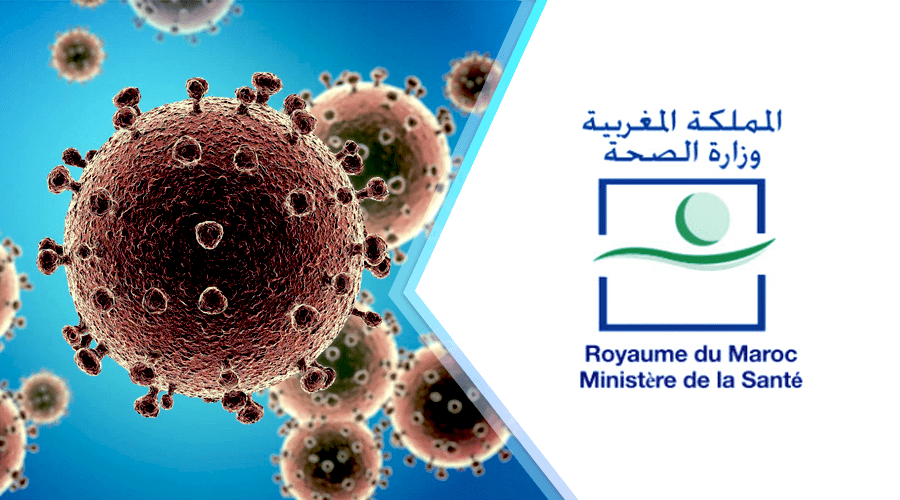
تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و54 حالة شفاء

نزيل بدار للعجزة يشكو حرمانه من أدويته وتعرضه للضرب والسرقة

نشرة خاصة.. الحرارة تصل إلى 48 درجة بهذه المناطق من المملكة

أمانة "البيجيدي" تؤكد ما نشرته جريدة الأخبار وتقر بارتكاب الوزيرين الرميد وأمكراز لمخالفة قانونية

الاستقلال يسائل وزير الشغل حول ظروف اشتغال العاملين بميدي 1 تيفي

"جون أفريك" تسلط الضوء على التدبير النموذجي للملك في الاستجابة للجائحة

المكتب الوطني للسكك الحديدية: 350 ألف مسافر منذ 25 يونيو المنصرم

احتجاجات ترافق اقتراب افتتاح المحكمة الابتدائية الجديدة لطنجة

مرافعات خارج الموضوع توقف زيان عن الترافع لمدة سنة

توزيع 50 ألف قناع واق على مرشحي البكالوريا بجهة طنجة وتخصيص حافلات بالمجان

تداعيات أزمة الاحتجاجات والتوقيفات بـ"ميدي1 تيفي" تصل للبرلمان

وصول 152 من المغاربة العالقين بمصر إلى مطار بني ملال
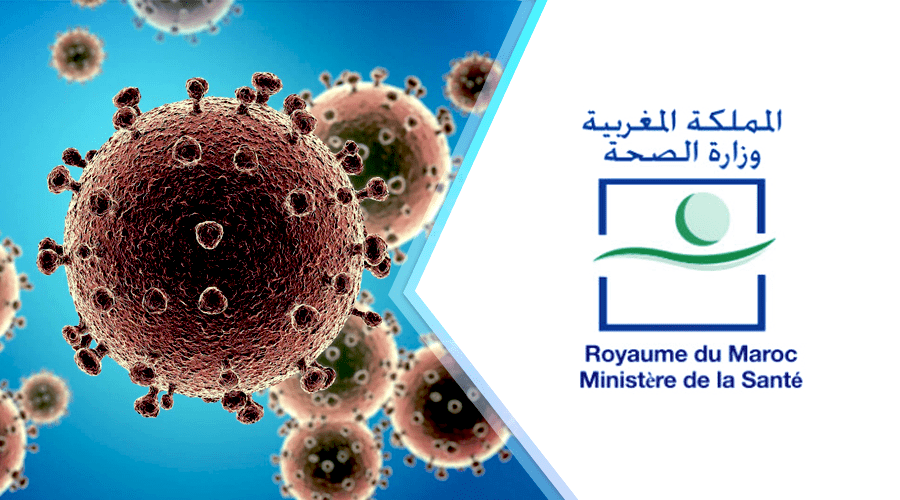
تسجيل 246 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و68 حالة شفاء

فواتير كهرباء وماء مضاعفة 5 مرات بعد الحجر

حادثة سير تنهي حياة نائب والي أمن القنيطرة

تطورات جديدة في ملف شبكة الاستيلاء على عقارات بتطوان
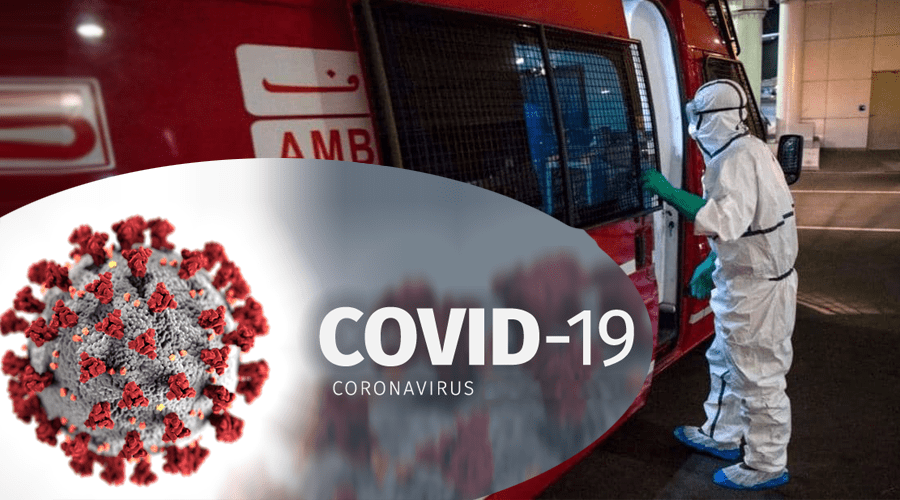
كورونا بالمغرب.. 333 إصابة و64 حالة شفاء ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

استمرار كبير في سحب السيولة من البنوك بسبب الأزمة

الخطوط الملكية المغربية تعزز تدريجيا برنامج رحلاتها الداخلية

هكذا يشتغل 35 مكتبا دوليا للمحاماة خارج القانون بالمغرب

الحكومة تُوقف التوظيف في 2021 باستثناء هذه القطاعات

في زمن كورونا.. لفتيت والحموشي وحرمو يتجندون لإنجاح استحقاق الباكالوريا

شكاوى حول عيوب في أشغال للإنارة العمومية بطنجة

قائد بسيدي سليمان يتسبب في مصرع مواطن في حادثة سير
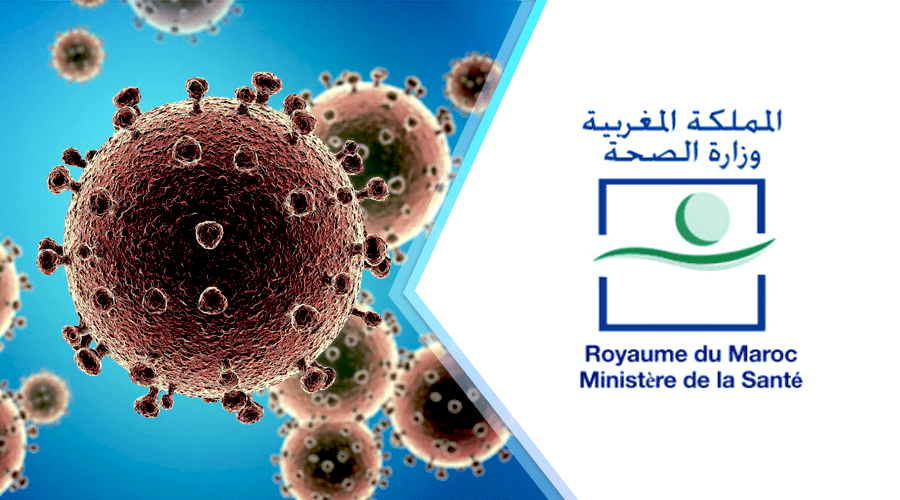
تسجيل 218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و26 حالة شفاء

هذا ما قرره قاضي التحقيق في ملف تصاميم البناء المزورة بفاس

هكذا سيجتاز التلاميذ المصابين بكورونا امتحانات الباكالوريا بالمغرب

لجنة تابعة لوزارة الصحة تحل بمستشفى طنجة لتباحث مسألة تحوله لبؤرة كورونا

كورونا بالمغرب.. 103 إصابات و106 حالات شفاء خلال 24 ساعة

ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 6,5 في المائة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين : لا مجال للرد على المشككين والوقت وقت عمل والمحاسبة تكون على النتائج

شركة تدبير مطرح أم عزة بالرباط تعلن التوقف عن استغلاله

مهنيو النقل الطرقي يعلنون إلغاء مسيرتهم الوطنية ويكشفون السبب

إعادة آخر مجموعة من المغاربة العالقين في اليابان
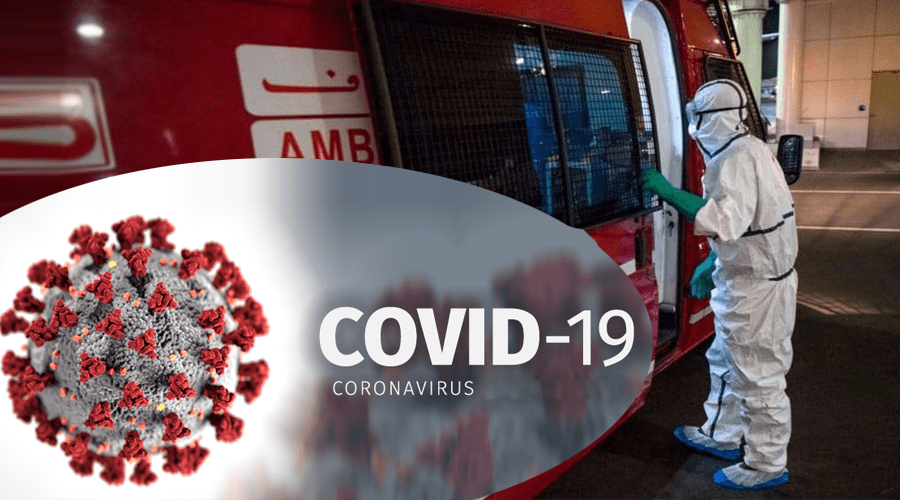
هذا هو التوزيع الجغرافي لإصابات كورنا الجديدة بالمغرب

المستشفى الجهوي لطنجة يتحول لبؤرة للفيروس بعد تسجيل 14 إصابة في صفوف الأطر الطبية
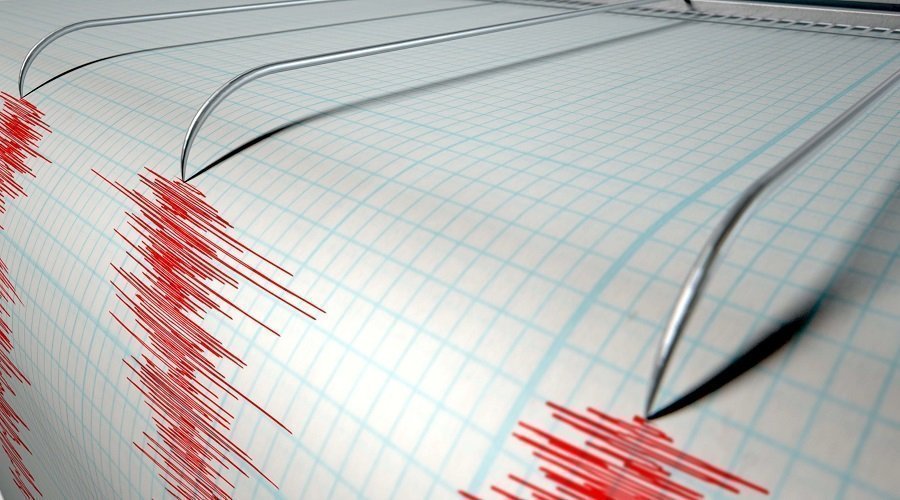
تسجيل هزة أرضية بإقليم تاونات
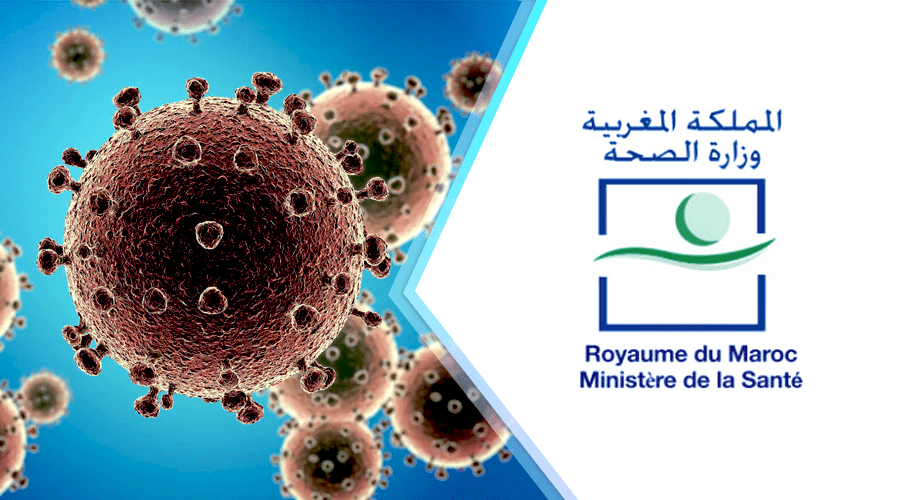
تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و58 حالة شفاء

هذه مواعيد امتحانات الباكالوريا

ايكينوكس تعلن نقل التلاميذ المعنيين بامتحانات الباكالوريا مجانا

صحافيو ومهنيو قناة ميدي 1 تيفي بالرباط وطنجة ينتفضون ضد المدير العام

كورونا بالمغرب.. 243 إصابة و87 حالة شفاء و3 وفيات خلال 24 ساعة

أمن طنجة يطيح بشخص متورط في ترويج أجهزة معلوماتية للغش في الامتحانات

الجمعية المغربية للإعلام والناشرين تشكّل مكتبها التنفيذي

استنفار بالعيون بعد فرار مصاب بكورونا من المستشفى

غرق أربعة أشخاص مع انطلاق موسم الاصطياف

اختلاس مليار ونصف من وكالة بنكية يطيح بمسؤول جهوي سابق ومستخدمة

الداخلية تسمح بكراء العقارات السلالية بهذه الشروط

نشرة خاصة.. الحرارة تصل إلى 46 درجة بهذه المناطق
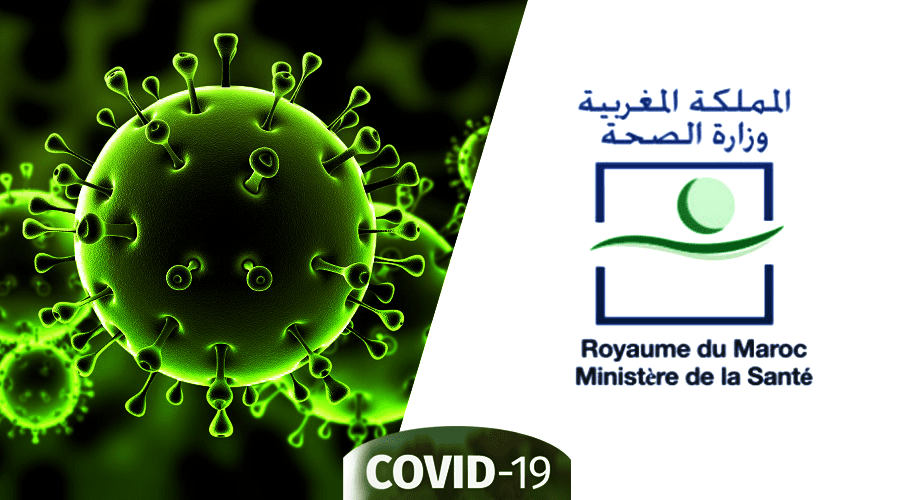
تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و6 حالات شفاء

سلطات سيدي سليمان تلجأ للقوة العمومية لمنع عودة مظاهر احتلال الملك العام

الأمم المتحدة تستنكر ظروف اشتغال عاملات الفراولة المغربيات بإسبانيا

كورونا بالمغرب.. 238 إصابة و93 حالة شفاء خلال 24 ساعة

ترويج معدات إلكترونية للغش في الامتحانات يطيح بـ14 شخصا
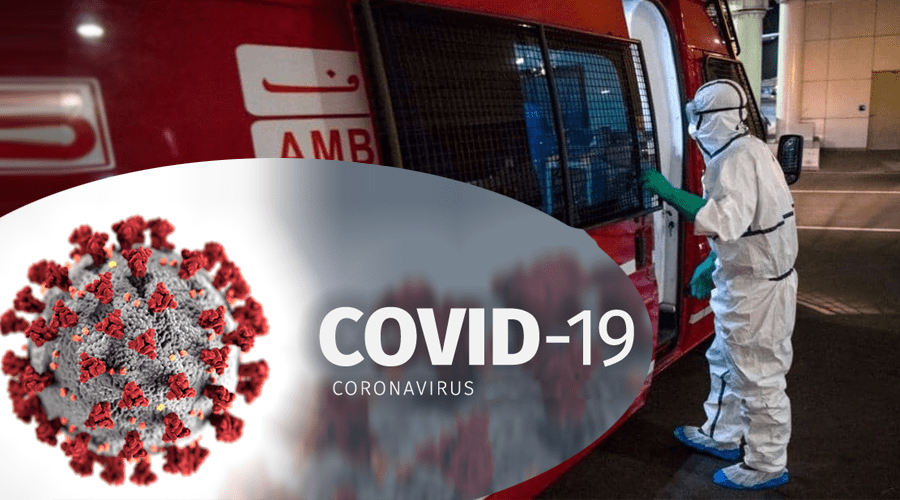
جنازة بسيدي قاسم تتسبب في إصابة مواطنين بفيروس كورونا

هذه حقيقة إعادة تصنيف عمالات وأقاليم المنطقتين 1 و 2

تفاصيل التحقيق مع مسؤولين بلجنة مراقبة الوحدات الإنتاجية بللا ميمونة

استئنافية تطوان تستدعي المتهمين في ملف فضيحة عقارية بالملايير

أستاذ متدرب يتابع تكوينه بأكاديمية جهة طنجة ينتحر بإلقاء نفسه أمام "البراق"

تفاصيل إخضاع 2000 بحار بميناء طنجة لتحليلات كورونا

أمن البيضاء يطيح بـ6 متورطين في ترويج المخدرات والاختطاف

كورونا بالمغرب.. 175 إصابة و17 حالة شفاء وحالة وفاة خلال 24 ساعة

لقاح صيني يثبت فعاليته في مواجهة كورونا

هكذا يعيش مشاهير مغاربة مع الحجر الاضطراري خارج الوطن
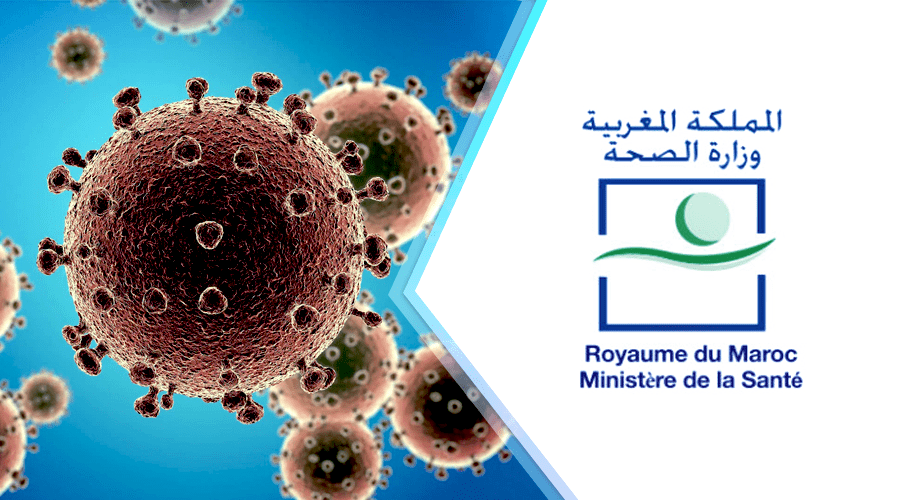
تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و7 حالات شفاء
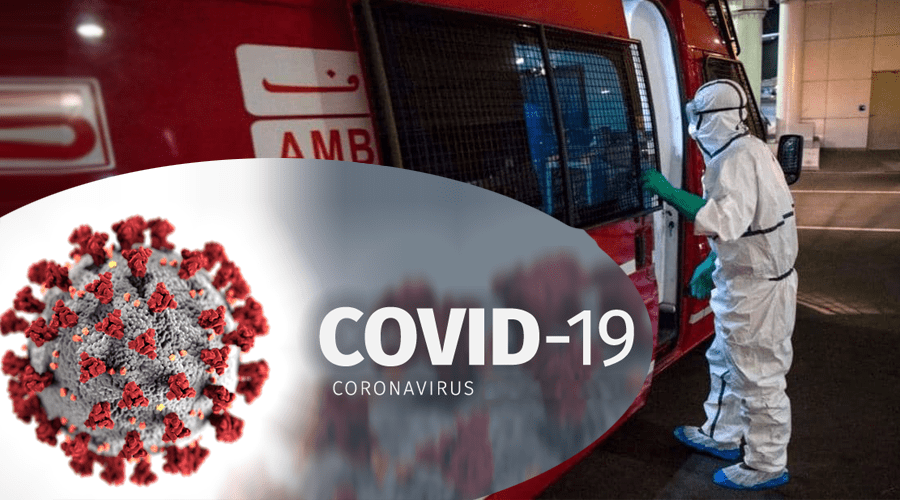
وزارة الصحة تكشف السبب وراء ارتفاع إصابات كورونا بالمغرب

كورونا بالمغرب.. 244 إصابة و67 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

إعادة 160 من المغاربة العالقين بإسبانيا

نشرة خاصة.. الحرارة تصل إلى 44 درجة بهذه المناطق من المملكة

قنصلية المغرب ببروكسيل تكشف ظروف ترحيل ابن الخياري
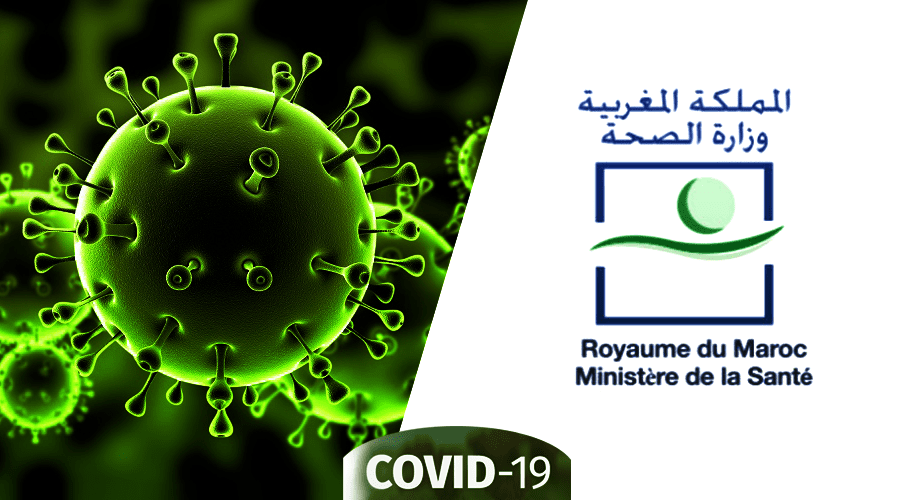
تسجيل 221 إصابة جديدة بكورنا في المغرب و44 حالة شفاء

مجلس المنافسة: قطاع الأدوية بالمغرب غارق في الاختلالات و15 مختبرا تتحكم في السوق

ارتفاع المداخيل الإجمالية الصافية للضرائب بنسبة 1,5 في المائة

كورونا بالمغرب.. 295 إصابة و156 حالة شفاء خلال 24 ساعة

تفاصيل تفكيك شبكة لتزوير السيارات يتزعمها مراسل صحافي

أول اجتماع لرئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع الوزير الفردوس يسفر عن خطة ب200 مليون درهم لإنقاذ الصحافة

شكايات احتلال الملك العام بأسواق الشمال على طاولة السلطة

سلطات الشمال تحذر من تفشي بؤر بسبب الاستخفاف بالفيروس

تفاصيل عمليات ناجحة لايقاف مبحوث عنهم للاتجار في المخدرات والسرقة بتطوان
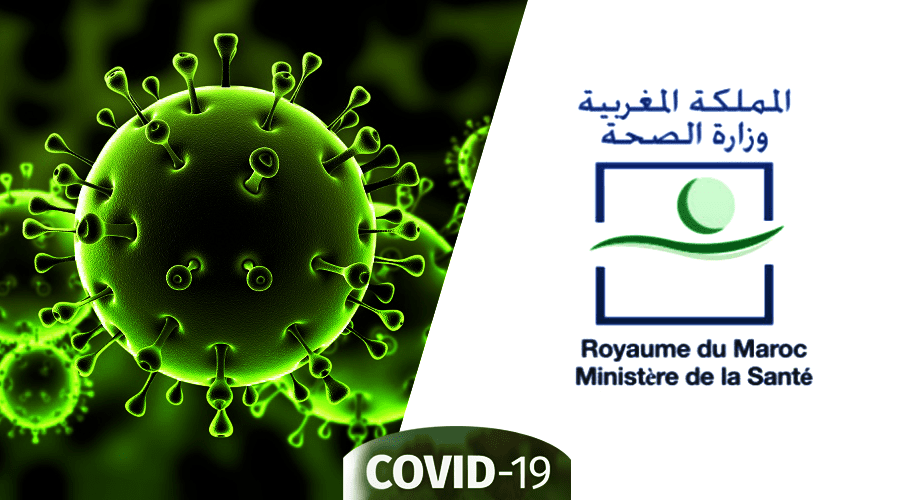
تسجيل 127 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و60 حالة شفاء

كورونا بالمغرب.. 431 إصابة و32 حالة شفاء خلال 24 ساعة

إطلاق أول رحلة داخلية بالمغرب بعد الحجر بين مطاري البيضاء والداخلة

أطباء يختبرون الماء المالح في علاج مرضى كورونا

بعد ساعات من التحقيق.. الصحافي عمر الراضي يغادر مقر الفرقة الوطنية

بالصور.. السلطات تقف على تطبيق معايير السلامة بالمقاهي والمطاعم

رئاسة النيابة العامة تأمر بتوسيع التحقيقات في ملف عقاري ونصب بالملايير
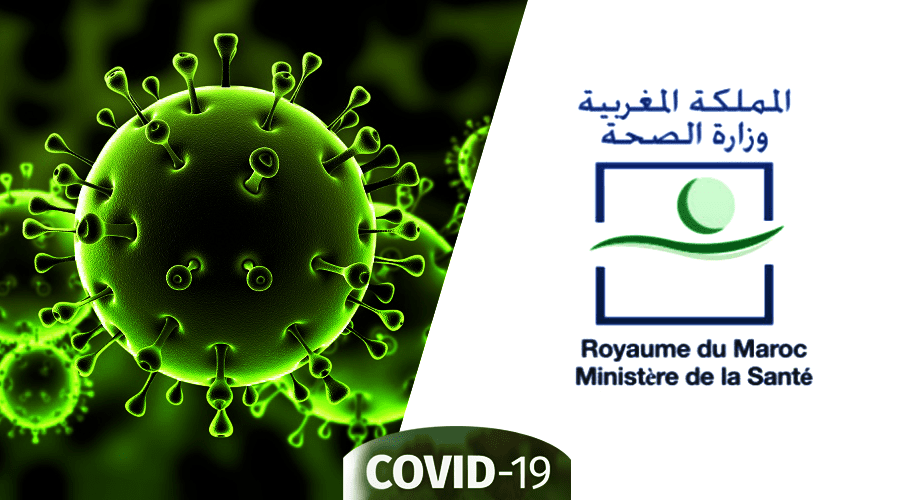
تسجيل 372 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و20 حالة شفاء
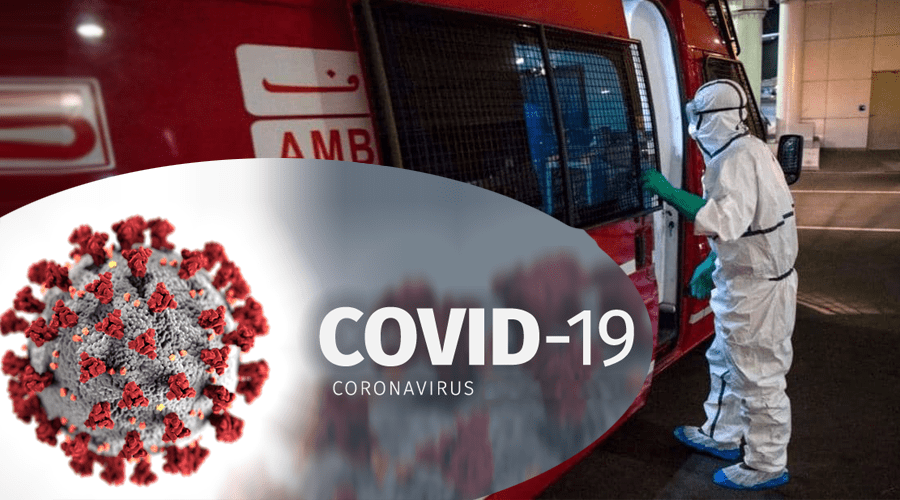
بؤرة العوامرة تتسبب في إصابة عاملات من سيدي سليمان بفيروس كورونا

النيابة العامة تحقق مع الصحافي عمر الراضي حول شبهة الحصول على تمويلات من جهات استخباراتية أجنبية

هذا تاريخ وطريقة استرجاع مصاريف الحج

كورونا بالمغرب.. 563 إصابة و61 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تختار دلمي رئيسًا لها وتشكل قيادتها للشروع في حلول لإنقاذ المهنة

توقيف 8 أشخاص بينهم جمركيان بتهم حيازة والاتجار في المخدرات

تأجيل استئناف الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية إلى هذا التاريخ
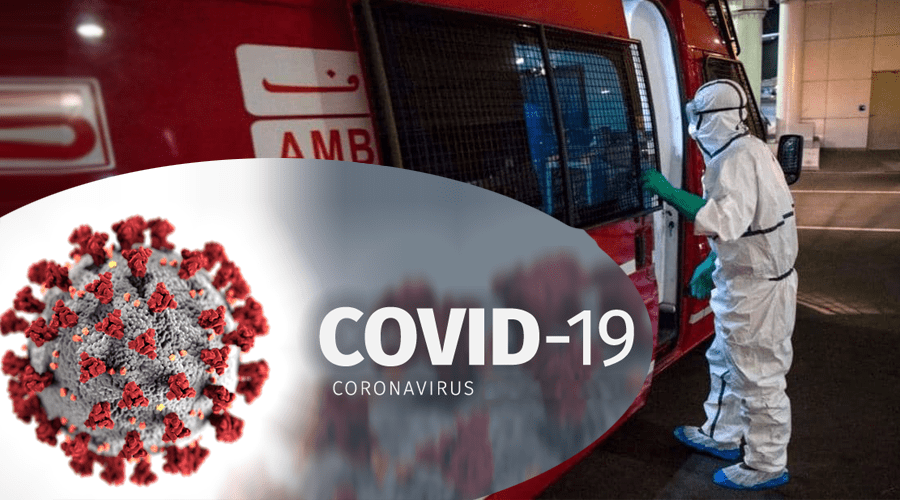
هذا هو التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة المسجلة بالمغرب

اعتقال رئيس جماعة تخصص في ارتكاب حوادث السير في حالة سكر
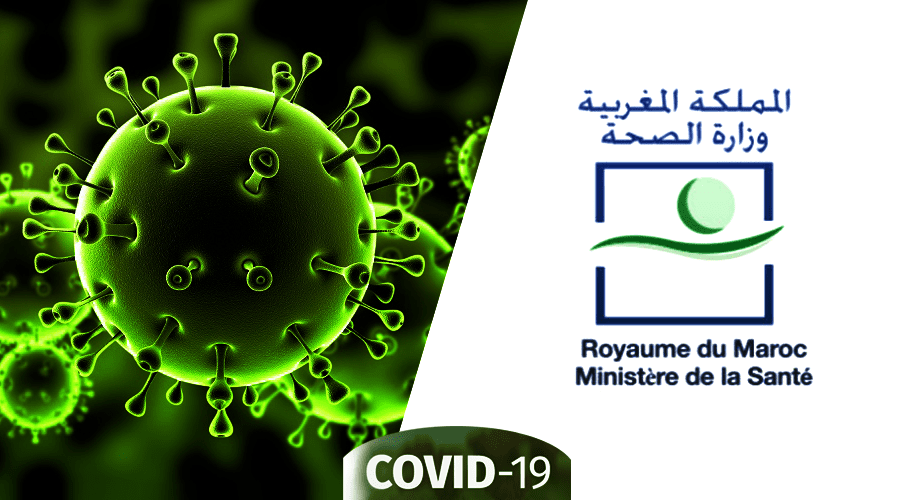
تسجيل 349 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الحصيلة إلى 10 آلاف و693 حالة

90 حالة تتلقى العلاج بتطوان ومئات التحاليل السلبية لمخالطين

قرارات جديدة للتخفيف على المواطنين من استهلاك الماء والكهرباء بطنجة تفاديا لإذكاء الاحتقان

كورونا بالمغرب.. 172 إصابة و41 حالة شفاء خلال 24 ساعة

وكيل الملك يأمر بفتح تحقيق في أسباب بؤرة للا ميمونة

الفردوس يعلن إلغاء المخيمات الصيفية بسبب جائحة كورونا

اللجنة الملكية تقرر استرجاع مصاريف الحج من الوكالات
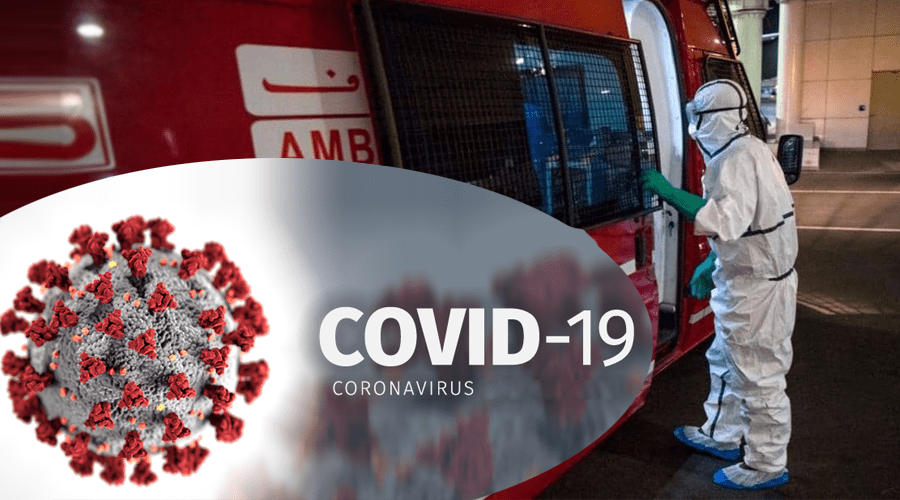
هذه حقيقة إصابة موظفي مجلس جهة الدار البيضاء بفيروس كورونا

هذه تفاصيل استئناف الرحلات الجوية والنشاط الفندقي بالمغرب

باشا يجر جمعويين للقضاء

بعد تسجيل إصابات بكورونا.. سلطات العيون تجمع مهاجرين أفارقة بمراكز للإيواء

اعتقال بلوغوز مغربية شهيرة في قضايا نصب بـ300 مليون
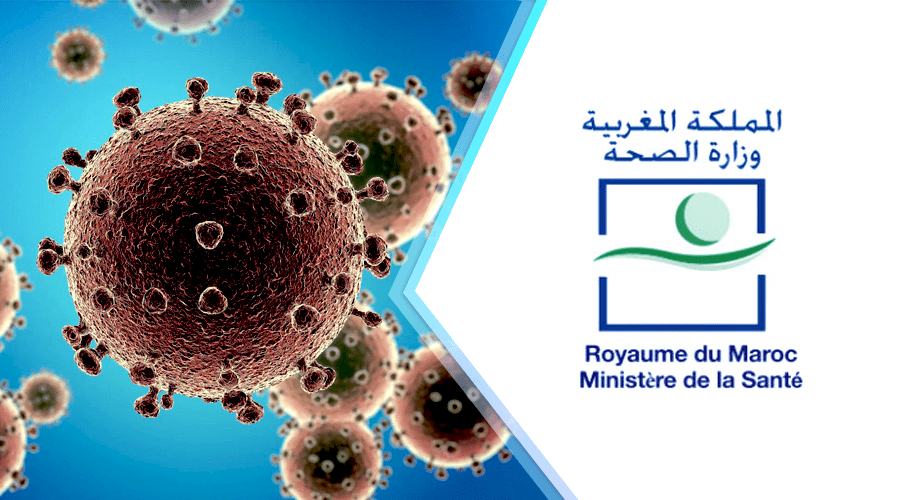
تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و18 حالة شفاء

كورونا بالمغرب.. 195 إصابة و82 حالة شفاء خلال 24 ساعة

قتيلان وجرحى في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

إعادة 151 مغربيا عالقا في تونس بسبب وباء كورونا

المغرب يشرع في إعادة 2580 من مواطنيه العالقين خلال 4 أيام

هذا ما ينتظر مخالفي إجراءات تخفيف الحجر الصحي

عودة 453 مغربيا من العالقين بتركيا بسبب كورونا

ظهور إصابات جديدة بكورونا في سيدي إفني يستنفر السلطات

وزارة الصحة تحقق في ملابسات وفاة مريضة بتطوان

السجن لمديرة بنك ورجل أعمال بتهمة اختلاس أموال عمومية
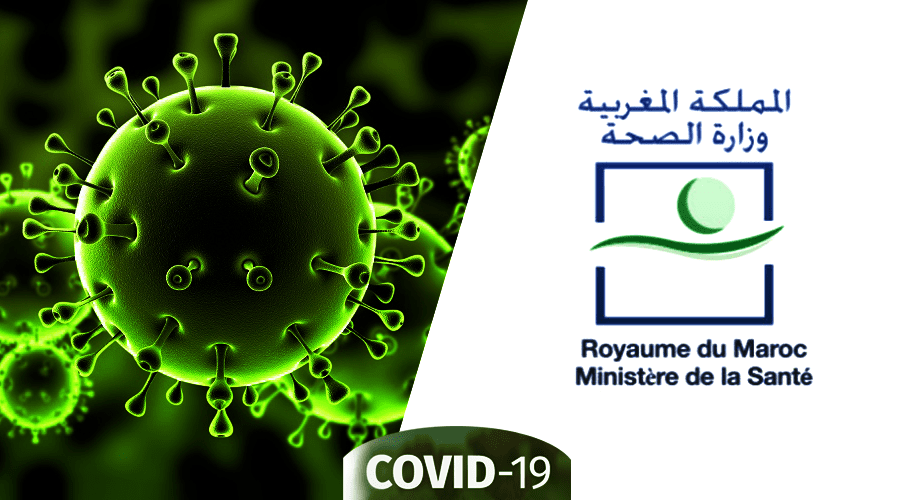
الإصابات تصل عشرة آلاف بعد تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كورونا بالمغرب.. 138 إصابة و61 حالة شفاء وحالة وفاة خلال 24 ساعة

مدير المعمل الإسباني يكشف روايته بخصوص بؤرة لالة ميمونة

مصدر : إجراءات التخفيف لا تشمل الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية

السماح بفتح المقاهي والقيساريات والشواطئ... هذه هي إجراءات رفع الحجر بالمنطقتين 1 و2
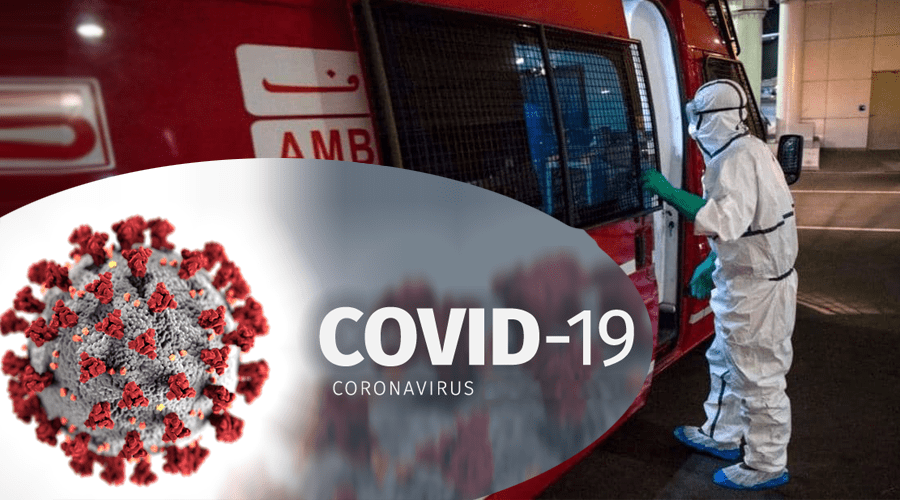
هذا هو التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة المسجلة بالمغرب

قادة دول اختاروا المغرب لتلقي العلاج والنقاهة
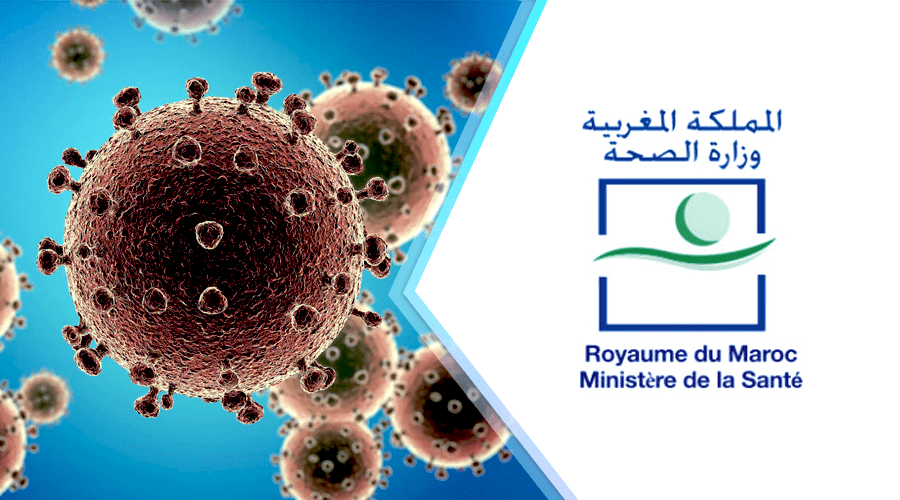
تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و26 حالة شفاء

عودة 302 مغربيا من العالقين بتركيا

لفتيت: سيتم ابتداء من اليوم الإعلان عن إجراءات تخفيف الحجر

كورونا بالمغرب.. 226 إصابة و106 حالات شفاء خلال 24 ساعة

توقيف سيدة متورطة في تلطيخ النصب التذكاري لعبد الرحمان اليوسفي

تفاصيل الإطاحة بالعلبة السوداء لشبكة كوكايين طنجة

فضيحة حرمان الوزير الرميد لكاتبته المتوفاة من الـCNSS تصل الصحف العالمية
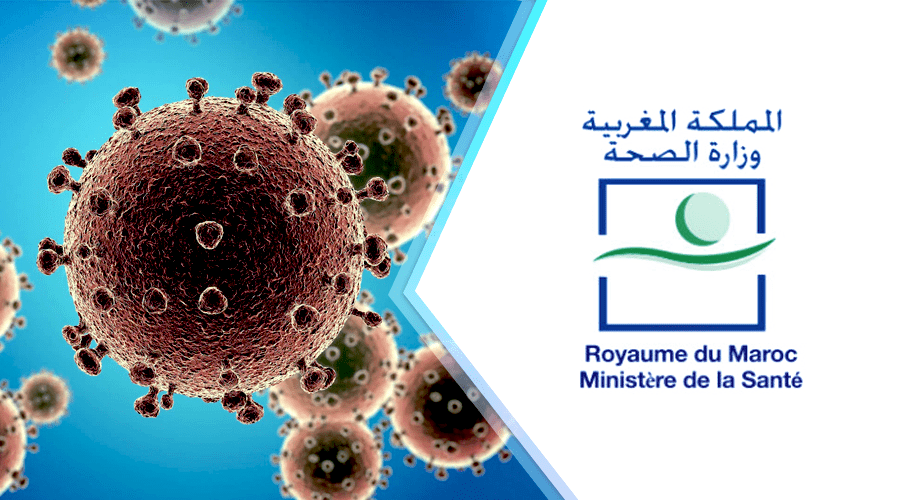
تسجيل 188 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و16 حالة شفاء

بسبب بؤر كورونا.. الداخلية تعلن تشديد القيود بهذه الأقاليم

تهيئة فضاء ثكنة عسكرية بسيدي يحيى الغرب لاستقبال مرضى كورونا

إعادة تصنيف مناطق التخفيف وهذه الأقاليم ستبقى في المنطقة2

اقتحم صيدلية بتطوان بغرض السرقة والأمن يعتقله

كورونا بالمغرب.. 539 إصابة و76 حالة شفاء خلال 24 ساعة

احتقان بسبب توزيع أموال سريا على موظفين بالصحة بأكادير

إجراءات كورونا تعيد تنظيم أسواق الشمال وفق شروط السلامة

المصالح القنصلية تتابع ملف وفاة قاصر مغربي بإسبانيا ووالدته ترفض استغلال الحادث للإساءة للمصالح الدبلوماسية

سرقة 20 طنا من الحديد واختفاء بارود يجران مستشارين ورئيس جماعة ومقاولا للقضاء

درك الخميسات يحجز 4 أطنان من زيوت محركات السيارات المقلدة
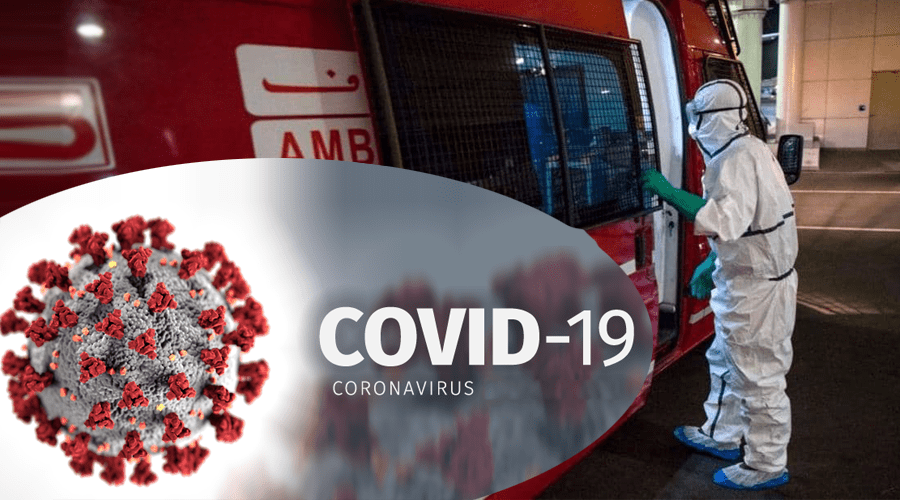
معمل فرولة يتحول إلى بؤرة كورونا وعدد الإصابات يتجاوز 600

الإعلان عن ميلاد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين
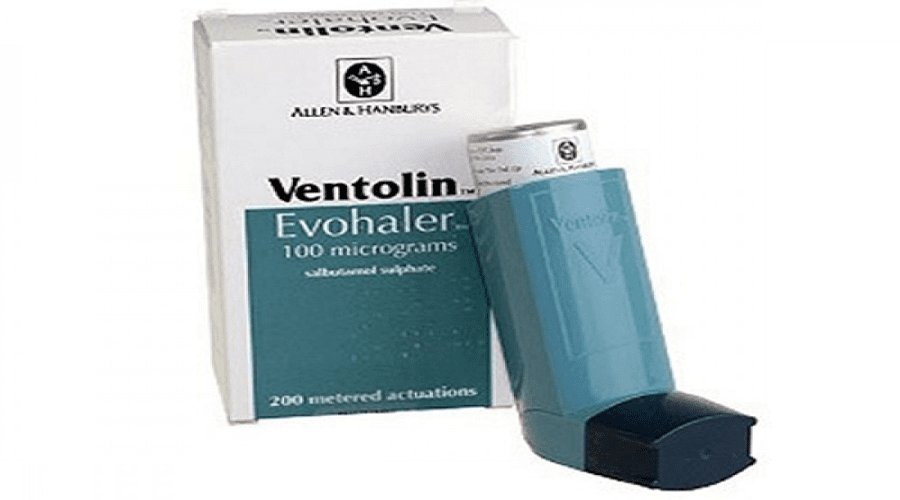
بخاخات Ventolin خارج لائحة الأدوية المعوض عنها من وكالة التأمين الصحي

وقفة حاشدة لمحامين أمام ابتدائية البيضاء احتجاجًا على إفراغ السلطات لمكتب زميل لهم

هذه تفاصيل الإطاحة بمنتحلة صفة إطار أمني للنصب

حجز أطنان من الرمال المسروقة بقيمة مليار سنتيم

تطورات جديدة في قضية الاعتداء جنسيا على طفلة بإقليم طاطا

حجز 7 أطنان و200 كلغ من المخدرات بضواحي الجديدة والمهاية

استدعاء 32 شاهدا في ملف البرلماني المتابع بالتزوير للسطو على عقارات
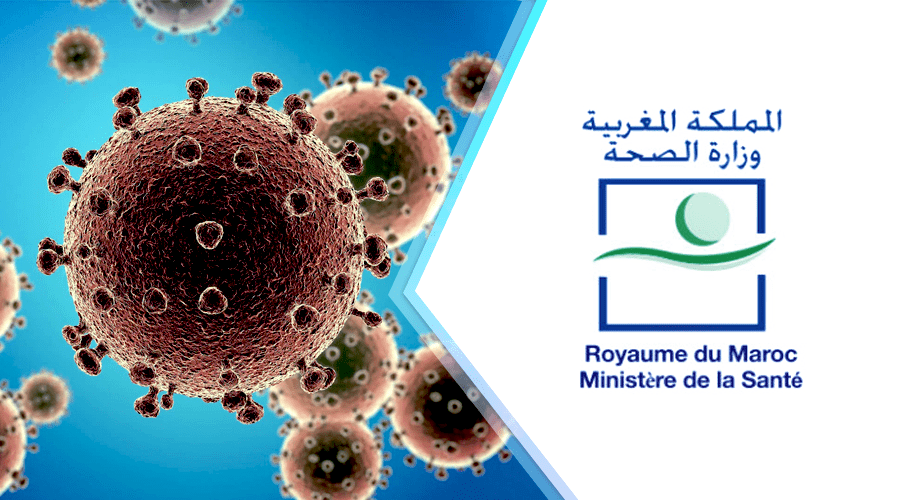
تسجيل 206 إصابات جديدة بكورونا في المغرب و40 حالة شفاء

الفيزا الفرنسية... هذا تاريخ البدء في العمل بالمصالح القنصلية وهذه أنواع الفيزات التي سيشرعون في إعطائها

الداخلية تحقق في واقعة تعرض مكتب محامي للإفراغ بالبيضاء

هكذا تستعد وزارة التعليم لزجر الغش في امتحان الباكالوريا

هذه هي المدن التي تستعد للانتقال من المنطقة 2 إلى منطقة التخفيف 1
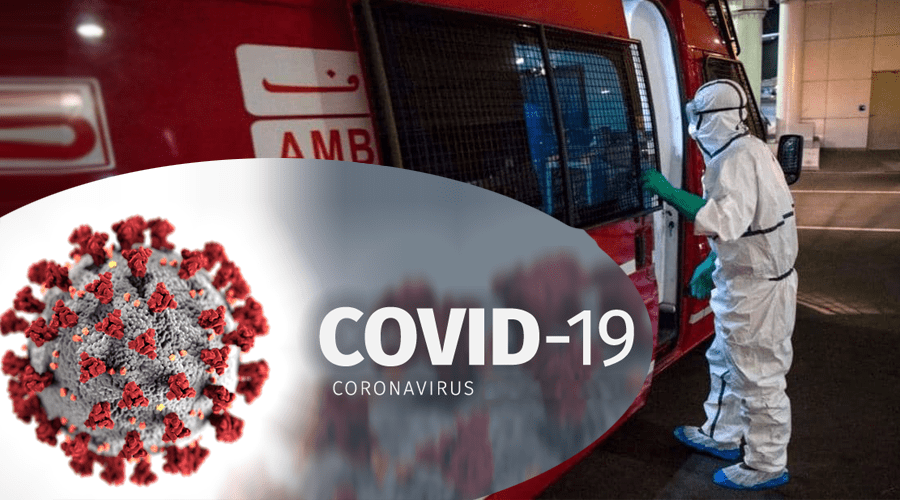
كورونا بالمغرب.. 77 إصابة و48 حالة شفاء خلال 24 ساعة

التوقف عن العمل والدعم يخرج مهنيي الطاكسي بجهة الرباط للاحتجاج

هكذا سيتم إجراء امتحانات الباكالوريا بالمغرب في زمن كورونا

أمن طنجة يجهض محاولة تهريب 5400 قرص طبي مخدر

ظهور أول إصابة بكورونا بعد تخفيف الحجر يستنفر سلطات العيون

توقيف مفتش شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء

أربعيني يهاجم شخصا بسكين داخل مقر للشرطة بمرتيل

مطالب باستقالة الرميد بعد فضيحة حرمان كاتبته المتوفاة من الـCNSS
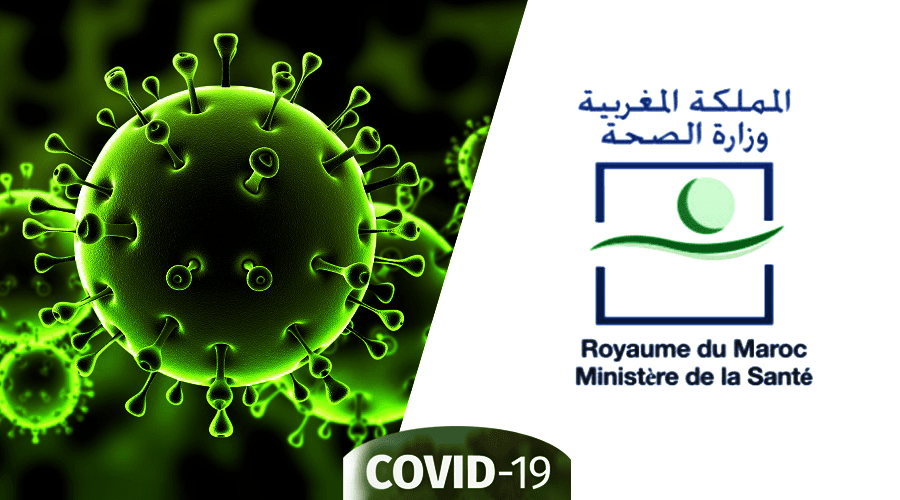
تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و6 حالات شفاء

الإطاحة بمنتحلة صفة إطار أمني للنصب على ضحاياها مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم بأصيلة

كورونا بالمغرب.. 66 إصابة و56 حالة شفاء وحالة وفاة خلال 24 ساعة

تحمي من التزوير وانتحال الهوية... هذه مميزات البطاقة الوطنية الجديدة

رفض السراح المؤقت لسليمان الريسوني

خبرة جينية تقود دركيا إلى السجن بتهمة اغتصاب فتاة

درك سطات يطيح بعصابة سرقت أزيد من 100 كبش
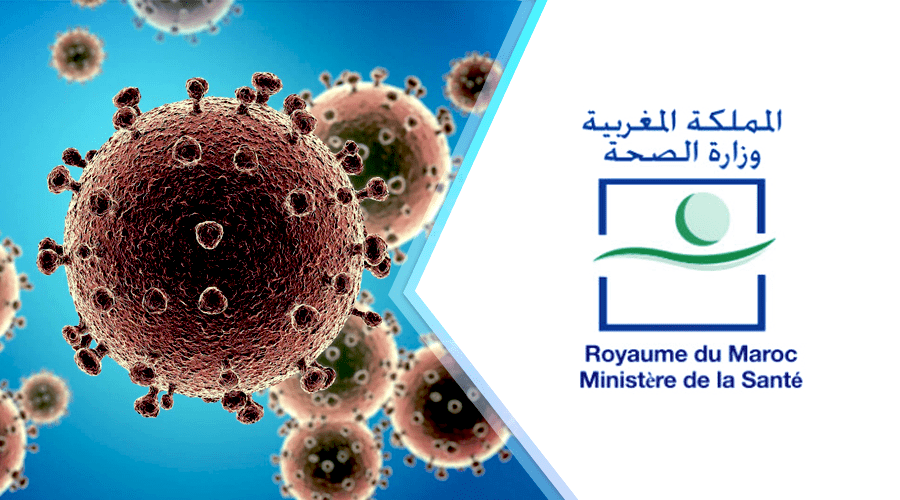
تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و23 حالة شفاء

ملوك وأمراء يطمئنون هاتفيا على صحة الملك محمد السادس

أمن سلا يطيح بالمتورطين في واقعة التريبورتور

إعادة 108 من المغاربة العالقين بجزر الكناري

هذه أسباب ارتفاع عدد المصابين بكورونا بإقليم القنيطرة

مقاضاة المدير الجهوي للصحة لنقابيين بأكادير يخلق الجدل

شكايات ضد موثقين بتطوان في ملفات تعميرية والنصب بالملايير
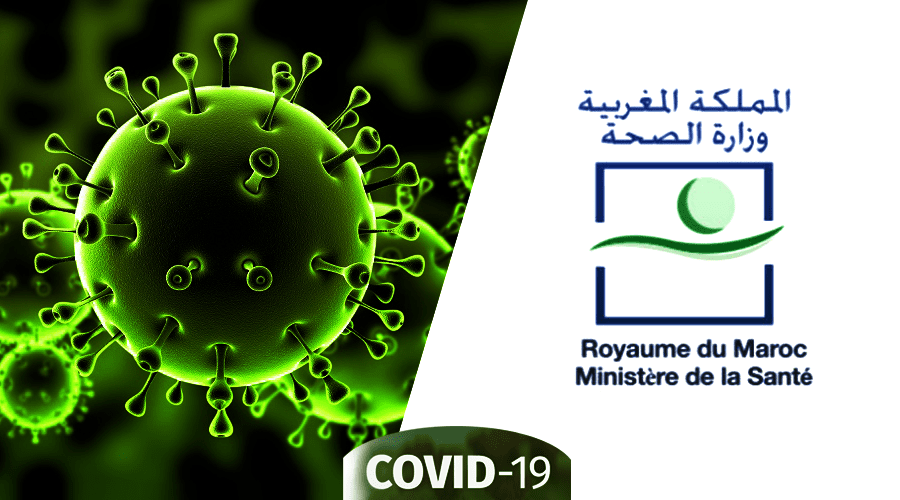
تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و52 حالة شفاء

ترحيل 16 مصابا بكورونا من تطوان لبنسليمان واستقرار الحالة الوبائية

كورونا بالمغرب.. 92 إصابة و63 حالة شفاء خلال 24 ساعة

لفتيت يكشف شروط تخفيف الحجر والانتقال من المنطقة 2 إلى المنطقة 1

إنتاج قناع خاص بالصم والبكم مغربي الصنع مائة بالمائة

بالصور.. انهيار جزئي لمنزل بالمدينة العتيقة لمراكش

خبير يؤكد بدأ الموجة الثانية من كورونا في أمريكا ويوصي بارتداء الكمامات

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض عناصر الأمن لاعتداء خطير بالقنيطرة

أمزازي يكشف شروط رفع الحجر الصحي كليا بالمغرب

رئيس جماعة يجر جمعويين للقضاء

وزير الصحة يلغي طلبات عروض لتفويت صفقات بالملايير ومطالب بالتحقيق
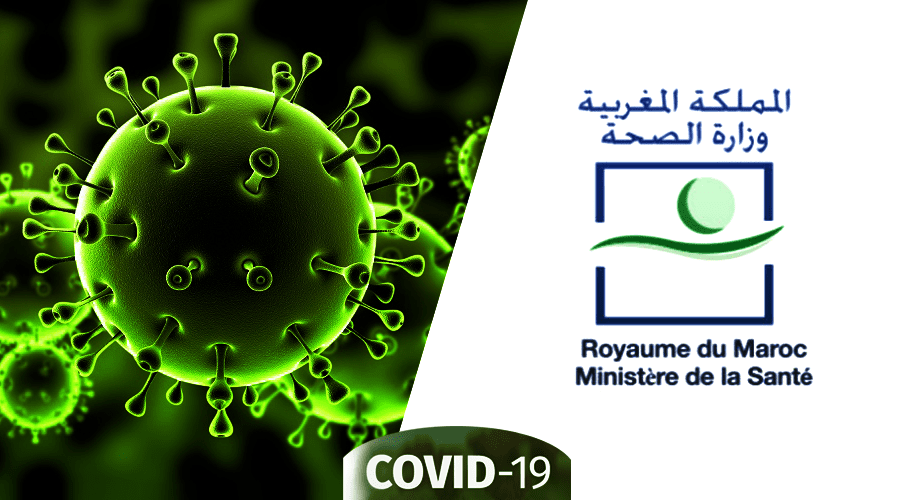
تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و14 حالة شفاء

الملك محمد السادس يجري عملية جراحية كللت بالنجاح

الترخيص لشركة مصرية بتصنيع وتوزيع علاج لكورونا في 127 دولة

كورونا بالمغرب.. 101 إصابة و69 حالة شفاء خلال 24 ساعة

البحث عن سائق تريبورتور ومرافقه بتهمة تعريض عناصر الأمن للخطر بسلا

عندما رفض الحسن الثاني اتصالات السفيرين الفرنسي والأمريكي... وتساقط سفراء دول كبرى فوق العشب

الملك محمد السادس يأمر بإرسال مساعدات طبية إلى 15 بلدا إفريقيا
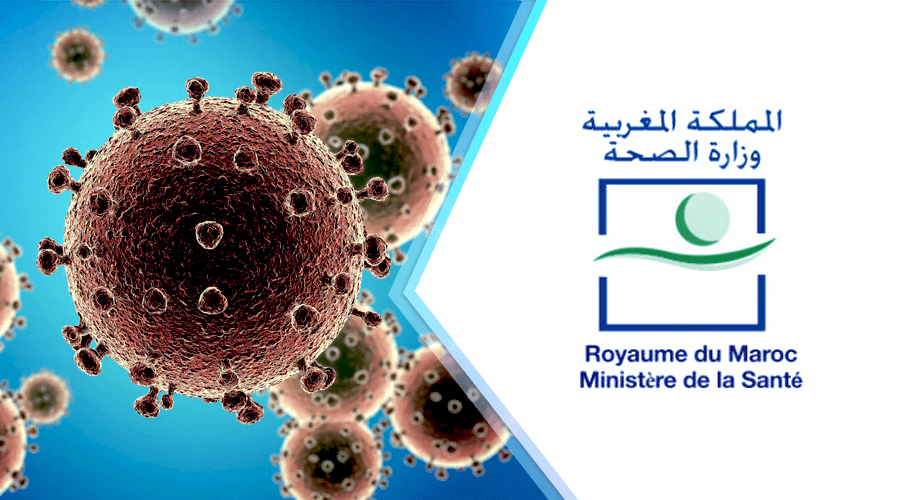
تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و29 حالة شفاء
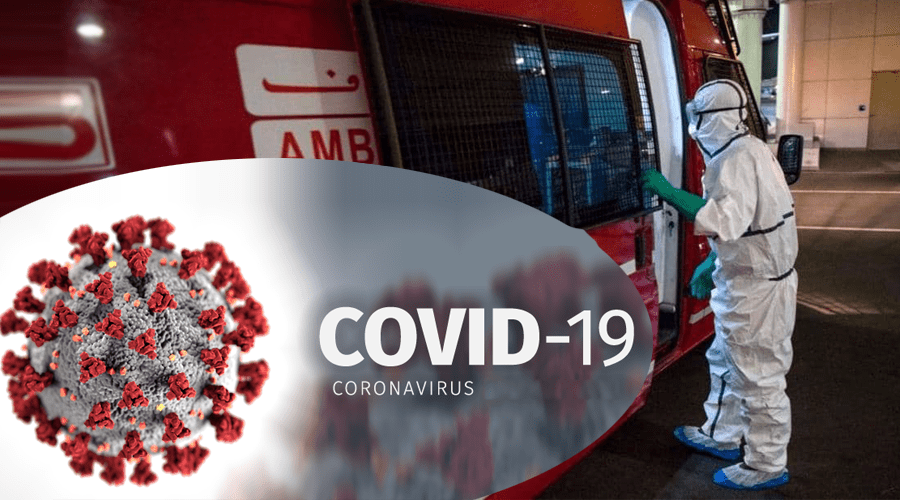
قرار بجمع كل المصابين بكورونا في بنسليمان وبن جرير لتسريع رفع الحجر

كورونا بالمغرب.. 82 إصابة و78 حالة شفاء خلال 24 ساعة

امتحان البكالوريا.. إلغاء اختبار التربية البدنية لجميع المترشحين الأحرار

مشروع عقاري بمرتيل يتهدد السكان بالفيضانات والسلطات تحقق

تفاصيل توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

توقيف مدير وكالة بنكية متورط في اختلاس 3.5 مليون درهم

وزارة الصحة تجر 3 نقابات إلى القضاء

هكذا نجحت دول في هزم كورونا
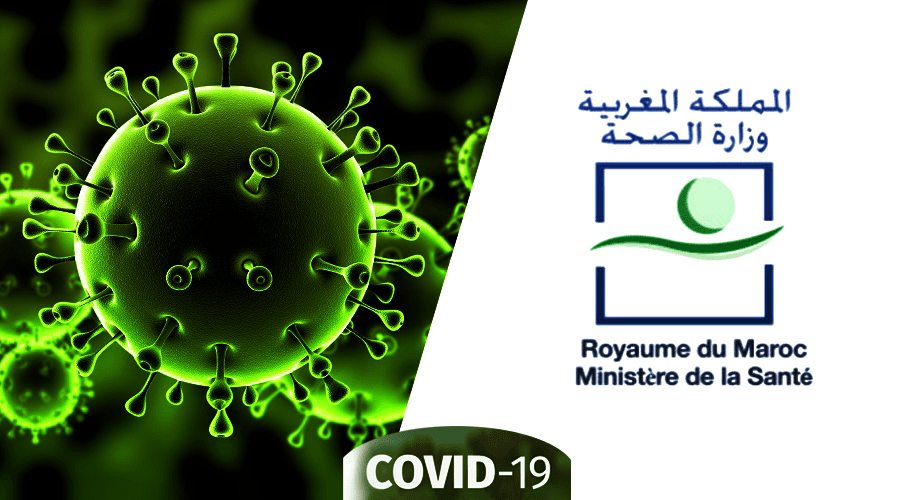
تسجيل 73 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و46 حالة شفاء

برلماني يورط البيجيدي بملتمس إعفاء المخالفين من رسم المحجز

السماح لرؤساء مجالس الجماعات بعقد الدورات حضوريا بهذه الشروط

كورونا بالمغرب.. 73 إصابة و35 حالة شفاء خلال 24 ساعة

وزارة التربية الوطنية: منصة التعليم عن بعد TelmidTICE أصبحت بالمجان

إعادة 300 من المغاربة العالقين بجهة مدريد الإسبانية

هذه حقيقة انتشار فيروس كورونا بسجون العالم

السماح بعرض دواءين جديدين للغدة الدرقية في المغرب

هذه إجراءات وزارة الخارجية لاستئناف العمل الحضوري

الملك يأمر بإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية إلى موريتانيا

وزارة العدل تصدر دليل التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد الطوارئ

بلاغ لقناة تيلي ماروك

هكذا تحول ملف فضيحة عقارية بتطوان إلى اتهامات ابتزاز وفساد

اختلالات في صفقات لوزارة الصحة بالملايير ومطالب بالتحقيق
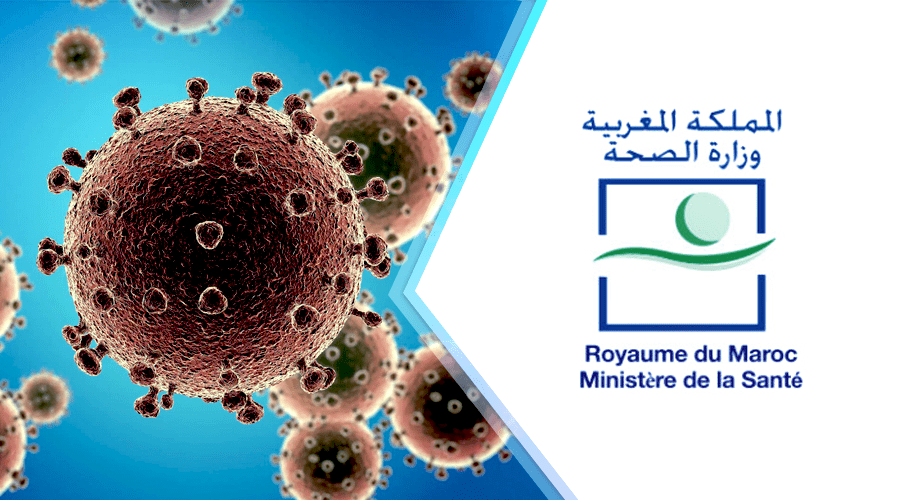
تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و17 حالة شفاء

قاضي التحقيق بابتدائية مكناس يأمر بإيداع "فيسبوكي" سجن تولال

كورونا بالمغرب.. 29 إصابة و18 حالة شفاء خلال 24 ساعة

المصادقة على القانون الخاص بالمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

بتعليمات ملكية أخنوش يقوم بزيارة ميدانية للمناطق المتضررة بعاصفة "التبروري" بجهة فاس مكناس

إعادة 300 مغربي من العالقين بإسبانيا

التحقيق مع مسؤولين حول الترامي على الأملاك المخزنية بإقليم القنيطرة

الدرك يفك لغز جريمة سرقة خزنة تضم الملايين من شركة للغاز
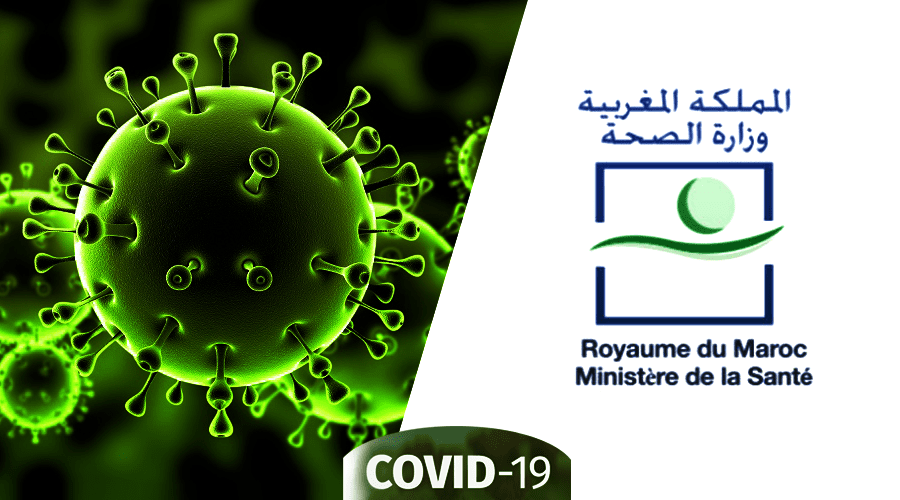
تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و5 حالات شفاء

طنجة تتصدر مجددا حالات الإصابات بكورونا أقل من يوم واحد من التقسيمات الإقليمية

كورونا بالمغرب.. 71 إصابة و72 حالة شفاء وحالة وفاة خلال 24 ساعة

العثماني: المغرب أصبح متحكما في الوباء وعلى الموظفين العودة لعملهم

انطلاق عملية الترشيح لاستفادة التلاميذ من منح الداخليات والمطاعم المدرسية

إعادة فتح المساجد بالمغرب.. المجلس العلمي الأعلى يوضح

استئنافية تطوان تنظر في ملف نصب بالملايير في فضيحة عقارية

الأمن يواصل الإطاحة بالمتورطين في شبكة كوكايين طنجة
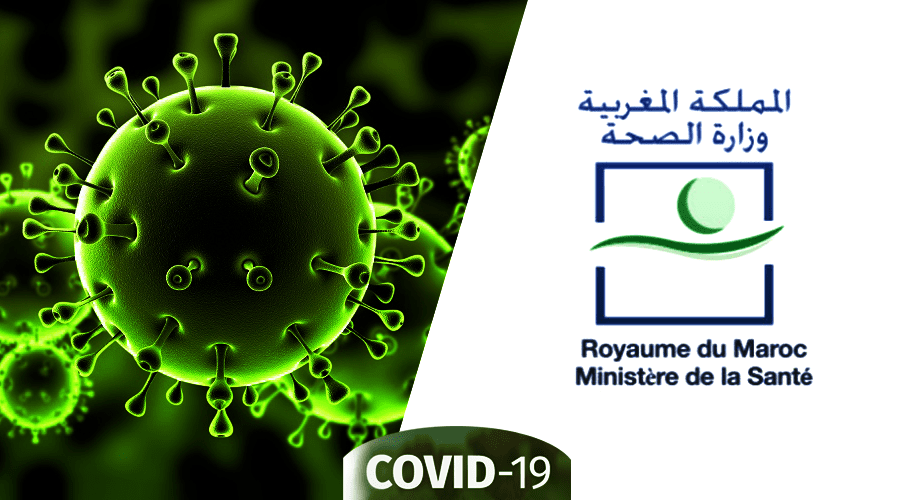
تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و3 حالات شفاء

هذه المدن المشمولة بإجراءات تخفيف الحجر الصحي

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لمدة شهر

كورونا بالمغرب.. 135 إصابة و85 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

هذا مخطط استئناف أنشطة المطارات بالمغرب

إطلاق النار لتوقيف شخص عرّض سلامة والدته للخطر بأكادير

الاستماع إلى برلماني في قضية السطو على عقار

دواء للسرطان يظهر نتائج إيجابية في علاج مرضى كورونا

تحقيقات في فساد قفة كورونا تهدد بسقوط مسؤولين

خادمة تقتل مشغلتها بطنجة
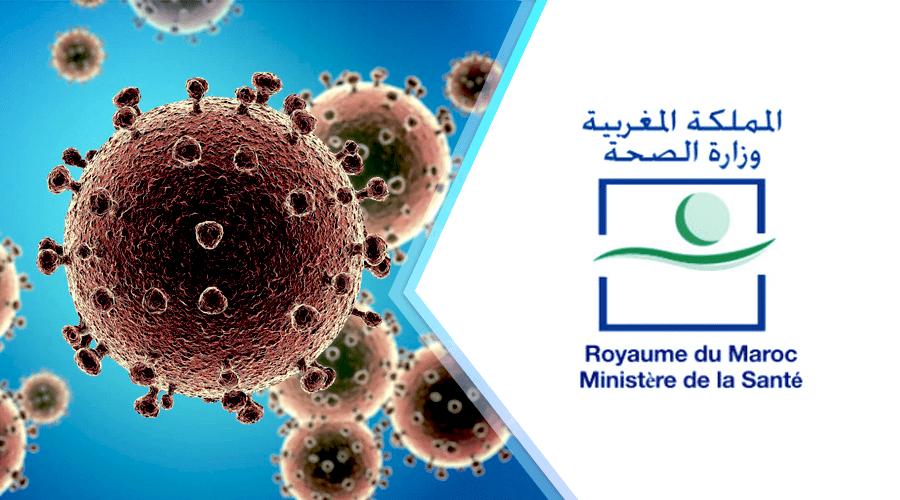
تسجيل 106 إصابات جديدة بكورونا في المغرب و15 حالة شفاء
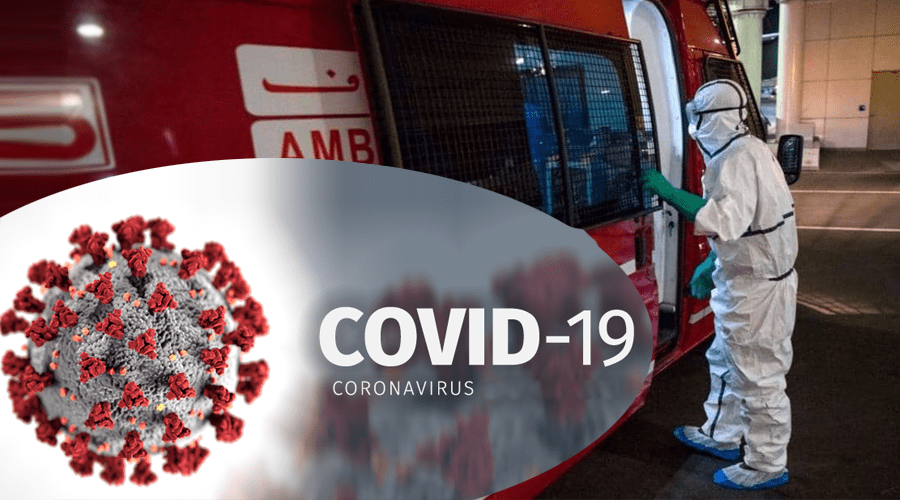
استقرار الحالة الوبائية بالشمال وصفر حالة جديدة بطنجة

هذه حقيقة الضغط على مواطنة لتتحول إلى مشتكية في مواجهة الريسوني

الشروع في صرف المنحة الدراسية لمتدربي التكوين المهني

كورونا بالمغرب.. 78 إصابة و44 حالة شفاء خلال 24 ساعة

تطورات مثيرة في فضيحة التزوير بجهة درعة تافيلالت

ملف.. هكذا عجلت تداعيات كورونا بالتغطية الاجتماعية والصحية للمغاربة

تفاصيل حوار وزارة الصحة مع مصنعي الأدوية لرفع قيود التصدير

تفاصيل توقيف مشروع عقاري ضخم فوت بطرق غير قانونية بالقنيطرة

رفض السراح وإرجاع سيارات فارهة لمتهمين بشبكة كوكايين الهرهورة

بائعة هوى تتسبب في بؤرة لكورونا بمراكش والأمن يطارد المواقع المشبوهة
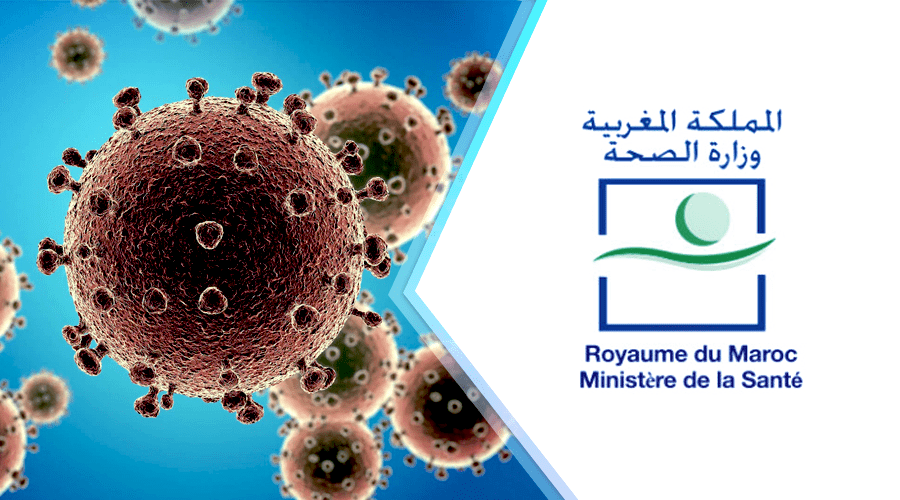
تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و6 حالات شفاء

عاصفة تتسبب في تضرر 9100 هكتار من المحاصيل الزراعية بجهة فاس-مكناس

كورونا بالمغرب.. 73 إصابة و49 حالة شفاء خلال 24 ساعة

المغرب يجري أزيد من 17 ألف و 500 تحليل كورونا يوميا

المروضون الطبيون يستنكرون الإقصاء ويتوعدون بالتصعيد

تاريخ.. مسؤولون وعلماء حاول مجهولون تدنيس ذكراهم بعد وفاتهم

دراسة جديدة تكشف أن 70 بالمائة من مصابي كورونا لا ينقلون العدوى
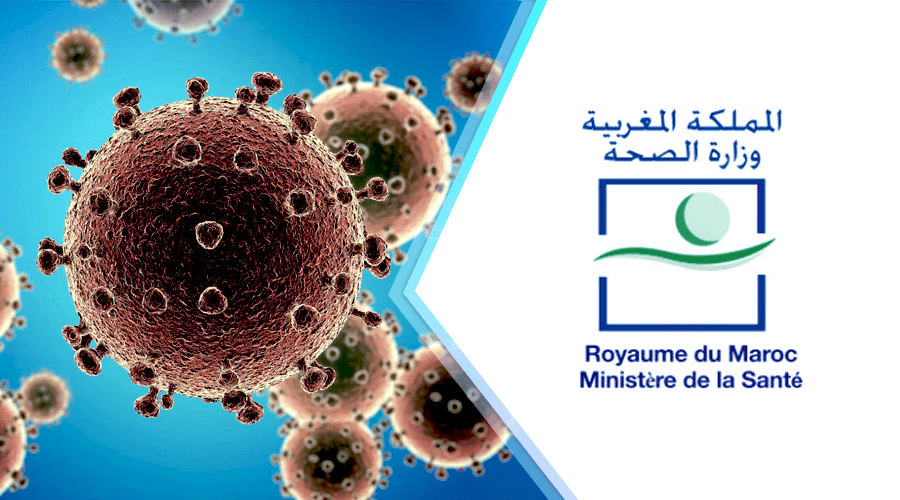
تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و13 حالة شفاء

أمن طانطان يطيح بـ4 أشخاص ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات
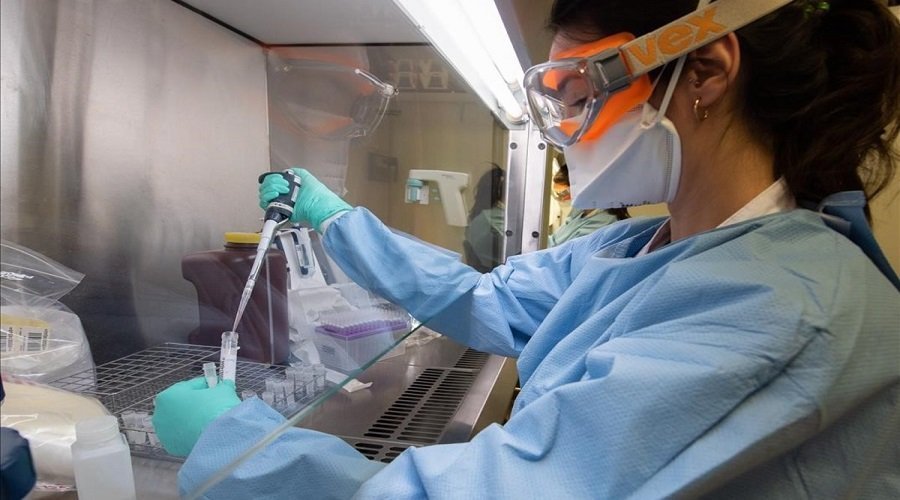
المصحات الخاصة تكشف حقيقة إجراء اختبارات كورونا

بالفيديو.. عاصفة رعدية قوية مصحوبة ببرد في فاس

كورونا بالمغرب.. 80 إصابة و47 حالة شفاء خلال 24 ساعة

استقرار الحالة الوبائية بالشمال وطنجة تقاوم لمحاصرة الوباء

تطبيق "وقايتنا" يتجاوز مليون تحميل بعد أقل من أسبوع على إطلاقه

مهنيو تعليم السياقة يرفضون استئناف العمل بعد الحجر بسبب توصيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

التحقيق مع رئيس جماعة بتهمة الإفتراء على عامل

تزوير أختام قاض والسطو على عقار يطيح بسمسار وموظفين

مداهمة مقهى للشيشة بطنجة تسفر عن توقيف 7 أشخاص ضمنهم مسير المقهى

6 حالات تتلقى العلاج بتطوان والحسيمة تعود لصفر كورونا

ترويج أجهزة متطورة للغش في الامتحانات يطيح بشخص في أكادير

كورونا بالمغرب.. 68 إصابة و73 حالة شفاء خلال 24 ساعة

حق استبدال الدواء يخلق الجدل بين نقابات الصيادلة ووزارة الصحة

حملات واسعة لمصالح الحموشي بالرباط في زمن كورونا
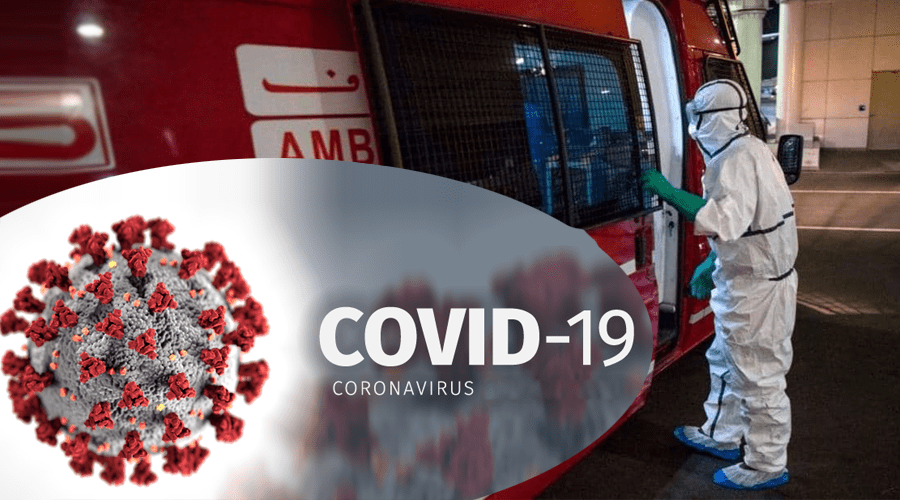
إقليم خريبكة خالي من كورونا بعد مغادرة آخر مصاب للمستشفى

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة
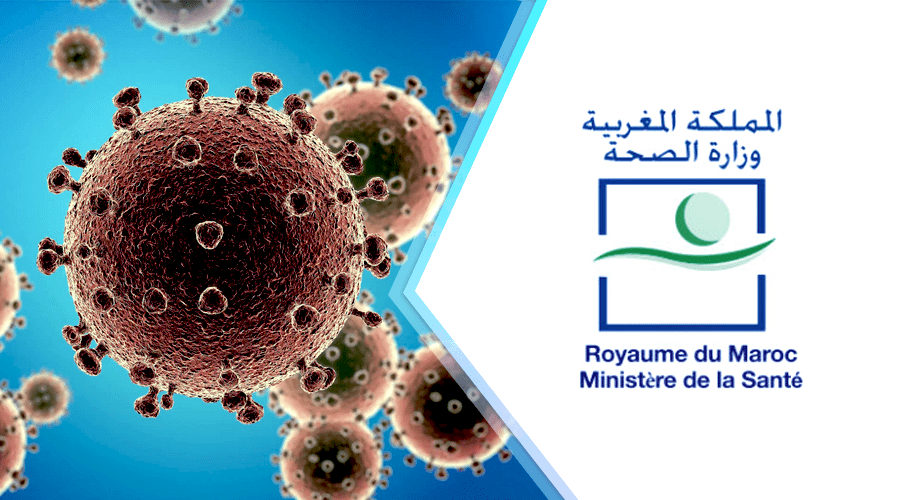
تسجيل 20 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب و27 إصابة

رادارات ألمانية متطورة لضبط حركة السير بشوارع طنجة

وزارة الصحة تنجز دراسات على نجاعة الكلوروكين في علاج كورونا

نفوق أغنام يستنفر الدرك والمصالح البيطرية ببرشيد

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

توقيف شخصين ينشطان في سرقة وتزوير السيارات بطنجة

سبعة مصابين بكورونا دفعة واحدة بالقصر الكبير بسبب عطلة عيد الفطر

كورونا بالمغرب.. 81 إصابة و329 حالة شفاء خلال 24 ساعة

مجلة سياحة عالمية تصنف المغرب كوجهة آمنة لقضاء العطلة بعد كورونا

فارس: المحكمة الرقمية خيار استراتيجي لا محيد عنه في المستقبل القريب

النيابة العامة بتطوان تحقق في اتهامات باستغلال قفة كورونا

صراعات بمجلس المضيق في عز "كورونا" والاستعداد للموسم الصيفي

التحقيق في اتهام رئيس جمعية بالمتاجرة في مساعدات موجهة للمعاقين

جماعة تطوان تستمر في خدمات عن بُعد والغاء التعامل الورقي

5 حالات تتلقى العلاج بتطوان ومئات التحاليل السلبية لمخالطين
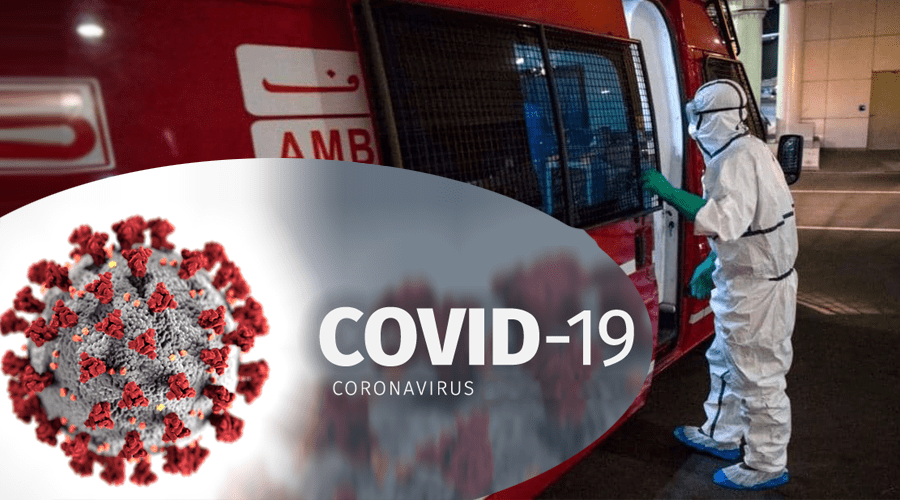
تسجيل إصابة مؤكدة بكورونا يعيد إقليم سيدي سليمان لنقطة الصفر
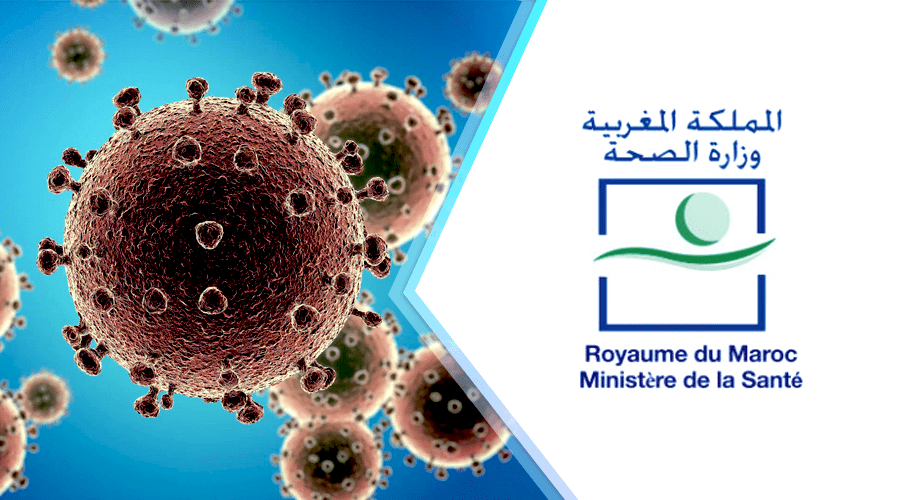
تسجيل 294 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب و45 إصابة

الملك يدعو المقاولات إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة لكورونا

شبان بالحسيمة والمدن الريفية يطلقون بادرة تزيين الأزقة والفضاءات

منظمة الصحة تقرر استئناف اختبارات الكلوروكين لعلاج كورونا

نسبة التعافي من الوباء بجهة الشمال تبلغ 85 بالمائة وعدد التحاليل 20666

انتابهم الذعر.. سكان يستفيقون على قبر قبالة منازلهم بطنجة

كورونا بالمغرب.. 56 إصابة و456 حالة شفاء خلال 24 ساعة

مراسلات الداخلية تكشف موعد رفع الحجر بالمغرب
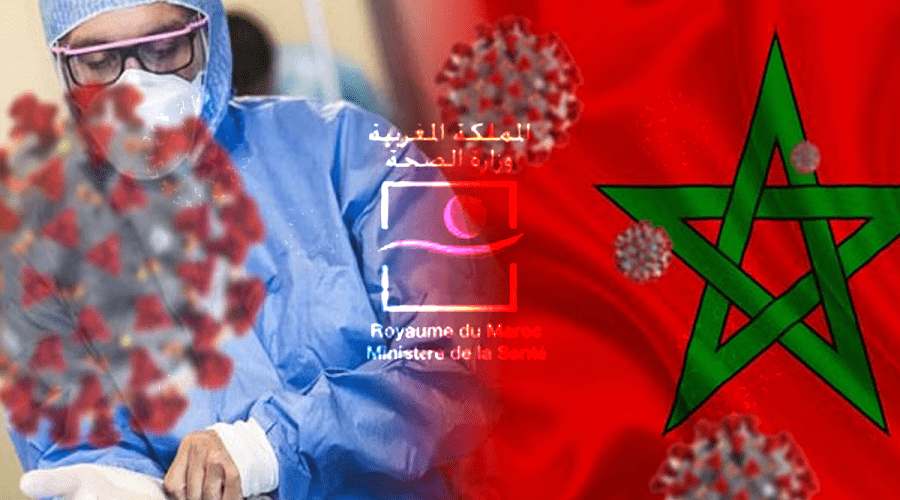
تعليمات ملكية لإجراء الفحوصات في القطاع الخاص

أرقام قياسية لحالات التعافي من كورونا بالمغرب وحوالي 900 حالة شفاء في يومين

بائع سمك يعيد الحالة الوبائية ببني ملال إلى نقطة البداية

إسبانيا تجلي 1600 من مواطنيها العالقين بالمغرب

هذه خطة الحكومة في أفق رفع الطوارئ

جمعية تحذر من انتشار كورونا بالقطارات وتطالب لخليع بالتدخل

محكمة تقضي باسترجاع منحة الحج من رئيس جماعة

فضيحة تزوير تهز مجلس درعة تافيلالت والشرطة القضائية تحقق

إعادة فتح صفقة توفر لوزارة الصحة 700 مليون

التحقيق في خروقات البناء العشوائي والترامي على أراضي الجموع بالقنيطرة

بارون مخدرات يورط ابن برلماني ودركيين
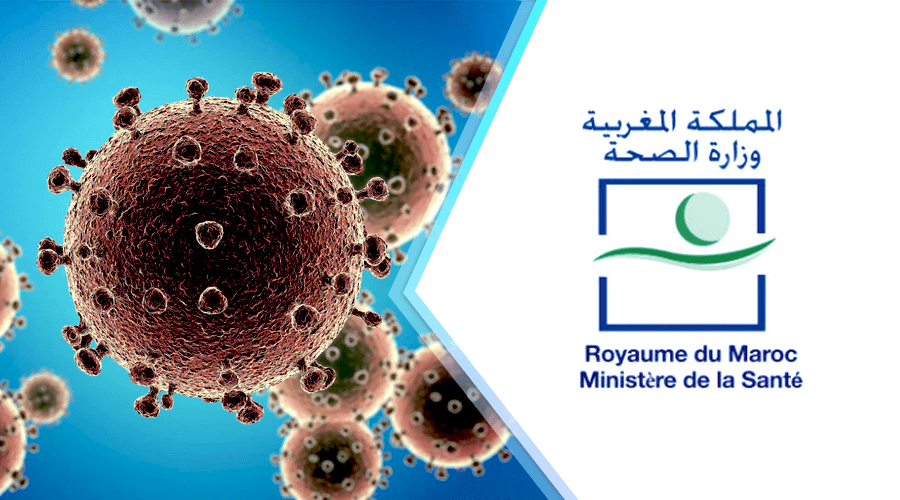
تسجيل 233 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب و44 إصابة
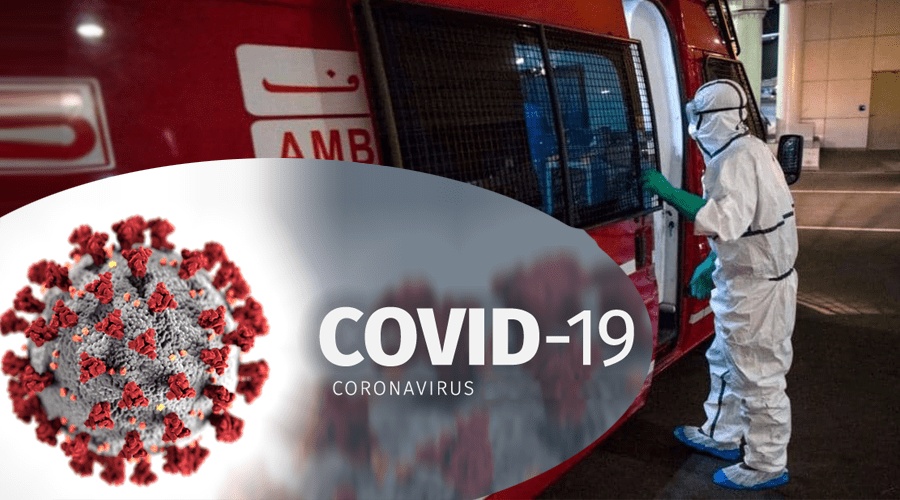
119 حالة تتلقى العلاج بجهة الشمال ومجموع المتعافين 952

لجان الداخلية قامت بأزيد من 4 آلاف زيارة مراقبة للوحدات التجارية

لفتيت: استفادة أزيد من 3,5 مليون شخص من مساعدات غذائية بقيمة مليار درهم

كورونا بالمغرب.. 33 إصابة و517 حالة شفاء خلال 24 ساعة

السلطات بطنجة تغلق الطرقات المؤدية إلى الشواطئ لمنع التسلل إليها

وزارة التعليم تنشر الأطر المرجعية لامتحانات نيل شهادة التقني العالي

سنة حبسا نافذا ليوتوبورز اعتبرت إصابة نقيب المحامين بمراكش بكورونا عقابا إلهيا

إطلاق مشروع نفق طرقي بغلاف مالي يناهز 40 مليون درهم بالرباط

لفتيت : الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني رفع الطوارئ

تسجيلات تكشف كواليس ما دار بين الصين ومنظمة الصحة حول كورونا

محكمة القنيطرة تعيد فتح ملف بارون المخدرات "اخريبيقة"

هذه تفاصيل مشروع مرسوم عمل موظفي الدولة من بيوتهم

حزب يقترح إلغاء عيد الأضحى بالمغرب بسبب كورونا

العزل والمتابعة يهدد رؤساء جماعات وبرلمانيين بالشمال

مطالب بالتحقيق في صفقات مشبوهة بالملايير داخل وزارة الصحة

مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بالدعم والإعفاء من أداء المأذونيات
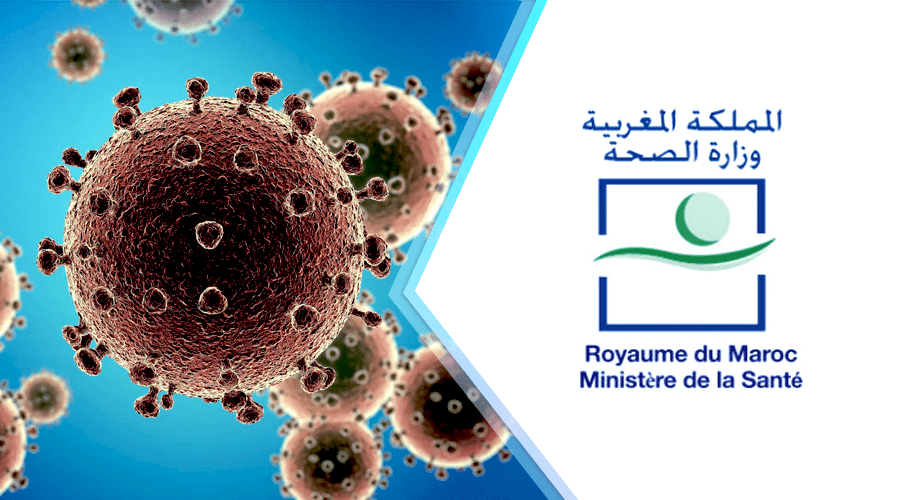
تسجيل 398 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب و26 إصابة

8 حالات تعافي من كورونا بجهة الشمال و4 إصابات فقط

تصميم طقم تشخيص لكورونا مغربي 100 بالمائة

كورونا بالمغرب.. 26 إصابة و434 حالة شفاء خلال 24 ساعة

توقيف 3 متورطات في إعداد منزل للدعارة بالبيضاء
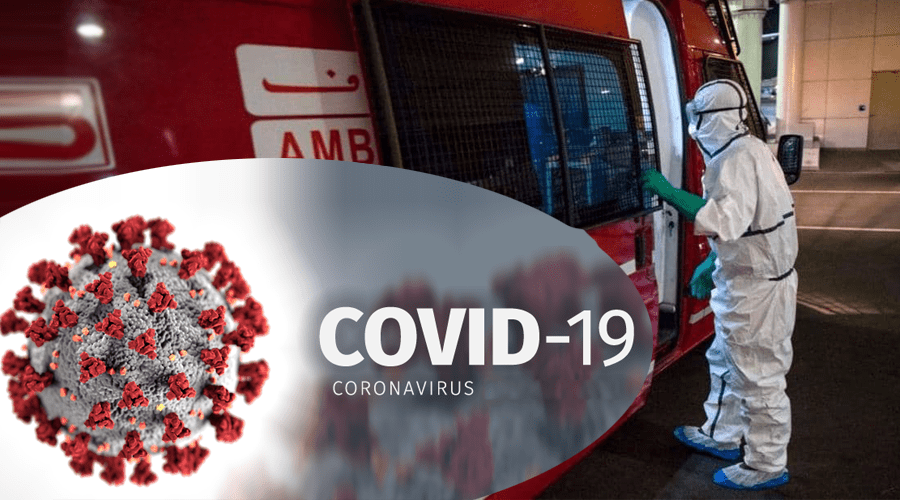
تسجيل أول إصابة بكورونا يستنفر سلطات سيدي إفني

الجمارك تفك قيود وزير الصحة على تصدير الأدوية

طائرة درون تطيح بتاجر مخدرات تحصن بجبال وادي أمليل

السلطات تواصل حربها على خارقي الطوارئ بالشواطئ المغربية

هيومان رايتس ووتش تكشف موقفها من قضية الريسوني وآدم

اتهام السلطات بالتلاعب في القفف والرخص يقود مدونين للحبس
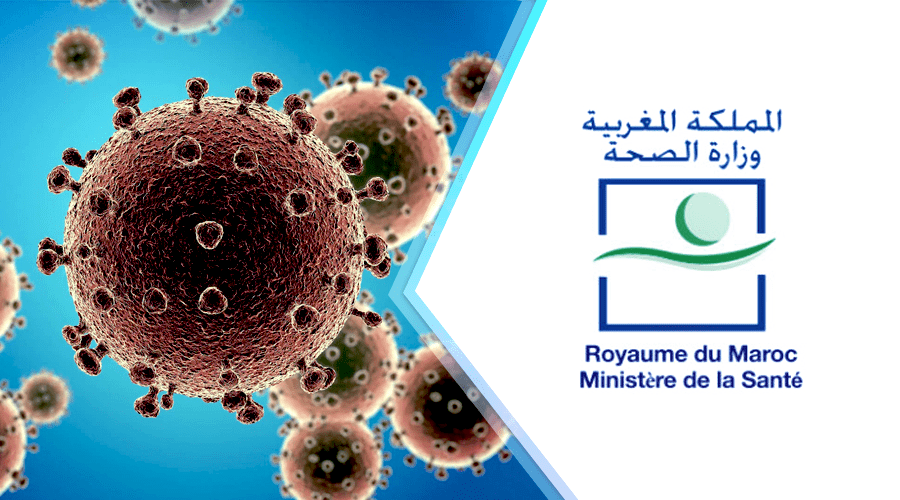
تسجيل 295 حالة شفاء من كورونا بالمغرب و12 إصابة جديدة

استقرار الحالة الوبائية بالشمال وطنجة تقاوم لمحاصرة الجائحة

التظاهرات المناهضة للعنصرية بأمريكا تهدد بموجة ثانية لكورونا

تسجيل 27 إصابة و58 حالة شفاء خلال 24 ساعة

إطلاق منظومة معلوماتية تمكن التلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد

أمن طنجة يفتح تحقيقا قضائيا في واقعة تشويه الرمز التذكاري لليوسفي

إطلاق عملية استثنائية لإنجاز بطائق التعريف الإلكترونية لمغاربة الخارج

مستخدمو المقاهي والمطاعم يدخلون على الخط ويطالبون بحقهم في الضمان الاجتماعي

تسجيل هزة أرضية بإقليم الخميسات

مجهولون يلطخون النصب التذكاري لليوسفي بعد يومين من وفاته
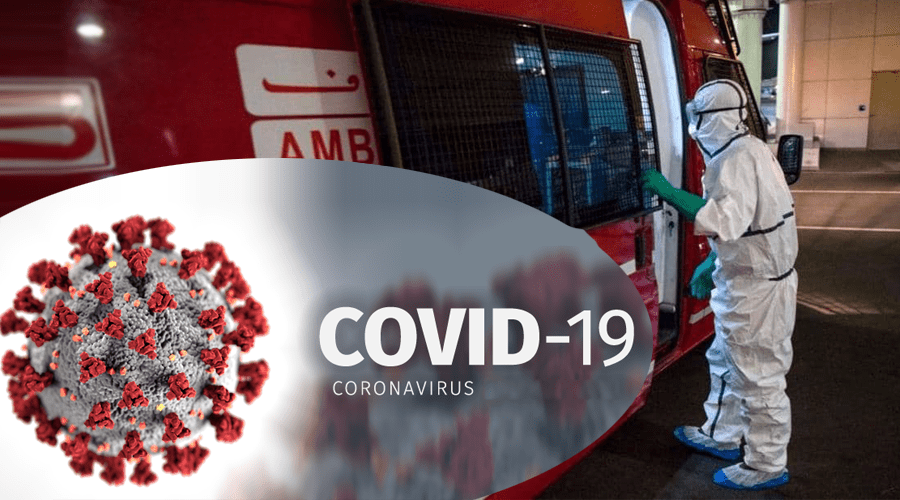
عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في 9 جهات بالمملكة
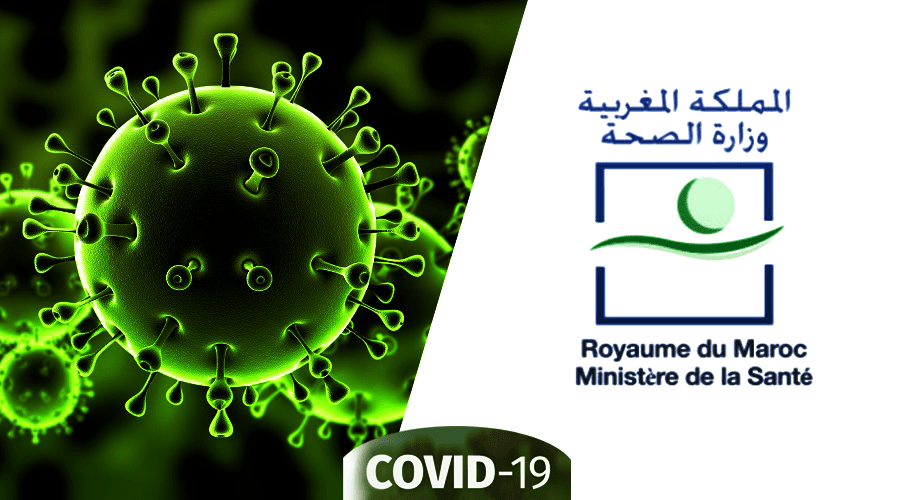
تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في المغرب وحالات الشفاء تبلغ 5412

عرض محتويات رقمية إباحية للتداول بين قاصرين تقود لتوقيف متورطين

بالفيديو.. حريق مهول يلتهم مصنعا بالمنطقة الصناعية بطنجة

6 حالات فقط تتلقى العلاج بالعرائش و3 حالات إصابة بتطوان

مشروع مرسوم يسمح للموظفين المغاربة بالعمل من منازلهم

كورونا بالمغرب.. تسجيل 66 إصابة و130 حالة شفاء خلال 24 ساعة

مصدر يكشف الهدف من إنشاء قاعدة جرادة عند الحدود مع الجزائر

هكذا كانت المقاهي بالمغرب قبل 120 سنة

الاستقلال يطالب الحكومة بكشف مخططها للخروج من الحجر الصحي

قصة حب اليوسفي وهيلين...ابنة خياط يوناني حركت قلب مناضل استثنائي

جوانب خفية من حياة الراحل عبد الرحمان اليوسفي

رفض ملتمسات السراح المؤقت لأمنيين في قضية مخدرات دولية

ترامب يعلن بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ

أم عازبة تقتل ابنيها ضواحي تازة

هكذا يستغل نافذون الطوارئ للاستحواذ على أراضي الجموع بالقنيطرة

الاستماع إلى برلماني عن البيجيدي حول استغلال قفة كورونا
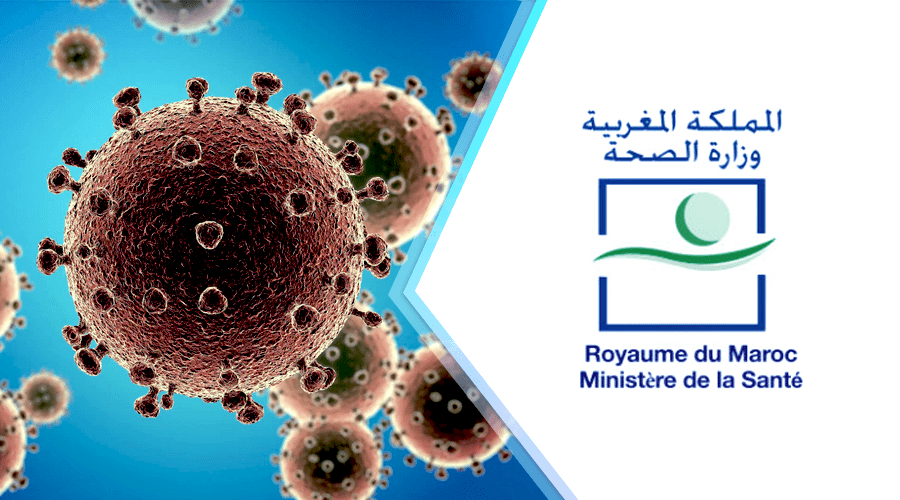
تسجيل 106 حالات شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7740

الملك ينعي اليوسفي في برقية مؤثرة إلى زوجة الفقيد

تسجيل حالتي إصابة بتطوان ومجموع المتعافين بالشمال يصل 906

معلومات الديستي تقود لحجز طن و766 كلغ من المخدرات بالبيضاء

بالصور.. جثمان الراحل عبد الرحمان اليوسفي يوارى الثرى بالدار البيضاء

من بينها المغرب... دولة عربية ستستأنف الرحلات نحو 12 دولة عربية بفاتح يوليوز

هذه هي الحافلات التي ستجوب شوارع الدار البيضاء (صور)

وزارة التعليم تنشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع امتحانات الباكالوريا

بعد إدانتهم بـ138 سنة سجنا.. لصوص الساعات الفاخرة أمام الجنايات

وزير الصحة يجدد التأكيد على نجاعة الكلوروكين في علاج كورونا

خروقات واختلالات ببلديتي بني ملال والفقيه بن صالح ومطالب للوكيل العام بالتدخل
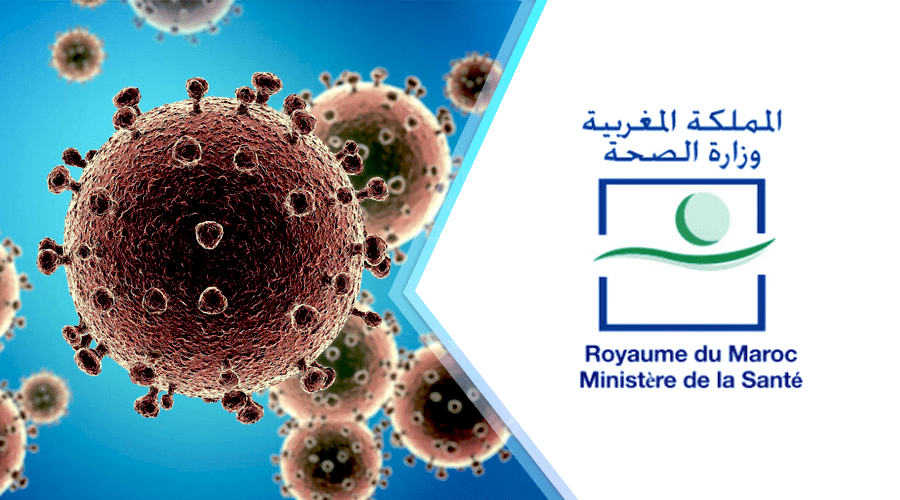
تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وحالات الشفاء تبلغ 5223

عبد الرحمن اليوسفي.. الزعيم المعارض والمنفي والوزير الأول يرحل إلى دار البقاء

وزير الصحة يكشف حقيقة إعادة 300 مغربي عالق بالخارج في الأسبوع
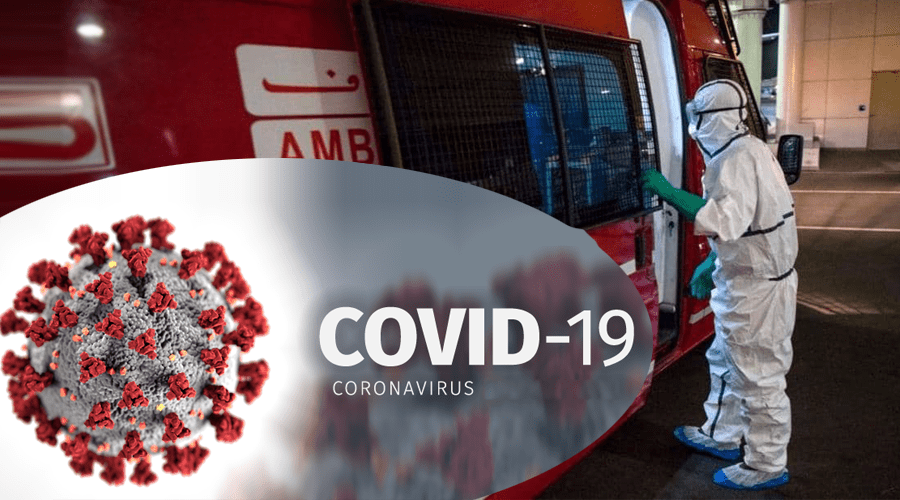
حالة إصابة وافدة بتطوان ومساع لمحاصرة بؤر للوباء بطنجة

ضابط شرطة يلجأ لسلاحه الوظيفي لتخليص عون سلطة من جانح احتجزه داخل فرن بالعرائش

بتعليمات ملكية.. قرار بإعادة 300 مغربي عالق في الخارج كل أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 42 إصابة و217 حالة شفاء خلال 24 ساعة

المقاهي والمطاعم بالمغرب تفتح أبوابها غدا بهذه الشروط

هذا موعد فتح المساجد في المغرب أمام المصلين

خروقات خطيرة بتعاضدية الموظفين ومطالب لبنشعبون بالتدخل

هكذا تستعد سلطات الشمال لتنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي

النصب عبر الانترنيت يطيح بطالب ببرشيد

تسجيل 131 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7636

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

الـONCF يعلن زيادة عدد القطارات السريعة بهذه الشروط
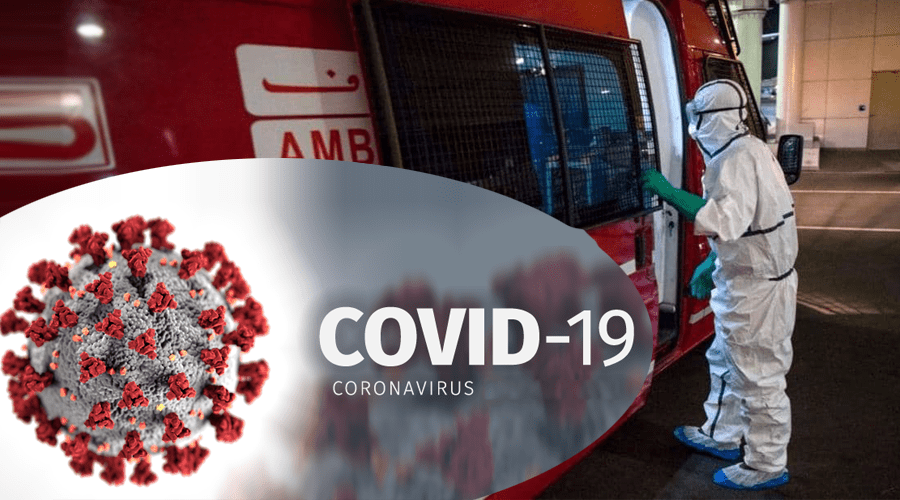
إصابة جديدة بالحسيمة واستقرار الحالة الوبائية بالعرائش

الداخلية تقاضي شخصا روج مغالطات حول قائدة اليوسفية

كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة و97 حالة شفاء خلال 24 ساعة

فضح اختلالات بقطاع الصحة بأكادير ومطالب للوزير بالتدخل

أزيد من 20 ألف معتقل تمت محاكمتهم عبر التقاضي عن بعد بالمغرب

تسجيل صوتي منسوب لمحام يفضح وساطة في ملف كوكايين

التحقيق في اتهام رئيس جماعة لبرلماني بتهديده بالقتل

عامل شركة الحليب بتطوان يغادر المستشفى بقرار من أطباء كوفيد 19

تطورات مثيرة في قضية التهريب الدولي للمخدرات لإحدى الدول الإفريقية

منظمة الصحة تعلق تجارب الكلوروكين ووزارة الصحة تؤكد فعاليته في علاج مرضى كورونا

جمعيات الداخلة تشيد بإجراءات الولاية للحفاظ على أمن الساكنة الصحي

لهذا يرفض أرباب المقاهي استئناف النشاط في زمن كورونا
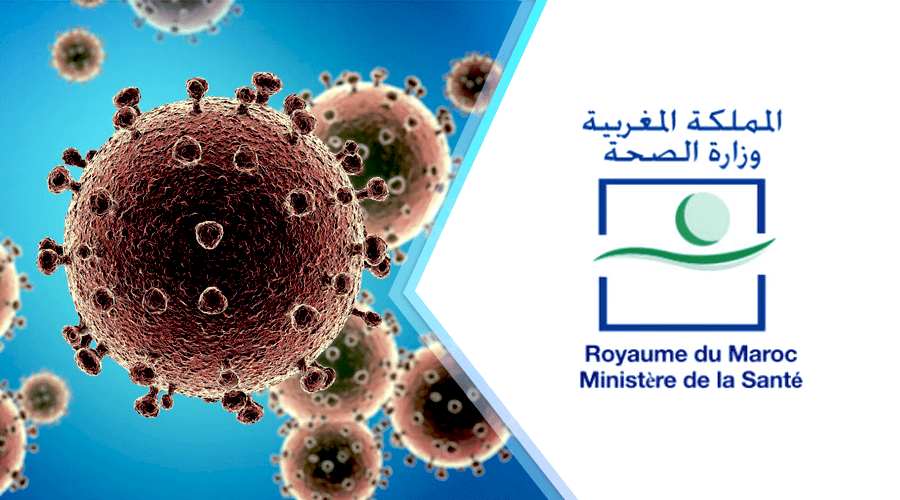
تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب وحالات الشفاء تبلغ 4969

عاجل: الداخلية تخفف إجراءات التنقل بين المدن

جمعية لبائعي الصحف تؤكد صعوبة استئناف العمل خلال الطوارئ
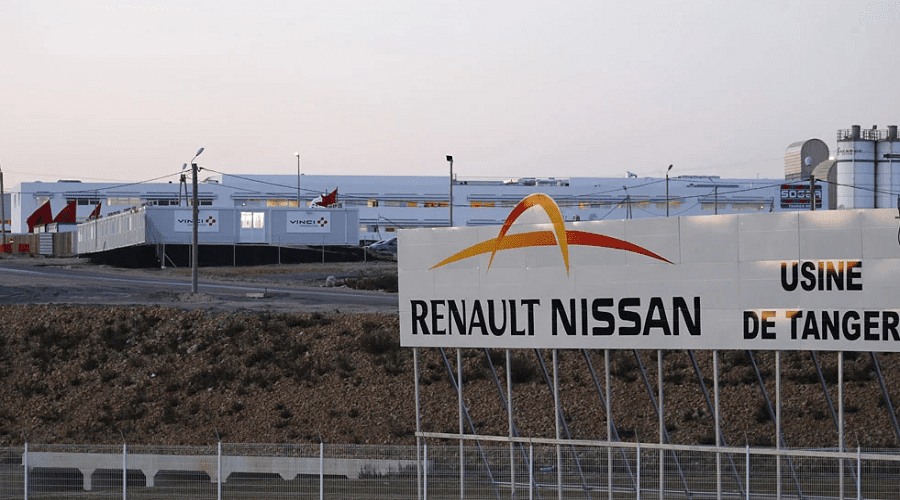
بعد أن قدموا من باريس في رحلة خاصة.. وضع 50 مهندسا من شركة "رونو"

كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة و107 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الحسيمة تلتحق بمدن صفر "كورونا" وتستعد لاستقبال الموسم الصيفي

عدم تسجيل أية إصابة جديدة بكورونا في 75 مؤسسة سجنية من أصل 76

حصري: الفرقة الولائية بالقنيطرة تتلقى تعليمات بالبحث في شكاية الراضي

مصدر أمني: اعتقال المدونة مايسة مجرد إشاعة

المغرب البلد الإفريقي الأكثر تكاملا في المجال الماكرو اقتصادي

تطوير بخاخ يساعد المرضى على مقاومة كورونا

هكذا سيتم طباعة ونسخ أوراق الامتحانات في زمن كورونا

مندوبية السجون تعتذر للمحامين عن إجراءات التفتيش

تجار يتهمون رئيس مقاطعة باستغلال كورونا لتهجيرهم

الطلبة المغاربة الحاصلين على تأشيرة الدراسة بألمانيا يطالبون الحكومة بالتدخل

أوراش البناء تستعد لاستقبال أزيد من مليون عامل هذا الأسبوع

الاعتداء على أعوان سلطة وأمنيين خلال هدم بنايات عشوائية بطنجة

دكاترة الوظيفة العمومية يساهمون في الحرب على فيروس كورونا

تفاصيل عودة تطوان لصفر "كورونا" وتحاليل سلبية لعامل شركة الحليب

هكذا كسبت مصالح الحموشي الرهان أمام بارونات المخدرات والمشرملين أيام العيد

استعدادات لتخفيف الحجر والداخلية تضع خطة لفتح المطاعم والمقاهي
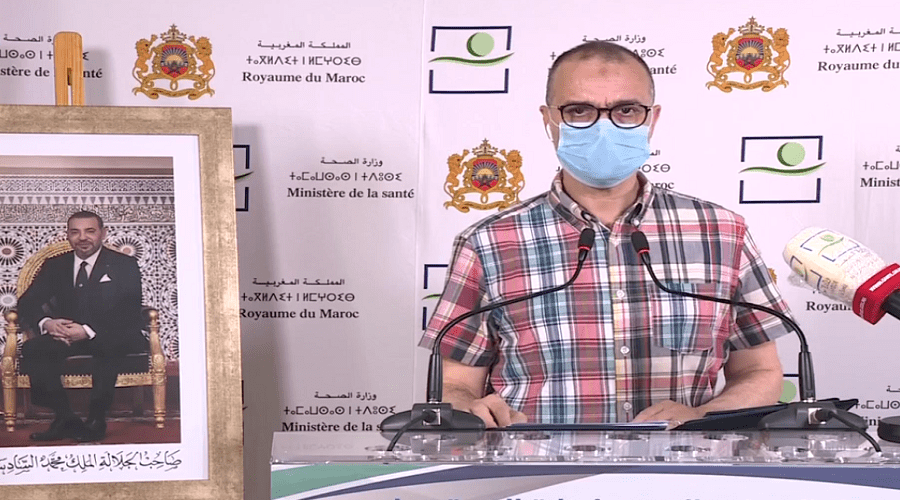
مدير الأوبئة: انخفاض طفيف لمؤشر انتشار كورونا على الصعيد الوطني
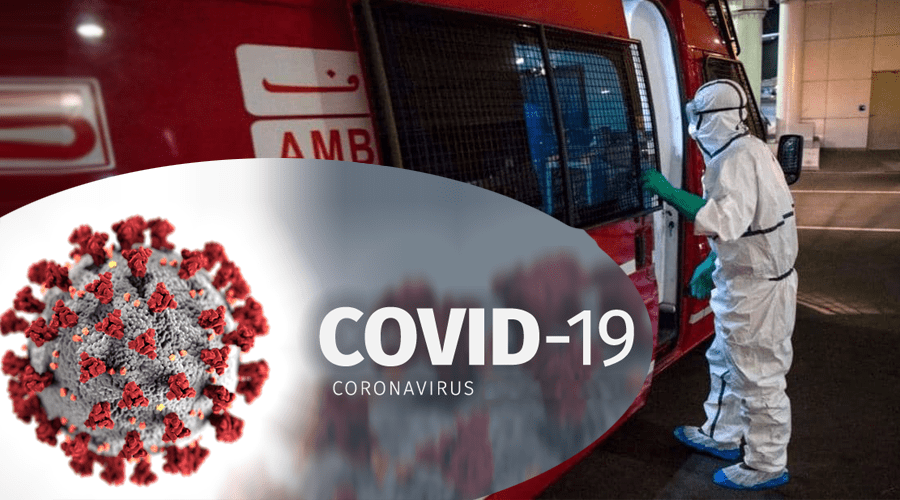
15 حالة فقط تتلقى العلاج من "كورونا" بالعرائش ومجموع المتعافين 148
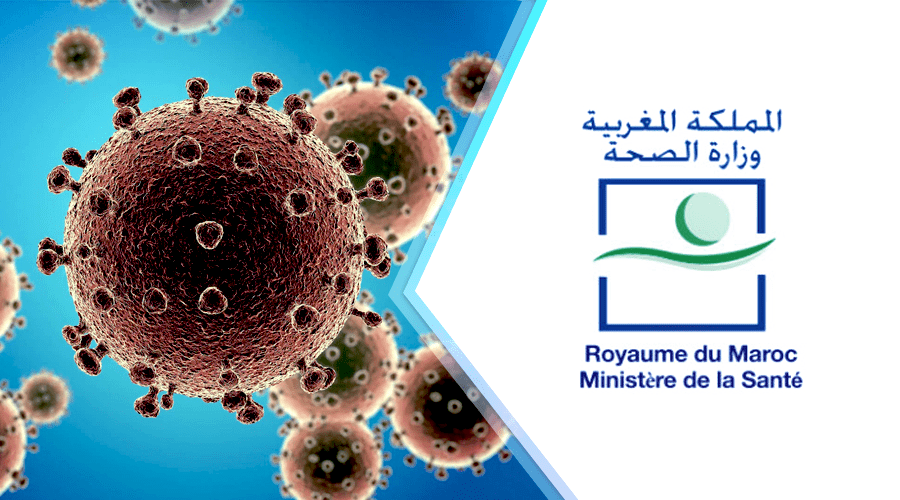
كورونا بالمغرب.. تسجيل 99 إصابة و71 حالة شفاء خلال 24 ساعة

شركة امريكية متخصصة في ألياف السيارات بطنجة تعلن عن 19 حالة إصابة بالفيروس دفعة واحدة

إطلاق النار لتوقيف شخص سرق سيارة بمكناس

نشرة خاصة.. طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

توقيف رجل سلطة عن العمل استولى على مساعدات غذائية

القاضي يوجه للريسوني تهم هتك عرض والاحتجاز التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات ويأمر بإيداعه عكاشة

طائرة شحن إسرائيلية تهبط في إسطنبول لأول مرة منذ 10 سنوات

العرائش تتعافى من الوباء و29 فقط يتلقون العلاج من أصل 164

عرض سليمان الريسوني أمام قاضي التحقيق

تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وارتفاع حالات الشفاء إلى 4737

حجز 3 أطنان من المخدرات على متن شاحنة للنقل الطرقي بكلميم

مديرية الأمن تكشف ملابسات تفتيش منزل سليمان الريسوني

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الشمال يوم العيد
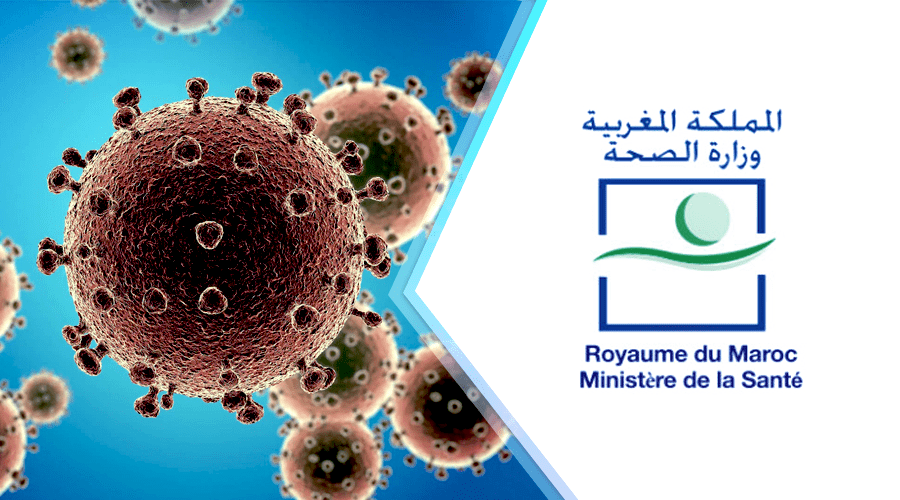
كورونا بالمغرب.. تسجيل 27 إصابة و65 حالة شفاء خلال 24 ساعة

صحيفة إلموندو الإسبانية تشيد بجهود المغرب في مواجهة تفشي كورونا

آدم يقرر وضع شكاية ضد محامي سليمان الريسوني بسبب خوفه على سلامته الجسدية

هذه قصة ميلاد علامة Made In Morocco

تاريخ.. كل ما يجب معرفته عن نشأة البنوك بالمغرب

الملك يؤدي صلاة العيد دون خطبة في احترام للحجر الصحي

عدد إصابات كورونا بمصنع صوماكا بالبيضاء يرتفع إلى 100 حالة

عفو ملكي لفائدة 483 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد

مركز الفلك الدولي: بعض الدول أخطأت في تحري هلال شوال

مندوبية السجون تقرر وقف العمل بنظام الحجر الصحي لموظفيها

معلومات الديستي تقود الأمن الإسباني لتفكيك خلية دواعش

كورونا بالمغرب.. تسجيل 74 إصابة و261 حالة شفاء خلال 24 ساعة

196حالة تعافي من "كورونا" بجهة الشمال وعدد التحاليل يصل 11648

العثماني يتهم القضاء بمتابعة أعضاء من حزبه بتهم باطلة

اعتقال عشرينية تروج كمامات غير طبية وحجز 25 طنا من الدقيق المدعم

تطورات جديدة في قضية تورط أمنيين مع بارونات مخدرات
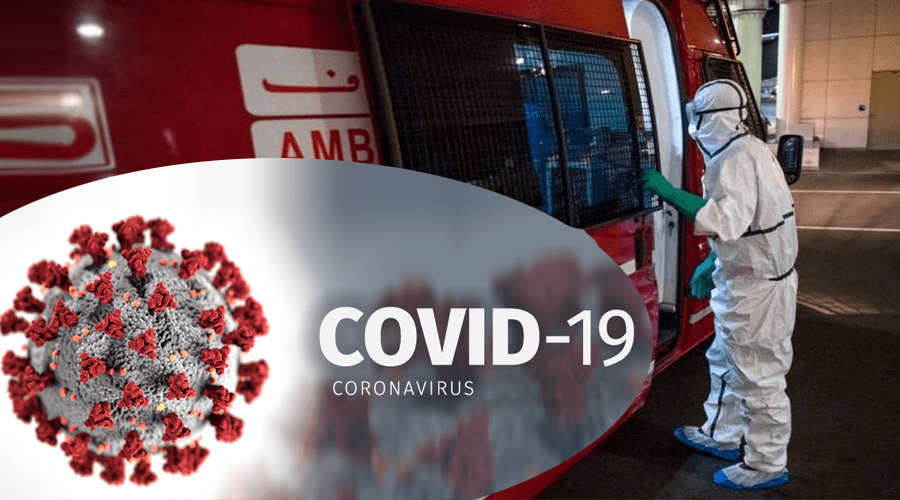
اكتشاف بؤر جديدة لكورونا يستنفر سلطات طنجة

اعتماد توقيت جديد بالميناء المتوسطي في أيام العيد يربك مصدرين

هكذا تمكنت سلطات الصويرة من هزم كورونا

سلطات برشيد تستعين بقاعة مغطاة ومركب رياضي وقاعة ندوات لإجراء الباك

وزارة الصحة تعدّل طريقتها في علاج المصابين بكورونا
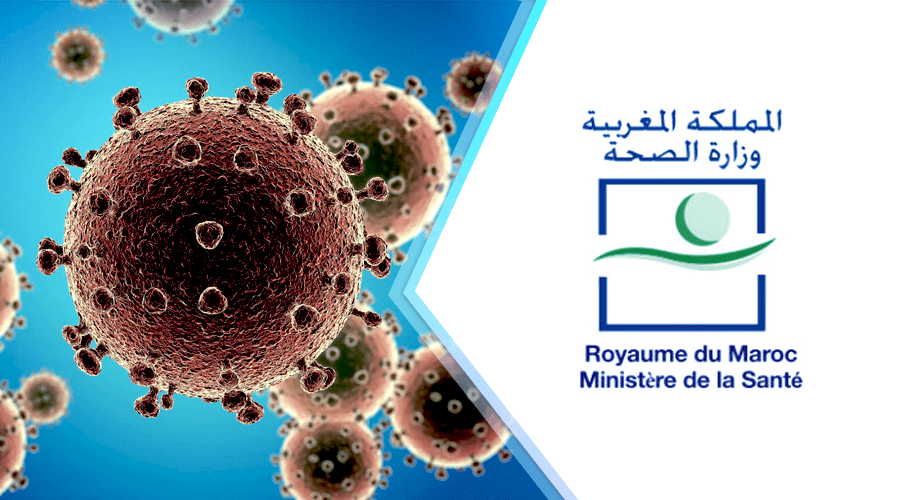
تسجيل 196 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7375

السلطات تغلق منافذ مؤدية إلى الشواطئ لمنع المصطافين من النزول للبحر بعد العيد

توقيف الصحافي سليمان الريسوني في ملف له علاقة باعتداء جنسي مفترض على شاب

أقاليم تطوان والمضيق وشفشاون ووزان بدون "كورونا"

وزارة الأوقاف تعلن موعد مراقبة هلال شوال وتحذر من البلاغات الكاذبة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 121 إصابة و97 حالة شفاء خلال 24 ساعة

هذه خطة الباطرونا لإنعاش الاقتصاد الوطني

نهاية كورونا.. تفاؤل ديديي راوول وتشاؤم منظمة الصحة

جريمة قتل قبيل الإفطار بسبب نزاع عائلي

الحموشي يطيح برئيس مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن العيون

حادثة سير تتسبب في إعفاء القائد الإقليمي للوقاية المدنية بسيدي سليمان

تزوير وثيقة للتنقل بين المدن يقود تاجرا للحبس

نقابات تطالب بإدراج كوفيد 19 ضمن الأمراض المهنية
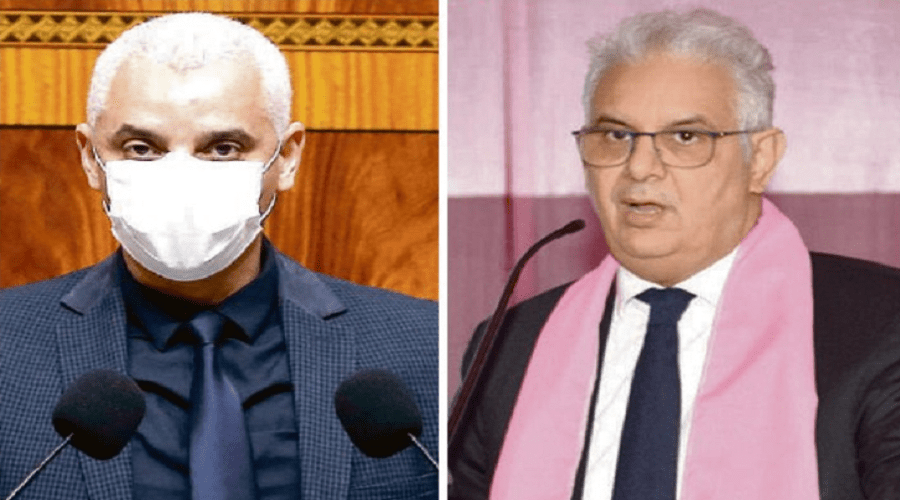
الاستقلال يقترح استعمال الأدوية الجنيسة وتبادل اتهامات بين الأطباء والصيادلة

وزارة الصحة تستعد لرفع الحجر بإجراء 1.8 مليون اختبار كورونا

تسجيل 67 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7300

خرق الطوارئ والاعتداء على الدرك يطيح بزوج قاضية

نسبة الشفاء بجهة طنجة تبلغ 55 في المائة من مجموع المصابين

تطوان تنتصر على "كورونا" بتعافي الجميع وصفر إصابة
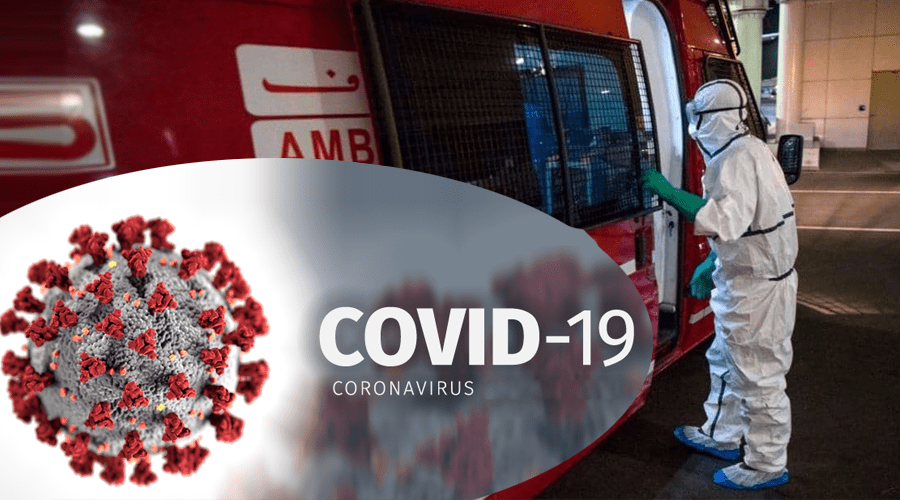
إصابة 31 سيدة حامل بفيروس كورونا بالمغرب

كورونا بالمغرب.. تسجيل 78 إصابة و182 حالة شفاء خلال 24 ساعة

إصابة 340 سجينا بكورونا في المغرب تعافى منهم 233

مستشفى عسكري يتكلف بتحاليل الكشف عن كورونا بإنزكان

تعيين 6 مغاربة بتمثيلية اللجان الدائمة بالكاف

نشرة خاصة.. طقس حار ابتداء من السبت بعدة مناطق بالمملكة

إتلاف وإرجاع 4935 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة وتحرير 375 مخالفة

لوحة تذكارية حول كورونا تخلق الجدل بالقنيطرة

الاشتباه بإصابة كورونا يستنفر شركة رونو بطنجة

الدرك يطيح برجل أعمال تم شحن مخدرات الكركرات داخل مصنعه بالقنيطرة

ميدي 1 تيفي تمنع صحافييها من لايفات مواقع التواصل

تفاصيل إعفاء المدير الجهوي والمندوبة الإقليمية للصحة بكلميم
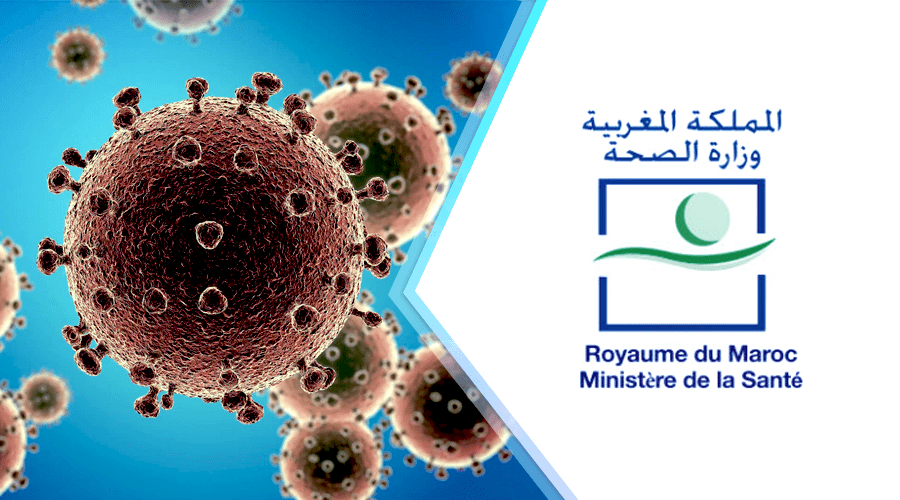
تسجيل 114 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7185

الانتهاء بنجاح من تجارب استغلال مشروع تحلية مياه البحر بالحسيمة

الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر

المجلس العلمي الأعلى يصدر فتواه بخصوص صلاة العيد
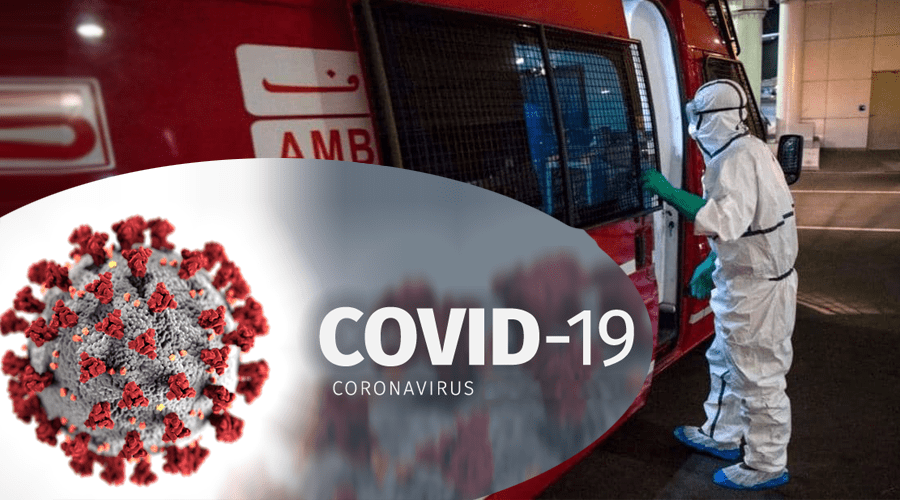
47 حالة تعافي من "كورونا" بجهة الشمال وحالة وفاة واحدة

العثماني: كافة سيناريوهات إعادة المغاربة العالقين بالخارج جاهزة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 110 إصابات و197 حالة شفاء خلال 24 ساعة

المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في السوق خلال الحجر الصحي

هذه قائمة الأدوية التي ستنزل أسعارها في المغرب

انطلاق خدمة التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي حصريا عبر "مسار"

توقيف عون سلطة بعد اتهامه بتعنيف رجل مسن

تبديد أموال عمومية والتزوير يجر مدير بنك بطنجة أمام جرائم الأموال

تسجيل 30 حالة كورونا بوحدة صناعية يستنفر سلطات برشيد

4 حالات فقط بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الإقليمي بتطوان

هكذا تخوض عناصر الدرك حرب شواطئ ضد خارقي الطوارئ

هكذا انتهت واقعة نائب وكيل الملك وأفراد القوات المساعدة بطنجة
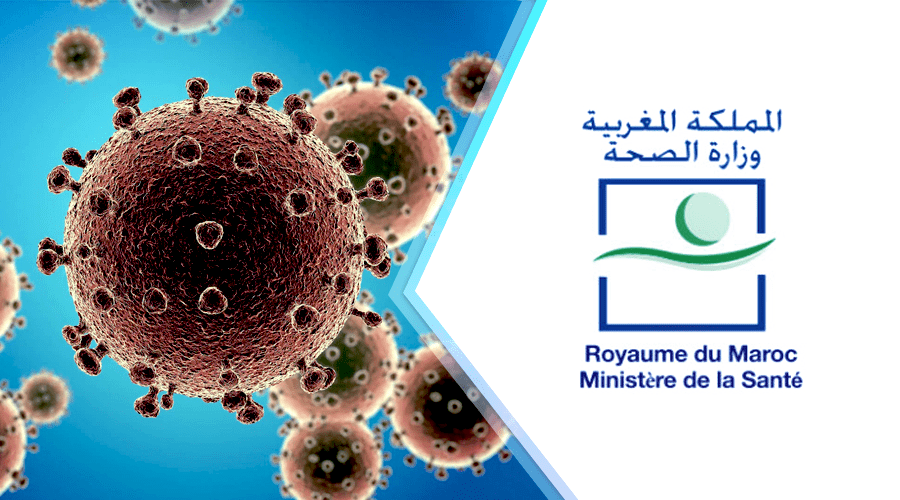
تسجيل 136 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 7048

8326 تحليلا بنتائج سلبية بجهة الشمال والعرائش تتجه لمحاصرة الوباء

28 حالة تعافي من الفيروس بالشمال و5 اصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 71 إصابة و143 حالة شفاء خلال 24 ساعة

مندوبية التخطيط تكشف مدى احترام الأسر المغربية لقواعد الحجر

موارد صندوق كورونا تبلغ 32.7 مليار درهم أُنفق منها 13.7 مليار

السجناء يشرعون في تصنيع الكمامات داخل المؤسسات السجنية بالمغرب

تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق... هذه هي الشروط

خرق الطوارئ ومقاومة السلطة يقود 5 جزائريين للاعتقال بالفنيدق

مطالب بكشف مصير 4 مليارات في قضية نصب عقارية بطلها رئيس جمعية

أمن سلا يطيح بشابين استغلا الطوارئ لسرقة مدفع أثري

تسجيل 132 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6972

الحبس النافذ في حق الفرنسي داهس قطيع أغنام
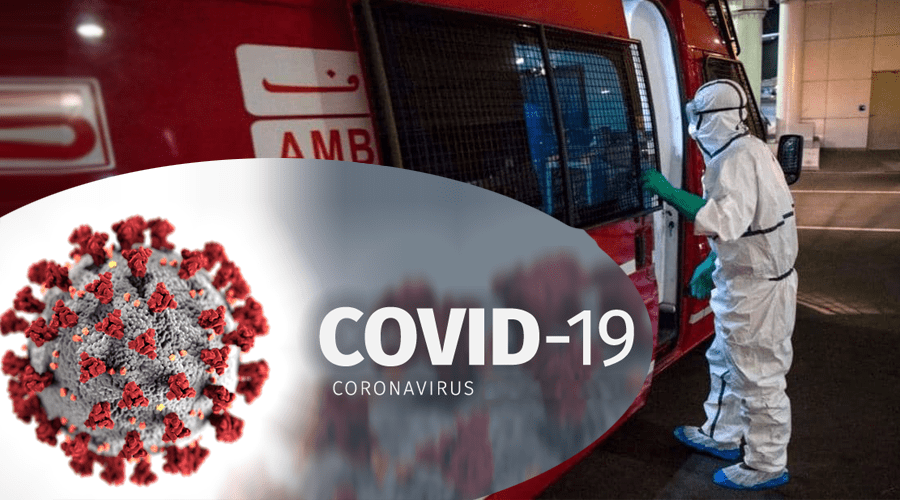
تفاصيل أعداد من يتلقون العلاج من "كورونا" بمستشفيات الشمال

37 حالة تعافي من الفيروس بجهة الشمال وعدد التحاليل يصل 8435

الحكومة تكشف استراتيجية تخفيف الحجر وخطة إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

اختلالات في تدبير أزمة " كورونا" تطيح بمدير سوق الجملة للخضر بطنجة

مندوبية السجون تنفي صحة ادعاءات بخصوص أعداد الإصابات بكورونا

مجلس الحسابات يدعو الأحزاب لإيداع حساباتها السنوية إلكترونيا

كورونا بالمغرب.. تسجيل 82 إصابة و98 حالة شفاء خلال 24ساعة

وزارة التعليم تكشف خطة استكمال الموسم الدراسي وموعد الامتحانات

عدم احترام الحجر وبروز بؤر عائلية وصناعية يساهم في تمديد الطوارئ بالمغرب

العثماني يعلن تمديد الحجر الصحي والطوارئ إلى غاية 10 يونيو

هكذا يشتغل البرلمان المغربي في زمن كورونا

هذه أجندة الامتحانات بمؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي

هكذا تعيش دواوير بالصويرة العطش في زمن كورونا ورمضان

تفاصيل فضيحة إطلاق أسماء دعاة للتطرف على أزقة وشوارع بتمارة

تفكيك شبكة لترويج المخدرات يطيح بدركي

تفاصيل مداهمة أوراش بناء ومقاهي مسؤولين كبار خرقت الطوارئ
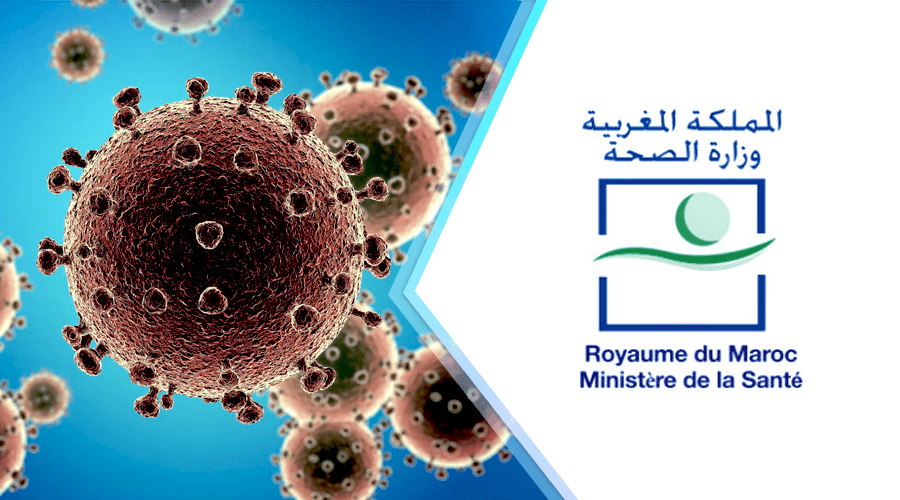
تسجيل 72 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6930

التحقيق مع "الضب" حول خريطة الكوكايين بطنجة يطيح بضابط في "الديستي" و 3 أشخاص اخرين

4 حالات تعافي بالعرائش واصابة واحدة فقط خلال 24 ساعة الماضية

إسبانيا تُسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ شهرين
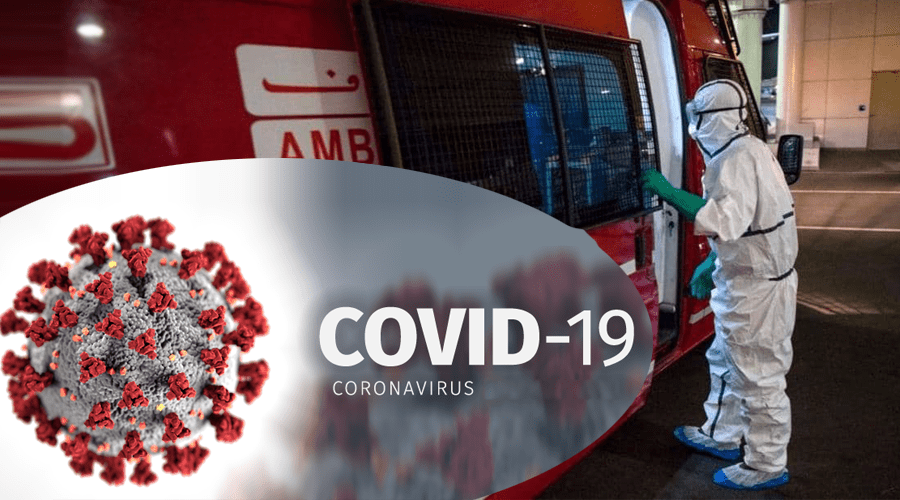
تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

دولة عربية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

إصابة 6 أطقم طبية مهنية بمستشفيات طنجة بفيروس "كورونا"

كورونا بالمغرب.. تسجيل 129 إصابة و173 حالة شفاء خلال 24 ساعة

هذا هو التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالمغرب حسب الجهات

أقدم شهادة في الطب مغربية وأقدم مستشفى في العالم مراكشي

الـCNSS يفتح باب التصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل وتأجيل الاشتراكات
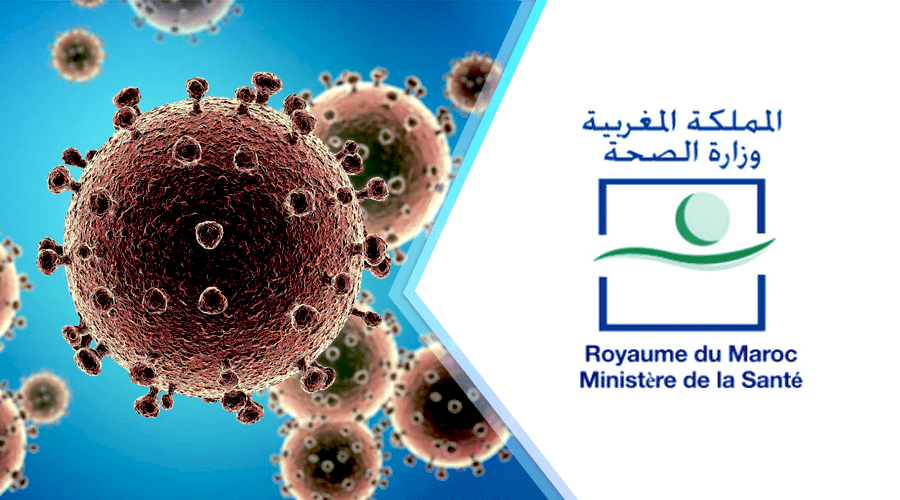
تسجيل 158 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6798
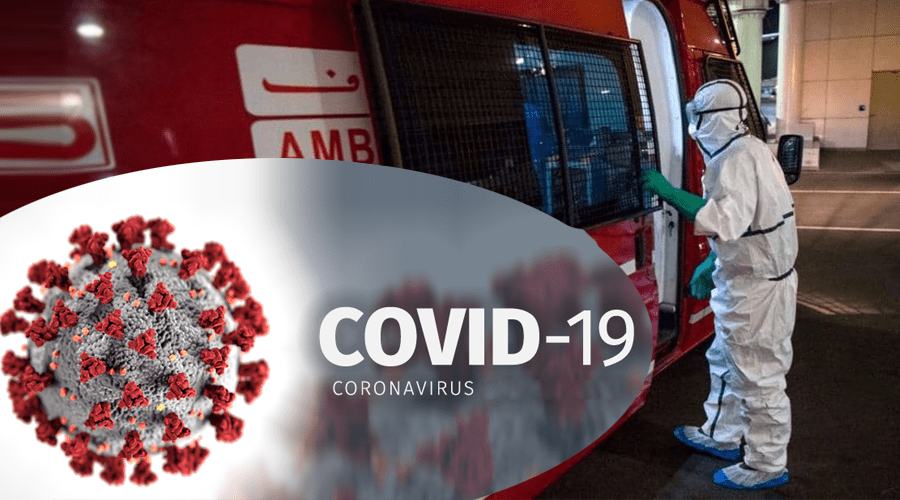
رفع الحجر بشكل عام بدون تدابير وقائية يهدد حياة ربع المغاربة

الوحدة الصناعية للدرك الملكي تنتج 17 مليون قناع بمواصفات دولية
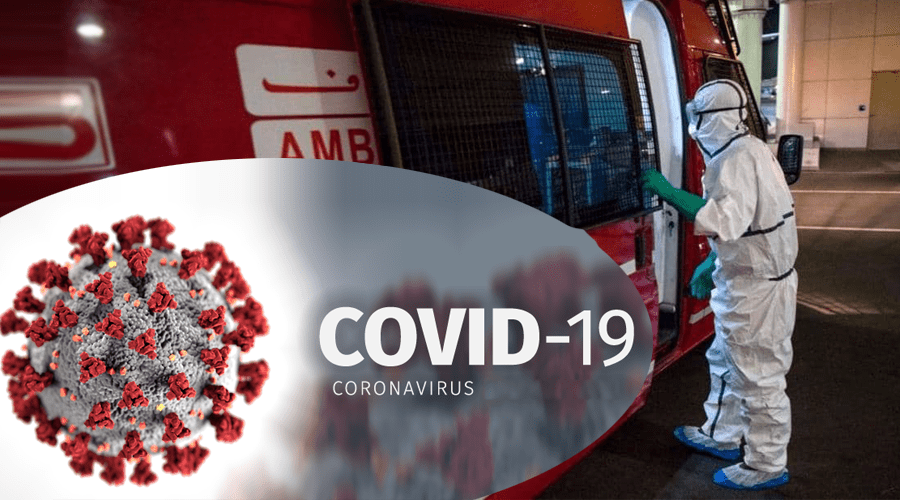
32 وفاة ب"كورونا" بجهة الشمال وعدد المتعافين يصل 353

11 حالة تعافي بالعرائش خلال 24 ساعة ولا اصابات جديدة بالفيروس
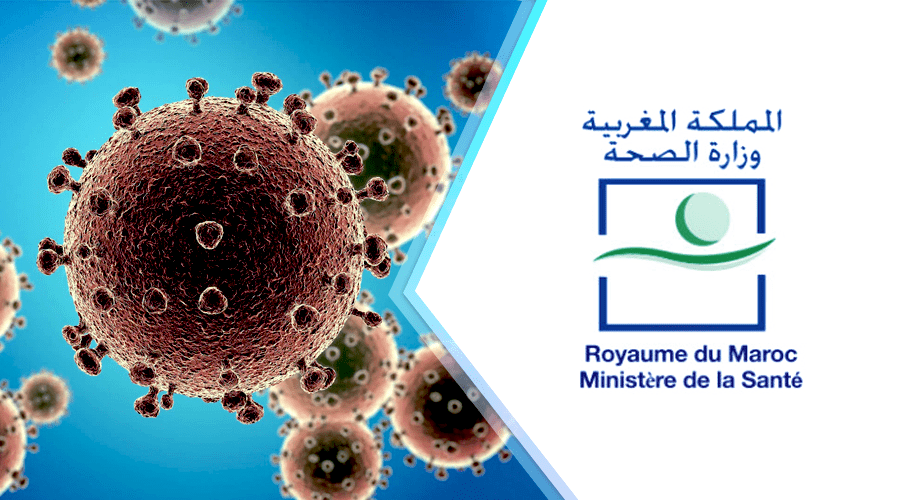
كورونا بالمغرب.. تسجيل 89 إصابة و87 حالة شفاء خلال 24 ساعة

ولاية أمن تطوان تكشف ادعاءات ضغط أمن القصر الكبير على شاب للتنازل

عناصر من القوات المساعدة تعنف وكيلا للملك بعد اجتيازه سياجا بحي بنكيران بطنجة

هكذا عرت الأمطار والرياح واقع البنية التحتية بسطات وبرشيد

تجهيز مختبر متطور للكشف عن كورونا بتطوان

هكذا فاقم الحجر الصحي عجز الميزانية خلال شهر أبريل

اتهام أعوان سلطة بالتلاعب في قفة المساعدات والنيابة العامة تدخل على الخط

تفاصيل الحالة الوبائية بالشمال خلال 24 ساعة الماضية
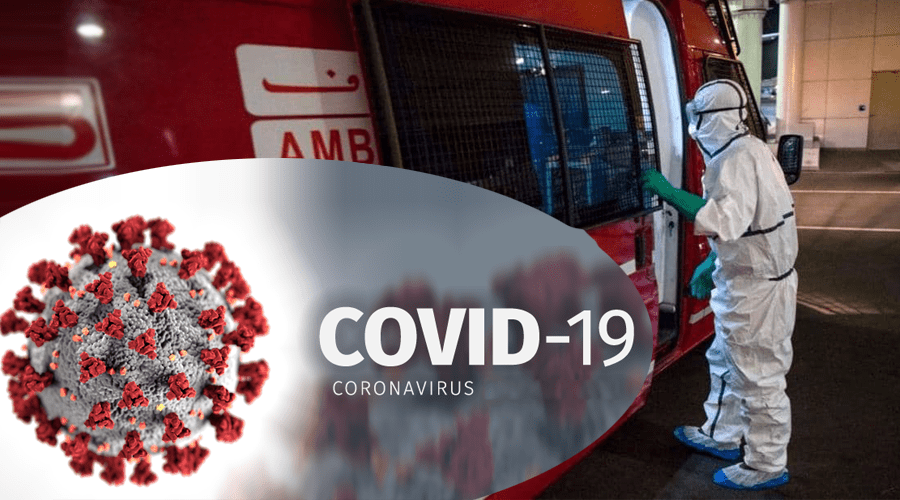
تسجيل حالتي اصابة بفيروس "كورونا" بالحسيمة بعد أيام من تحاليل سلبية

المغربي منصف السلاوي يكشف أمام ترامب موعد طرح لقاح كورونا

كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة و90 حالة شفاء خلال 24 ساعة

اليابان تعتمد رسميًا عقار ريمديسيفير في علاج كورونا

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة

الخزينة العامة: تفاقم العجز ب 10.6 مليار درهم في متم أبريل

"لارام" تفقد 50 مليون درهم في اليوم الواحد من رقم معاملاتها منذ اندلاع الأزمة

المغرب يشرع في ترحيل مواطنيه العالقين بمليلية على مرحلتين

تسجيل 541 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية شهر رمضان

الحشرة القرمزية تهاجم الصبار بأحواز القنطيرة

حواجز إسمنتية لعزل الأحياء الموبوءة بطنجة

تحفظات وزارة الصحة على رفع الحجر قبل عيد الفطر

المغرب يغير استراتيجية تعقب كورونا بإجراء 10 آلاف اختبار يومي
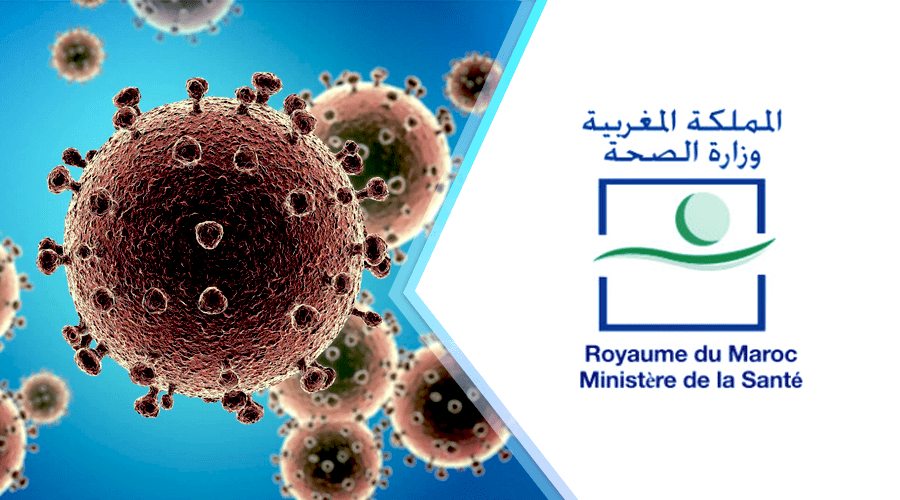
تسجيل 73 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6623

مسؤول صحي: من الصعب تغيير الحالة الوبائية خلال أسبوع ورفع الحجر سيكون بالتدريج

91 % من مرضى كورونا بالمغرب بدون أعراض و1% فقط حالتهم حرجة

إسبانيا ترحل مواطنيها العالقين بالمغرب عبر رحلات بحرية

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتغيير أسماء أخرى
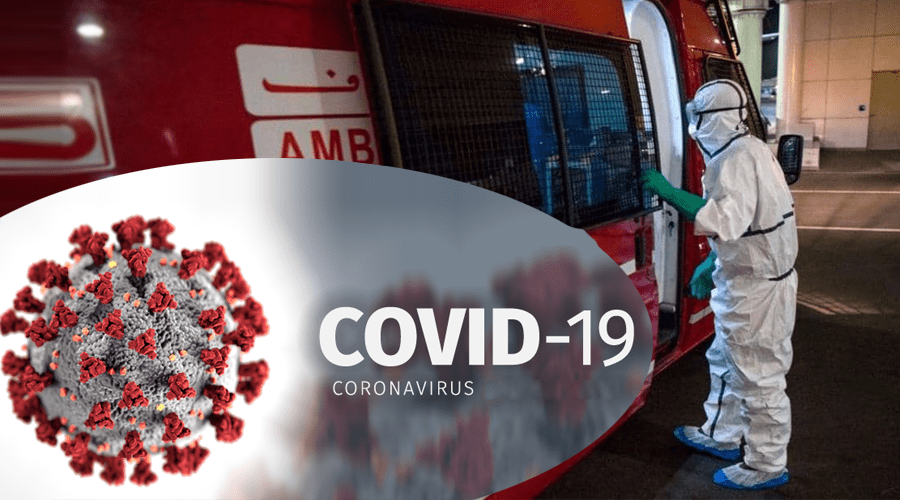
591 يتلقون العلاج من "كورونا" بالشمال وعدد التحاليل يصل 7042

هذه وضعية قطاعي الطاقة والمعادن بالمغرب في زمن كورونا

شفشاون تحافظ على صفر "كورونا" ومطالب بتخفيف اجراءات الطوارىء

لهذا يفتك كورونا أكثر بالدول الغنية

منح طلبة التعليم العالي... هذا موعد الصرف

تسجيل 17 حالة جديدة بفيروس كورونا بجهة طنجة وعدد المصابين يصل ل938

الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية

كورونا بالمغرب.. تسجيل 95 إصابة و179 حالة شفاء خلال 24 ساعة

هذه سيناريوهات إنقاذ الاقتصاد المغربي بعد إنهاء الحجر الصحي

تفاصيل العثور على قاصر وشاب منتحرين شنقا ضواحي تطوان

رعد ورياح قوية غدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة

تسجيل 91 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6593

رجل أعمال بتزنيت يصيد الغزلان في عز حالة الطوارئ

بسبب تفشي الأمراض التنفسية.. جماعة طنجة تتحاشى الكشف عن نسبة تقدم الأشغال بالمطرح الجديد

دقائق من الأمطار تغرق أحياء بمقاطعة بني مكادة بطنجة

بعد جنازة البيضاء.. وقفة احتجاجية بالقنيطرة تخرق الطوارئ

تفاصيل الحالة الوبائية بالشمال خلال 24 ساعة الماضية

3 حالات فقط تتلقى العلاج بالحسيمة في وضعية مستقرة

10 حالات تعافي بالعرائش خلال 24 ساعة ولا إصابات جديدة
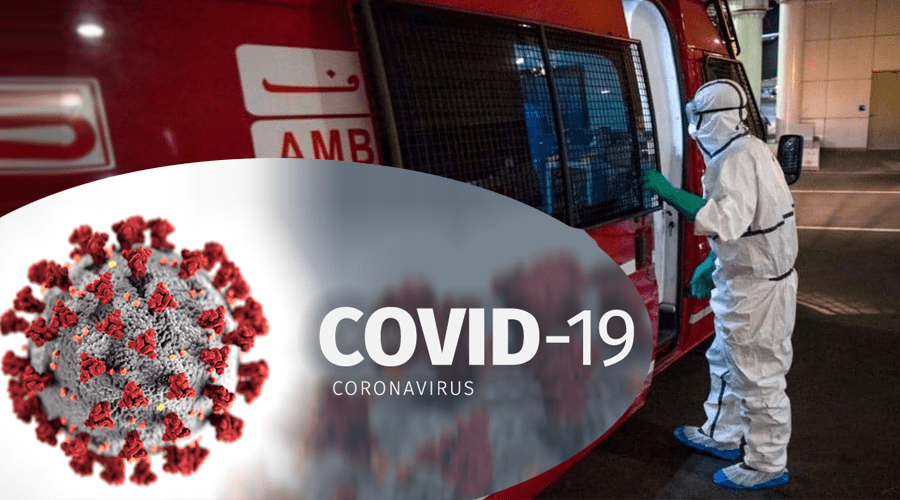
عدم تسجيل أية وفاة بكورونا في المغرب خلال 3 أيام على التوالي

وزارة التعليم تكشف طريقة التسجيل القبلي بالسنة أولى ابتدائي
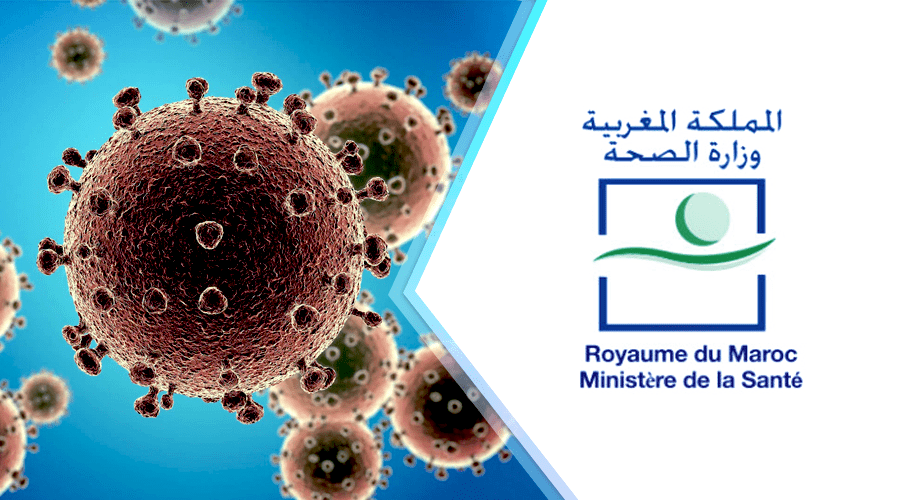
كورونا بالمغرب.. تسجيل 94 إصابة و140 حالة شفاء خلال 24 ساعة

توقيف المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل بالبيضاء

متابعة خمسة أشخاص بسيدي سليمان بتهمة نشر أخبار زائفة عبر "الواتساب"

أمن البيضاء يحدد هوية أشخاص ظهروا في فيديو يستحمون بسكة الطرامواي

الاستقلال ينتقد تدبير حكومة العثماني لأزمة كورونا ويدعو لتجاوز الصراعات السياسية

تحذير.. رياح قوية وزخات رعدية بهذه المناطق من المملكة

تصاعد أرقام المصابين بكورونا بالرباط والسلطات تغلق مداخلها

حجز حوالي طن ونصف من المخدرات ورصاصتين بإقليم سطات

تسجيل عشرات الإصابات بكورونا في صفوف الأطر الطبية

هذه تفاصيل تطبيق وقايتنا لتتبع المصابين بكورونا بالمغرب

الحبس لشخص رشق باشا بالحجارة

تجمهر السكان يتسبب في توقيف قائد بالبيضاء

تسجيل 108 حالات شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6466

14 حالة تعافي من كورونا بالشمال في 24 ساعة والمجموع يصل 276

برنامج الغذاء العالمي: 47,6 مليون شخص سيعانون من الجوع بسبب كورونا

وحدات صناعية بطنجة تستأنف أنشطتها جزئيا والسلطات تشرع في إحصاء العاملين تخوفا من البؤر

معهد ملكي إسباني يشيد بالتدبير النموذجي للمغرب في التصدي لكورونا

نشرة خاصة.. رياح قوية وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة
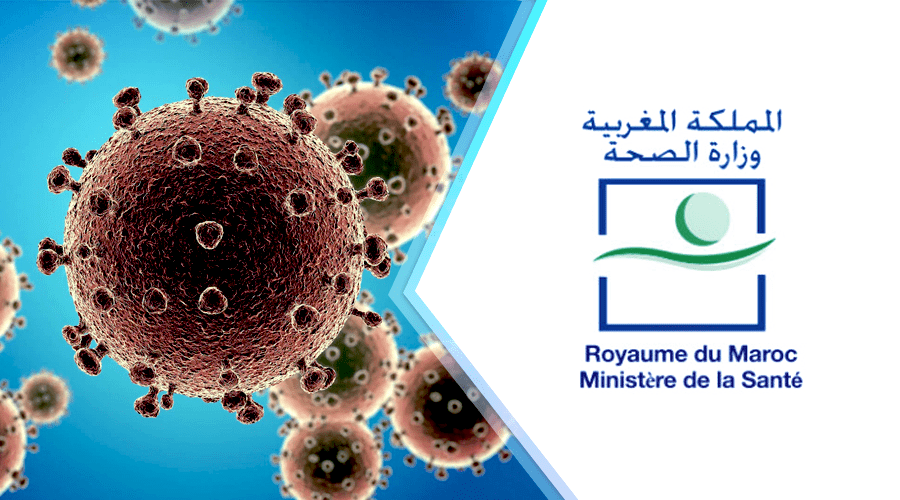
كورونا بالمغرب.. تسجيل 137 إصابة و180 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أمزازي يستعرض حصيلة التعليم عن بعد ومخطط استكمال العام الدراسي

إدارة سجن صفرو تنفي تسجيل أية حالة إصابة بكورونا

رحيل السعيدي مهندس خوصصة لاسمير

خيانة الأمانة وشيكات بالملايير تطيح بموثق بتطوان

التوقيف والإنذار في حق أعوان سلطة بالقنيطرة بسبب البناء العشوائي

خرق الحجر الصحي يهدد بتحويل مدينة الدروة إلى بؤرة لكورنا

أمزازي يكشف موعد التحاق التلاميذ بالمدارس

أمزازي : إقرار سنة بيضاء أمر مستبعد تماما

اختلاس وتبديد أموال بتعاضدية الموظفين والتحقيق يطال عبد المولى وأتباعه

تسجيل 119 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6380
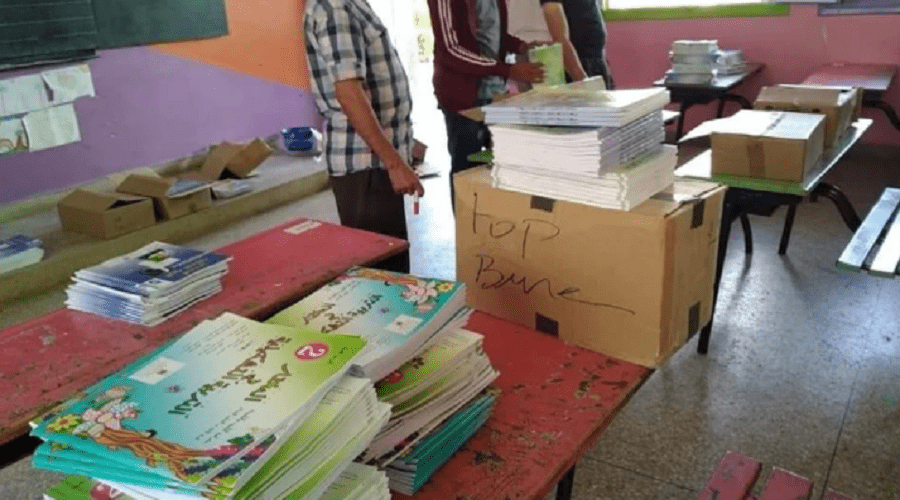
توزيع كراسات للدعم التربوي على مليون تلميذ بالمناطق النائية

7 حالات تعافي بالعرائش اليوم و5 حالات اصابة جديدة بالفيروس

تفاصيل أعداد من يتلقون العلاج من كوفيد 19 بالشمال

تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار والجودة منذ بداية رمضان

الإعلان رسميا عن تطبيق "وقايتنا" لتتبع فيروس كورونا
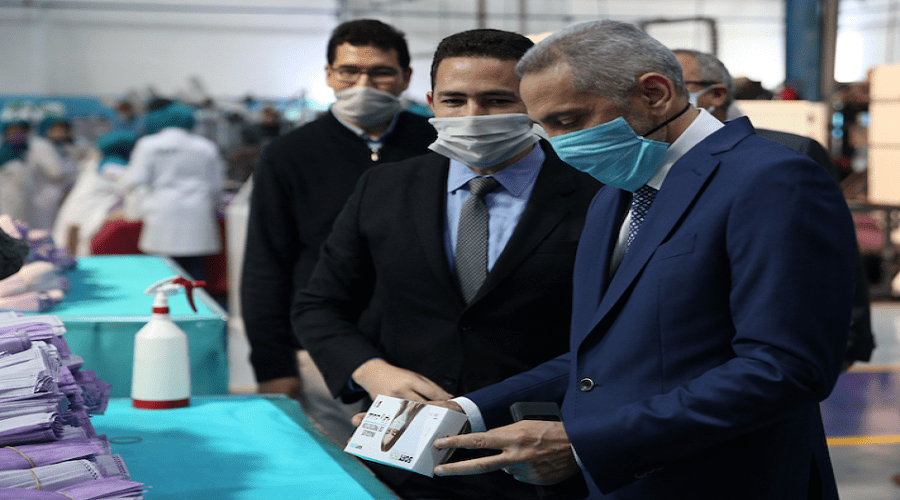
المغرب يقرر تصدير الكمامات إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
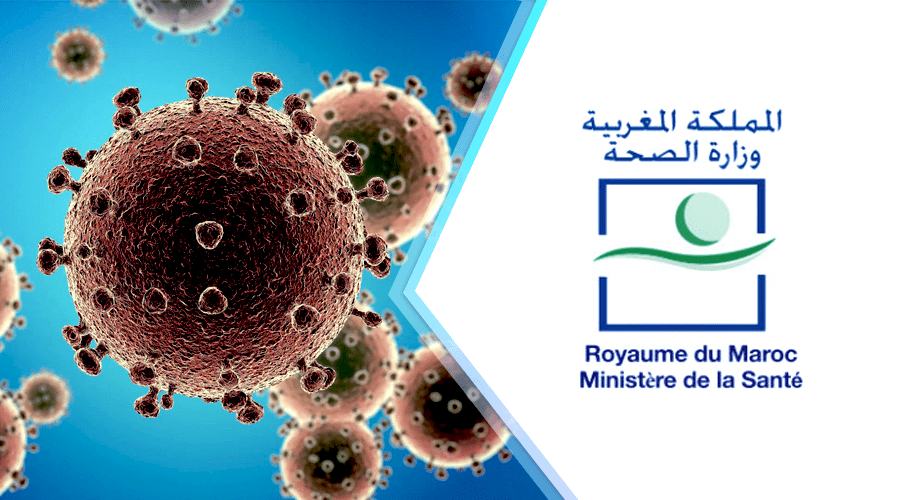
كورونا بالمغرب.. تسجيل 218 إصابة و257 حالة شفاء خلال 24 ساعة

مصدر عسكري ينفي صحة الادعاءات المتعلقة بعدد العسكريين المصابين بكورونا

71 بالمائة من المقاولين يرون أن اجراءات الدعم الاقتصادي للمقاولات غير كافية للخروج من الأزمة

ضبط 25 كيلوغرام من الكوكايين بميناء طنجة المتوسط في شاحنة قادمة من أوروبا

اختلالات بأشغال إصلاح بوابة ميناء أصيلة والسلطات تحقق

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تطلق خدمة جديدة عن بعد

مندوبية السجون تكشف سبب توقيف موظفَين بسجن طنجة

مهلة إضافية من الكاف للمغرب لتحديد توقيت عودة البطولة

انتحار معتقل في إطار قانون مكافحة الإرهاب بسجن تولال

اتهام السلطات بالتلاعب في قفة رمضان يقود فيسبوكيين إلى السجن

التحقيق في وفاة غامضة لطبيب يشتغل بمستشفى سيدي إفني

رباح يستغل الطوارئ لتمرير مخطط يهدد الثروة السمكية والنظام البيئي

تسجيل 205 حالات شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 6226

حمام منزلي يتسبب في إصابة 11 امرأة بكورونا

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

وزارة الفلاحة : أخبار مساعدات الخيول لا أساس لها من الصحة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

وزارة التعليم تطلق استطلاع رأي لتقييم عملية التعليم عن بعد

ملف.. هكذا يقضي أثرياء ومشاهير المغرب الحجر الصحي

تسجيل حالتي تعافي من كورونا بتطوان ومناطق تحافظ على صفر إصابة

وزارة التعليم تنفي صحة تصريحات منسوبة لمدير المناهج بشأن الامتحانات

تاريخ.. هكذا تمت صناعة لوبي المدارس الخاصة بالمغرب

تسجيل حالات عدوى جماعية بفيروس كورونا بالصين
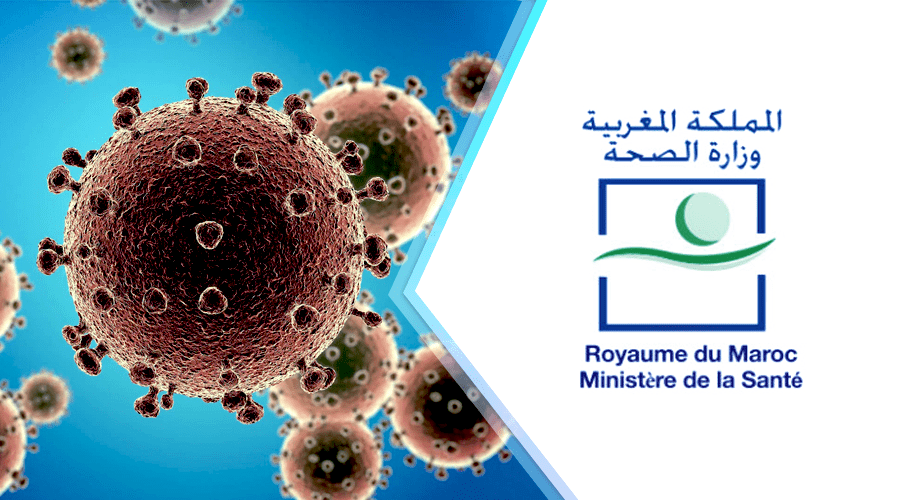
كورونا بالمغرب.. تسجيل 153 إصابة و93 حالة شفاء خلال 24 ساعة

حجز 3 أطنان ونصف من المخدرات وتوقيف شخصين بالبيضاء

الداخلية تقرر إعادة افتتاح 12 سوقا أسبوعيا بهذه المدن

مصابون بكورونا يتكلمون من داخل أقسام العزل بمستشفيات البيضاء

التحقيق في حيازة مغربي يشغل مهمة قنصل شرفي لأسلحة نارية

صحافية تتهم الرئيس الفرنسي السابق بالتحرش

هذه حصيلة الوضع الوبائي بسجون المملكة

تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب ترفع الحصيلة إلى 6038

الأمن يطيح بناشر إشاعة سنة بيضاء

إدانة فتاتين بتطوان بشهر حبسا نافذا لخرقهما قانون الطوارىء الصحية
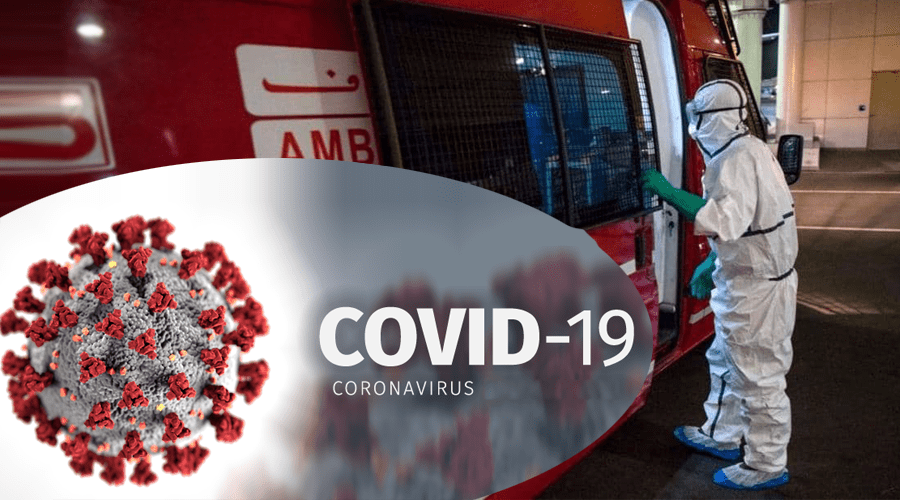
وزارة الصحة تنفي شائعات تسجيل حالات كورونا باقليم بولمان

9 حالات تعافي بالعرائش اليوم و5 حالات اصابة جديدة بالفيروس

تدابير جديدة للجنة اليقظة الاقتصادية تهم الافراد و المقاولات
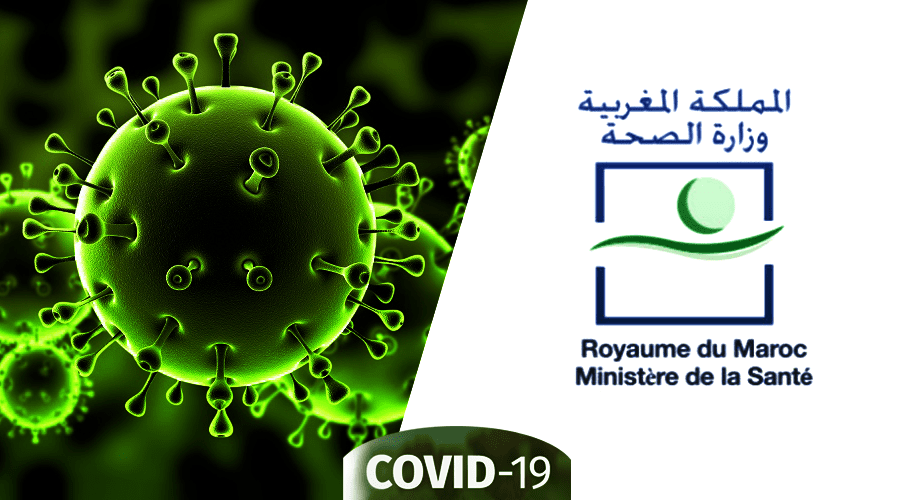
كورونا بالمغرب.. تسجيل 199 إصابة و137 حالة شفاء خلال 24 ساعة

متابعة قيادي وعضوين بشبيبة البيجيدي بعد تورطهم في صفحة فيسبوكية للكذب والتشهير

تعنيف شخص يقود عنصرين من القوات المساعدة للتوقيف

قصص رجال أمن سطع نجمهم خلال تنزيل الطوارئ بتطوان

إجراءات وقائية بجھة الداخلة وادي الذھب للحفاظ على صفر إصابة بكورونا

تاج الدين الحسيني: استثمار المغرب لدبلوماسيته الصحية سيعزز مكانته الدولية

هذه رواية الداخلية بخصوص اتهام قائد بالاعتداء على صحافية ومصور

وزير الصحة يكشف شروط رفع الحجر الصحي بالمغرب ويحذر من التسرع

هذه سيناريوهات رفع الحجر الصحي في مجال النقل بالمغرب

الدرك يستعين بمروحية لإيقاف أربعيني قتل زوجته وابن شقيقه

تسجيل 162 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب ترفع الحصيلة إلى 5873

الشروع في بث حصص التوجيه المدرسي والمهني والجامعي عبر قناة العيون

اعتماد الانتقاء عبر منصة توجيه عوض الانتقاء الأولي لولوج هذه المدارس

البؤر الصناعية بطنجة والعرائش وراء 61 حالة إصابة جديدة في يوم واحد بالجهة

توقيف طبيب بتطوان في حالة تلبس وبحوزته وصفات القرقوبي دون أسماء

4 حالات تعافي بالعرائش في 24 ساعة ومجموع التحاليل الايجابية يصل 129
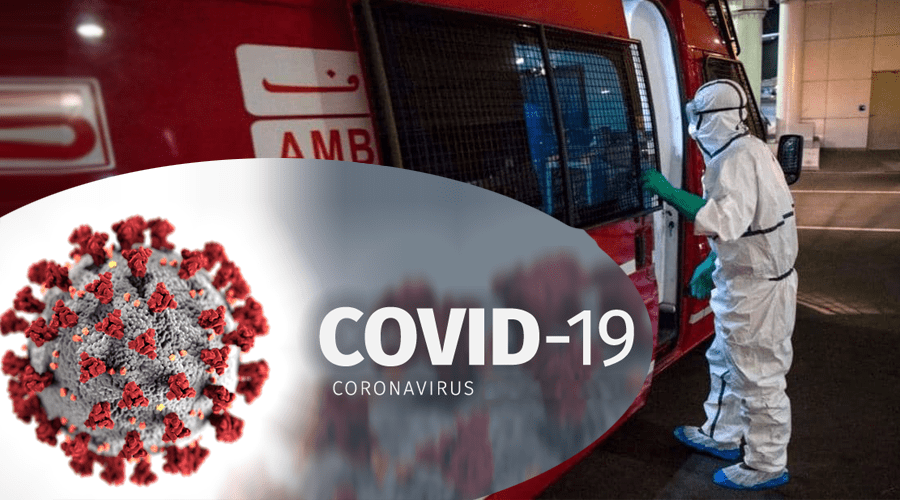
بؤر عائلية وصناعية ترفع إصابات كورونا بالمغرب

مجلس الحكومة يشيد بتدابير سفارات وقنصليات المملكة تجاه المغاربة العالقين

كورونا بالمغرب.. تسجيل 145 حالة شفاء و163 إصابة خلال 24 ساعة

خبير إيطالي : إدارة المغرب لأزمة كورونا نموذج يمكن الاقتداء به

8 دول تسارع لاقتناء عقار تقليدي صيني بعد إثبات فعاليته في علاج كورونا

بالفيديو.. توقيف أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وصوروا اعتقالات وهمية

وزارة الصحة تكشف حقيقة الوثائق المتداولة بخصوص رفع الحجر الصحي
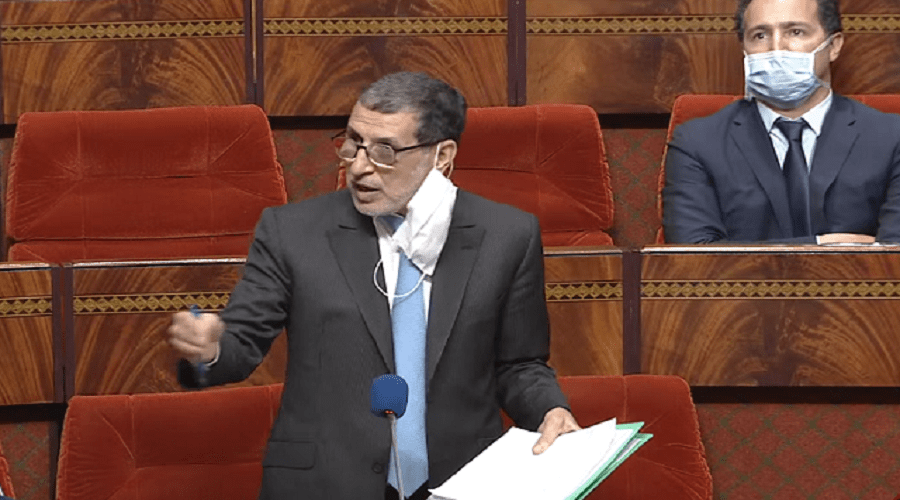
استفادة المدارس الخاصة من دعم صندوق كورونا يخلق الجدل

إصابة طبيبة وممرضة بكورونا يثير استياء الأطر الصحية بسوس

اكتشاف بؤر عائلية لفيروس كورونا يستنفر سلطات طنجة

البعوض يشعل الحرب بين مجالس الشمال

اعتقال مشتبه فيه بالإرهاب بإسبانيا بالتنسيق مع الأمن المغربي
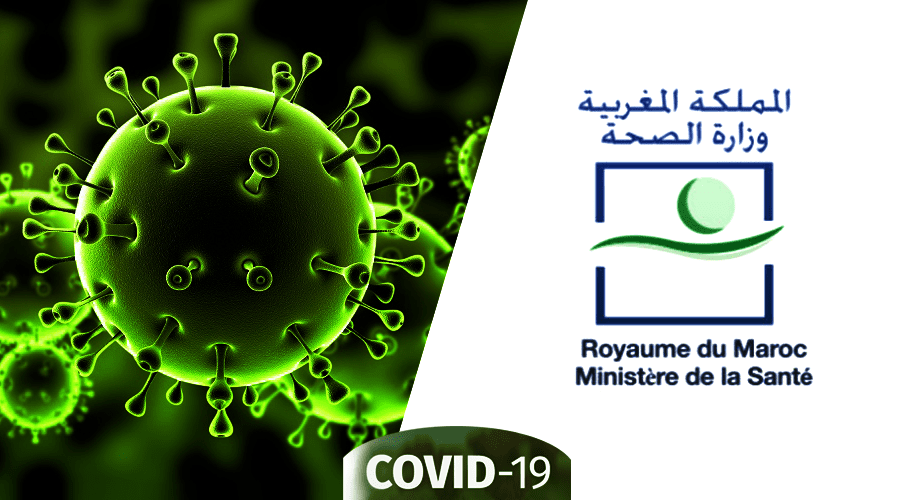
تسجيل 123 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 5661

استنفار بقناة ميدي1 تيفي بطنجة بعد الاشتباه في إصابة رئيس تحرير بكورونا

وزارة ااتعليم تنفي ما يتم تداوله بخصوص إعلان نجاح جميع التلاميذ

3 حالات فقط تتلقى العلاج بالحسيمة وقرب اعلان المنطقة بدون وباء

18 حالة تعافي من "كورونا" بالشمال في 24 ساعة والمجموع يصل 206

وزارة الصحة تضع مخططا لرفع الحجر الصحي يوم 20 ماي

هكذا يتم التحضير لعودة المغاربة العالقين بالخارج

19 حالة إصابة جديدة بجهة طنجة ترفع عدد المصابين ل 780 مصابا

مستشار استغل حالة الطوارئ لحفر بئر بسيدي سليمان

مدير الأوبئة : 3186 حالة تتلقى العلاج من كورونا

الحكومة تضع قانون شبكات التواصل الاجتماعي في الثلاجة
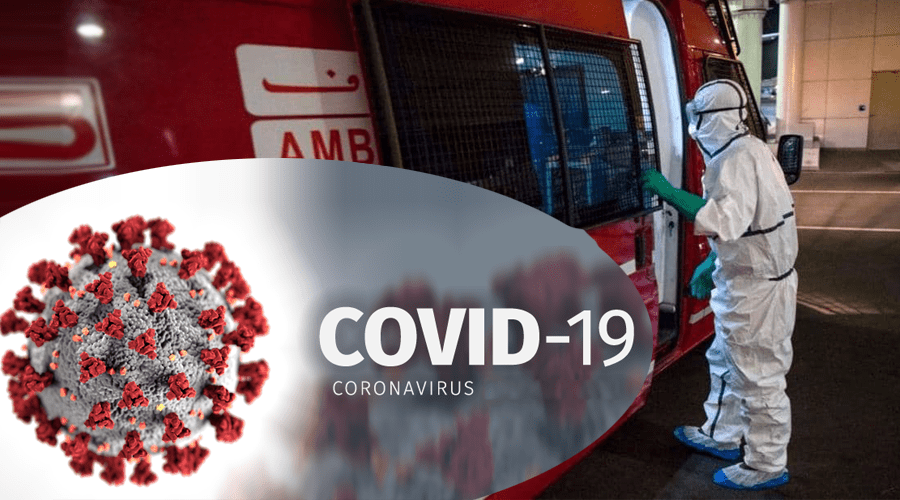
كورونا بالمغرب.. تسجيل 140 إصابة و162 حالة شفاء خلال 24 ساعة

انطلاق بيع طابع بريدي حول موضوع المغرب متحد لمواجهة كوفيد-19

مجلس الحكومة يصادق على قانون لتحرير الإصلاح الزراعي

اينوي تقدم مجموعة جديدة من فورفيات الهاتف النقال

هذه أسباب إعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة

هكذا يهدد السقي بالمياه العادمة بنشر كورونا في سطات وبرشيد والنواصر

تسجيل أول إصابة بكورونا يستنفر سلطات بن سليمان

كورونا بالمغرب.. تسجيل 107 حالات شفاء جديدة والإصابات تبلغ 5505

أيقاف طبيب نساء مزيف بطنجة وحجز أدوية وسلاح ناري

نسبة المتعافين من كورونا بالمغرب من الأعلى عالميا

8 حالات تعافي بالعرائش في 24 ساعة وعدد الاصابات يصل 123

4962 تحليلا سلبيا لفيروس كورونا بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

صحيفة إسبانية.. المغرب تحرك بكل جرأة وسرعة في التصدي لكورونا

أساتذة مؤسسة للتعليم الخاص بسيدي سليمان يطالبون بأداء أجورهم

توقيف طبيب نساء مزور بطنجة

تسجيل 179 حالة شفاء من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة

ترحيل فرنسيين عالقين بالمغرب عبر مطار مراكش

صحيفة فرنسية : المغرب ضمن 5 دول في العالم طبقت الحجر الصحي بشكل صارم

ملفي عزل رئيسين عن البام بالشمال أمام إدارية الرباط

آباء يحتجون بواسطة السيارات أمام مدرسة خصوصية بطنجة قطعت الدروس على أبنائهم

المصادقة على قانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
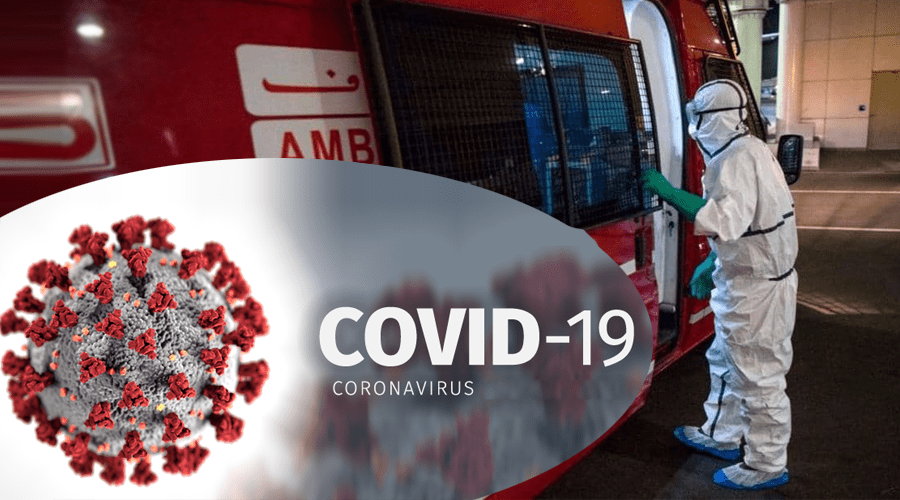
تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بمدينة بوزنيقة

اتهام السلطات بالتلاعب في رخص التنقل يقود مدونا للاعتقال

هذه تفاصيل إعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة من مهامه

اقتراب نفاذ مخزون صفائح الدم بمستشفيات البيضاء يهدد المرضى

كورونا بالمغرب.. تسجيل 131 حالة شفاء جديدة والإصابات تبلغ 5382

مشاهد نادرة من زلزال أكادير المدمر

العرائش تسجل 34 حالة تعافي من أصل 119 اصابة بكورونا

5 فقط يتلقون العلاج بالحسيمة وصفر "كورونا" بشفشاون والمضيق ووزان

مشاهد حصرية ليوم تشييع المغاربة لجنازة الملك الراحل محمد الخامس
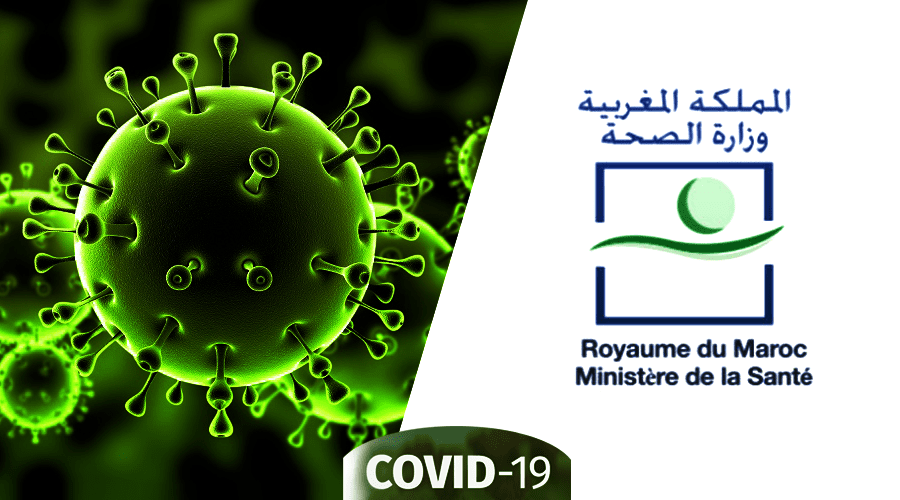
المغرب يسجل 185 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

دولة أوروبية تعلن السيطرة على وباء كورونا

حجز أزيد من 3 أطنان ونصف من المواد الغذائية الفاسدة بتارودانت

المغرب ينتج 160 مليون كمامة ويستعد لتصديرها إلى الخارج

مندوبية السجون تعرض مستجدات الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية

ألو 2233.. منصة جديدة للتواصل بين وزارة الشغل والمرتفقين

وزارة التعليم تنفي شائعات حول إعلان سنة بيضاء

ارتباك في تدبير جائحة كورونا بجماعة طنجة

انطلاق محاكمة ولد الفشوش المتهم بخرق الطوارئ وإهانة الأمن بتطوان

تفاصيل إخضاع 146 عاملا للكشف بعد مخالطتهم لمصاب بكورونا

خلطات تقليدية لعلاج كورونا تتسبب في مقتل شخص وأطباء يحذرون
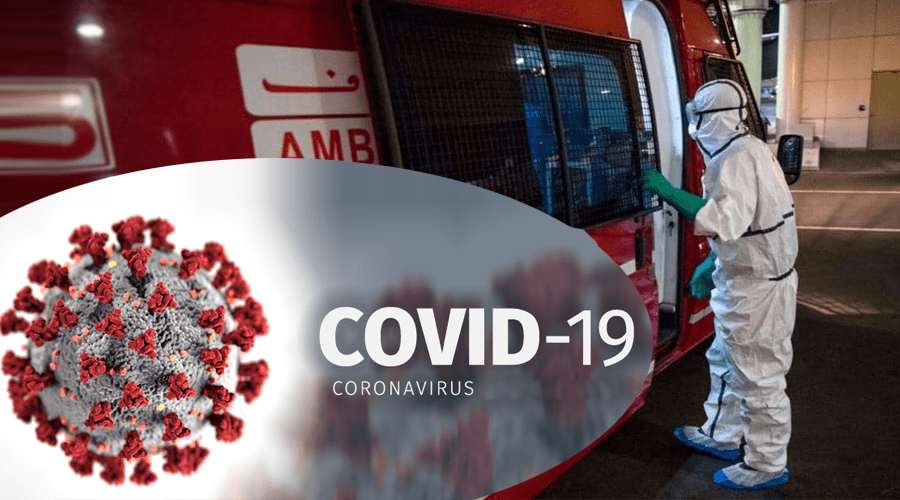
المغرب يسجل 146 حالة شفاء جديدة من كورونا والإصابات تبلغ 5153

الملك يترحم على روح جده الملك محمد الخامس

روبورتاج.. أزمة كورونا تخفض أثمنة الدجاج ومهنيو القطاع يشتكون

الوضع الوبائي في المغرب.. إلى أين ؟ مع الدكتور محمد عبور

الداخلية تحذر من استعمال مياه الصرف الصحي بسبب انتشار جينات كورونا عبرها (وثيقة)

الحسيمة تتجه الى التعافي من الوباء بصفر وفيات و6 حالات تعافي

23 حالة شفاء جديدة ترفع عدد المتعافين من كورونا ل 170 حالة بجهة طنجة

4214 تحليلا سلبيا لكورونا بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

أزيد من 900 ألف أجير تم التصريح بتوقفهم عن العمل برسم شهر أبريل

لجنة وزارية.. الأسواق مزودة بشكل جيد والعرض يغطي حاجيات رمضان

المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية للمتعافين من كورونا

وزارة الصناعة والتجارة.. اختيار 34 مشروعا استثماريا لمواجهة وباء كورونا بالمغرب
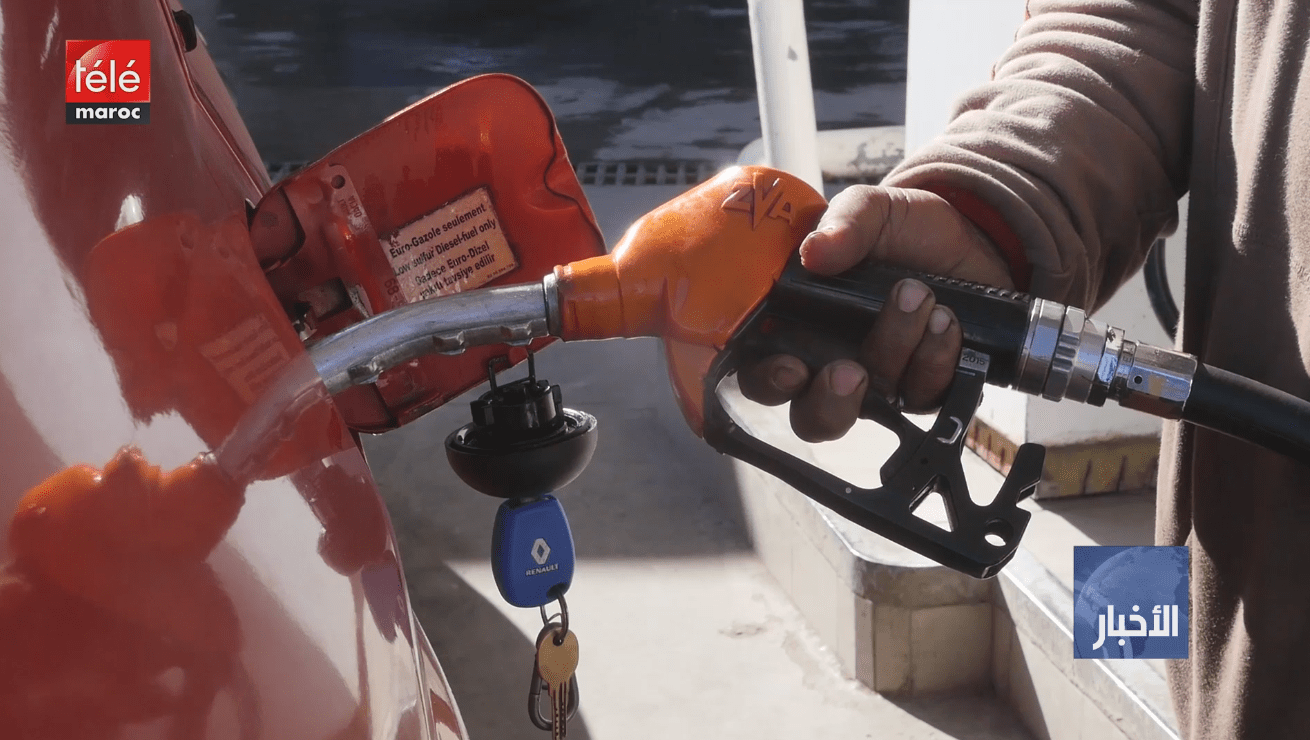
وزارة الطاقة والمعادن.. وضعية إمدادات السوق الوطنية بالمواد البترولية مستقرة

وزير التربية.. برمجة الامتحانات رهينة بظروف رفع الحجر الصحي

رئيس النيابة العامة يوجه دورية لتفعيل التكوين عن بعد

رئيسة قسم التمريض بكوفيد 19 بتطوان تصر على العمل رغم مرضها المزمن

حجز أزيد من 7 أطنان من المخدرات وتوقيف 3 أشخاص بالبيضاء

هكذا يتماطل الشوباني في أداء 8 ملايير ديونا لشركة لارام

هكذا تتصدى مصالح الحموشي وحرمو لمافيا المخدرات في زمن كورونا

التحقيق في وضع سيدة بمصلحة العزل دون إصابتها بكورونا
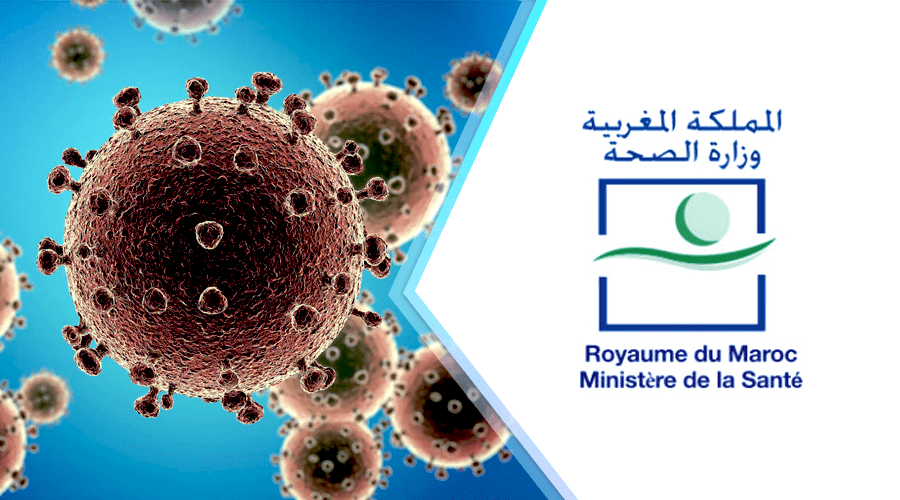
كورونا بالمغرب.. تسجيل 127 حالة شفاء جديدة والإصابات تبلغ 5000

هذه الحالة الوبائية بسجون جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

تسجيل 30 حالة شفاء من فيروس كورونا في يوم واحد بجهة طنجة

جهتي العيون والداخلة خاليتين من كورونا

تعافي طبيب بتطوان من كورونا والتحاليل السلبية في ارتفاع

تسجيل 182 حالة شفاء من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 4903

بومبيو يؤكد وجود أدلة على أن مصدر كورونا هو مختبر ووهان
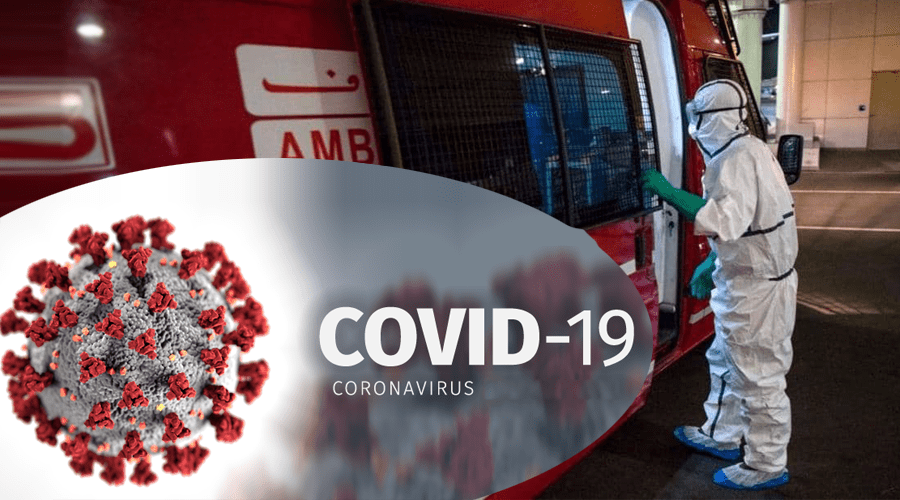
صفر حالة كورنا في صفوف رجال الأمن بتطوان

شركة طيران ريان إير تسرّح 3 آلاف موظف بسبب أزمة كورونا

وفاة شخص كان محتفظا به تحت المراقبة الطبية ببني ملال

تاريخ.. هكذا كان يتم تدبير الأزمات في المغرب

بالفيديو.. فرنسي يدهس قطيعا من الأغنام عمدا ضواحي المحمدية

المهنة : حاقد على المغرب
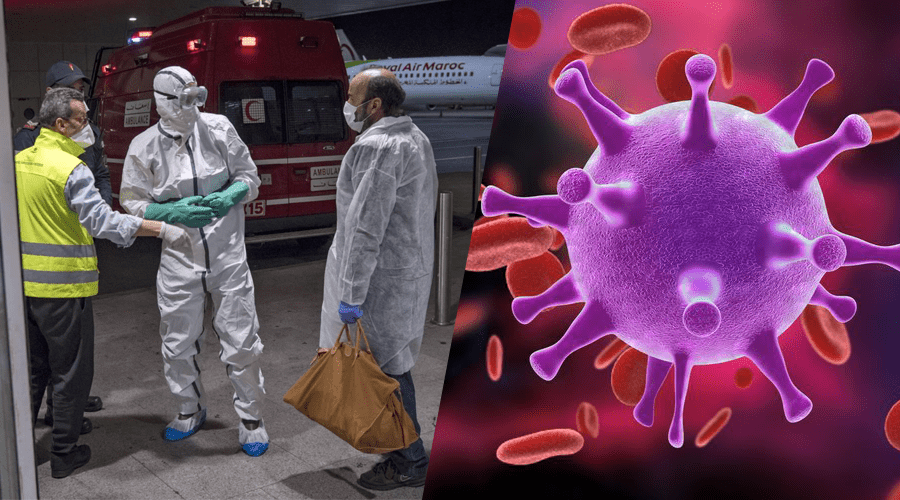
فرانس سوار.. المغرب أصبح نموذجا يثير الإعجاب في تدبير كورونا
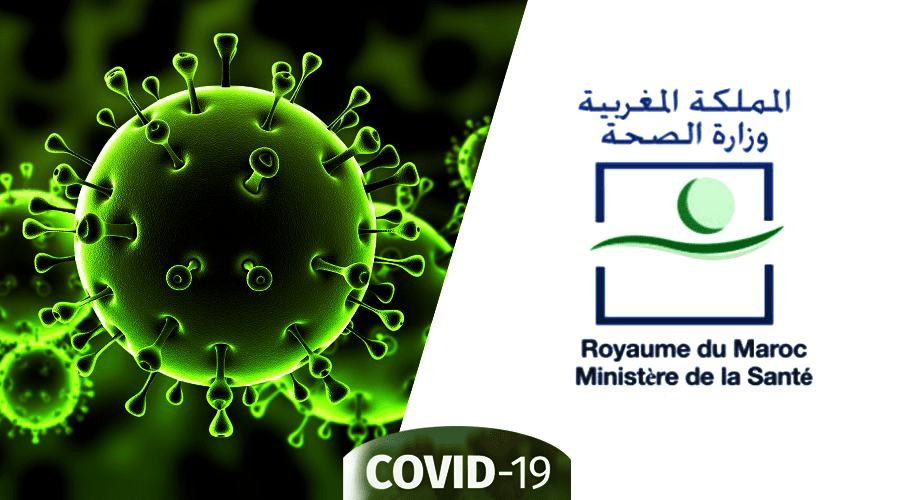
المغرب يسجل 168 حالة شفاء جديدة من كورونا والإصابات تبلغ 4880

وزان تعود لصفر "كورونا" بعد تعافي سيدة من الفيروس

التلاعب في قفة المساعدات يطيح بعوني سلطة
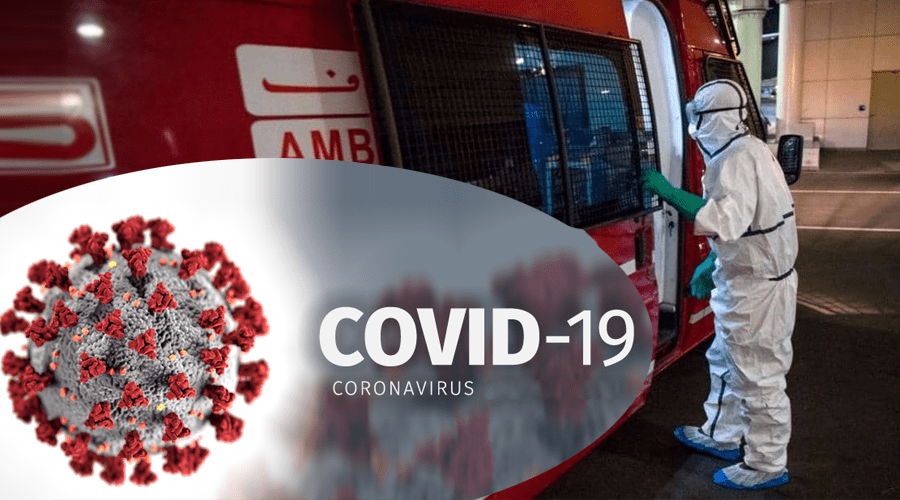
تسجيل 173 حالة شفاء خلال 24 ساعة بالمغرب والإصابات تبلغ 4729

نشرة خاصة.. الحرارة تبلغ 43 درجة بهذه المناطق من المملكة

بسبب كورونا.. نادية فتاح علوي أمام البرلمان

انخفاض حالات العنف ضد النساء بالمغرب خلال فترة الحجر

كفاءات طبية عسكرية تسهم في محاصرة كورونا بالشمال

3 حالات تعافي بتطوان وعدد المؤكد اصابتهم بالفيروس في انخفاض
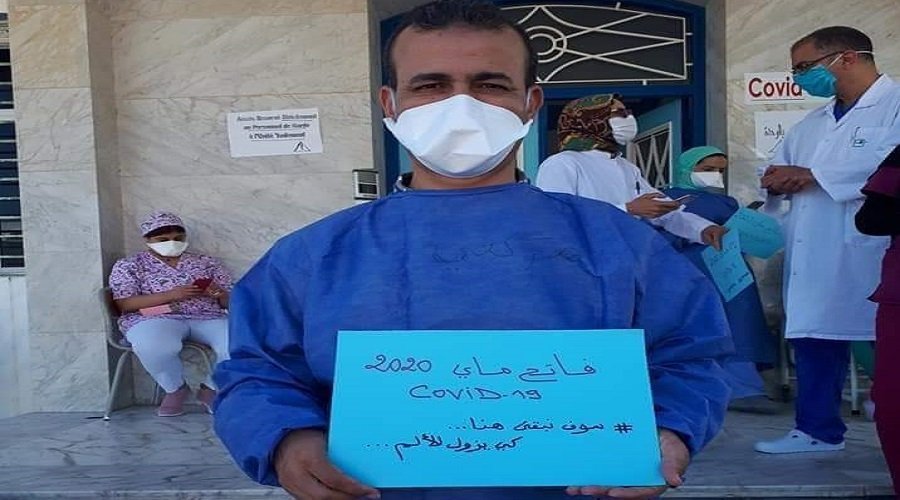
مصلحة كوفيد 19 بتطوان تحتفل بفاتح ماي تحت شعار سنبقى هنا، حتى يزول الألم

وزارة الصحة تتدارس مساعدة مسرحي بعد 3 أشهر من وفاته

تسجيل 152 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 4687
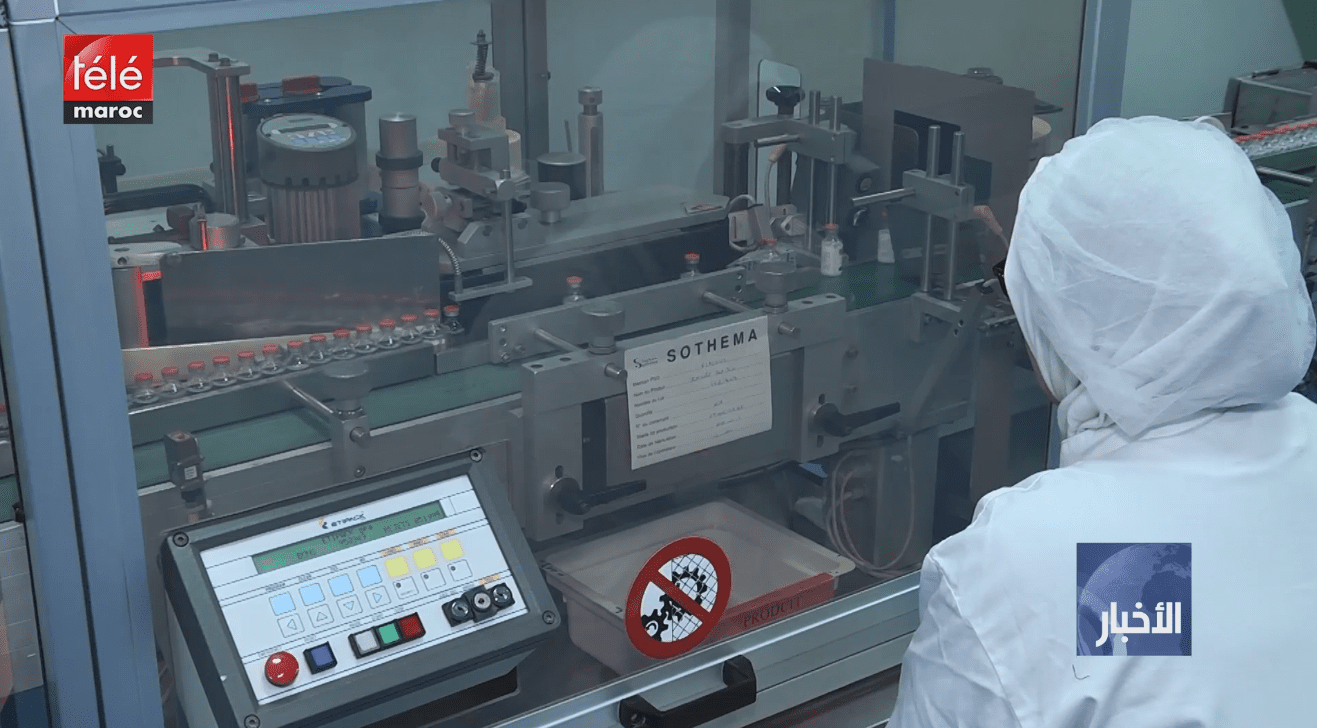
جمعيات.. مطالب للعثماني بتوفير الحماية لأجراء المقاولات المشتغلة في فترة الحجر الصحي

منظمة أوكسفام تدعو المغرب لمعالجة الفوارق التي قد تنفجر مع أزمة كورونا

روبورتاج.. مقاولات صناعية ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف كمامة في اليوم لتغطية الأسواق الوطنية

روبورتاج.. الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفيات تواصل عملها لمحاربة وباء كورونا في رمضان

انتحار سجين بسجن عكاشة بالدار البيضاء

تعافي 101 مصاب من كورونا بجهة طنجة .. ضمنها خمسيني قضى 3 أسابيع تحت التنفس الاصطناعي

أمن تطوان يوضح مزاعم تشريد اسبانية واضرام النار في منزل تكتريه بمرتيل

"لوموند" : انتاج سبع ملايين قناع يوميا يسمح للمملكة بالبدء في التصدير

قناة روسيا اليوم تقدم المغرب وألمانيا كنموذج في مواجهة كورونا

تسجيل 99 حالة شفاء من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 4569

قرار رفع حالة الطوارئ الصحية رهين بنزول مؤشر انتشار الفيروس لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين

شهر رمضان.. الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات والأسعار مستقرة

ارتفاع المبادلات التجارية للسلع و ارتفاع العجز التجاري الى 209.2 مليار درهم

المصادقة رسميا على رفع سقف التمويلات الخارجية

رئيس وزراء روسيا يعلن إصابته بكورونا

نشرة خاصة.. درجات حرارة تصل 41 درجة في هذه المدن
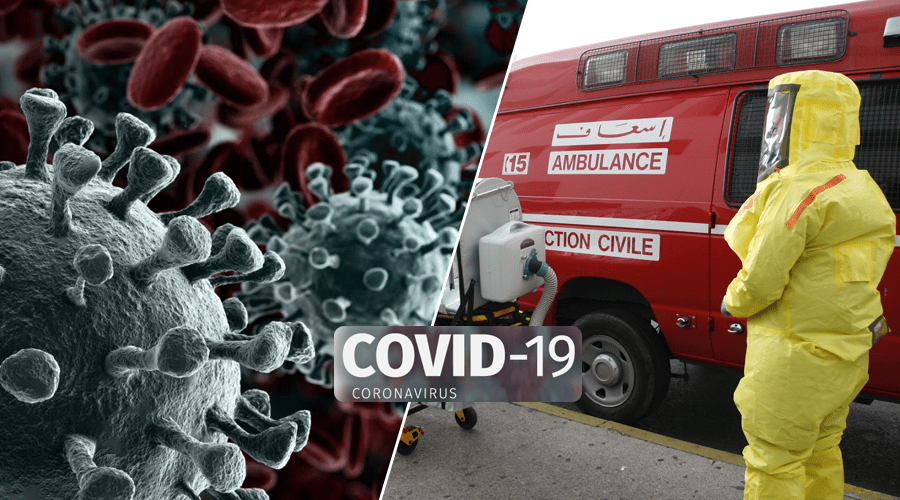
إغلاق مركز تجاري بطنجة بعد إصابة مستخدم بكورونا

اتهامات بالتلاعب في القفة ببرشيد والأمن يحقق

أمن الرباط يطيح بمغتصب قاصر تحت التهديد

هكذا تستعد الداخلية لسيناريوهات رفع الحجر الصحي
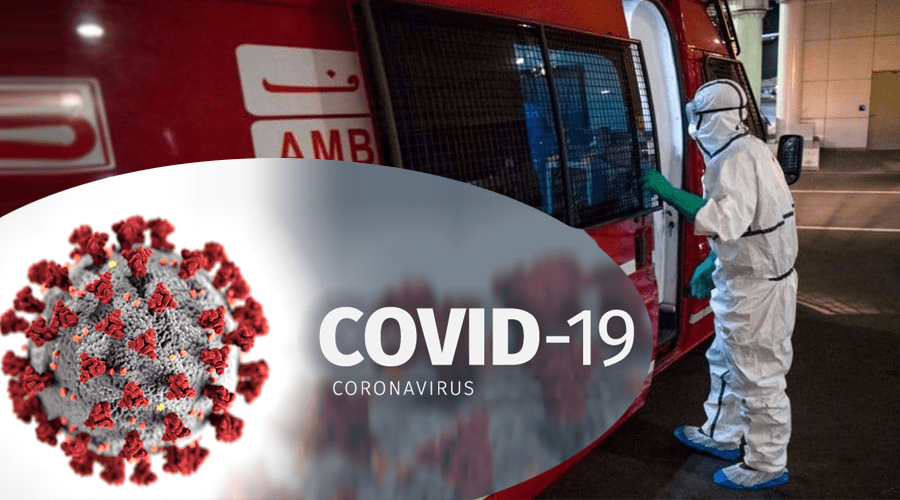
حالات الشفاء بالمغرب من كورونا تتجاوز الألف حالة والإصابات تبلغ 4529

الصين ترسل كمامات بجودة عالية لسكان بالحسيمة تضامنوا معها ضد الجائحة

تسجيل 56 حالة شفاء من كورونا والإصابات تبلغ 4423

وزارة السياحة ترخص لمهنيي السياحة بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين

تعافي رجل أمن بتطوان من "كورونا" و38 غادروا المؤسسة الاستشفائية

المصادقة على قانون سن أحكام خاصة بعقود الأسفار والمقامات السياحية
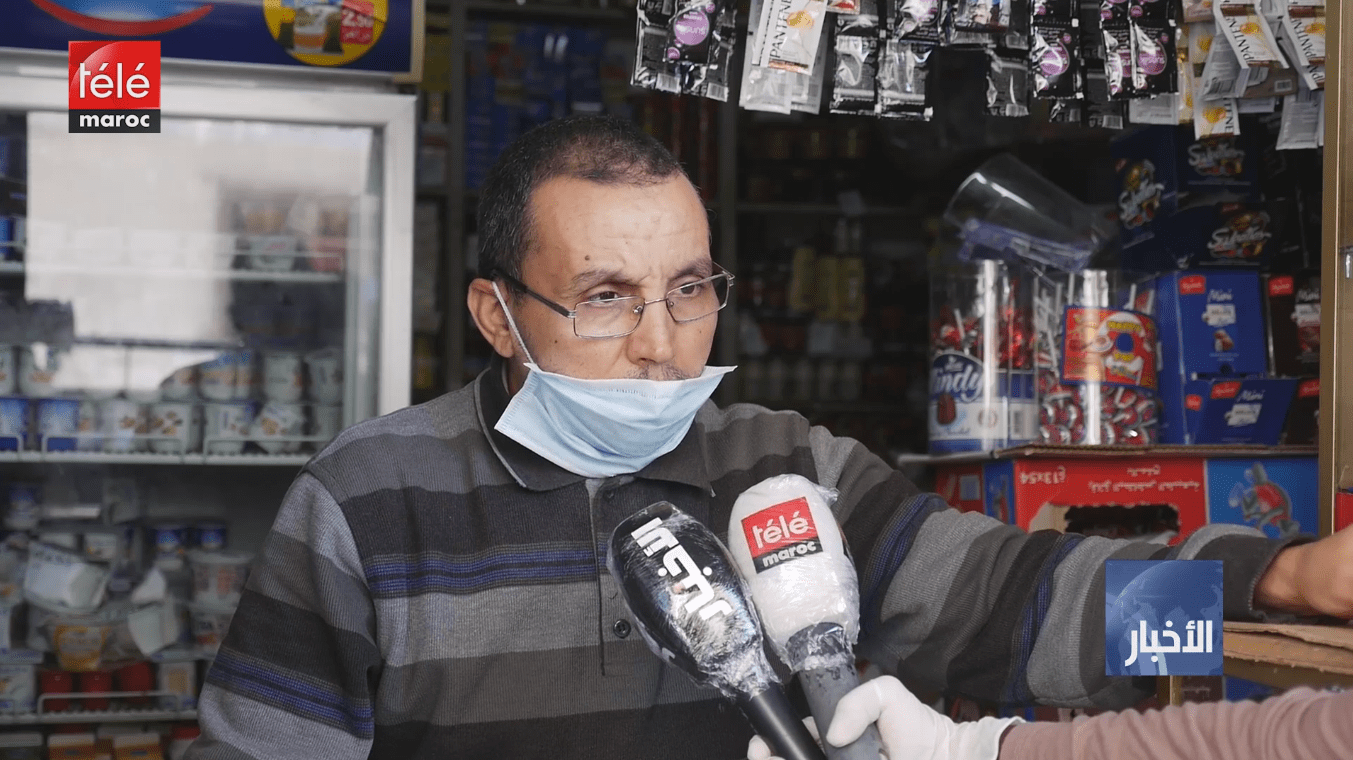
روبورتاج.. البقالون يشتكون من نفاذ الكمامات الواقية بسبب الإقبال الكبير عليها

وزارة التربية الوطنية تنفي صحة الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات
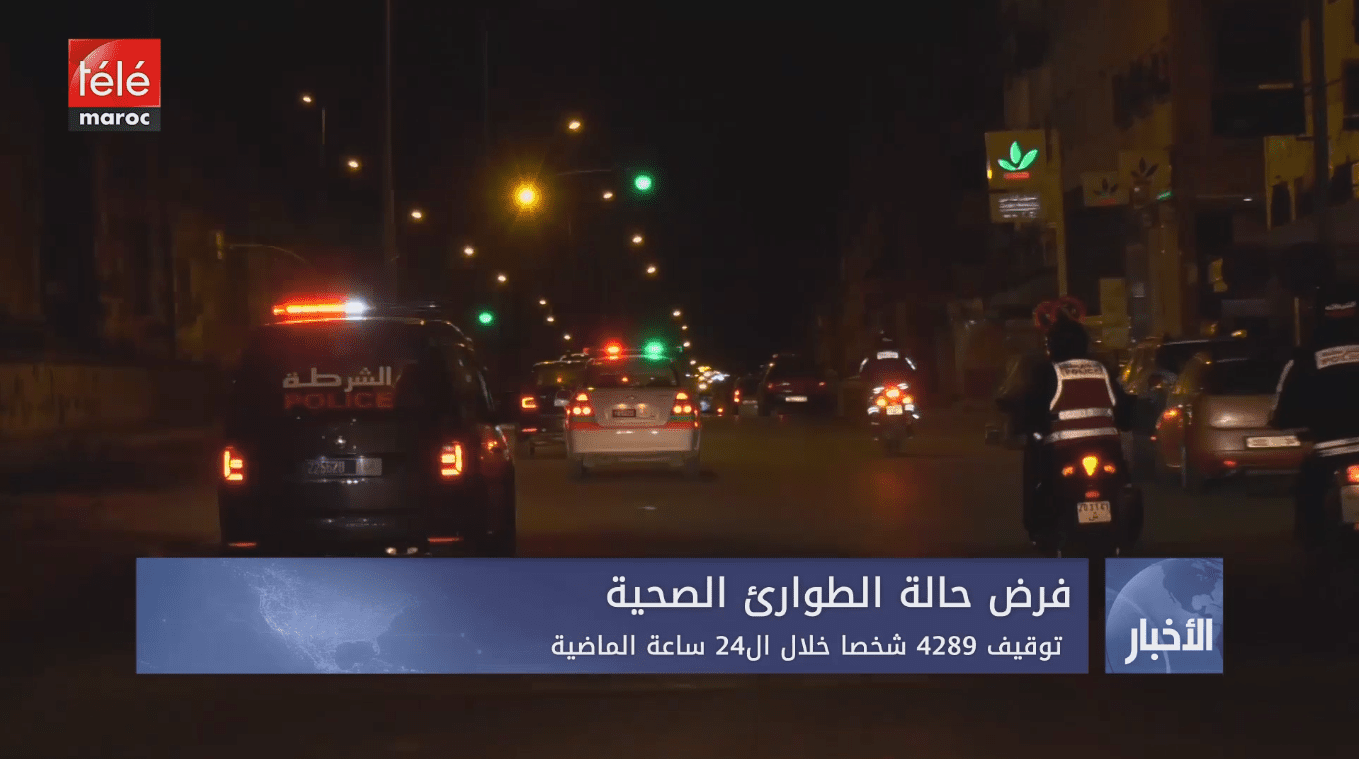
حالة الطوارئ الصحية.. توقيف 4289 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

لفتيت يكشف عدد الأسر المستفيدة من إعانات كورونا وسيناريوهات رفع الطوارئ

رامز جلال يشعل الخلاف بين إم بي سي ونقابة الإعلاميين المصريين

تجار بالعيون يقدمون مساعدات غذائية ومالية للجالية القمرية

تفاصيل إخضاع عمال ببرشيد لتحاليل كورونا

تفاصيل وضع 361 شخصا في أحياء جامعية بالقنيطرة في الحجر الصحي

التلاعب في قفة المساعدات يجر جمعويين أمام القضاء

وزيري الداخلية والفلاحة يحددان مساحة وشروط تمليك الأراضي السلالية
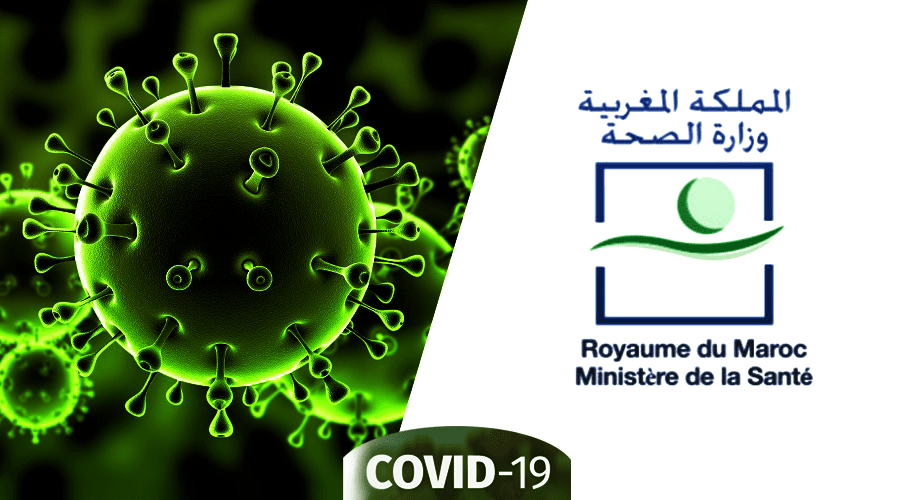
كورونا بالمغرب.. تسجيل 38 إصابة جديدة و41 حالة شفاء

حفر مقالع الرمال تتسبب في غرق فلاح بسيدي قاسم

لفتيت : أشخاص لم يستحقوا دعم كورونا وأخذوه وآخرون يستحقونه لم يتوصلوا به
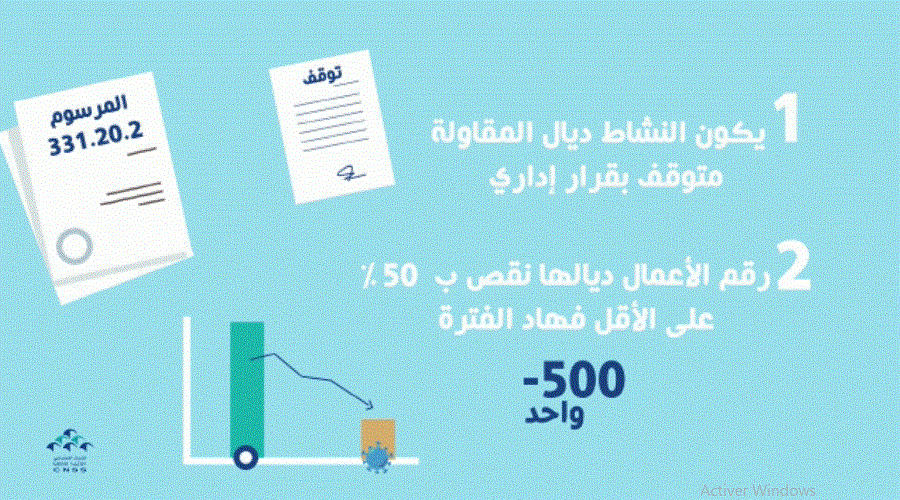
بالفيديو.. شروط صرف تعويضات شهر أبريل للأجراء المتوقفين عن العمل

توقيف ثلاثيني وبحوزته 400 كمامة واقية لا تستجيب للسلامة الصحية

النيابة العامة تدعو لتسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد

حالتا تعافي من كورونا بتطوان وتحاليل سلبية بشفشاون
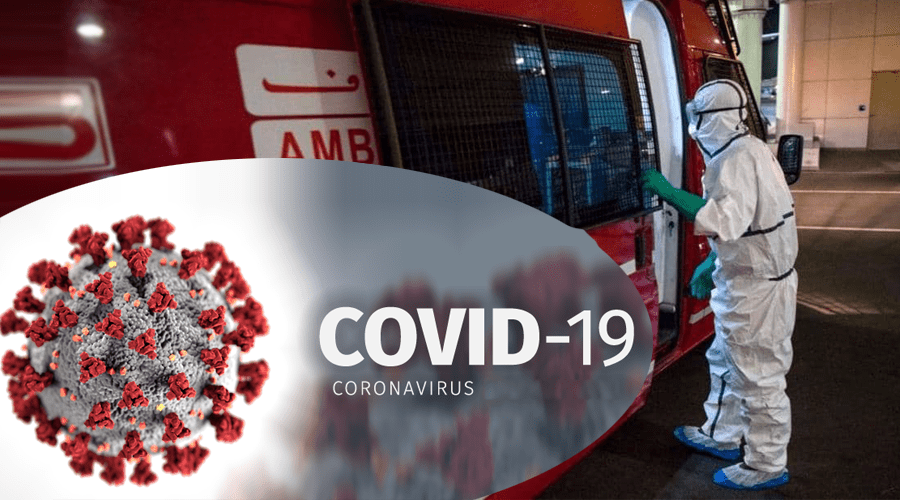
تسجيل 150 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 4321

هذه أهم الأوبئة التي عرفها المغرب المعاصر وهكذا تم علاجها

مركز أبحاث : الملك انتهج مقاربة استباقية لمواجهة التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية لكوفيد-19

الاستخبارات والبنتاغون الأمريكيان ينفيان أن يكون كورونا سلاحا بيولوجيا

روبورتاج.. أزمة كورونا تخفض حوادث السير وأعداد الضحايا تتهاوى بشكل كبير

الطوارئ الصحية.. توقيف 4582 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

الطوارئ الصحية.. المغرب يفند بشكل قاطع مزاعم بعض المنابر الصحفية

الـ CNSS يكشف إجراءات صرف التعویض الجزافي لشھر أبریل 2020

إهانة قائد وخرق الطوارئ يقود شابا للسجن

سفارة المغرب بروسيا تعلن مواصلة تعبئتها لخدمة الجالية المغربية

وزارة الفلاحة : الأسواق ممونة جدا والأسعار أقل من رمضان الماضي

الإطاحة بنصاب انتحل صفة دبلوماسي واستهدف شركات ومرشحين للهجرة

تفاصيل قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي الذي أثار أزمة بالحكومة

تعافي 112 حالة جديدة من كورونا بالمغرب

سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة : الانتهاكات المزعومة ضد المغرب غير واردة في أية وثيقة رسمية للمفوضية

الطاقم الطبي لكوفيد 19 بتطوان يختار حمل ملصقات لصور شخصية

مدير الأوبئة : 8850 مخالطا لمصابين بكورونا لا يزالون قيد التتبع
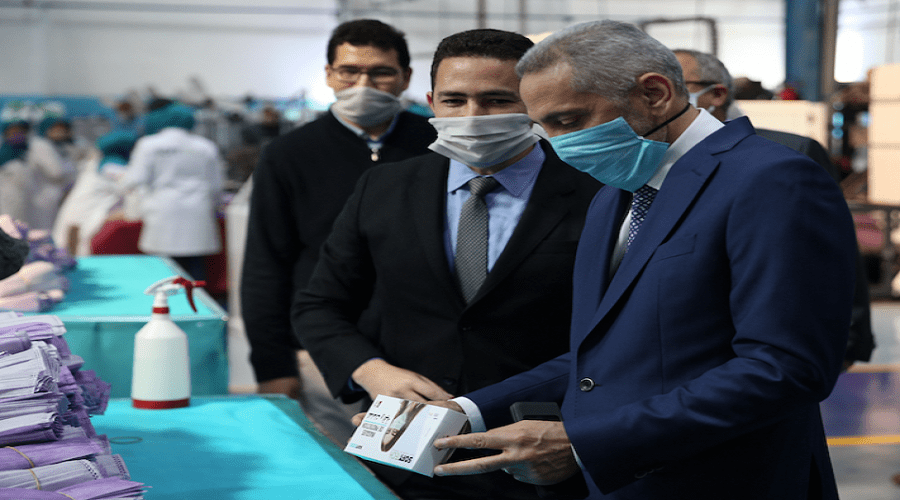
العلمي يؤكد تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة يوميا

الولايات المتحدة تسلّم معدات واقية من كورونا لمعهد الصحة بالرباط

روبورتاج.. السلطات تعزل أحياء بكاملها وتشدد ولوجها خوفا من انتشار كورونا
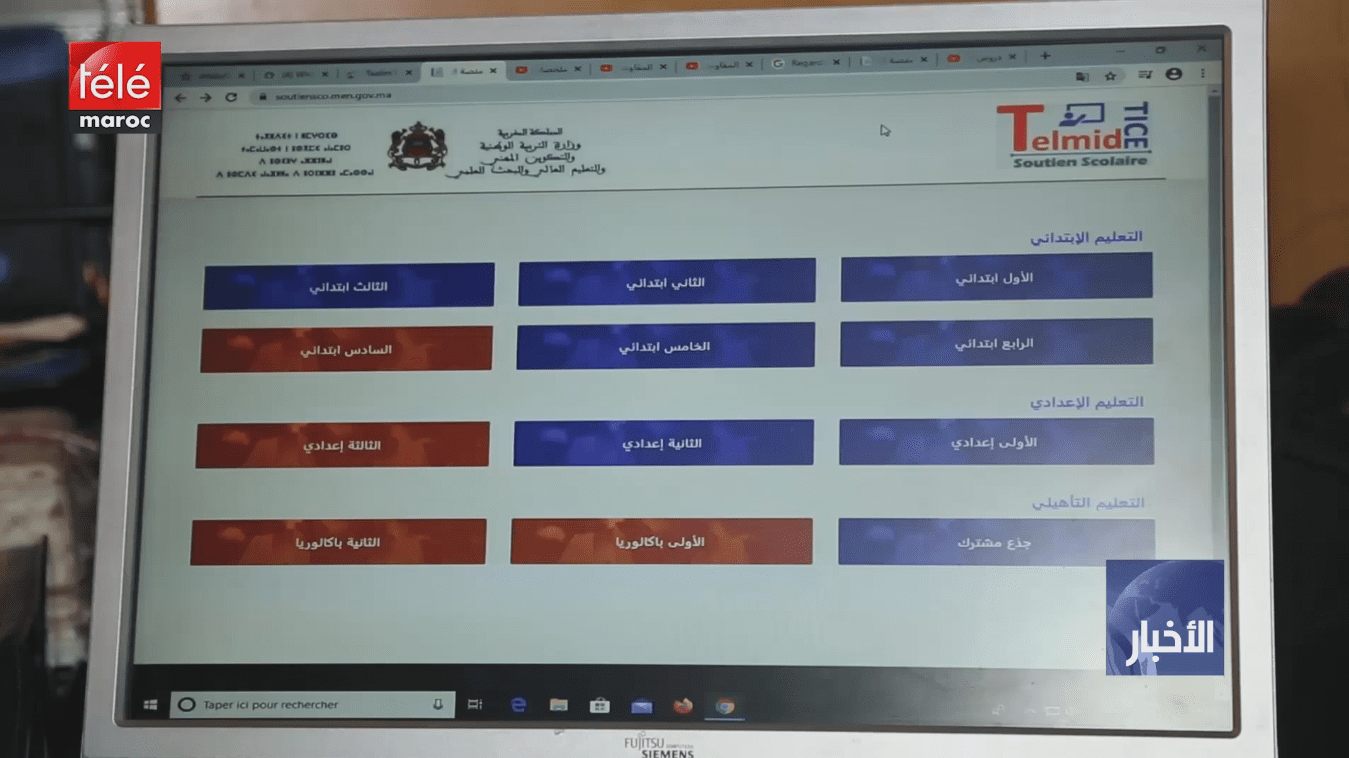
نقابة تعليمية تدعو الحكومة إلى توفير الهواتف والإنترنت المجاني للتلاميذ المحتاجين

المركزية النقابية تحذر من استغلال تداعيات كورونا لتشريد آلاف العمال

تفاصيل انطلاق أول جلسة محاكمة عن بعد بابتدائية سلا

سلطات تمارة تستعين بطائرات الدرون لمطاردة مخالفي الطوارئ

هذه حصيلة اختبارات كورونا بسجون المغرب

تسجيل أول إصابة بكورونا يستنفر سلطات برشيد

فقدان 4 بحارة بالمضيق والسلطات تحقق

سيناريوهات ما بعد الحجر الصحي بالمغرب
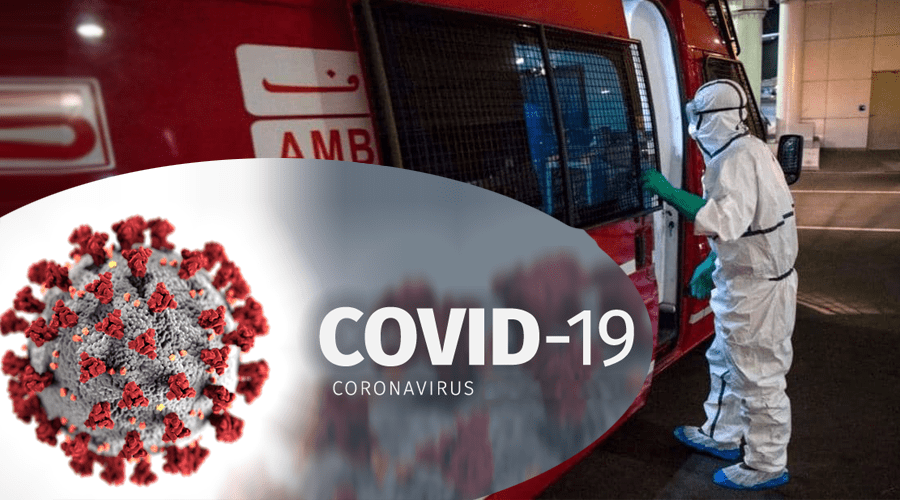
تسجيل إصابة بكورونا داخل سوق تجاري بالقنيطرة يستنفر لجنة اليقظة
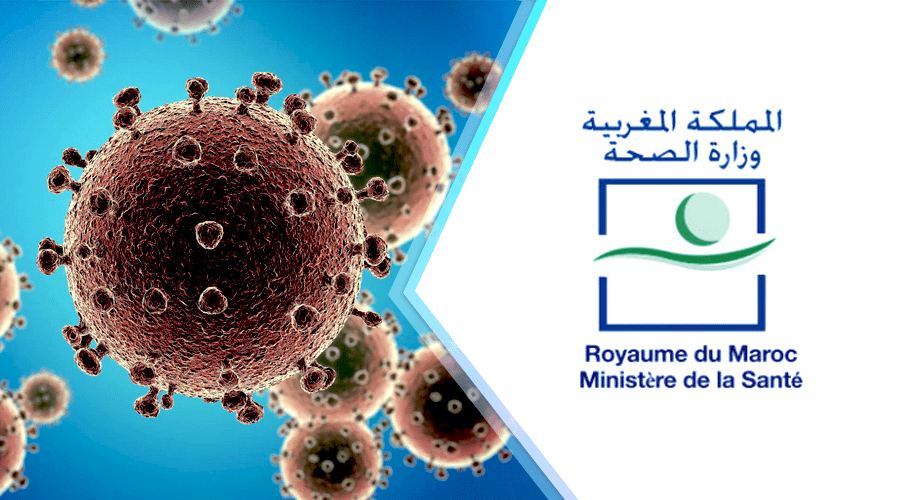
ارتفاع إصابات كورونا إلى 4246 وتسجيل 163 وفاة و739 حالة شفاء

ارتفاع نسبة الشفاء من الوباء الجديد إلى 16,5 في المائة

الداخلية تستثني الصحافيين حاملي البطاقة المهنية من حظر التنقل الليلي

طبيب نساء يغادر مستشفى تطوان بعد تعافيه من كورونا

تسجيل 102 حالة شفاء من كورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة بالمغرب

دول عظمى تعود إلى زمن القرصنة في زمن كورونا

روبورتاج.. أسعار الأسماك تلهب جيوب المواطنين بسبب الطوارئ الصحية

حالة الطوارئ.. توقيف 3795 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية
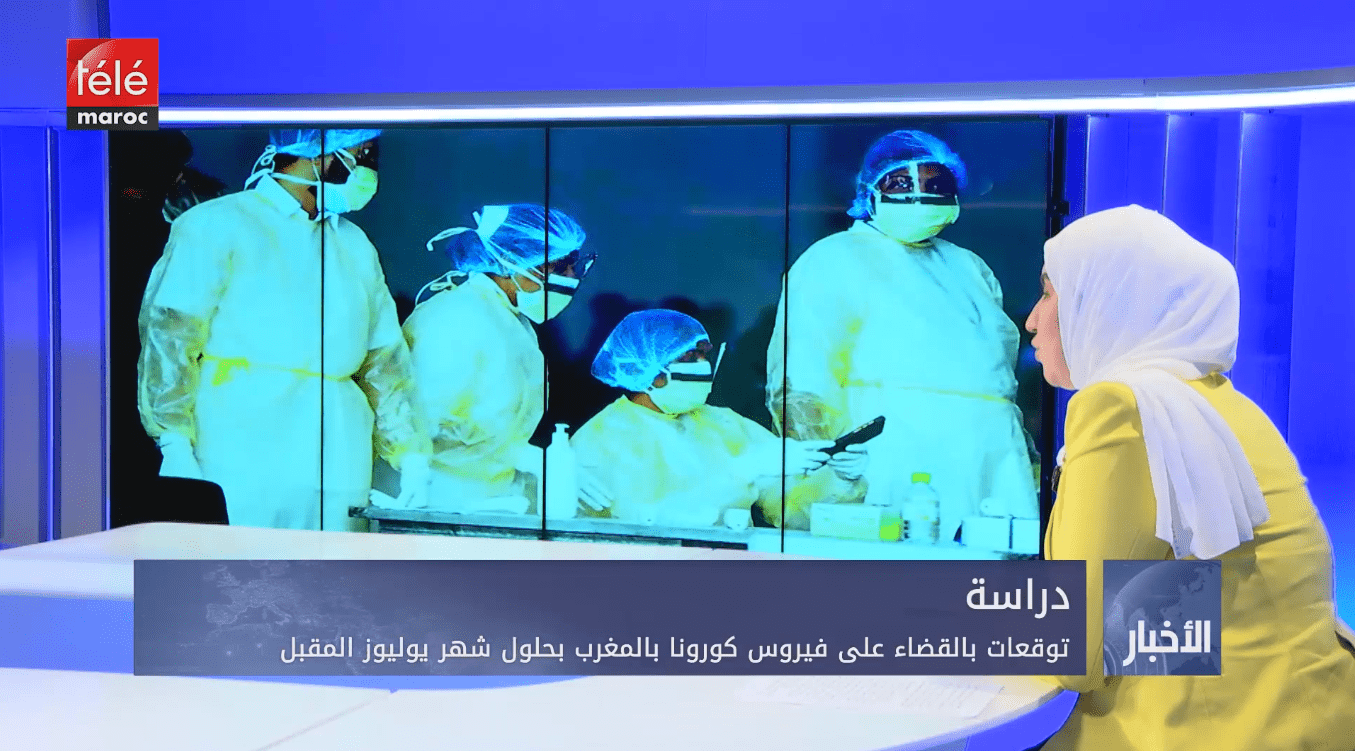
دراسة.. توقعات بالقضاء على الفيروس المستجد بالمغرب بحلول شهر يوليوز المقبل

نقابة تدعو إلى إدراج كورونا ضمن الأمراض المهنية للعاملين في قطاع الصحة

تسفيه مجهودات الطوارئ يقود فتاتين للاعتقال بتطوان

تفاصيل إحداث مركز وطني لتخزين معطيات الحالة المدنية
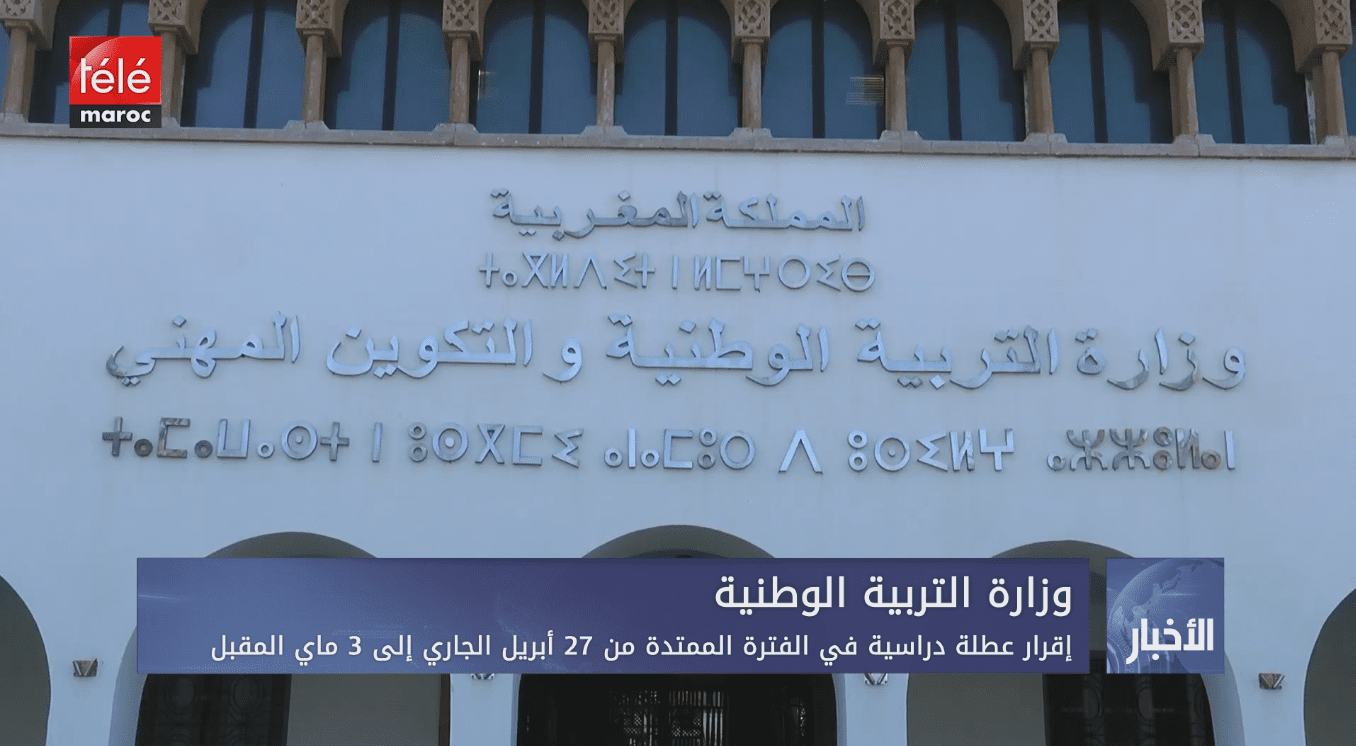
وزارة التربية الوطنية.. إقرار عطلة دراسية في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل

هكذا ستكون احتفالات النقابات بعيد الشغل في زمن كورونا

الكفاءات المغربية في مجال الابتكار والبحث العلمي تسارع الزمن لإيجاد حلول عملية لمواجهة الجائحة

تفاصيل الإطاحة بمستشار نافذ ضمن شبكة لترويج المخدرات

وزارة العدل تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لاعتماد المحاكمات عن بعد

الحبس والغرامة لشباب اعتدوا على قائد بطانطان

الدرك يعتقل فتاتين بتهمة قتل رضيعين ضواحي الخميسات

تسجيل 76 حالة شفاء جديدة من كورونا بالمغرب والإصابات تبلغ 4115

وزارة التعليم تعلن عطلة دراسية لمدة أسبوع

367 تحليلا سلبيا لكورونا خلال 24 ساعة بجهة الشمال

صفر حالة "كورونا" بالسجن المحلي الصومال بتطوان

10 حالات تغادر المستشفى الجامعي بمراكش بعد تعافيها من كورونا
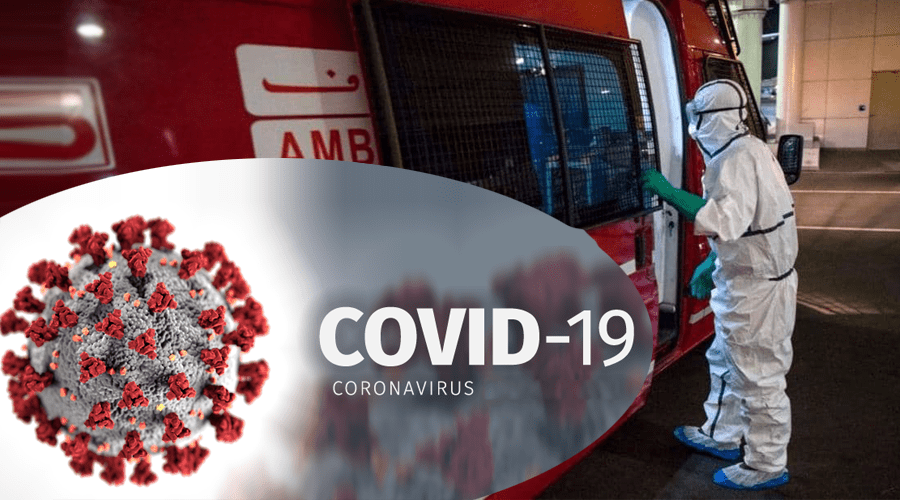
عقب فراره من مستشفى طنجة.. توقيف الستيني المصاب بكورونا في تطوان

وفاة قاصر كان رهن المراقبة لخرقه حالة الطوارئ الصحية

تسجيل 56 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 4065

إطلاق النار لتوقيف مجرم خطير ببرشيد

قصص أطباء وممرضين أجانب ماتوا في مواجهة الأوبئة بالمغرب

تاريخ.. هكذا كان القصر يُنقذ المغاربة من الإشاعات والمخاطر خلال الأزمات

مندوبية السجون تمنع إخراج المعتقلين إلى المحاكم والمستشفيات إلا في الحالات المستعجلة

خرق حالة الطوارئ يقود 3500 شخص للتوقيف خلال 24 ساعة

تسجيل إصابات جديدة بكورونا بسجني طنجة وفاس
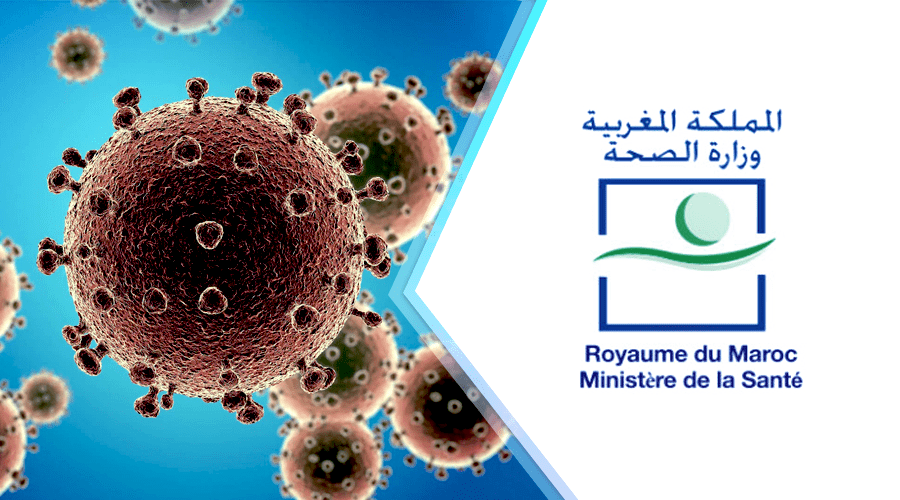
تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى4047 حالة

مدير الأوبئة: أزيد من 7 آلاف مخالط لمصابين بكورونا تحت المراقبة
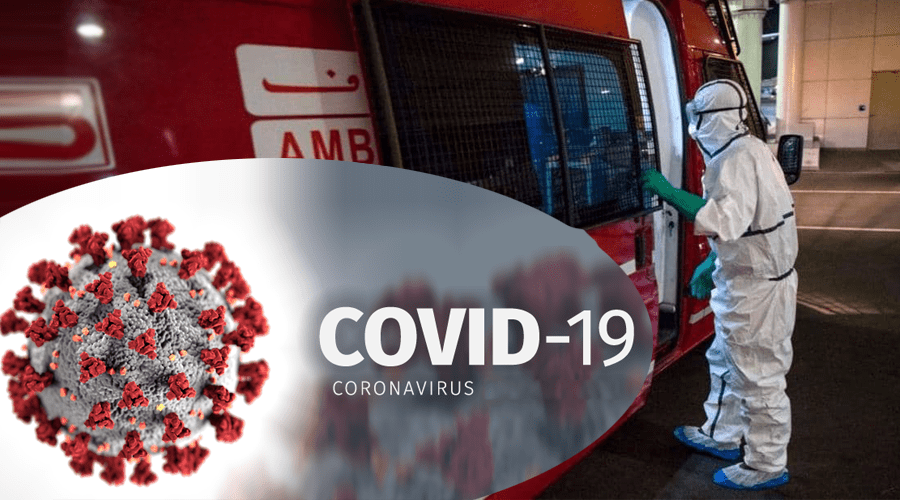
كورونا بالمغرب.. تسجيل 51 حالة شفاء جديدة والإصابات تبلغ 3897

3417 تحليل سلبي بجهة الشمال ومناطق تحافظ على 0 إصابة

انطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة

المجلس العلمي يعتبر موتى كورونا شهداء ويفتي بجواز عدم تغسيلهم

الملك يعطي انطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي لفائدة 600 ألف أسرة

نقابات الصيادلة تطلب حق استبدال الدواء لفائدة المواطنين لتجاوز مشكل انقطاع الأدوية

أرباب المقاهي يطالبون بإنقاذهم من شبح الإفلاس

تطورات مثيرة في قضية مصرع فتاة سقطت من عمارة بالرباط

زخات رعدية قوية اليوم السبت بعدد من مناطق المملكة

حجز سيارات فارهة لدى نصاب انتحل صفة وكيل عام لخرق الطوارئ

هكذا نجت تطوان من تسجيل بؤر لكورونا

المغرب يحارب المضاربات بتقنين أسعار الكمامات الطبية

هكذا تعيش تعاضدية الموظفين على إيقاع الفوضى خلال فترة الطوارئ

الدرك يتعقب عصابة خرّبت مسجدا بحثا عن كنز

عالم مغربي يجيز صلاة التراويح خلف التلفاز

ارتفاع إصابات كورونا إلى 3889 وتسجيل 159 وفاة و498 حالة شفاء

السلطات العمومية توضح حالات الاستثناء من قرار حظر التنقل الليلي

قطاع الصحة.. إطلاق منصة إلكترونية للإرشادات والتوعية والاستشارات الطبية

تغيير برمجة دروس التلفزة المدرسية خلال رمضان

5000 يورو للهجرة السرية من إسبانيا نحو المغرب
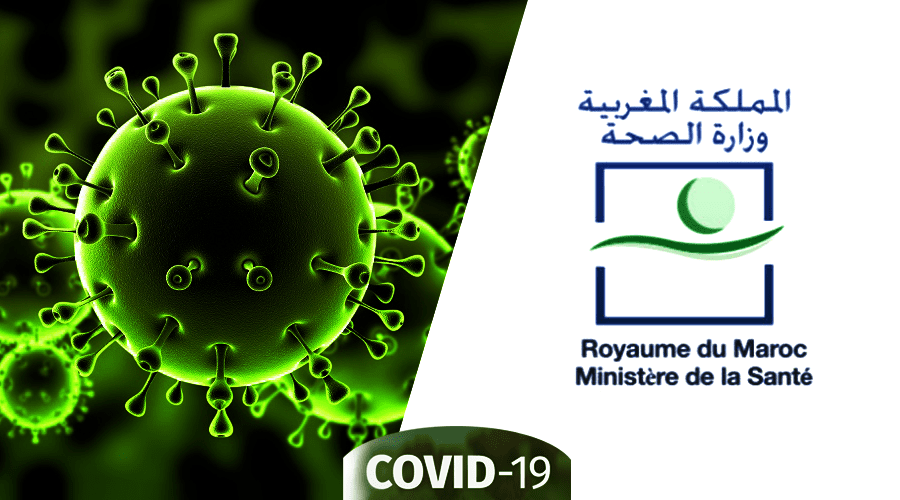
تسجيل 30 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الإصابات إلى 3758

المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالحالة المدنية والمشغلين المتضررين من كورونا

توقيف موظف سابق بتهمة انتحال صفة وكيل عام للملك

تدابير استباقية بسجون الغرب والقنيطرة لمحاصرة وباء كورونا

توفير كافة التسهيلات لسائقي الشاحنات المغاربة لتموين السوق الموريتانية

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بهذه المناطق من المملكة
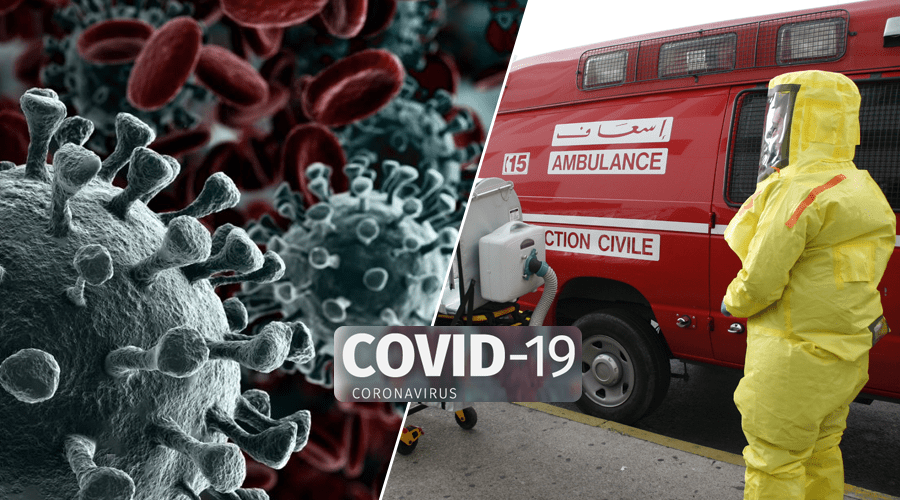
هكذا استنفر تسجيل أول حالة كورونا سلطات إقليم آسفي

المغرب يرفض انتهازية دولة أوروبية بشأن ملف حاملي الجنسية المزدوجة

تفاصيل الإطاحة بمستشار جماعي ضمن شبكة للمخدرات
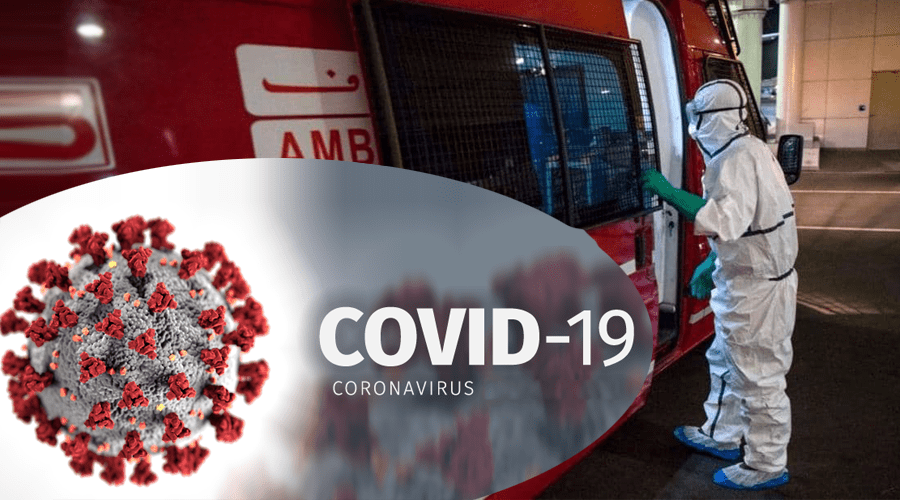
ارتفاع إصابات كورونا إلى 3692 وتسجيل 155 وفاة و478 حالة شفاء

روبورتاج.. مجموعة "شباب الخير" توزع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة المتضررة من فيروس كورونا

روبورتاج.. الطلبة الأفارقة بالمغرب يواصلون دروسهم عن بعد تزامنا مع الحجر الصحي

عليم بركاني.. مهندس مغربي يخترع كمامة طبية قابلة للاستعمال 120 مرة

وزارة الصحة تنفي منع تصدير أدوية وتؤكد أن مراقبة احترام المخزون الاحتياطي للأدوية الأساسية تتم أسبوعيا

وزارة الأوقاف تعلن السبت أول أيام رمضان بالمغرب
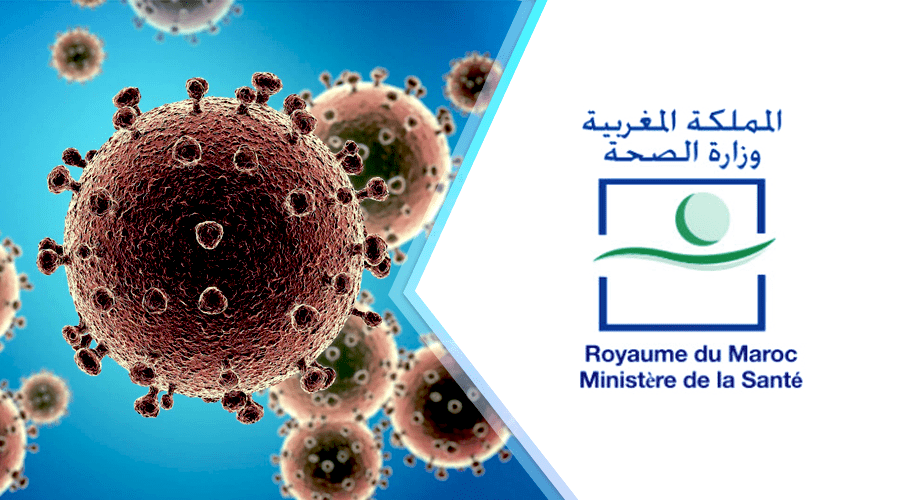
تسجيل 39 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 3568

السلطات تعلن حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان

البنك الإفريقي للتنمية يتوقع انخفاضا في الناتج الداخلي الخام للبلدان الإفريقية ب22.1 مليار دولار

مندوبية الصحة بالحسيمة تعلن خلو سجن المدينة من فيروس كورونا

لجنة وزارية.. الأسواق مزودة بكل المنتجات والأسعار مستقرة

توقيت مسترسل للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات خلال رمضان
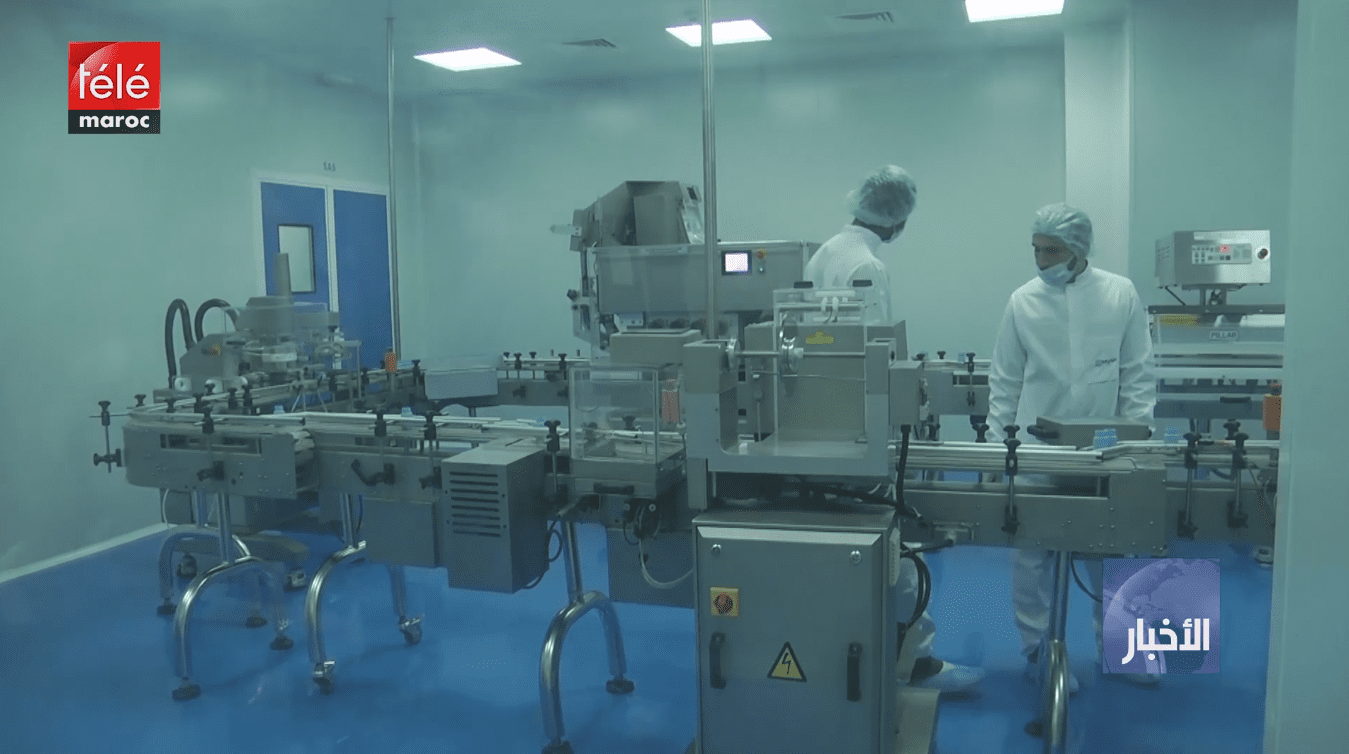
المندوبية السامية للتخطيط.. 57 في المائة من المقاولات توقفت عن العمل بشكل كلي أو جزئي بسبب الوباء الجديد

فرض حالة الطوارئ الصحية.. توقيف 3590 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.. لا حالات مشتبه بها أو مؤكدة للإصابة بالوباء الجديد بسجني القنيطرة وسوق الأربعاء

وزارة الصحة.. إطلاق مباريات توظيف 1151 منصبا لمواجهة الخصاص في القطاع

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

هكذا استعانت جماعة بمياه البحر لتعقيم الشوارع من كورونا

المغرب يشدد المراقبة على شركات البيع الهرمي والكازينوهات وألعاب القمار

اتهام معامل بنشر كورونا بطنجة ومطالب بمقاضاة أصحابها
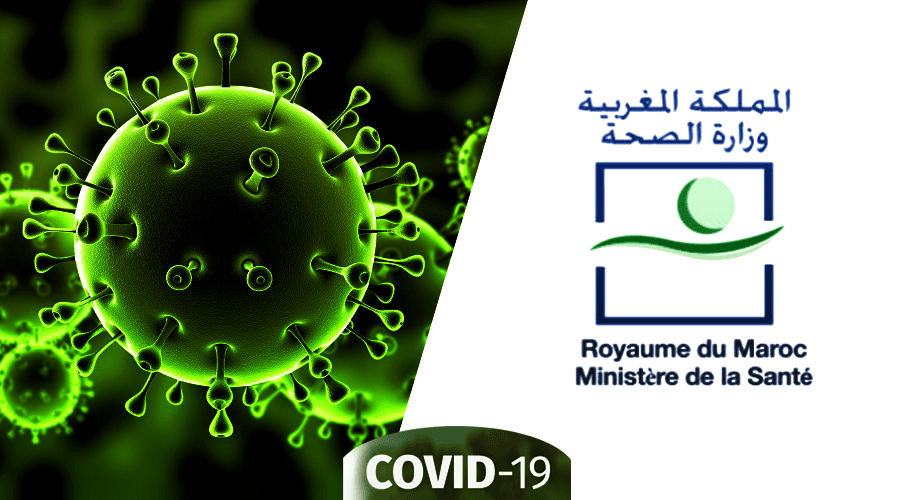
ارتفاع إصابات كورونا إلى 3537 وتسجيل 151 وفاة و430 حالة شفاء

تأجيل إجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي

الحموشي ينزل إلى الشوارع لتفقد عناصره والوقوف على حسن استعمال التطبيق المعلوماتي للحجر الصحي

وزارة الفلاحة تتوقع إنتاج 30 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض 42٪ مقارنة بموسم 2018/2019

مدير الأوبئة : تسجيل 186 إصابة بكورونا في بؤرة بمدينة ورزازات

تسجيل 237 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 3446

الداخلية تمنع إنعقاد دورات المجالس المحلية لشهر ماي

سنة سجنا في حق شقيق الوزير السابق منصف بلخياط

إطلاق منصة رقمية للمساعدة الطبية والنفسية لفائدة مغاربة العالم

سلوكيات لا مسؤولة لبعض السياح الفرنسيين بالمغرب في زمن كورونا

حالة الطوارئ.. توقيف 3277 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

منع تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص من كورونا

قرار بإخلاء مستشفى سطات بعد ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الأطر الصحية

تعافي 8 حالات من كورونا بجهة طنجة يرفع الحصيلة إلى 59 حالة

العثماني يجدد التأكيد على أن الوضعية الوبائية بالمملكة متحكم فيها

تاريخ استئناف الرحلات الجوية يخلق الجدل

حياة مرضى القلب في خطر بعد انقطاع أدوية مضادة للتخثر

مطالب بفضح أسماء 5828 مدرسة خاصة طلبت تعويضات من صندوق كورونا

300 ألف شخص مهددون بالموت جوعا يوميا بسبب كورونا
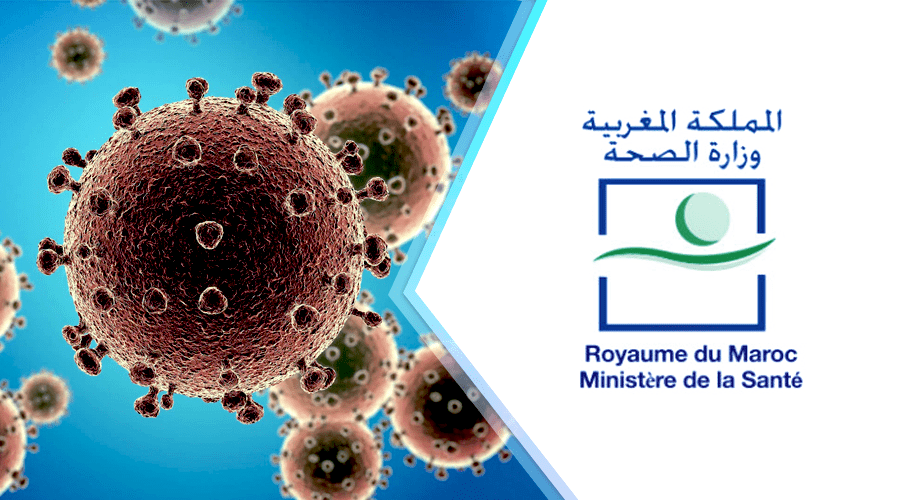
ارتفاع إصابات كورونا إلى 3377 وتسجيل 149 وفاة و398 حالة شفاء

روبورتاج.. ردود أفعال متباينة للمغاربة تجاه قرار تمديد حالة الطوارئ

وزارة الصحة.. استعمال 5 بالمائة فقط من أسرة الإنعاش التي أعدتها الوزارة للتكفل بالحالات الحرجة

فتوى للمجلس العلمي الأعلى تنهي جدل التراويح والحجر الصحي

إستشارات مجانية عن بعد لتخفيف العبء عن المستشفيات العمومية

الجمعية المغربية للمصدرين تدق ناقوس الخطر

تسجيل 43 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 3209

مديرية الأمن تطلق تطبيقا لتتبّع المواطنين خلال حالة الطوارئ

وفاة رائد صناعة العطور بالمغرب محمد عزبان بعد إصابته بكورونا

مسؤولو وموظفو وكالة التنمية الفلاحية يساهمون في صندوق كورونا

الاعتداء على قائد أثناء جولة ميدانية لتطبيق الحجر الصحي

الداخلية تدبر بنجاعة جائحة كورونا بتمارة أمام هشاشة مجلس البيجيدي

إغلاق 10 مقاولات بالمنطقة الصناعية بطنجة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الضرورية

"النجاح للجميع" مجرد إشاعة

مخاوف من وجود بؤرة لكورونا بمستشفى سطات بعد تسجيل 9 حالات

المديرية الجهوية للصحة بطنجة تفتح باب التطوع للمتقاعدين وحاملي الشواهد في القطاع

روبورتاج.. مبادرات تستهدف الأسر المعوزة عبر مساعدات غذائية مع قرب حلول شهر رمضان
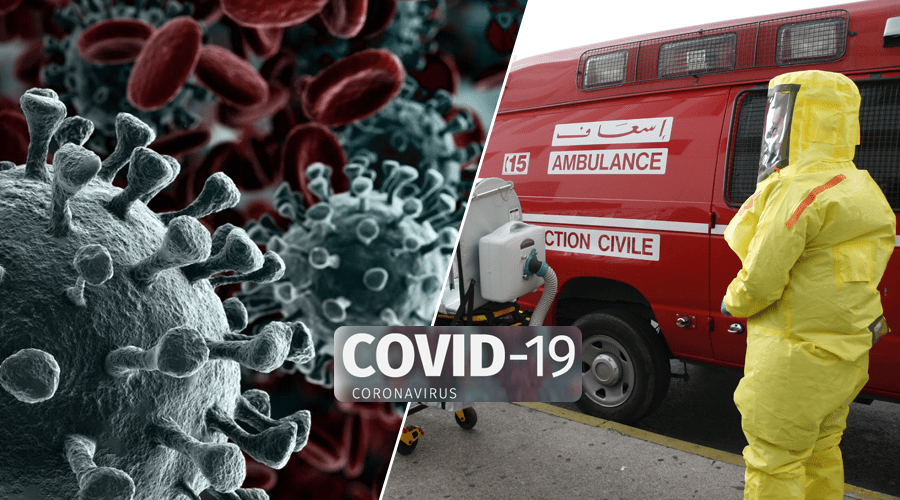
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بسيدي قاسم

الحكومة تواجه "البؤر الصناعية" للوباء الجديد بإغلاق 10 مصانع بطنجة

بسبب كورونا قرض بدون فائدة لفائدة المقاولين الذاتيين

لجنة اليقظة.. صرف إعانة كورونا لأزيد من 200 ألف أسرة فقيرة

مخطط استعجالي من وزارة الإسكان والتعمير لما بعد كورونا

هكذا يشتغل أزيد من 400 طبيب دون أجور أو تأمين في عز أزمة كورونا

الدولة تعطي انطلاقة تحليق الطائرات لمحاربة الناموس بالشمال

66 إصابة بكورونا في سجن ورزازات وإخضاع جميع المعتقلين للكشف
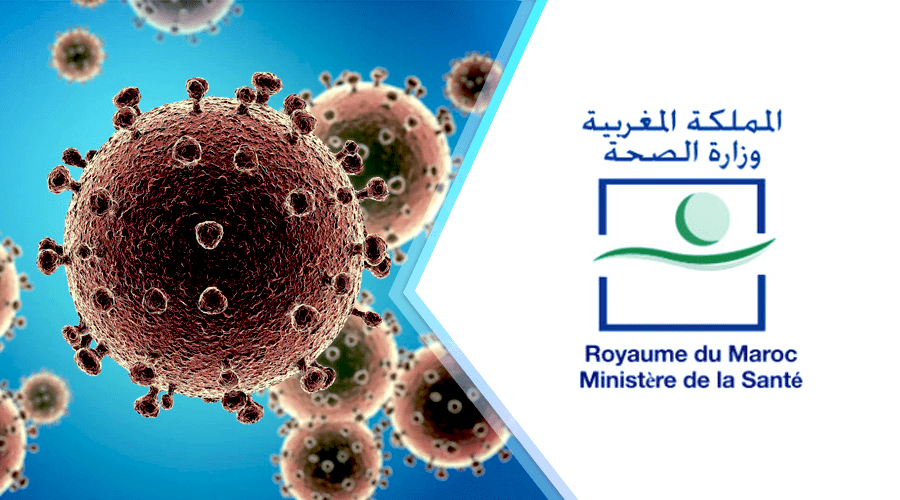
ارتفاع إصابات كورونا إلى 3186 وتسجيل 144 وفاة و359 حالة شفاء

الصيدليات تشرع في بيع الكمامات الواقية دون احتساب هامش الربح
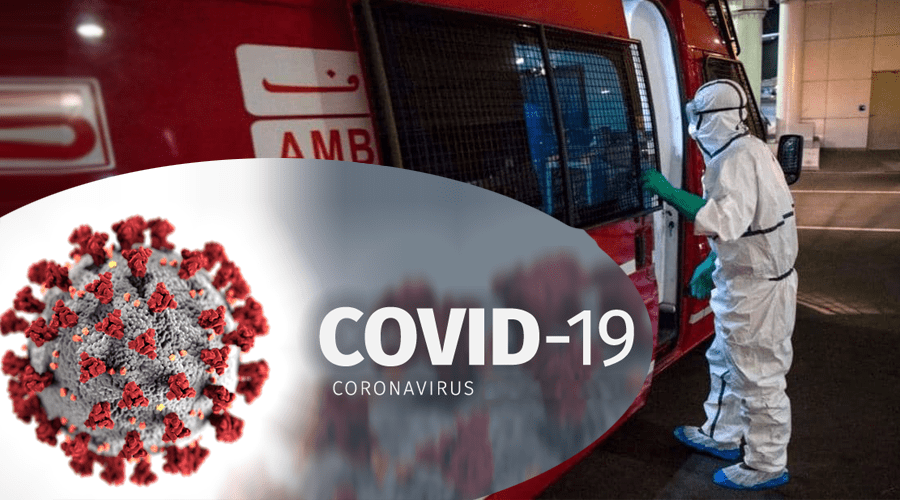
إصابات كورونا بالمغرب تتخطى 3000

نشر ادعاءات كاذبة حول كورونا والتشهير بمغاربة الخارج يطيح بشخصين بسطات
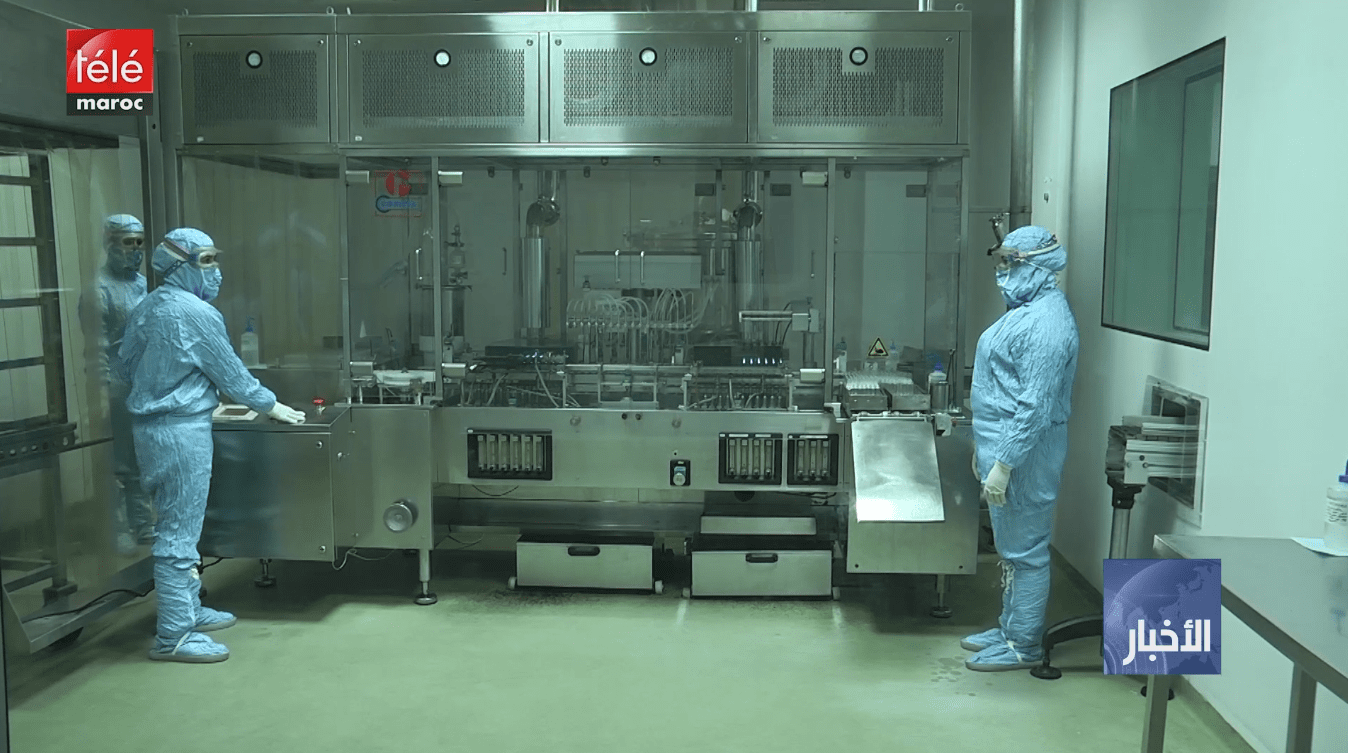
توصيات لتعزيز التدابير الاحترازية داخل المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية

السلطات تضع معايير صارمة لتفادي التلاعب في صناعة الكمامات

ملف.. هذه هي التحديات الاقتصادية والمالية التي تنتظر المغرب بعد كورونا

بالصور.. مديرية الحموشي تنتقل للسرعة القصوى لضبط حالة الطوارئ

إدراج حصص التعليم الأولي ضمن دروس التعليم عن بعد في هذا التوقيت

معمل عين السبع يرفع عدد إصابات كورونا ببرشيد

56 سائحا عالقون بالوليدية وبحارة آسفي يستأنفون عملهم

العلمي يخوض الحرب ضد الاتجار بالكمامات المزيفة

الموثقون يقررون استئناف عملهم في هذا التاريخ

السلطات تغلق مداخل مشرع بلقصيري

تحذيرات من تلوث واد رضات بإقليم سيدي قاسم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 2990 وتسجيل 143 وفاة و340 حالة شفاء
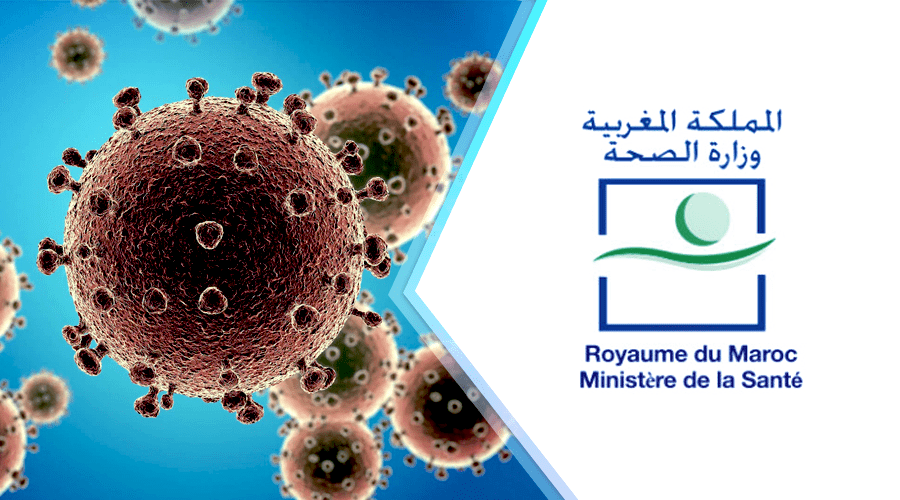
وزير الصحة: 2855 إصابة بكورونا وتسجيل 141 وفاة و327 حالة شفاء

توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بطنجة

مندوبية السجون تكشف عدد المصابين بكورونا في صفوف الموظفين والمعتقلين

أدمغة مغربية مشتتة على طول الكرة الأرضية... يحكمون وكالات عالمية وإمبراطوريات مالية وصناعية

هكذا أصيب سياسيون وأدباء ورياضيون وحقوقيون مغاربة بكورونا وتعافوا منها

ارتفاع إصابات كورونا على متن حاملة طائرات فرنسية إلى 1046 حالة

ارتفاع إصابات كورونا إلى 2820 وتسجيل 138 وفاة و322 حالة شفاء

الـ CNSS يضع مصحاته رهن إشارة السلطات في الحرب ضد كورونا
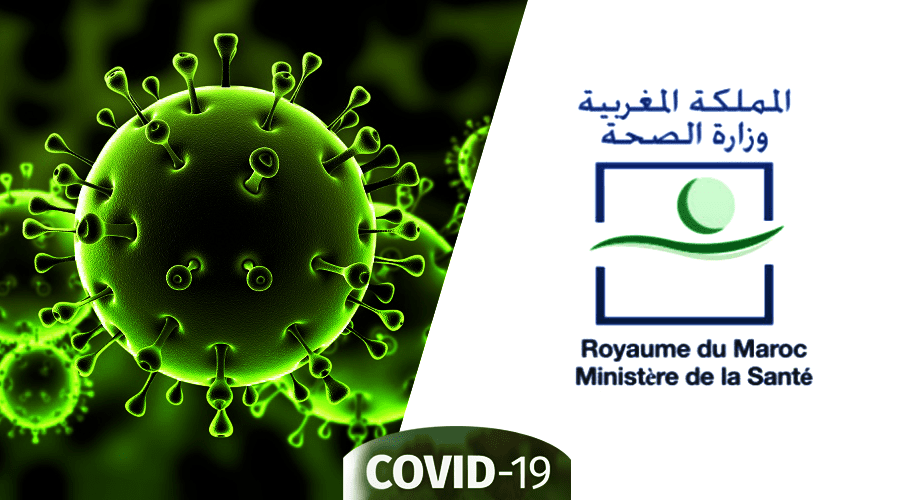
تسجيل 33 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الإصابات إلى 2685

رسميا..هذا هو مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر

عاجل..تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل

مصالح الحموشي تحقق العلامة الكاملة بتنزيل الطوارئ الصحية بالرباط

60 سريرا بفندق لاستقبال حالات كورونا بطنجة

7 حالات شفاء من كورونا بتطوان

مطالب بحماية أطر مصلحة كوفيد-19 ببرشيد

أمن مراكش يطيح بستة تجار للمخدرات

التحقيق في مصنع للعسل المزور بتطوان

إعفاءات لمسؤولين بقطاع الصحة بالحسيمة

كمامات عالية الجودة تسقط متقاعدا بالفوسفاط بخريبكة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبش في الطابوهات

مجلس حكومي لتمديد حالة الطوارئ الصحية

وزارات الصحة والصناعة والشغل تحث المقاولات والوحدات الصناعية على تعزيز التدابير الاحترازية

العثماني يدعو إلى المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر لتجاوز هذه الظرفية الصعبة

مكتب الرباط.. مواطنون يحتشدون أمام وكالات مخصصة لتسلم دعم الفيروس المستجد

الصيدليات بالمغرب تستعد لتسويق الكمامات المدعمة انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري

متابعة أزيد من 25 ألف شخص قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية
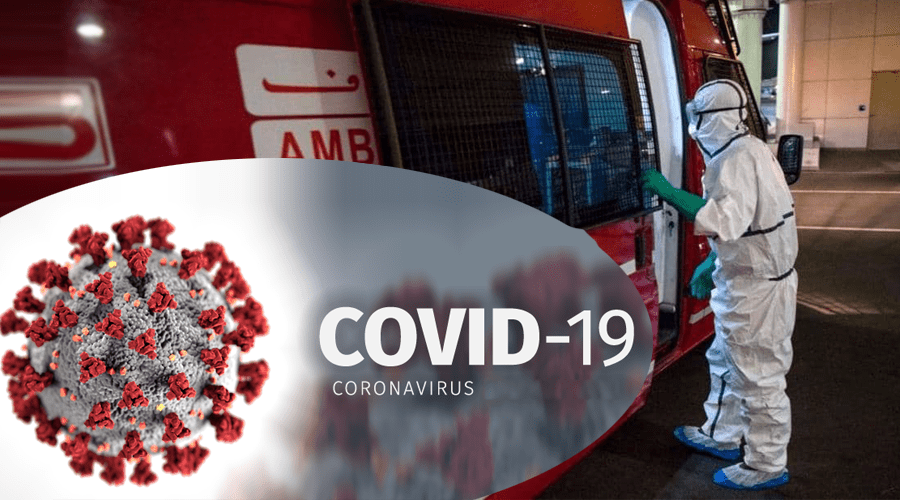
وفاة موظف بالوكالة الحضرية لتطوان مصاب بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات يصل 5

الحكومة تتجه نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر

تسجيل 135 وفاة و281 حالة شفاء من كورونا وارتفاع الإصابات إلى 2564

وزارة الصناعة والتجارة تمدد فترة مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد الى غاية شهر يونيو

المغرب يرسل مساعدات لإفريقيا الوسطى لمواجهة كورونا

تفاصيل إصابة 111 عاملة بكورونا في مصنع بالبيضاء

في عز أزمة كورونا ..أطباء بالمستشفيات العمومية يواجهون المصير المجهول

غرق طفل داخل بانيو وآخر داخل سطل يستنفر السلطات بسيدي سليمان

في الوقت الذي يستعرض فيه المسؤولون التجهيزات الطبية نائب عمدة طنجة يستعرض توابيت وثلاجات الموتى

مندوبية التخطيط تستجوب الأسر حول تأثرها من كورونا

الحكومة تتصدى لتحايل أرباب المدارس الخاصة بسبب كورونا

رحلة استثنائية لإعادة أكثر من 300 مواطن اسكندنافي إلى بلدانهم

روبورتاج.. السلطات تخصص لكل حي سوقا صغيرا للتبضع لتفادي التجمعات البشرية
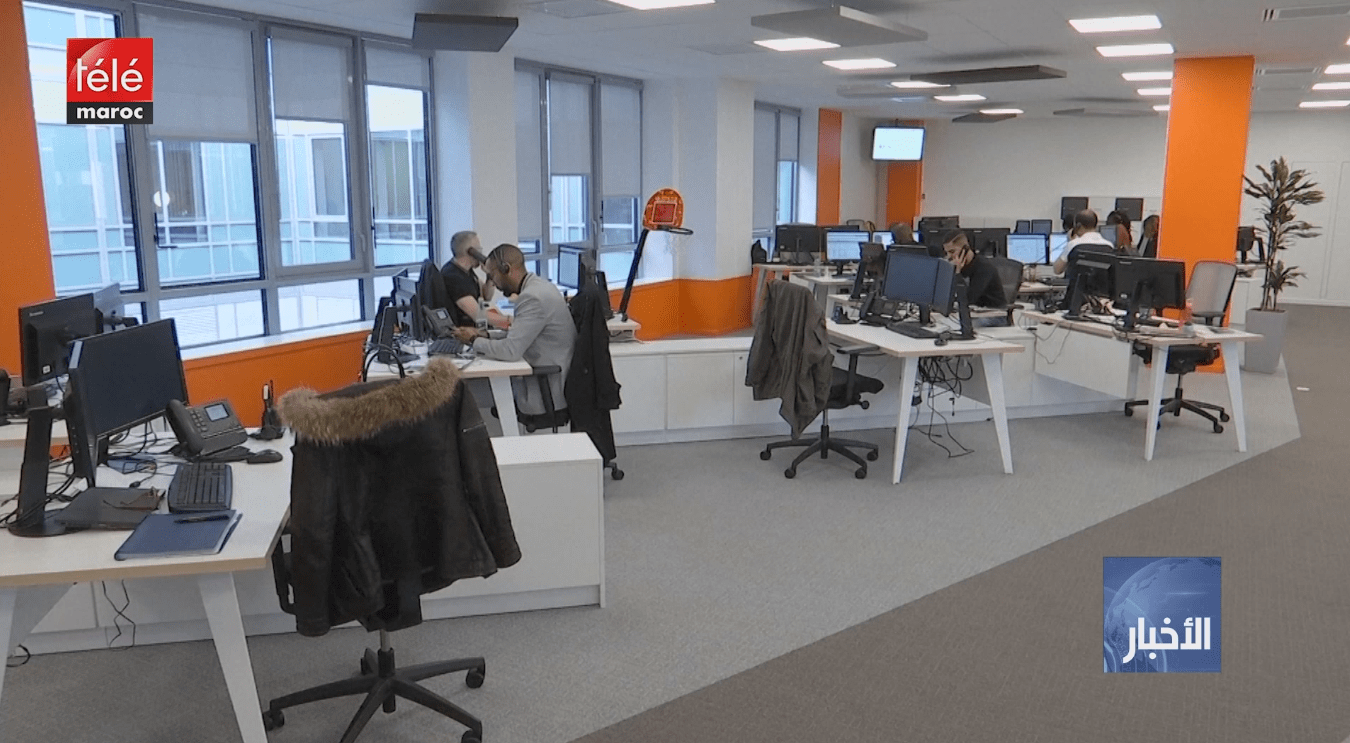
وزارة الشغل والإدماج المهني.. أزيد من 131 ألف مقاولة تضررت من تداعيات جائحة كورونا

فرض حالة الطوارئ الصحية.. توقيف 2715 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

منح مخصصات سياحية استثنائية للمغاربة العالقين بالخارج بهذه الشروط

رحلة استثنائية لترحيل فرنسيين عالقين في أكادير عبر مطار مراكش

تجهيز مصحتين بطنجة لاستقبال حالات كورونا

إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بسيدي قاسم
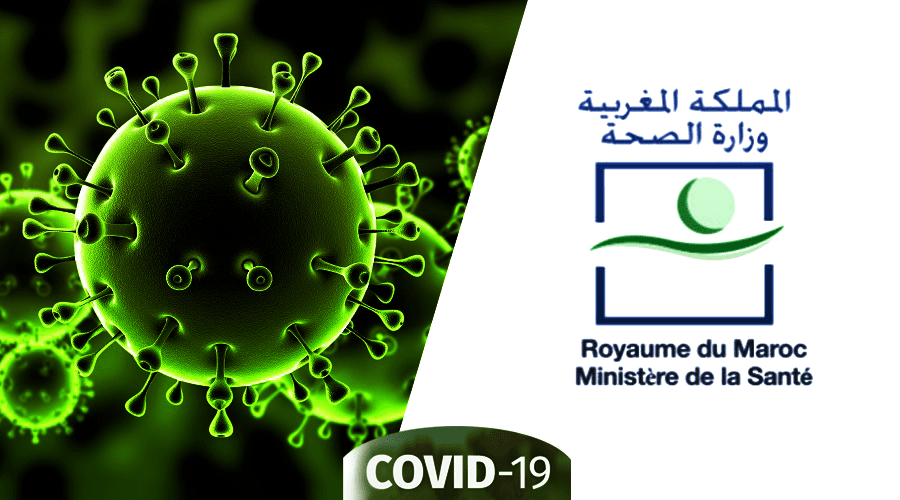
تسجيل 245 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2528 حالة

الداخلية تشرف على توزيع 112 مليونا بالفنيدق

السكال يستغل الجائحة لرصد 6 ملايير للبحث العلمي

تفاصيل منع طاقم باخرة من دخول العيون

المقدم فالدو.. عون سلطة يسطع نجمه بحي شعبي بالقنيطرة

فضيحة تبديد أموال عمومية بالملايير تهز البيجيدي بمراكش

تفاصيل البروتوكول الجديد لعلاج المصابين بكورونا في المغرب

مبادرة لمتخصصين في علم النفس لتقديم الدعم النفسي للمواطنين في ظل الحجر الصحي

روبورتاج.. 32 مريضا بكوفيد-19 يتابعون العلاج بمستشفى القرب سيدي مومن بالدار البيضاء

مدير الأوبئة : اكتشاف بؤر لكورونا داخل وحدات صناعية وتجارية

اكتظاظ أمام المستشفيات أثناء استقبال مرضى فيروس كورونا ينذر بكارثة
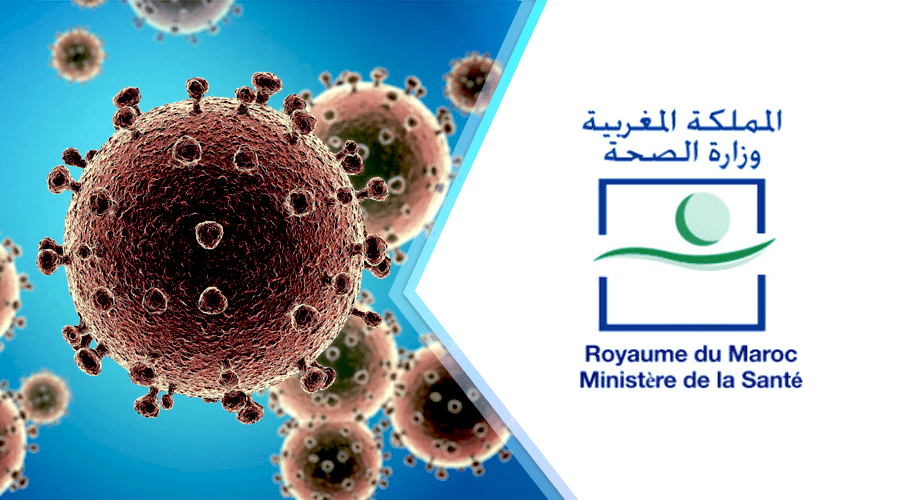
تسجيل 20 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة والإصابات تبلغ 2283

الحكومة تستثني موظفي الصحة من الاقتطاع في الأجور

وكالة أنباء هنغاريا: اقتراح الملك إطلاق مبادرة إفريقية للحد من كورونا حكيم وعملي

بعد الاقتطاعات من أجور الموظفين.. مطالب للعثماني بتخفيض أجور كبار المسؤولين

جمعية سند الأجيال أكادير تنظم حملة تضامنية لدعم الأسر المعوزة بسوس ماسة

تسجيل 8 حالات شفاء من كورونا بجهة درعة تافيلالت

وزارة الصحة توصي باستمرار تلقيح الأطفال أثناء جائحة كورونا

السلطات تعزل أحياء بمدينة فاس بعد ظهور بؤرة لفيروس كورونا

بالصور.. ثلاث حالات تغادر مستشفى الأنطاكي بمراكش بعد شفائها من كورونا

حجز طن و691 كلغ من المخدرات وتوقيف 3 أشخاص بزاكوروة

وزارة الفلاحة تسرع تسليم العلف المدعم لإنقاذ المواشي بجهة البيضاء

التموين يتسم بالوفرة والاستقرار والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية

وزارة الصحة تقرر إعطاء الكلوروكين لمخالطي المصابين حتى قبل إجراء التحاليل المخبرية

فرض حالة الطوارئ الصحية.. توقيف 2686 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد والمالية.. إصدار دليل خاص حول العمل عن بعد بالإدارات العمومية

روبورتاج.. رغم أزمة كورونا المدارس الخاصة تفرض الأداء على الآباء والجدل يستمر

وزارة التربية الوطنية تدرج حصص التربية البدنية ضمن دروس التعليم عن بعد

بالصور.. 3 أشخاص يغادرون مستشفى الرازي بمراكش بعد تعافيهم الكامل من كورونا

مياه الصرف الصحي تهدد سكانا ببرشيد

مطالب لوزير الفلاحة بوقف الرعي الجائر باشتوكة

تعويضات كورونا تحرج بيجيدي الفنيدق

هذه المدن المغربية لم يدخلها وباء كورونا

وزير الصحة يكشف شروط رفع العزلة الصحية وحالة الطوارئ

بوسكورة تسجل أخطر جريمة خلال الطوارئ
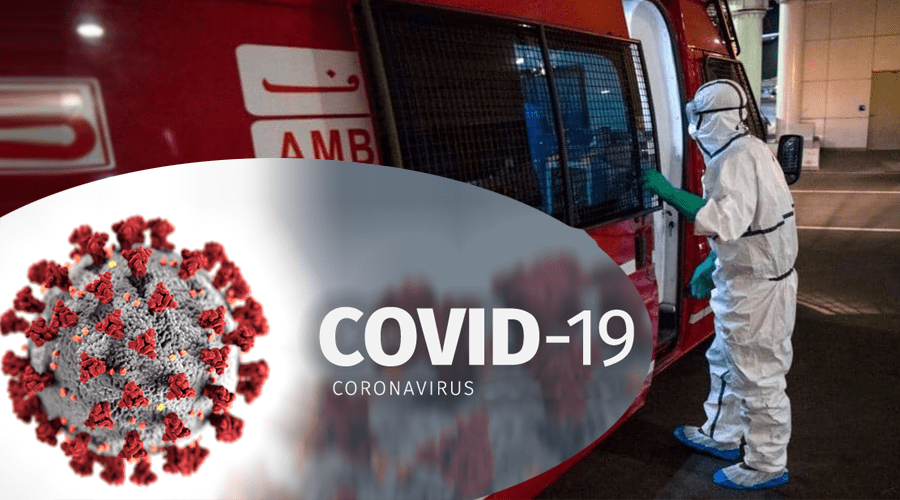
آسفي واليوسفية والصويرة بدون إصابة بكورونا

بعد إصابة زميلتهم بكورونا.. أطباء يطالبون بتجهيزات الحماية

إعفاءات ضريبية وإلغاء غرامات التأخير في إنجاز الصفقات العمومية

مدارس خاصة استخلصت واجبات شهر مارس واستفادت من تعويضات كورونا

رفع العزل عن حي شعبي بالقنيطرة بعد 14 يوما من الحجر

تسجيل 10 إصابات بكورونا يستنفر سلطات القصر الكبير

ارتفاع إصابات كورونا إلى 2251 وتسجيل 128 وفاة و247 حالة شفاء

حصيلة قياسية.. 2569 وفاة بكورونا خلال يوم واحد بالولايات المتحدة
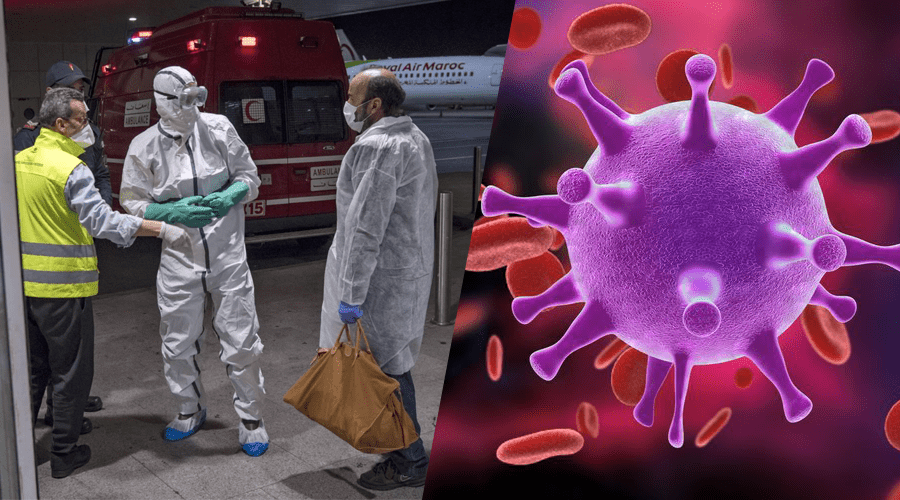
هكذا يتجه المغرب للسيطرة على وباء كورونا

ترقية استثنائية ومكافأة مالية لمقدم شرطة تعرض لاعتداء خطير

آيت الطالب يتحدث عن استمرار حالة الطوارئ ويؤكد توسيع دائرة الكشف
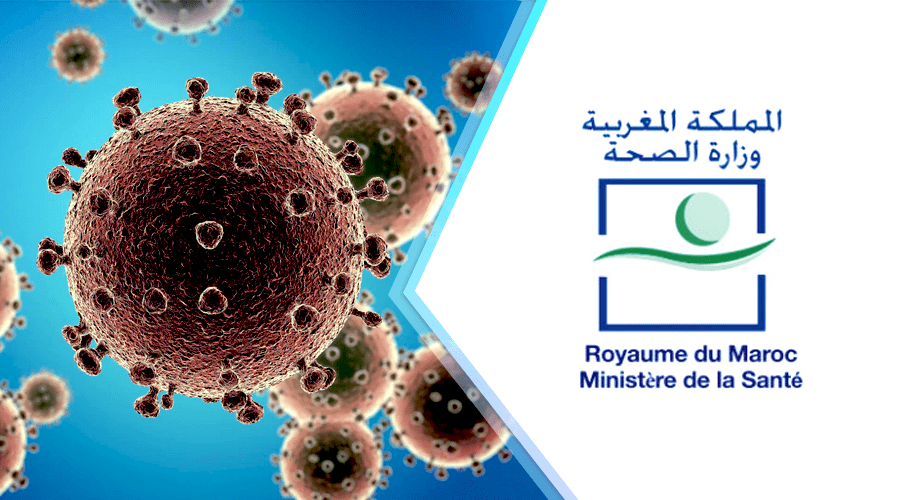
كورونا بالمغرب.. 127 وفاة و229 حالة شفاء والإصابات تبلغ 2024

بالصور.. 4 أشخاص يغادرون مصحة أنوال بالبيضاء بعد شفائهم من كورونا

وزارة الاقتصاد والمالية تعد دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة

تشديد الإجراءات ينجح الحجر الصحي بالأحياء الشعبية

غياب مختبر لتحليلات كشف كورونا يثير مخاوف بجهة طنجة

الخارجية تكشف مصير المغاربة العالقين بالخارج

الحبس النافذ للمستشار سمسار المحاكم بأكادير

المديرية العامة للأمن الوطني.. نفي فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة بدعوى إصابة موظفيها بكورونا
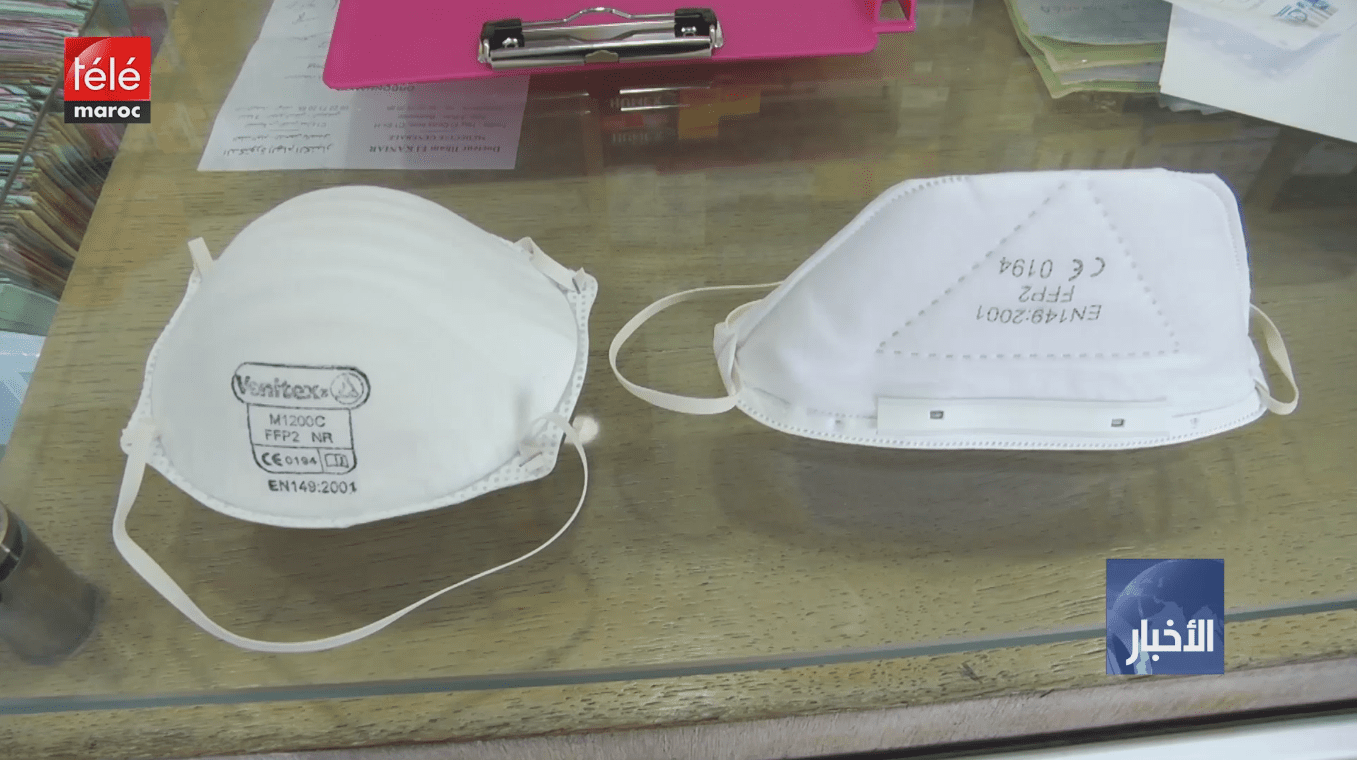
العلمي : الكمامات الواقية سيتم تسويقها بالصيدليات
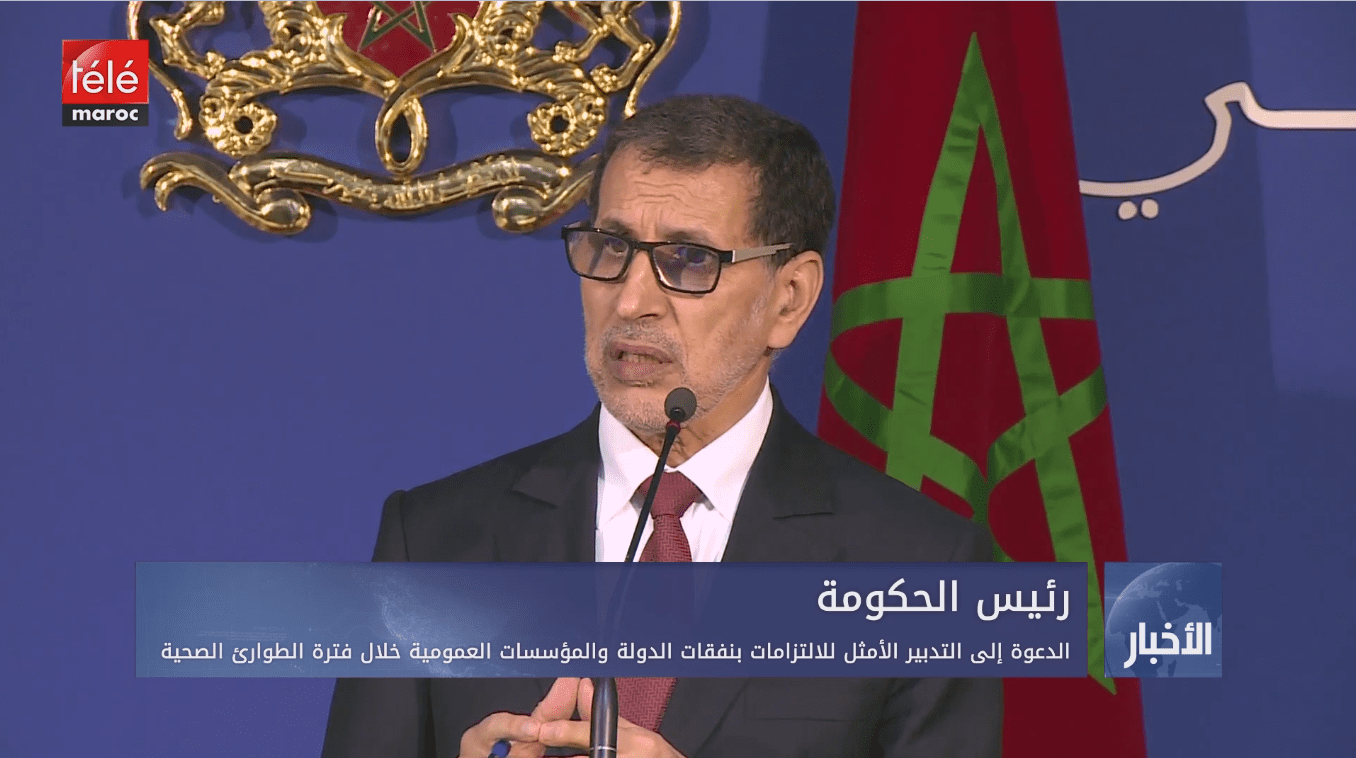
رئيس الحكومة يدعو إلى التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية

وزارة الصحة.. التجربة المغربية في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد تميزت بوحدة مصدر القرار والاستباقية

وزير الصحة.. سيتم تنويع وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية والاستعداد لرفع حالة الحجر الصحي

اعتقال شيخ قروي وعون سلطة بتمارة لأجل التزوير

كورونا يصيب طبيبة تشتغل بمستوصف صحي بالقنيطرة

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1988 وتسجيل 127 وفاة و218 حالة شفاء

العثماني يراسل وزراءه لاقتطاع ثلاثة أيام من رواتب الموظفين طيلة ثلاثة أشهر

فارس يدعو إلى إصدار الأحكام العادلة داخل آجال معقولة بعد رفع حالة
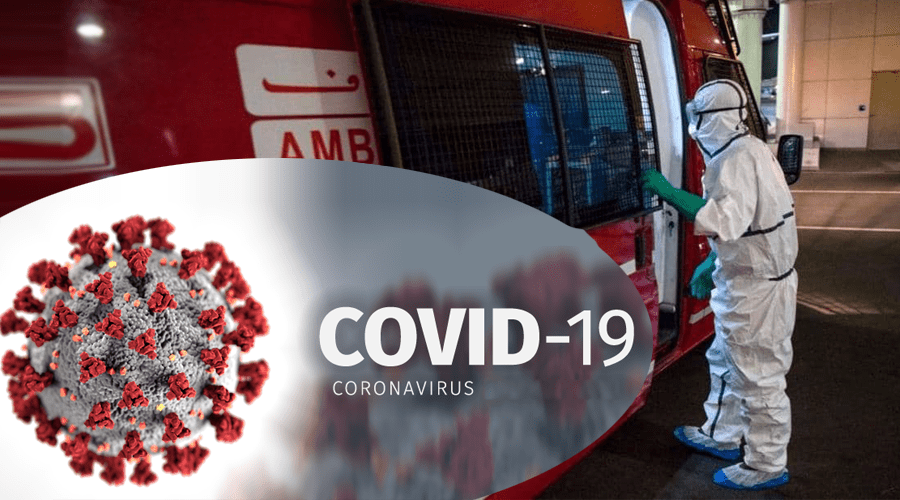
كورونا بالمغرب.. تسجيل 14 حالة شفاء جديدة دون وفيات خلال 24 ساعة

جهة العيون-الساقية الحمراء خالية من كورونا بعد تعافي كل الإصابات

توقيف شخص وشقيقته بسبب التحريض على العنف وخرق حالة الطوارئ

11 بالمائة من وفيات كورونا بالمغرب يهود

وزارة العدل توفر خدمة "الزواج عن بعد" عبر الأنترنيت

مؤسس سيتي باص يساهم من ماله الخاص في صندوق كورونا

المغرب يعود لتوقيت غرينيتش في هذا التاريخ

استنفار بسبب تسجيل يطالب الآباء بمستحقات دروس خصوصية

السلطات تخول للمغاربة مزدوجي الجنسية مغادرة المملكة نحو أوروبا

صندوق الإيداع والتدبير.. من المتوقع اتساع عجز السيولة في النظام المصرفي في 2020 بسبب الفيروس المستجد

هكذا تتجاهل مدارس خاصة إجراءات التعليم عن بعد

رئيس الحكومة.. استفادة أزيد من 700 ألف أجير من تعويض شهري قدره 2000 درهم

العثماني.. 80 مصابا بكوفيد-19 يوجدون في حالة حرجة

ميساء مغربي تواجه إشاعة فضيحة أخلاقية وتقاضي صاحبها
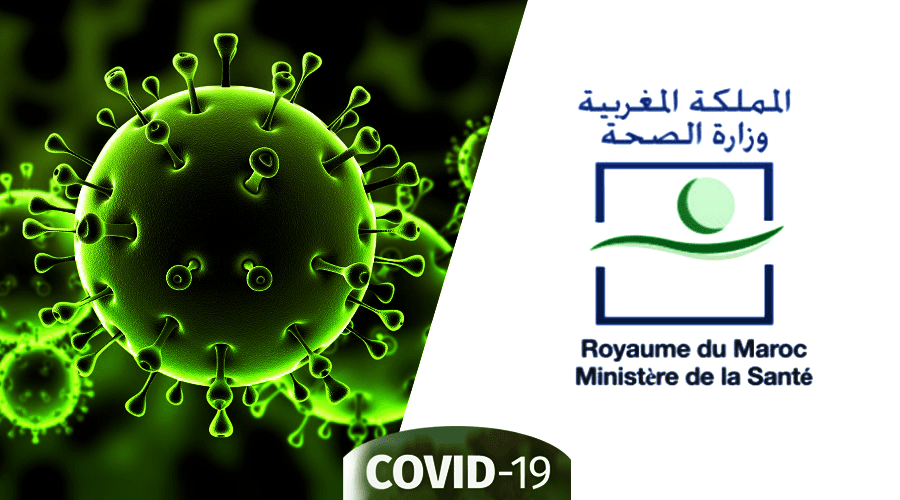
كورونا بالمغرب.. تسجيل 126 وفاة و210 حالات شفاء والإصابات 1838

تسجيل إصابات بفيروس كورونا بسجن القصر الكبير

تداول أخبار زائفة حول البنيات التحتية الصحية يقود شخصا للاعتقال

توقيف بقال متورط في ترويج كمامات مغشوشة والمضاربة في أثمانها

الملك يقترح مبادرة إفريقية لتدبير تداعيات جائحة كورونا

أطباء مغاربة يجيبون مجانا على تساؤلات المواطنين في مجالي الصحة والتكنولوجيا

تسجيل 26 حالة شفاء من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة
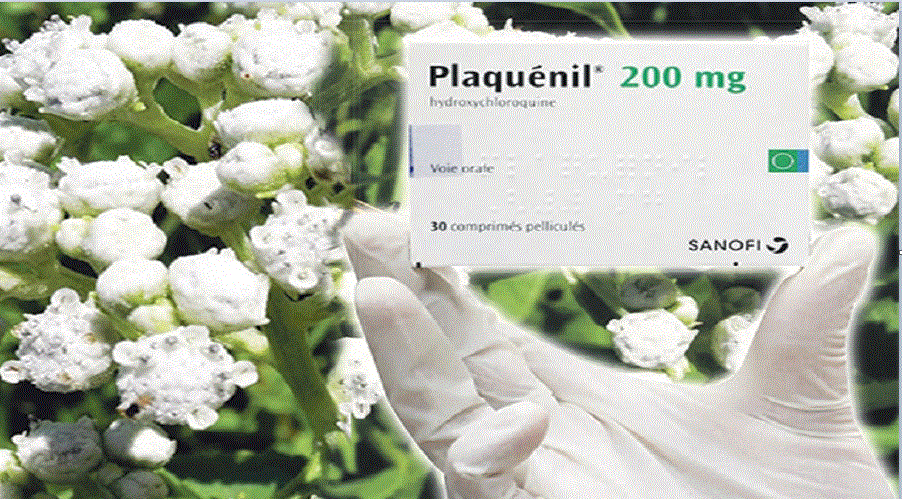
كل ما تجب معرفته عن دواء الكلوروكين

تسجيل أول حالة ولادة لامرأة مصابة بفيروس كورونا بالمغرب

هذا هو المبلغ الإجمالي الموضوع في صندوق تدبير كورونا

هذه حقيقة فيدوهات اجتياح خنازير برية لمدن مغربية

الداخلية تدخل على خط أزمة التشريح الطبي بسيدي سليمان
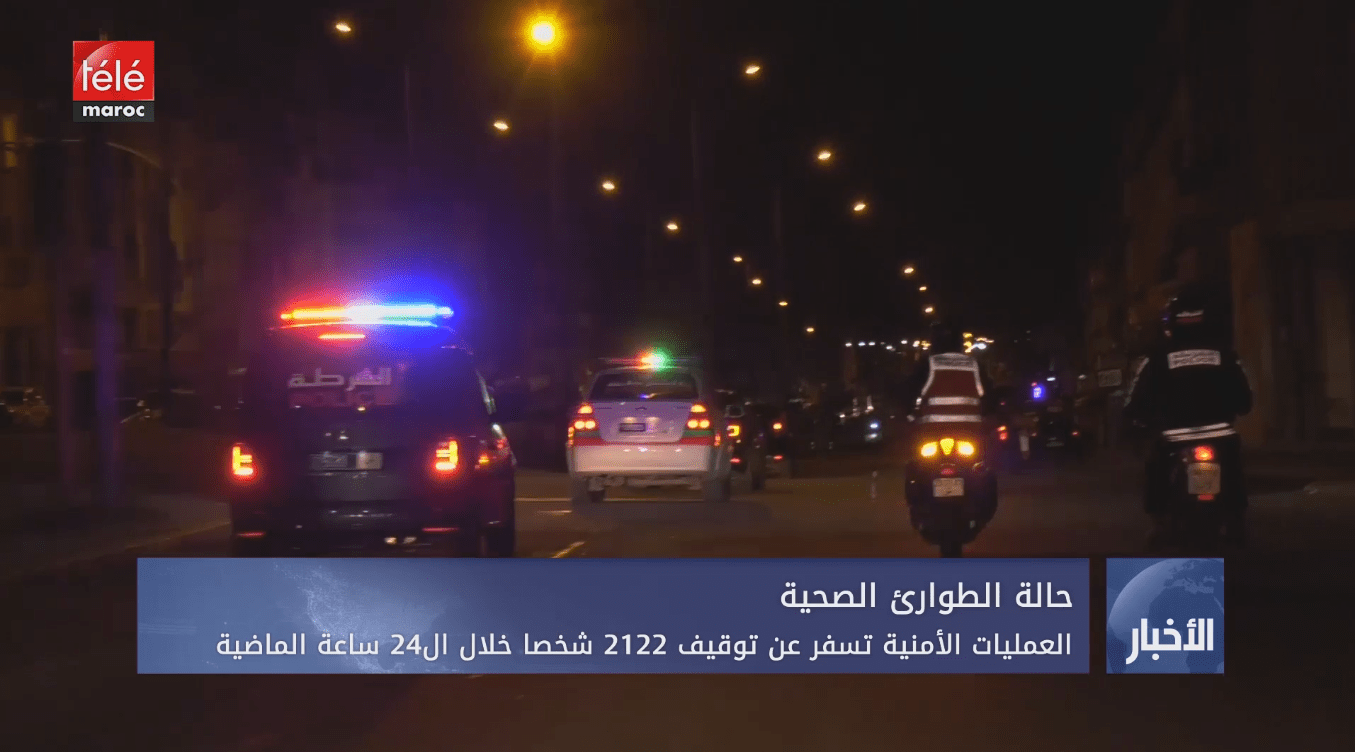
العمليات الأمنية تسفر عن توقيف 2122 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الحكومة يحل بالبرلمان للحديث عن التداعيات الصحية والاقتصادية للفيروس المستجد

اليوبي : الإجراءات المتخذة ساهمت في تمكين المغرب من التحكم في الفيروس المستجد والتقليل من خطورته

العثماني : كل الاحتمالات المتعلقة برفع حالة الطوارئ في الموعد المحدد واردة

روبورتاج.. حالة الطوارئ تخفض أسعار المحروقات وتراجُع في رقم معاملات محطات الوقود

يقظة السلطات في تنزيل حالة الطوارئ تقودها للإطاحة بصيد ثمين

أمن الناظور يوقف 4 متورطين في التهريب الدولي للمخدرات

حجر حي سكني بآسفي واعتقال 11 شخصا بمنزل معد للقمار
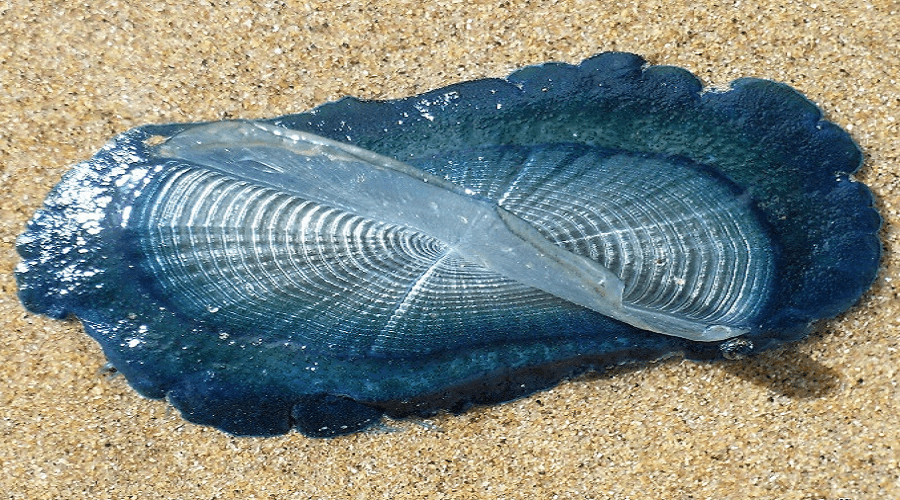
قنديل البحر المزيف يغزو شواطئ مغربية ووزارة الفلاحة توضح

علماء أمريكيون يطورون لقاحا قد يكون فعالا ضد كورونا

الدرك يستمع لرئيس المجلس الجماعي للصخيرات والسبب سيارة BMW
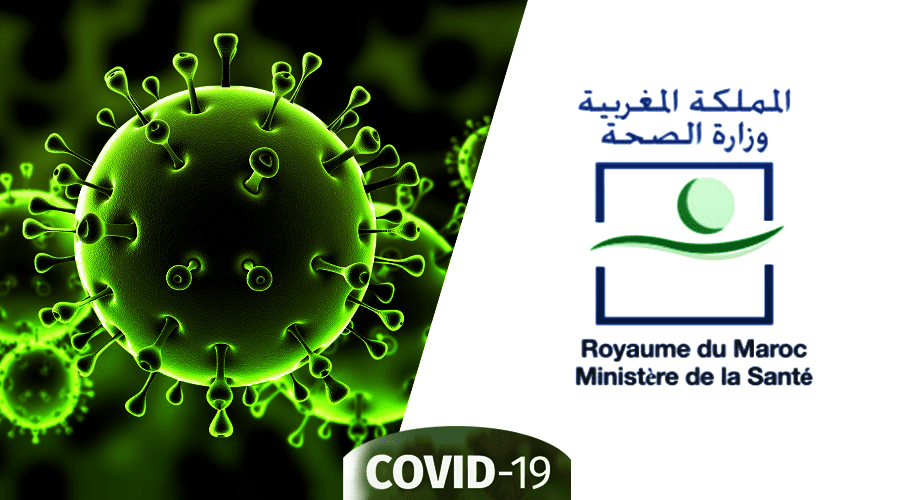
ارتفاع إصابات كورونا إلى 1746 وتسجيل 120 وفاة و196 حالة شفاء

توقيف 2.122 شخصا خلال 24 ساعة بسبب خرق حالة الطوارئ

قائد يحمل مساعدات غذائية لدير مسيحي بميدلت

شفاء 31 حالة من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة

مغادرة 7 حالات للمستشفى بعد تعافيها من كورونا بسلا

شفاء رضيعة من فيروس كورونا بفاس
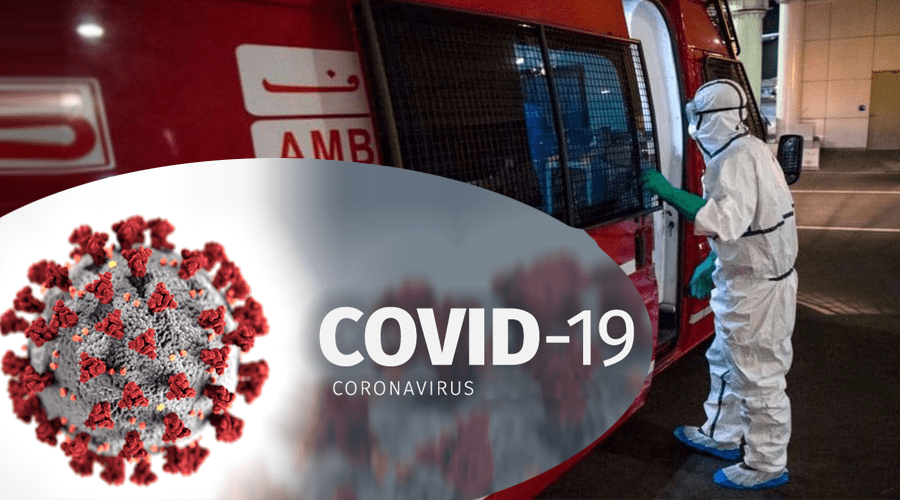
وزارة الصحة ترخص لمستشفيات جامعية بإجراء فحوصات كورونا بهذه المدن

عندما وهب المغرب مساعدات لأقطار العالم

أطباء وممرضين ورجال سلطة وصحافيين مغاربة استشهدوا في الحرب ضد كورونا

كورونا بالمغرب.. ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 153 والوفيات إلى 113 والإصابات تبلغ 1617

خبر سعيد... شفاء طبيبين بالمستشفى الجامعي لفاس من كورونا

هام لأصحاب راميد.. إجراءات استثنائية للإستفادة من المساعدة المالية

نقل 24 شخصا للمستعجلات بالداخلة لهذا السبب

أمن البرنوصي يوقف مغربيا متهما في قضية قتل بإيطاليا

تكليف 15 شركة ببناء مستشفى ميداني في ظرف أسبوعين بالدار البيضاء
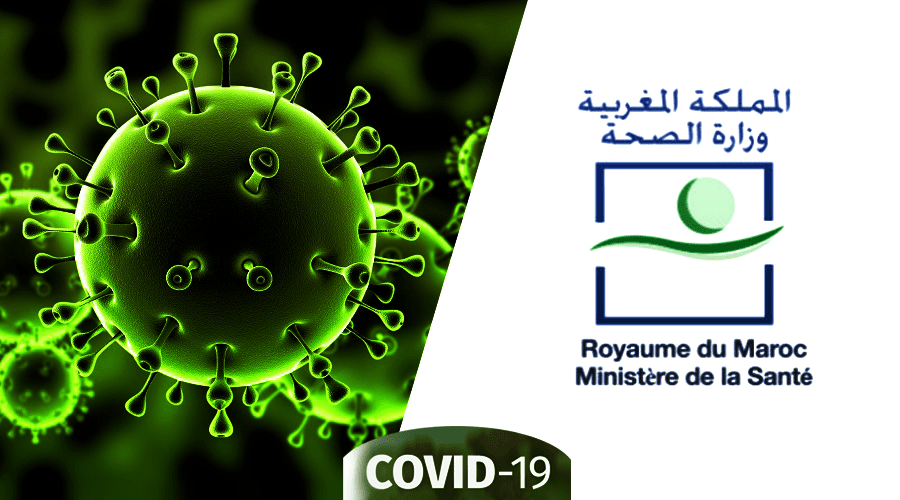
ارتفاع إصابات كورونا إلى 1545 وتسجيل 111 وفاة و146 حالة شفاء

وزارة الخارجية تجند كافة بعثاتها ومراكزها بالخارج لمواكبة أوضاع المواطنين العالقين ومساعدتهم ودعمهم

إطلاق منصة رقمية خاصة بكافة طلبة الأقسام التحضيرية

حالة الطوارئ الصحية.. العمليات الأمنية تسفر عن توقيف 1769 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية
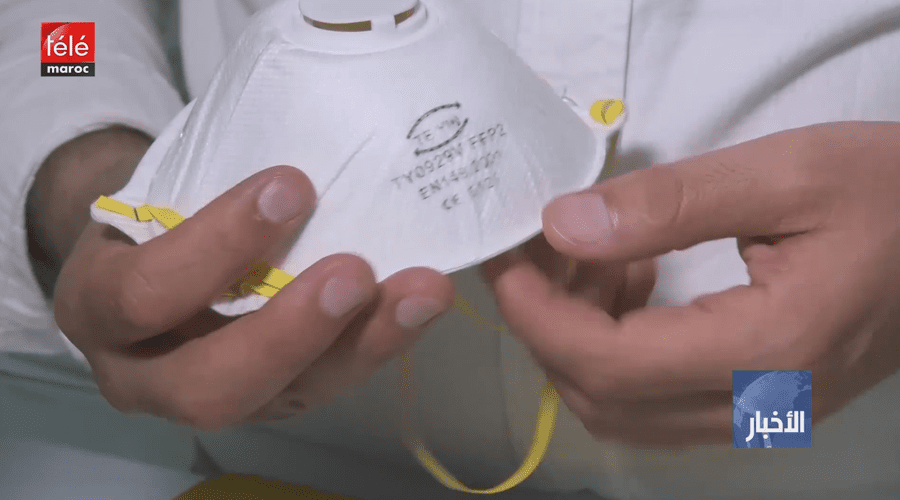
صيادلة المغرب يوضحون سبب تباين أسعار الكمامات

وزارة التعليم تأمر بمراقبة عملية التعليم عن بعد وإرسال تقارير بشأنها

روبورتاج.. تعقيم الشوارع بمدينة الدار البيضاء للحد من انتشار وباء كورونا المستجد

لجنة الطلبيات تكشف خروقات صفقة معالجة النفايات الطبية بـCHU فاس

مافيا تستغل الطوارئ لسرقة الرمال بتطوان

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1527 وتسجيل 110 وفيات و141 حالة شفاء

هام بالنسبة للموظفين... توضيحات مهمة من CNSS

عدم ارتداء الكمامات يجر 174 شخصا للمتابعة

هكذا يؤثر الحجر الصحي على العلاقة بين الأزواج
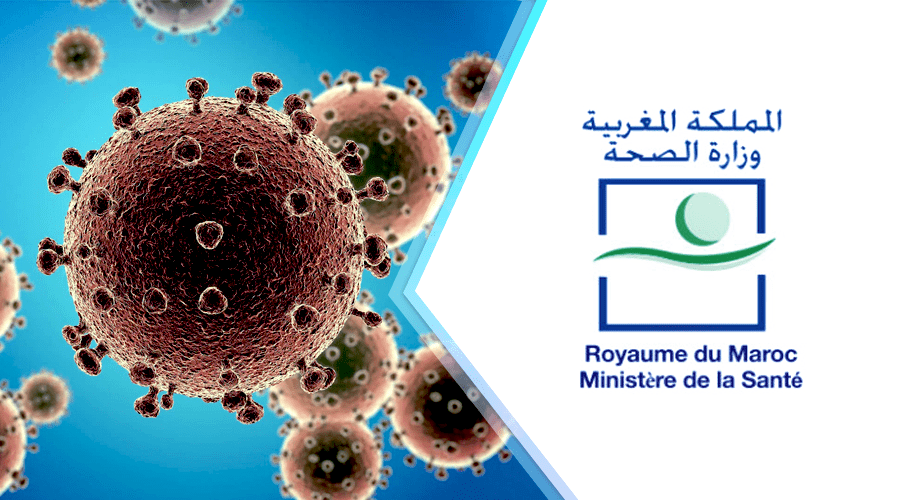
تسجيل 122 حالة شفاء و107 وفيات بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 1448
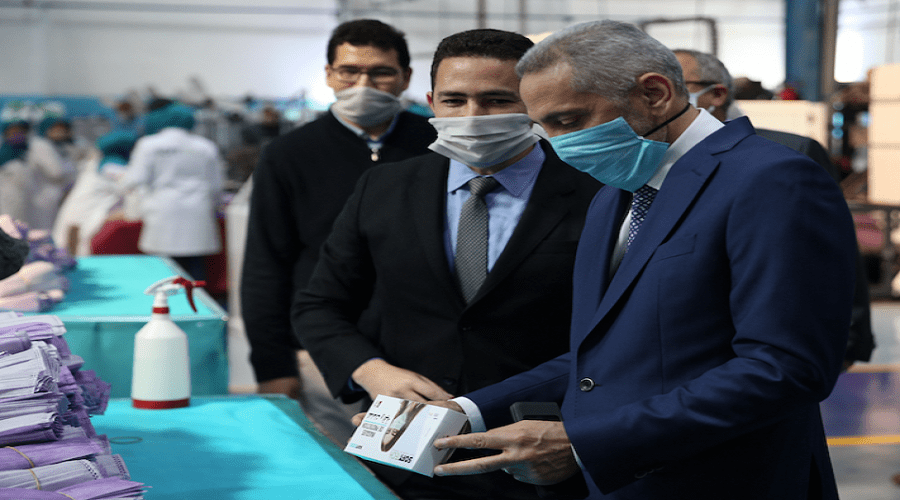
العلمي : المغرب يتجه لإنتاج 5 ملايين كمامة اعتبارا من الثلاثاء القادم

وعود من البنك الأوروبي للاستثمار بدعم المغرب لمواجهة كورونا

المندوب الوزاري شوقي بنيوب يساهم بنصف راتبه طوال أشهر الحجر في صندوق كورونا

وكالة أنباء إيطالية : تدابير المغرب لمواجهة كورونا غير مسبوقة

وزارة الفلاحة: إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق إلى غاية دجنبر 2020

الإعلان عن مسطرة التصريح الخاصة بالمشتغلين في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في "راميد"

العثماني يدعو المواطنين لمزيد من الصبر والالتزام بالحجر الصحي بعد ظهور بؤر عائلية

روبورتاج.. مواطنون حائرون بين البحث عن الكمامات وتفادي عقوبات عدم وضعها

22 ألف و542 شخصا ضبطوا متلبسين بخرق إجراءات الطوارئ
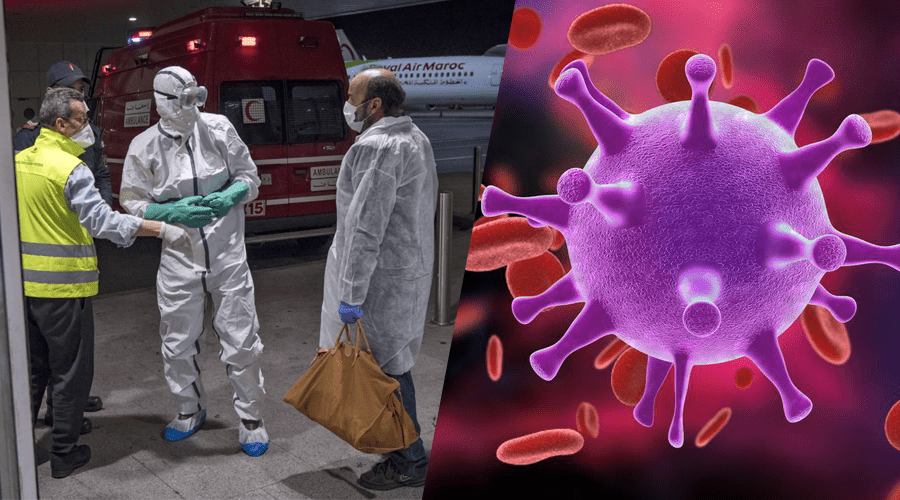
تفاصيل تعميم المغرب لعلاج أعراض كورونا بالكلوروكين قبل نتيجة التحاليل
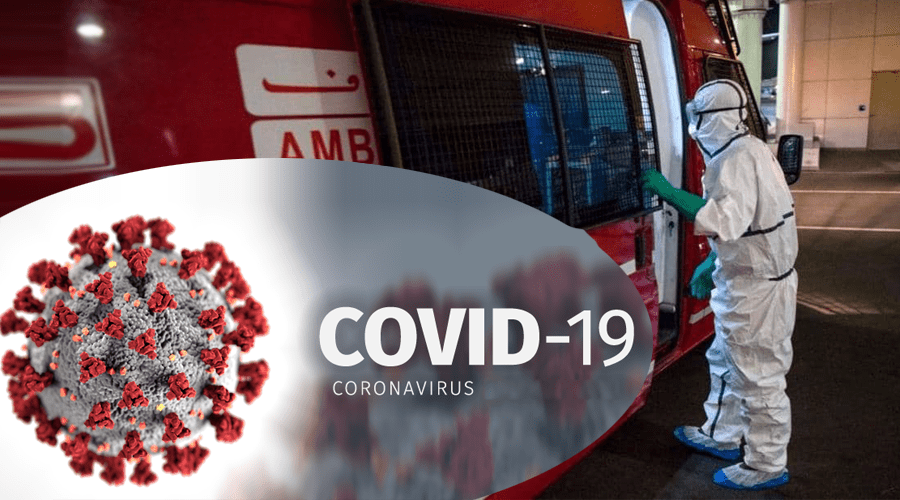
ارتفاع إصابات كورونا إلى 1431 وسجيل 105 وفاة و114 حالة شفاء

روبورتاج.. مبادرات لتعقيم الفضاءات العمومية وتوزيع المعقمات والكمامات مجانا بشوارع الدار البيضاء
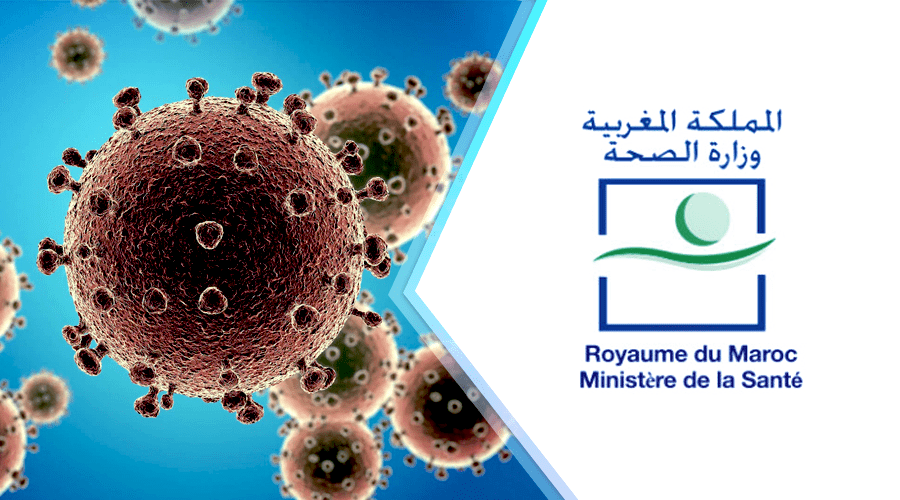
كورونا بالمغرب.. شفاء 12 حالة خلال 24 ساعة وارتفاع الإصابات إلى 1374

لجنة وزارية: وضعية الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية

كورونا تودي بحياة 100 طبيب بإيطاليا

الداخلية تنفي خبر إغلاق المحلات التجارية من الجمعة للإثنين

ممنوع بيع الكمامات بالتقسيط ومن يخالف ذلك سيعاقب

إسبانيا تكشف حقيقة مصادرتها لأدوية موجهة للمغرب
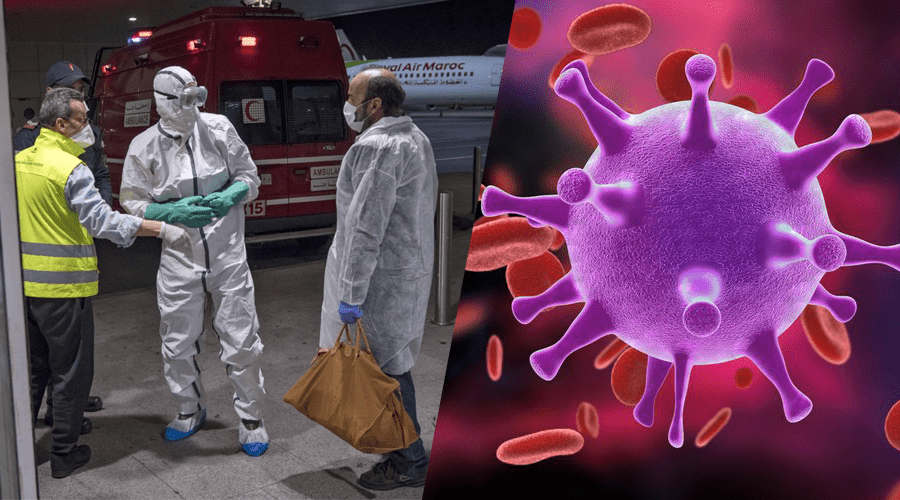
دراسة.. هكذا تجنب المغرب 6000 وفاة بسبب كورونا

المغرب يلجأ إلى صندوق النقد الدولي ويسحب 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة

إطلاق برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق ب " كوفيد-19" بغلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم

روبورتاج.. أحياء لاتحترم حالة الطوارئ وتمضي يومها بشكل عادي

معركة ملائكة الرحمة المغربية متواصلة لإنقاذ المصابين بكورونا

برافو... صناعة أجهزة تنفس اصطناعية بإنتاج مغربي مائة بالمائة

فيروس كورونا يهاجم الجيش الفرنسي

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1346 وتسجيل 96 وفاة و103 حالات شفاء

وزير الصحة يحذر من استعمال أعشاب وخلط مواد خطيرة في التعقيم ضد كورونا

عاجل... وزير الصحة يدعو إلى تعميم العلاج بدواء "كلوروكين" على جميع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا
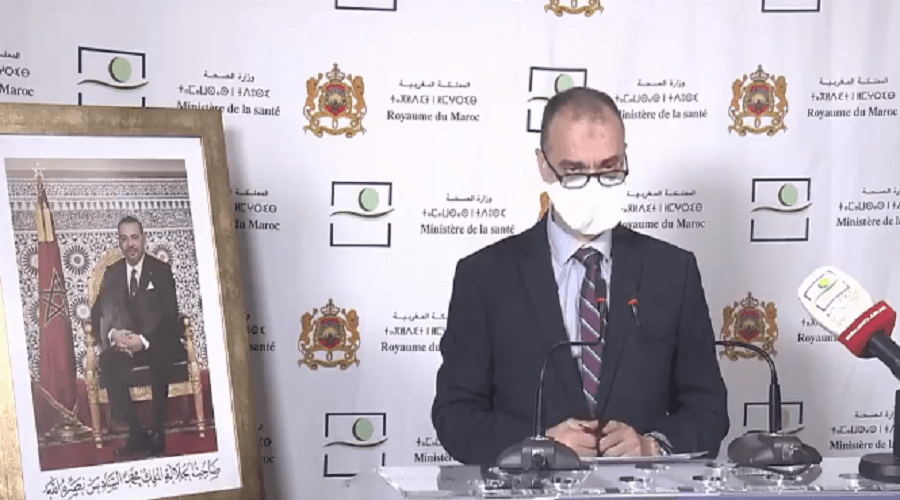
مدير الأوبئة: تم اكتشاف 445 إصابة بكورونا من بين 8600 مخالط
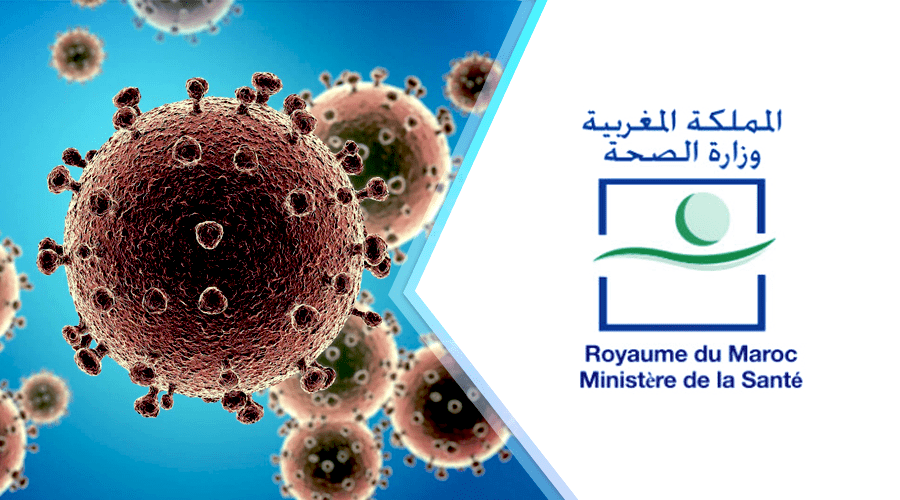
ارتفاع إصابات كورونا إلى 1275 وتسجيل 93 وفاة و97 حالة شفاء

الملك يعفي مكتري محلات الأحباس من دفع واجبات الكراء

إطلاق رقم أخضر جديد لمستعملي منصات التعليم عن بعد

الدار البيضاء.. مركز أمل لعلاج القصور الكلوي يفتح أبوابه لفائدة المصابين بالفيروس المستجد

روبورتاج.. بائعون بالتقسيط يحصون خسائرهم بعدما عادت حركة التبضع إلى وتيرتها العادية

وزير الصحة يدعو أطباء الأسنان إلى تعليق العمل بسبب الفيروس المستجد

800 محامي يتابعون يوتوبرز هاجمت نقيب هيأة مراكش

التجارة الخارحية.. رفع الطابع المادي عن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية ابتداء من 8 أبريل
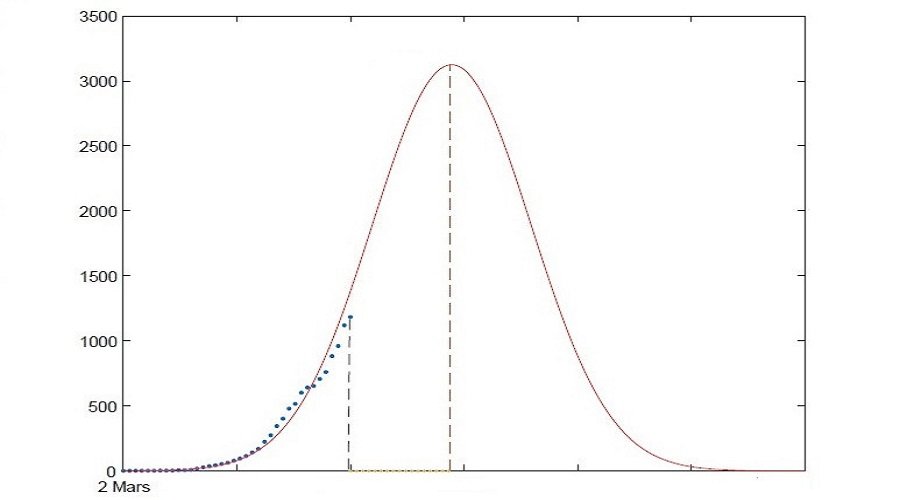
رسم بياني يتنبأ بتاريخ انتهاء وباء كورونا بالمغرب

رجال يخوضون الحرب في الميدان ضد وباء كورونا في المغرب
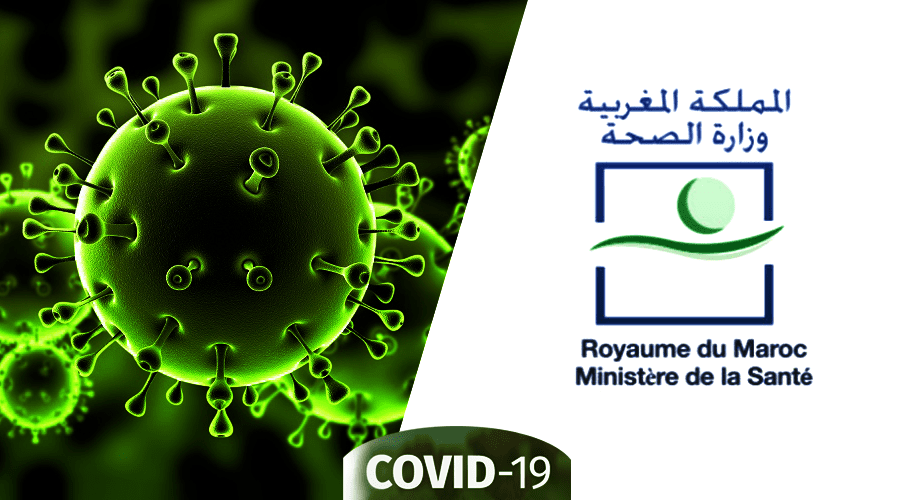
تسجيل 97 حالة شفاء و91 وفاة بكورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 1242

المتاجرة غير المشروعة في الكمامات تقود شخصا في أكادير إلى السجن
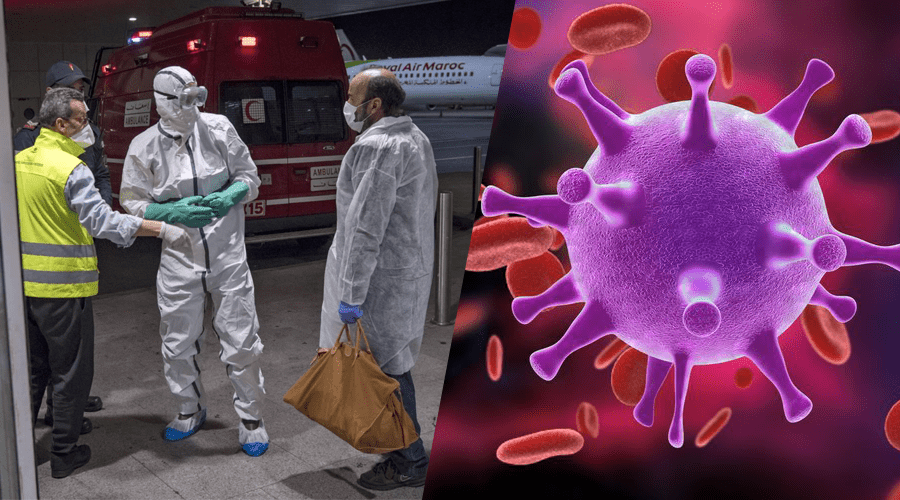
وزارة الصحة تكثف من فحوصات كورونا وتستعين بالمستشفيات الجامعية

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1184 وتسجيل 90 وفاة و93 حالة شفاء

هكذا يتساقط أتباع عبد المولى تباعا أمام القضاء

إصابة رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بكورونا وإخضاع مخالطيه للفحص

فرنسيون يهاجمون سلطات بلدهم بسبب عجزها عن توفير الكمامات ويشيدون بالمغرب

النيابة العامة : هذا ما يواجهه الخارجون إلى الشارع دون وضع كمامة

العثماني : المغرب وصل "منعطفا حاسما" والمطلوب رفع درجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

محلات تضع حواجز في أبوابها وتفرض على زبنائها تعاملا عن بعد

رصد مخالفات مهنية لبعض مراسلي المنابر الصحفية الأجنبية المعتمدة بالمغرب في تغطية تطورات وباء كورونا

ارتفاع إصابات كورونا إلى 1141 وتسجيل 83 وفاة و88 حالة شفاء
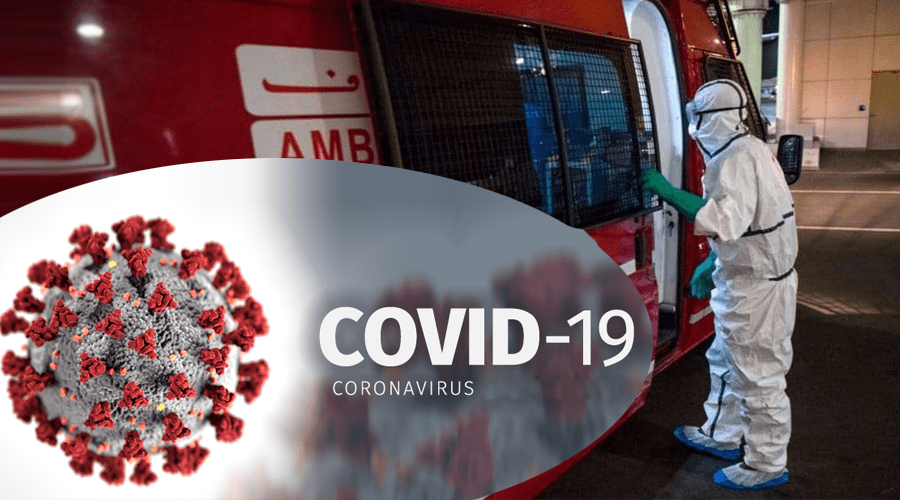
فيروس كورونا يفتك بعائلة طبيب بمكناس

بالصور.. شفاء شابين من فيروس كورنا بمستشفى الرازي بمراكش

إدخال رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور حالته بسبب كورونا

وضع الكمامات الواقية أصبح إجباريا بقوة القانون ابتداء من غد الثلاثاء

التحقيق في فيديو لأجنبي يدعي تعرضه للعنف من طرف أشخاص يتهمونه بنقل كورونا

مدير الأوبئة يكشف سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ويوصي بارتداء الكمامات
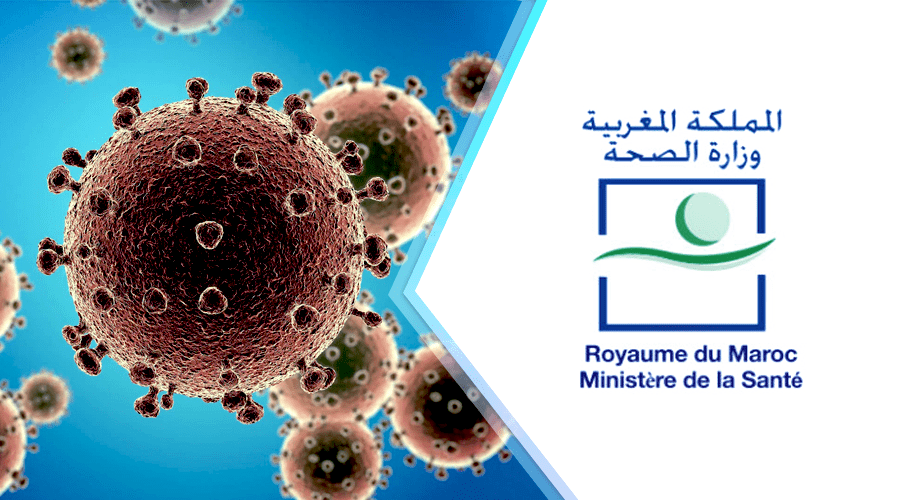
ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 80 وعدد حالات الشفاء إلى 81 والإصابات تبلغ 1120

خبراء مغاربة يوصون بارتداء الكمامة لجميع المواطنين

جونسون آند جونسون تعمل على إنتاج مليار لقاح لفيروس كورونا دون تجارب سريرية

إحداث وحدة ملحقة للاختبار والفحص بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

لجنة وزارية : وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية

تفكيك عصابة تسرق السيارات وتستعملها في النقل السري لكسر الطوارئ

الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة تساهم في صندوق تدبير كورونا

مراقبة صحية مشددة للبضائع وسائقي النقل الدولي بالموانئ والمطارت

المعهد الوطني للجيوفيزياء.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات بإقليم فكيك

وكالة التنمية الفلاحية تدعم التعاونيات أمام تداعيات الفيروس المستجد

توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية في إطار مكافحة الأخبار الزائفة
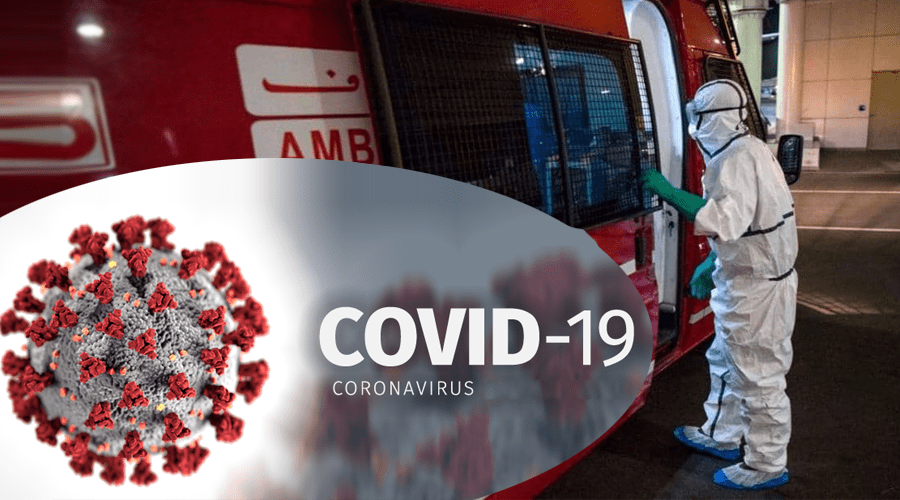
وزارة الصحة تنفي وفاة طبيب بمراكش وتحذر من الشائعات

سلطات آسفي تمنع طاقما صينيا من مغادرة باخرة تجارية
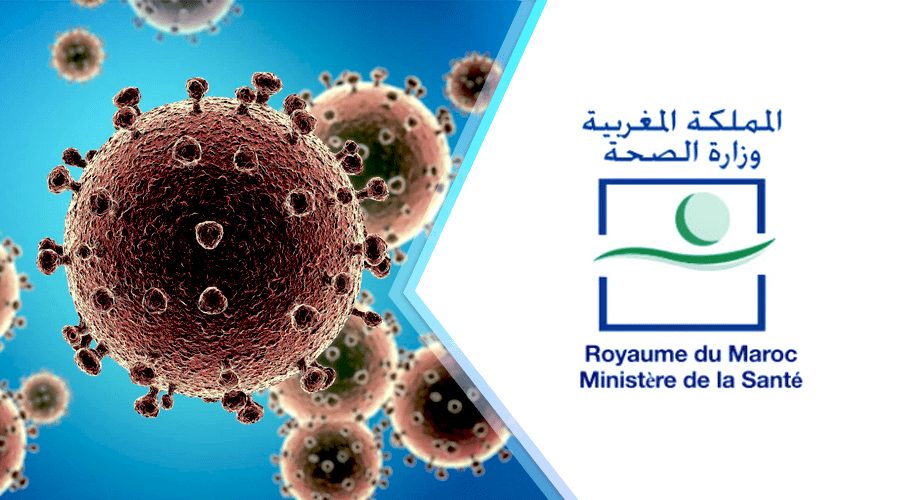
تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1113 حالة

الأخبار الزائفة وخرق حالة الطوارئ يقود 8612 شخصا للتحقيق

الشروع بالمغرب في توزيع 500.000 كمامة يوميا لمواجهة كورونا
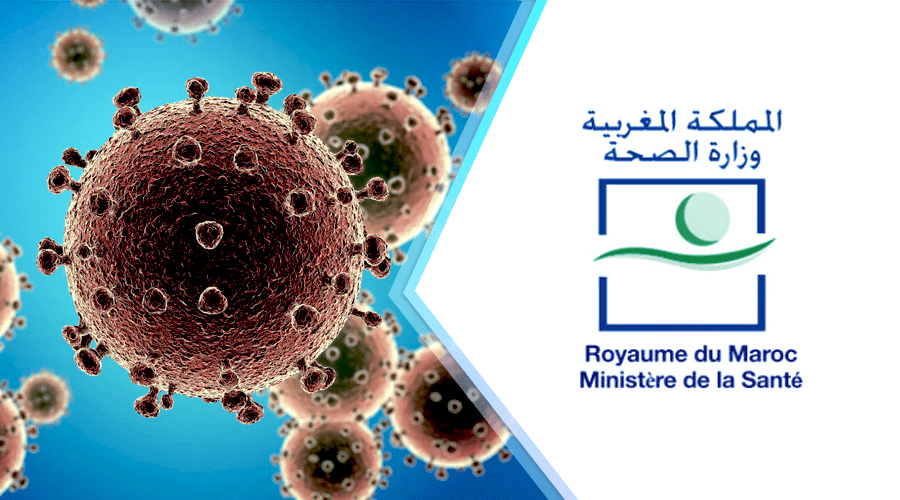
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 1021 حالة

مصائب قوم... أرباح الصين من مبيعات الكمامات تتجاوز مليار أورو خلال شهر واحد

حجر صحي كامل على أحياء كاملة بالناظور لوقف تفشي كورونا
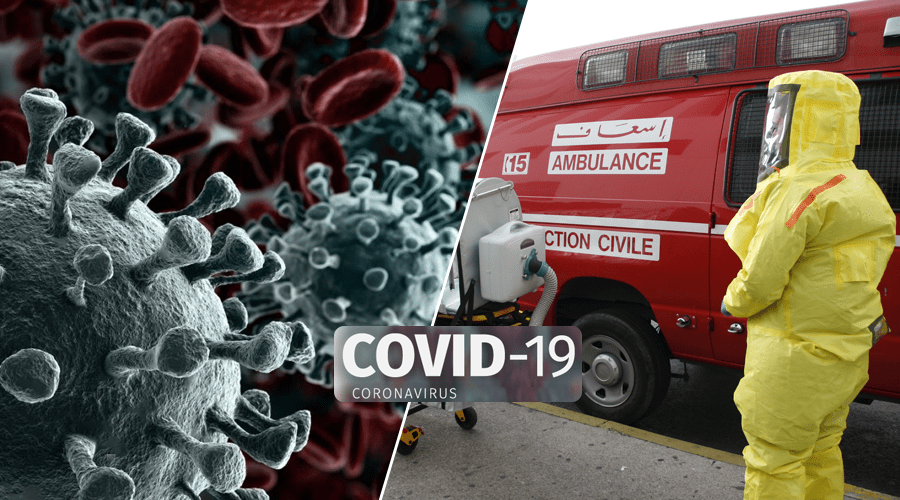
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 990 وظهور بؤر للفيروس داخل الوسط العائلي

الشروع في بناء مستشفى ميداني بسعة 700 سرير بالدار البيضاء

أخصائيو الإنعاش بالقطاع الخاص يقدمون يد المساعدة للقطاع العمومي

الـ ONEE يقرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى ما بعد حالة الطوارئ

المخابز تواصل نشاطها خلال الأوقات المحددة من قبل السلطات

نساء سلطة وضعن أحياء تحت السيطرة

علي بابا يرسل إلى نيويورك 1100 جهاز تنفس اصطناعي

د الطيب حمضي : هذه هي الحالات التي يجب خلالها ارتداء الكمامة

كورونا يحرك بضواحي القنطيرة أكبر معمل في إفريقيا لإنتاج الكحول الطبية
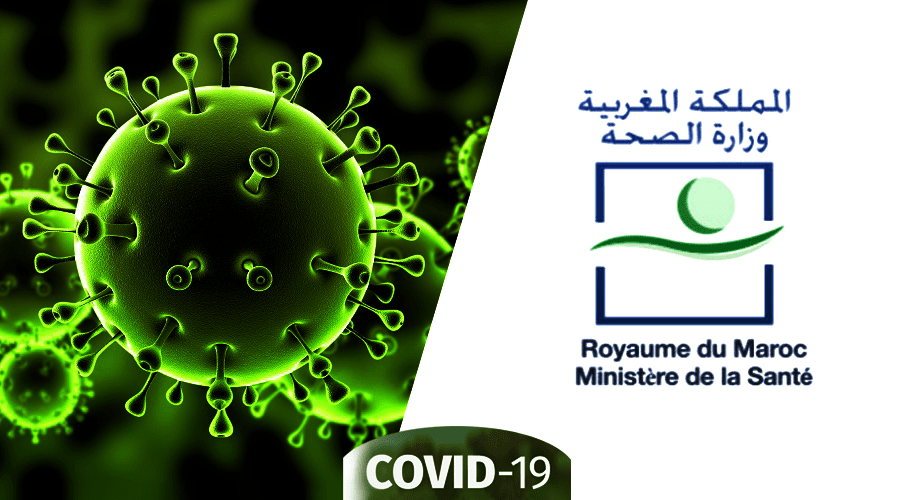
ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 70 والوفيات إلى 69 حالة

وفاة رئيس جماعة بسبب إصابته بفيروس كورونا

مدارس خاصة تهدد الآباء وتطالبهم بأداء مصاريف التمدرس

الملك محمد السادس يصدر عفوه عن 5654 معتقلا
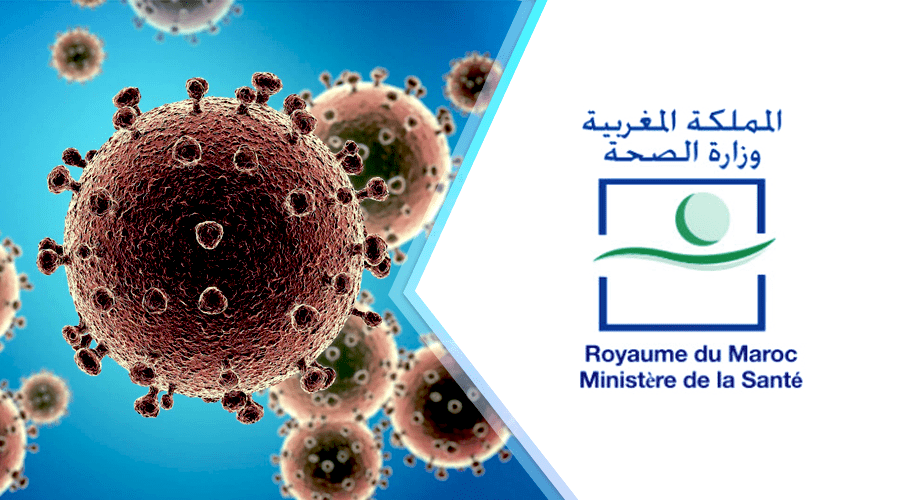
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 960 وعدد حالات الشفاء إلى 69

تفاصيل سحب الإعانات بالنسبة للأجراء التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي

فيروس كورونا يودي بحياة 3 أطباء مغاربة في يوم واحد

توقيف 4 متورطين في النصب بدعوى جمع تبرعات لضحايا كورونا

مدير الأوبئة يؤكد ظهور بؤر لكورونا داخل الوسط العائلي
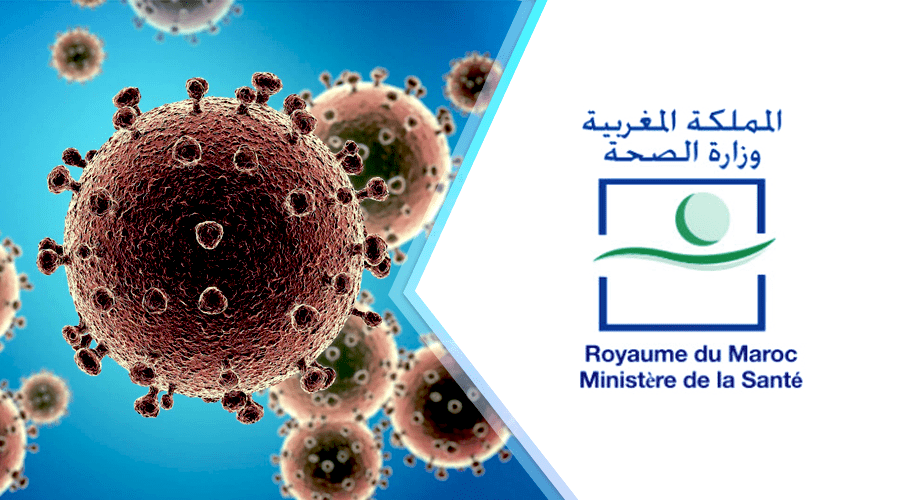
تسجيل 11 حالة وفاة و9 حالات شفاء من كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة
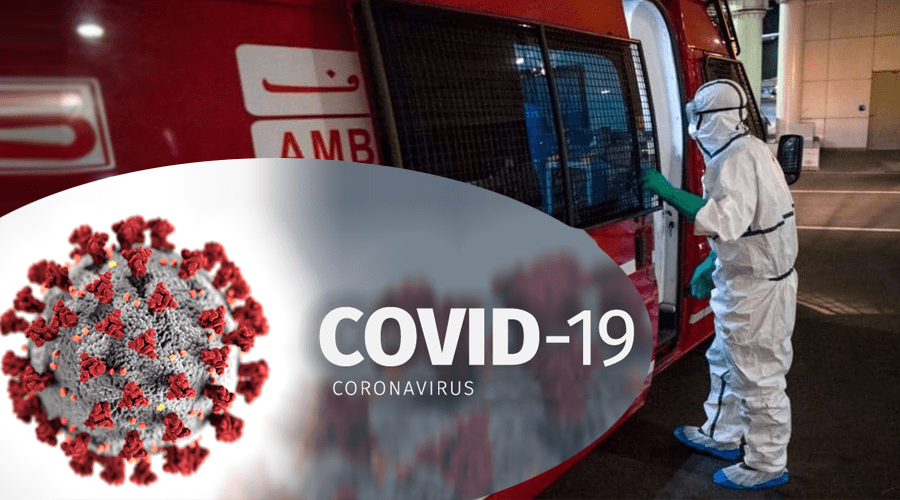
وزارة الصحة : 65 حالة شفاء و58 حالة وفاة و883 حالة إصابة

مستشفى ابن رشد يحتفل بشفاء أول حالة إصابة بكورونا بقسم الإنعاش

وفاة رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط بعد إصابته بكورونا

إيواء أزيد من ألف مغربي من العالقين بتركيا بفنادق بإسطنبول

حالات الشفاء من كورونا بالمغرب ترتفع إلى 62 حالة

وزارة العدل تتخذ إجراءات حمائية للقضاة والأطر والموظفين التابعين لها وكذا المرتفقين والمتقاضين

أمزازي يؤكد استمرار تقديم الدروس عن بعد مستبعدا الإعلان عن سنة بيضاء

سكان الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء يواصلون الالتزام بالحجر الصحي تفاديا لتفشي وباء المرض الجديد
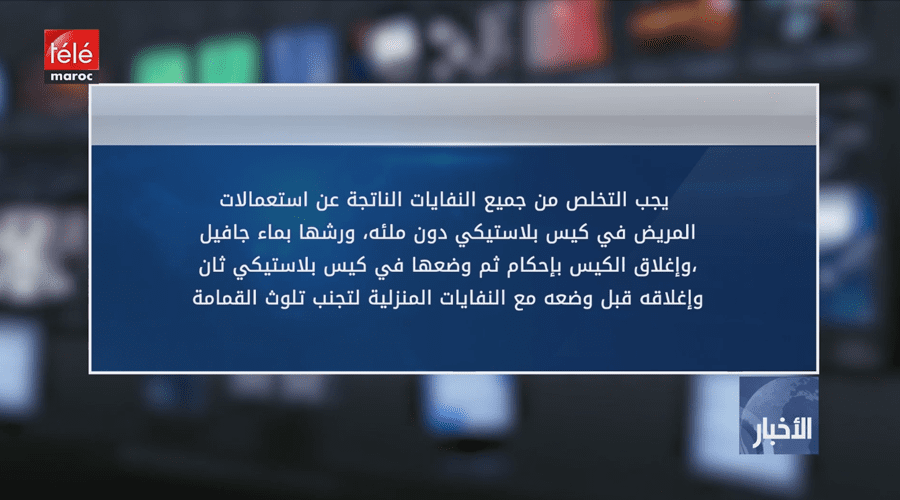
وزارتا الصحة والطاقة تتخذان تدابير لحماية الأطباء وعمال النظافة من نفايات الفيروس المستجد

أمريكا تجمع بيض الدجاج في مزارع سرية لإنتاج لقاح للإنفلونزا
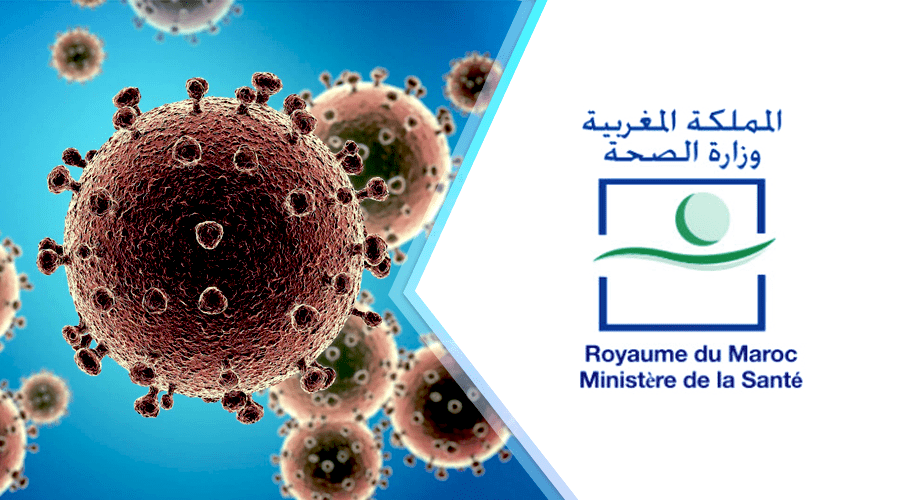
تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 844 حالة

القوات المسلحة تستعين بـ 2000 طبيب متقاعد لمواجهة كورونا

وزارة الصحة : الحجر سيرفع تدريجيا تجنبًا لعودته من جديد

اعتقال شخص ظهر في فيديو وهو يحرّض على خرق الطوارئ الصحية بخريبكة

المغرب يسجل 47 حالة وفاة و56 حالة شفاء و761 إصابة بفيروس كورونا
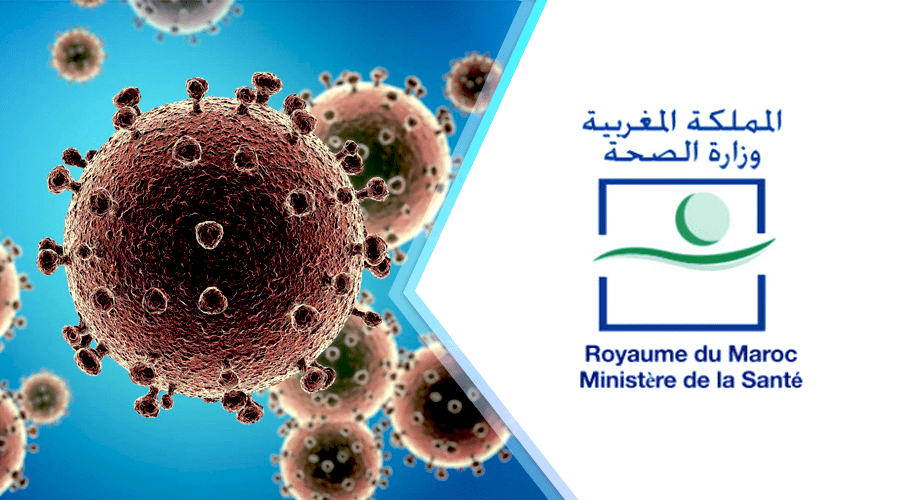
لأول مرة... عدد حالات الشفاء من كورونا بالمغرب يتجاوز عدد الوفيات

اعتقال فتاة تتزعم عصابة متخصصة في السطو على إعانات الطوارئ

هكذا سيمكن للإدارات مواكبة العمل عن بُعد

نادي المحامين بالمغرب يرفع دعوى ضد طبيب فرنسي بسبب تصريحاته العنصرية
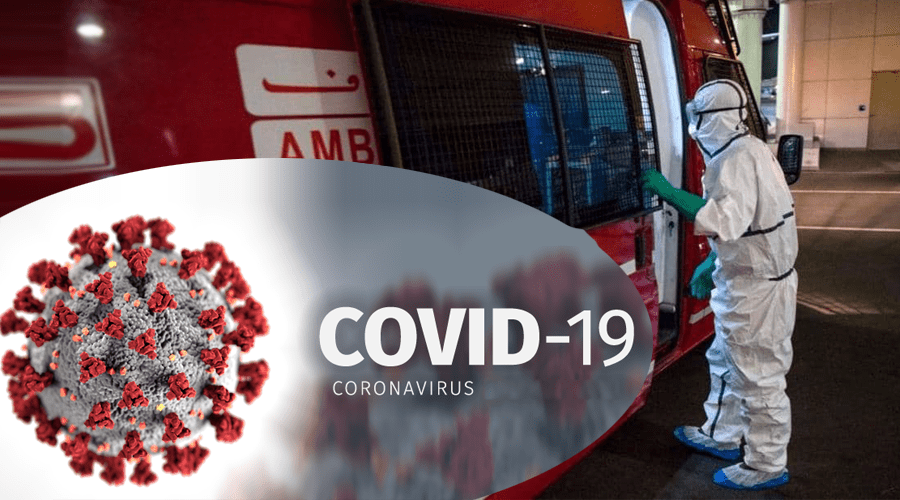
سيدتان إحداهما تبلغ 84 سنة تنتصران على كورونا بطنجة

جمعيات ومبادرات تدعم المتشردين ونزلاء دور الرعاية تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية

وزارة الفلاحة والصيد البحري.. الإنتاج الفلاحي مستمر بشكل عاد والسوق مزود بشكل كاف بالمنتجات الغذائية والفلاحية

مهن يضطر أصحابها للخروج للعمل رغم حالة الطوارئ الصحية

تفاصيل عزل حي شعبي بالقنيطرة بعد إصابة 4 أطفال بكورونا

ترويج أخبارا زائفة حول كورونا يجر عضوا بشبيبة البيجيدي إلى السجن

توقيف 3 أشخاص بتهمة انتحال صفات رجال سلطة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 735 وتسجيل 3 حالات شفاء جديدة

أمزازي : لا سنة بيضاء وهذا موعد الامتحانات

الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وكيفية المساهمة فيه – النسخة الأمازيغية
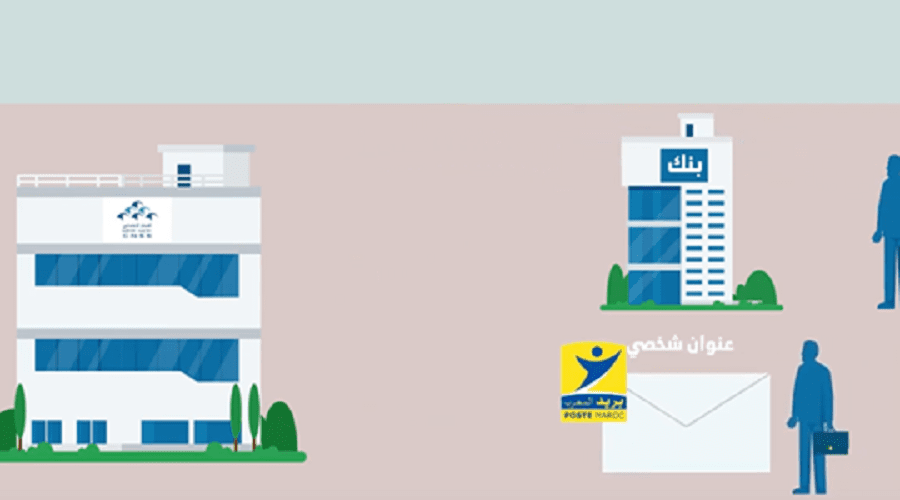
تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء

تسجيل صوتي حول كورونا يجر ممرضة للتحقيق

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تحول ثلثي موظفيها إلى الدوام الجزئي

هذه تدابير CDG لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة

بانوراما.. إشاعات خاطئة حول فيروس كورونا تجب محاربتها

متابعة 4835 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية و58 بنشر أخبار زائفة

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 691 حالة

القوات المسلحة الملكية تنهي بناء أول مستشفى عسكري ميداني ببنسليمان

وزارة التربية الوطنية تكشف الحصيلة الأولية لعملية التعليم عن بعد

عشاب يزعم اكتشاف علاج لكورونا ومطالب بمحاكمته

الداخلية تشرف على توزيع 100 مليون من المساعدات بالمضيق

أمكزاز : تسجيل أزيد من 700 ألف من الأجراء المنخرطين في الضمان الاجتماعي للاستفادة من التعويضات

اليوبي : من السابق لأوانه إجراء تقييم لعقار كلوروكين.. وفتح تحقيق في وفيات كورونا

هذه توقعات مدير الأوبئة بخصوص تطور الإصابات بكورونا في المغرب

معاناة مستعملي النقل العمومي بعد توقف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة

وزارة الفلاحة تؤكد استمرار تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية والفلاحية بشكل عادي

مختبر فارما 5 يساهم ب 8 ملايين درهم في صندوق مكافحة كورونا

تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ترتفع الحصيلة إلى 676 حالة

أطباء بطنجة يطالبون بآليات الحماية ووسائل التعقيم

فيديو بلغة الإشارة للإجراءات الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من كورونا

إجراءات الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل – بنسخة التريفيت

قواعد النظافة الواجب اتباعها من اجل الوقاية من انتشار كورونا
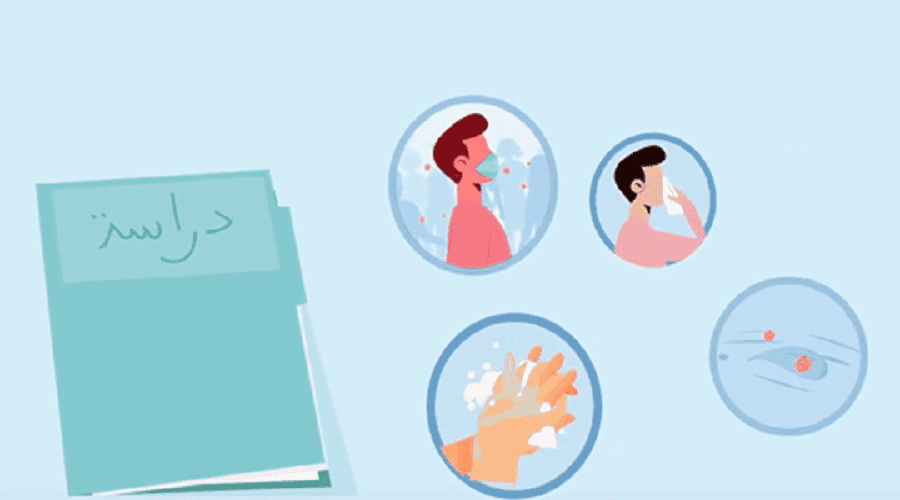
أسئلة و أجوبة لتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة عن المرض الجديد

تحسن الوجبات الغذائية بالمستشفيات بعد التعليمات الملكية

أنباء عن إصابة المندوب الإقليمي للصحة بأكادير بفيروس كورونا
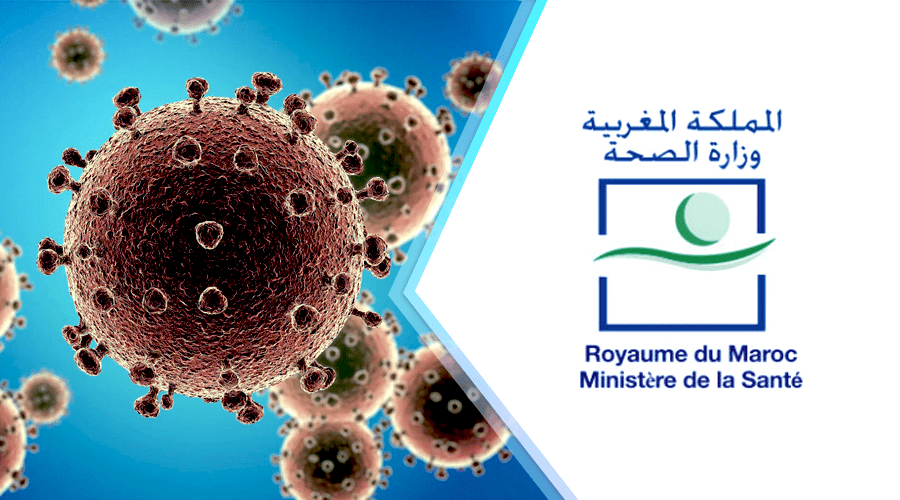
تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 654 حالة
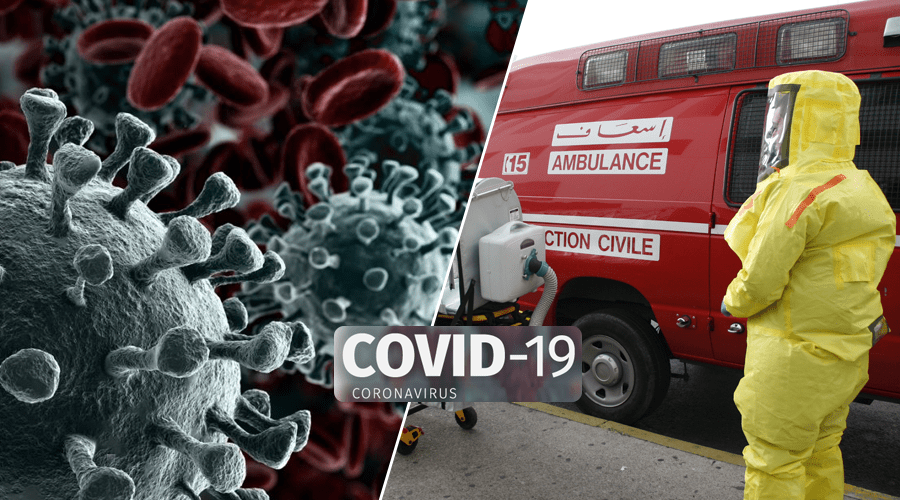
أخبار سارة... تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد إصابات كورونا بالمغرب
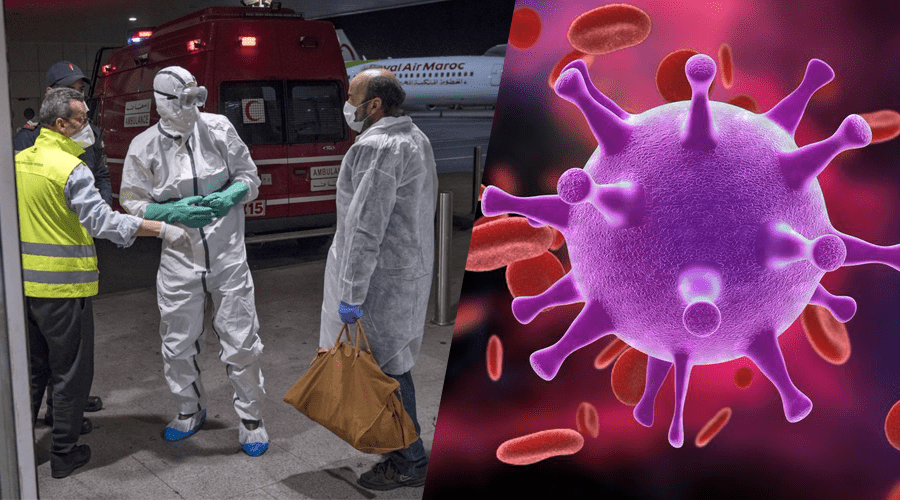
تحقيق علمي لتحديد أسباب الوفيات الناجمة عن كورونا بالمغرب

الحموشي يوقف عميد شرطة أخل بإجراءات الطوارئ الصحية
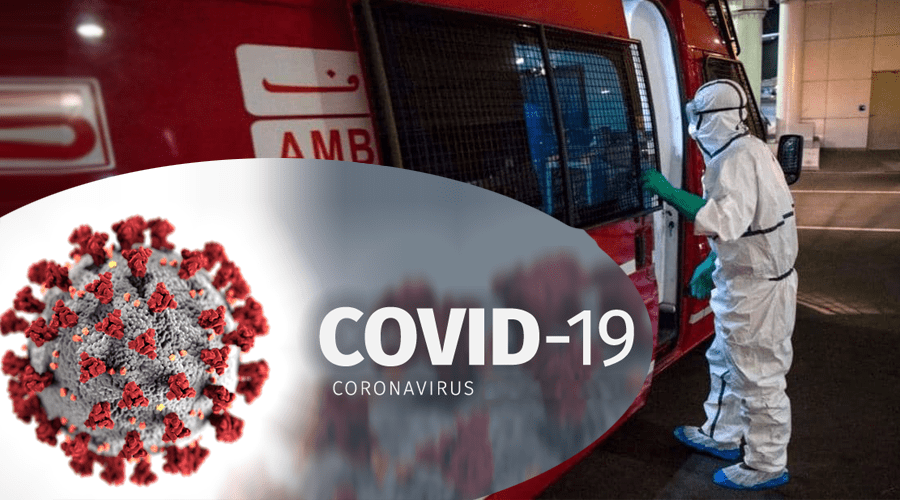
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 642 حالة

نقابات قطاع الصحة الخاصة تقلب الطاولة على الهيئة الوطنية للأطباء

المغرب يقتني مائة ألف تحليلة الكشف السريع عن كورونا

أول مصاب بكورونا في مراكش يغادر المستشفى رفقة أفراد عائلته (صور)

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المغرب إلى 26 وعدد الوفيات إلى 37

المصحات الخاصة تضع 500 سرير رهن إشارة الدولة لمواجهة كورونا

وزير الصحة.. الإجراءات الاستباقية جنبت المغرب السيناريو الأسوء

السلطات تترصد المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بالدار البيضاء

الـ AMAIPP تساهم بـ 10 ملايين درهم في صندوق تدبير كورونا

هكذا يستغل البيجيدي قفة كورونا انتخابيا بالشمال

سلطات سيدي سليمان تحرر الملك العام تزامنا مع حالة الطوارئ

إدارة مستشفى الرازي تنفي صحة فيديو يوثق تصريحات بعض الممرضات
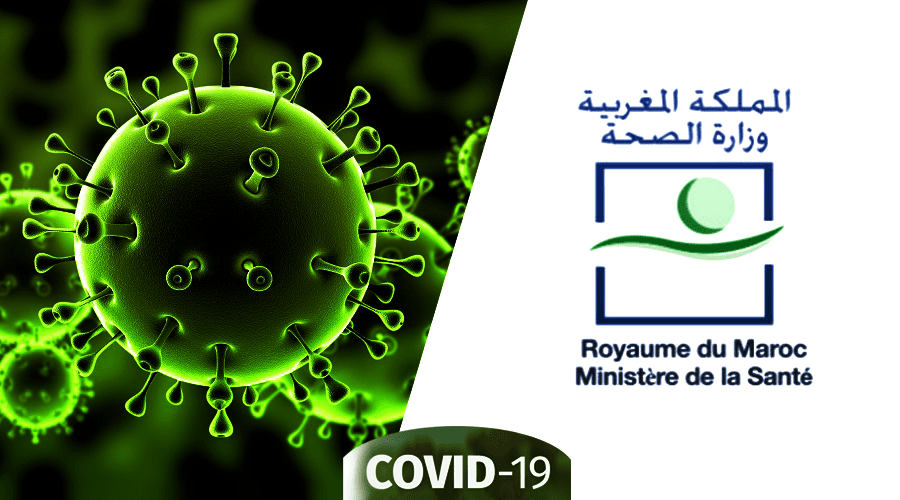
تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الحصيلة إلى 638 حالة

الحبس النافذ لرئيس جماعة بسبب الشطط والارتشاء

شركة Lamatem تشرع في تزويد الدولة بالمنتجات الطبية من النسيج لمواجهة كورونا

تعليمات ملكية بتوفير رعاية خاصة لمرضى كورونا

بعد المدارس الخصوصية هيئة الأطباء تطالب بمساعدة من صندوق كورونا

إصابة ابن مسؤول بكورونا لمخالطته وافدا من إيطاليا تستنفر سلطات الهرهورة

إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لمواجهة تحديات كورونا

بالفيديو.. 4 حالات تعافت من كورونا تغادر المستشفى على وقع التصفيقات والفرح

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأمر بإجراءات احترازية لحماية المعتقلين من الفيروس المستجد

السلطات تتصدى لمهربي النقل السري نحو الصحراء عبر مسالك غير معبدة

1109 متعافين من فيروس كورونا في 24 ساعة
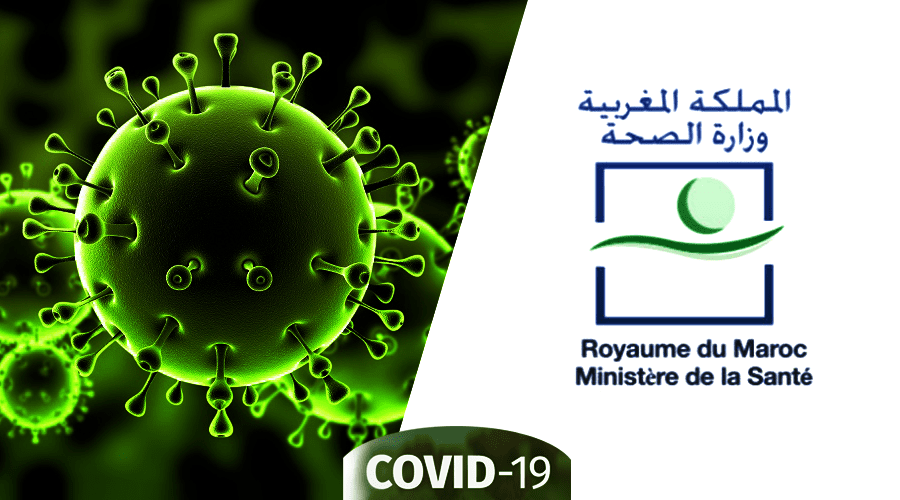
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 602 وعدد حالات الشفاء إلى 24

هكذا تخطط وزارة الصحة لتوسيع شبكة إجراء تحاليل كورونا

كل ما يجب معرفته حول الآثار النفسية السلبية للحجر الصحي

حقيقة استفادة باطما وسكينة غلامور من معاملة خاصة داخل السجن

المركزية الشريفة للسيارات تساهم بـ50 مليون درهم في صندوق كورونا

وفاة 3 يهود مغاربة بكورونا بعدما حضروا حفل زفاف بأكادير

وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت

قطاع الصحة.. دعوات لتوفير شروط الوقاية للأطر الصحية والتمريضية لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا

سعد الدين العثماني.. تأجيل ترقية الموظفين إلى حين تجاوز أزمة كورونا

الدار البيضاء.. الأجواء من أمام محطة القطار بعد دخول قرار منع التنقل بين المدن حيز التنفيذ

حواجز ودوريات أمنية في العاصمة لتشديد المراقبة وتطبيق حالة الطوارئ

الـONEE يتخذ إجراءات خاصة لحماية مسيري النظام الكهربائي والمائي

وفاة أزيد من 3 آلاف شخص بسبب كورونا في الولايات المتحدة

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الحصيلة إلى 574 حالة

الديستي تطيح بخمسيني استغل حالة الطوارئ وانتحل صفات سامية للنصب

ولاية جهة الشرق ترد على تصريحات والدة الرضيعة المتوفاة بكورونا

بنكيران ينفي التبرع بمعاشه لصندوق تدبير جائحة كورونا
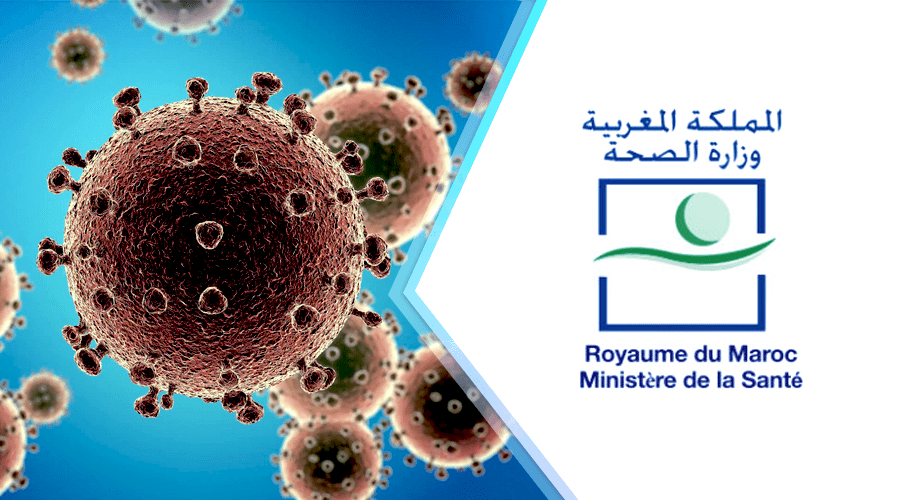
تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 556 حالة

تداول أخبار زائفة حول الحالة الوبائية يطيح بـ3 أشخاص
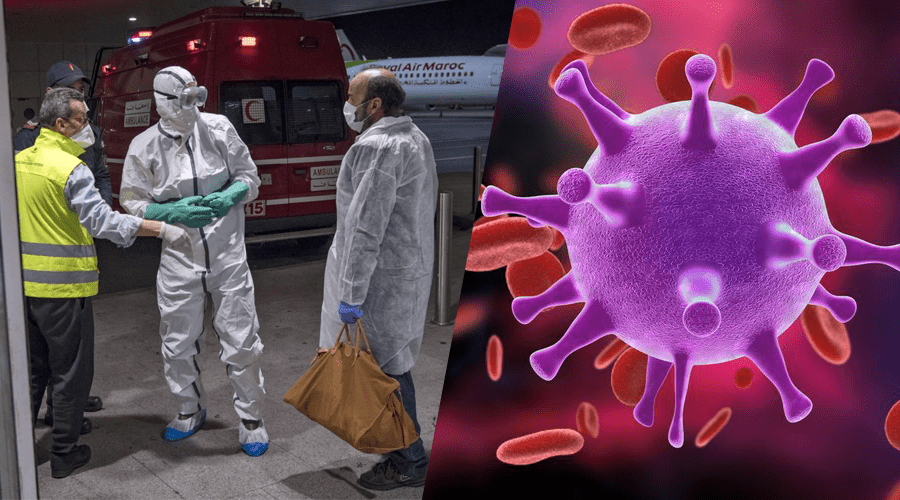
ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في المغرب إلى 33 وعدد المتعافين إلى 14

مدير الأوبئة : رحلة سياحية وحفلة تسببتا في ظهور بؤرتين لكورونا بالمغرب

ترامب: إذا توفي 100 إلى 200 ألف أمريكي بفيروس كورونا سنكون قد حققنا إنجازا كبيرا !

هذا آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين عن العمل للحصول على 1000 درهم

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 534 حالة

أطباء الأحرار يطلقون خدمة خاصة بمرضى السرطان

سائحة فرنسية تنصف الأطقم الطبية المغربية بعد تعافيها من كورونا وتشيد بوطنيتهم

مستشفى مراكش يرد على فيديو لشخص مصاب بكورونا

شروط خاصة للأطباء الراغبين في إغلاق عياداتهم خلال فترة الطوارئ الصحية

الدار البيضاء.. الرفع من وتيرة حركة طرامواي في بعض الأوقات لمنع انتشار فيروس كورونا

إطلاق برنامج لدعم استثمارات المقاولات في تصنيع المنتجات المستعملة في مواجهة كورونا

مواطنون يخرقون حالة الطوارئ الصحية بسبب الدعم والداخلية تدخل على الخط

جولات أمنية ليلية لزجر المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بشوارع العاصمة الاقتصادية

تفاصيل وضع حي بأكمله بالعرائش تحت الحجر الصحي

نشرة خاصة.. أمطار قوية بهذه المناطق من المملكة
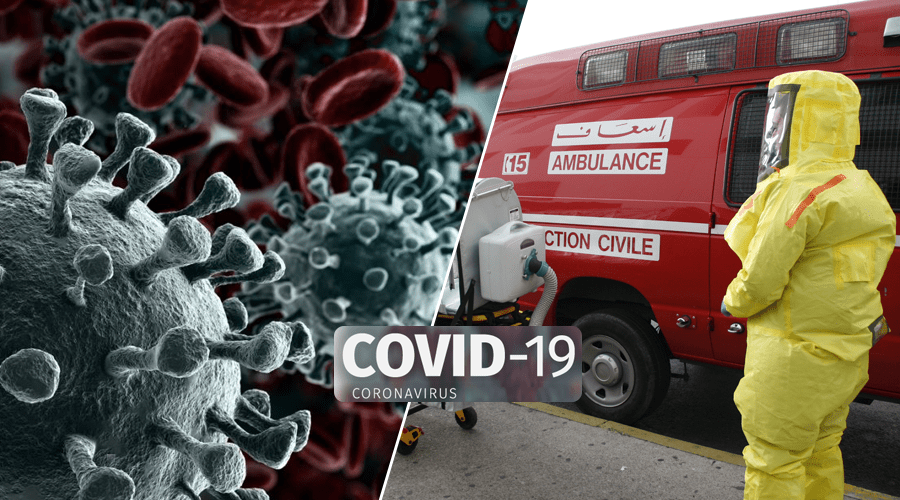
ارتفاع عدد وفيات كورونا بالمغرب إلى 29 وعدد المتعافين إلى 14 حالة

بعد فضيحة باب دارنا.. حسن الفد في ورطة

صورة تكشف تقدم الأشغال في بناء المستشفى الجامعي بطنجة

بالفيديو.. هكذا يمكنكم للاستفادة من تعويض التوقف عن العمل بسبب كورونا
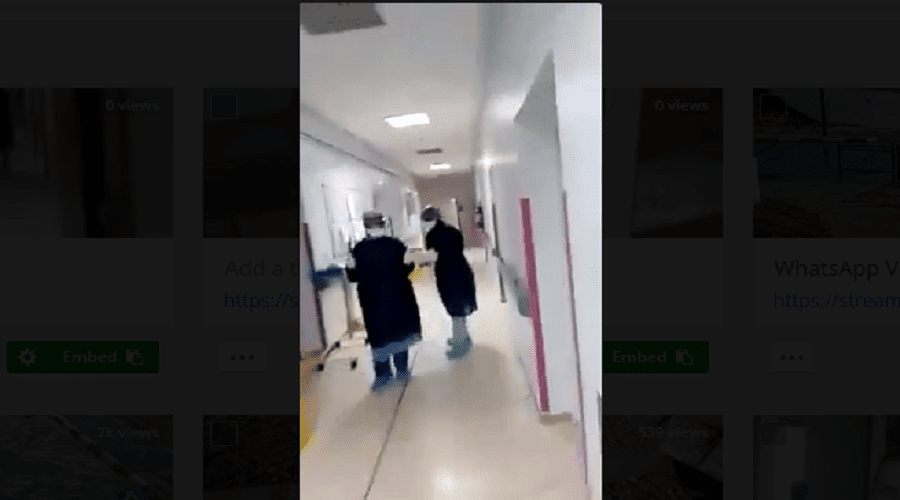
فيديو من داخل مستشفى يرقد فيه مرضى كورونا بالمغرب يقدم رواية أخرى
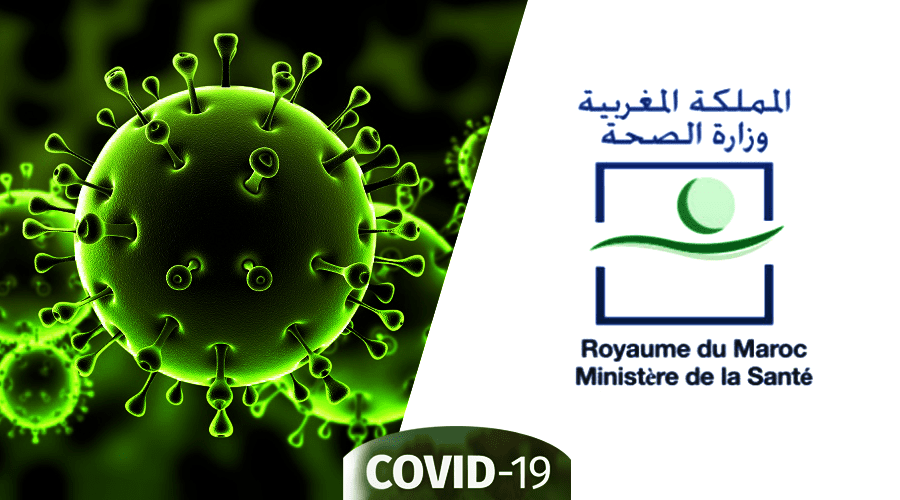
تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 516 حالة

أطباء مغاربة يعقدون اجتماعا مع خبراء صينيين لمحاربة فيروس كورونا
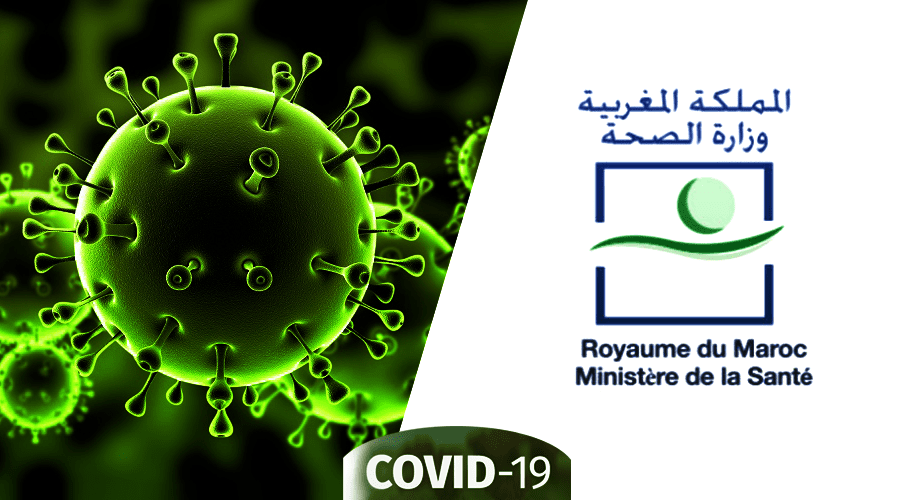
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 479 حالة
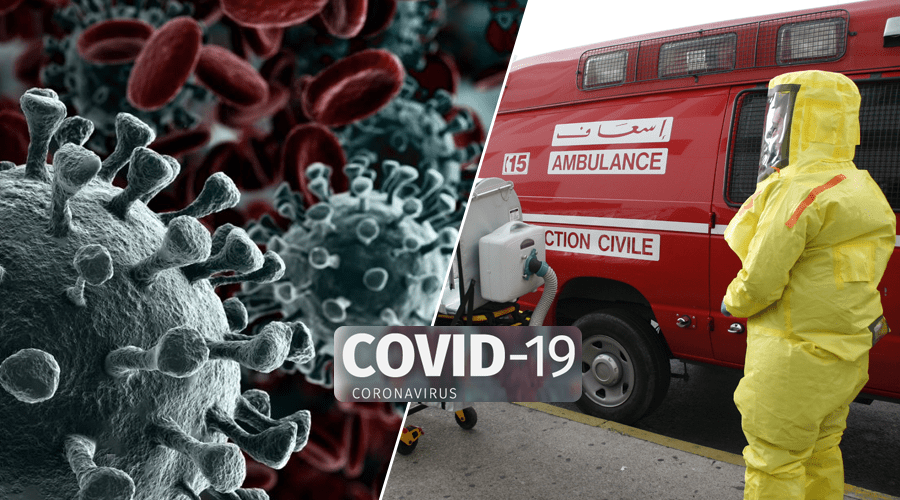
هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكورونا في المغرب

وزارة التعليم تقرر تأجيل العطلة الربيعية بالنسبة لجميع الأسلاك

تدوينة حول كورونا تجر نائبا عن البيجيدي للاعتقال
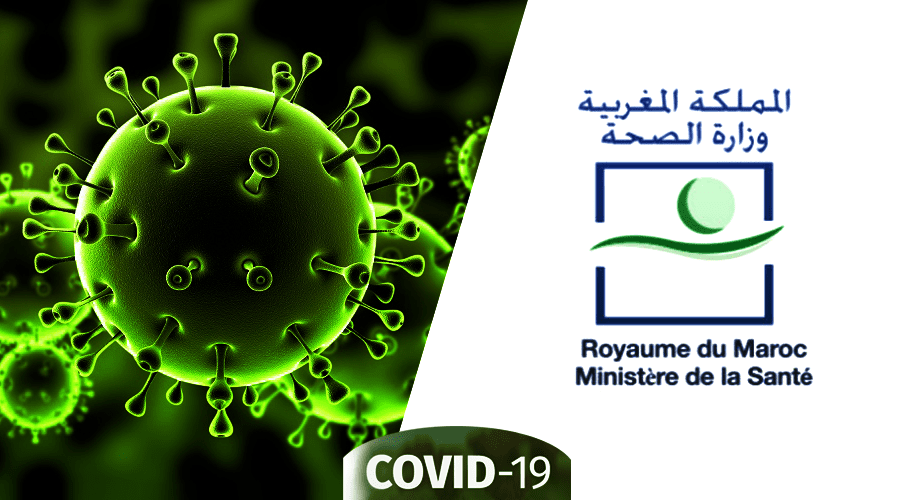
تسجيل 104 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 463 حالة

بالفيديو.. تطهير وتعقيم الشوارع بمقاطعات بالدار البيضاء
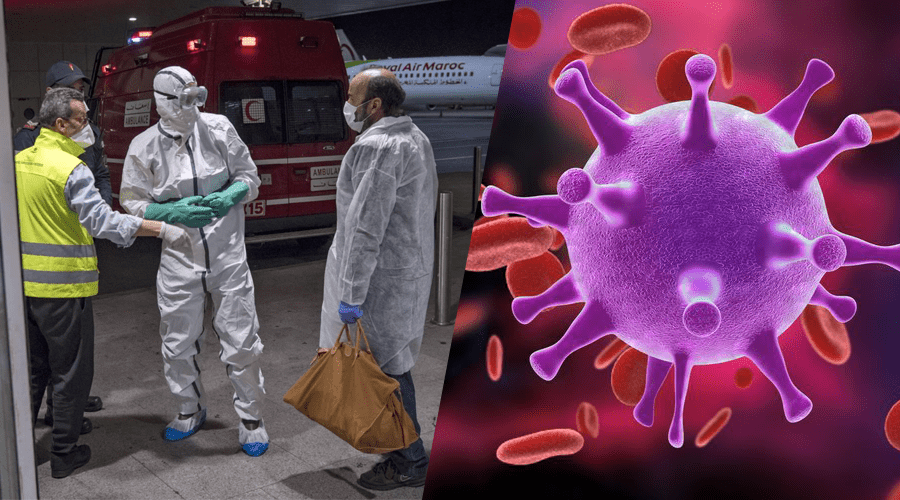
أخبار مفرحة... تفاصيل شفاء ثلاث حالات من كورونا في مراكش

توقيف باقي بطلات فيديو السخرية من نظام اليقظة للتبليغ عن كورونا

المغرب يقتني 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من كوريا الجنوبية

وفاة رضيعة بالمغرب بعد إصابتها بفيروس كورونا

ملف.. مليارديرات مجهولون من طرف وسائل الإعلام والرأي العام

تسجيل 13 حالة جديدة بكورونا ترفع العدد الإجمالي إلى 450 حالة

بالفيديو ... أجانب علقوا بالمغرب يشكرون المغاربة على حسن ضيافتهم

رباح يخرق حالة الطوارئ الصحية ويعقد تجمعا يهدد حياة المواطنين

تاريخ.. هكذا حاربت الدولة مستغلي الكوارث لمراكمة الأموال

توقيف فتاتين من بطلات فيديو السخرية من نظام اليقظة الخاص بكورونا
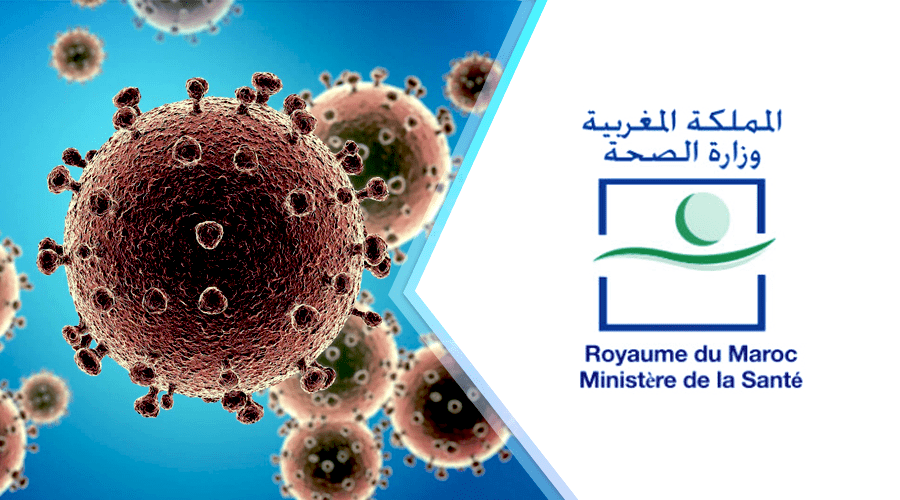
تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 437 حالة
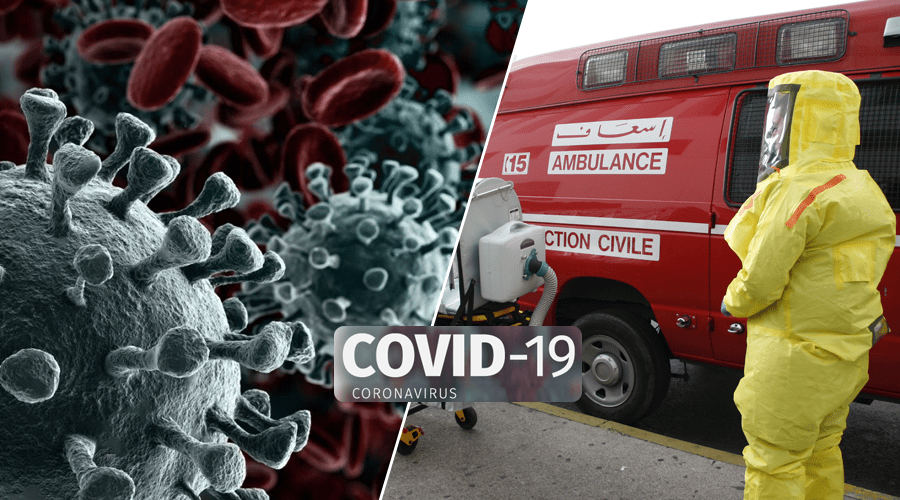
عاجل... عدد المصابين بكورونا في المغرب يقفز إلى 402 حالة

بالفيديو.. هذه حقيقة فيديو مواطنة في الحجر في مستشفى سطات بسبب كورونا

خبر مفرح... شفاء أول مصاب بكورونا عولج بالكلوروكين في المغرب

هذه هي التسهيلات التي ستتخذها البنوك ابتداء من الإثنين المقبل مع أصحاب الكريدي
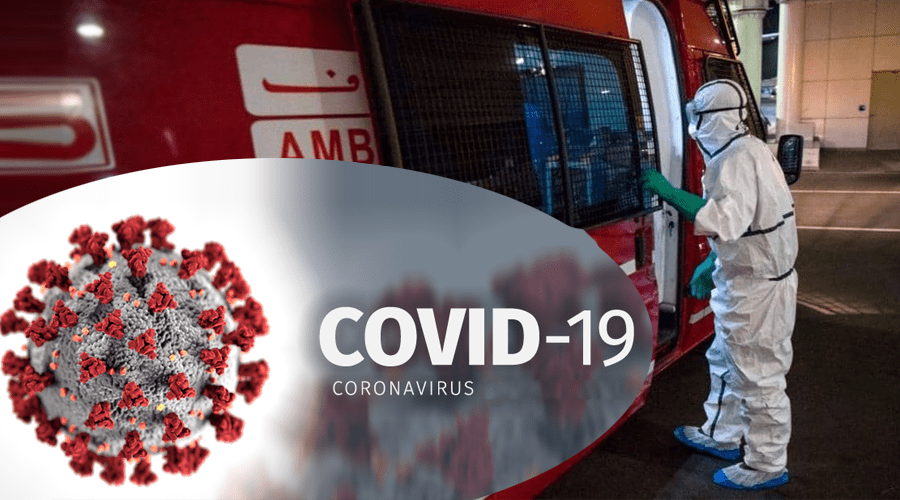
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 390 حالة
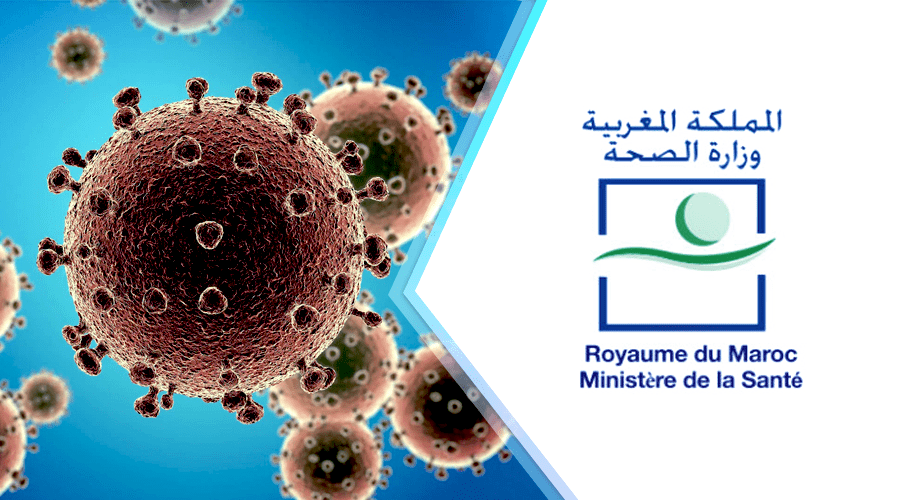
359 إصابة بكورونا في المغرب وارتفاع عدد الوفيات إلى 24

إصابة 16 من اليهود المغاربة بكورونا بعد حضورهم حفل ديني بالبيضاء

فيروس كورونا يفاقم أوضاع سائقي سيارات الأجرة بالبيضاء

أجواء الحجر الصحي بشوارع الدار البيضاء

منتهى الجشع... مدارس خاصة تهدد الأسر بعدم اجتياز أبنائهم للإمتحانات إذا لم تدفع المستحقات

دوريات أمنية تسهر على تطبيق حالة الطوارئ واعتقالات واسعة في صفوف المخالفين

مديرية الأمن تكشف حقيقة مقطعي فيديو لأحداث شغب خلال إجراءات الحجر الصحي

مسؤول: النيابة العامة تابعت 56 شخصا نشروا أخبارا زائفة حول كورونا

باخرة إسبانية وفرنسي هارب من الصويرة يستنفران سلطات آسفي

تطوير جهاز يكشف الإصابة بكورونا في 5 دقائق
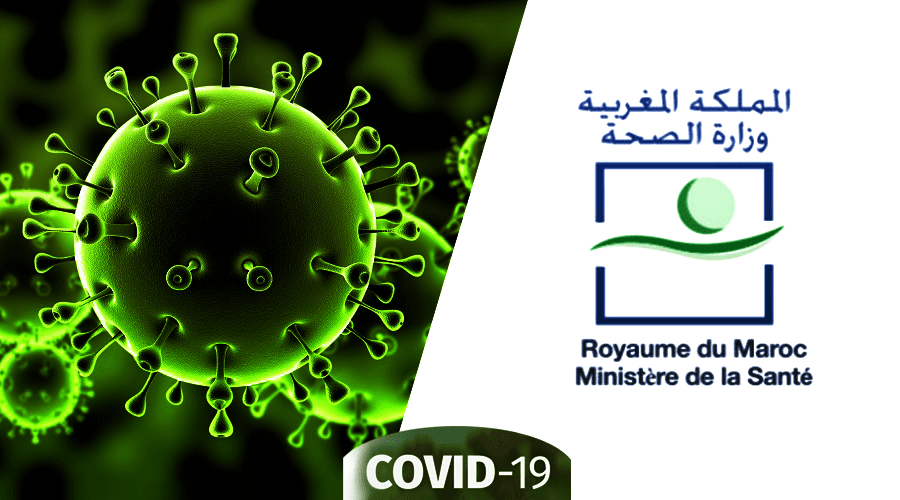
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 358 حالة
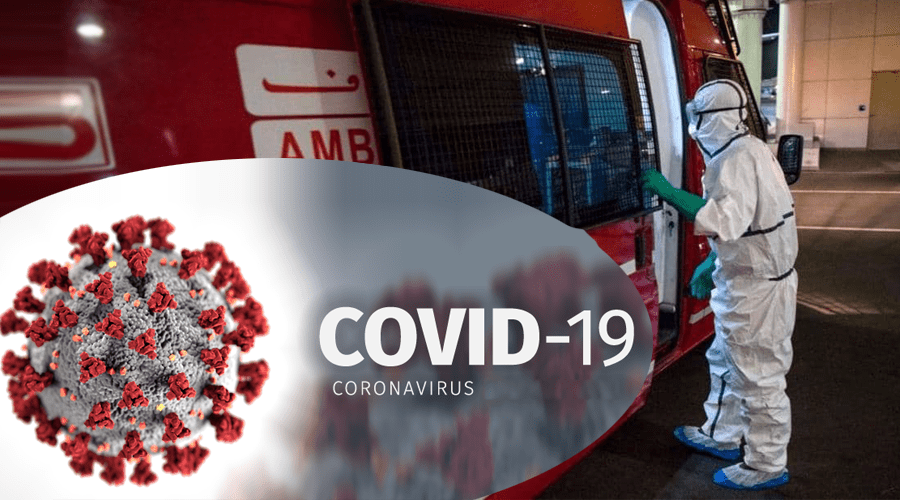
تسجيل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة في ظرف ثلاث ساعات

هكذا ستوزع الحكومة المساعدات المالية على حاملي بطاقة راميد المتضررين من كورونا

السلطات تضع فندق L' Amphitrite تحت الحجر الصحي بسبب مصابة بكورونا
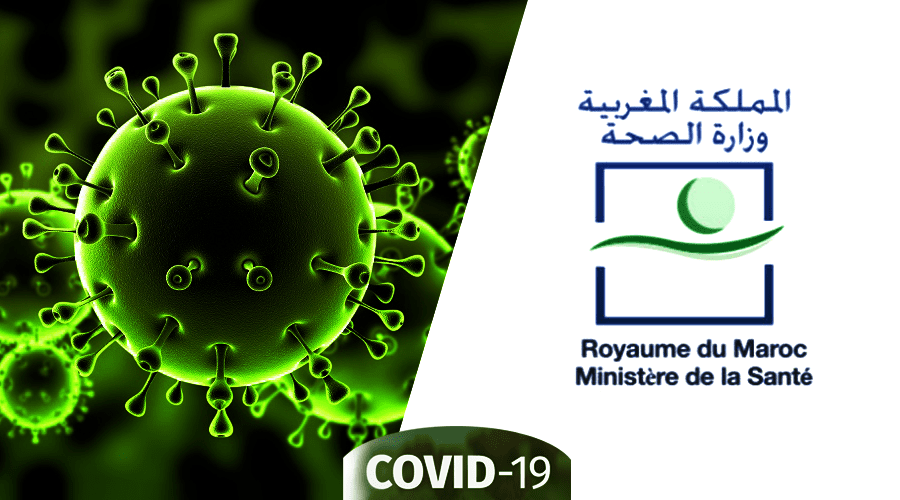
هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات المصابة بكورونا

رصد 200 مليار سنتيم من صندوق تدبير جائحة كورونا لتأهيل المنظومة الصحية
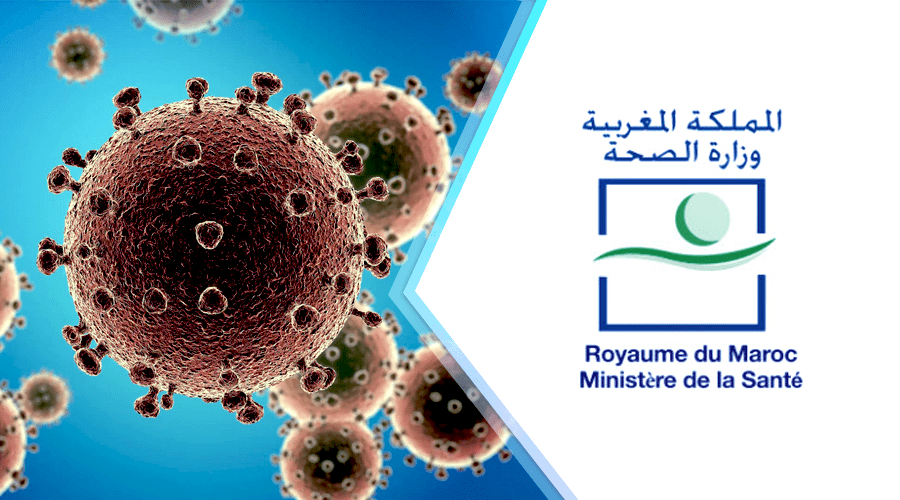
تسجيل 58 إصابة بكورونا و11 وفاة والحصيلة ترتفع إلى 333 حالة
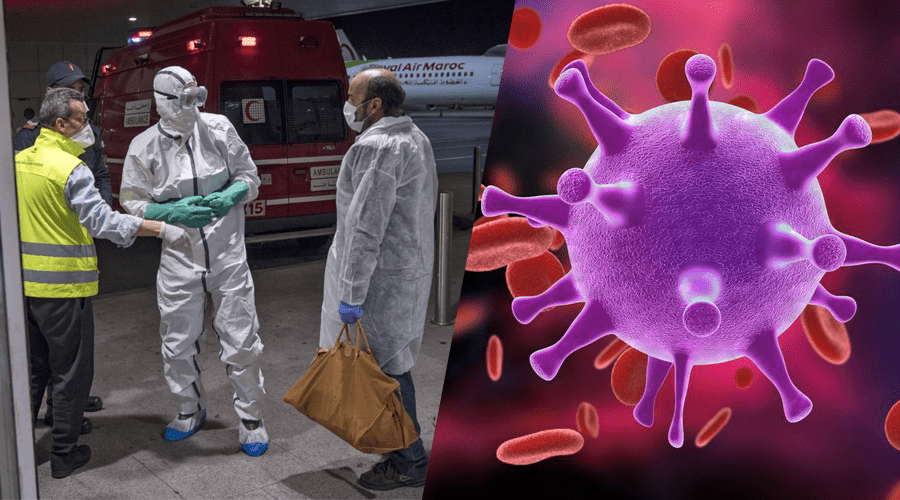
الحكومة تحذر المغاربة...الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء كورونا

شاب مغربي يتطوع لصناعة واقيات للوجه للأطباء مجانًا

تأكيد استمرار تزويد الأسواق باللحوم الحمراء والمواد ذات الأصل الحيواني

كورونا تخطف شيخا في التسعين وخطيب مسجد في مراكش

الداخلية تنفي إغلاق كافة الفضاءات التجارية اليوم وطيلة نهاية الأسبوع

بتعليمات ملكية..رفع طاقة غرف للإنعاش إلى 3000 سرير

زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

بالصور... مراسيم دفن جثمان أول ضحايا كورونا بمراكش والذي فارق الحياة بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس

شوارع الدار البيضاء في ظل حالة الطوارئ الصحية

ركود تجاري بالأسواق المغربية في ظل حالة الطوارئ الصحية

معهد باستور يستقبل مئات العينات يوميا لتشخيص الإصابات بفيروس كوفيد-19

بعد الترويج لإشاعة انتحاره...قائد بالرباط يعتذر لسودور حول محله لبيع الخضر
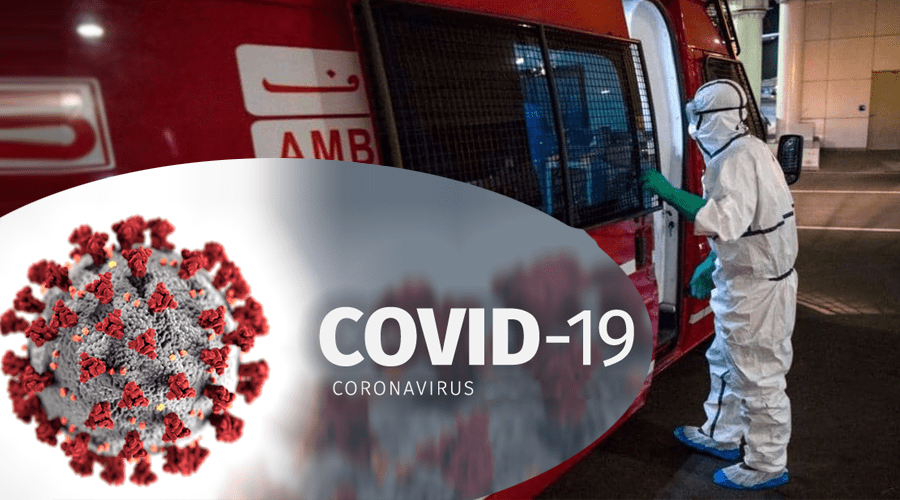
عاجل...وفاة محامي بهيئة مراكش بفيروس كورونا

اتصالات المغرب معبئة بالكامل لضمان استمرارية خدماتها خلال فترة الطوارئ الصحية
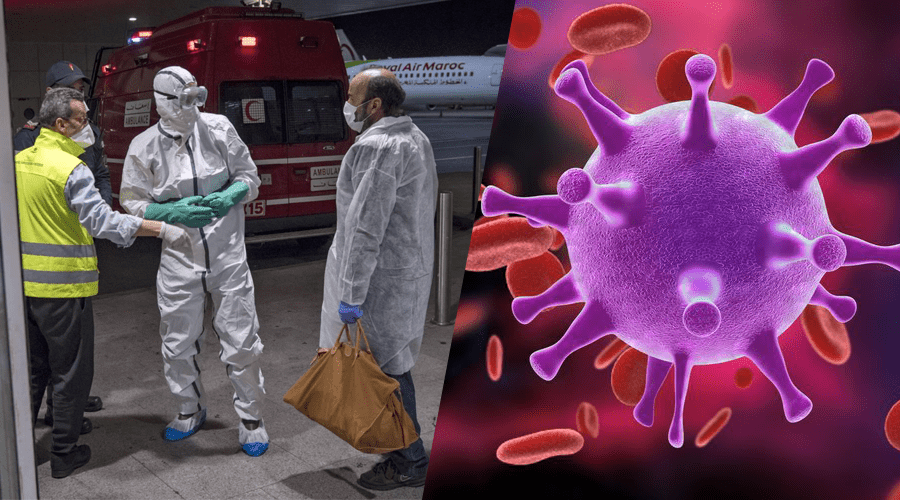
هذه حقيقة إصابة أطباء مغاربة بكورونا

سقوط عصابة استغلت هدوء الشوارع بسبب كورونا لتنفيذ سرقات بالعنف

إقرار سنة بيضاء في التعليم... الحقيقة من الخيال
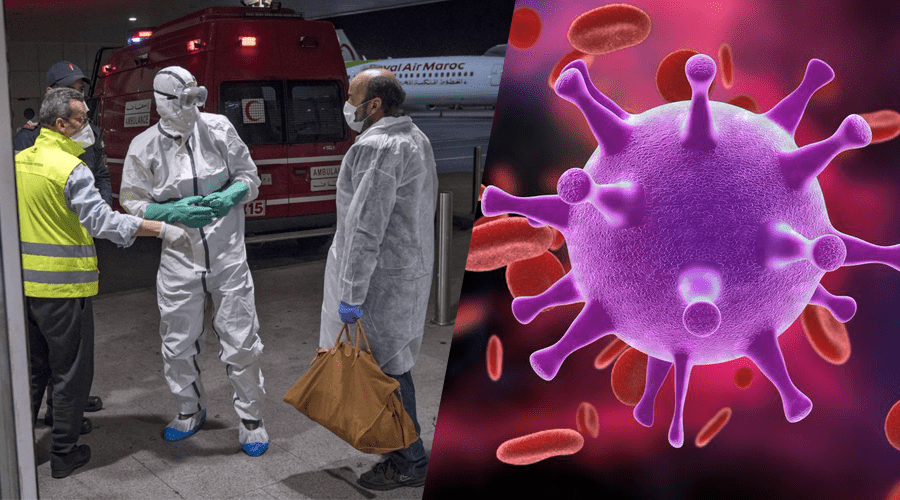
عاجل... وفاة قاضية ثانية بالمجلس الأعلى للحسابات بفيروس كورونا

وفاة قاضية وإصابة زميلتها بفيروس كورونا بعد رحلة سياحية إلى مراكش بمناسبة 8 مارس

تعليمات ملكية بتصنيع ملايين الكمامات ومواد التعقيم محليا

وزارة التعليم تمكّن تلاميذ التعليم الخصوصي من استعمال خدمة Teams

صندوق الإيداع والتدبير يخصص 8000 سرير لمواجهة كورونا

بعدما أقرها المغرب فرنسا توافق رسميا على استخدام كلوروكين لعلاج مرضى كورونا
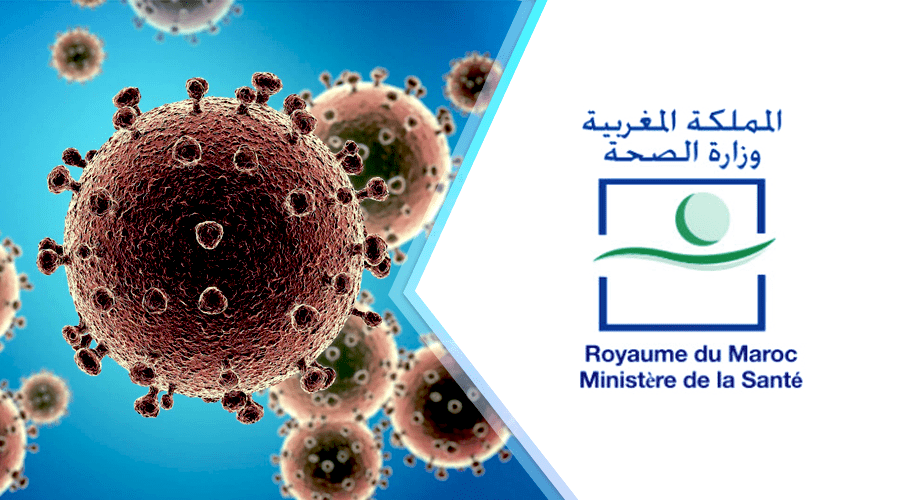
تسجيل 50 إصابة جديد و 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 275 حالة مؤكدة

السجن عامين لكل من يسعل بوجه رجال الشرطة أو الطوارئ

استقلاليو العالم يطالبون العثماني بإعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب كورونا

لهذا السبب تتحكم ألمانيا في كورونا

خبر سعيد رغم كل شيء...الأشغال تتقدم في المستشفى الجامعي الجديد بأكادير

تفاصيل المساعدتين اللتين توصل بهما المغرب من شنغهاي الصينية وكويجو اليابانية
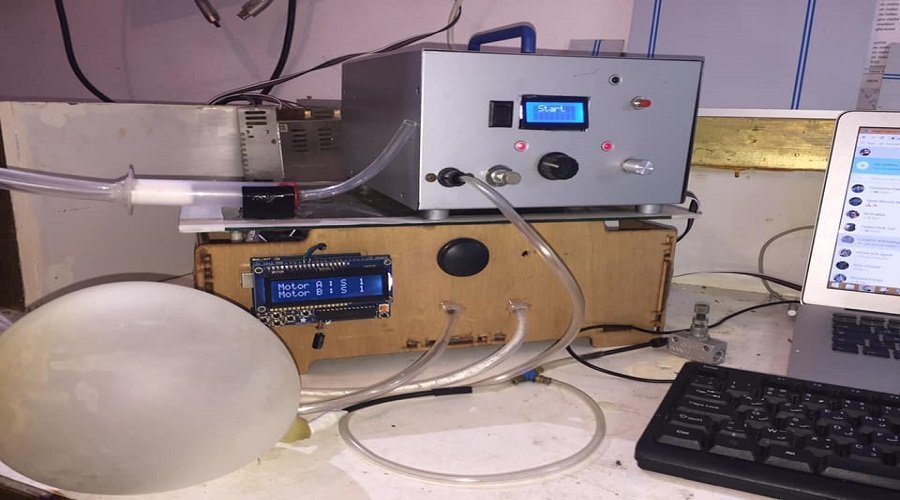
بالفيديو.. مخترع مغربي يطور جهاز تنفس بتكلفة منخفضة

مندوبية السجون تكشف حقيقة تسجيل صوتي حول كورونا

10 في المائة من مرضى ووهان أصيبوا مجددا بكورونا بعد تعافيهم

تجمع من شركات الصناعات الغذائية يقدم تبرعات بملايين المنتجات لفائدة الأسر المحتاجة

وزارة الفلاحة.. الفاعلون في القطاع الفلاحي يحافظون على نشاط الإنتاج في احترام صارم للتدابير الصحية

كوفيد-19.. الأطر الصحية تطالب الوزارة الوصية بتوفير مستلزمات الوقاية

هذا هو التوزيع الجغرافي للمصابين بكورونا في المغرب حسب المدن

ارتفاع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا إلى 28 مليار درهم
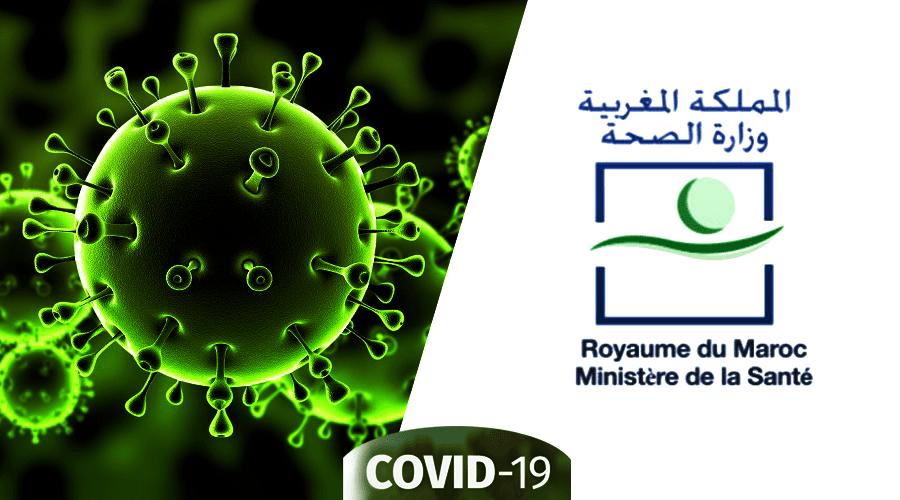
وزارة الصحة تكشف تفاصيل استعمال دواء كلوروكين في علاج مرضى كورونا

حقيقة فيديو مساجين عكاشة وهم يرقصون

بالفيديو.. هذه طريقة الاستفادة من تعويض 2000 درهم عبر بوابة covid19.cnss.ma

وصول طائرة مغربية محملة بمساعدات طبية صينية لمواجهة كورونا وأخرى في الطريق

علماء يطورون جهازا يكشف الإصابة بكورونا في 5 دقائق

مسؤول أميركي يطالب كبار السن بالتضحية والموت على الإضرار بالاقتصاد
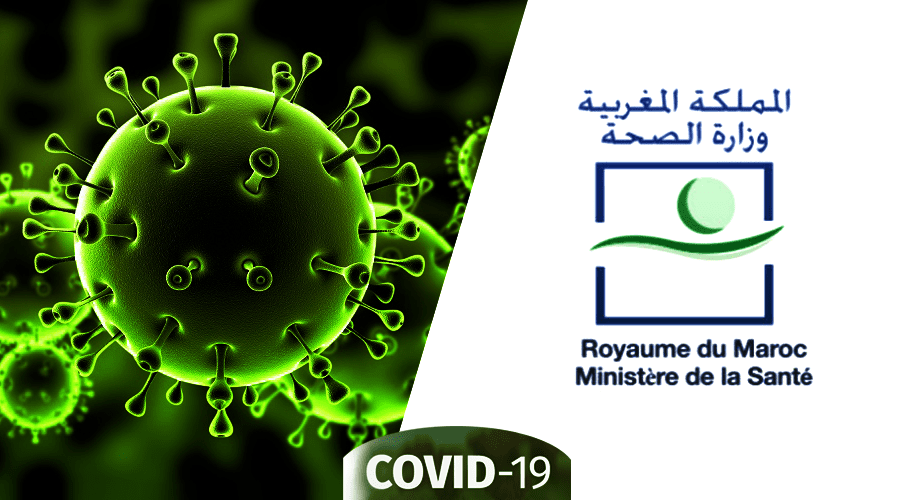
55 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 225 حالة

كوفيد-19.. فدرالية المطاحن تتبرع بـ 5000 طن من الدقيق والسميد

الفاعلون في القطاع الفلاحي مستمرون في نشاطهم مع احترام صارم للتدابير الصحية

شرطة الرباط تفك لغز سرقة وكالة لتحويل الأموال

التبليغ عن جريمة وهمية يقود شخصا للاعتقال بالبيضاء

تأجيل الترقيات وإلغاء التوظيف بسبب وباء كورونا

توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لمربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية

مجموعة رونو المغرب تساهم بخمسين سيارة إسعاف لمواجهة جائحة كوفيد-1

الداخلية والجيش يضعان رقم ألو 300 لتقديم الإرشادات وتلقي الشكايات بخصوص كورونا

مندوبية السجون توفر الإقامة لموظفيها بالمؤسسات التي يشتغلون بها

نشر محتويات زائفة حول كورونا يطيح بـ50 شخصا
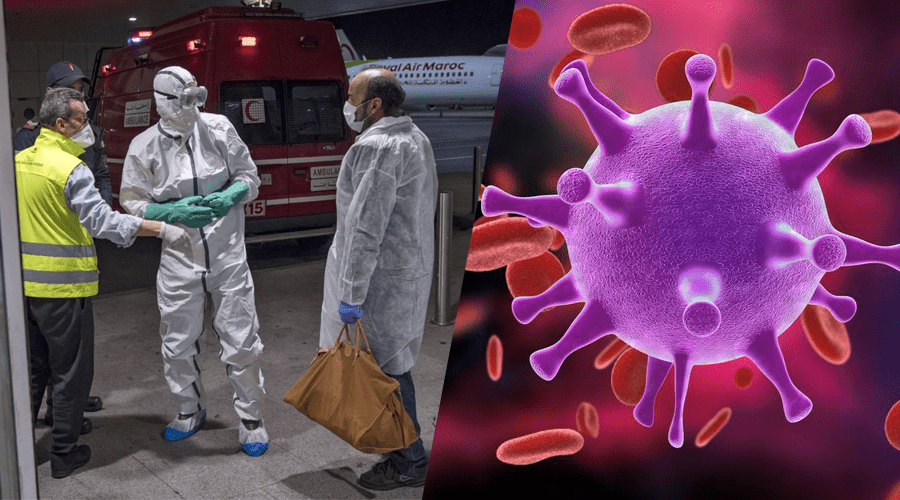
تفاصيل حصرية حول إصابة مواطنين من مكناس بكورونا خلال رحلة سياحية لمصر

هكذا سيتم تعويض العمال والتجار غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي
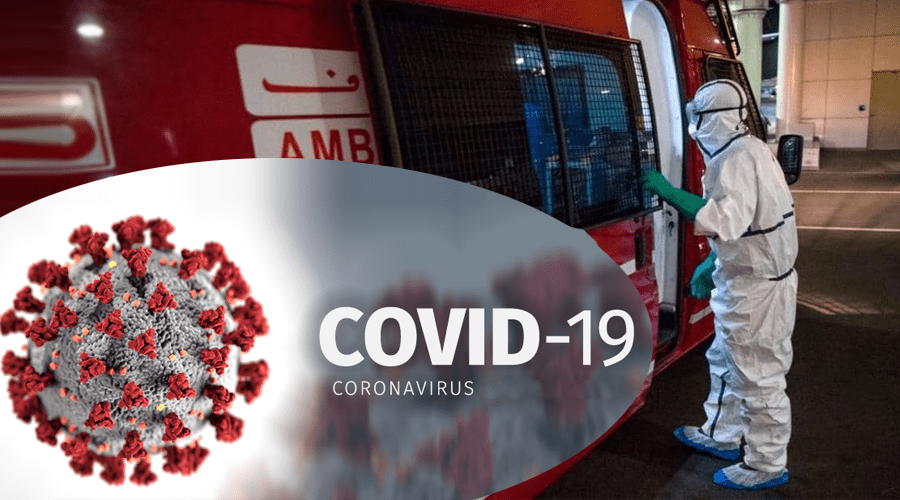
15 في المائة من المصابين بكورونا في المغرب حالتهم خطيرة

نيويوك تايمز الأمريكية تتحدث عن التدابير التي اتخذها المغرب لصالح فاقدي الشغل

رونو تساهم بـ50 سيارة إسعاف لمواجهة جائحة كورونا
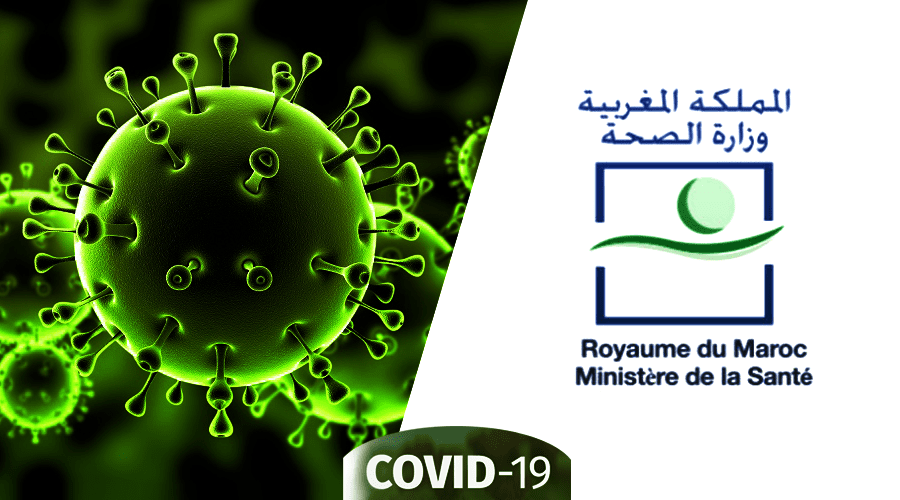
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 170 حالة

مسؤولو وكالة المحافظة العقارية يساهمون بجزء من راتبهم في صندوق كورونا

حالة الطوارئ الصحية تخلي شوارع وأزقة الرباط كليا

عبد النبوي يوصي بالصرامة في معاقبة المخالفين لقانون الطوارئ الصحية

نشرة خاصة.. أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

توقيف 113 شخصا راشدا و9 قاصرين رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية

وباء كورونا.. هيئة الأطباء تطلق أرقاما هاتفية للمتابعة النفسية

الداخلية : قانون حالة الطوارئ الصحية يوفر إطارا قانونيا مواتيا للحد من تفشي كورونا

مسؤول: قانون حالة الطوارئ الصحية يروم حماية المواطنين من مخاطر كورونا

مكتب الكهرباء والماء يكشف حقيقة تعليق استخلاص الفواتير
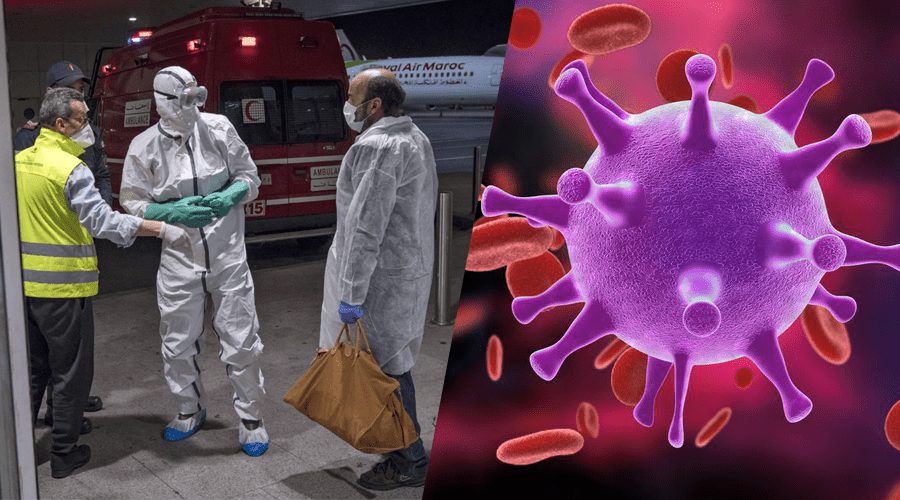
المغرب يشرع في استعمال دواء كلوروكين لعلاج المصابين بكورونا
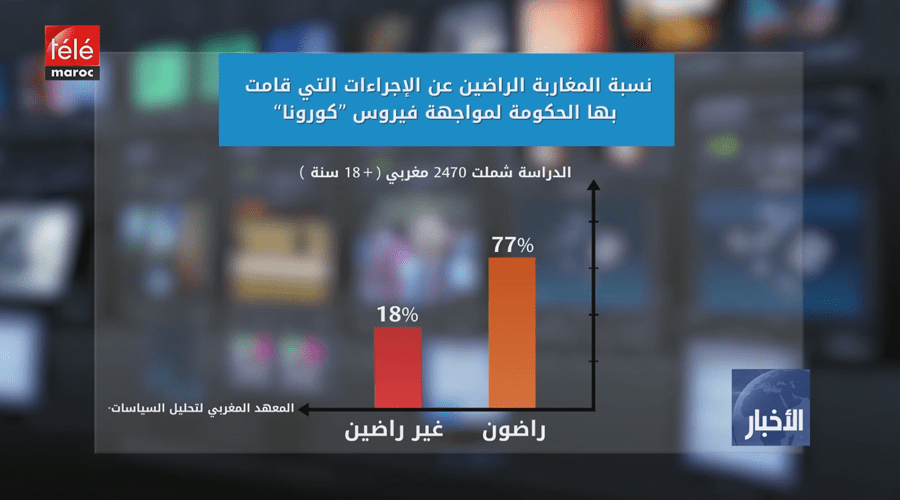
دراسة.. %77 من المغاربة راضون عن إجراءات الحكومة لمواجهة كوفيد-19

مهنيو إنتاج الخضر والفواكه يلتزمون بتزويد السوق بحاجياته ويحذرون من تخزينها

اقتصاديون يدعون الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة ومباشرة للأسر والفئات المعوزة

موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت 23,5 مليار درهم

الكشف عن نتيجة أول اختبار كورونا للمستشارة الألمانية ميركل
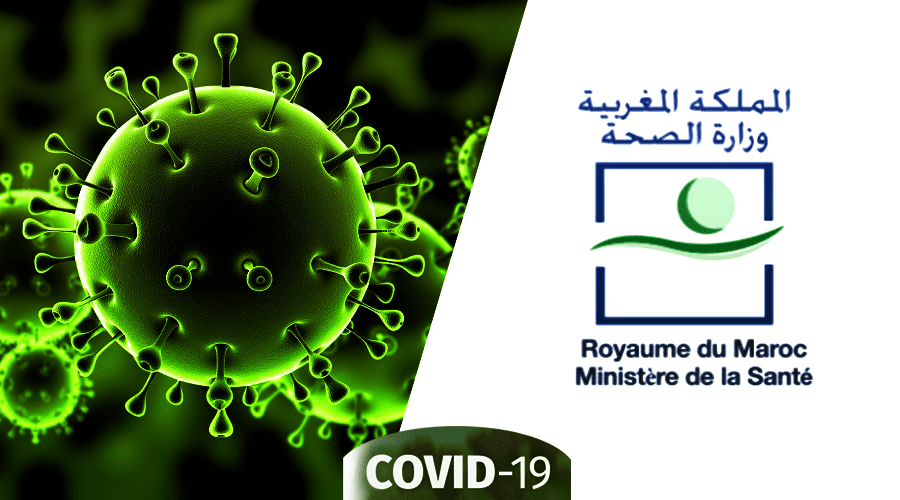
تسجيل 28 إصابة بفيروس كورونا اليوم والحصيلة ترتفع إلى 143 حالة

فندق بضواحي فاس يضع 200 غرفة تحت تصرف وزارة الصحة

توقيف 5 أشخاص بتهمة التحريض على خرق إجراءات الطوارئ الصحية

لفتيت يدعو المواطنين للالتزام بإجراءات السلطات العمومية

ميناء البيضاء يتخذ تدابير خاصة بشأن استقبال البواخر والبضائع

توقيف شخصين بتهمة تصنيع مواد كيميائية وترويج أدوية بدون رخصة

كيف ستقوم CNSS بتعويض المستفيدين في ظل حالة الطوارئ الصحية

شركة مغربية للنسيج توفر 10 ملايين قناع صحي مجانا لوزارتي الداخلية والصحة

رسميا.. السجن والغرامة في انتظار مخالفي حالة الطوارئ الصحية
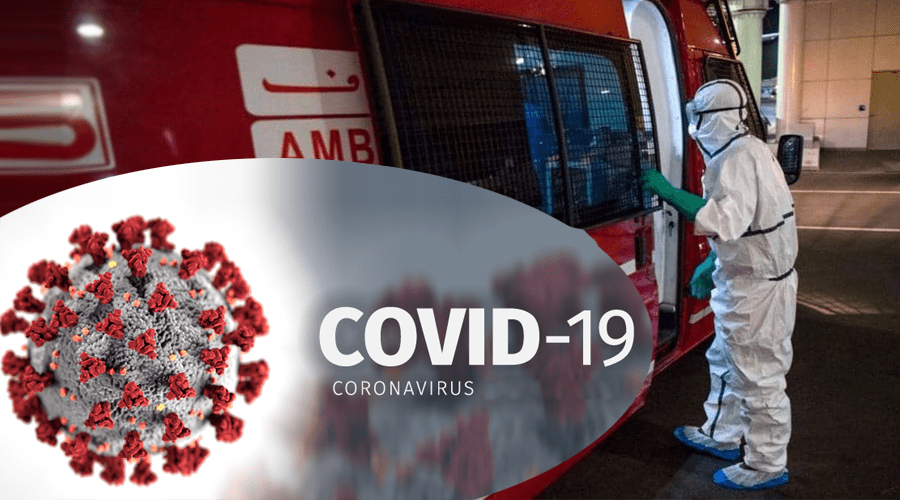
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 134 حالة

ملف.. حين ينخرط خدام الدولة في جهود دفع الأضرار عن العباد والبلاد
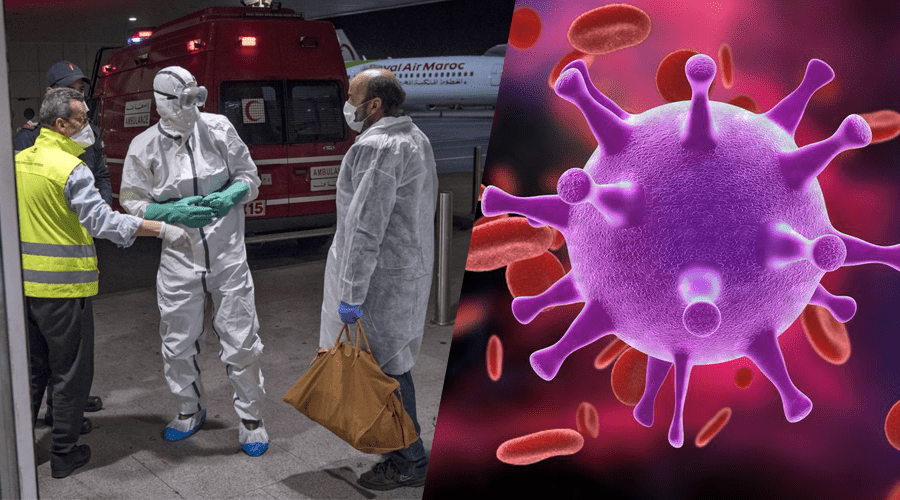
هذا هو التوزيع الجغرافي لحالات كورونا السبع المسجلة صباح اليوم
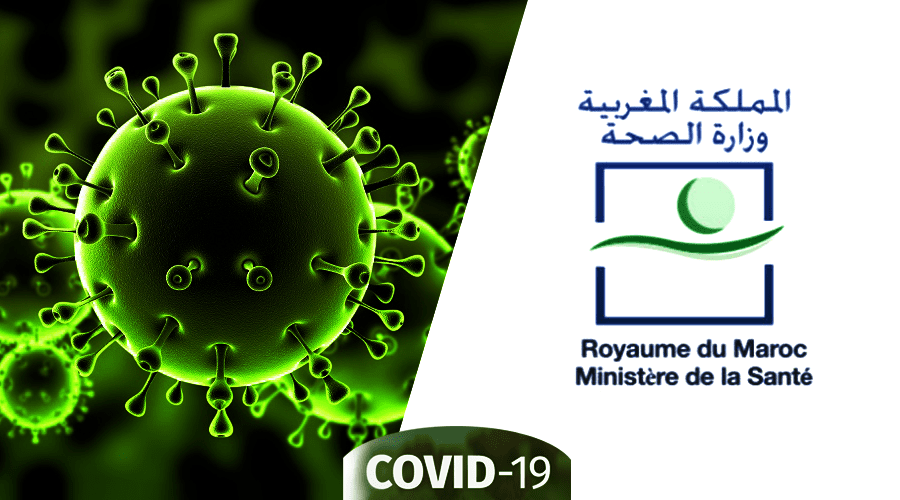
تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 122 حالة

إغلاق عيادة طبيب بتطوان مصاب بكورونا فحص مرضى وأجرى عمليتين جراحيتين

ترامب يتهم الصين بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا

هذه مدة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

تعليمات ملكية بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني لمكافحة وباء كوفيد19

توقيف شخصين بتهمة التحريض على التجمهر والعصيان بطنجة

دورية للولاة والعمال: الداخلية تشدد الخناق على المضاربات واحتكار "بوطا غاز"
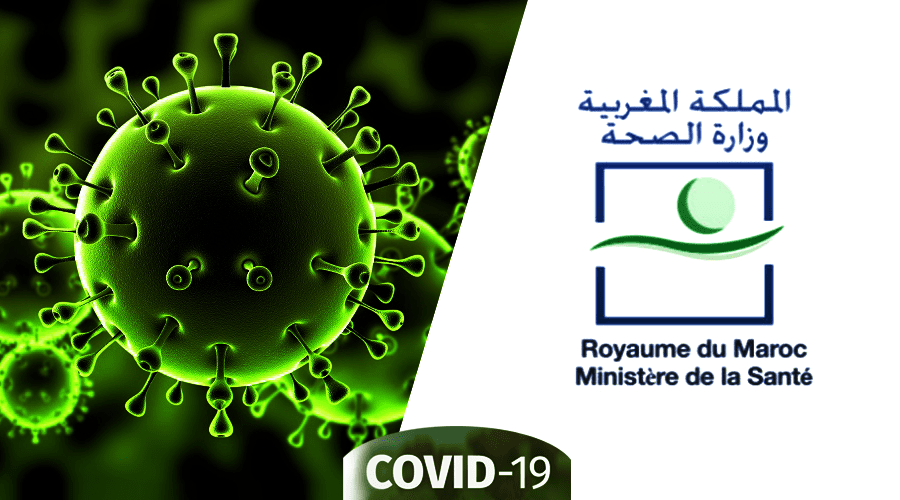
تسجيل 19 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في ظرف 24 ساعة

هذه الأفعال يعاقب أصحابها بالسجن في قانون حالة الطوارئ الصحية

الحكومة تصادق على حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 أبريل المقبل

عاجل... الحكومة تصادق على قانون يعاقب بالحبس من شهر لثلاثة أشهر في حق مخالفي أوامر الطوارئ الصحية

سانوفي المغرب تسلّم كل مخزونها من دواء نيفاكين لوزارة الصحة

شكاية ضد المحرضين على "مسيرة كورونا" على مكتب عبد النبوي

لهذا طارت إحدى طائرات لارام اليوم الأحد نحو الصين

الكونفدرالية المغربية للفلاحة تؤكد استمرارية الإنتاج الفلاحي وتموين الأسواق

قطاع الدواجن يستمر في العمل بشكل طبيعي

قرار بجعل الولوج إلى جميع مواقع التعليم أو التكوين عن بعد مجانا
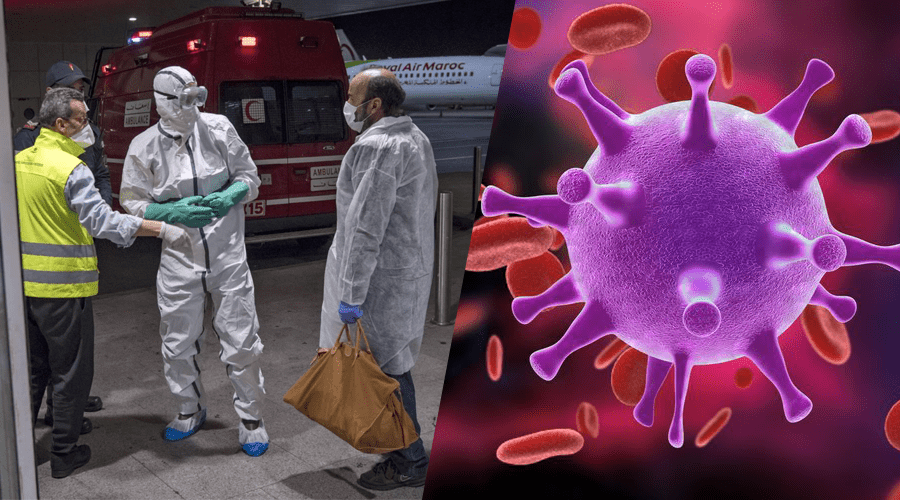
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 109 حالات

إغلاق المحلات التجارية والمساحات الكبرى بجهة طنجة ابتداء من السادسة مساء

وزارة الثقافة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف
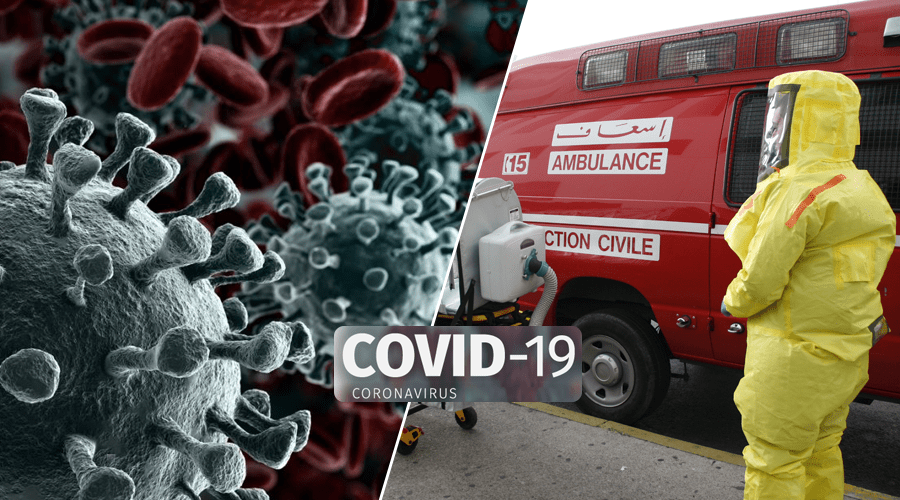
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 108 حالات

توقيف 3 أشخاص بتهمة بث وتوزيع أخبار زائفة حول كورونا

نشرة خاصة.. أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالعديد من مناطق المملكة
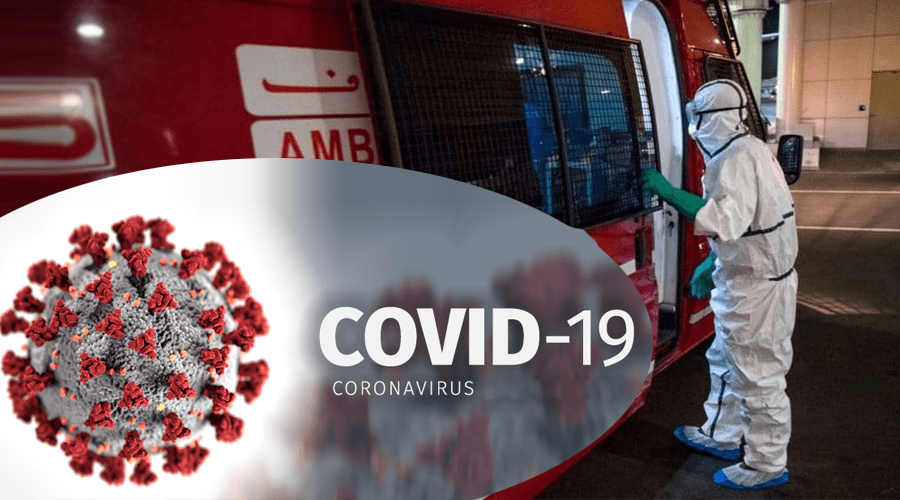
هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات الثمانية المسجلة صباح اليوم الأحد
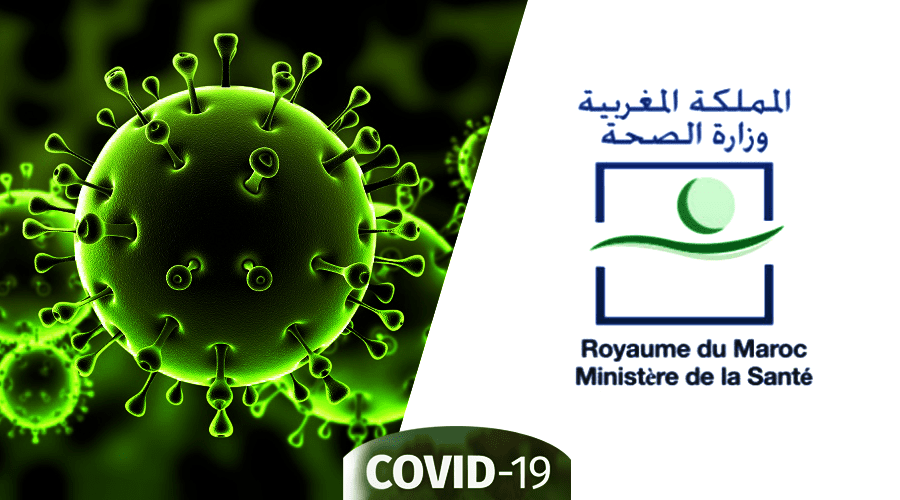
تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 104 إصابة

الحموشي يأمر بفتح تحقيق مع عناصر أمنية ظهروا في فيديو وهم يعنفون مواطنين

منع التنقل بين المدن باستعمال وسائل النقل الخاصة والعمومية
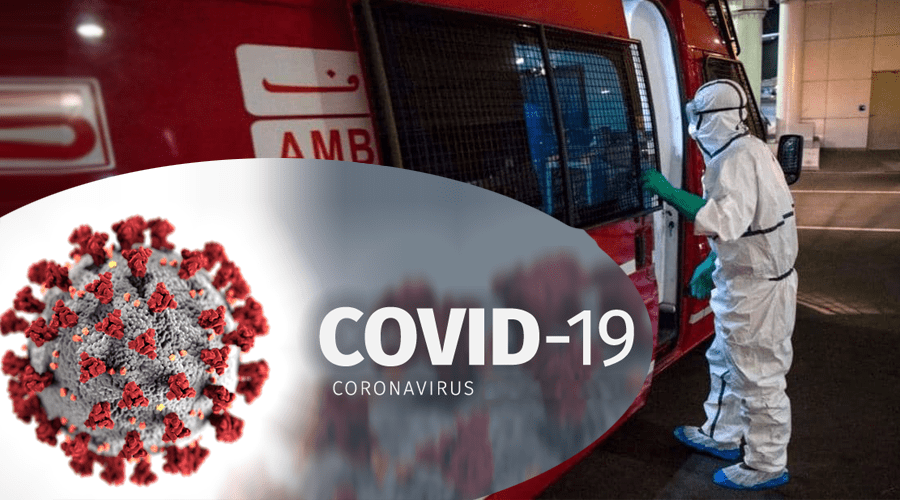
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 96 حالة

الطوارئ الصحية.. توقيف سيارات الأجرة عن العمل
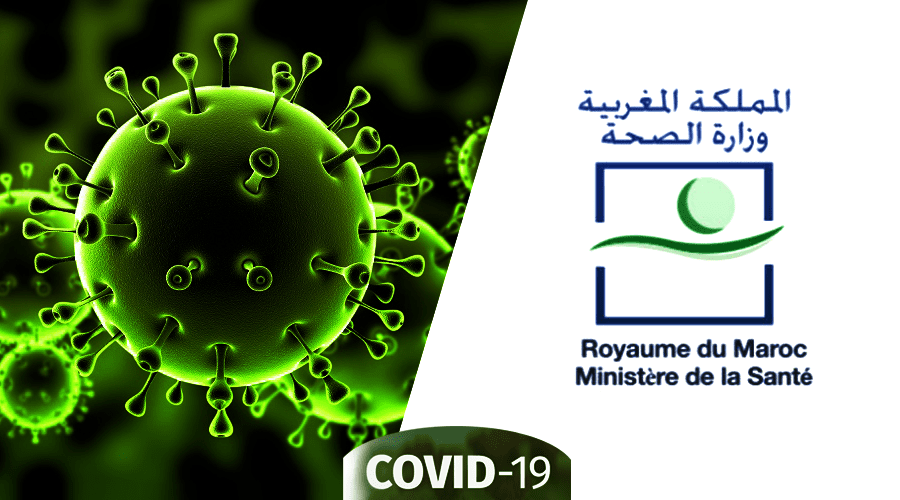
شفاء ثالث حالة مصابة بكورونا في المغرب

الـOCP يشرف على تأهيل 4 مستشفيات تأهبا لأي طارئ بخصوص كورونا

وزير الصحة يتفقد مركز الأنفلونزا والفيروسات التنفسية

الصناعة الغذائية تواصل أنشطتها لضمان التزود العادي للسوق الوطنية

وزارة الفلاحة تعلق رسوم استيراد القمح والقطاني لتخفيض الأسعار

وزارة الفلاحة تؤكد وجود تموين منتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية

توقيف شخص بتهمة ترويج استمارات مغادرة المسكن وبيع كمامات بدون رخصة
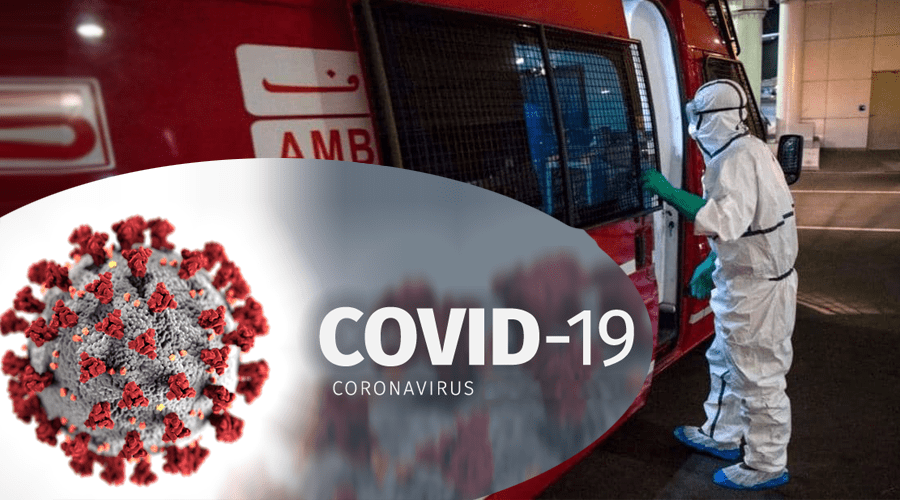
الباطرونا والـOFPPT والنقابات يساهمون بـ 500 مليون درهم في صندوق كورونا

توقيف جميع القطارات وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب

حالة الطورئ الصحية.. الداخلية تسمح للصحافيين بالتحرك بالبطاقات المهنية فقط

اعتقال شخصين بتهمة نسخ وترويج استمارات التنقل الاستثنائية

النيابة العامة تقرر متابعة أبو النعيم في حالة اعتقال

أكابس تساهم بمبلغ 15 مليون درهم في صندوق تدبير جائحة كورونا

إطلاق خدمة الـ SMS على الرقم 1919 للمشاركة في صندوق تدبير كورونا

إعادة بث دروس منتقاة من شبكة دروس هذا الأسبوع يومي السبت والأحد من خلال القناة الثقافية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. مؤسسات العلاجات معفاة من الموافقة المسبقة على طلب التحمل

هكذا يستغل النظام الجزائري كورونا للتضييق على معارضيه في الخارج

التلاعب بفيديو تعقيم العاملين وتجهيزات القوات الملكية الجوية
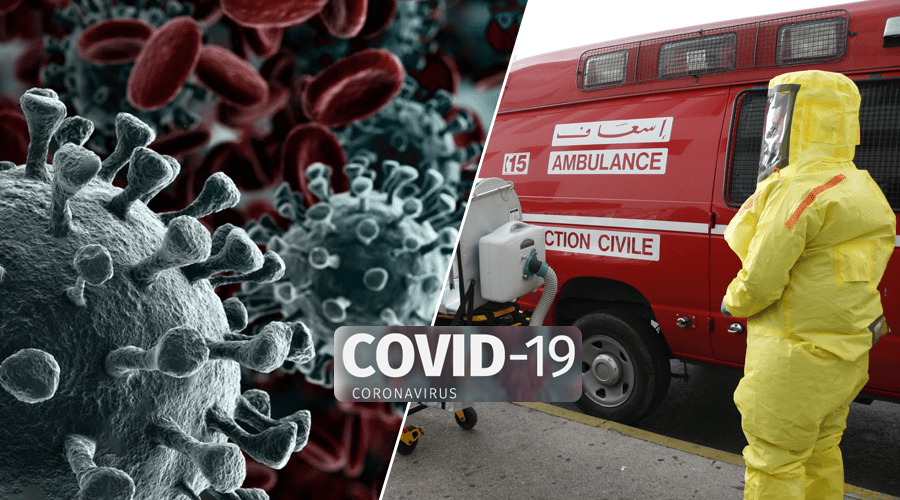
اعتراف دولي بصرامة وجدية تدابير المغرب الأمنية والصحية لمواجهة فيروس كورونا

توقيف حافلات نقل المسافرين بين المدن لمنع تفشي كورونا

المتاجرة في شهادة التنقل الاستثنائية يورط شخصين

هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية التي يجب أن تستمر خلال فترة الطوارئ الصحية
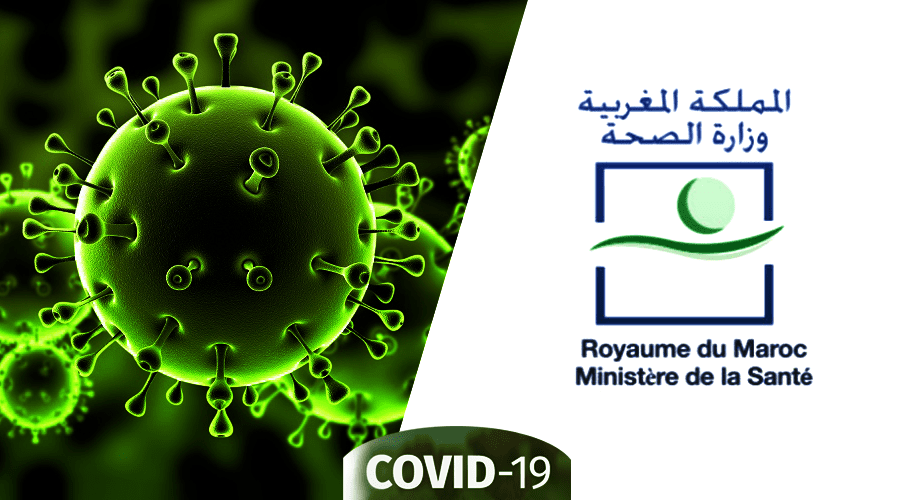
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 86 حالة

عمالة انزكان تفتح القاعات الرياضية لإيواء الأشخاص المشردين
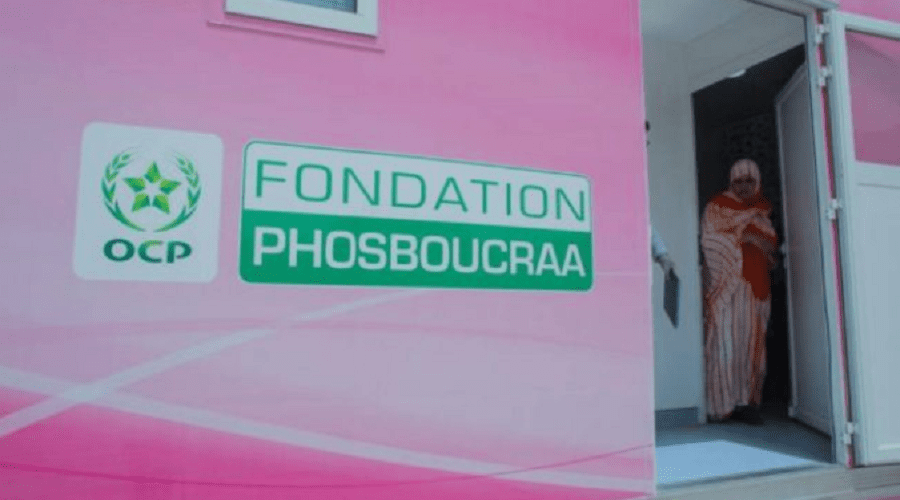
مؤسسة فوسبوكراع تطلق منصة لفورماصيون من دارك
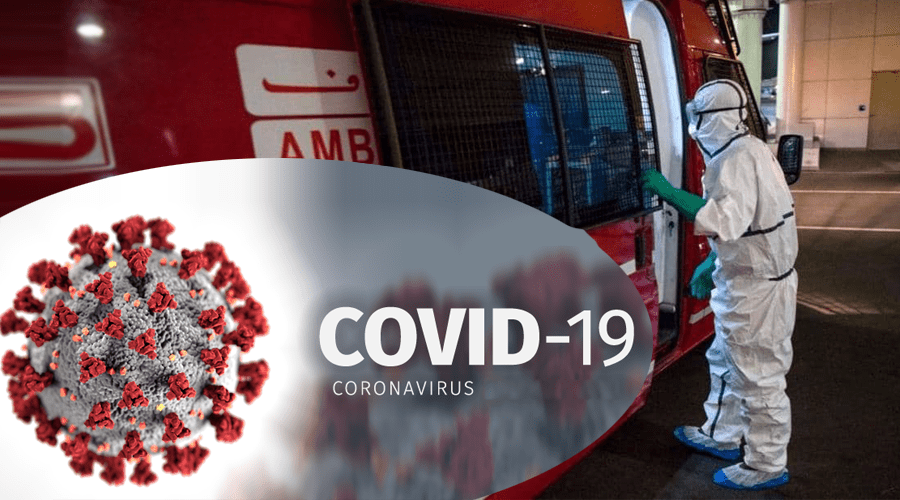
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 77 حالة

حركة استثنائية في شوارع الرباط والمواطنون يلتزمون بالحجر الصحي

الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية في المملكة

بريد المغرب يساهم بـ153 مليون درهم في صندوق تدبير جائحة كورونا

مخزون المغرب من "بوطا غاز" يمكنه تغطية 40 يوما من الاستهلاك

اتخاذ جميع الإجراءات لاستمرارية التزود بالكهرباء على المستوى الوطني

استعداد وحدات من الجيش لفرض تطبيق واحترام حالة الطوارئ الصحية
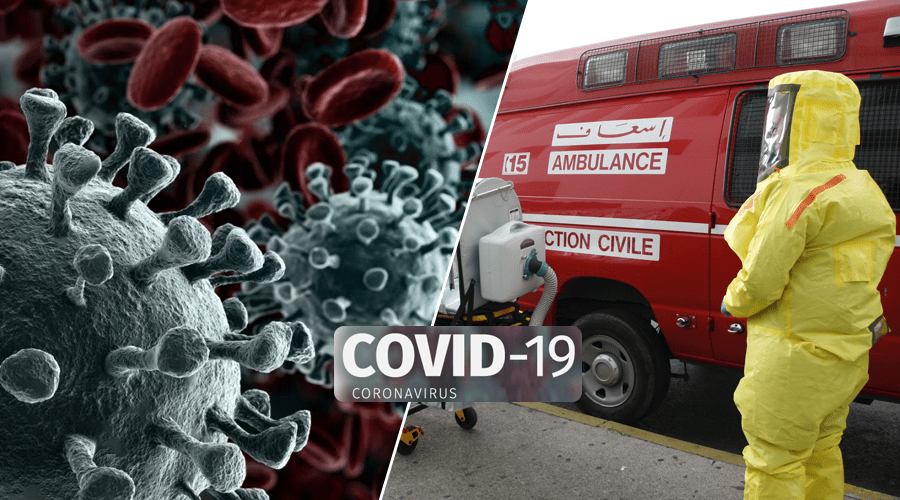
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 74 حالة

الداخلية توضح كيفية الحصول على الترخيص بمغادرة المنزل في حالة الطوارئ

السلطات تواصل جهودها بالدار البيضاء لتحسيس المواطنين بالعزلة الصحية

لا خوف من نفاذ الخضر والفواكه...تزويد السوق المغربية يتم بطريقة منتظمة

هكذا سيحصل المواطنين على ترخيص مغادرة المنزل للضرورة

هذا ما ينتظر مخالفي قرار الحجر الصحي الإجباري
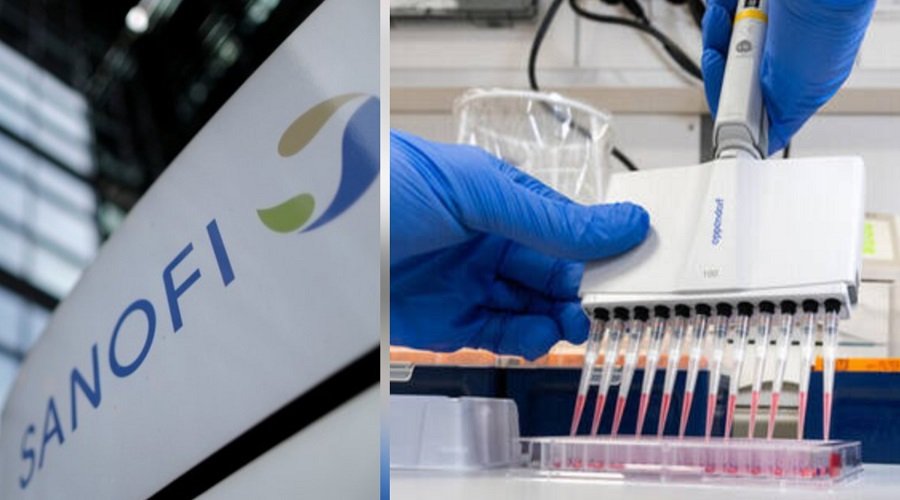
فرع شركة سانوفي بالمغرب يكشف حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عقار مضاد لكورونا

وثيقة مغادرة مقر السكن ليست صحيحة وتدخل ضمن الأخبار الكاذبة

أداء مسبق لكافة المستفيدين من المعاشات والإيرادات

توقيف 11 شخصا بعد تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة حول كورونا
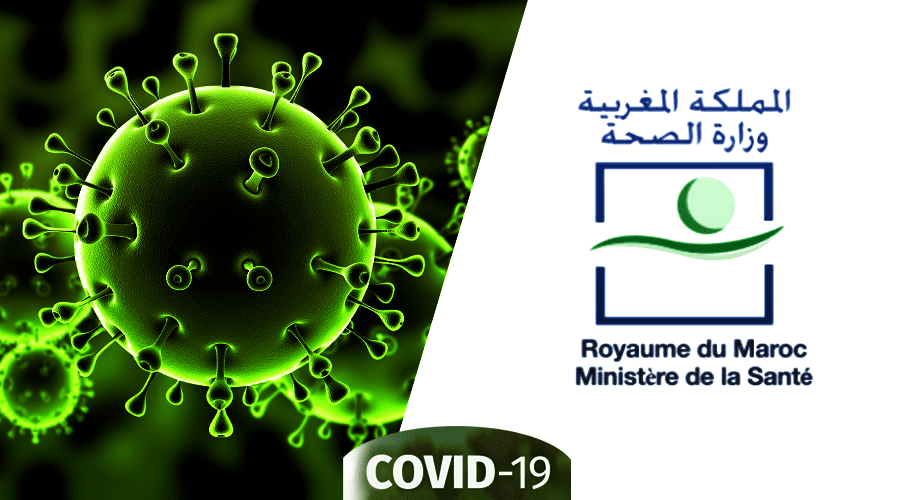
تسجيل ثالث وفاة بكورونا في المغرب وارتفاع عدد المصابين إلى 66

توقيف شخص شارك في إعداد وبث فيديو زائف حول كورونا بالجديدة
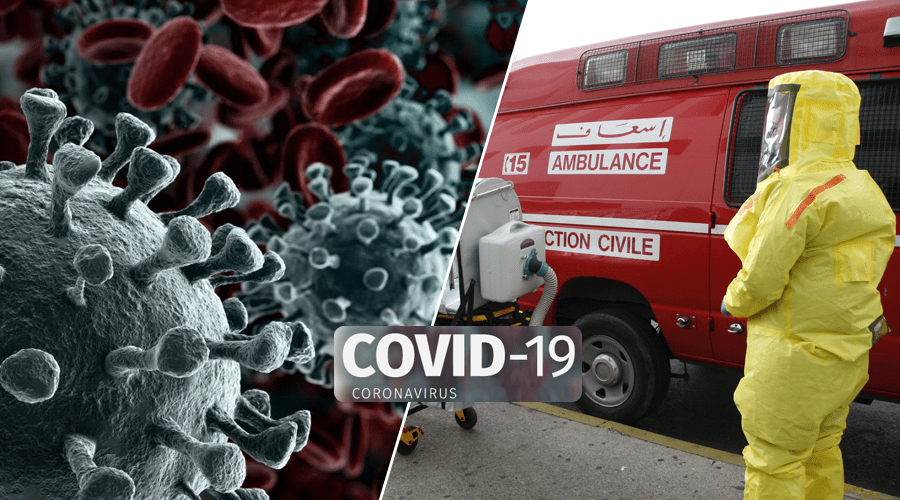
ارتفاع عدد إصابات كورونا في المغرب إلى 63 والداخلية تعلن حالة الطوارئ الصحية

خبراء مغاربة يعبرون عن استعدادهم لتطوير نظام للكشف المبكر عن كورونا

أطباء القطاع الخاص يضعون عياداتهم تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

بعد إغلاق المساجد.. دروس محاربة الأمية عن بعد

أموال الصندوق الخاص بمواجهة جائحة كورونا تسيل لعاب لوبي المدارس الخاصة

موارد صندوق تدبير جائحة كورونا تبلغ حوالي 22 مليار درهم
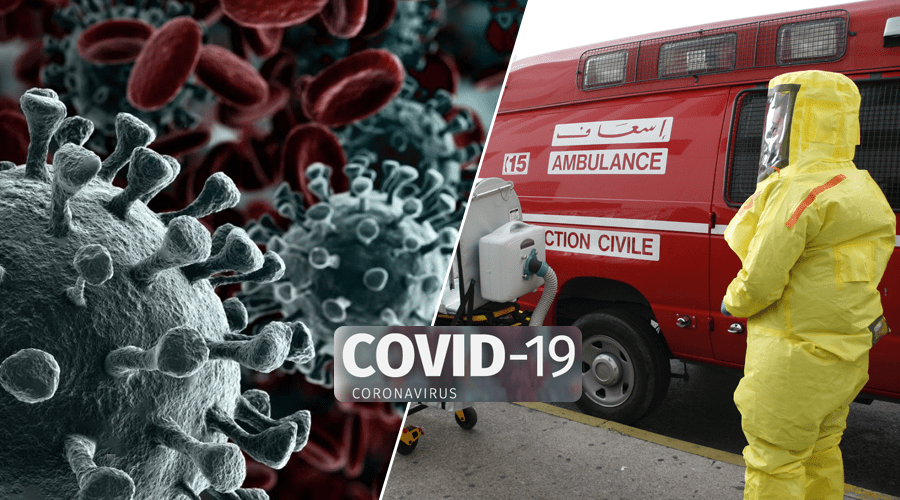
رؤساء ومديرون المؤسسات العمومية الاستراتيجية يساهمون براتب شهر لمواجهة كورونا
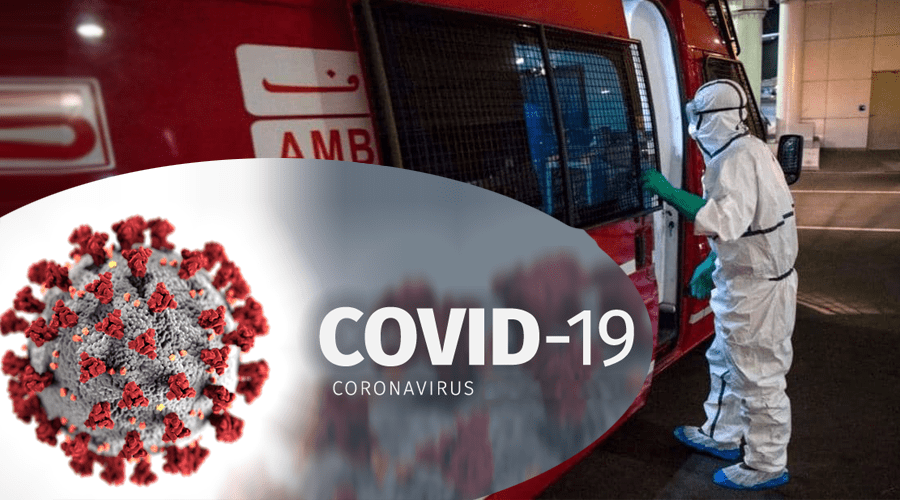
المغرب يعلن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

العثماني يؤكد البدء في تسجيل انتقال عدوى كورونا داخل المغرب

الأمن يداهم حانة بمراكش تعود ملكيتها لمسير رياضي بعد فتحها سرا في وجه الزبناء

إدارة السجون تساهم في صندوق مواجهة فيروس كورونا
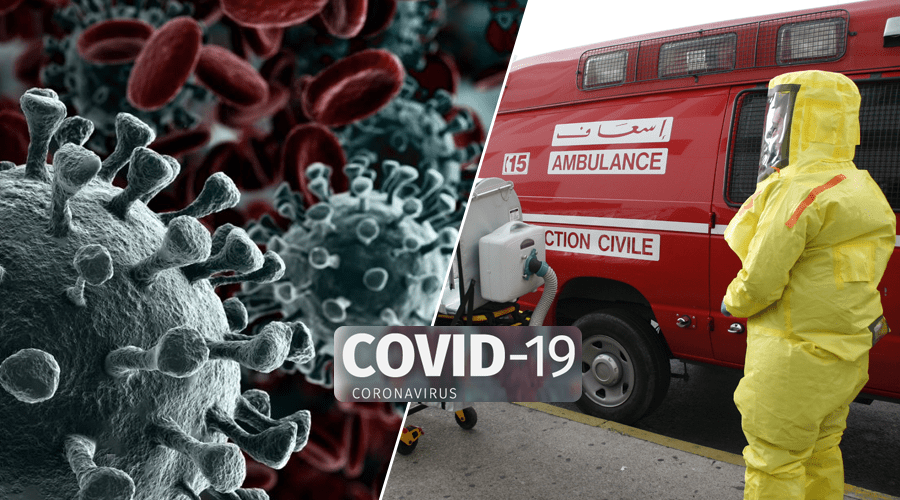
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 61 حالة

الحموشي يساهم ب 40 مليون درهم في صندوق مكافحة كورونا

اعتقال صاحبة قناة في اليوتوب بعد نشرها محتوى زائف حول كورونا

وزارة الصحة.. المغرب يتوفر على 44 مستشفى مخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19

وزارة الصحة.. إطلاق البوابة الرسمية لفيروس كوفيد-19 المستجد بالمغرب

فيروس كوفيد-19 يغلق الأحياء الجامعية والطلبة يغادرونها استعجالا

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ يؤكد استمرار صرف المعاشات والإيرادات

الضباط السامون للقوات المسلحة الملكية يساهمون في صندوق تدبير جائحة كورونا
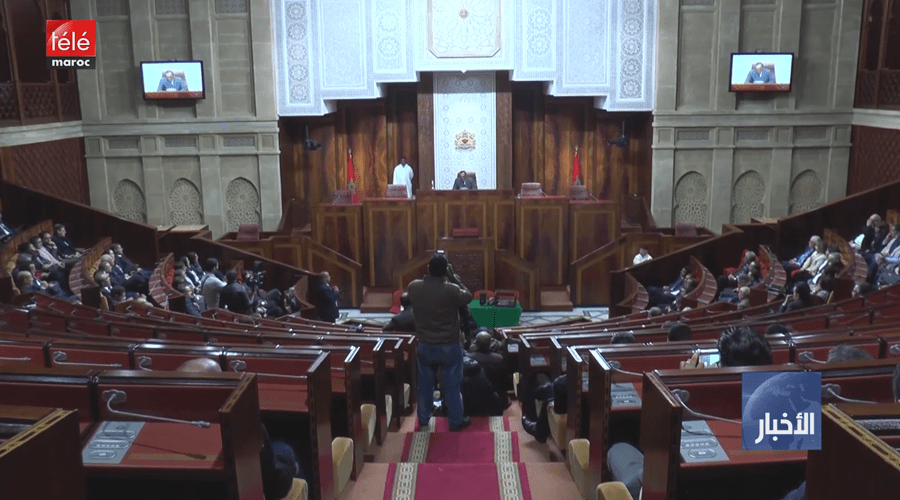
مجلس النواب يبعث مذكرة استعجالية لرئيس الحكومة للحد من تداعيات أزمة كوفيد-19

متضامن_OCP#.. مبادرة لتخفيف آثار فيروس كورونا بالمغرب
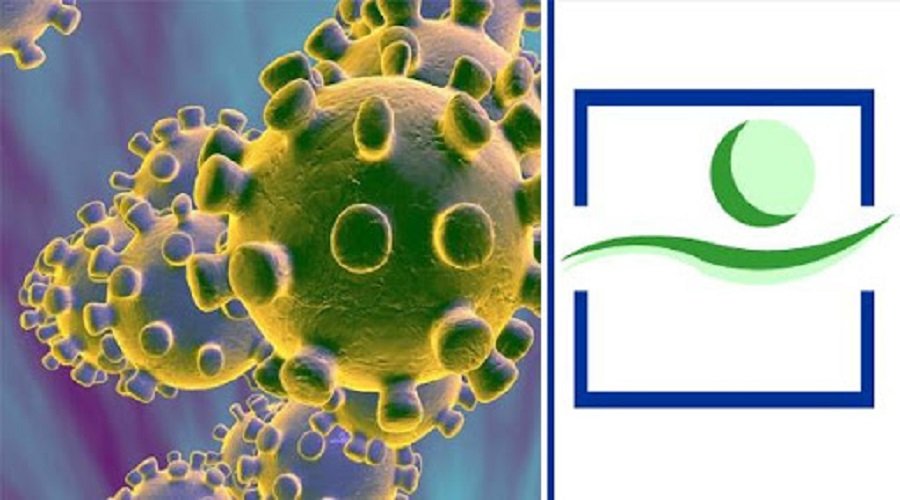
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 58 حالة

كورونا.. تفاصيل حول الحالات الخمس المسجلة مساء الأربعاء بالمغرب

وزير الصحة : ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 54 والأيام القادمة حاسمة

تساقطات ثلجية ورياح قوية ابتداء من اليوم بهذه المناطق

موروكو مول يغلق أبوابه باستثناء الخدمات الحيوية

مندوبية السجون تسمح بالزيارة لفرد واحد من أسرة النزيل كل شهر

مساهمة الولاة والعمال براتب شهر في صندوق مواجهة كورونا

سيدة في سن 103 أعوام تتعافى من كورونا

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.. الصيدليات ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية ودون أدنى تغيير في خدماتها

المغرب يستعين بالأمن والدرك لتطبيق العزلة الصحية

وكالة المحافظة العقارية تساهم بمليار درهم في صندوق مواجهة كورونا

مؤسسات تقدم مساهمات في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كوفيد-19

وزارة الصحة.. تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 بالمغرب

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كوفيد-19

توقيف شخصين ببرشيد والقنيطرة بثا ادعاءات كاذبة حول كورونا
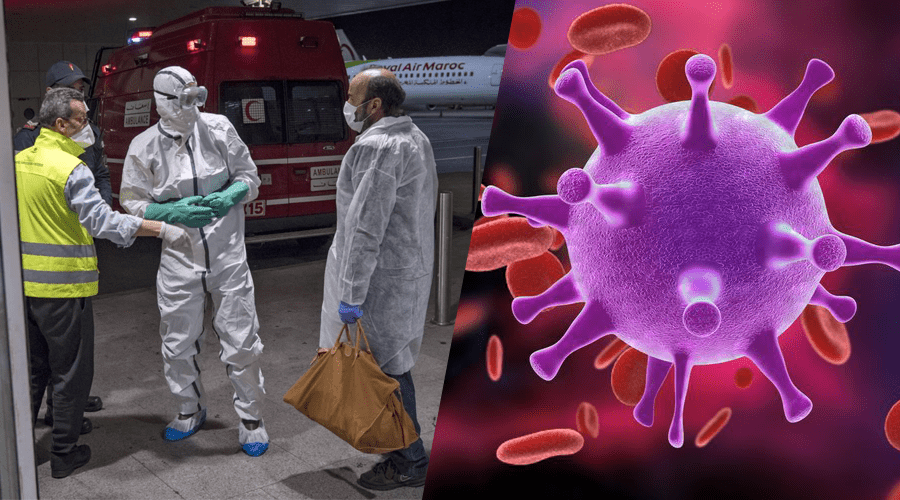
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 49 حالة

حملة تبرعات واسعة في صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب

دواء للملاريا يثبت قدرته على علاج المصابين بفيروس كورونا

أول ظهور للوزير عمارة بعد إصابته بكورونا

الملك يترأس جلسة عمل لتتبع تدبير انتشار وباء كورونا بالمغرب
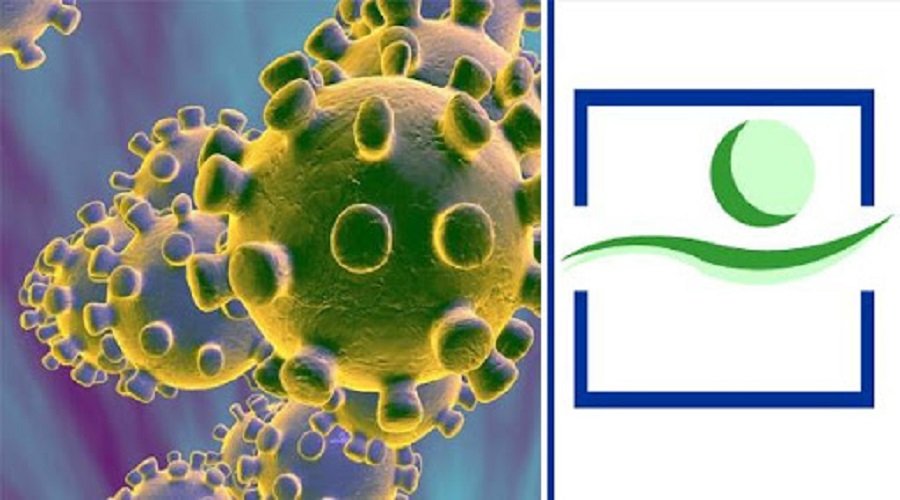
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 44 حالة

الهولدينغ الملكي يتبرع بـ 200 مليار لصندوق مكافحة كورونا

اعتقال سيدتين لنشرهما أخبار زائفة حول كورونا وهذه حقيقة فيديوهات إغماء مواطنين في الشارع

مولاي حفيظ العلمي يتبرع بـ20 مليار من ماله الخاص لمواجهة كورونا

الداخلية تنفي المعلومات المتداولة بخصوص فرض حالة الطورئ

أعضاء البرلمان يساهمون بشهر من تعويضاتهم لمواجهة كورونا

أعضاء الحكومة يساهمون براتب شهر لمواجهة كورونا

أطباء القطاع الخاص يضعون أنفسهم ومصحاتهم رهن الإشارة لمواجهة كوفيد-19

المكتب الوطني للسكك الحديدية.. إجراء تعديل على عدد القطارات الرابطة بين الدار البيضاء ومطار محمد الخامس

الرباط.. التوقيع على مرسوم يتعلق بالصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كوفيد-19
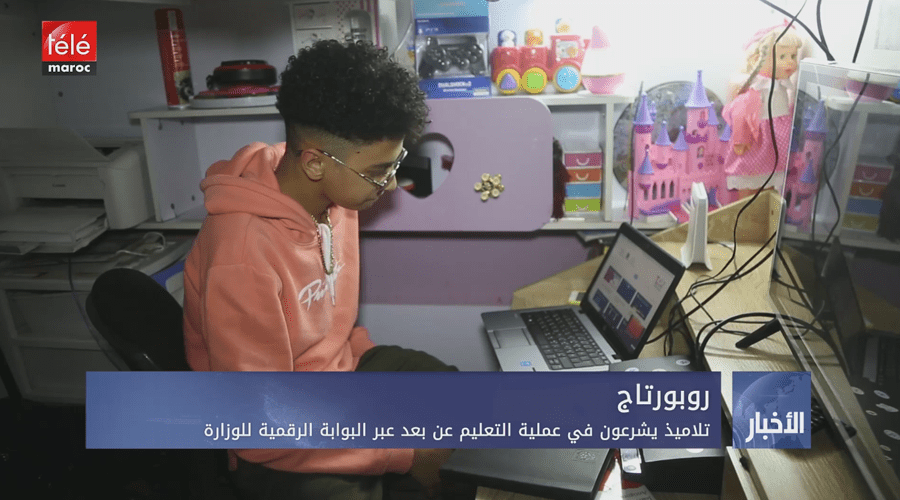
تلاميذ يشرعون في عملية التعليم عن بعد عبر البوابة الرقمية للوزارة

النيابة العامة تتوعد مروجي الأخبار الزائفة بخصوص كورونا

وزارتي الداخلية والفلاحة تقرران تموين المحلات التجارية بالفواكه والخضر بشكل مباشر

البنوك تحدد عدد الزبناء الممكن ولوجهم لمنع انتشار كورونا
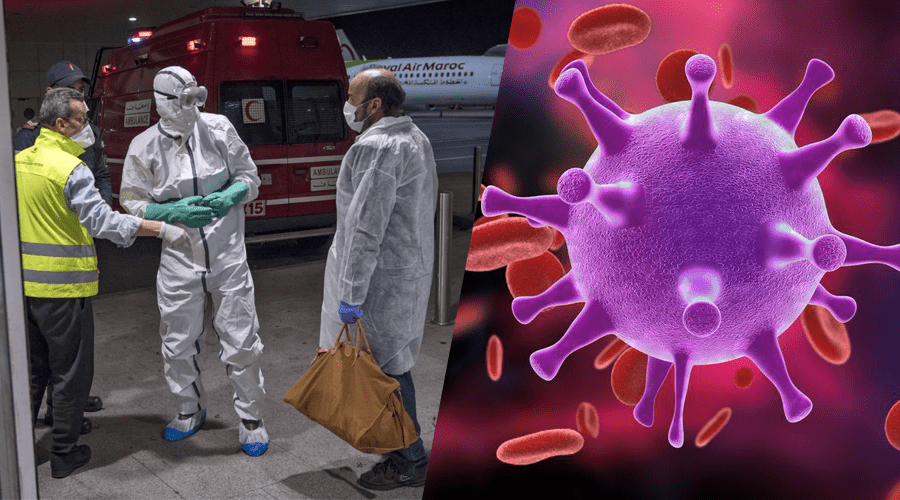
عاجل.. تسجيل ثاني حالة وفاة وحالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالدار البيضاء

هذه حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وضعية التزويد بالماء الشروب

المجلس الوطني للأطباء يفتح باب التطوع في وجه جميع الأطباء

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 37 حالة

رخص برحلات جوية إستثنائية لإجلاء أوروبيين

التضامن الافتراضي يواجه الشائعات

تاريخ.. بودرقة العلبة السوداء لأحداث 1973 يكشف حصريًا وثائق الثورة

وزارة الفلاحة تؤكد استمرار تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية

ملف.. قصص وزراء وقياديون عانوا من عزلة الحجر الطبي

تعقيم المؤسسات العمومية بالدار البيضاء لمنع تفشي كورونا

الداخلية : استخدام وسائل النقل العمومي للضرورة القصوى فقط

نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أعضاء الحكومة المغربية جاءت سلبية

المغرب يقرر إغلاق المساجد ابتداء من اليوم لمنع انتشار كورونا

مولاي حفيظ العلمي يؤكد أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري بخصوص تموين السوق

تعقيم مختلف الفضاءات والمرافق الإدارية بمراكش لمنع انتشار كورونا

المغرب يقرر إغلاق المقاهي والمطعم والقاعات السينمائية والحمامات بسبب كورونا

فيروس كورونا يواصل حصد الأرواح ودول العالم تغلق حدودها
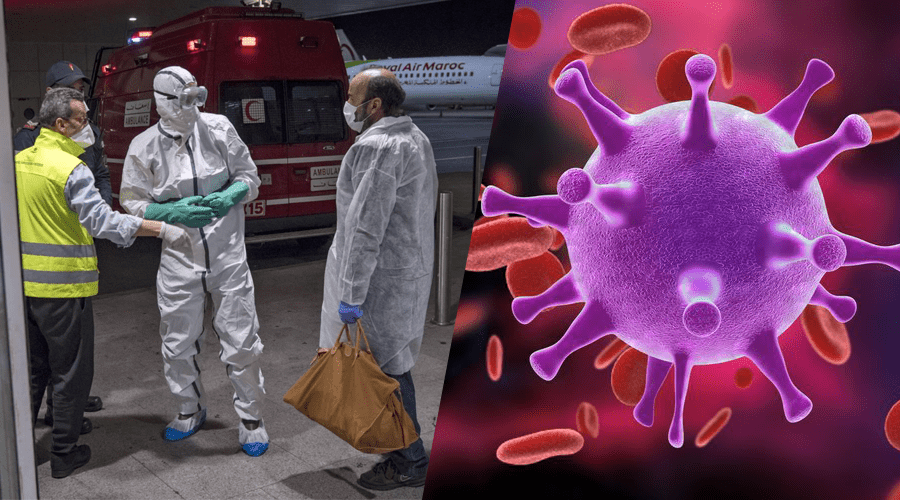
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 29 حالة

وزارة التعليم تعلن انطلاق عملية التعليم عن بعد

مدير الصحة الفرنسي : الوضع مقلق جدا ويتدهور بسرعة
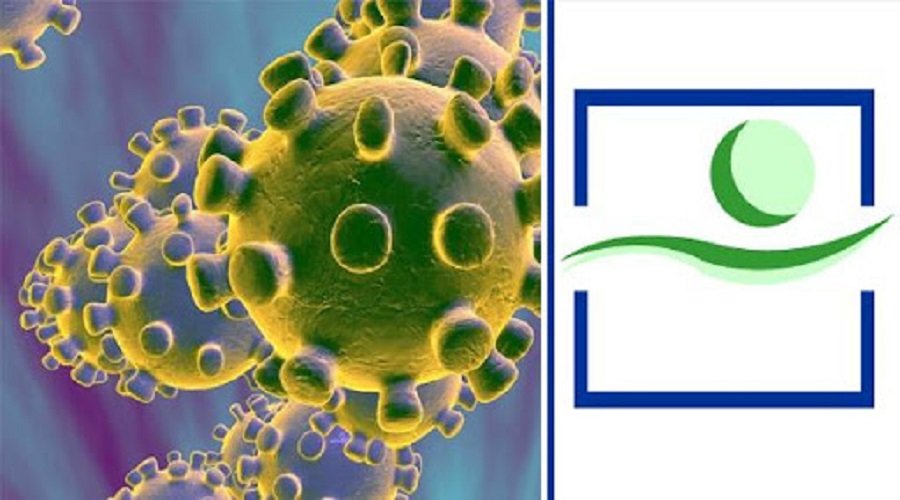
ألو 141.. وزارة الصحة تطلق رقما للمساعدة الطبية الاستعجالية خاص بالكورونا

انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من الغد بحوالي درهم

بعد إصابة اعمارة بكورونا.. العثماني يكشف نتائج تحاليل باقي الوزراء

ارتفاع الاسعار يستنفر وزارة الداخلية

مهربو الكمامات أمام المحكمة

وزارة التعليم تدعو الأساتذة والأطر الإدارية إلى الالتحاق بمقرات عملهم

الملك يأمر بإحداث صندوق خاص بـ 10 ملايير درهم لمواجهة انتشار كورونا

وزارة العدل تقرر تأجيل امتحانات بسبب فيروس كورونا

عاجل..المغرب يقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية

إرتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 28 حالة

بعد إغلاق المدارس هذه تفاصيل تفعيل قرار التعليم عن بعد للتلاميذ

شكاية لمكتب الصرف حول استثمارات خارجية تقود البرلماني عبد المولى لضيافة الشرطة القضائية بطنجة

الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق في خروقات جماعة بوزنيقة

ملكة بريطانيا تغادر قصرها بسبب فيروس كورونا

ابتزاز سيدة في مبلغ 600 درهم يطيح بممرضتين

إخضاع وزراء حكومة العثماني لفحص كورونا بعد إصابة اعمارة بالفيروس

المغرب يغلق حدوده في وجه 21 دولة بسبب كورونا

العثماني : الملك أمر بالتعامل بشفافية بخصوص كورونا واحتياطي المواد الغذائية متوفر

إصابة الوزير اعمارة بفيروس كورونا

حقيقة وجود بؤرة وبائية لكورونا بالبيضاء

سياح عالقون بمطار مراكش بعد تعليق الرحلات لتفادي تفشي كورونا (فيديو)

المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب إلى 17 حالة

حركة الممرضين وتقنيي الصحة تعلن تعليق إضراباتها الوطنية بسبب مستجدات فيروس كوفيد-19

إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات وتعليق رخص العطل بسبب كورونا

وزير الصحة ينفي وجود "بؤرة وبائية" بالدار البيضاء

وزير التعليم يكشف عن الإجراءات البديلة من أجل توفير الدروس عن بعد لجميع التلاميذ والطلبة

المغرب يمنع التجمعات فوق 50 شخصا ويوقف جميع مباريات كرة القدم

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي

تسجيل ثامن حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب

كارفور يعلن نفاذا مؤقتا لبعض منتوجاته ويعلن توفره على مخزون كاف لأشهر

توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمغرب بسبب كورونا

بعد تعليق الرحلات.. المغرب يفتح معبري سبتة ومليلية لعودة السياح الإسبان

الموت يغيب الحاج الحسين برادة.. آخر شهود مرحلة تسليح المقاومة بالمغرب

شبح الجفاف يخيّم على العالم القروي

فضيحة تهرب ضريبي بمبالغ طائلة تهز قطاع العقار

صديقي يوزع كعكة التفويضات على مستشاري البيجيدي بمجلس الرباط

الرقم الأخضر يسقط ثلاثة موظفين في يوم واحد

العثماني : الشخص المصاب بكورونا قضى فترة بفرنسا وجاري البحث عمن احتكوا به

وفاة أمريكي متورط في تهريب الكوكايين بمستشفى بالدار البيضاء

سفارة المغرب بمدريد تحدث خلية لتتبع تطورات كورونا

كورونا يجبر فنادق مصنفة على الاستغناء عن خدمات عمال موسميين

جمعيات تطالب الحكومة بضخ أموال في ميزانية وزارة الصحة لمواجهة كورونا

وزير الصناعة والتجارة يكشف عن تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتجات بسبب فيروس كورونا

الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس يشيد بدعم الملك لصمود أهل القدس في وجه الاحتلال

إجراءات خاصة داخل سجون المملكة بسبب كورونا

رسميا.. تأجيل جميع مباريات أبطال أوروبا ويوروبا ليغ بسبب كورونا

وزارة الداخلية.. توجيه مراسلة للولاة والعمال بجهات وأقاليم المملكة لتأمين الأسواق بالمؤونة
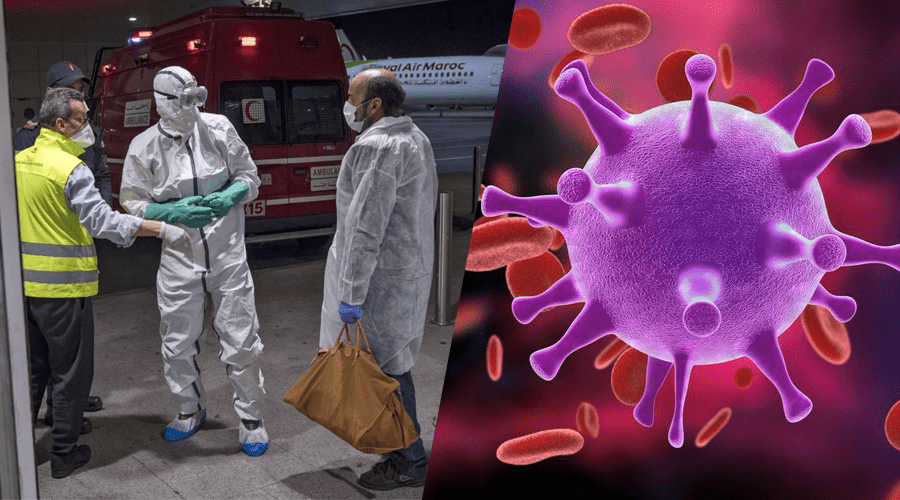
المغرب يعلن عن تسجيل 7 حالة إصابة بفيروس كورونا

هكذا تم السماح لباخرتين قادمتين من إيطاليا بدخول ميناء آسفي

رئيس الحكومة : وباء كورونا يستوجب تعاملا جديا لكن دون مبالغة أو تهويل

مقاهي ومطاعم بالرباط لا تتوفر على مواد التنظيف والحكومة تعلن ارتفاع أثمانها

المغرب يعلّق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا

هكذا يستعد الجيش المغربي في حال انتشار فيروس كورونا

هذه تفاصيل قانون ترقيم المغاربة المعروض على مجلس المستشارين

إيداع المتهمين بقتل فتاة سلا وتقطيع جثتها سجن العرجات

فبركة بلاغ لوزارة الصحة حول تسجيل 7 إصابة بكورونا والأمن يدخل على الخط

المغرب يسجل تراجعا بثلاثة مراكز في مؤشر سيادة القانون لسنة 2020

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.. ارتفاع الرواج الإجمالي للموانئ المغربية بـ % 11.3

توضيح رسمي.. ترحيل مغاربة إيطاليا إلى المملكة عبر رحلات خاصة بسبب كورونا غير صحيح

وزارة الفلاحة تخصص 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية

استنطاق عمدة مراكش ونائبه في ملف صفقات كوب 22

مرض كوفيد-19.. مراقبة أزيد من 35 ألف شخص على مستوى نقط العبور بالمغرب إلى حدود 8 مارس الجاري

الدار البيضاء.. الملك يستقبل الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية

إحباط محاولة إدخال حوالي 12 ألف قرص مخدر إلى المغرب من باب سبتة

هكذا فوت رئيس جماعة صفقة نظافة إلى شركة أوزون قبل تأسيسها

وزارة الاقتصاد والمالية تُنشئ لجنة اليقظة لتتبع انعكاسات كورونا

الفيروس المستجد يلهب أسعار الثوم في السوق المغربية

وزارة التعليم تكشف حقيقة تغيير تاريخ العطلة المدرسية

أمن مراكش يوقف سائق السيارة الذي دهس تلاميذ

تأخر الأمطار يدفع فلاحين لسقي أراضيهم بمياه الواد الحار ببرشيد

هذه خطة وزارة الفلاحة لمواجهة نقص التساقطات المطرية

المغرب يلغي جميع المواسم الدينية بسبب كورونا

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 6 حالات

أونسا.. تلقيح 12 مليون من الأغنام و 1.5 مليون من الأبقار ضد الأمراض المعدية

افتتاح منتزه أنفا بارك.. المتنفس الأخضر للمدينة البيضاء

وزارة الصحة.. تقديم معطيات وتوضيحات للرأي العام بخصوص أول حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا تطيح بمسؤول في وزارة الصحة من منصبه

اليوبي : وزارة الصحة تراقب بشكل يومي 300 شخص كانوا على اتصال مع الحالات الثلاث المصابة بفيروس كورونا

بالفيديو.. النيران تلتهم حافلة وسط المحطة الطرقية بالقنيطرة

تورط أطباء في شبكة سرقة أدوية عمومية

السجن للرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة

الدرك يطيح بعصابة إجرامية روعت فيلات المهاجرين والأعيان
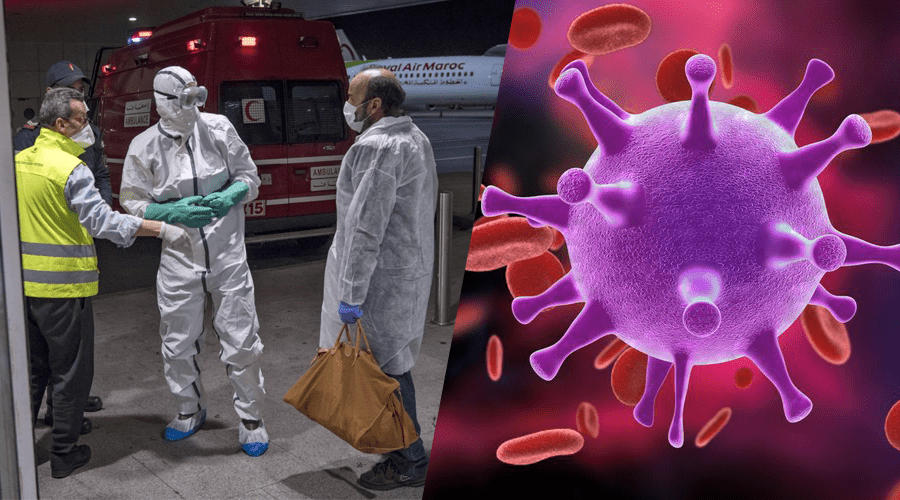
المغرب يؤكد تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا

وثائق تكشف اختلالات تدبيرية ومالية بشركة العمران سوس- ماسة

وزارة الصحة.. رصد 66 حالة محتملة بفيروس كورونا والوضع الصحي للحالتين المصابتين المؤكدتين مطمئن

اليوبي يكشف حالة المصابين بكورونا وهكذا سيتم دفن السيدة المتوفاة

وزارة الصحة تكشف الوضع الصحي للحالتين المصابتين بكورونا

صفقات الصابون والمطهرات تستنفر المؤسسات العمومية

الرصاص لتوقيف شخصين هاجما رجال الأمن بواسطة مقدة

الدار البيضاء.. وضع برنامج لدعم إنشاء ومواكبة 1000 مقاولة

عاجل... المغرب يسجل أول وفاة بفيروس كورونا

متصرفو المغرب يعودون إلى الاحتجاج من جديد بعد عجز الحكومة عن تحقيق مطالبهم

نافورات مهملة بالرباط والمواطنون يطالبون بإعادة تشغيلها

8.6 مليار درهما حجم مبيعات سوق الأدوية الخاص بالمغرب

سيتي كلوب أمام القضاء لهذا السبب

هل تصدم الداخلية شركة أوبر
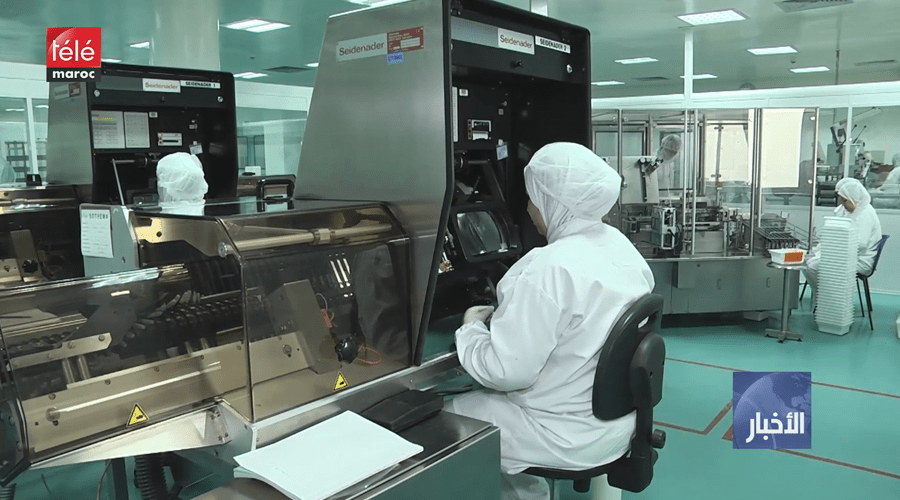
المندوبية السامية للتخطيط.. أكثر من نصف النساء المغربيات خارج سوق الشغل

الموزعون المغاربة يرفعون من واردات المحروقات بسبب فيروس كوفيد-19

المغرب يعلّق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

إدانة مروج شائعة كورونا وأمن تطوان يتعقب الصفحات المشبوهة

المغرب يعلن تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تكشف حقيقة تسجيل حالتي إصابة بكورونا في القنيطرة

أمريكية تُسقط قائدا اتهمها بربط علاقة حميمية مع معلم

مارينا سلا.. نافذ يحول مطعما إلى ملهى ليلي ويتسبب في فوضى عارمة بالمنتجع

مجلس بوعياش يتحدث عن محاكمة معتقلي الحسيمة وسبب اعتقال الزفزافي

ملف.. قصة قانون تجريم الإثراء الذي قض مضجع أثرياء المغرب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفرج عن تقريره حول أحداث الحسيمة

الموثقون يرفضون تسقيف الأتعاب ويعلنون عن وقفات احتجاجية وإضراب وطني لأربعة أيام

وزارة الصحة.. عدد الإصابات المحتملة بـ "كورونا" يرتفع إلى 62 و 2 منهم مؤكدتين

بوعياش : أغلب الأخبار الزائفة بخصوص أحداث الحسيمة مصدرها الخارج

وزارة الصحة تؤكد ارتفاع عدد المشتبه في إصابتهم بكورونا

مجلس بوعياش يكشف روايته حول وفاة الناشط عماد العتابي

تسجيل أول وفاة بسبب فيروس كورونا في إفريقيا

تاريخ إلغاء مسابقات كرة القدم في الملاعب المغربية

العثماني : الإجراءات المتخذة ضد كورونا هدفها حماية البلد والمواطنين

نساء المغرب تطالب بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا والوظائف الانتخابية

رئاسة النيابة العامة تدخل على خط تدابير الوقاية من كورونا

لارام تعلّق رحلاتها مؤقتا نحو ميلانو والبندقية بسبب كورونا

الأطباء يدعون إلى استعادة الطب العام لمكانته في المنظومة الصحية
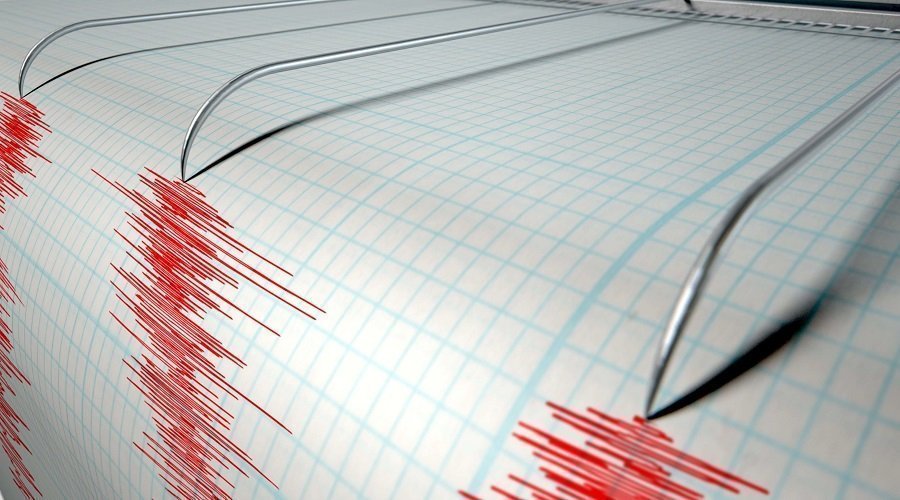
هزة أرضية تضرب سواحل أكادير وجزر الكناري

الصيادلة يحمّلون وزارة الصحة مسؤولية رفع أثمنة الكمامات والمعقمات

الداخلية تحقق في تجاوزات وخروقات البيجيدي بالفنيدق

تطورات مثيرة في قضية تهريب بريطاني لـ17000 كمامة بمطار أكادير

التحقيق مع شخصيات تستفيد من عقارات تفوق المليار بمراكش

عناصر الشرطة القضائية تبحث عن شباط بفاس

قطاع الفلاحة والغابات و الصيد البحري يستحوذ على نصيب الأسد في تشغيل النساء

مؤسسات الدولة تواصلُ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورون

الصيادلة يدعون وزارة الصحة للتدخل بعد نفاذ الكمامات الطبية

وزير الصحة يدعو إلى التجند ضد تفشي كورونا

فيروس كورونا يُفرغ المطاعم الصينية من الزبناء بالدار البيضاء

المغاربة يرفضون تعليق صلاة الجمعة بعد الشائعات التي انتشرت بخصوص إجراءات التصدي لكورونا

وزارة الصحة تكشف عن الوضع الوبائي بالمغرب وخطر الوصول لـ500 حالة مؤكدة مرتفع

فضائح أخلاقية تتسبب في حل ناد رياضي

المغرب أخضع 21805 مسافرين لفحص كورونا بـ 33نقطة عبور

فارس يمنع الفضوليين من دخول المحاكم بسبب كورونا
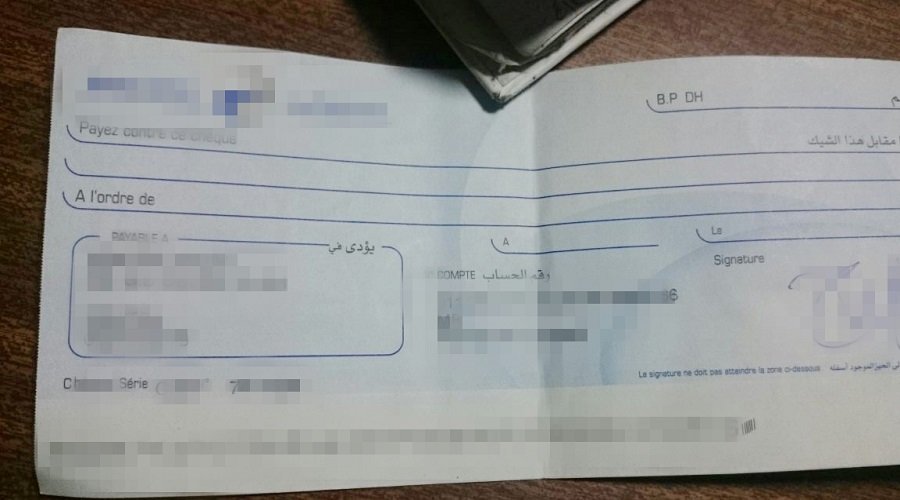
اختفاء رئيس جماعة بعد قرار تبليغه بحكم في قضية شيك بدون رصيد

جطو يحيل ملفات رؤساء جماعات على رئاسة النيابة العامة

أطباء القطاع الخاص يطالبون باشراكهم في المعركة ضد وباء كورونا

تنسيق نقابي يحمل وزارة التربية مسؤولية الاحتقان في التعليم ويسطر برنامجا احتجاجيا

اليوبي : 260 شخصا يخضعون للمراقبة بسبب كورونا

لوبيات العقار ومنتخبون يشهرون ورقة القضاء بعد مضاعفة عامل للضريبة
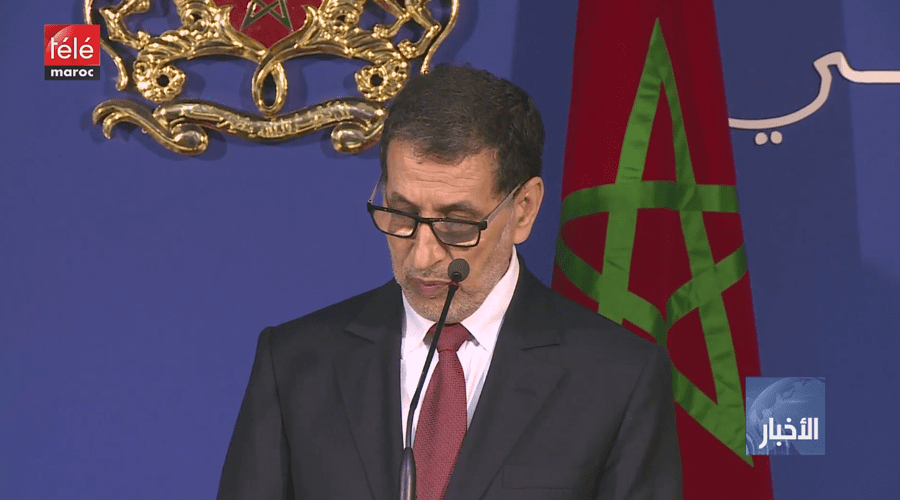
العثماني : الحالة الوبائية بالمغرب عادية ومستعدون لأي تطور

تفاصيل إجهاض محاولة تهريب 7 أطنان من المخدرات بالكركارات

السجن والغرامة في حق سائق حافلة فاجعة الرشيدية

غياب الكمامات من الصيدليات ونقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر

وزارة الصحة.. المصابة الثانية بفيروس كورونا المستجد "حالتها حرجة"

تدابير خاصة من لارام بسبب فيروس كورونا

التحقيق في تسريب لائحة ركاب الطائرة التي كان ضمنها مصاب بكورونا

هذا قرار الحكومة في إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

عامل يحقق في اتهام رئيس جماعة بتسيير دورة وهو في حالة سُكر

هذه تفاصيل متابعة محاسب مجلس المستشارين بالتزوير
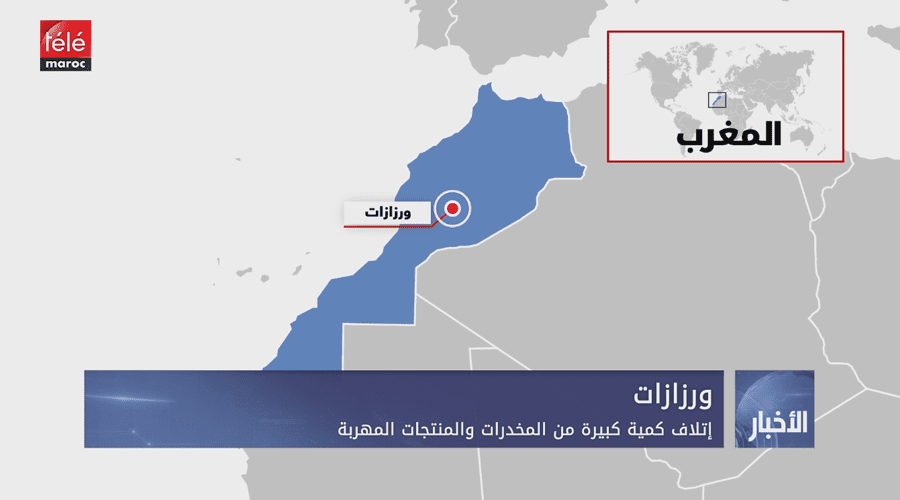
ورزازات.. إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمنتجات المهربة

أساتذة التعاقد ينظمون وقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن المغربية

اقبال كبير على مواد التنظيف والمعقمات للوقاية من خطر تفشي كورونا

وزارة التربية الوطنية تطلق حملات تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا

سفينة قادمة من إيطاليا تستنفر السلطات بميناء أسفي

اختلالات التعليم والصحة والشغل أهم خلاصات برنامج "100 يوم 100 مدينة" للأحرار

السعودية ترجع أموال المعتمرين المغاربة

تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا بالمغرب

الفرقة الوطنية تحقق مع الوزير السابق مبديع في تهم فساد

تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية هذه مميزاتها

تهم تبديد الملايين تلاحق ولاة سابقين

شبح بنبركة يطارد موظفين كبار ورجالات دولة

المغرب يمنع تصدير الكمامات بسبب فيروس كورونا

الداخلية تتوعد مروجي الأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا

الـ ONEE يوضح حقيقة اعتزامه تقليص المدة الزمنية للتزويد بالماء الشروب

القضاء يصدر حكمه بحق المتابعين في ملف الماستر مقابل المال

اتهامات بتعطيل مشروع ملكي بسلا تطارد العمدة المعتصم

حجز طن و482 كلغ من المخدرات واعتقال شخصين بالرشيدية

بايدن يقلب الطاولة على ساندرز ويفوز بولاية تكساس

فاس.. إطلاق برنامج بـ670 مليون درهم للحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة

وصول باخرة تقل 3000 سائح لميناء أكادير تستنفر السلطات

10 ملايير سنتيم كفالة في قضية بمراكش

الحجز على مليار سنتيم من حساب أحد البنوك

وزارة الداخلية تبدأ مشاورات مع الاحزاب حول الانتخابات

لهذا تم إخلاء مقرات شركة أكسا للتأمينات من كل مستخدميها اليوم

مكافأة بـ 200 ألف دولار لمن يكتشف علاجا لكورونا

النيابة العامة تحقق في تسجيل منسوب لسمسار في الأحكام القضائية

إطلاق النار على شخص عرض حياة المواطنين للخطر بالناظور

الحكومة تطمئن المغاربة وتؤكد أن المغرب يتوفر على احتياطي 12 مليون كمامة

وزير الصحة يؤكد مراقبة محيط حامل فيروس كورونا والمسافرين الذين كانوا معه في الطائرة

بالفيديو.. فوضى وتدافع وسرقة خلال افتتاح متجر إسباني بالرباط سانتر

وزير الصحة : حالة المصاب بكورونا مستقرة وهكذا تم التعامل مع عائلته

وزارة التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

وزير الصحة : الشخص المصاب بكورونا احتك بعدد من الأشخاص

النقابات الصحية تندد بالاعتداءات المتكررة التي تطال الأطر الطبية

الكشف عن دواء جنيس لدواء ليفوتيروكس الخاص بمرضى الغدة الدرقية

إلغاء تنظيم الدورة الـ15 للمعرض الدولي للفلاحة بسبب كورونا

المغرب يعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الملك يطلق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية بالمدينة العتيقة لفاس بـ 670 مليون درهم

مجلس آسفي يصرف مليارين و500 مليون لموظفين أشباح

إرجاع مصاريف المعتمرين الذين ألغي سفرهم بسبب كورونا

أمن وجدة يطيح بـ 5 أشخاص بينهم جزائريان ضمن شبكة دولية للمخدرات

تفاصيل إفشال تهريب 17000 كمامة طبية بمطار أكادير

ملف.. هكذا اختارت نساء أوروبيات العيش في أحضان مغاربة

تاريخ.. هذه أشهر الأوبئة التي ضربت المغرب وتسببت في مصرع شخصيات شهيرة

لهذا أصبح الحشيش المغربي عملة نادرة في أوروبا

الدكاترة المعطلون يطرقون باب القضاء قبل العودة إلى الشارع

أزمة في وسائل النقل والرباطيون يلجؤون إلى الخطافة

أب يقتل ابنته ويحاول الانتحار بأكادير

آخر جديد الفتاوى... من مات بفيروس كورونا فهو شهيد

الرجاء يستعين برجال أمن خاص وطباخين لمواجهة مازيمبي

أزمة الترخيص بالاشتغال في المصحات تتفاقم بين أطباء القطاع الخاص والهيئة الوطنية للأطباء

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 4 دواعش بسيدي سليمان

المغرب يعلن احتمال تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية وإلغاء التجمعات المكثفة بسبب كورونا

وزارة الصحة تتجه لتعميم التعاقد في القطاع

1560 مشروع متوقف في الدارالبيضاء

كورونا يربك وكالات الأسفار المغربية

اختفاء موثق حصل على 20 مليار من موكليه

توقيف شرطي أشهر مسدسه وهو في حالة سكر خلال نزاع شخصي

إحالة رئيس بلدية من البيجيدي على غرفة الجرائم المالية

الداخلية تحيل قانون ترقيم المغاربة على المستشارين وهذه أهدافه

عامل يقاضي برلمانيا بسبب خروقات التسيير

5 سنوات سجنا لأستاذ متدرب بعد متابعته في قضية إرهاب

وزارة التربية تتعهد باستئناف جلسات الحوار القطاعي والنقابات تصفها بالتافهة

وكالات الأسفار تخير المتضررين من تعليق العمرة مؤقتا بين التأجيل أو التعويض

مواطنون يلقون القمامة ويتبولون في أسوار عتيقة بالعاصمة ترميمها يكلف الملايين

نقابة تطالب بإدماج المتعاقدين بالوظيفة العمومية وتدعو أمزازي للتعجيل باستئناف الحوار القطاعي

السجن لملياردير متابع في قضية مخدرات والتحريات تطيح ببارون جديد

هكذا اعتصم مواطنون للمطالبة بمقبرة جماعية

تفاصيل إخضاع طاقم صيني في 3 بواخر بآسفي لفحوصات كورونا

هذه أخطر الأمراض النادرة التي تهدد المغاربة

مشاريع متعثرة وتلاعب بالصفقات يورّط رؤساء جماعات

تطورات مثيرة في قضية تبديد 117 مليارا من أموال الموظفين

اعتقال ممرض ووكيل تجاري يتاجران في أدوية المستشفيات

وزارة الصحة تطمئن المغاربة وتعلن خطتها لمواجهة فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي يرد على تهديدات أردوغان بفتح الحدود للاجئين

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في فرنسا والفيروس يصل الجيش الألماني

المغرب يواجه نقص مخزون الدم.. ووزارة الأوقاف تنادي بالتبرع

الحكومة تتوعد ناشري الأخبار الكاذبة حول كورونا بمتابعة أصحابها مباشرة للمس بأمن المغاربة

وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة حول تسجيل إصابات بفيروس كورونا

وزارة الصحة تكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا بالمغرب

الموثقون يحتجون على تسقيف الأتعاب ويدخلون في إضراب وطني

فضيحة تخلي مستشفيات عن حاضنات كلفت 3 ملايير تهز وزارة الصحة

الداخلية تعلن الحرب على فوضى المقاهي وقاعات الألعاب

مجلس النواب الإسباني يدعو إلى حل عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء المغربية

مديرية الحموشي تحقق في ادعاءات فساد

نقابتان تستنكران إلغاء وزارة التعليم الحوار مع أساتذة التعاقد وتصفان القرار بالعبثي

استبيان عنصري حول مغاربة إيطاليا والسفارة المغربية تدخل على الخط

وزارة الصحة تؤكد تسجيل 17 حالة محتملة لكورونا كلها سلبية
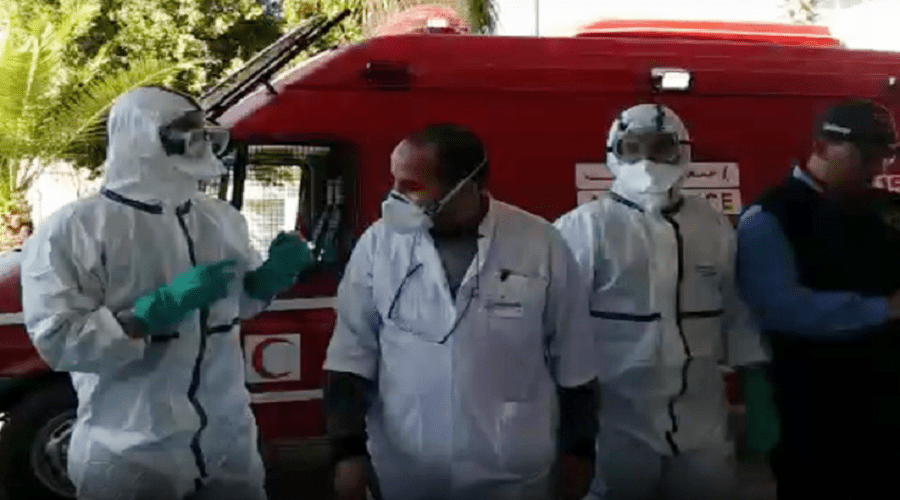
بالفيديو.. الاشتباه في إصابة شخص بكورونا يستنفر مستشفى بسطات

المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ممنوعة من مغادرة المغرب

قضاة جطو يفتحصون تركة العماري بمجلس جهة طنجة الحسيمة

إيداع ثلاثة حراس بسجن سلا2 سجن تيفلت بتهمة الارتشاء

13 قتيلا و 1965 جريحاَ حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

المكفوفون يهاجمون الحكومة ويتهمونها بالتنصل من التزاماتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة
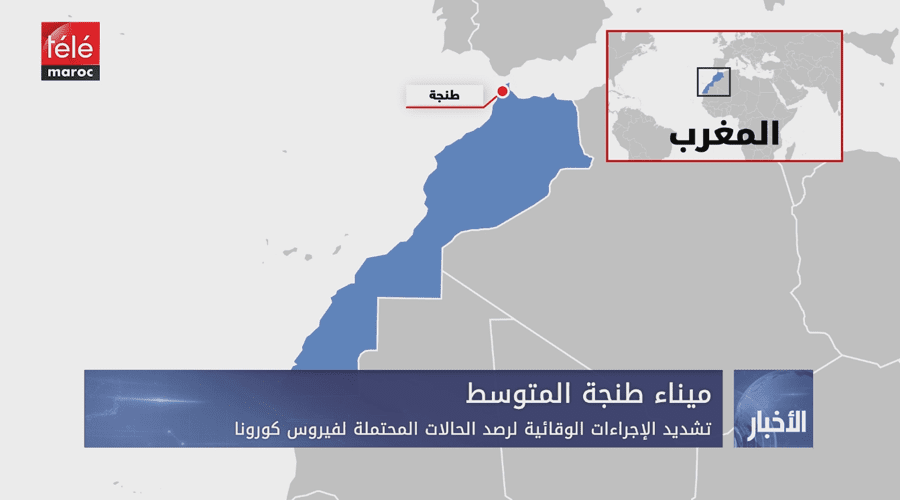
تشديد الإجراءات الوقائية لرصد الحالات المحتملة لفيروس كورونا

سعد الدين العثماني : الحكومة تسعى جاهدة لإنجاح ورش إصلاح منظومة التكوين الطبي

إغلاق الحدود في وجه مقاولين بسبب تورطهم في صفقات مشبوهة

محكمة البيضاء تصدر حكمها في حق نصاب القريعة

الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة تنفي وجود خصاص في الشاي وتؤكد وفرة المادة

30 سنة سجنا لمتهمين في اغتصاب معاق

النقل الطبي يخرج الممرضين للاحتجاج

محاربة الفساد والرشوة تجمع النيابة العامة والأمن

تفاصيل مداهمة سلطات مكناس لمقهى للشيشة رخص له بوانو

قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه قيادي في البام متهم في قضايا فساد
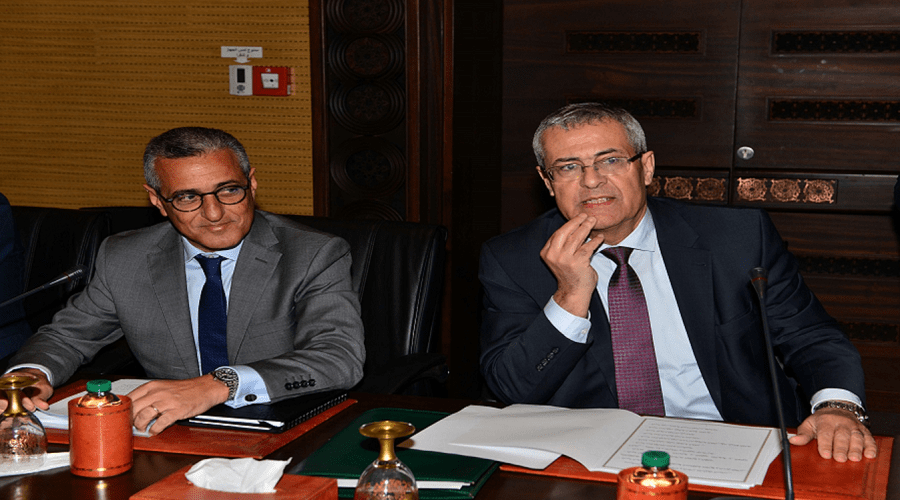
بنعبد القادر : ثغرات قانونية يتم استغلالها للاستيلاء على عقارات الغير

هكذا ورطت مكالمات هاتفية عميد شرطة في شبكة للكوكايين

السلطات المغربية ترفع درجة التأهب الصحي لمواجهة كورونا
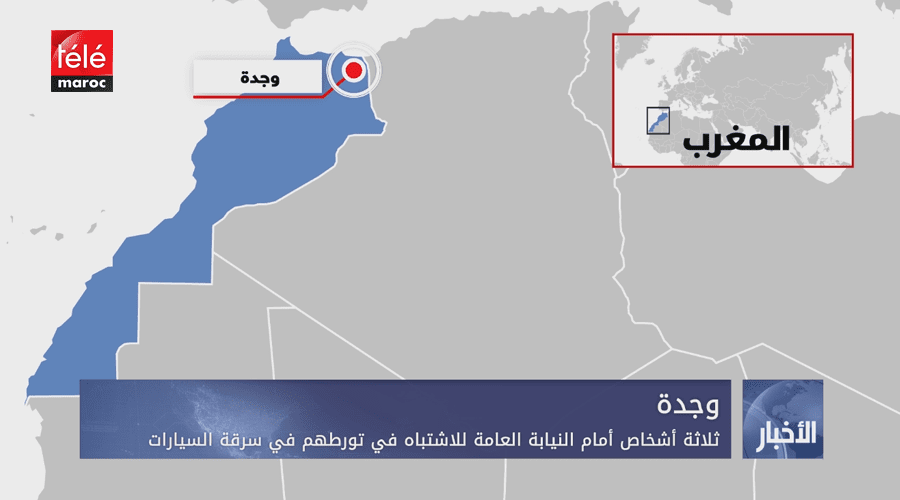
ثلاثة أشخاص أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في سرقة السيارات

أزيد من 10 ملايين مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية

سفيرة المغرب بإسبانيا تبحث مع رئيسة الحكومة المحلية لجهة مدريد سبل تفعيل علاقات التعاون

مقهى يفتح باب التدريب أمام شباب مصابين بمتلازمة داون وأصوات تنادي بتعميم البادرة

بعد إعلانهم خوض إضرابات ومسيرات احتجاجية.. وزارة التعليم تعلق الحوار مع أساتذة التعاقد

اعتقال خطّاف رفض الامتثال وعرّض رجال الشرطة للخطر (فيديو)

المغرب يضع تدابير جديدة للحماية من خطر إشعاعات مسببة للسرطان

بعد سلسلة من الاحتجاجات.. وزارة التربية الوطنية تعقد اجتماعا من أجل مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين

سكان جرى ترحيلهم يستغلون الشارع للمبيت وينشرون غسيلهم في الحدائق

ارتفاع عدد القتلى بسبب كورونا في إيطاليا والسفارة المغربية تحدث خلية أزمة

تطورات جديدة في قضية احتجاز طبيبة و3 نساء ومحاولة اغتصابهن

إيقاف بنت مكة بسبب الإثارة والإساءة للتقاليد
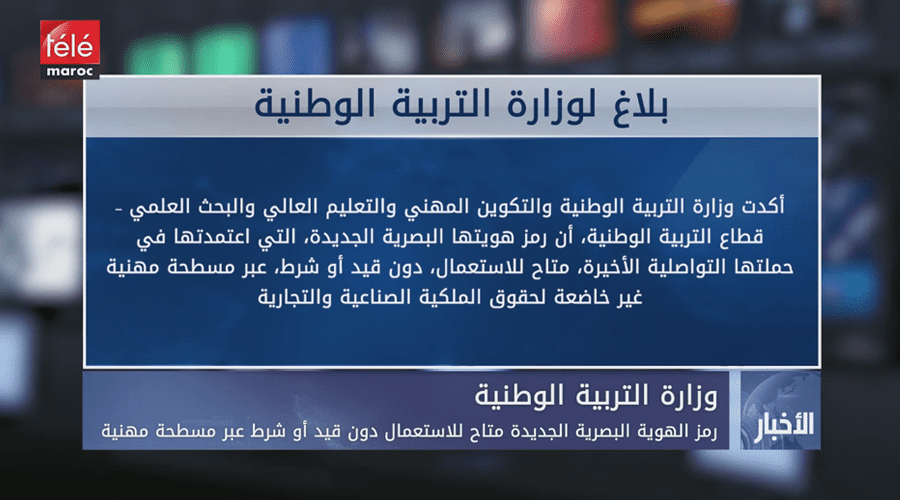
رمز الهوية البصرية الجديدة متاح للاستعمال دون قيد أو شرط عبر مسطحة مهنية

المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية على الصعيد الإفريقي.. والجزائر تتذيل القائمة

الداخلية تراقب نفقات الولاة والعمال

صاحب ملفات تادلة في ذمة الله

الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر توقيف حوالات موظفين في وضعية استشفاء

لفتيت يصدر تعليمات تشدد على ترشيد المصاريف وعدم تبديد أموال عمومية

التحقيق في صفقات إنجاز مشاريع ملكية

هل تورطت عصابة حمزة مون بيبي في انتحار قاض بمراكش

نواب برلمانيون يعتزمون إقناع الحكومة بإحداث "مجلس وطني للمناطق الجبلية"

تاريخ.. مجهولو مصير دفنوا جنب الطرق الوطنية وكتبوا وصاياهم قبل إعدامهم

اختفاء أدوية لعلاج القصور الكلوي وضغط الدم ومختصون يعزون السبب إلى ارتفاع الضرائب

تعثر مشروع "الواي فاي" المجاني بالشوارع يسائل جماعة الدار البيضاء

بعد انتشار كورونا بإيطاليا.. الخارجية المغربية تدخل على الخط

وزارة الصحة تكشف حقيقة إصابة طالب إفريقي بكلية الناضور بكورونا

تأمين الحياة يثير الخلاف بين وسطاء التأمين والأبناك

العثماني يعين 1100 عضوا في أحزاب الأغلبية في مناصب عليا

إختفاء أدوية حيوية بسبب صراع الوزارة والمختبرات

حد أقصى لأتعاب الموثقين

مغاربة في صدارة الضمان الاجتماعي في إسبانيا

مشروع الدراجات السياحية يتحول إلى خردة في الرباط

رؤساء 11 جماعة يهددون بالانسحاب من جهة الرباط لهذا السبب

مجلس جطو يحقق في ديبلومات ماستر مزورة

تقرير يفضح تستر مستشار حوّل مرحاضا إلى مطعم

مغاربة ووهان يغادرون الحجر الصحي ومنظمة الصحة تحذر من تضاؤل فرص احتواء كورونا

تعثر في إنجاز 3 محاجز جماعية وشكايات من أضرار تلحق بالسيارات
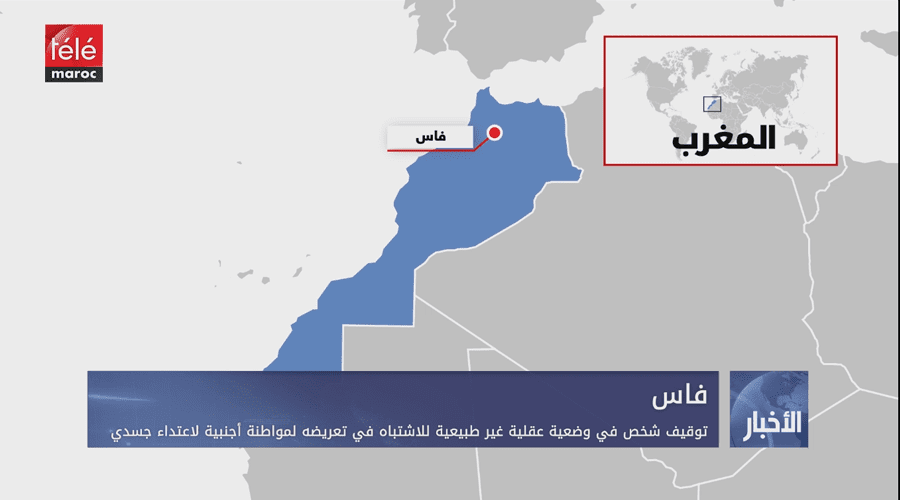
توقيف شخص في وضعية عقلية غير طبيعية للاشتباه في تعريضه لمواطنة أجنبية لاعتداء جسدي

88 في المائة من المغاربة ضد العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال

أمزازي : المناهج والكتب المدرسية بالمغرب تناهض كل أشكال " التمييز ضد النساء "

أمن مطار محمد الخامس يوقف جزائريا مبحوث عنه دوليا

فضيحة تهريب مجلس رباح لحافلات القنيطرة تصل النيابة العامة

ميناء آسفي كلّف 4 ملايير درهم ومع ذلك لا يمكنه استقبال البواخر

أحياء شعبية تغرق في الظلام الدامس بسبب أعطاب الإنارة العمومية
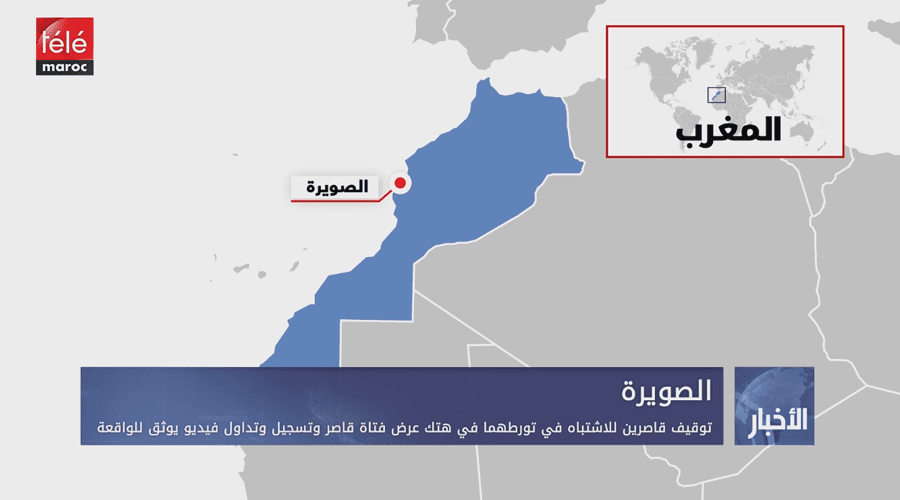
توقيف قاصرين للاشتباه في تورطهما في هتك عرض فتاة قاصر وتسجيل وتداول فيديو يوثق للواقعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تبرز ريادة المغرب في مجال الحكامة

الجزائر تستدعي سفيرها بالكوت ديفوار بعد افتتاح قنصليتها بالعيون

مجلس القنيطرة يخصص 860 مليون لتهيئة مساحة 200 متر

الداخلية ترفض طلب بوانو القاضي بتغيير تسمية مطار فاس سايس

الأنفلونزا في المغرب.. انطلقت سريعا هذا العام والصغار أكثر تعرضا بسبب المدرسة

طلب تعويض من "كنوبس" عن عملية جراحية يفجر فضيحة تزوير

الوزير السابق مبديع في قلب زوبعة بسبب منزل في فرنسا

التامك يقرر مقاضاة والد الزفزافي بتهمة استغلال أحداث الحسيمة

المتصرفون يهددون بشل الإدارات العمومية

دكاترة الوظيفة العمومية ينتفضون بإضرابات في وجه الحكومة

"المتعاقدون" يضربون لأربعة أيام ويحتجون في " 20فبراير"

المكفوفون يراسلون مجلس التعاون الخليجي من أجل ملفهم الإنساني

الرميد يؤجج نار التوتر داخل الحكومة بسبب القانون الجنائي

معدلات البطالة أكثر ارتفاعا لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات وأغلب العاطلين يتمركزون بالمدن

شكوك في إصابة صيني بكورونا يستنفر مصالح الصحة بالقنيطرة

موثق يستولي على وديعة بـ60 مليونا

بعد فاجعة آسا الزاك.. انقلاب سيارة إسعاف بالحسيمة

وزارة العدل تخرج عن صمتها بخصوص تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت

متابعة عمدة مراكش ونائبه بسبب تبديد 28 مليارا

ذبائح وسط روث البهائم وكلاب ضالة وقطط تتجول داخل مجزرة بنسليمان ومطالب بإغلاقها

المغرب يحتل الرتبة الأولى في غياب المعلمين عن الأقسام

الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد تستعد لإطلاق دراسة ميدانية حول ظاهرة الفساد بالمغرب

بمساعدة الديستي.. أمن فاس يجهض تهريب طنين و60 كلغ من المخدرات

التحقيقات تكشف هوية مروج محاضر مزورة للدرك حول مافيات المخدرات

إغلاق عشرات المجازر بالدار البيضاء يشرد مهنيين ووقفات احتجاجية للمطالبة بالبديل

الملك يهنئ رئيس جمهورية غامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هكذا تستنزف سفريات صديقي ونوابه ميزانية الرباط

مركز تحاقن الدم يدعو المغاربة للتبرع من أجل تغطية نقص المخزون

أساتذة التعاقد يخرجون في مسيرات جهوية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

اليابان تجدد التأكيد على موقفها الثابت بعدم الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية" المزعومة

تأييد الحكم بـ 4 سنوات سجنا في حق مول الكاسكيطة

الوالي العدوي تستجوب منتخبين وبرلمانيين بأكادير

أزمة خانقة تهدد المغاربة بالحرمان من لحوم الدواجن

وزارة الصحة تتجه إلى التخلي نهائيا عن طلبات العروض لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية

صناع الأسنان يطالبون الحكومة بقانون ينظم المهنة

انتهاء أشغال مد الخط الثاني من ترامواي الرباط سلا بعد نقل الخط الأول 273 مليون شخص منذ إنطلاقه

سيارة فاخرة تجر رئيس المجلس البلدي بالصخيرات للتحقيق

عبد النباوي يدعو القضاة وضباط الشرطة للقيام بواجبهم ويحذر من الفيسبوك

شبهة تهريب الأموال تلاحق وزيرا سابقا في حكومة بنكيران

ملف.. هكذا تربع زعماء سواسة على كراسي القيادة الحزبية

انتشار الكلاب الضالة يسائل نجاعة مشروع القضاء على داء السعر بالدار البيضاء

بالفيديو.. اندلاع حريق داخل شقة سكنية بسلا

قرابة نصف مليون شخص زاروا معرض الكتاب بالدار البيضاء

أزيد من 230 ألف سائح مغربي زاروا تركيا سنة 2019 بارتفاع بنسبة 32 بالمائة

الضمان الاجتماعي يكذب خبر إعفاء المدير الجهوي بالعيون ويحقق في خروقات

هزتين أرضيتين بإقليم ميدلت

المغرب يقتني طائرات درون فرنسية

مديرة صندوق النقد الدولي في المغرب لهذا الغرض

حرمان مسؤولين من السفر بسبب اختلاس أموال عامة

جمعيات مقربة للاحزاب تحت مجهر الداخلية

عطلة البرلمانيين تكلف 4 ملايير سنتيم

الجيش يتصدى للهجمات الإلكترونية

تاريخ .. حين كان أصحاب الدكاكين أكثر نفوذا من الوزراء

اعتقالات في صفوف جماهير الجيش الملكي بعد منع مسيرة ضد الجامعة

قرار عاملي يرفع تسعيرة الطاكسي الصغير بدرهم ونصف

تفريغ حوالي 5 كيلوغرامات من المخدرات من أمعاء 6 ايفواريين

وضع الجداول النهائية للوائح الانتخابية رهن اشارة المواطنين

تهم التلاعب في صفقات تلاحق موظفين بوزارة الصحة

تعويض ضحية خطأ بنكي بـ 5 ملايين

هكذا حول مستشار مرحاضا عموميا إلى مطعم بشاطئ الهرهورة

وزارة التربية تلقن أطفال التعليم الأولي التعايش مع غير المسلمين

دعوات لاصلاح معاشات المتقاعدين في المغرب

توقيف فرنسيين بميناء طنجة لهذا السبب

المغرب يعتمد البطاقة الصحية للمسافر لمحاصرة فيروس كورونا

المغرب يطمح إلى بلوغ معدل تغطية صحية بنسبة 90% في أفق 2025

برقية تهنئة من الملك إلى رئيس جمهورية صربيا

العزل يطال 4 رؤساء جماعات بجهة سوس ماسة

70 حافلة إسرائيلية ستجوب شوارع البيضاء ومجلس البيضاء ينفي علاقته

أمن طنجة يطيح بـ3 متورطين في الابتزاز عبر الإنترنت

الاستماع إلى رئيس جماعة واعتقال نائبه في ملف السطو على عقار

العلمي ينتقد تشويش البيجيدي ويهدد بالاستقالة

دعوى جديدة ضد بطمة تؤزم وضعها القانوني

أمزازي يمتص غضب المتعاقدين باتفاق مبدئي

هكذا تم التخطيط لطمس المعالم العبرية للحافلات الإسرائيلية الموجهة للبيضاويين

تخلص مستشفيات من النفايات الطبية بعشوائية يهدد صحة المواطنين

تراجع نسبة البطالة بنقطة مئوية واحدة خلال فترة 2017-2019

18 مدينة إيطالية تدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية
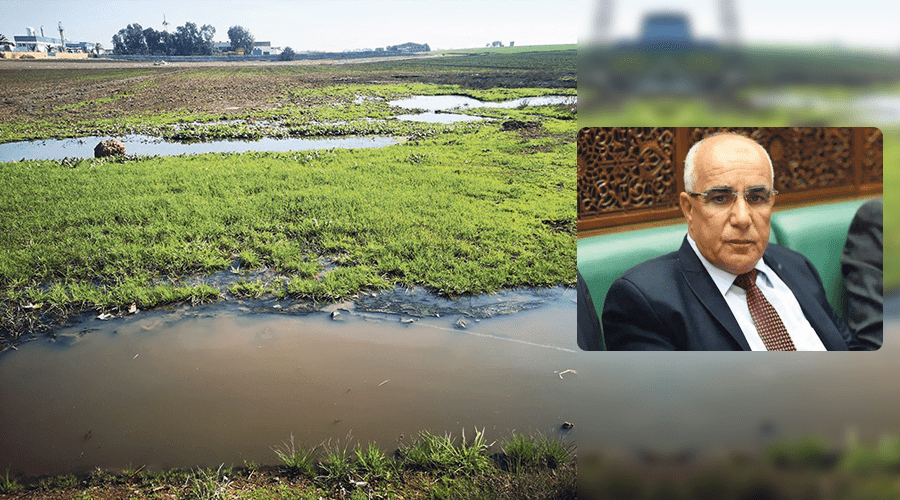
هكذا تهدد المياه العادمة والملوثة سكان إقليم برشيد

هذا قرار إحالة عمدة آسفي على الجنايات في ملف التزوير بمشروع ملكي

وفاة 6 أطباء وإصابة 1716 آخرين بسبب فيروس كورونا

نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب

تنسيق نقابي يرفض منهجية أمزازي ويدعو للإحتجاج

أخنوش يقدم أمام الملك الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر

إحباط تهريب أطنان من المخدرات يقود عسكريين للتحقيق

بنك المغرب يعلن عن الإجراءات المتعلقة بإعادة التمويل في برنامج دعم المقاولات

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء وصل حدود 90 درهما للكيلوغرام الواحد

الملك محمد السادس يدشن منصة أركانة لمواكبة شباب إنزكان لولوج سوق الشغل وإنشاء مقاولاتهم

لارام توضح حقيقة سيلفي غير لائق داخل إحدى طائراتها وتعتذر

رؤساء جماعات بطنجة يتحسسون رؤوسهم خوفا من مقصلة الداخلية

اعتقال 13 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الرجاء والجيش

سلطات بوزنيقة تغلق محلا لشي اللحم بعد حجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة

محروقات سيارات الدولة تكلف 100 مليار

الملك يدشن منصة الشباب أركانة بآيت ملول بكلفة 7 ملايين درهم

هل اقتنى مجلس البيضاء حافلات إسرائيلية مستعملة ؟

إحالة وزير الداخلية الإيطالي السابق على القضاء بسبب المهاجرين

مجلس آسفي يصرف 12 مليارا لموظفين أشباح

مخدرات تجر مسؤولا أمنيا كبيرا وأجودان في الدرك للمحاكمة

بنك المغرب يعلن إجراءات برنامج دعم وتمويل المقاولات

إسبانيا تمنح مسرح سيرفانتيس للمغرب

السلطات تفرض على سيارات الإسعاف الخاصة عرض التسعيرة في الواجهة

19 قتيلا و1976 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

المغرب يشكل مركز جذب للمقاولات الأجنبية الراغبة في العمل أو الاستقرار في إفريقيا

سنتان سجنا نافذا لثلاثة متهمين ضمنهم المدونة سكينة كلامور

إطلاق تطبيق هاتفي جديد يمكن أولياء التلاميذ من تتبع المسار الدراسي لأبنائهم

المغرب يوقع اتفاقيتين للتعاون مع كل من السنغال ومالي تتعلقان بمجالي التعمير والإسكان

تحقيقات سرية في تطوان حول قضايا فساد

حجز 7 أطنان من المخدرات وأسلحة وتوقيف 8 أشخاص بكلميم

المغرب يتدارس إمكانية استعمال القنب الهندي لأغراض علاجية

تقارير سوداء تقرّب دفعة جديدة من رؤساء الجماعات نحو مقصلة القضاء

تلميذ يقاضي المديرية ومفتشين وإدارة ثانوية بسبب نقاط عشوائية

تلميذ يقاضي المديرية ومفتشين وإدارة ثانوية بسبب نقاط عشوائية

مشروع سكني بالرماني يهدد 12 ألف هكتار من شجر البيرول النادر بالاندثار

صيادلة المغرب يخرجون في وقفة احتجاجية حاشدة ويتوعدون بإغلاق شامل للصيدليات

مولاي حفيظ العلمي.. تركيا قبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعها مع المغرب

سفير الصين بالمغرب يؤكد أن بلاده اتخذت إجراءات تفوق في فعاليتها ما أوصت به منظمة الصحة العالمية

الملك يهنئ عبد اللطيف وهبي بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة

تأجيل محاكمة حامي الدين إلى هذا التاريخ

اتهامات لوزارة الصحة بخرق مبدأ المنافسة في تفويت الصفقات

ملف.. قصص مسؤولين كبار أصبحوا سجناء

إدارية أكادير تعزل رئيس جماعة من البيجيدي واثنين من نوابه

تقديم تقرير الملك بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب

رسائل مجهولة ضد أمنيين تستنفر مديرية الأمن

التلاعب في صفقات مواجهة العطش يجر منتخبين للتحقيق

حجم الإنفاق السنوي للأسر المغربية على المواد الغذائية بلغ 5800 درهم

أزيد من 75 ألف شكاية ضد الإدارة العمومية في الفترة مابين 2011 و 2018

بوريطة.. المغرب يرفض التدخل الخارجي ويؤكد على أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين

دفاتر مستوردة تحتوي على مواد ضارة وسوء المنافسة.. مشاكل تحد من جودة وتسويق الدفتر المغربي

الآلاف يحتجون في الرباط ضد صفقة القرن

معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 9.2 بالمائة سنة 2019

النقابة الوطنية للتعليم تحتج بسبب تعطيل الحوار القطاعي

الملك محمد السادس يهنئ "منتخب الفوتسال" بإحراز كأس إفريقيا

تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجالي نقل وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية في اتجاه اسبانيا

البكالوريوس ينطلق في شتنبر.. وقروض بنكية تنتظر الطلبة

أسواق الجملة تمنح الجماعات 350 مليون درهم

بنشعبون.. القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية

اشتباكات وفوضى تفجر المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة وبنشماش يتهم كودار

مديرية الضرائب تحاصر شركات الفواتير المزورة

الداخلية تخضع ولاة وعمال لإعادة التأهيل

الصيادلة يحتجون ضد المنافسة غير القانونية ويطالبون بالتحقيق

تفعيل نظام المراقبة الصحية بالكركرات لمواجهة فيروس كورونا

البسيج يفكك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والهجرة السرية
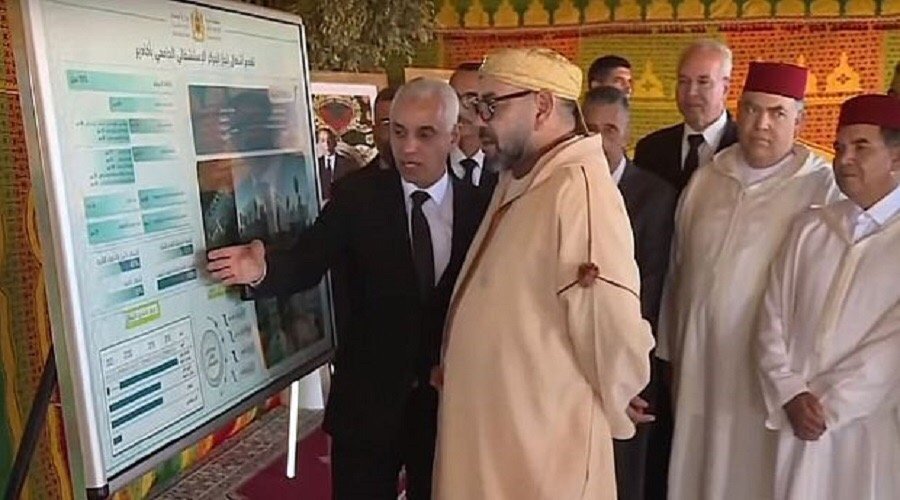
الملك يعطي انطلاقة بناء مستشفى الأمراض النفسية بأكادير

دراسة.. تضاعف عدد المصابين بالسرطان مرتين.. وسرطانات الرئة والثدي الأكثر فتكا بالمغاربة

القطاع الخاص يوفر الشغل لملايين الأجراء خارج مقتضيات القانون

العثماني والحجوي ينوهان بالفوج الأول لطلبة التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وفق النظام الجديد

الملك يعطي انطلاقة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات سوس-ماسة

سفارة الصين بالمغرب : نحن لا نأكل كل شيء وفيروس كورونا مرض طبيعي

استنطاق دركي هرّب شرطيا سابقا متهما في قضية كوكايين الهرهورة

التحقيق في وفاة أول طبيب حذر من فيروس كورونا

الملك يعطي انطلاقة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات سوس-ماسة

الأمن يطيح بمُفبرك خبر انتشار فيروس كورونا في المغرب

تأجيل الزيارة العائلية للطلبة العائدين من ووهان الصينية لهذا السبب

رئاسة النيابة العامة تطلق خدمة الشكاوى الإلكترونية

تفاصيل السطو على 500 مليون من وكالة لتحويل الأموال

تحويلات الجالية المغربية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم في سنة 2019

النقابات تعلن فبراير شهرا للاحتجاجات.. والإدريسي يدعو أمزازي للجلوس إلى طاولة الحوار
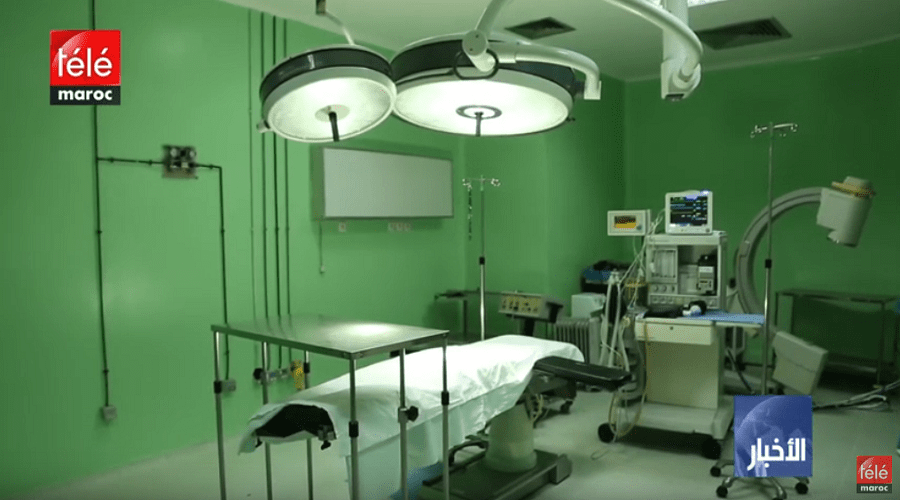
الشامي.. تدهور خدمات الرعاية الصحية يشكل خطرا على استقرار الوضع العام في البلاد
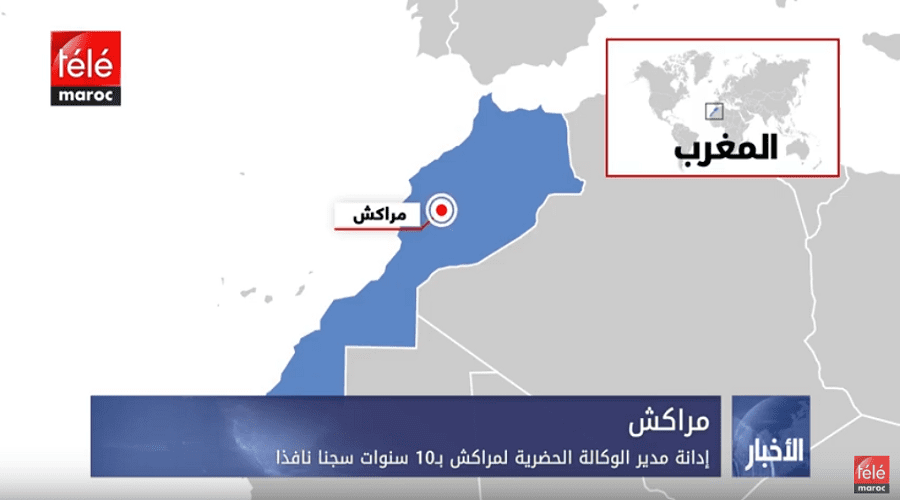
إدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش ب10 سنوات سجنا نافذا

الحبس لأبوين متورطين في تعذيب ابنتهما بالكي

إدانة مدير الوكالة الحضرية لمراكش بـ10 سنوات سجنا نافذا

حرب القوارض والحشرات تنطلق بالبيضاء

تعليمات للنيابة العامة لزجر الخروقات المالية والاقتصادية

فرنسا تعرض الحدود الذكية على المغرب

توقيف متهم 7 على علاقة بخلية الدواعش المفككة بالبيضاء والمحمدية وأزيلال

تقرير.. تأليف 2932 كتابا بالمغرب خلال سنة 2019 أغلبها بالعربية

الإثراء غير المشروع يجمع أحزاب الأغلبية لحسم موقفها

الملك يطلق برنامجا للتنمية الحضرية بأكادير بقيمة 6 ملايير درهم

أوراش تتسبب في إهدار المياه و5 ملايير سنتيم لترشيد الاستهلاك بالبيضاء

الملك محمد السادس يطلق برنامجا للتنمية الحضرية لأكادير بـ 6 ملايير درهم

سنة سجنا نافذة لكل من العلمي مدير CDG السابق وغنام مدير CGI

مغاربة يتزعمون شبكة سلاح

مجلس جطو يرصد اختلالات المواعيد الطبية

محمد أمكراز.. الوزارة أطلقت دراسة ستساعد على إصلاح أنظمة التقاعد

مجلس الأمن يعقد اجتماعا الخميس مع كوشنر لبحث خطة السلام في الشرق الأوسط

نقابة أطباء تحذر من خصاص مهول لمواجهة فيروس كورونا

عمر هلال.. سنة 2020 ستكون مفصلية في مجال العمل من أجل المناخ

إطلاق برنامج انطلاقة لدعم وتمويل المقاولات بامتيازات غير مسبوقة

إحالة ملف باب دارنا على الجنايات

اعتقال سيدة بفاس بسبب فيديو كورونا

تفكيك خلية إرهابية وتوقيف 6 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

مجلس جطو يفضح اختلالات الحسابات المالية للأحزاب السياسية

تاريخ.. محامون مغاربة جمعوا بين الوزارة وصداقة الحسن الثاني

الأساتذة المتعاقدون يعلنون عن خوض احتجاجات لأربعة أيام متتالية خلال شهر فبراير الجاري

نزار بركة.. النموذج التنموي الجديد مطالب بإيلاء الأهمية لمطالب الشباب

وسط استياء المغاربة.. العثماني يشيد بالساعة الإضافية وبانجازات حكومته

وفاة معتقل احتياطي بالمستشفى بعد إصابته برصاص الشرطة

5 ملايين درهم لقياس مستويات التلوث بالبيضاء وغياب محطات لمراقبة الهواء يسائل مجلس المدينة

ملف.. هكذا وقع سياسيون ورياضيون وفنانون وإعلاميون ضحايا لأخطاء طبية

29 كيلو من المخدرات في حقائب فرنسيتين بمطار مراكش تتسبب في توقيفهما

مديرية الأوبئة تكشف الحالة الصحية للمغاربة العائدين من ووهان الصينية

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 360

تغريدة للعثماني حول فلسطين تثير الجدل

مخدرات تورط جمركيين وأمنيين

تلاعبات في مشروع ملكي بتطوان

تفاصيل وصول طائرة تقل 167 مغربيا مقيما بووهان الصينية

إجراءات جديدة للطلبة الراغبين في الحصول على فيزا شينغن

الخلفي يتعرض للطرد من قبل ساكنة حي التقدم بالرباط (فيديو)

تأجيل الزيارة العائلية للطلبة العائدين من ووهان الصينية لهذا السبب

خاص.. هكذا فشلت وزارة الصحة في معالجة مشاكل القطاع بالشمال

تركي ومغربي ينصبان على شركات في 3 ملايير

هكذا يستبق البيجيدي القضاء للتأثير على ملف عمدة مراكش ونائبه

تزوير صفقة بـ7 ملايير يهز وزارة الصحة

البسيج يطيح بعصابة متخصصة في تنظيم الهجرة السرية

انخفاض عدد حوادث السير المميتة بنسبة 1.83 بالمائة خلال سنة 2019

دراسة.. المغرب يمكن أن يصبح رائدا تكنولوجيا بإفريقيا في صناعة السيارات

وزارة الصحة: الخطة الوطنية للرصد والتصدي تبقى متلائمة مع الوضعية

21 دولة تشارك في الدورة الثالثة لجائزة المغرب الكبرى الدولية والبطولة العربية لرماية أسلحة الخرطوش

صندوق الحسن الثاني يساهم ب 2 مليار درهم لفائدة المقاولات بالعالم القروي

توقيف موظف أمن متلبسا بتلقي رشوة

الملك يترأس حفل تقديم مساهمة بـ2 مليار درهم لتمويل المقاولات

بوريطة: مايزال اتفاق الصخيرات مرجعا مرنا بما فيه الكفاية لإخراج ليبيا من أزمتها

البرلمان يصادق على قانون يجبر الإدارة على تبسيط مساطرها بقوة القانون

فضائح عقارية تطارد عدولا وموثقين وسياسيين

اللجنة التحضيرية لمؤتمر البام تعلن أسماء المرشحين لسباق الأمانة العامة

متابعة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبدد واختلاس أموال عمومية

بسبب كورونا لارام تعلّق رحلاتها نحو بكين مؤقتا

صفقة القرن تخرج منظمات حقوقية للاحتجاج أمام قنصلية أمريكا بالبيضاء

مخزون هائل من الغاز بالمغرب يفوق التوقعات

متابعة رئيس بلدية شيشاوة بالتزوير والاختلاس

نزيل مختل عقليا يقتل زميله خنقا بخيرية عين عتيق بتمارة

توزيع 150 هاتفا على الدواوير ولا وجود لأي عزلة بالمناطق الثلجية

تقرير الأنشطة الفلاحية يضع المملكة في طليعة الدول المغاربية 2020

مجلس جطو.. خدمات النقل الحضري المقدمة للمغاربة متدنية

وزارة الصحة .. لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب وما يروج له مجرد إشاعات

الكوت ديفوار تعتزم فتح قنصلية عامة لها بالعيون

جطو : المغاربة يدفعون سنويا 100 مليار للأولى ودوزيم دون طائل

أمن مراكش يجهض عملية لتهريب 380 كيلوغراما من المخدرات

صراعات البام تستعر قبيل المؤتمر الوطني

برلماني يزور شيكا بـ 480 مليون وينتهي في السجن

أمراض وهمية بمستشفى خاص بالبيضاء

الملك يصدر عفوا استثنائيا عن 201 سجينا إفريقيا

توقيف شخص متورط في تزوير وثائق الحصول على الفيزا

اتهامات لرئيس مجلس بلدي بالابتزاز والفرقة الوطنية تدخل على الخط

تقاعد المغاربة في كف عفريت وجطو يقرع ناقوس الخطر

تدارس مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التلوث الذي تتسبب فيه السفن بالسواحل المغربية

نظام وطني جديد سيتم الاعتماد عليه لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

الهدر الجامعي يكلف الملايير والدولة تضمن مجانية الباكالوريوس

جطو ينتقد تأخر الحكومة في إنقاذ أنظمة التقاعد من إفلاس وشيك

إحالة عمدة مراكش ونائبة و70 مقاولا على محكمة جرائم الأموال

جيش الاحتلال يقمع مسيرة منددة بصفقة القرن شمال بيت لحم

الحموشي يستقبل نظيره الموريتاني رفقة وفد رفيع المستوى

الفساد يستنزف 50 مليار درهم سنويا

نصاب القريعة يمثل أمام القضاء وعشرات الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية
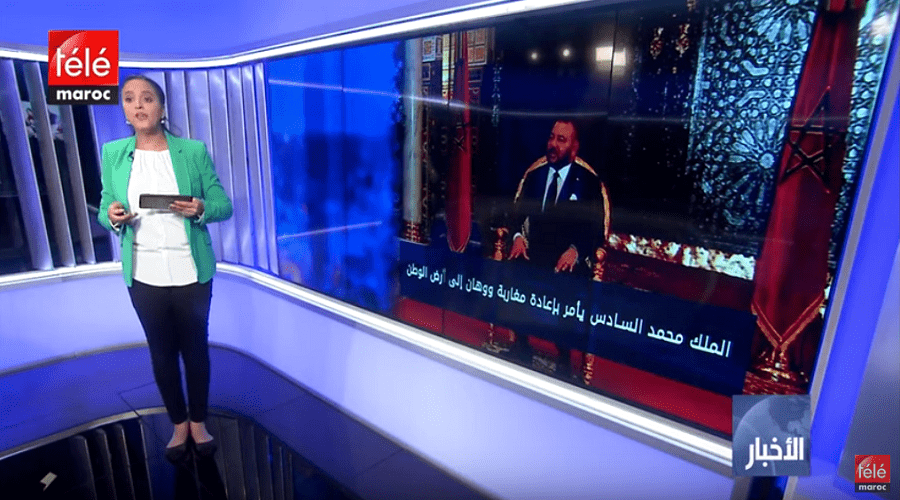
الملك يصدر توجيهاته بإجلاء المواطنين المغاربة من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا

الحموشي يتخذ قرارات وتعيينات جديدة داخل المديرية العامة للأمن الوطني

تركيا تعلن ترحيل 4 دواعش فرنسيين إلى بلدهم

خنازير تهاجم أحياء راقية بالرباط

البحرية الملكية تحبط عمليتين كبيرتين لتهريب المخدرات

المتعاقدون يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع

العثماني .. المغرب أصبح سنة بعد أخرى أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية

بنك المغرب يتخذ سلسلة من التدابير لتنفيذ التوجيهات الملكية لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل

الملك يترأس حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به

أحكام جديدة في قضية سمسار الأحكام القضائية

البحرية الملكية تحبط عمليتين كبيرتين لتهريب المخدرات

الملك يترأس حفل توقيع اتفاقيات لدعم وتمويل المقاولات

الملك يأمر بإعادة 100 مغربي عالق في الصين بسبب فيروس كورونا

تفاصيل إدانة لصوص ساعات القصر بقرن و26 سنة سجنا

تنسيق نقابي بالتعليم يدعو لإضراب وطني ويحشد لمسيرة أساتذة التعاقد

وفاة المصممة كاميليا المراكشي...الرواية الأخرى

تتبّع تنفيذ مشاريع مؤسسات التكوين المهني الممولة من قبل صندوق شراكة

انتشار فيروس كورونا يضع المملكة أمام تحديات المراقبة الوبائية

الملك يهنئ رئيس جمهورية الهند بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

احتقان في صفوف المهنيين بعد تعثر إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة بمجازر البيضاء

تاريخ.. اختفاء أغراض الملوك وهكذا تعامل القصر مع الذين حاولوا سرقته

التحقيق مع شرطي وشريكه بتهمة التزوير

أزمة النقل تشتد بالقنيطرة

أمن مراكش يطيح بـ 300 مرشد سياحي مزور

الداخلية تحقق في ملف العلب الليلية ومقاهي الشيشة بطنجة

السجن لممرضات بسبب حقنة قاتلة

كورونا يستنفر المطارات والموانئ المغربية والصحة توصي المغاربة بالنظافة

توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون

إتلاف أزيد من17 ألف طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 2019

لحبابي : نرفض بيع الأدوية للعموم بالمصحات الخاصة وعيادات البيطرة

وزارة الصحة تعلن اتخاذ تدابير التشخيص لمواجهة فيروس كورونا القاتل

وزيرة الخارجية الاسبانية تؤكد على جودة العلاقات المغربية الاسبانية
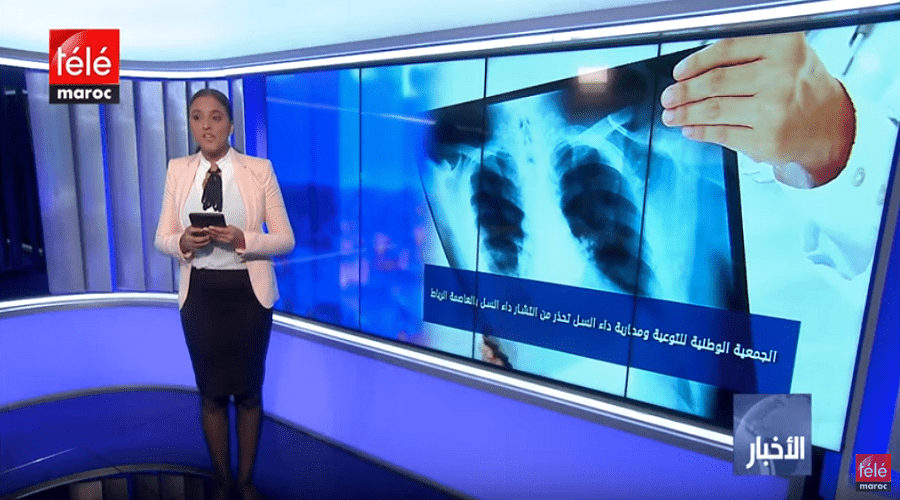
تحذيرات بعد وفاة 61 في المائة من المصابين بداء السل بين 2016 و2018

صندوق الإيداع والتدبير يشخص وضع الاستثمار الوطني وتأثيره في انخفاض نسبة النمو

وزارة الصحة : لم يتم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب
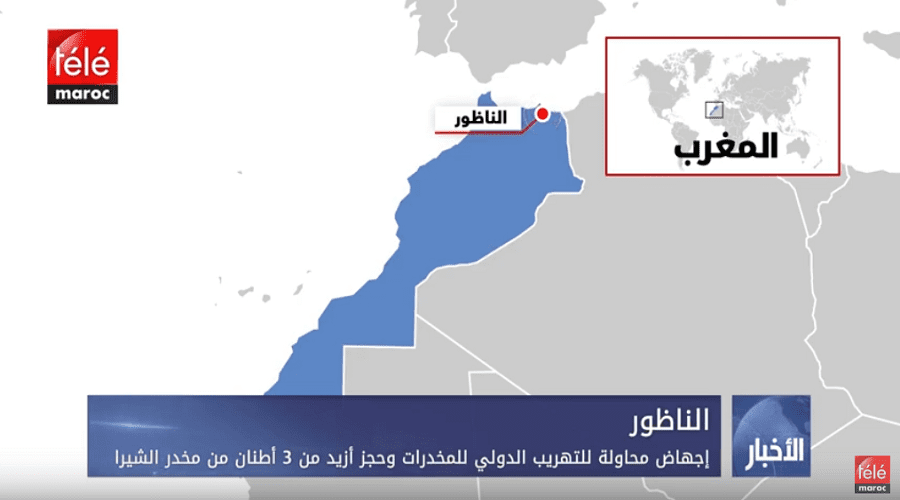
إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا

غياب النواب عن الجلسات يعطل عمل الغرفة الأولى والمالكي يبحث عن حلول

الحكومة تمرر قوانين مهنة القبالة والتمريض

الدار البيضاء سطات أول جهة تلجأ لاقتراض 100 مليون دولار لتمويل مشاريع للبنيات التحتية

مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض أمن المواطنين لتهديد جدي

الملك يهنئ السيدة ايكاتيريني ساكيلا روبولو بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية اليونان

الحكومة تفرج عن قانوني الممرضين والقابلات بعد سنوات من الفراغ

بوريطة ينتقد بيانات الخارجية الجزائرية وهكذا رد على تصريحات تبون

هذه تعليمات سفارة المغرب ببكين لمغاربة الصين بخصوص الفيروس القاتل

تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد خلال 2019

أكواب وأواني بلاستيكية مصنوعة في الهند تهدد حياة المستهلكين المغاربة

فشل تزويد المقاطعات والبنايات الإدارية بألواح شمسية بالدار البيضاء

لحظة توقيف مجرم هاجم أصحاب محلات تجارية في سلا

المغرب الأغلى مغاربيا في كلفة العيش في 2020

أونسا يعلن إتلاف 17 ألفا و641 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة

بمساعدة الديستي.. أمن الناظور يجهض تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات

صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وأكباس تدق ناقوس الخطر

عاصفة غلوريا تواصل ضرب إسبانيا وعدد القتلى يرتفع إلى 10

شرطي يطلق النار على شخص هدد سلامة المواطنين بسلا

شكيب لعلج يخلف مزوار على رأس الباطرونا بعد حصوله على أزيد من 96 في المائة من الأصوات

انقطاع أدوية لعلاج أمراض نفسية وعقلية يفاقم معاناة المرضى

مجلس النواب يقر قانونا جديدا لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب

محاكم المغرب تسجل رقما قياسيا في عدد القضايا والشكايات المسجلة

المصادقة على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية

حاويات أزبال متكسرة وتراكم نفايات في أحياء عدة يسائل منتخبي الرباط

خاص.. هكذا فشلت حكومة العثماني في خلق بديل للتهريب بالشمال

سيارات إسعاف خاصة في الرباط تستغل عائلات المرضى وتقدم خدماتها بأسعار خيالية

رصد 24 مليون درهم لتجهيز حدائق البيضاء بشبكات للري الأوتوماتيكي والتعثر يلازم المشروع

بسبب الفيروس القاتل.. السلطات الصينية تعزل 11 مليون مواطن

فارس: تعقّد المساطر القانونية يؤثر على منسوب الثقة ويعطل المصالح

الملك يستقبل أسقف الرباط الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو

عبد النباوي يدعو لمحاربة الفساد والإصغاء لانشغالات المواطنين

اعترافات القابض الجهوي للضرائب المتهم باختلاس 4 ملايير

توقيف رئيس جماعة متلبسا بتسلم مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية

الجواهري يدعو الى مراجعة الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني

حوالي 7 ملايين امرأة مغربية تم تعنيفها والعثماني يؤكد أن قانون محاربة العنف ضد النساء متقدم

تشديد الإجراءات الحكومية للحد من خطر المباني الآيلة للسقوط يدخل حيز التنفيذ

صندوق التقاعد يرفع من الإعفاء على معاشات المتقاعدين ليصل 60 في المائة

طلبات الزواج بقاصرات تناهز 32 ألف حالة.. والقرى تتصدر

المغاربة ثاني جالية مصرح بها في إسبانيا برقم فاق 268 ألفا

العاصفة غلوريا مستمرة في ضرب إسبانيا وتصل فرنسا

صفقة تسلح جديدة بين المغرب وأمريكا

قراصنة البطائق البنكية في قبضة الأمن

توقيف رئيس جماعة ينتمي إلى البام متلبسا بتلقي رشوة

غموض حول انفاق البرلمان لـ700 مليار في عشر سنوات

ميلشيات البوليساريو في الكركرات

صفقة لقاحات تسيل لعاب شركات الأدوية

وزارة الأوقاف تهاجم محرضي الأئمة على الاحتجاج

القضاء يقرر الحجز على ممتلكات أعضاء مجلس إدارة لاسامير

برلمانيون يقترحون اعتماد "طبيب الأسرة" لتقليص الاكتظاظ في المستشفيات المغربية

مجلس النواب يعقد جلسة الأربعاء لإقرار ترسيم الحدود البحرية للمغرب

مرضى السرطان يحتاجون إلى تغطية صحية شاملة وليس لمجانية العلاج

مندوبية التخطيط ترصد تشاؤم أسر مغربية وتتوقع استمرار التدهور

منتدى كرانس مونتانا يعلن انعقاده في مارس حول إفريقيا والتعاون جنوب جنوب

غياب الأمصال ضد لدغات الحيوانات المسعورة يقلق ساكنة الرباط

قرض بقيمة 100 مليار سنتيم لمد الخط الثالث والرابع من ترامواي البي

خطير...برنامج تجسس خبيث يسرق صور ومعطيات هواتف المغاربة

توقيف عشرينية اختطفت رضيعة بالدار البيضاء

اعتقال زعيم شبكة كوكايين الهرهورة بالإمارات ونقله إلى المغرب

المستشار الملكي أندري أزولاي يتعرض لحادث سير

ملف... القنص في حياة ملوك المغرب ولقاءاتهم مع قادة العالم في مناطق الصيد

تحذيرات من ارتفاع نسبة الملح في الخبز في 80 مخبزة بالدار البيضاء
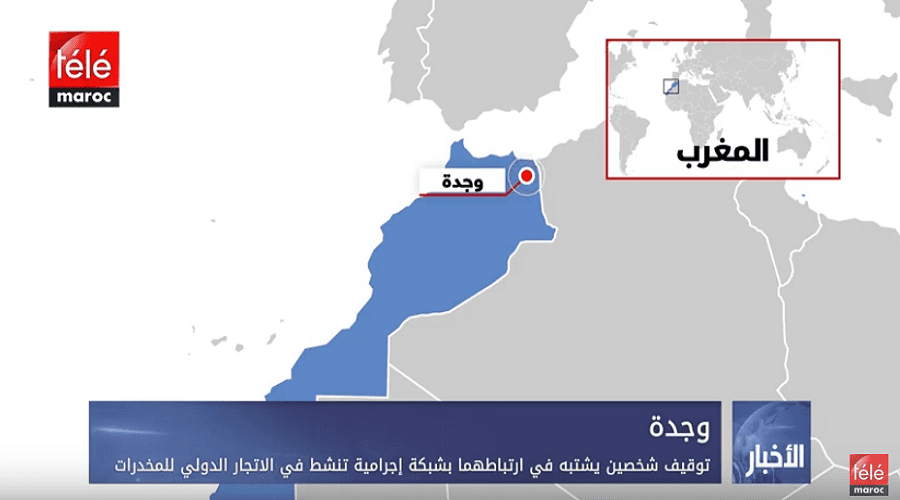
إحالة أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في الاحتيال المالي وقرصنة بطاقات الأداء وانتحال هوية الغير

ثلاثة ملايين سائح زاروا مراكش خلال سنة 2019

أساتذة التعاقد يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية

قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة

تاريخ .. هكذا تم تأسيس الطيران المغربي

وزير الشغل أمكزاز يتعرض لحادث سير

ضحايا باب دارنا يكشفون كيف تم النصب عليهم في 70 مليارا

إحالة 4 متورطين في قرصنة بطاقات الأداء على النيابة العامة

قاضي جرائم الأموال يفتح ملف التزوير بالأراضي السلالية

الرميد يكذب أسطورة إفلاس بنكيران ورغبته في سياقة طاكسي

التلاعب بملفات الكفالات المالية يجر موظفين للتحقيق

الرصاص لإيقاف مبحوث عنه تسبب في مصرع دركي

هكذا يخطط البيجيدي للسيطرة على تعاضدية الموظفين

أمن أكادير يجهض تهريب أزيد من طنين من المخدرات ويعتقل 3 أشخاص

بوريطة : تصريحات الانفصاليين بخصوص رالي أفريكا مثيرة للشفقة

6 سنوات سجنا لقائد ومصادرة مليار و600 مليون من أمواله

غينيا تفتح قنصلية عامة لها بالداخلة

تحذير.. رياح قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق من المملكة

اختفاء لوحات فنية ثمينة أهداها الملك الراحل الحسن الثاني للبرلمان

الملك يسلم جائزة محمد السادس للمتفوقين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد

قانون جديد لاستعمال المبيدات الزراعية والسجن في انتظار المخالفين

اتهامات بالسطو على عقارات الغير تلاحق وزارة التجهيز

تسريب معطيات خاصة يستنفر وزارة التربية

90 شكاية ضد حكومة العثماني

اعتقال عصابة لصوص القصر

الملك يدشن سد مولاي عبد الرحمان بالصويرة الذي سيوفر المياه لربع مليون شخص

توقيف داعشي مغربي بإسبانيا

تخفيض عقوبة التلميذ حمزة من 4 سنوات إلى 8 أشهر

أعمال شغب بعد مباراة طنجة والرجاء والأمن يوقف 13 شخصا

ضباط مغاربة يطورون مشروعا لتحصين الدبابات والمدرعات

الملك يزور الصويرة ويتفقد ورش تأهيل المدينة العتيقة ويفتتح بها بيت الحكمة

ثمانون في المائة من زيت الزيتون الذي يستهلكه المغاربة لا يخضع للمراقبة الصحية

أمزازي يأذن بطبع مقررات الموسم الدراسي المقبل تفاديا للخصاص

بنك المغرب..انخفاض نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية من 6,1 في المائة إلى 5,2 في المائة

دكاترة الوظيفة العمومية يسارعون الزمن للضغط على رئيس الحكومة

الحكومة ترفع من قيمة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية بالقطاع الخاص

التوفيق يكشف عدد المساجد بالمملكة ونحو 200 مسجد يغلق كل سنة للترميم

مندوبية التخطيط تتوقع تراجعا طفيفا لمعدل الدين العمومي في 2020

روائح الأزبال تزكم أنوف الجديديين

عقوبات مشددة لصانعي الميكا

رئيس جماعة يستغل شاحنة البلدية لخدمة مصالح شركته الخاصة (فيديو)

عمارة: لا وجود حاليا لمقالع استخراج رمال الشواطئ وكل التراخيص انتهت صلاحيتها سنة 2018

المصادقة بالإجماع على قانون تبسيط المساطر الإدارية

الأغلبية البرلمانية تؤيد تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع

أولر هيرمس..خطر الإفلاس يستمر في تهديد آلاف المقاولات المغربية سنة 2020

مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الإقتراض الخارجي

صندوق النقد العربي..تقرير ينبه المملكة إلى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية

التقصير يجر الأطباء إلى القضاء

القضاة غاضبون من الحكومة

إغلاق مجازر بالبيضاء يخرج مهنيين للاحتجاج

جدل الساعة الإضافية يعود إلى الواجهة من جديد وسط صمت حكومي

الدار البيضاء..جزّارون ينتفضون ضد إغلاق المذابح بالبيضاء ويحذرون من تشريد مئات المهنيين

تعثر في إنجاز ممرات جديدة للراجلين وقلتها تعمق إشكاليات البيضاويين

المكفوفون ينتفضون في وجه الحكومة ويراسلون الأمم المتحدة بخصوص المباراة الموحدة

الدار البيضاء..تواصل أزمة النقل و"ألزا" تشرع في تشغيل 400 حافلة مستعملة مطلع فبراير المقبل

أموال الإنعاش الوطني بعيدة عن اعين مجلس الحسابات

المتحول جنسيا صوفيا طالوني يعترف بمتاجرته في الفيزات

هل اقتربت نهاية الساعة الإضافية ؟

هكذا ارتكب رباح مجزرة بيئية بالقنيطرة

قطاع الصحة..صيادلة المغرب يدعون لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط يوم 10 فبراير

قطاع الصحة ..68% من المغاربة يستفيدون من التغطية الصحة وآيت الطالب يشدد على ضرورة تجويد الحكامة

مراكش..الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ينفي إطلاق سراح متهم ضبط بتلقي رشوة

الملك يترأس حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027

عبد الوافي لفتيت:إنجاز جرد شامل لتحديد حاجيات المستقبل من الماء في أفق 2027

عزيز أخنوش:أزيد من 22 مليار درهم خصصت لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية منذ 2017

مولاي حفيظ العلمي:نخسر 2 مليار دولار سنويا في علاقتنا التجارية مع تركيا

وضع الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة تارودانت تحت تدابير الحراسة النظرية

شبكة للاتجار بالبشر تجني مليون يورو من ضحايا مغاربة

الملك يترأس توقيع الاتفاقية الإطار للتزويد بالماء باستثمارات تفوق 115 مليار درهم

الأغلبية البرلمانية تؤيد تقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع
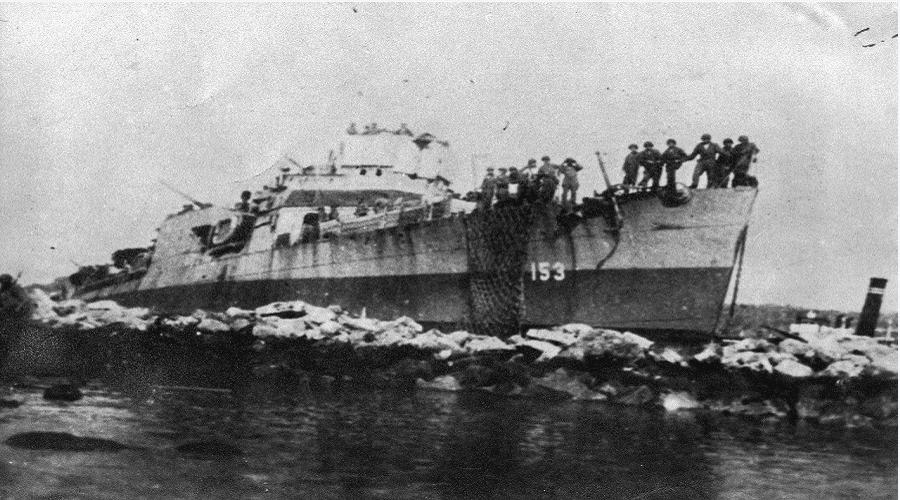
تاريخ... عندما طلبت أمريكا من المغرب حماية سفنها من القراصنة

أطباء الأسنان ينتفضون ضد تهميش وإقصاء وزارة الصحة

الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى إسقاط مخطط التعاقد

انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ46 في المائة

تراجع احتياجات البنوك من السيولة إلى 64,1 مليار درهم خلال الشهر الماضي

هجرة الأطباء تكلف اقتصاد المغرب خسائر بالمليارات

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في تقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

اعتقال دركيين وملياردير ضمن شبكة للترويج الدولي للمخدرات

شكاية جديدة توسع دائرة المتهمين في فضيحة باب دارنا

لمياء شابة من المحمدية اختارت مهنة غسل السيارات لمواجهة البطالة

الباييس..إسبانيا تمكنت من خفض الهجرة السرية بأكثر من النصف بفضل التعاون مع المغرب

الدار البيضاء..أرباب المطاعم والمقاهي يستنكرون قرار إغلاق محلاتهم قبل منتصف الليل

تعديلات فرق الأغلبية تشدد العقوبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين

نزار بركة:المغرب يعرف انتشار ظاهرة توريث الفقر الجيلي

المغرب يترأس اجتماعا للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بالقواعد والمعايير

المغاربة في صدارة الأجانب المقيمين بإسبانيا وأعداد الإسبان في انخفاض

حادثة هيجان ثور وإرساله شخصا للمستعجلات تعجل بمطلب ترحيل مجزرة الرباط

أطباء الأسنان بالقطاع الحر يخوضون إضراباً وطنياً الأسبوع المقبل

سعيد أمزازي:بدء اعتماد نظام البكالوريوس من أربع سنوات جامعية في شتنبر المقبل

سعد الدين العثماني:قانون الإطار للتعليم نقلة نوعية ببلادنا

برقية تهنئة من الملك إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور بمناسبة توليه مقاليد الحكم

برقية تعزية من الملك إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الصحراء المغربية..الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالسماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة بالكركرات

تزنيت...حزب التجمع الوطني للأحرار ينظم الدورة الثانية لأزافوروم احتفالاً برأس السنة الأمازيغية

مجلس جطو..أغلب ما يستهلكه المغاربة لا يخضع للمراقبة الصحية والبيطرية

العثماني يؤكد رفض أي إساءة لمؤسسات الوطن ورموزه

هل تخطط الحكومة لإغلاق باب سبتة بصفة نهائية ؟

السجن لشابين تخصصا في السطو على أموال الأغنياء ورجال الأعمال

ختلاس محجوزات الجمارك يستنفر أمن تطوان

أحكام نهائية ضد الدولة بقيمة 3.68 مليار درهم في 2018

وزارة التجهيز والنقل..إحداث الحكومة لرسوم شبه ضريبية جديدة والزيادة في قيمتها أخبار غير صحيحة

تأخر آجال الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات بالمغرب

البنك الدولي..أداء الاقتصاد المغربي يبقى جيداً مقارنة بدول الجوار

الساعة الإضافية تواصل إثارة سخط المغاربة والحكومة خارج التغطية

أمواج عاتية تتسبب في مد بحري قوي يلفظ أحجارا تهدد المواطنين ومطالب بتسييج الكورنيش

نقابة "العدالة والتنمية" تدعو أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج وتتهم أمزازي بالتماطل في تسوية أوضاعهم

وزارة المالية..منح تعويضات للمواطنين في حالة تعرضهم لأضرار ناجمة عن كوارث طبيعية

بوريطة يتباحث بالرباط مع وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية

إيفانكا ترامب تهنئ المغرب على تعزيز حقوق النساء في الأرض

العثماني يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتوفير حاجيات الماء الشروب

توقف مؤقت لحركة السير بين الجديدة والدارالبيضاء

الملك يصدر عفوه عن 265 شخصا بينهم محكومات في قضايا الإرهاب

عبد النباوي يدعو إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام

أمريكية تغادر أرض الوطن بعد نشرها فيديوهات إباحية لمغربية متزوجة

كنوبس..منح استفادة مجانية مدى الحياة للأبناء المعاقين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

الحكومة المغربية تجدد رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

أكثر من 70 في المائة من المغاربة يرون أن تكاليف المعيشة مرتفعة

إحداث ثلاث مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء سطات بغلاف مالي يناهز 127 مليون دولار

الولايات المتحدة..بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب قريبا إلى مجلس الشيوخ

الشروع في محاكمة ولد الفشوش المتهم بقتل دركي الهرهورة

المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المقيمين في إسبانيا بشكل قانوني

البنك الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 3.5 في المائة في 2020

إطلاق خطة العمل الوطنية للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2020-2021

أمزازي:إحداث نظام البكالوريوس من شأنه الاستجابة لانتظارات المجتمع وسوق الشغل

اختفاء هبة ملكية من مستشفى للأمراض العقلية بمراكش

أزمة صامته بين البيجيدي والتوحيد والاصلاح

هكذا وضعت طائرات بوينغ لارام في ورطة

توقيف 6 متورطين في شبكة للهجرة السرية والاتجار في البشر

الملك يهنئ بيدرو سانشيز بمناسبة نيله ثقة البرلمان الجديد كرئيس للحكومة الإسبانية

وزارة الإقتصاد توضح بعد اتهامات باختلالات مباراة توظيف ذوي الإعاقة

أبناك تلزم زبائنها بتبادل المعطيات مع السلطات الإدارية والقضائية

المصادقة على مشروع قانون لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

هيئات تطالب بالحفاظ على استقلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

المغرب رئيسا للمرة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد

اليابان..وزيرة العدل تشن هجوما حادا على غصن وتقول ان هروبه قد يمثل جريمة

قرارات الإغلاق تستنفر أصحاب مقاهي الشيشة بطنجة

اختفاء أزيد من 300 ألف علبة من دواء الغدة الدرقية

شاشة تفاعلية..السعودية تسمح بمنح تأشيرات السياحة لحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا وشنغن

أخنوش يؤكد على أولوية الشغل والصحة والتعليم في بناء النموذج التنموي الجديد

شركة نقل المدينة بالبيضاء خلفت وراءها ديونا فاقت 46 مليار سنتيم

تدني مستوى مداخيل المغاربة يدفعهم للجوء إلى الاقتراض من العائلة

سبعة وأربعون في المائة من الطلبة يمضون أكثر من 5 سنوات بالجامعة ويغادرونها بدون شهادة

المصادقة على مشروع قانون لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تفاصيل إدانة 4 كولونيلات و 15 مسؤولا دركيا بالسجن

الأحكام القضائية تكلف خزينة الدولة أزيد من 700 مليار

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بترسيم أساتذة التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية

مراكش..انطلاق الكونغرس العالمي للتربية بمراكش والملك يوجه رسالة إلى ألف مشارك

الوافي تعد برقمنة الخدمات الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج

المملكة المغربية تعرب عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا وترفض أي تدخل أجنبي بالملف

محمد أمكراز:وزارة الشغل انتشلت 776 طفلا من الأشغال الخطيرة

16 قتيلاً و1914 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

الملك يترأس جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي

خريبكة..مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض سلامة عناصر الشرطة للتهديد

شرطي يستخدم سلاحه لتوقيف شخص هدد سلامة المواطنين

السجن لـ 4 كولونيلات بالدرك الملكي

البرلمان بناقش تقرير للجنة الاستطلاعية حول القنصليات

سعد الدين العثماني:الفساد يعيق التنمية ومحاصرتهُ ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني

الوكالة القضائية للمملكة..الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 25 مليون درهم من الأموال المختلسَة

خردة الحافلات الاوربية تصل البيضاء

رئيس محاربة الرشوة يحذر من خطورة تغول الفساد وتدني منسوب ثِقة المواطنين في المؤسسات

مراكش..غياب الأدوية بصيدلية المركز الاستشفائي يهدد حياة مرضى السرطان

اتفاقيات..موانئ المغرب تتحول نحو الطاقات المتجددة النظيفة

الداخلية والتعمير تشددان مساطر رخص البناء والترميم

الملك يطلق برنامجا بـ 115 مليار درهم

الزبائن يشتكون غياب إطار قانوني ينظم التخفيضات الموسمية

غياب المعدات يراكم جبلا من النفايات في شوارع البيضاء

فصل التلاميذ المكررين..الوزارة تتجه لمراجعة عدد السنوات التي تسمح بالتكرار
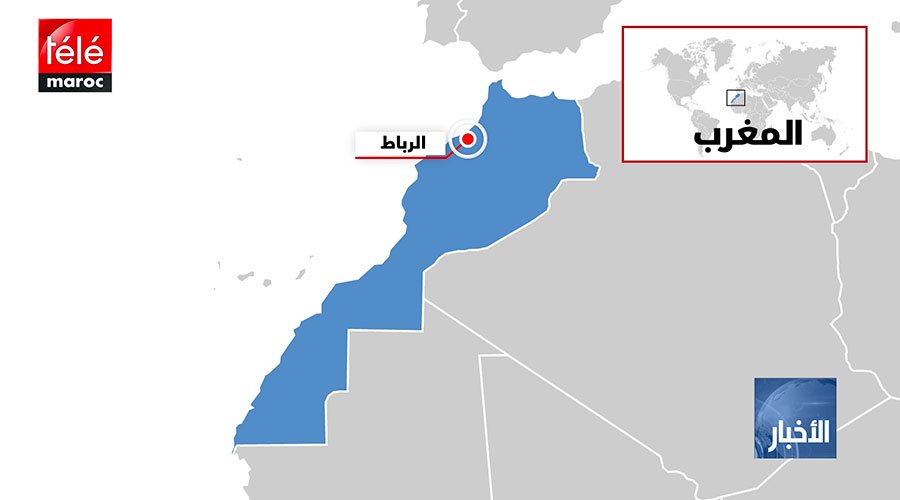
الرباط..مباحثات مغربية-أمريكية حول الممارسات الفضلى في مجال محاربة الجريمة

المصلي:عدد الأطفال حديثي الولادة المتخلى عنهم لا يتجاوز 360 طفلا خلال سنة 2018

مذكرة اعتقال في حق زوجة كارلوس غصن

عشرات القتلى في جنازة قاسم سليماني بإيران

الحبس لزوجة الشرطي الإسباني التي صفعت جمركيا مغربيا بباب سبتة

مجلس النواب يدقق في أرباح الأبناك

وصف حافلات البيضاء بالخردة وتساؤل عن مصير عمال شركة نقل المدينة

الحكومة تشرع في تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري

الإندماج المحلي يواجه تطورات قطاع صناعة السيارات في المملكة

توقعات بتحقيق الإقتصاد الوطني نسبة نمو 3.3 في المئة

جهة الرباط..رصد 129 مليون درهم لبناء وتجهيز 16 مؤسسة تعليمية

إرتفاع بحوالي 23 في المئة في عدد السياح الوافدين على أكادير خلال نونبر 2019

السجن موقوف التنفيذ للكاتب العام السابق لوزارة الصحة

الكيف يتسبب في زوبعة داخل الحكومة

حجز ما يقارب 3 أطنان من المخدرات بطانطان

عزل رئيس بلدية بني ملال

طريق سيار جديد بين الرباط والبيضاء

البرلمان يحقق مع الأبناك

إطلاق النار بالشارع العام يستنفر أمن الناظور

اختلالات التعمير بالرباط على طاولة الوالي يعقوبي

ترامب يهدد بغداد بعقوبات بعد دعوة البرلمان لرحيل القوات الأمريكية

قطاع التعليم..تنسيقية الأساتذة غير المجازين تصعد ضد أمزازي

قطاع الصحة..هيئة الدواء الأمريكية تعتمد عقارا لعلاج سرطان البنكرياس

البدء في التحقيق في الإتهامات الموجهة للقطاع البنكي

المحكمة تغلق الحدود في وجه دنيا بطمة وشقيقتها وترفع الكفالة إلى 80 مليون

تاريخ... وثائق سرية لـCIA تكشف صداقات وعداوات السياسيين مع القصر

تجاهل صفقة إحداث مراحيض متنقلة والقوارض تجتاح الممرات تحت أرضية التاريخية

موظفة تنصب على رجال أعمال ومقاولين في الملايير

المندوبية السامية للتخطيط..غالبية المهاجرين المغاربة شباب ومتزوجون

المكفوفون يشككون في نتائج المباراة الموحدة ويهددون بالنزول إلى الشارع من جديد

117 حالة زواج قاصر تسجل كل يوم في المغرب

نزهة بوشارب:التوقيع على قرار اجتماعي يخول لموظفي الوكالات الحضرية الاستفادة من التقاعد التكميلي

وزارة التربية الوطنية تسعى إلى الحصول على دعم أمريكي لإصلاح التعليم العالي

دونالد ترامب..الولايات المتحدة ستستهدف 52 موقعا إيرانيا إذا استهدفت إيران أمريكيين

نزار بركة : حكومة العثماني ظلت وفية لسياساتها التي أبانت عن عقمها

الهيئة الوطنية للنزاهة..لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة

فرنسا..آلاف المحتجين الفرنسيين يتظاهرون للمطالبة بسحب مشروع أنظمة التقاعد

كنوبس..الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي يجبر المصحات على مراجعة أسعار الخدمات الطبية

الدار البيضاء..ARTEM Gallery رواق فني جديد يعرض قطعا فنية شاهدة على تاريخ المغرب

آسفي... توقيف شخص في حالة تخدير للاشتباه في تورطه في محاولة الإعتداء على موظفي الشرطة
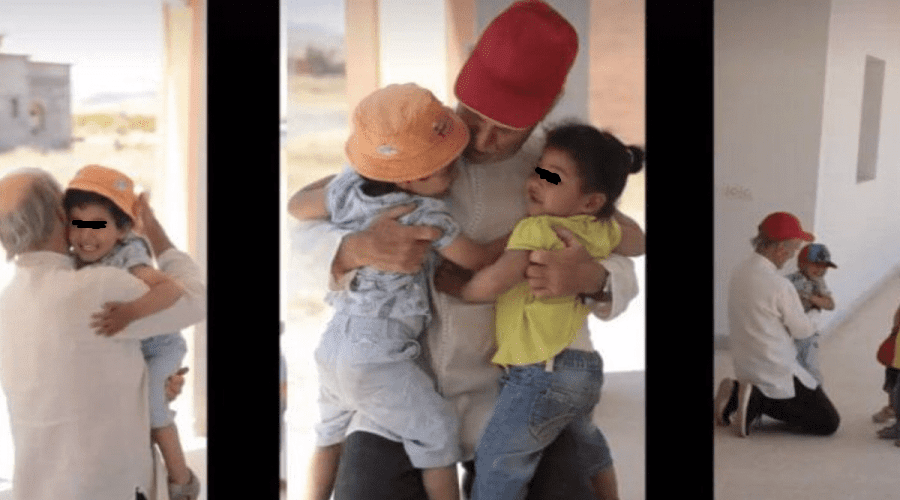
درس بليغ للأثرياء المغاربة ... سويسري يتبرع بنصف ثروته لأطفال مغاربة متخلى عنهم
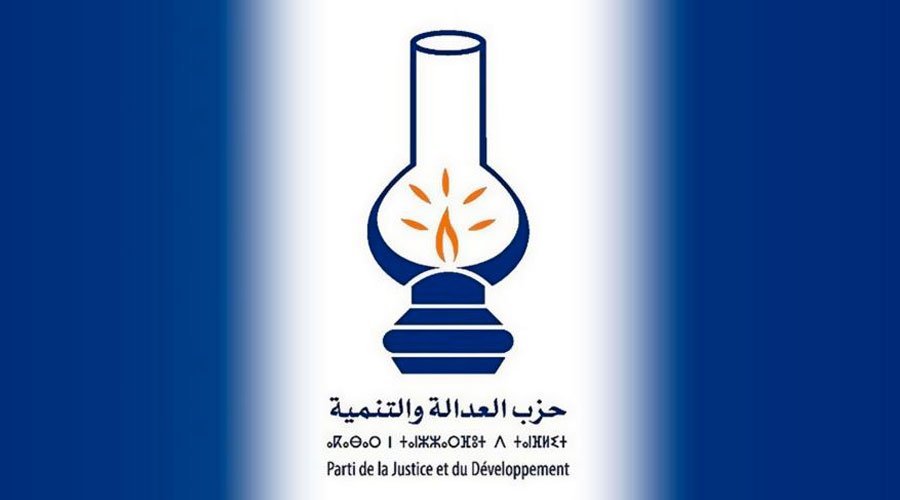
حرب داخلية بالبيجيدي تكشف استغلال المناصب في الربح والريع

ظهور تيارات جديدة يفاقم أزمة البام

وزارة التربية الوطنية تقدم للنقابات أجوبتها حول الملفات العالقة وتتجاهل أزمة المتعاقدين

جمعية تنتقد غياب الشروط الموضوعية للعاملين في مجال الإسعاف

الملك يهنئ رئيس جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

قانون مالية 2020..رئيس الحكومة يتجاهل الإنتقادات ويدافع عن المادة 9

العثماني يصف الزيادة التي منحتها الحكومة للموظفين بغير المسبوقة

تسويق الغاز الطبيعي..ساوند إنيرجي تواصل مفاوضاتها مع المغرب لبيع غاز تندرارة

عزيز أخنوش: مهرجان ربيع تاملالت قيمة مضافة للتنمية الترابية

رئيس الحكومة يوقع مرسوما يقر رسوما للوقاية من الحوادث

حريق البوناني يضع مقاهي الشيشة بطنجة تحت المجهر

هذه المنتجات ستعرف تغييرات في التعريفة الجمركية مع بداية السنة

هكذا حجز محام على الحساب البنكي لمجلس إقليمي

إيداع صاحب مقهى فاجعة البوناني بطنجة السجن

أطباء الأسنان بالقطاع الحر يخوضون إضرابا وطنيا ويتشبثون بمطالبهم مع تنظيم وقفة "الإصرار"
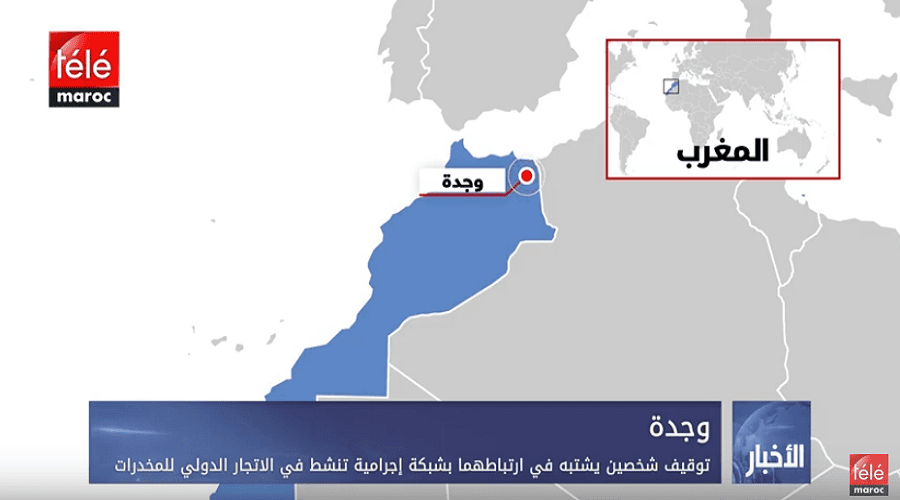
توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات

رئيس الحكومة يوقع مرسوما يقر رسوما للوقاية من الحوادث

العثماني يكشف خلفيات قرار إعفاء المقاولات من الغرامات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي

كنوبس يحذر المصحات الخاصة من التلاعب بالفواتير

مطالب بتوسيع حملة تحرير الملك العمومي لتشكل التجار الكبار والصغار على حد سواء

الحكومة تعيد الساعة الإضافية إلى طاولة النقاش

مستشار حول مراحيض عمومية إلى مطعم بشاطئ الهرهورة

شركة طيران تركية تكشف كيف هرب كارلوس غصن من اليابان

بحث يسجل نية ربع المغاربة في الهجرة والشرق يتصدر القائمة

متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 48.7 يوما

أكاديمية التربية تعد بتعميم التعليم الأولي في البيضاء قبل 2025

أحزاب تقدم تصوراتها بخصوص النموذج التنموي الجديد

استئناف العمل ببرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة لسنتين إضافيتين

نقابة تتهم وزارة الصحة بالكذب على مرضى الغدة الدرقية

الملك يهنىء أومارو سيسوكو إمبالو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غينيا بيساو

دراسة.. ربع المغاربة يرغبون في الهجرة إلى الخارج

سكان جهة الدار البيضاء ينتجون أكثر من ثلث النفايات بالمغرب

السطو على سيارة شاب مغربي يضع العثماني في ورطة

الفرصة الأخيرة تنتظر المغاربة للتصريح بممتلكاتهم خارج البلاد

رغم انتهاء الأشغال .. فضاءات بسياجات حديدية تعيق ولوج البيضاويين

المتعاقدون يتوعدون حكومة العثماني ببداية سنة على وقع الإضرابات

الممرضون ينتفضون ضد آيت الطالب ويبدؤون العام الجديد بإضراب وطني

الداخلية تجر 30 رئيس جماعة للمحاكمة

الداخلية تحمّل رباح مسؤولية أزمة النقل الحضري بالقنيطرة

هكذا أطاح تنسيق أمني مغربي إيفواري بنائب مدير شركة باب دارنا

تسجيل ارتفاع طفيف للنمو الإقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019

حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334.95 مليار درهم في الفصل الثالث من 2019

الفرصة الأخيرة تنتظر المغاربة للتصريح

مع بداية 2020..ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب

عمليات استباقية وتدابير مشددة.. هكذا استنفر الحموشي رجاله لتأمين احتفالات رأس السنة

حملة اعتقالات وفتح تحقيق في تركيا بسبب هروب غصن

التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تكوين جهاز سري

وزارة الصناعة..إطلاق طلب عروض لتهيئة وتطوير 3 مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء
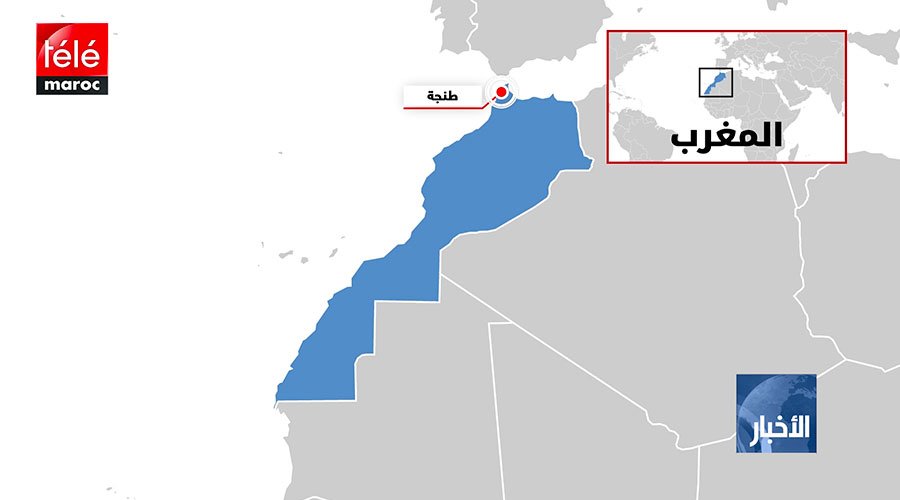
طنجة..مصرع شخصين في حريق بأحد مقاهي طنجة

استئناف الحوار بين وزارة التعليم والنقابات والاستعداد لمناقشة قضية التحقيق مع المتعاقدين

تقرير..المغرب يحتل المرتبة 60 كأقوى اقتصاد من بین 193 دولة في العالم

أرقام صادمة عن الهدر المدرسي.. وأكبر حركة إعفاءات وتنقيل في يناير

الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية هايتي بالعيد الوطني لبلاده

عدد التعاونيات الفلاحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ارتفع إلى 1300 تعاونية خلال السنوات العشر الأخيرة

تقرير رسمي يعترف بتغول الفساد في المجتمع المغربي أمام جهود الإصلاح

بلاغ..وزارة الصحة تضع "بصفة ظرفية واستثنائية" رقماً هاتفياً أخضر رهن إشارة مرضى الغدة الدرقية

انخفاض صادرات السيارات المصنعة بالمغرب

الحجز على كلينيك بعد تورط صاحبه في السطو على عقارات

مجلس الشامي يقترح تخصيص 3 في المائة من الناتج المحلي للبحث العلمي

اختفاء 5 ملايير درهم من صندوق الطرق

بعد توقفه لسنتين.. الداخلية تعلن استئناف دعم تجديد الطاكسيات

وزارة المالية..رصد 198 مليار درهم للاستثمار العمومي

الدار البيضاء..المصالح الأمنية تنجح في تأمين احتفالات رأس السنة

أكادير..المصادقة على 9 مشاريع استثمارية بقيمة مالية تصل حوالي 629 مليون درهم

خالد آيت طالب: الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة مهول ويلزمنا أكثر من 20 سنة لسده

نور الدين بوطيب: وضعية الجريمة عادية والأمن يستجيب لشكايات المغاربة

احتفالات رأس السنة..تعزيزات أمنية مكثفة ليلة رأس السنة لتأمين الإحتفالات بالرباط
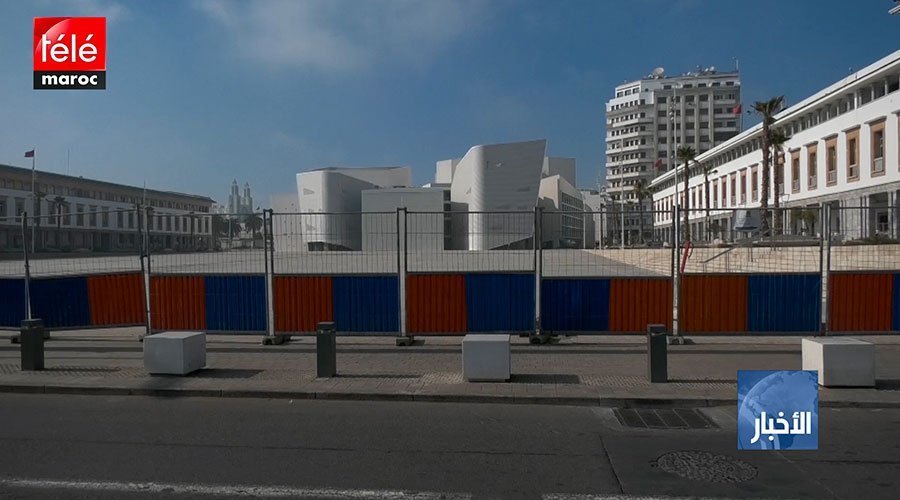
تأخر في تسليم المسرح الكبير بالدار البيضاء وتعثر في إيجاد شركة تدبره

تقرير ..زيادة معاشات المتقاعدين تعجل بعجز صندوق الضمان الإجتماعي

عدد مستعملي ومشتركي الهاتف بالمغرب أكثر من عدد السكان

حكومة العثماني تحتجز مشروع ترقيم المغاربة

المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي تسرب مياه عادمة من السجنين المحليين العرجات 1 و2

تعزيزات أمنية مكثفة بالدار البيضاء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية

صراعات صديقي والمعارضة تشل مجلس الرباط

حرب بين أصحاب سيارات الأجرة وحافلات الميني بيس بالقنيطرة

تفاصيل إسقاط عصابة روعت تمارة

هذه الهواتف ممنوعة من واتساب مع بداية 2020
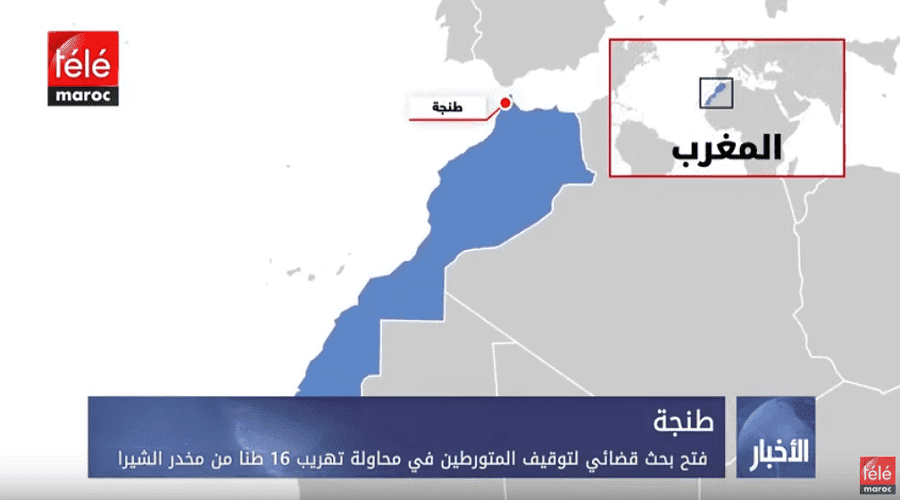
فتح بحث قضائي لتوقيف المتورطين في محاولة تهريب 16 طنا من مخدر الشيرا

بنك المغرب .. البنوك استطاعت أن تحافظ على مردوديتها

إطلاق منصة دولية لدعم الصحراء المغربية والدفاع عنها

العثماني .. المغرب ينتج سيارة كل دقيقة ونصف الدقيقة تقريبا

العثماني يؤكد أن الحكومة وفت بأغلب التزاماتها

عمر الراضي يغادر سجن عكاشة بعد استفادته من السراح المؤقت

العثماني يحث الموظفين على قبول زيادة 400 درهم في الأجور

لمحاربة العنف ضد النساء.. الحكومة تستعين بالمساجد عبر24 ألف خطبة

ديون الشركات والأسر تسجل ارتفاعا في 2019

ترقية أزيد من 7400 شرطي من مختلف الرتب برسم السنة المالية 2019

تنسيقية التعاقد تتهم وزارة أمزازي بسرقة الأجور وتعلن عن إضراب وطني جديد

اقتراح تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد

هذا رأي دبلوماسيين عرب في إدريس البصري

تاريخ.. ما حقيقة الصداقة التي جمعت بين بنبركة وأوفقير؟

إيداع بطمة السجن بعد متابعتها في قضية حمزة مون بيبي

الصحراء المغربية..منصة دولية لدعم الصحراء المغربية والدفاع عنها

البنيات التحتية أهم إنجاز حققه المغرب برأي 62% من المغاربة

مجلس النواب..مقترح قانون جديد بالبرلمان للرفع من إجازة الولادة للموظفات

مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر بشأن الإستغلال المفرط للموارد المائية بالمغرب

العثماني ينهي التوظيف الوطني بالقطاعات الحكومية ويعوضه بالجهوية

قطاع التعليم..ارتفاع مهول في صفوف التلاميذ المغاربة المغادرين لكراسي الدراسة

تقرير يتوقع تحسّن تغطية الإحتياجات الغذائية للمغاربة سنة 2025

70 مليون درهما لنقل باعة متجولين صوب أسواق نموذجية والحصيلة تسائل مجلس البيضاء

المكتب الوطني للسكك الحديدية..استلام أول قاطرة كهربائية من الجيل الجديد لتعزيز الأسطول السككي

الحموشي يجتمع بمسؤولي جهاز الاستخبارات

مقترح قانون يروم ملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا

مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر بشأن الاستغلال المفرط للموارد المائية
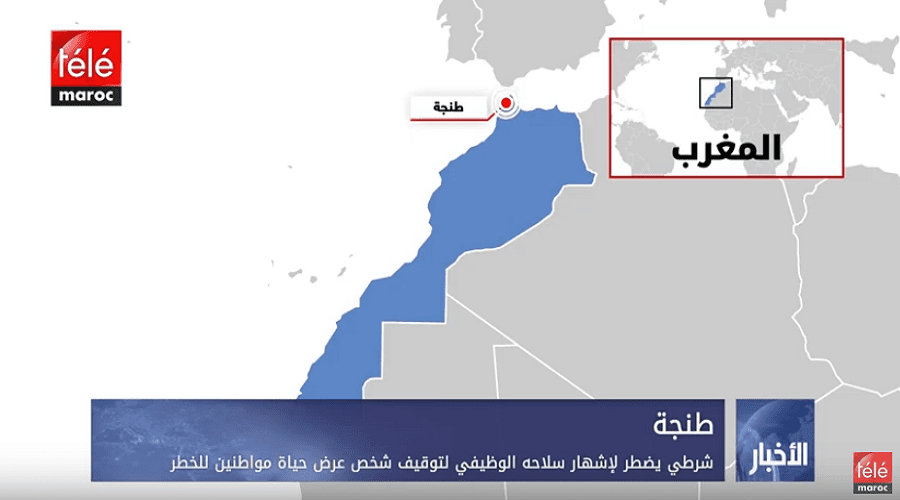
شرطي يضطر لإشهار سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

سوق الجملة بمراكش يحقق مداخيل قياسية خلال 2019

رئيس الحكومة ينهي التوظيف الوطني بالقطاعات الحكومية ويعوضه بالجهوية

وزارة التربية الوطنية تدعو النقابات لاستئناف الحوار

الأيام الثقافية الإسلامية ال39 تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس

تأجيل تعديلات القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام

بوشارب تدعو إلى تشجيع السكن المندمج بالعالم القروي لوقف الهجرة

النساخ القضائيون يشلون المحاكم

انفراد.. هذه تفاصيل السياسة الجنائية الجديدة

الداخلية تطوي صفحة الاحتقان بالجماعات المحلية

سنوات قليلة تفصل الصندوق المغربي للتقاعد على الإفلاس

اختلالات بسلك الدكتوراه تستنفر مجلس الحسابات

89 سنة سجنا لمتهمين خططوا لاختطاف سياح أجانب

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية

ارتفاع صادرات الأدوية المغربية إلى ما يزيد عن 1.6 مليار درهم

أمكراز يؤكد على ضرورة تشجيع التشغيل الذاتي بالنضر للإمكانيات التي يقدمها المجال

الأمن فعال في رأي 43 ٪ من المغاربة والتعليم والصحة أقل فعالية

مجلس رسمي يدعو إلى جيل جديد من الخدمات العمومية
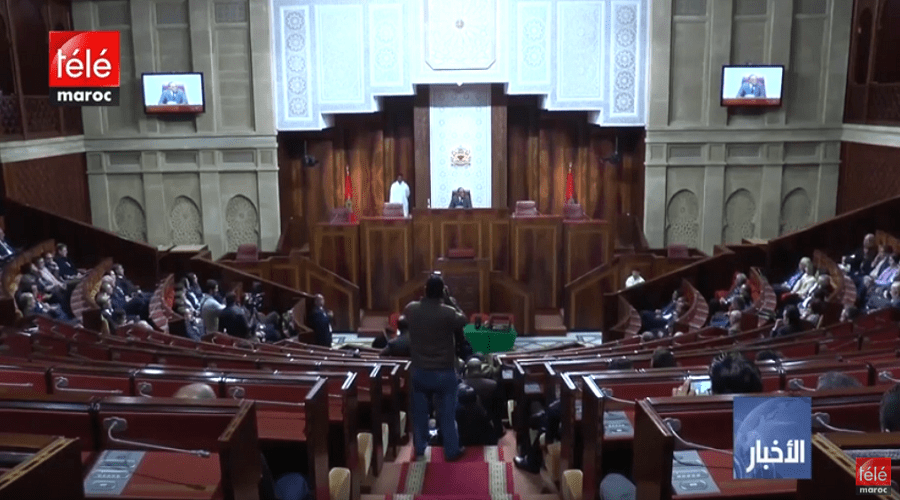
غياب الفرق البرلمانية يؤجل مناقشة تقرير النيابة العامة حول السياسات الجنائية

مديرية الحموشي تقدم حصيلة عملها لسنة 2019 وتطلعاتها لسنة 2020

سطو نافذين على عقارات تابعة لأملاك الدولة والأمن يدخل على الخط

تهميش بنايات تاريخية يسائل برامج التهيئة الحضرية والتراث العمراني بالبيضاء

توقيف شخص ظهر في فيديو وهو يحرّض التلاميذ على تعنيف الأساتذة

إدارية الرباط تغرم إدارة الدفاع 15 مليون في قضية حياة

بعد اعتقاله بمراكش.. المغرب يسلم زعيم مافيا إلى إيطاليا

أمن القنيطرة يطيح بـ 3 متورطين في الهجرة السرية والاتجار بالبشر

العثماني ..نواكب إصلاح التعليم عن كثب وسيكون جيدا ومنصفا بعد 3 سنوات

وزارة الصحة تعلن التكفل المجاني بعلاج الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالسرطان

تقرير الوسيط يقتفي أثر تظلمات المغاربة من الإدارات العمومية

توقيف ثمانية طلبة للاشتباه في تورطهم في الإعداد والتحضير لارتكاب أفعال إجرامية

تحقيقات في قضايا للنصب بملايير السنتيمات بقطاع العقار

بنك المغرب يحذر من سرقة معلومات البطائق البنكية بالسكيمنغ

تعثر في مشروع إحداث مكتبات بحدائق الدار البيضاء

غياب ممرات الراجلين في الشوارع أمام مدارس يهدد حياة التلاميذ بالرباط

مديرية الحموشي تحذّر بنك المغرب من تعرض مواطنين للنصب

مشاريع سكنية وهمية تجر الوزيرة بوشارب إلى المساءلة

هذا ما قضت به المحكمة بحق المتورطين في قضية تجنيس الإسرائليين

متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة أحد القضاة

بعد تخصيص صديقي الملايين لمحاربتها.. الجرذان تقض مضجع الرباطيين

منع والي جهة سابق من السفر للخارج

هذا سر تواجد مدمرات أمريكية بشمال المغرب

بعد فضيحة "باب دارنا" ...ضحايا النصب العقاري يخرجون للعلن

سلطات البيضاء تعلن الحرب على محلات الشعوذة

رشوة 12 مليونا تورط جنودا

سرقة بيانات البطائق البنكية تستنفر الأمن وبنك المغرب

أربع سنوات سجنا لمول الكاسكيطة وغرامة 40 ألف درهم

إحالة الصحافي الراضي على النيابة العامة لهذا السبب

سكان سابقون بدوار الكرعى بالرباط بدون مأوى بعد هدم بيوتهم القصديرية

صندوق الضمان الإجتماعي..الرفع من نسبة تعويض الأدوية الجنيسة إلى 90 في المائة

المندوبية السامية للتخطيط.. أغلبية التجار يتوقعون استقرار سوق الجملة بالمملكة

العثماني:المغرب يخصص 383 مليار درهم لمواجهة العطش خلال العقود الثلاثة المقبلة

أزمة النقل تلهب جيوب القنيطريين ومطالب بمحاسبة الرباح

هذه حصيلة مديرية الحموشي لسنة 2019 وآفاق عملها لسنة 2020

إصابة سجين بالتهاب السحايا.. مندوبية السجون توضح

النقاط الرئيسية لاتفاق الداخلية ونقابات الجماعات الترابية

5 ملايين درهم لتحويل العاصمة الإقتصادية لمدينة ذكية وشوارع لا تعكس ذلك

تقرير..المغرب يتصدر خمسة بلدان في تصنيف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

برلمانيون يطالبون بتشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في اختلالات السكن الإقتصادي

نزهة الوافي:المغرب يعمل على تحديد هويات القاصرين المغاربة بالدول الأوروبية

النموذج التنموي..نقابيون يطالبون لجنة بنموسى بمحاربة الريع في نموذج التنمية

بنشعبون:آلية التمويل التعاوني تغري المغرب بمصادر بديلة للمشاريع المبتكرة

هذه تفاصيل الزيادة في معاشات التقاعد

أمن البيضاء يوقف شخصا ظهر في فيديو وهو يهدد ويتحرش بسيدة

ضريبة القمح في مجلس الحكومة

مساعدات مالية استثنائية لرجال الأمن

الحكومة عاجزة عن توفير أدوية ومطالب بالكشف عن مصير 250 مليارا

الأمن الهولندي ينوه بالحموشي

تعويض طالبة بـ 40 مليون بعد اتهامها بالغش

أحمد التوفيق: 15 مسجد لكل 5 آلاف مواطن بالقرى مقابل 4 لنظرائهم بالمدن

وزارة الاقتصاد والمالية ..موظفو الوزارة سيستفيدون من امتيازات غير مسبوقة

الحكومة تخطط للزيادة في أسعار الدواء وتعد بتغيير شامل للقوانين المتعلقة به

المديرية العامة للأمن الوطني..الرادارات مكنت من تسجيل أزيد من مليوني مخالفة مرورية في 2019

أزمة العقار بالمغرب..تراجع الطلب على اقتناء السكن وخسائر فادحة للمنعشين

السجن لرئيس بلدية سابق بتهمة تبديد أموال عمومية

هكذا تخطط حكومة العثماني للزيادة في أسعار الدواء

تصاميم البناء المزورة تستنفر وزارتي الداخلية والسكنى

بلاغ..الإعلان عن إنشاء قطب فندقي وطني يروم تعزيز التميز في الخدمات الفندقية الراقية بالمغرب
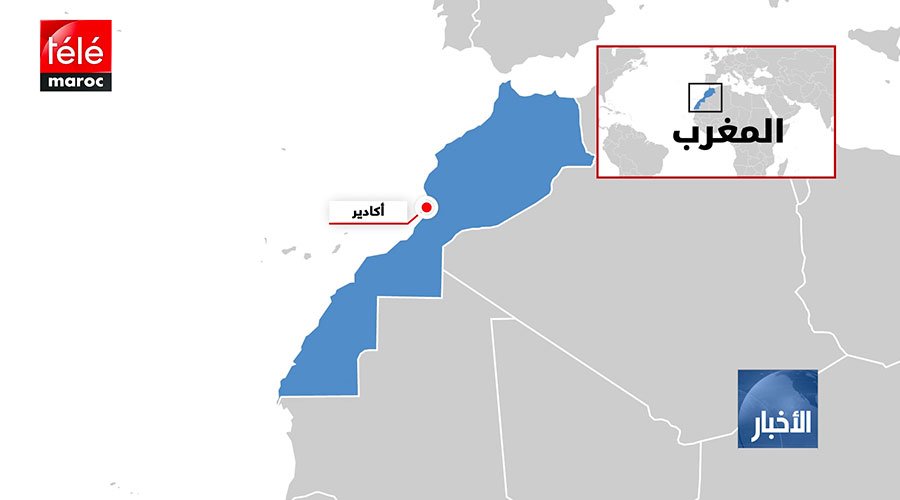
أكادير..حجز طن و770 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة موصولة بمقطورة للتبريد

الحكومة تعجز عن توفير أدوية مرض السرطان إلى يناير 2020

مبلغ الأموال الإحتياطية للضمان الإجتماعي بصندوق الإيداع والتدبير ارتفع إلى 53 مليار درهم

ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء..الرباح: 85 في المئة من المغاربة لا يتجاوزون الشطر الأول والثاني

شاشة تفاعلية..نصف الطرق في وضعية كارثية و500 قنطرة مهددة بالإنهيار بالمغرب

المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية مول الكاسكيطة

اختلاس وتبديد أموال عمومية يورط مدير بنك و9 متهمين

النصب في مشروع عقاري بـ100 مليار في أصيلة

الديستي تقود حملة توقيفات واسعة لمنتسبين للسلفية الجهادية

حجز طن و770 كيلوغراما من المخدرات على متن شاحنة بأكادير

مجلس النواب يؤجل المصادقة على ترسيم الحدود الإقليمية البحرية

عدد تلاميذ التعليم الخاص يتضاعف خمس مرات والأساتذة بدون تكوين

إحداث أزيد من 341 ألف منصب شغل في القطاع الخاص المهيكل خلال سنتي 2017 و2018

في نهاية 2019.. جامعة التعليم تطالب الحكومة بحل الملفات العالقة

رئيس الحكومة: التحول الرقمي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية

تواجد مراقبين اثنين تابعين للمينورسو في المؤتمر المزعوم للبوليساريو لايعكس أي موقف سياسي

غياب وزراء عن جلسات مجلس النواب يثير غضب فرق المعارضة والأغلبية

الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي

ما حقيقة زيادة الحكومة في فواتير الماء والكهرباء لإنقاذ دوزيم ؟

أرشيف بلدية القنيطرة وسط القمامة

سيارات فارهة مشبوهة تورّط مسؤولين

عدد تلاميذ التعليم الخاص بالمغرب يتضاعف 5 مرات

مخلفات البناء تورط مجلس البيضاء وشركات تشتكي ارتفاع سومة تفريغ النفايات الهامدة

اتفاقيات..فرنسا توقع مع المغرب إعلان نوايا تتعهد بموجبه بدعم تعميم التعليم وتطويره

المديرية العامة للأمن الوطني.. أكثر من نصف مليون مغربي أمام العادلة في حصيلة الأمن لعام 2019

وزيرالصحة: نقص الموارد البشرية خاصة في العالم القروي من أكبر تحديات قطاع الصحة

الخطوط الملكية المغربية..إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وبكين في 16 يناير القادم

مجلس النواب..قانون جديد يمهد كسر البيروقراطية بإدارات المملكة

"القتل الرحيم" يثير الجدل بالبرلمان

جمعية حماية المال العام تدخل على خط ملف القناة الثانية

تاريخ.. هكذا استغلت فرنسا مغربيات جنسيا خلال الحرب العالمية الثانية

أزيد من 745 ألف تدخل أمني ناجع في الشارع خلال 2019

غياب الوزراء يفجر جلسة برلمانية والرميد يفقد أعصابه

السجن لشرطي سابق هو المتهم الرئيسي في قضية كوكايين الهرهورة

سجناء تزوجوا من معتقلات وزائرات ونزيلات خرجن من السجن فوق العمارية

الاستعداد لمناقشة مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب تزامنا مع ما بات يعرف بفضيحة باب دارنا

مجلس النواب..قانون جديد يمهد كسر البيروقراطية بإدارات المملكة

صحة ..هيئة الدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الثدي الإيجابي

احصائيات أوروبية..أكثر من 362 ألف مغربي قدموا طلباتهم على فيزا شنغن إلى فرنسا

أزمة نقل حادة بالقنيطرة ورباح يعترف بالفشل

مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء

قناطر تهدد سلامة البيضاويين ومضايقات جراء تعطل الأشغال

مرضى السرطان من دون دواء وصيادلة المغرب يحملون المسؤولية لوزارة الصحة

نقابيون يطالبون مصلي بالتدخل وفتح تحقيق حول خروقات بالمؤسسة

مذكرة طعن حول عدم دستورية المادة 9 من قانون مالية 2020

العثماني :الحكومة تواصل دعم التعليم العمومي وترفع ميزانيته ب32 في المائة

خريبكة ..كمين يوقع مبحوثا عنه في قبضة الدركيين

مطالب لوزارة الصحة بالتحقيق في إصابة طبيبتين وممرضة بالسل

أعمال شغب بعد ديربي البيضاء والأمن يعتقل العشرات

جمعية تدق ناقوس الخطر بعد تسجيل 3 إصابات بالسل في مشفى بالرباط

المركز المغربي لحقوق الإنسان..مذكرة طعن حول عدم دستورية المادة 9 من قانون مالية 2020

نسبة ملء السدود تبعث على التفاؤل في الموسم الفلاحي

أمكراز..اسبانيا تتعهد بتوفير تكوينات قصيرة الأمد لعاملات الفراولة المغربيات

لفتيت: تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بشكل دوري كل سنتين

حريق مهول بحي صفيحي يخلف خسائر جسيمة وإصابات بالقنيطرة

الانحراف النرجسي.. بين الضحية والمعتدي

عيوب تقنية تهدد بنايات بالقنيطرة بالانهيار

الجامعة الشتوية تناقش العيش المشترك بحضور 100 شاب من مغاربة العالم بإفران

البرلمان يحدد موعدا نهائيا لتقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي

البنوك تعتزم استقطاب المخالفين لتسوية ممتلكات المغاربة بالخارج

العثماني: قطاع التربية والتكوين "من أولوية الأولويات" بالنسبة للحكومة المغربية

تعليق الحوار يعيد احتجاجات النقابات التعليمية إلى شوارع المملكة

الممرضون وتقنيو الصحة والقابلات يطالبون بصرف مستحقات الحراسة
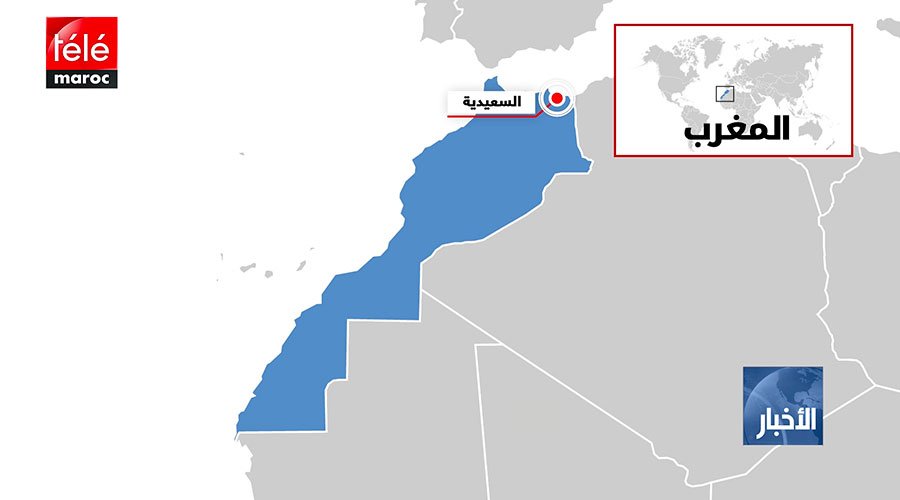
السعيدية..توقيف 5 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بمجال الاتجار الدولي في المخدرات

الملك: التطبيق الفعلي للجهوية رهين بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ

هذه تفاصيل اعتقال الراقي أشرف الحياني

نواب للجماعات السلالية يمكثون بمناصبهم منذ 30 سنة

قضية وفاة فرح وجنينها أمام استئنافية طنجة في هذا التاريخ

مستشارون يحذرون البيجيدي وسلطات الرباط من جريمة بيئية

مقترح قانون يهم وضعية المرضى في حالة غيبوبة دائمة بالمغرب
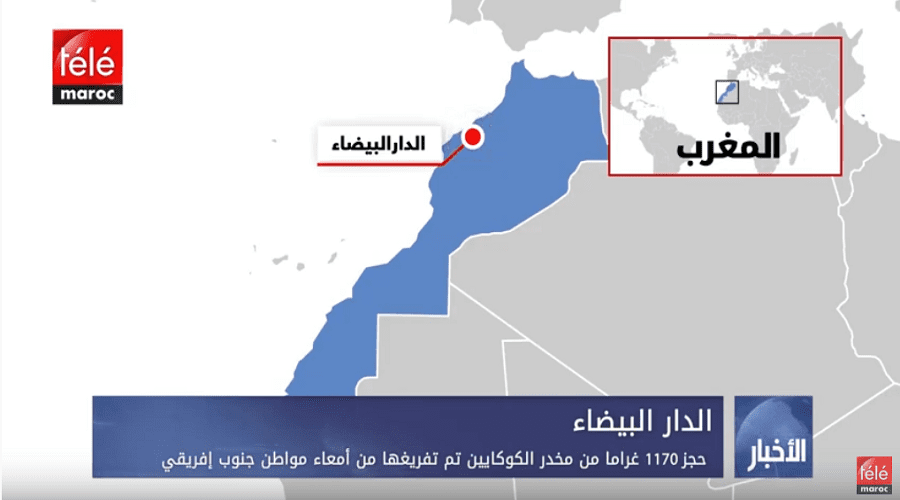
حجز 1170 من مخدر الكوكايين تم تفريغها من أمعاء مواطن جنوب إفريقيا

قانون جديد يفرض طلاء المباني المتقادمة ويضبط أوراش البناء

تعليق الحوار يعيد احتجاجات النقابات التعليمية إلى شوارع المملكة

بوريطة يجري سلسلة مباحثات مع نظرائه من موريتانيا وغينيا وغانا

قانون جديد يضبط أوراش البناء والحبس في انتظار المخالفين

تعليمات صارمة من أجل مواجهة أي خطر بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية

مجموع الاستثمارات بالقطاع الفلاحي بلغ 103 مليار درهم

اعمارة يعترف بفشل مشروع موله البنك الدولي بـ642 مليون درهم

الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وصل إلى الباب المسدود وتهديد بالتصعيد

تحديد هوية 6 متورطين في العنف والشغب الرياضي

تزوير تذاكر مباراة الرجاء والحسنية يطيح بـ8 أشخاص
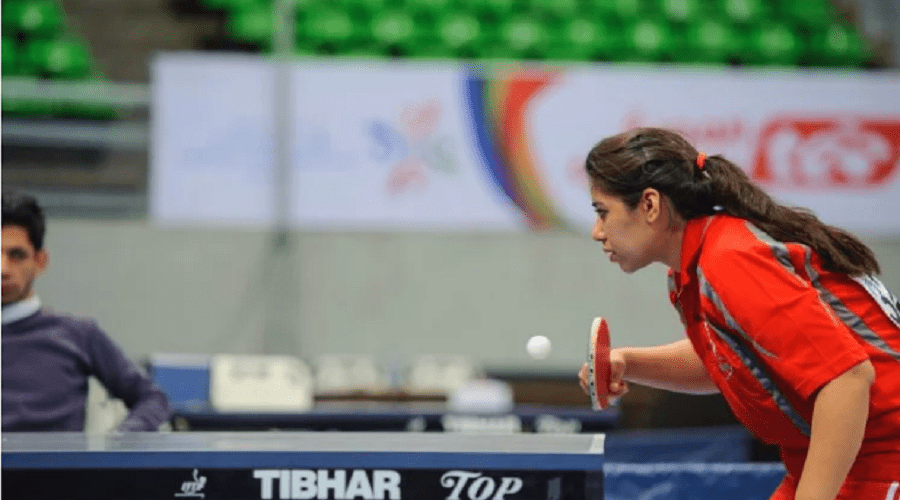
المغرب ينسحب من بطولة عالمية بالجزائر بعد المساس بوحدته الترابية

أصغر رئيسة وزراء في العالم تقترح تقليل أيام العمل إلى 4

ميني تسونامي يضرب الرباط والدار البيضاء وأمواج عاتية تهدد حياة المارين

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع انخفاض نشاط البناء في الفصل الأخير من 2019

فرنسا تمنح المغرب قرضا ب150 مليون أورو ومساعدة مالية ب9 ملايين أورو
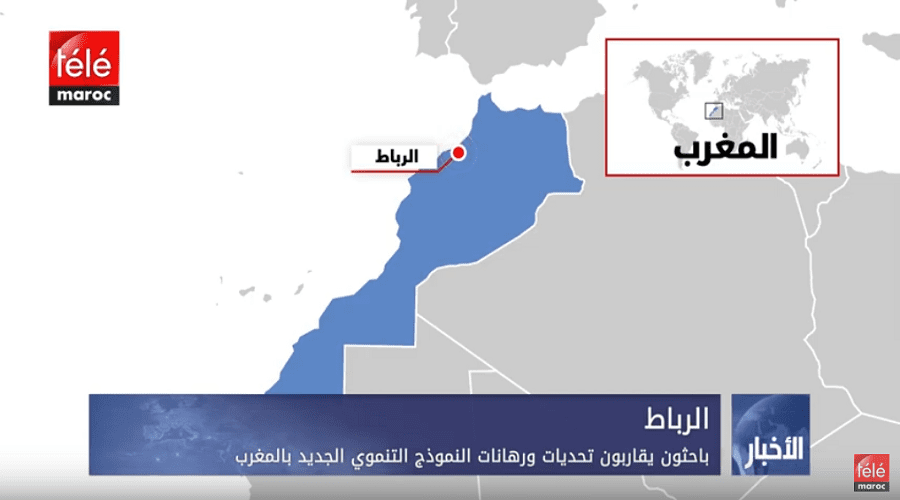
باحثون يقاربون تحديات ورهانات النموذج التنموي الجديد بالمغرب

فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب

غياب المساحات الخضراء يسائل جماعة الدار البيضاء حول نجاعة مشاريع بيئية

توصيات من رئاسة النيابة العامة لرفع مستوى التفتيش والمراقبة داخل المقاولات

بالصور.. افتتاح أشغال قمة الطلاب والشباب الأفارقة بالرباط

الملك : ورش الجهوية متعثر بسبب غياب سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ

تحذير.. رياح قوية من المستوى البرتقالي بهذه المناطق من المملكة

هكذا تتحايل مختبرات أشباح لاستيراد أدوية وإعادة بيعها

رئيسة مقاطعة الرياض تمضي ساعات في الجحيم أمام مجلس الحسابات

هكذا أطاحت الفرقة الوطنية بالمتهم الرئيسي في قضية كوكايين الهرهور

ضبط 26 مليون درهم بالعملة الصعبة في معبر باب سبتة

نقطة سوداء وسط الرباط.. عطب يصيب أعمدة إنارة ساحة عمومية حديثة التدشين

وزير الصحة: نقص الموارد البشرية و ضعف التنسيق تحديات تواجه مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمغرب

تقرير..المغاربة أنفقوا 42 مليار سنتيم على طلبات فيزا شنغن في السنة الماضية

الملك يهنئ بوريس جونسون بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة

فرنسا تحذر من استهلاك الباراسيتامول الأكثر استعمالا في المغرب من دون وصفة طبية

أمزازي يتعهد بضبط وتحديد رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة

الملك يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة عيد استقلال بلاده

التنسيق النقابي الخماسي يعبرعن رفضه تعليق الحوار من طرف وزارة التربية الوطنية

لجنة العدل بمجلس النواب..مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة تحول حقيقي في مسار القرارات الإدارية

الجواهري :عروض تنافسية للمصارف التشاركية تهدد النظام البنكي

تحذير .. أمواج خطيرة تضرب السواحل المغربية

السجن للمتابعين في قضية ضحية الهجرة السرية حياة
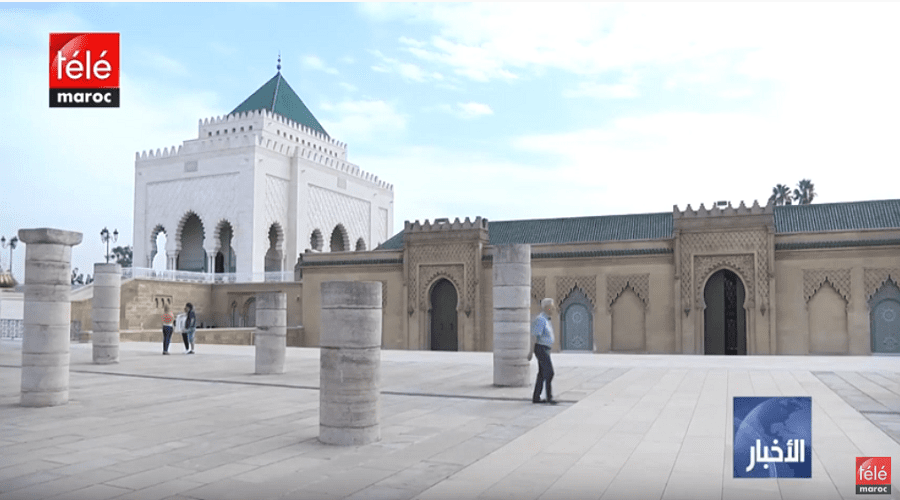
إدراج العاصمة الرباط ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي

37 في المائة من المغاربة يلجؤون للاقتراض من أجل تلقي العلاج

المصادقة على التدابير المتعلقة بدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة

مجلس النواب يكشف حقيقة حوار المالكي مع صحيفة إسرائيلية
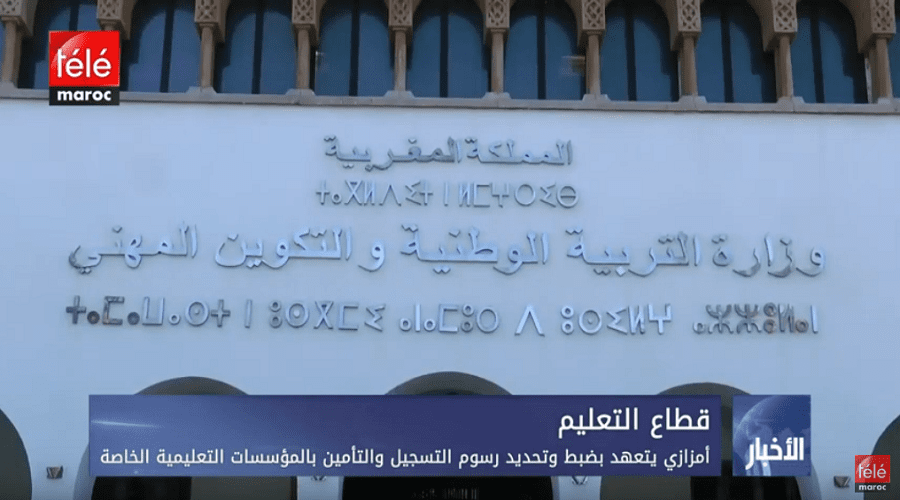
أمزازي يتعهد بضبط وتحديد رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات التعليمي

وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري

الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

إطلاق أسماء بحيرات مغربية على كوكب ونجم

أمزازي يتوعد المدارس الخصوصية بمراجعة أسعار التسجيل والدراسة

رئيس مجلس يقحم عاملا في فضيحة كورنيش

بعد اعتقاله بتطوان.. انتربول الرباط يسلم إسبانيا أخطر المجرمين

المؤبد لسائق تاكسي اغتصب أكثر من 100 امرأة

مجلس البيضاء يقر بانتهاء الأشغال في كورنيش العنق وتواصل الأشغال يطرح علامات استفهام
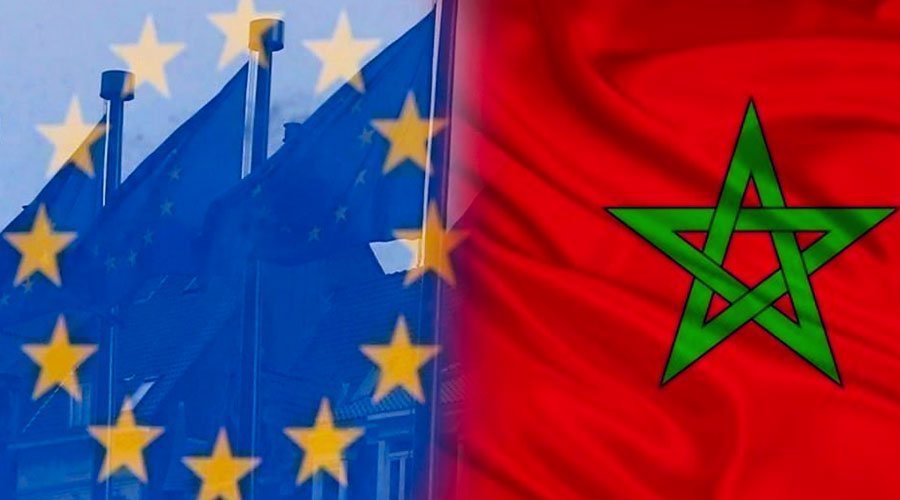
البنك الأوروبي للاستثمار يدعم المغرب ب400 مليون أورو

إعادة فتح جميع المقاطع الطرقية التي عرفت انقطاعا بفعل الثلوج

المندوبية السامية للتخطيط..انخفاض الإدخار الوطني بنسبة 1,3 في المئة سنة 2018

قانون المالية 2020 يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد نشره بالجريدة الرسمية

صندوق النقد الدولي يطلب تسريع الإصلاح الضريبي وضبط الأجور في المغرب

موظفو الجماعات المحلية يضربون ودعوات ضد مخطط إصلاح الوظيفة العمومية

بركان.. توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة

السجن لرئيس القسم الاقتصادي لولاية مراكش وتهم خطيرة تلاحقه

الداخلية تُطيح بـ 6 مستشارين من البام والبيجيدي بالحسيمة

امتحانات الشرطة.. رصد 96 حالة غش بينها 16 تتعلق بموظفين للشرطة

تباع في المغرب.. فرنسا تحظر بيع أدوية دون استشارة الطبيب بسبب خطورتها

الشرطة تلقي القبض على العقل المدبر لجريمة لاكريم
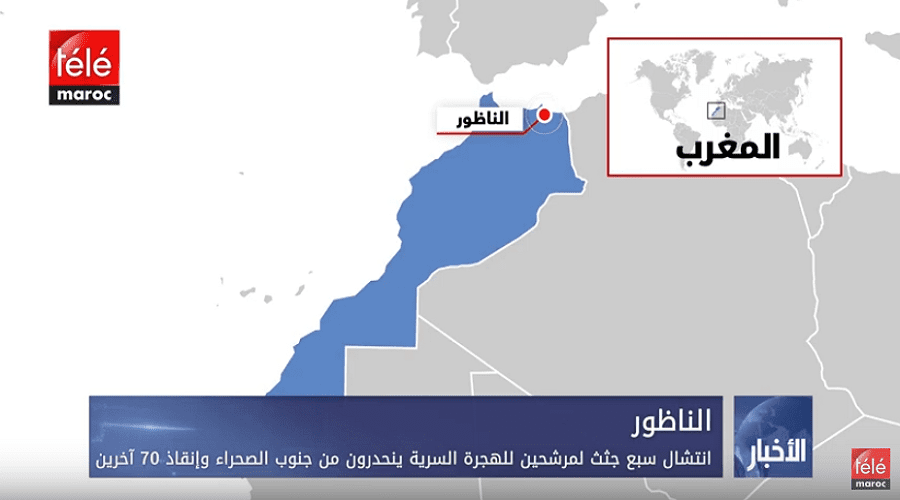
انتشال سبع جثث لمرشحين للهجرة السرية ينحدرون من جنوب الصحراء وإنقاذ 70 آخرين

نقابة تطالب أمزازي بفتح تحقيق حول اختلالات بمديرية التعليم بسيدي بنور

قانون المالية..نظام التغطية ضد المخاطر الكارثية يدخل حيز التنفيذ في بداية 2020

وزير النقل يعترف بوجود مئات القناطر الآيلة للسقوط بالمغرب

ناصر بوريطة: المغرب يعلن ترسيم حدوده البحرية لتمتد إلى أقاليم الصحراء

هكذا تورط الفد في فضيحة باب دارنا

هكذا ردت واشنطن على تهديد أردوغان بإغلاق قاعدتين أمريكيتين

الأسر المغربية عاجزة عن الادخار ومديونيتها تبلغ 23.7 مليار درهم

التساقطات المطرية تخفض أسعار الخضر في أكبر سوق للجملة بالمملكة

وزارة التجهيز توضح بشأن قانونية محاضر مخالفات مدونة السير المعاينة بطرق آلية

أبوظبي..التأكيد على أهمية إعلان مراكش لمحاربة الفساد

صندوق النقد الدولي يمنح المغرب خطا جديدا للوقاية والسيولة بحوالي 3 مليار دولار

المغرب تاسع الدول العربية الأكثر نفوذا في العالم في 2019

الناتج المحلي للمغرب بلغ 1106 مليار درهم.. ومديونية الأسر ترتفع

انطلاق أشغال الاجتماع ال 14 لمنظمة شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة

فاس..توقيف حارس أمن للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي باستعمال قنينة غاز مسيل للدموع

دراسة..توزيع الرواتب يتركز حول الحد الأدنى للأُجور في المملكة

شكيب بنموسى: اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مطالبة بإجراء تشخيص دقيق للوضع الحالي

بعد متابعته بالاتجار في البشر.. عضو مجلس جهة ممنوع من مغادرة البلاد

عواصف رملية قوية تغطي سماء مراكش
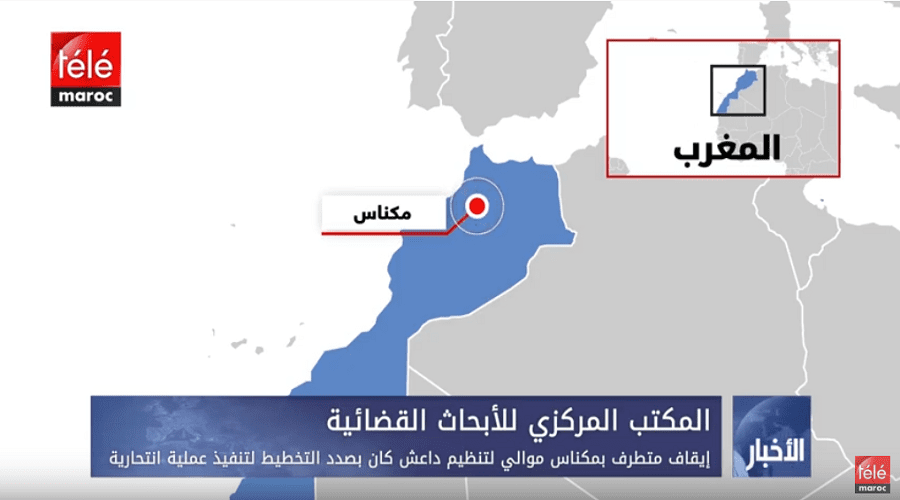
إيقاف متطرف بمكناس موالي لتنظيم داعش كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية

المغاربة لا يقرؤون كثيرا .. وتراجع كبير يهدد المكتبات

ألف مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة يتنافسون على 200 منصب شغل

نقابيون وأطباء يحذرون من فتح المجال أمام الأجانب
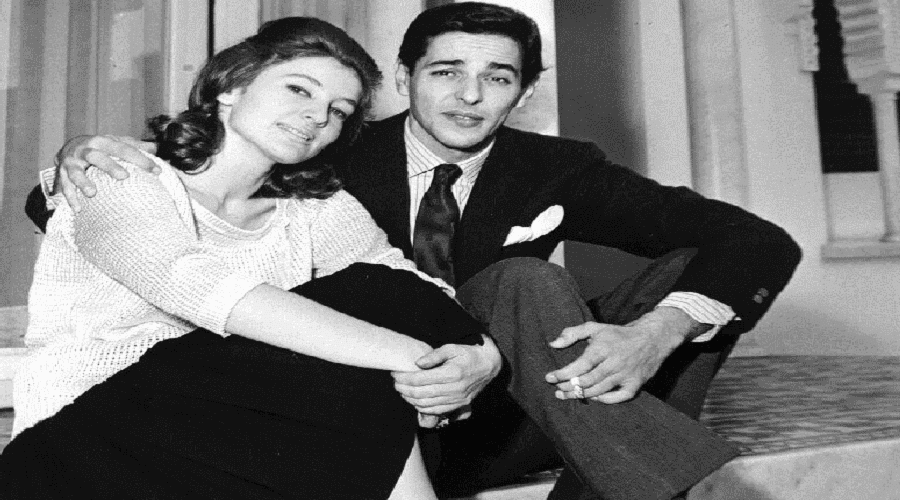
تاريخ.. عندما تزوج ملوك وسلاطين المغرب من أجنبيات

الملك يهنئ عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الداخلية تحقق في اختلالات كورنيش آسفي

المغرب يشارك في أشغال اللقاء التحضيري للاجتماع ال12 للجنة المختصة في الدفاع والسلامة والأمن بإفريقيا

العثماني يصدر منشورا لتفعيل الأمازيغية في التعليم وفي الحياة العامة

تعثر إنجاز مراكز لمعالجة الإدمان يرفع من إقبال الشباب على استهلاك المخدرات بالهراويين

إيقاف متطرف بمكناس موالي لتنظيم داعش كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية

تقرير رسمي..الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية أهم مسببات العنف الزوجي في المغرب

إيقاف داعشي بمكناس خطط لتنفيذ عملية انتحارية

طانطان...توقيف 3 أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني وتعريض سلامة الأشخاص للخطر

تخصيص حوالي 318 مليون درهم لتمويل أزيد من 19 مشروعا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

الاستقلال يوجه انتقادات لقطاع الصحة ويصف قانون المالية بقانون الإعفاءات والترضيات
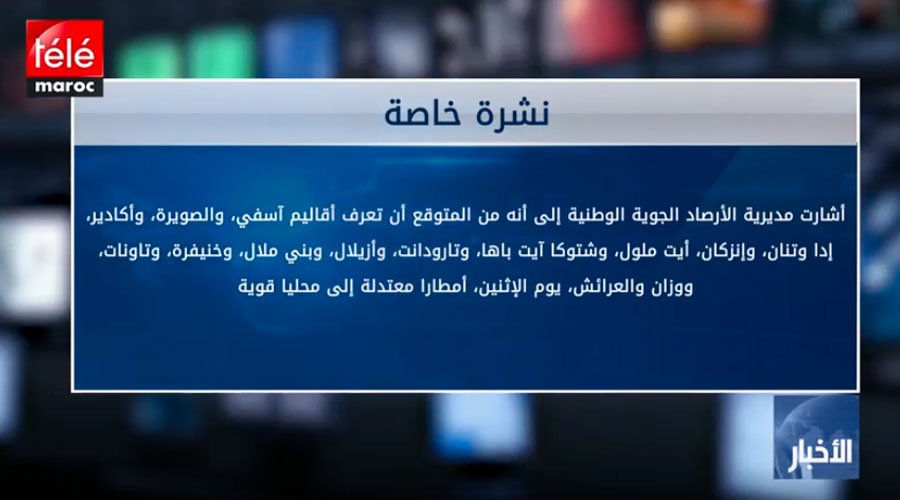
تساقطات ثلجية ورياح أحيانا قوية من المستوى البرتقالي بعدد من أقاليم المملكة

مجلس النواب... مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي بالمملكة يدخل مرحلة جديدة

أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار على السواحل الأطلسية ابتداء من يوم غد الإثنين

بركة يهاجم حكومة العثماني ويشببها بـ"الجزر المفككة"

فاس...مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تعقد دورتها الثالثة بحضور أزيد من 300 عالم إفريقي

تقرير... 53في المائة من المغاربة يرون أن نسبة الفساد تضاعفت في السنة الأخيرة

البرلمان يستعد للمصادقة على مشروع قانون تبسيط المساطر الإدارية

بحث رسمي...نصف عدد المغاربة يجهلون برامج محاربة الفقر

تاوريرت... أخنوش يترأس افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصناعات التحويلية للزيتون

أزمة العطش تستنفر ولاية وعمالات جهة طنجة

هكذا أطاح الفساد الانتخابي ببرلماني من مجلس المستشارين

مستشفيات سلا بدون مستلزمات طبية

تطورات جديدة في قضية دهس قائد نواحي أزيلال

تحذير من المضاعفات الجانبية لأدوية على صحة الأطفال

ترخيص سلطات البيضاء لتطبيقات ذكية يثير حفيظة سائقي سيارات الأجرة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم المسار السياسي لحل نزاع الصحراء

هكذا هجّرت سلطات البيضاء 180 قاصرا مشردا ورمتهم في العراء

التزوير يطيح برئيس ناد رياضي وعون سلطة وموظفة

بمساعدة الديستي.. أمن أكادير يجهض تهريب 650 كلغ من المخدرات

تعزية من الملك إلى رئيس جمهورية النيجر إثر الهجوم الإرهابي على قاعدة إيناتيس

معرض فني للسجناء .. إبداعات ما وراء الجدران أو حين يحرر الفن

تركيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب قرار إبادة الأرمن

محكمة المدققين الأوروبية تنتقد ضعف نتائج الدعم المالي للمغرب والحكومة ترد

بعد حملة "مابغيناش نموتو" ... أزمة فقدان أدوية مرضى السرطان تصل للبرلمان

الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف

الحكومة توسع اختصاصات "مديرية المناهج" لضمان تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة

أحياء سكنية تنمو في جنبات مطرح مديونة وتعثر في إخراج مطرح النفايات الجديد إلى حيز الوجود

هكذا رد أوغلو على عزم المغرب مراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا

وزير الخارجية السعودي يشيد بتواصل مواقف المغرب الثابتة للتعريف بقضية القدس الشريف

دجاج نافق يستنفر الأونسا والسلطات

دورية لفتيت حول صرف المال العام تستنفر رؤساء جماعات

هذه أسماء أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد الذين عينهم الملك

إنقاذ حياة الشابين العالقين في الثلوج بمرتفعات ايساغن

مندوبة السجون تتهم جمعية حقوق الإنسان بنشر الأكاذيب

البنك الإفريقي للتنمية يهب المغرب تمويلا بقيمة 245 مليون يورو لإنارة قرى المملكة

تصنيف مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة الأجود عالميا

محتجون يقتحمون مراكز تصويت في انتخابات الجزائر

الملك يدعو البلدان الإسلامية للتصدي لمحاولات نشر نعرات الانفصال

نصف الطرق بالمغرب في وضعية كارثية و500 قنطرة مهددة بالانهيار

تكريم المغرب في عرض عسكري بمناسبة الذكرى ال 59 لعيد استقلال بوركينا فاسو

الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط

إصابة 25 عاملا فلاحيا في حادث انقلاب بيكوب ضواحي بني ملال

فضيحة باب دارنا تطيح بالموثق والوكيل التجاري للشركة

الحكومة تلجأ للفصل 77 من الدستور للإطاحة بتعديل إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

الدار البيضاء..مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرفة العامة للتجارة بهونغ كونغ

44 في المائة من المغاربة يرون أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطين في الفساد

محمد صالح التامك: مندوبية السجون عملت على أنسنة ظروف الاعتقال
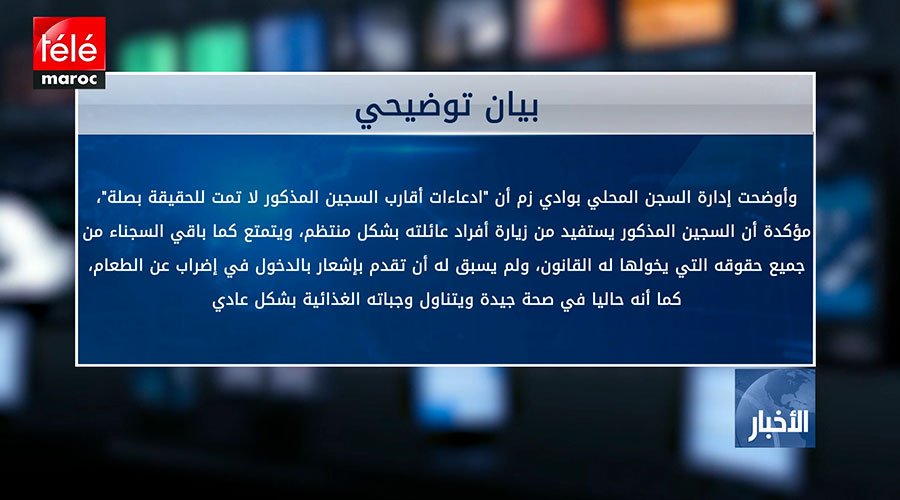
إدارة السجن المحلي بوادي زم تنفي صحة محتوى شريط فيديو نشره اقارب أحد نزلاء السجن

تريدون اجتياز مباريات أسلاك الشرطة... هذه هي الشروط المطلوبة

قرض بـ245 مليون أورو لكهربة العالم القروي

الملك يترأس مجلسا وزاريا هذه تفاصيله

السجن لأستاذين وخياط اختلسوا ملايير ودادية سكنية

وفاة المدير العام للجامعة الملكية المغربية للملاكمة في ظروف غامضة

ربورتاج .. شوارع فاس تفقد بريقها والإقبال السياحي يتراجع إلى مستويات متدنية
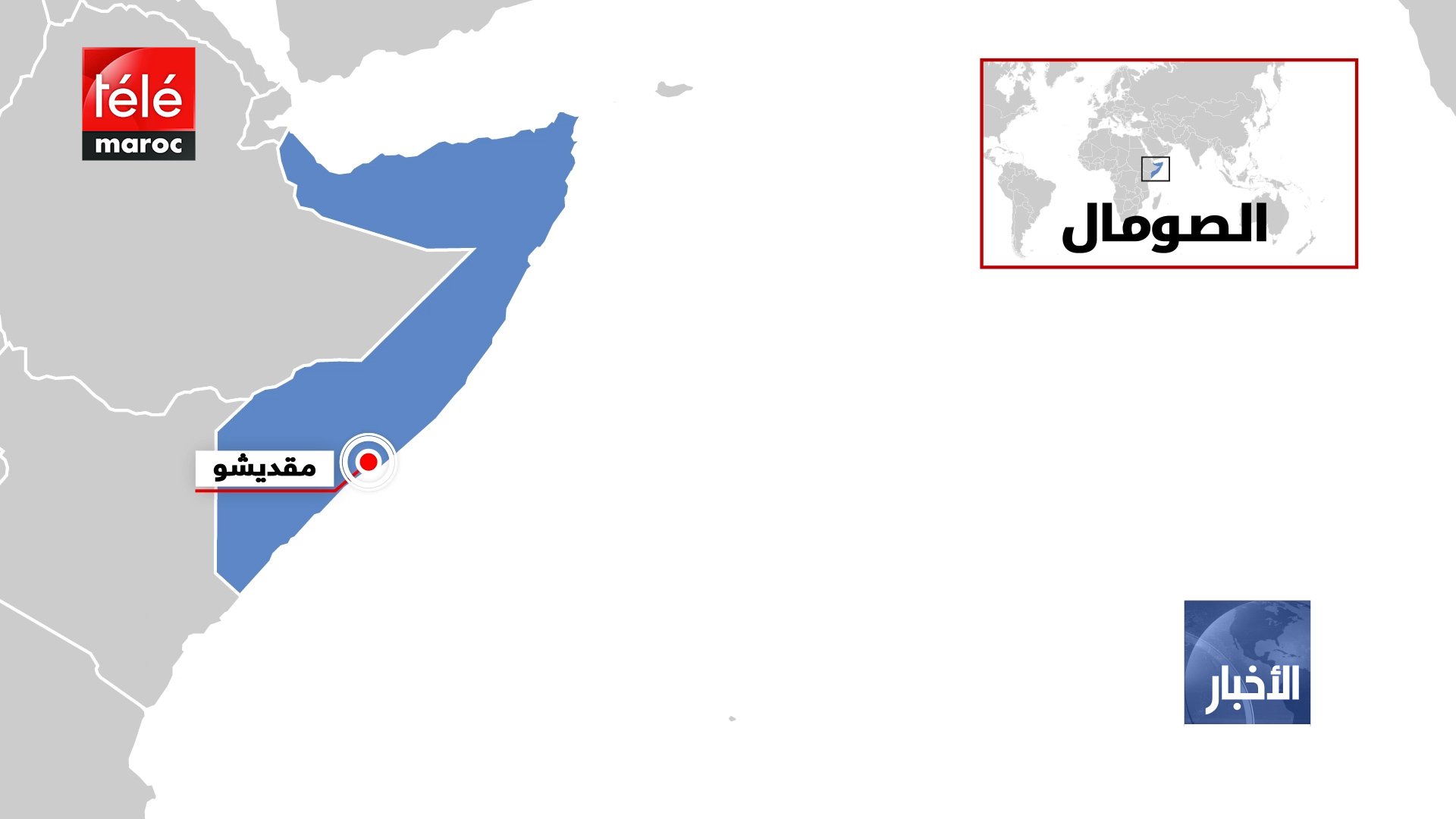
الصومال.. خمسة قتلى في هجوم جهاديين على فندق في مقديشو

إدارة السجن المحلي العرجات..وفاة سجين بمستشفى مولاي عبد الله بسلا

الأمم المتحدة تنفي بشكل قاطع الشائعات حول تعيين مبعوث شخصي جديد بالصحراء المغربية

منظمة أوكسفام .. الإنصاف هو الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية لـ2020

أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب سنويا

مجلس إقليمي بدون مقر يخصص 82 مليونا لصيانة بنايات إدارية

وزارة الفلاحة والصيد البحري..الاستثمار العمومي بمناطق الواحات وشجر الأركان بلغ 63.6 مليار درهم

المصطفى الرميد:930 سجينا بالمغرب يتابعون دراستهم الجامعية من وراء القضبان

نزهة بوشارب:المغرب يستخدم نظاما معلوماتيا والأقمار الاصطناعية لمحاربة دور الصفيح

اتفاقيات..إبرام 109 اتفاقيات شراكة بـ 5.6 مليار درهم لمعالجة الدور الآيلة للسقوط

وزارة الاقتصاد والمالية تقترح عفوا لصالح 670 ألف شخص ممنوعين من الشيك

مولاي يعقوب..انهيار جزء من زليج حامة عين الله يتسبب في إصابة بعض مرتادي الحامة

المندوبية السامية..7,6 مليون مغربية تعرضت للعنف خلال 12 شهرا بنسبة 57%

مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بجيرسي الأمريكية

الداخلية تحقق في استفادة أقارب أعضاء مجلس إقليمي من دعم الجمعيات

هذا ما قررته المحكمة في حق مول الكاسكيطة

قصص نزيلات غادرن مراكز حماية الطفولة فوق العمارية

اختفاء 80 مليونا تقود مستخدما بوكالة توزيع الماء للسجن

تعثر إنجاز مرائب بالدار البيضاء يزيد من عشوائية ركن السيارات بالمدينة

أزيد من 22 ألف مغربي غادروا للعمل بالخارج مع نهاية شتنبر

وزارة التربية الوطنية تعلق الحوار مع النقابات التعليمية بشكل مفاجئ

غوتيريس يستعد لتعيين وزيرة الخارجية الأسترالية مبعوثة خاصة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية

الملك يدشن بسلا مركب محمد السادس لكرة القدم

منتخبون على رأس مرتكبي خروقات التعمير

أزيد من 22 ألف مغربي غادروا للعمل بالخارج خلال 9 أشهر

المغرب يتقدم بدرجتين في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2019

التعليم العمومي المغربي يغيب عن مؤشّر دولي لـ"الجامعات الخضراء"

منظمات أمميّة تنتقد استمرار تزويج القاصرات في المجتمع المغربي

مؤتمر كوب25.. المنظمات غير الحكومية المغربية تترافع في مدريد دفاعا عن المناخ

الملك يدشن بسلا مركب محمد السادس لكرة القدم

تراكم النفايات وحاويات مكسورة، مظاهر تؤرق ساكنة فاس

مسدس يقود نجل دبلوماسي سابق للإعتقال

مغنو الراب والنساء... قصص مثيرة وحكايات مؤلمة

تاريخ... الأوراق المنسية لأحداث دجنبر الأسود وناج يروي تفاصيل حصرية

90 ألف إصابة بالجلطات الدماغية في المغرب

قطار أكادير يسيل لعاب فرنسا والصين وأمريكا

دواء الغدة الدرقية يختفي من الصيدليات مجددا

الفساد يجر رؤساء جماعات لتحقيقات الداخلية

مذكرة بحث في حق داهس قايد دمنات

إرهابيون خططوا لتفجير البرلمان والأضرحة

الحموشي يصرف منحة استثنائية لجميع موظفي الأمن الوطني

هكذا فقد البيجيدي الأغلبية بجماعة الفنيدق
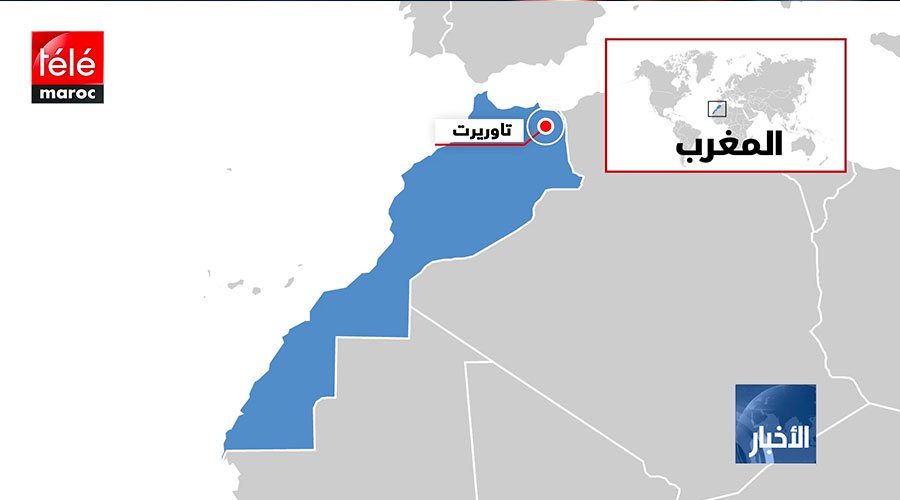
تاوريرت ..رئيس فرقة الشرطة القضائية يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص هدد سلامة عناصر الشرطة

التنسيق النقابي الخماسي لموظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات يمدد إضرابه الوطني لأسبوع ثان

105 جمعيات مغربية تلقت أزيد من 34 مليار سنتيم دعما من خارج المملكة

الأميرة لالة حسناء تترأس حفل تخليد الذكرى الثلاثين لتأسيس جمعية الإحسان

الأحكام القضائية تكبد خزينة الدولة أزيد من 950 مليار سنتيم

تلميذ يبلغ عن وجود قنبلتين وهميتين بمنزل

تفاصيل لقاء أمزازي بالنقابات

الممرضون يهددون بالخروج إلى الشارع وشل القطاع

ضحايا مشروع "باب دارنا" يعودون للاحتجاج

مشروع بـ82 مليون أورو يدعم فلاحين مغاربة ضد تغيرات المناخ

الطيران المدني المغربي يخطط لنقل 70 مليون مسافر في 2035

3 ملايين درهم لتقديم طلب لليونسكو لإدراج البيضاء ضمن لائحة المدن المبدعة في العالم

عكس ما راج... بنموسى لازال يزاول مهام سفير للمغرب بفرنسا

الممرضون يعودون للإحتجاج بالإضراب يومي 9 و10 دجنبر واعتصام أمام مقر الوزارة

الصيادلة يطالبون بمراجعة القوانين التي تضعهم على قدم المساواة مع تجار المخدرات

الرباط..المديرية العامة للأمن تكشف حقيقة إدعاءات مغلوطة لشرطي موقوف عن العمل

ميلانو..عزيز أخنوش يعتبر أن من يسب الوطن ويمس بثوابته لا مكان له بين المغاربة

النرويج..مسلمون يوزعون 10 آلاف نسخة من القرآن الكريم لمواجهة الكراهية

انطلاق اقتراع الجالية الجزائرية في الخارج وسط إصرار شعبي على رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية
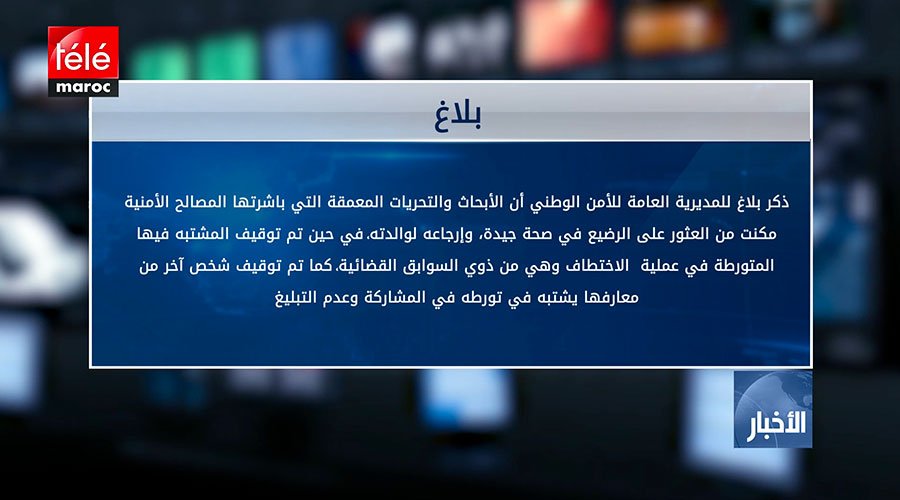
العثور على الرضيع الذي تم التصريح باختطافه من طرف والدته وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في العملية

الأميرة للا مريم تترأس حفل تدشين "البازار الدولي" للنادي الدبلوما

الملك يهنئ براديب روبن بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية موريس

فلورنس... أقدم ساحة بفاس تتحول إلى مرتع للمتشردين

التجمع الوطني للأحرار يعقد مؤتمره الجهوي بإيطاليا بحضور أزيد من 1000 مغربي

التزوير يطيح بموظفة وعون سلطة ورئيس جمعية رياضية

محكوم بالإعدام في مقتل سائحتي إمليل يستنفر أمن آسفي

قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في التريبورتورات

مقترح قانون يطالب بنسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي

مجلس إقليمي يوزع 300 مليون سنتيم على جمعيات مقربة

تكريم النجم العالمي روبيرت ريدفورد وسط حضور جماهيري كبير

عمال حافلات "شركة ألزا" للنقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة يخوضون إضرابا عن العمل
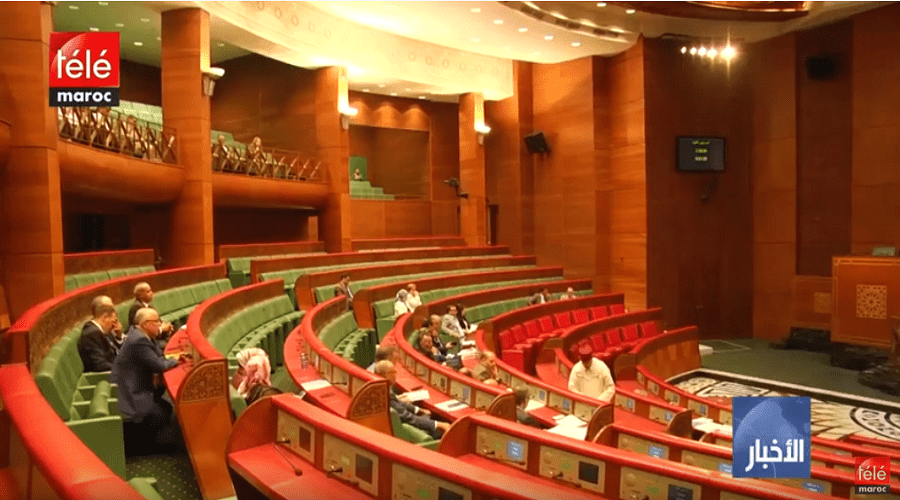
وسط غياب ملحوظ للبرلمانيين .. 37 مستشارا فقط يصوتون لتمرير مشروع قانون مالية 2020

وزارة الطاقة تقر بضعف جودة ومخزون المنتجات البترولية
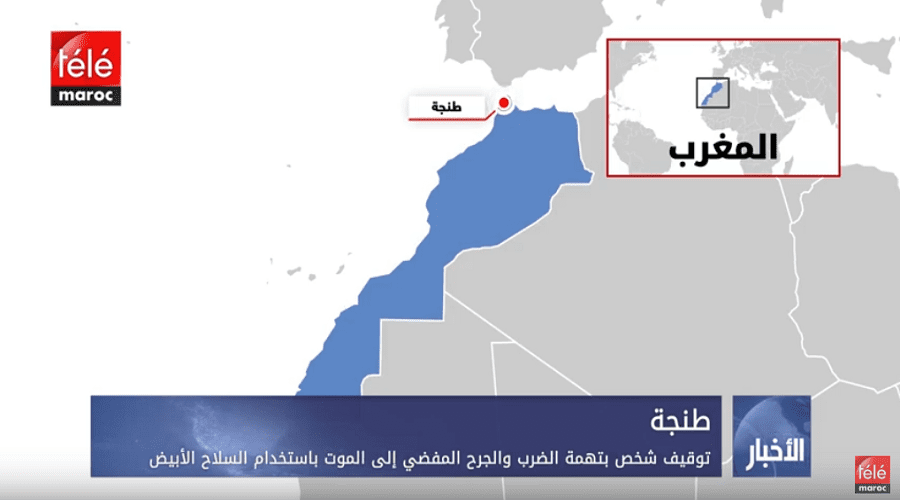
توقيف شخص بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض

الملك يترأس حفلا دينيا بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

أمن الرباط يوقف سائق سيارة الأجرة المتورط في قتل زميله

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم السينما الأسترالية والنجمة الهندية بريانكا شوبرا

مديرية الحموشي تكشف أرقام جرائم الابتزاز الإلكتروني

حريق المركز التجاري الرباط سانتر... هذا تفسير ما حدث

تطورات مثيرة في قضية كوكايين الهرهورة

أمن الرباط يحقق في قتل سائق سيارة أجرة لزميله

اندلاع حريق في المركز التجاري "الرباط سانتر" أيام قليلة بعد افتتاحه
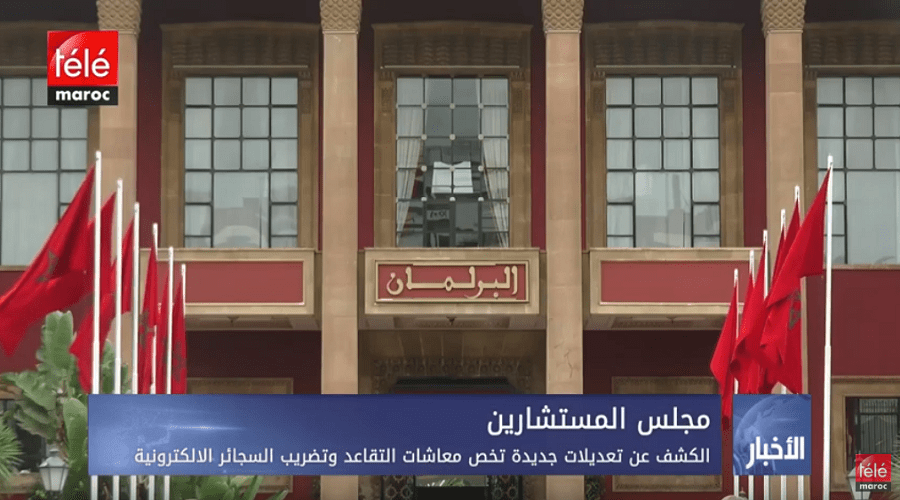
الكشف عن تعديلات جديدة تخص معاشات التقاعد وتضريب السجائر الالكترونية

أزيد من 500 جسر وقنطرة بالمملكة في وضعية تآكل

دراسة جديدة تستهدف دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم

تماطل في ترحيل سوق الدواجن إلى منطقة الخيايطة والساكنة تشتكي اجتياح الثعابين والحشرات

حقوقيون ومحامون ينتفضون أمام البرلمان

بوريطة يكشف الملفات التي تمت مناقشتها على هامش زيارة بومبيو للمغرب

النيابة العامة تطارد مستغلي الأطفال في التسول

العرض الأول لفيلم "سيد مجهول" وتكريم الفنانة منى فتو

الاتحاد الأوربي يدعم قطاع التربية الوطنية ببرنامج "التربية2"

الوالي اليعقوبي يوجه تنبيها لعمدة الرباط لهذا السبب

الحموشي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي بمقر الديستي

هكذا كبد رباح واعمارة خزينة الدولة 470 مليارا

وزير الخارجية الأمريكي يحل بالمغرب
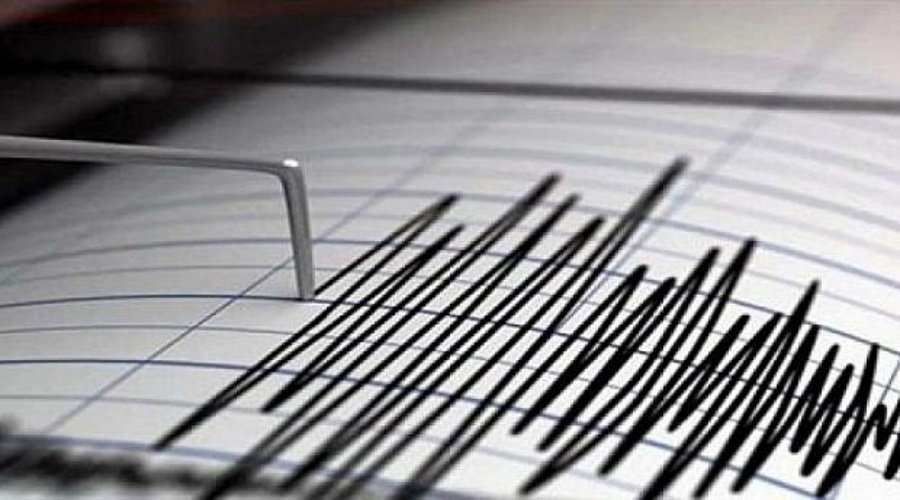
تسجيل هزة أرضية بإقليم الدريوش

تفكيك خلية إرهابية بالمغرب وإسبانيا.. مدريد تشيد ب "التعاون الممتاز" بين الأجهزة الأمنية في البلدين

مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تطلق حملة عمليات جراحية مجانية لداء الساد

فيضانات بشوارع البيضاء بعد تعثر مشاريع لتخزين مياه التساقطات

أمزازي..عدد الطلبة الممنوحين يقدر بـ380 ألفا

أخنوش يفتتح الملتقى الوطني للزيتون بالعطاوية

حجز أزيد من 5 أطنان من المخدرات بالناظور

بالفيديو.. مواطن يدهس قائدا بسيارته

وزارة الصحة تحرق أدوية منتهية الصلاحية بـ5 ملايير

الديستي تطيح بزوجين ضمن شبكة لتهريب السيارات المسروقة

إضراب قطاع الطيران بفرنسا يربك رحلات LA RAM نحو أوروبا

سفير بريطانيا بالرباط: هناك مؤشرات قوية على وجود النفط والغاز بالمغرب

وزير الصحة يكشف أن وزارته توصلت بطلبات استقالة من 183 طبيب

تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي غدا للمغرب

تبديد الملايير لشراء أدوية فاسدة

حجز مواد لصناعة المتفجرات في القنيطرة

مديرية الأمن تكشف حقيقة فيديو مفبرك منسوب لعناصرها

العدول يطعنون بعدم دستورية قانون المالية

سفير بريطانيا بالمغرب يتحدث لأول مرة عن سبب انتقاده لخدمات LA RAM

عملية اعتقال دواعش خلية الناظور في صور

جمعية تقدم خدمة الإستحمام للمشردين بالدار البيضاء

84 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب عاطلون عن العمل أو يستغلون في التسول

مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يهددون باللجوء للمحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9

أمطار قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق من المملكة

تقرير دولي لمهارات التلاميذ يضع المغرب في ذيل الترتيب

مندوبية السجون تكشف حقيقة إضراب بوعشرين القصير عن الطعام

شخص شغل جهاز إنذار ترامواي البيضاء فانتهى في السجن

ملف تعاضدية الموظفين أمام وكيل الملك

تعثر تهيئة مطرح سيدي مومن السابق يحرم الساكنة من فضاء ترفيهي

المغاربة قدموا 10 آلاف شكاية ضد الإدارة والمواطن لم يلمس إقلاعها عن الممارسات المسيئة

وزير الصحة: سياسة شراء الدواء المعتمدة لا تتوافق مع حاجيات المواطن

بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة

الحكومة تراجع قوانين الانتخابات

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 4 دواعش ينشطون بين المغرب وإسبانيا

إحالة مول الكاسكيطة على المحكمة في حالة اعتقال ومداخيله تفوق 30 ألف درهم شهريا
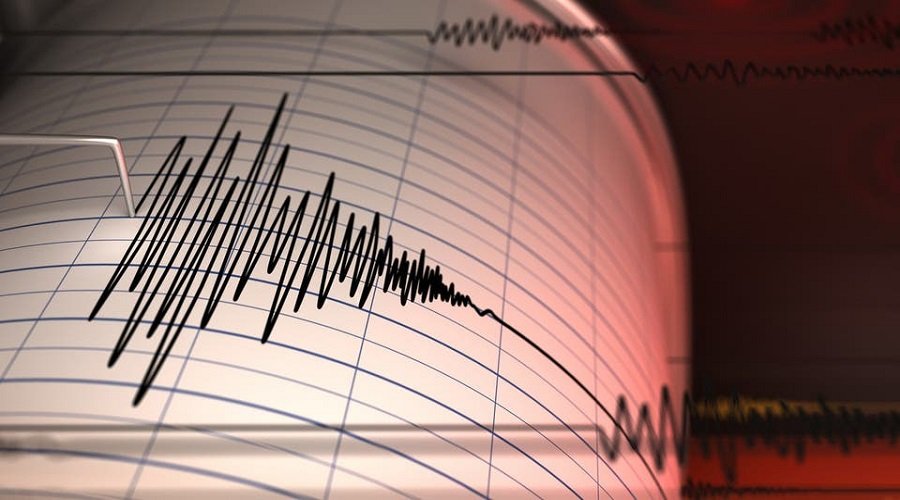
تسجيل هزة أرضية بإقليم بولمان

غرامات ثقيلة تنتظر صناديق التغطية الصحية

43 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعات دون شهادة

لفتيت للبرلمانيين : اعطيوني أسماء ولاد لحرام

هذا ما قضت به المحكمة في حق المتهمين في قضية سمسار القضاء

غياب الولوجيات بالمرافق الجماعية والطرقات بالبيضاء يسائل مجلس المدينة

مجلس النواب..وزير الصحة يؤكد أن القطاع في حاجة لإعادة تأهيل وإصلاح عميقين

مجلس المستشارين..التصويت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020

الناظور..توقيف شخص من ذوي السوابق للإشتباه في تورطه في الإحتجاز والإغتصاب

تسجيل37 ألف إصابة جديدة بداء السل في ظل استمرار غياب الأدوية

أمزازي:سنقضي على الإكتظاظ في المؤسسات العمومية في سنة 2023

السجن لطبيب ومولدتين في قضية وفاة فرح وجنينها بالعرائش

مدير بنك يختلس 800 مليون ويفر إلى تركيا

تأجيل محاكمة حامي الذين لهذا السبب

شرطة لمحاصرة مافيا المقالع

برلمانيون مغاربة في عداد المختفين

تفكيك ثلاث شبكات للاتجار في البشر

كل ما يجب معرفته عن تاريخ ديربي الوداد والرجاء

أحلام الملوك.. من المولى إسماعيل إلى محمد السادس

تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تعتبر رائدة ومتكاملة بفضل تعدد أبعادها

وزير الداخلية يدعو الشباب المغاربة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية

قانون مالية 2020..الباطرونا تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

تصنيف المغرب ضمن الدول المنخفضة الخطورة على السياح في 2020

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ينفرد بالعرض الأول لفيلم لالة عائشة للمخرج محمد البدوي

طنجة..توقيف شخص يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية للضرب والجرح المفضي إلى الموت

النقابات التعليمية تشتكي اقتطاعات الأجور وتدعو أمزازي لإنجاح لقاءاتها

تحذير.. أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق من المملكة

بالفيديو.. النيران تلتهم سيارة بقنطرة مولاي الحسن بين سلا والرباط

حرب بين الموثقين والعدول بسبب قانون المالية

برلمانيون يطالبون بفرض مساهمة تضامنية على شركات المحروقات

ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة تازة إلى 17 قتيلا

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة بإقليم تازة

الداخلية تشرع في تحديث اللوائح الانتخابية

الرميد يهاجم المجلس الوطني لحقوق الانسان بسبب القانون الجنائي

العثماني : الظروف صعيبة

وكيل الملك: ضبط مخدرات عند توقيف مول الكاسكيطة

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يواصل فعالياته لليوم الثاني بلقاءات مع كبار نجوم السينما العالمية

طنجة..ندوة مجلس الصحافة تناقش تحديات المهنة وسبل مواجهتها وتصدر توصيات

الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة ال 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

حركة الممرضين وتقنيي الصحة تتجه إلى شل مستشفيات المملكة

هكذا باع مول مشروع "باب دارنا" الوهم لمئات الأسر المغربية وجمع الملايير بمشاريع على الورق

كتابة الألم.. أدباء وتجربة المــرض

المصدرون يحتجون على الإجراءات الضريبية الجديدة

افتتاح فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور ألمع النجوم

يوم دراسي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يبرز دور التكنولوجيا في تطوير النموذج التنموي الوطني

وزارة الصحة ترفض تجهيز مركز لتصفية الكلى

تورط مستثمرين ومنعشين عقاريين في الاتجار الدولي للمخدرات

التحقيق في تفويت 5 هكتارات من ملك الدولة لبرلماني سابق

الأمن يفك لغز الإعتداء على مسؤول أمني كبير بالسفارة الألمانية في بيته بغرض السرقة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 30 نونبر 2019

مجلس الصحافة يجمع إعلاميين من 12 دولة لمناقشة واقع الصحافة ومستقبلها

وزارة التربية الوطنية تفشل في إقناع النقابات بالتراجع عن خوض 3 إضرابات وطنية

لحليمي يستعد لإحصاء 2024 ويهاجم المؤسسات بسبب المعلومة

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعود هذه السنة ليؤكد التزامنا لفائدة التقارب بين الثقافات

افتتاح فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور ألمع النجوم

رسب في امتحان التعاقد فتسلق عمود كهرباء وحاول الإنتحار

بارون هرب 400 طن من المخدرات بشاحنات الطماطم

فيليب موريس توزع سجائر إسرائيلية بالسوق المغربية

هذا ما قضت به المحكمة في حق أستاذ الجنس مقابل النقط

مجلس المدينة يتجاهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي

الفساد يعيق التنمية ويهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي

السحب الكامل لحصة منتوج كريات السردين غير المطابقة للشروط على المستوى الصحي
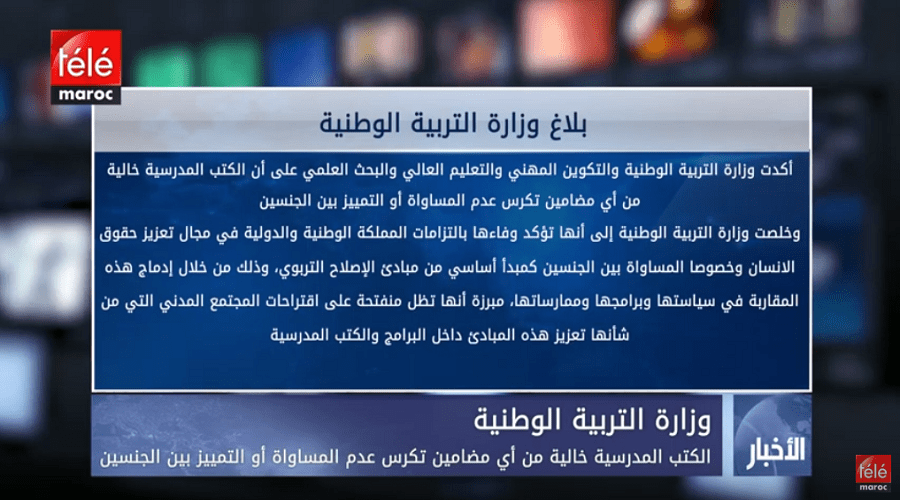
الكتب المدرسية خالية من أي مضامين تكرس عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين

الحكومة تحدد مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية بالمغرب

لهذه الأسباب حذرت إسبانيا مواطنيها من الذهاب إلى الجزائر وتندوف

الملك: أزيد من مليوني فلسطيني يعانون من العقاب الجماعي

حرب بين شركات ومجالس جماعية بسبب عشوائية الأشغال

عطب تقني يشل حركة سير طرامواي البيضاء

بعد تحذير أونسا.. سحب كريات سردين كارل من الأسواق

تشديد المراقبة على شركات البيع الهرمي والكازينوهات

تصريح قوي من ريكو قبل مواجهة بدر هاري

وكالة تقنين المواصلات تدقق في أنشطة شركات الاتصالات

مدير وكالة حضرية المعتقل بالرشوة يقحم رجل أعمال فرنسي شهير في ملفه

مستشار سابق لرباح أمام جرائم الأموال بتهمة الارتشاء

جدل حول التمييز بين الجنسين في الكتب المدرسية

فقدان أدوية داء السل يثير الرعب بالمستشفيات

المنتخب المغربي يتراجع في تصنيف الفيفا

أونسا تحذر من "سردين كويرات" مسموم يباع في المغرب

ترقب وسط تجار وجزاري الرباط بعد تأخر أشغال تهيئة مجزرة العاصمة

الصحراء المغربية..الولايات المتحدة تجدد التأكيد على موقفها الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي

رسم ضريبي على عقود التأمين ابتداء من يناير 2020 لفائدة صندوق التضامن ضد الكوارث

وزير الصحة يمنع فرض الأداء على الحالات المستعجلة بالمستشفيات

قانون مالية 2020..المحامون يحتجون ضد المادة 9 ويطالبون بضريبة خاصة تراعي خصوصية المهنة
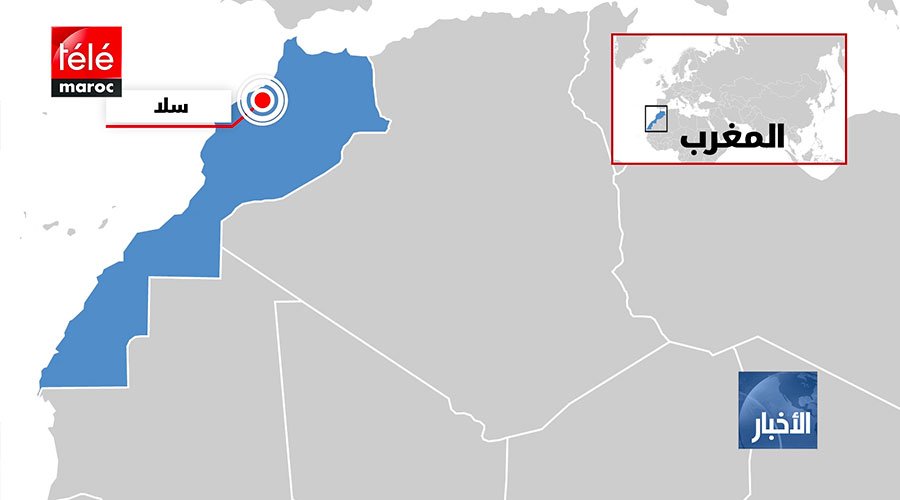
سلا..توقيف أربعة متورطين في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى الرئيس الفرنسي على إثر وفاة 13 جنديا فرنسيا بمالي

السجن لمدير وموظف متهمين بالسطو على مليار من بنك

احتقان بجامعة مولاي إسماعيل ومطالب بالافتحاص

مواجهات بين مقاولين ومهندسين ومسؤولين في فضيحة رشوة

تعثر في انجاز مشاريع حديقة الحيوانات وكورنيش عين السبع يسائل مجلس المدينة

الأغلبية والمعارضة تنتفضان في وجه العثماني لهذا السبب

مغاربة ضحايا عملية نصب بـ5 مليارات دولار

ترحيل سجناء على خلفية أحداث الحسيمة من فاس إلى كرسيف

برلمانيون يدافعون عن القدرة الشرائية لمستهلكي الخمور

مؤشر الازدهار العالمي ل2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا

قطاع العقار ..حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب

أكثر من 100 ألف عائلة تعيش في دور الصفيح في المدن المغربية

مصطفى الرميد :سجون المملكة تعرف اكتظاظاً بلغت نسبته 138في المائة

تأجيل محاكمة سمسار القضاء ومن معه إلى 28 نونبر الجاري

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن زيارة للمغرب مطلع دجنبر المقبل

مرضى الغدة الدرقية بدون دواء ووزارة الصحة خارج التغطية

ضياع قارب صيد يطيح بشبكة دولية لتهريب المخدرات

تطورات جديدة في قضية سمسار الأحكام القضائية

تفاصيل توقيف ثلاثيني بتهمة قتل طفلا بسلا

سقوط جزء من فندق لينكولن العتيق يعرقل حركة السير بالعاصمة الاقتصادية

400 حافلة مستعملة لنقل البيضاويين

هكذا أفسد المنتخبون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

توقيف شخص موالي لداعش خطط لعملية انتحارية بالمملكة

وزير الاقتصاد والمالية يؤكد تمسك الحكومة بالمادة 9 من قانون مالية 2020

الجهوية المتقدمة..الحكومة تخصص أكثر من 100 مليار درهم لإنجاز مشاريع في 10 جهات

الوكيل العام يصدر مذكرةً لمحاربة سماسرة المحاكم واعتقالهم من المقاهي

بسبب وفيات الحوامل.. برنامج حكومي لإحصائهن في المناطق النائية

مراكش..اجتماع رؤساء الشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور الأنتربول

انهيار جزء من فندق لينكولن يشل حركة ترامواي البيضاء

اعتقال مجندين هربوا من مركز التكوين العسكري

الحكومة تمنح راتبا ب6 ملايين شهريا لأعضاء ضبط الكهرباء

100 مليون درهم لتجهيز الساحات العمومية بنافورات ومساحات خضراء والتعثر يلازم المشروع

هزة أرضية تضرب ميدلت من جديد

حافلات مستعملة قادمة من أوروبا تصل البيضاء

انهيار جزء من فندق لينكولن يشل حركة ترامواي البيضاء

سابقة... السردين بأقل من درهم و نصف في آسفي والميناء يحقق رقما قياسيا بصيد 800 طن في يوم واحد

الدخيسي يكشف مصير عائلات الدواعش المغاربة

5.000 فرصة عمل في الجيش وميزانية المؤسسة ترتفع إلى 45,4 مليار درهم

هذا ما قضت به المحكمة في حق الرابور الكناوي

السجن لمتهمي كوكايين الهرهورة والبحث جار عن شرطي معزول

حاجب سيدنا.. رجال على رأس الحجابة الملكية

توقيف شخص حاول سرقة وكالة بنكية باستعمال بندقية صيد

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوجه انتقادات شديدة لقانون مالية 2020

تخصيص 56 مليون درهم لرقمنة العقود في سجلات المحاكم

مجلس المدينة وشركة البيضاء للتراث يتقاذفان معلمة الكرة الأرضية

تاريخ.. هكذا كان القصر يؤدب وزراءه

هجمات إلكترونية تستهدف وزارات ومؤسسات استراتيجية

توقيف شقيقين بتهمة السرقة والاعتداء على شرطي بتطوان
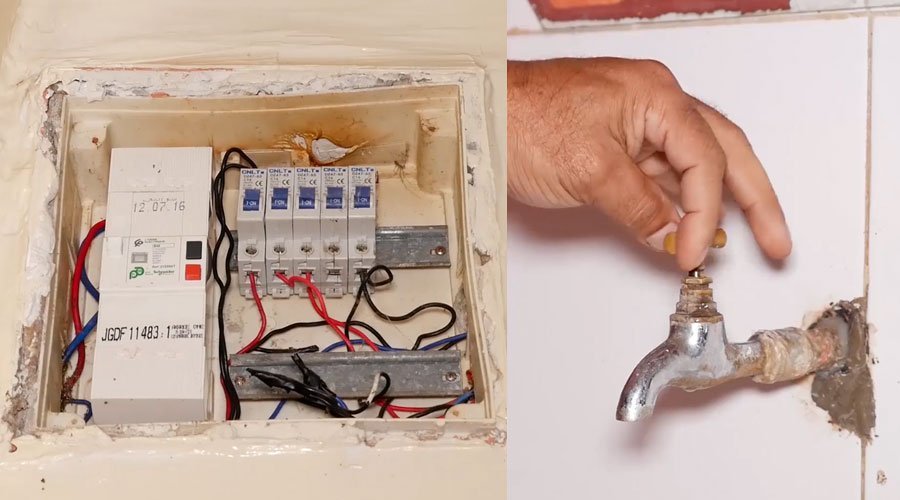
انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء وغضب من غلاء الفواتير

جرحى في انقلاب حافلة كانت تقل مشجعي النادي القنيطري

خاليلوزيتش منبهر بالديربي ومعجب بهذا اللاعب

توقيف عشرات الأشخاص وحجز أسلحة بيضاء على هامش مباراة الديربي

وزارة الثقافة والشباب والرياضة تقر بمجانية ملاعب القرب ومذكرتها تبقى وقف التنفيذ

المستهلك المغربي عانى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال أكتوبر الماضي

دخول 14 سجيناً من معتقلي أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام عارٍ من الصحة

صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية تسجل 45 مليار درهم في 2019

قانون المالية 2020 ..ابتداء من يناير..الحكومة تعفي أملاك وعقارات الأحزاب من رسوم التسجيل

العثماني: تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين سيصل إلى 90 بالمائة

الدار البيضاء..توقيف مواطن من جنسية هندية بحوزته أربع كيلوغرامات و615 غراما من مخدر الشيرا

الأميرة للا مريم تترأس حفل اختتام الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 23 نونبر 2019

غرق سفينة صيد قبالة طانطان .. عمليات البحث متواصلة والتعبئة لا تزال في الحد الأقصى

12 ألف حالة عنف ضد نساء المغرب .. والعنف النفسي يتصدر القائمة

ارتفاع عدد الرضع الوافدين على مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بسبب

الرئيس المصري يستقبل ناصر بوريطة حاملا رسالة خطية من الملك

وفاة صيادين وفقدان آخرين في غرق سفينة قبالة طانطان

بالفيديو.. لحظة توقيف منعش عقاري نصب على مواطنين في 17 مليار

بارون مخدرات يقدم نفسه ويسلم مسدس الدركي المسروق

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 22 نونبر 2019

الإعدام والمؤبد لعصابة سفاح الداهومي

أخنوش يتسلم وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي

نشرة خاصة.. أمطار ورياح قوية بالعديد من أقاليم المملكة

رئيس مجلس يخصص 117 مليونا لتعويضاته وسفرياته

نسبة ملء حقينة السدود بجهة طنجة - تطوان -الحسيمة ناهزت 53,6 في المائة
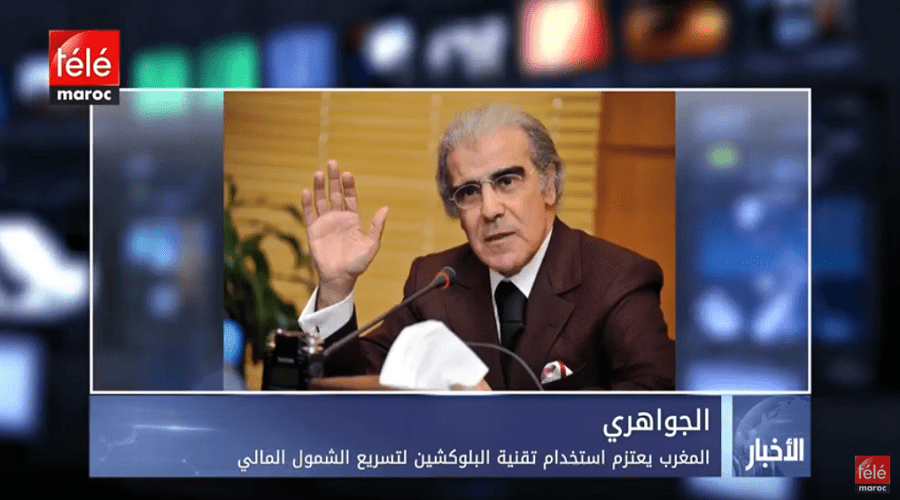
المغرب يعتزم استخدام تقنية البلوكشين لتسريع الشمول المالي

تقديم دليل مساطر الوقاية من الانتحار داخل الفضاءات السجنية

"أساتذة الزنزانة 9" يهددون بالعودة للاحتجاج بعد إحالة منسقهم الوطني على المجلس التأديبي

نقابيون يعلنون شهر غضب بالإدارات العمومية ضد الحكومة
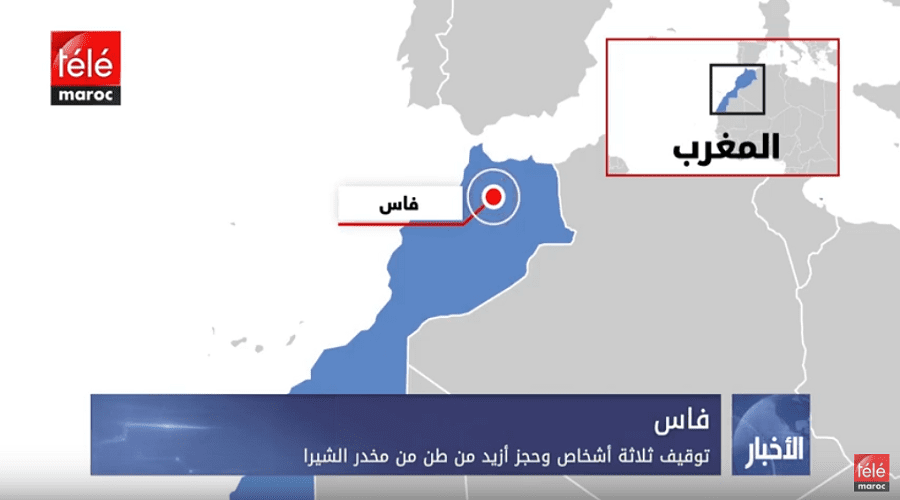
توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من طن من مخدر الشيرا

اتهامات لطبيب مشهور بالتحرش والابتزاز الجنسي

التأمين الإجباري على الكوارث يدخل حيز التنفيذ

تدابير أمنية صارمة تحاصر تيفوهات الديربي العربي

توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من طن من المخدرات بفاس

اختفاء أدوية يهدد حياة آلاف المصابين بالأمراض المزمنة

حريق يلتهم 50 محلا تجاريا بإنزكان

الريسوني يهاجم فرنسا ويتهمها بالتضييق على المسلمين

الحكومة تخرق مبدأ الحد الأدنى للأجر

البراءة لمسرب شريط إمليل
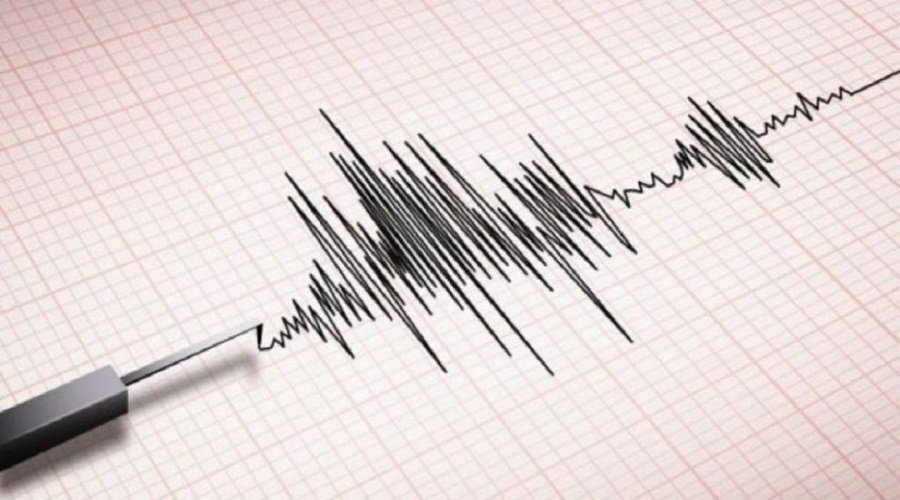
هزة أرضية تضرب ميدلت من جديد

عودة جدل تقاعد البرلمانيين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 21 نونبر 2019

توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بمجال التهريب الدولي للمخدرات

الرضا العام عن الخدمات المسجدية يتعدى 60 في المائة

2.5 مليون شخص سافروا على متن "البراق" إلى نهاية أكتوبر2019

مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين يخلق الجدل
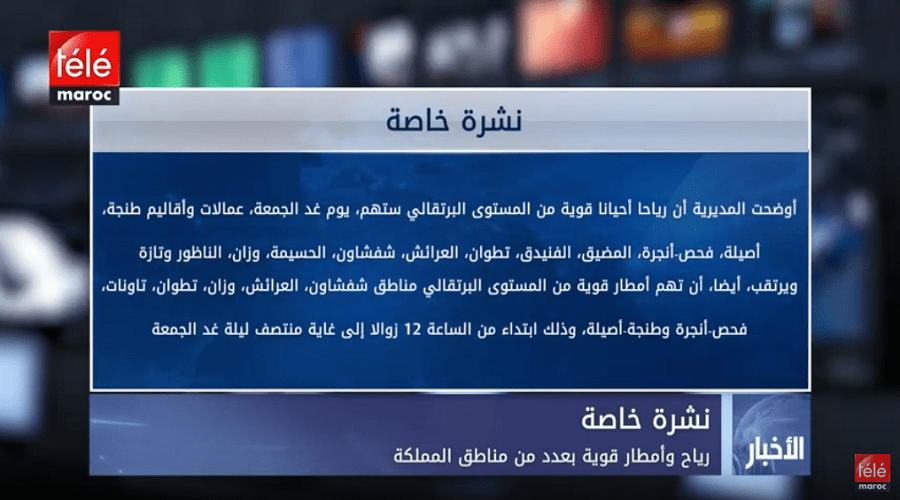
رياح وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة

طفل يقتحم بنكا ويسرق شيك بمبلغ 35 مليون

تحذير.. رياح وأمطار قوية بهذه المناطق من المملكة

المغرب يشتري 36 مروحية أباتشي

تعثر مشروع مختبر جماعي يفاقم معاناة مرضى السكري المعوزين بالعاصمة الاقتصادية

المحامون يتظاهرون ضد المادة 9 أمام البرلمان

اتهامات بالسطو على أراضي تلاحق وزراء وبرلمانيين

حجز 476 كيلوغراما من الكوكايين داخل شقة بالهرهورة

برلماني يستنزف الشواطئ ويدمر الغابة بمقالعه العشوائية

خروقات التعمير تطيح برئيس بلدية الناظور ونائبيه

خسارة كأس العرش تطيح بمدرب الحسنية من منصبه

إدارية وجدة تبطل الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة

حرب الفواتير تسقط برلمانيين

ارتفاع صاروخي لأسعار الخضر والفواكه

مستشارون ضد رفع أسعار "البيرة" و"الروج"

إرهابيون خططوا لاستهداف قضاة ووزراء

الملك يهنئ غوتابايا راجاباكسا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية سريلانكا

مكناس..توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بمجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

المندوبية السامية للتخطيط.. بحث جديد يرصد الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمقاولات المغربية

تذكرة مزدوجة للحافلة والطرام .. مشروع مع وقف التنفيذ بالدار البيضاء

أزيد من مليوني شاب يبحثون عن عروض شغل هزيلة بالمغرب

وزيرالتجهيز:أزيد من 700 ألف مغربي يعانون سنويا من موجة البرد

إضراب معتقلي أحداث الحسيمة.. مندوبية السجون توضح

تزوير لوائح الأراضي السلالية يورط مسؤولين وبرلمانيين

الملك يكلف شكيب بنموسى برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

هذا ما قررته المحكمة في قضية سمسار الأحكام القضائية

اعتقال مستشار جماعي ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات

قانون المناجم على طاولة المجلس الحكومي

بارون مخدرات يسطو على مسدس دركي

عبد النبوي ينبه البرلمانيين

العثماني: الزيادة في سعر البوطا إشاعة وسنواصل دعم صندوق المقاصة ب14 مليار درهم

صحة..تحرير حوالي 2800 محضر مخالفة خلال عمليات مراقبة المواد الغذائية

إقبال كبير على مباراة التوظيف الجهوي في وزارة أمزازي

ميزانية 2020 :إعفاء ضريبي عن تفويت السكن الرئيسي

باب سبتة ..توقيف فرنسي يشكل موضوع أمر دولي لتورطه في قضايا تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من جديد في غياب إجراءات احترازية من الحكومة

مجلس المستشارين يحسم في تشديد عقوبات مستعملي الأكياس البلاستكية

قرى مغربية أنجبت جنرالات وصلوا للقمة وآخرين صاروا انقلابيين

التلاعب في مزادات علنية يطيح بمسؤولين

تفكيك عصابة تهجير القاصرين

هكذا سقطت بنات زعماء عرب وأجانب في حب المغرب

لفتيت يراسل الولاة والعمال لرقمنة الحالة المدنية

مديرية الأمن تكشف حقيقة الاتهامات المنسوبة لمسؤولين أمنيين

مدير بنك يختلس مليارين

اعتقال 4 أشخاص على خلفية فيديو سمسار الأحكام القضائية

ساكنة ميدلت تبيت في الخيام والداخلية تستنفر مصالحها

توقيف 4 تونسيات حاولن تهريب مخدرات بمطار مراكش

قطاع التعليم: نقابة وطنية تطالب بضرورة توفير شروط الوقاية من موجة البرد

أطباء التخدير والإنعاش ينتقدون الظروف "الكارثية" لعملهم

قانون المالية 2020 : محامو المغرب يحتجون رفضاً لمنع الحجز على أملاك الدولة

صحيفة مصرية تبرز دلالات احتفال المغرب بذكرى عيد الاستقلال

هزة أرضية جديدة تضرب ميدلت

شاهد لحظة فرار مسؤولين بسبب الهزة الأرضية بميدلت

مندوبية السجون تدخل على خط فيدو سمسار القضاء

الزلزال يضرب ميدلت من جديد وأسر تبيت في العراء

توقيف شخصين مواليين لداعش بالرباط خططا لأعمال إرهابية

تعثر مشروع انجاز 8 مراكز لاستقبال الأشخاص المسنين بالدار البيضاء

يونسكو المغرب يوقع الاتفاقية المعدلة حول الاعتراف بالدبلومات في التعليم العالي
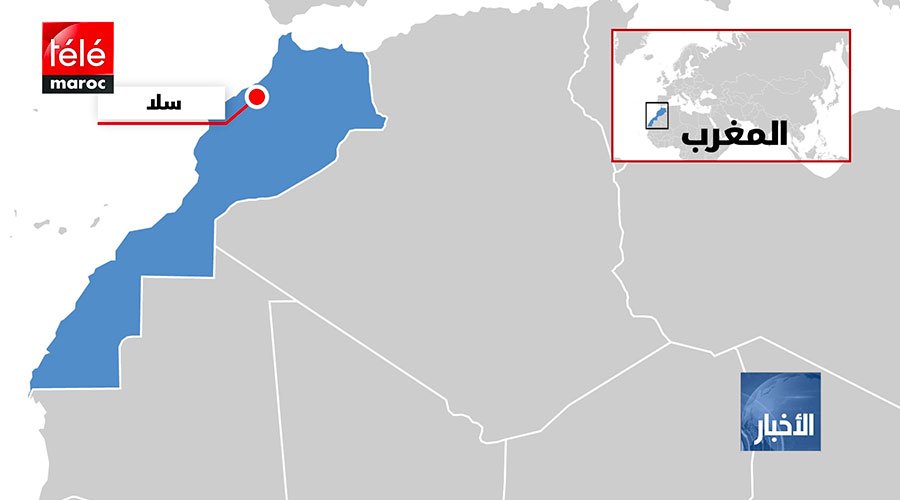
سلا : توقيف 10 أشخاص للاشتباه في تورطهم في تبادل أعمال عنف

البنك الدولي يشيدُ بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال

الدار البيضاء : النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تحذر من الضرر بصحة المستهلك المغربي

جرادة : السلطات الإقليمية تتخذ مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة آثار موجة البرد

سلطات إفران والحسيمة تتعبأ لمواجهة تداعيات موجة البرد القارس

الدورة ال40 للمؤتمر العام: المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بتعزيز التعاون مع اليونسكو

رشوة بخمسة ملايين تطيح بموظف ومستشارين جماعيين

الداخلية تفضح فساد التسيير بمجلس آسفي

توقيف شخص حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بمكناس

الثلوج تتسبب في قطع الطرق وتحاصر المسافرين بميدلت

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 16 نونبر 2019
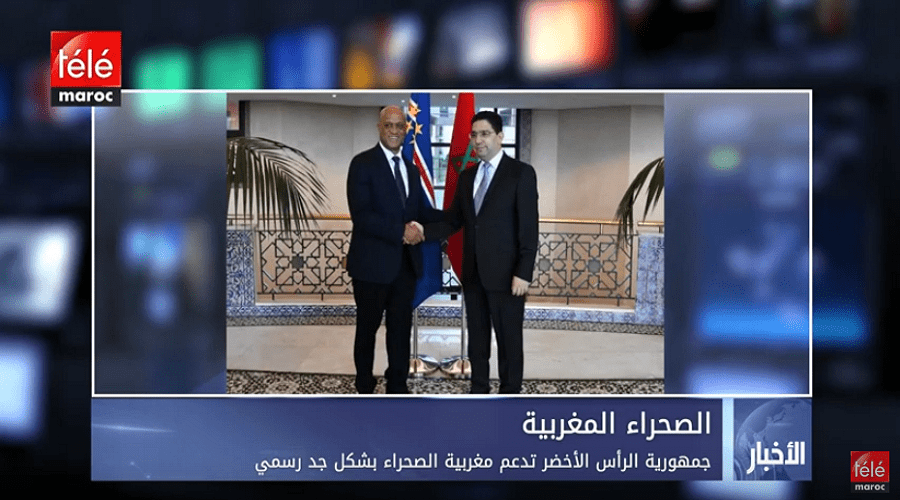
جمهورية الرأس الأخضر تدعم مغربية الصحراء بشكل جد رسمي

التنسيق الخماسي لنقابات الوزارة يهدد بإضراب وطني مفتوح ابتداء من 2 دجنبر

الداخلية تراسل العمال والولاة من أجل رقمنة معطيات الحالة الدنية

توقيف مواطن ايطالي للاشتباه في تورطه في المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

إيقاف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يساوم سيدة للتدخل لفائدة والدتها المعتقلة

حبل العزل يلتف حول رقبة رئيسة مقاطعة الرياض

مندوبية السجون: لا وجود لاتفاق مع CNDH بخصوص معتقلي الحسيمة

تفكيك 13 خلية إرهابية في 2019

100 جماعة محلية تحت مجهر البنك الدولي

اعترافات مثيرة في محاكمة بارون مخدرات

توقيف شخص سرق 32 مليون من وكالة تجارية بطنجة

انتخاب المغرب رئيسا لهذه المنظمة العالمية

الأمن يوقف بطل فيديو المتاجرة في الأحكام القضائية

رفع سن التوظيف بالتعاقد يشعل أزمة داخل الحكومة

نادي قضاة المغرب يدخل على خط فيديو سمسار القضاء

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولي ليوم الجمعة 15 نونبر 2019

التعاون جنوب - جنوب في قطاع الفلاحة محور هام في مخطط المغرب الأخض

إطلاق منصة للتدبير الالكتروني لملفات التقاعد

توقيف خمسة أشخاص يشتبه في حيازتهم لأقراص مهلوسة والاتجار فيها

وزارة الصحة تتكفل بحوالي 882 ألف مريض مصاب بالسكري

900 ألف أجير بالمغرب يستفيدون من إعفاء الضريبة على الدخل

أسر بالرباط تطالب ببناء مصلحة الحروق بمستشفى ابن سينا بعد 7 سنوات من تدشينها

سيدي حرازم توضح أسباب تلوث عينات من المياه المعبأة

لهذا تم إلغاء صفقة اقتناء 700 حافلة بالبيضاء

البناء العشوائي يجتاح جوانب الوديان بمدن الشمال

الأخطار الشائعة لاستعمال المسكنات

جمارك وجدة تحبط تهريب 1680 من طائر الحسون

تطورات جديدة في قضية الرابور الكناوي

هكذا أفلست 8 آلاف مقاولة بسبب صعوبة التمويل

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 14 نونبر 2019

العثماني يهنئ الغنوشي بانتخابه رئيسا للبرلمان التونسي

الالتهاب الرئوي يقتل طفلا في كل 39 ثانية

1395 طفل مغربي يوجد قيد الاعتقال والمغرب مازال يبحث عن بدائل

السفير المغربي يؤكد أن العلاقات المغربية الايطالية تشهد زخما جديد

سلطات سلا ترفع الراية البيضاء أمام أوكار الشيشة

قتلى وجرحى في محاولة سرقة خط للغاز بمصر

عقار يورط وزيرا سابقا

إعادة فتح ملف جريمة "مقهى لاكريم"

رجل أعمل يهرب ب8ملايير

هكذا ردت مندوبية السجون على تقرير مجلس بوعياش

مشروع جديد لربط مراكش وأكادير بـ TGV

مجلس حقوق الإنسان: لا أثر للتعذيب في حق معتقلي أحداث الحسيمة

توقيف مقدم شرطة متلبسا بتلقي رشوة

نصاب يحصل على الملايين من بيع قطع لويز مزيفة

تحذير.. تساقطات ثلجية وحرارة تحت الصفر بهذه المناطق من المملكة

"البيجيدي" يهاجم القضاة ويتوعدهم بنزع سلطتهم

إشكالية دور آيلة للسقوط تُسائل جماعة البيضاء في تنفيذ برنامج إعادة الإيواء

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس البوركينابي إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب شركة تعدين

رئيس الحكومة يقرر رفع سن الترشح للتباري من أجل التعاقد إلى 50 سنة

المكتب المركزي للأبحاث القضائية : إيقاف أحد المتطرفين الموالين ل"داعش" ينشط بمدينة كلميم

حكومة : المغرب ضمن ترتيب الدول الخمسين الأوائل عالميا في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021

13 قتيلا و1828 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

بنعزوز يواصل إغراق الطرق السيارة بالمقربين والأصدقاء

قرصنة البطاقات البنكية تطيح بـ 3 شبان في ميدلت

البلوكاج يخيم على مجلس درعة تافيلالت

صفقات مشبوهة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء

مقترح برلماني باستثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

العثماني يرفع سن الترشح لمباراة التعاقد إلى 50 سنة

الكلاب والجرذان تلتهم 6 ملايير من خزينة الدولة

صيد ثمين في قبضة البسيج بكلميم

سن الزواج عند المغاربة يرتفع بـ8 سنوات

فرق الأغلبية بمجلس النواب تؤيد منع الحجز على ممتلكات الدولة

العثماني: المغرب سيواصل دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا

شروط جديدة للتعيين في المناصب العليا وتمديد سن التقاعد بالجماعات الترابية

معبر باب سبتة:إيقاف مواطنة رومانية بحوزتها 159 كلغ من مخدر الشيرا

اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: الاندماج المغاربي لبنة أساسية في مسلسل الاندماج القاري

وزارة الاقتصاد والمالية تتجه للسماح للمغاربة بفتح حسابات بنكية بالعملات الأجنبية

أحداث الحسيمة: الإجراءات التأديبية في حق بعض السجناء احترمت جميع الشروط القانونية

توقيف جزائري متورط في سرقة داخل فندق بالبيضاء

دراسات تكلف مجلس المدينة 6 ملايين درهم لتأهيل أسواق بالبيضاء

تعثر إنجاز 400 مرآب مخصص لعربات نقل البضائع بالدار البيضاء

إيقاف تنفيذ حكم قضائي يشرد 46 عائلة لعمال شركة للنقل بعين حرودة

انهيار أقسام دراسية كاد يتسبب في كارثة بتارودانت

تحذيرات من جراثيم خطيرة في مياه سيدي حرازم والشركة توضح

لفتيت يراسل الولاة والعمال بخصوص سن الإحالة على التقاعد

حلاقو المشاهير.. حكايات مع رؤوس السياسيين والفنانين والرياضيين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الاثنين 11 نونبر 2019
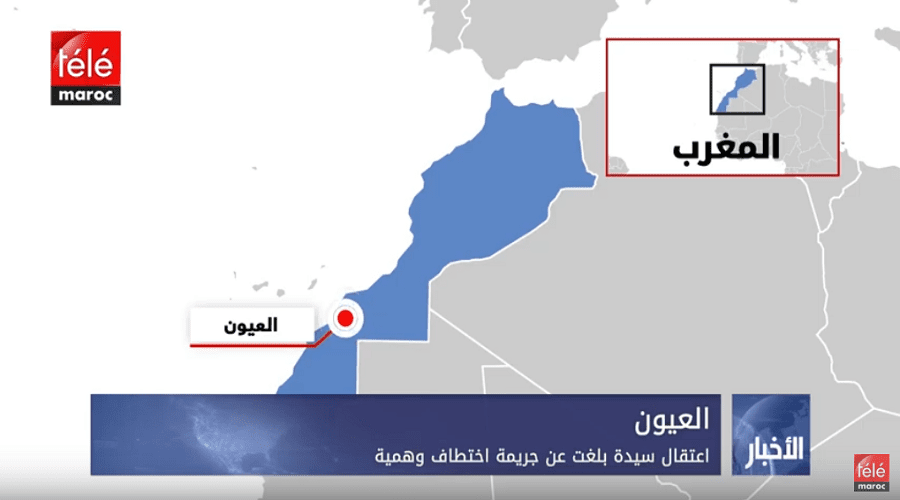
اعتقال سيدة بلغت عن جريمة اختطاف وهمية

المكفوفون يصفون قرار الحكومة توظيف 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحايل

وفاة مواطن مغربي بعد إصابته بأزمة صحية على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية

نواب برلمانيون مغاربة يشاركون في مؤتمر إقليمي حول وضعية اللاجئين

نصف مليون شخص يقبلون على حفظ القران في 14 ألفا من الكتاتيب القرآن

تاريخ... المذكرات المجهولة لصديق القصر

وفاة مغربي إثر أزمة صحية على متن طائرة تركية

الحزب الاشتراكي يتصدر الانتخابات الإسبانية واليمين المتطرف يتقدم

التبليغ عن جريمة اختطاف وهمية بالعيون تكلف عشرينية حريتها

أمزازي يؤكد شروع وزارة التربية الوطنية في تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتعليم

30 مليون درهم لتوفير سيارات إسعاف لنقل المعوزين والتعثر يلازم المشروع

اليعقوبي يمهد لعزل رئيسة مقاطعة الرياض

تحذير.. أمطار قوية ورياح عاصفية بهذه المناطق من المملكة

برنامج تحدي القراءة العربي : تأهل 5 متنافسين ضمنهم تلميذة مغربية الى المرحلة النهائية لنيل اللقب

المغرب يرسل أكثر من 22 ألف باحث عن الشغل إلى دول العالم

أمزازي يؤكد شروع وزارة التربية الوطنية في تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتعليم

الملك يصدر عفوه السامي على 300 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

الملك يترأس حفلا دينيا في مراكش إحياء لليلة المولد النبوي

الشروع في محاكمة متهمي قضية مقهى لاكريم

خروقات مالية وإدارية خطيرة تهدد رؤساء جماعات بالعزل

الديستي تفك لغز سرقة 3 وكالات لتحويل الأموال

قرض جديد للمغرب من البنك الدولي بـ 300 مليون دولار

المخترع المغربي يوسف العزوزي يفوز بلقب أفضل مخترع مغربي
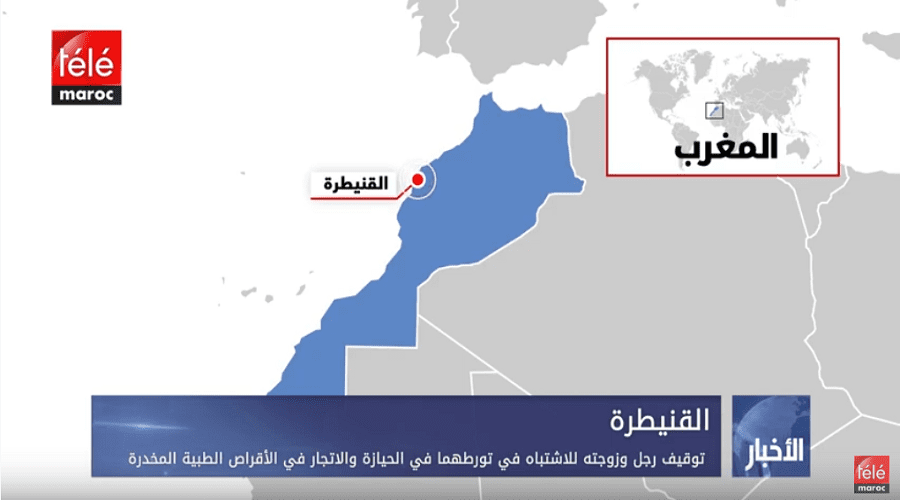
توقيف رجل وزوجته للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة

صندوق النقد الدولي ينفي خضوع المغرب لضغوط في تحرير سعر الدرهم

إيفانكا ترامب تزور المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات
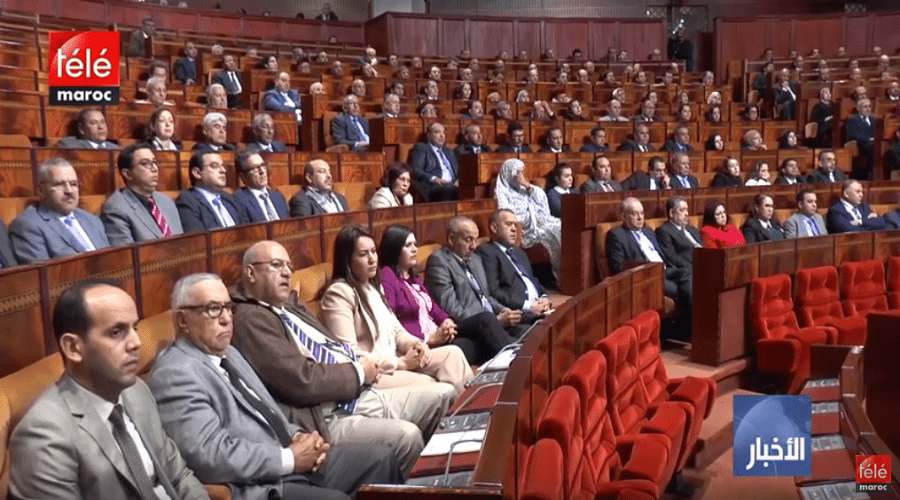
نواب يستعجلون الإعداد للانتخابات ويتساءلون عن دعم الأحزاب

هكذا عجزت مجالس الشمال عن حل ملفات التدبير المفوض

الملك محمد السادس يترأس اليوم السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بمراكش

الحموشي يدخل على الخط في اتهام أمنيين بالتلاعب في محاضر
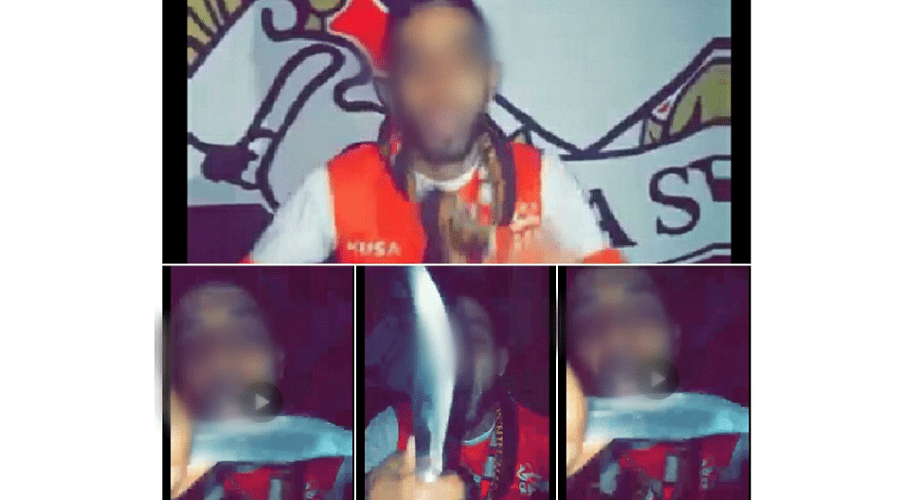
السجن لشاب من أكادير ظهر مسلحا في فيديو وهو يحرض على العنف ضد جمهور فريق رياضي

سقوط طالبة من الطابق 5 لأحد الفنادق وسط الرباط

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 08 نونبر 2019

معاناة طلبة مغاربة بالمدارس العليا الفرنسية حرموا من منح الاستحقاق

ضياع خمسين ألف يوم عمل بالمغرب بسبب 85 إضرابا

إيقاف شخصين للاشتباه في حيازتهما للمخدرات

الفساد الإداري يعزل عشرات المنتخبين المغاربة بالجماعات الترابية

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف إيفانكا ترامب

منتخبات ألمانيا لن تخوض مبارياتها في هذه الدول

بعد عرس مبدع الأسطوري هكذا تعيش مدينة الفقيه بنصالح

مستجدات قانون الحجز على ممتلكات الدولة

معاناة طلبة مغاربة بالمدارس العليا الفرنسية حرموا من منح الاستحقاق

فضيحة ولادة سيدة بالشارع تطيح بالمدير الإقليمي لوزارة الصحة

أموال المخدرات تجر البرلماني مضيان إلى القضاء

30 مليار تطيح بمسؤول بسوق الجملة بالبيضاء

الحكومة تفوت خمس مستشفيات جامعية بـ4.5 ملايير درهم

صراعات الأجنحة داخل التعاون الوطني تحرج المصلي

هذه خطة الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية

مديرية الأمن ترد على زيان بشأن اعتقال الكناوي

بالفيديو.. إيفانكا ترامب تزور حقول الزيتون بسيدي قاسم

ميناء طنجة المتوسط يسجل أكبر ارتفاع في مجال مؤشر الربط خلال العقد الأول منذ تشغيله

الداخلية.. رصد أزيد من 22 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي

نجل دبلوماسي في بلجيكا متورط في قضية حنان بنت الملاح

الكونغرس يباشر جلسات استماع علنية قد تنتهي بعزل ترامب

زيارة إيفانكا ترامب تستنفر مسؤولي عمالة سيدي قاسم

الملك يدعو للتفكير في ربط مراكش وأكادير والجنوب بخط السكة الحديد

الملك: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء و163 دولة لا تعترف بالكيان الوهمي

تحرير السلطات أسواقا عشوائية يخلف أزبالا متراكمة بالرباط

الداخلية تتابع 82 رئيس جماعة وتعزل 84 رئيسا

التامك يرد على تدوينة طليمات

إيفانكا ترامب تحل بالمغرب

شاشة تفاعلية : الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب

ماء العينين تنتقد الشيخ الكتاني بسبب بلافريج

فضيحة تهز وزارة التجهيز والنقل

شاهد آخر مكاين فالتهريب...أطنان من المخدرات وسط الرخام في فاس

تحالف البام والبيجيدي يحدث أزمة داخل الاستقلال

هكذا تنهب مافيا العقار الأراضي السلالية قبل تمليكها

النيابة العامة مستعدة للنظر في مزاعم الزفزافي بهذا الشرط

الحكومة ترخص لمصنع متفجرات في أكادير

متابعة 5 موثقين و20 عدلا

لفتيت يدعو للرفع من نجاعة العمل الجهوي

الملك يوجه خطابا بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء

إسبانيا تبحث عن أزيد من 16 ألف عاملة مغربية

أخنوش يؤكد أن الفلاح الصغير والمتوسط في قلب برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر

الدار البيضاء ..الإفراغ يهدد عائلات بعين السبع والساكنة تطالب وزارة الداخلية بتعويض عن الضرر

مع حلول الشتاء.. أحياء بالرباط تغرق في مياه الأمطار ومواطنون يوجهون نداءات استغاثة

انخفاض نسبة وفيات الأطفال ب22 في المائة بين 2011 و2018

لفتيت يعلن نهاية تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الكاميروني على إثر حادث بافوسام

بنعبد القادر يفضح أرقام بوليف حول حوادث السير

لفتيت يحرم المنعشين العقاريين من أراضي الدولة بالمدن

مديرية الأمن تحذّر من النصابين باسم العروض الإعلانية على النيت

انتحال صفة رئيس تعاضدية الموظفين يعرض عبد المومني للمتابعة

هذا ما قررته النيابة العامة في حق الرابور الكناوي

سبع سنوات سجنا نافذا للبرلماني مول 17 مليار

العلبة السوداء لأكثر الأحزاب المغربية إثارة للجدل

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الاثنين 04 نونبر 2019

العلم الوطني.. حكاية علم تغيرت أشكاله وأريق على جوانبه الدم

الأكاديميات تواصل الاقتطاع الشهري من أجور أساتذة التعاقد حتى ماي 2020

أكادير.. الأمن يوقف مروجا لمخدر الشيرا والأقراص المهلوسة

الحكومة تحذر صيدليات بالمملكة وتعد قوانين جديدة لمهن الطب

العثماني يتهم جهات بقيادة حملات تبخيس ويدعو الأحزاب إلى التدخل

الملك محمد السادس يهنئ رئيس كومنويلث الدومينيك بمناسبة احتفال الكومنويلث بعيده الوطني

حريق يجبر قطارا يربط بين مراكش وطنجة على التوقف بالبيضاء

احتارين يكشف سبب اختياره اللعب لهولندا عوض المغرب

الكاشو والحرمان من الزيارة عقوبة السجناء المتمردين على خلفية تسجيل الزفزافي

اندلاع حريق في قطار بالبيضاء و ONCF يوضح

النيران تلتهم حافلة ركاب بأمسكرود

أخنوش: يجب التركيز على تحسين العيش اليومي للمواطن

دراسة.. هذه المناطق الساحلية ستختفي من المغرب

الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 02 نونبر 2019

محاكم المملكة تبت في 231 ألف قضية حادثة سير
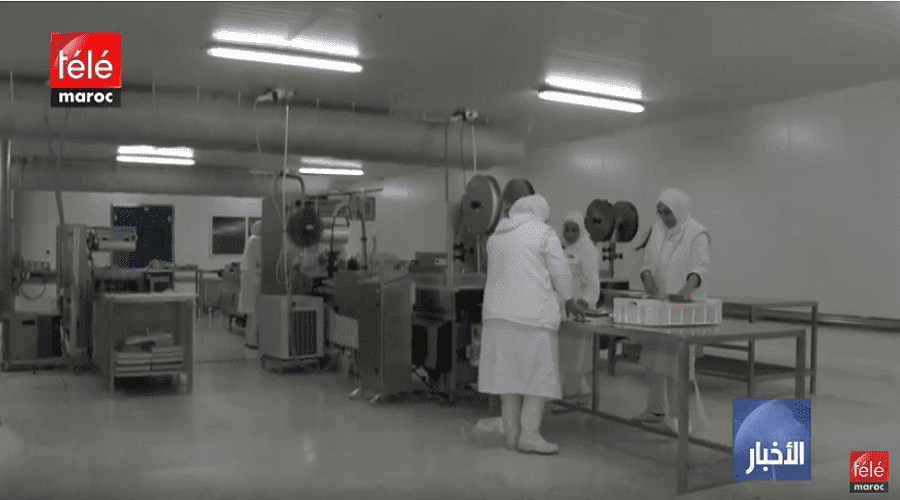
تجنب الإفلاس يدفع المصدرين إلى مطالبة الحكومة بتعديلات جبائية
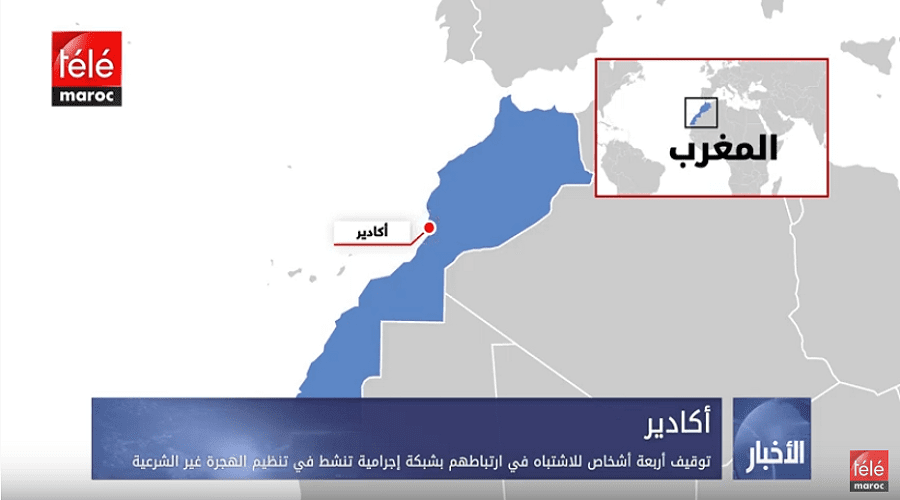
توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية

أخنوش: العقار الفلاحي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

هكذا كانت خلية طماريس تحضر لهجوم بمتفجرات وسموم قاتلة

المجلس الأعلى للحسابات: هذا مآل التوصيات الصادرة عن المجلس

المندوبية العامة لإدارة السجون :بحث حول تسجيل صوتي منسوب للزفزافي

دفاع ضحايا بوعشرين يطعن بالنقض

أساتذة التعاقد يهددون بالعودة للإضراب

بوريطة: رسائل القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص الصحراء

رجال الحموشي يتعقبون أبناء أعيان بسبب الاتجار في المخدرات

تسجيل صوتي للزفزافي يطيح بمدير سجن و3 موظفين

لهذا جر العثماني مدير حملته الانتخابية للقضاء

أمن القنيطرة يوضح حقيقة فيديو تريبورتور سيدي سليمان

المادة 9 من قانون المالية تشعل الخلاف داخل الحكومة

الصراعات السياسية تحرم الرباط من ميزانية 2020

زهراش: على بوعشرين ومن معه دفع رواتب الصحافيين العالقة عوض مساومة الضحايا لتحرير تنازلات

شكاية تهدد باسقاط مشروع قانون المالية

الحكومة تلجأ لتأمين الغاز والمحروقات

حقوقيون يضعون شكاية ضد حارقة العلم الوطني بباريس
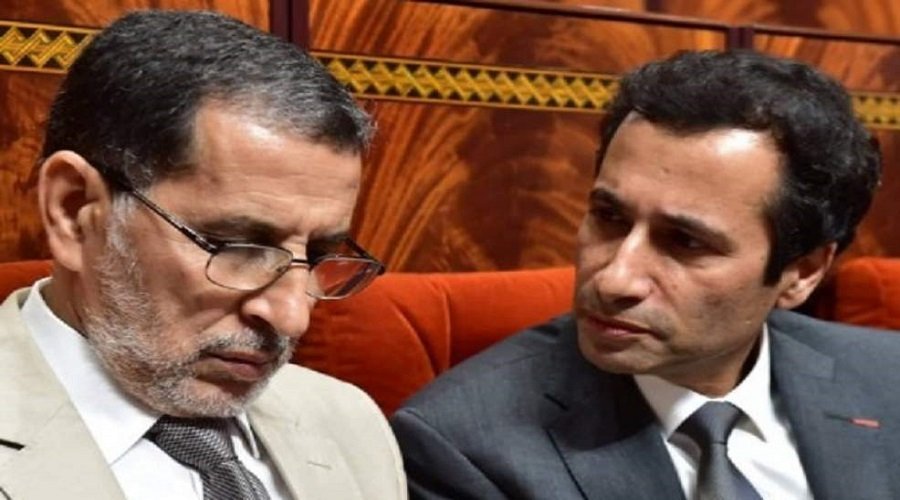
الحجز على 10 ملايير درهم من أموال الدولة خلال 3 سنوات

خروقات وتجاوزات بأحياء البيضاء بسبب النفايات الهامدة والاستثنائية

تأكيد حكم الإعدام في حق المتهمين في قضية إمليل

نقابات التعليم العالي تنتقد تمرير المخطط البيداغوجي دون دراسته

51 في المائة من خريجي الجامعات المغربية تتجاوز بطالتهم 12 شهرًا

الكويت تجدد التأكيد أمام مجلس الأمن على موقفها الداعم للحكم الذاتي

قانون فرنسي جديد يحظر ارتداء الأمهات للحجاب

هذه هي المفاجاة التي حصلت على متن طائرة لارام المتوجهة من البيضاء

هذا ما قضت به المحكمة في حق راقي بركان

20 مليون كتعويض لموظفي وزارة الشباب عن الألعاب الإفريقية

أستاذان وخياط اختلسوا الملايير من ودادية سكنية

مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو لعام في الصحراء المغربية

المحكمة تقضي بإعدام المتهمين بذبح السائحتين الاسكندنافيتين

الأمن يطارد السوري ممول خلية طماريس

حزب الاستقلال يتهم الحكومة بنشر الرعب الضريبي

إحالة 100 ملف فساد على محاكم جرائم الأموال

8 آلاف مقاولة أفلست في المغرب

بالفيديو.. حجز بضائع مهربة بقيمة 17 مليون درهم بطنجة

ثمن البرّاكة بالقنيطرة يصل إلى 60 ألف درهم

ائتلاف ينادي بسنّ ضرائب على الكربون والتلوث في ميزانية 2020

مجلس المستشارين.. وزير الداخلية يعترف بتفشي الذبيحة السرية

التعويض عن فقدان الشغل... أكثر من 54 ألف مستفيد

توظيف الأساتذة بـالكونطرا... إعادة النظر

معطيات رسمية .. المغاربة الأقل تبرعا بالدم

الدار البيضاء:صناعة الطيران بالمغرب... وحدات جديدة
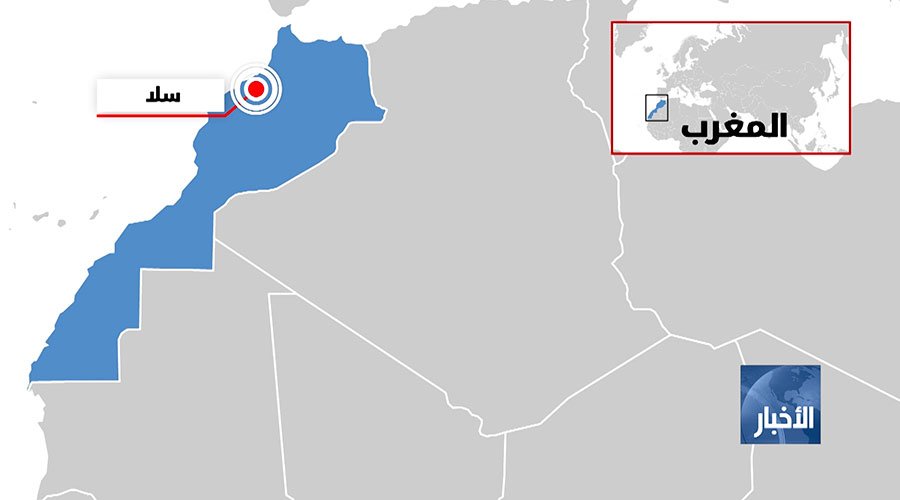
الحريك يصل ضفة واد أبي رقراق واعتقال 23 مرشحا

مديرية الأمن تحذر المواطنين من المشعوذين

هذه مميزات بطاقة التعريف الجديدة

مجالس الحكومة تحولت إلى اجتماعات لتوزيع المناصب

سرقة أزيد من 260 هاتفا من قسم المحجوزات بمحكمة مراكش

ملف صفقات كوب 22 على طاولة عبد النبوي

وكالة عمومية تكبد الدولة 11 مليارا

أراضي الدولة تجر مسؤولين للتحقيق

ضبط 111 مرشحا للهجرة غير المشروعة بوجدة

رجال الحموشي يفكون لغز جريمة حي الملاح بالرباط
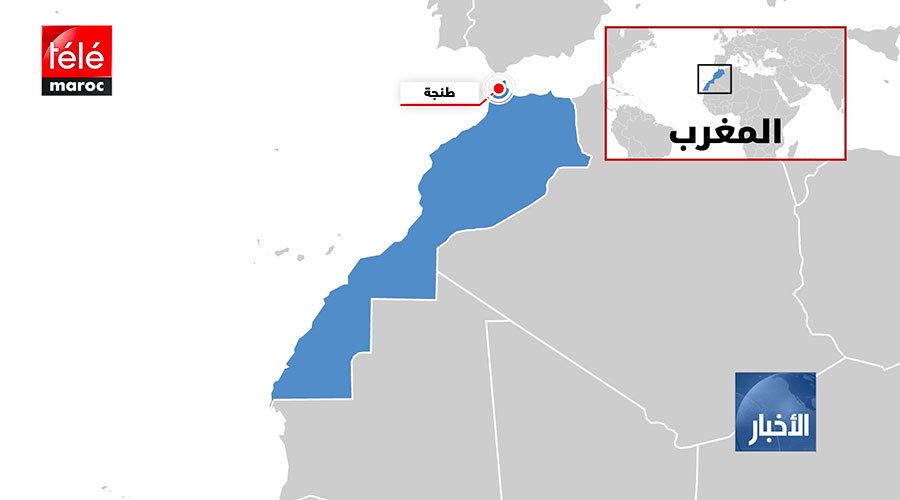
إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و830 كيلوغراما من مخدر الشيرا

تقرير يصنف المغرب ضمن أفضل الوجهات السياحية في 2020

تعيين نور الدين بشيري رئيسا مؤقتا للاتحاد خلفا لمزوار

العثماني: المغرب سيكون بين الـ50 الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021

وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع الأساتذة المتعاقدين

فاتح شهر ربيع الأول 1441 غدا الأربعاء

مصحات تغتني على ظهور المرضى

سيارة فاخرة لمن يقتني شقة

بالفيديو.. حروب طاحنة في غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط

هذه تفاصيل تقرير أكابس الذي أطاح بعبد المومني

20.000 درهم تمنع بطلة مغربية في الحساب الذهني من بطولة عالمية

هذه كواليس تعيين وزراء بدون حقائب

وسطاء يسطون على 76 مليارا في أسواق الجملة

أزيد من 80 بالمائة من لحوم البيضاء مهربة

حقوق الملكية تطيح بأغنية لمجرد سلام من اليوتيوب

عندما كان القياد يجمعون الضرائب عن الحشيش

المغرب سوى وضعية ما يناهز خمسين ألف حالة مهاجر في وضعية إدارية غير نظامية
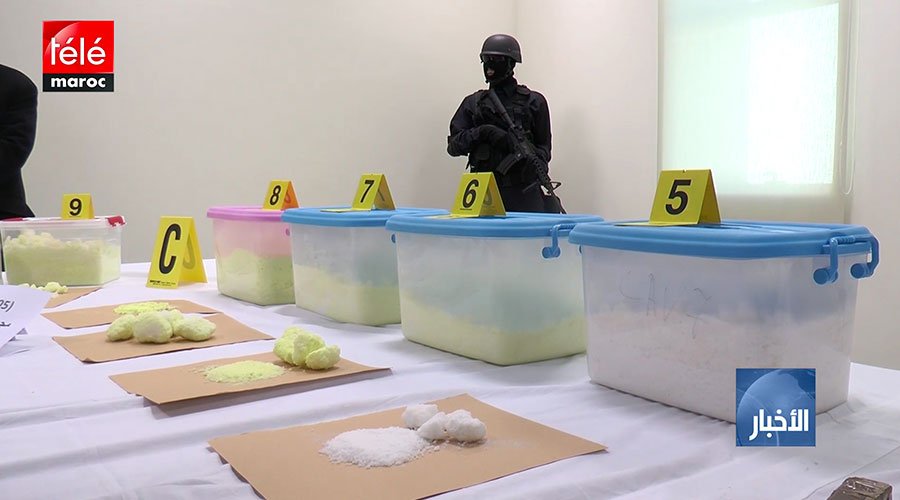
المديرية العامة للأمن الوطني تكشف نزوح المتطرفين نحو المناطق النائية في المغرب

مهنيو التصدير يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية القطاع

عناصر الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف 5 أشخاص أبدوا مقاومة عنيفة

من هو خليفة البغدادي في زعامة داعش

الخيام : خلية طماريس خططت لتنفيذ هجمات خطيرة بالمملكة

مدير مديرية الأدوية يلوح بالاستقالة لهذا السبب

لفتيت يجبر رؤساء الجماعات على نشر ميزانياتهم للعموم

انفصاليون يحرقون العلم المغربي بباريس ومجلس الجالية يرد

استياء في صفوف المهنيين بعد تعثر إحداث وتأهيل 6 محطات نموذجية لسيارات الأجرة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 26 أكتوبر 2019

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تنشط بالدار البيضاء ووزان وشفشاون

عريضة مغربية تطالب بتسريع إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن

التمور المصرية تلقى رواجا لدى زوار الملتقى الدولي للتمور

تبرئة أدوية من المواد المسرطنة بعد سحبها من الصيدليات المغربية

المحكمة ترفع سجن توفيق بوعشرين إلى 15 عاما نافذا

مصدر أمني ينفي مزاعم استهداف خلية طمارس لمدارس أجنبية

توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بالحدود الشرقية للمملكة

المطالبة بالاستماع للرميد والمغراوي في قضية ذبح السائحتين

حوايج البال تجر المتلاعبين بمنقولات التعاون الوطني إلى الحبس

محكمة الاستئناف ترفع عقوبة بوعشرين إلى 15 سنة

بالصور.. مداهمة ضيعة نواحي طنجة وحجز 8 أطنان من المخدرات

الداخلية تكشف المخططات الإجرامية للخلية الإرهابية المفككة

اختلالات بصفقة النقل بآسفي تفوق مداخيلها 36 مليارا

ارتفاع حركة النقل الجوي للمسافرين خلال شهر شتنبر الماضي بنسبة 9,14في المائة

عزيز أخنوش يفتتح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمور

مصالح وزارة التجهيز والنقل توصلت بـ3523 ملفا لتجديد الحظيرة خلال سنة 2019

قهوة نواة التمر منتوج صحي و فريد يميز الملتقى الدولي للتمور

رئيس الحكومة يمثل الملك محمد السادس بالقمة الأولى "روسيا-إفريقيا"

القضية فيها مسدسات وبنادق... البسيج يفكك خلايا إرهابية في دار بوعزة وشفشاون ووزان

اكتشاف مواد مسرطنة في حليب الأطفال

حمار يفضح رئيس المجلس الإقليمي للصويرة

تعويضات رباح ونوابه تصل إلى 74 مليون

الحكومة تتراجع عن المادة 9 من قانون المالية

أخنوش: إنتاج التمور زاد بـ 41% وتم غرس 3 ملايين نخلة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 24 أكتوبر 2019
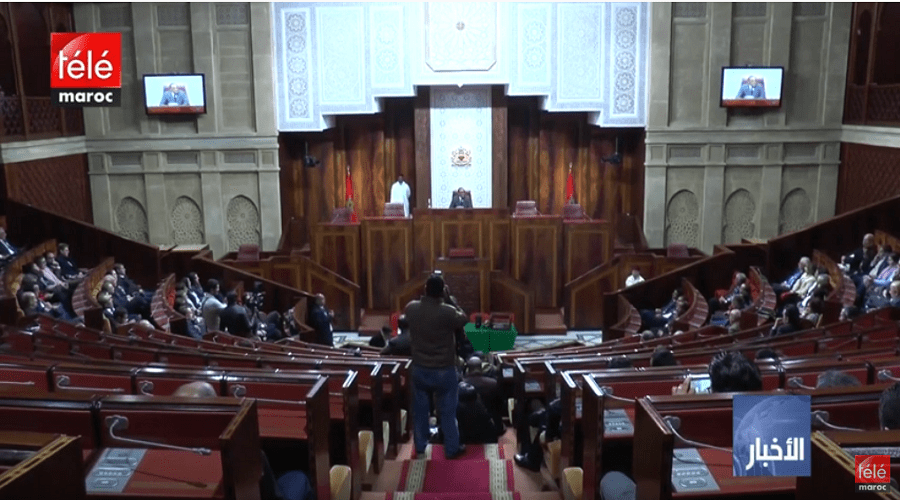
أبناك مغربية تلزم الزبناء بالإدلاء بجرد لممتلكاتهم بدون سند قانوني

المغرب يشارك في المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي ويوقع اتفاقية بحوالي ملياري أورو

عمر هلال: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد للخلاف حول الصحراء المغربية

الملك يهنئ جوستين ترودو بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الجهاز التنفيذي بكندا

بنشعبون يتوعد مهربي الأموال بالحجز على ممتلكاتهم في الخارج

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين

اعتقال قاض بتهمة تسلم رشوة من سيدة بأكادير

حذف وزارة الاتصال يورط العثماني

بنوك تجبر زبائنها على جرد ممتلكاتهم

هذا ما قضت به المحكمة في حق معترض الموكب الملكي

السطو على عقار يطيح بخليفة قائد وأعوان سلطة

تبيض أموال يسقط رجال أعمال

ثلاثة شبان يدهسون شرطيا باولاد تايمة

هذه حقيقة الزيادة في أسعار قنينات الغاز

العثماني يعفو عن أصحاب الأموال المكدسة داخل الكوفرفورات

بطل مغربي في التايكواندو يختار الهجرة عبر قوارب الموت ويرمي ميداليته في عرض البحر

توقيف 8225 شخصا خلال عمليات أمنية نوعية بالبيضاء

توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج ابتداءً من سنة 2021

12 قتيلا و2003 جريح حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

توقيف شخص لتورطه في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

حوالي 70 ألف موظف عمومي سيحالون على التقاعد في أفق سنة 2024

حاويات أزبال متكسرة وتراكم نفايات في أحياء عدة يسائل منتخبي الرباط

بعد مغادرته للحكومة الصمدي يعود إليها من هذا الباب

فضيحة نصب واحتيال تتفجر بتعاضدية الموظفين

احتقان بوزارة الصحة بسبب إلزامية الخدمة
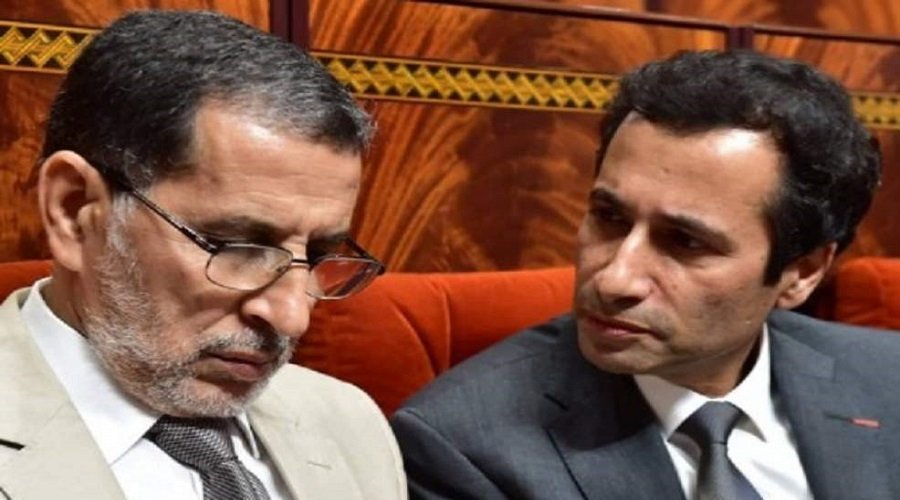
منع الحجز على اموال الدولة يثير الانتقادات لقانون المالية

مادة ملغومة بمشروع قانون المالية

أمطار عاصفية من المستوى البرتقالي بهذه المناطق من المملكة

نفقات الموظفين تجاوزت 112 مليارا

الحكومة تعتزم رفع نسبة الاقتراض إلى 14 في المائة برسم سنة 2020

إحداث صندوق بـ6 مليارات درهم لتمويل مشاريع الشباب

تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد

عرض سيارات الدولة للبيع بالمزاد العلني يطيح بشبكة للنصب

شاب يقتل والده ويقطع جثته بجماعة عين حرودة بالبيضاء

بنعزوز يواصل إغراق شركة الطرق السيارة بالمقربين منه (وثيقة)

مجلس آسفي بدون ميزانية والعمدة يستنجد بالمعارضة

الشوباني مهدد بالعزل من رئاسة الجهة

المغرب يستضيف أضخم مناورة في إفريقيا

الحكومة تعتزم اقتراض 9700 مليار سنتيم

العثماني يعفو عن مهربي الأموال ويتخلى عن 2800 مليار

مصرع شخص في حادث لـطرامواي البيضاء

تصريحات منفلتة.. عندما تزل ألسنة خدام الدولة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019

اللجنة الرابعة: دعم معزز ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي
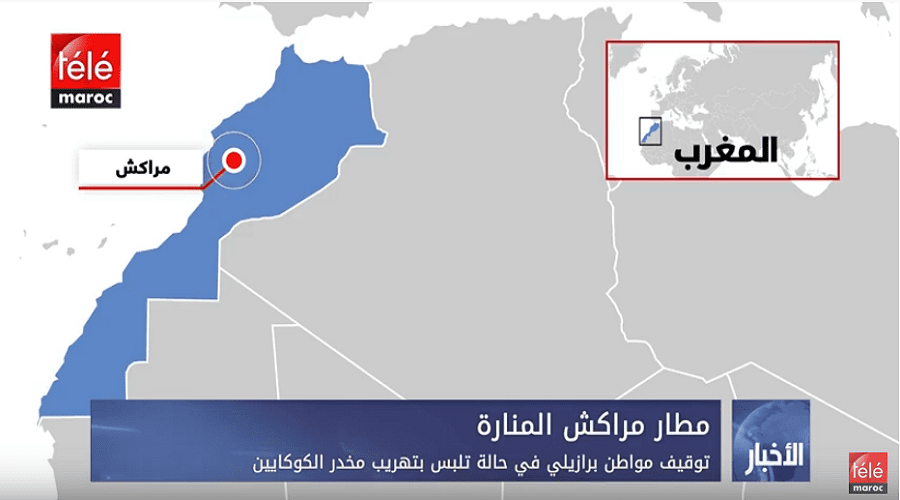
توقيف مواطن برازيلي في حالة تلبس بتهريب مخدر الكوكايين

أزيد من 3000 مقاول شاب ينجون من خطر دخول السجن

الملك : العدالة من المفاتيح المهمة لتحسين مناخ الاستثمار

التحاق وزيرة السياحة بالمكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار

تيار ولد رشيد يسيطر على قيادة الشبيبة الاستقلالية

المغاربة وتوانسة... مد وجزر من الملك باي إلى قيس سعيد

منع صرف شيكات بـ9 آلاف مليار سنتيم

الحكومة تحصن أموالها من الحجز القضائي

تحذير.. أمطار عاصفية ورياح قوية بهذه المناطق من المملكة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 19 أكتوبر

أرباب حافلات بالقامرة يعلنون إفلاسهم بعد انتعاش حملات covoiturage على وسائل التواصل الاجتماعي

إطلاق مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر

الحكومة تقلص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفا

متابعة عمدة آسفي بالتزوير في مشروع ملكي كلف 146 مليارا

الهاكا تنذر إذاعة "ميدي 1" بسبب تغليط المستمعين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 18 أكتوبر

تقليص عدد أعضاء الحكومة سيمكن من تحقيق "نجاعة أكبر وتنسيق أفضل"
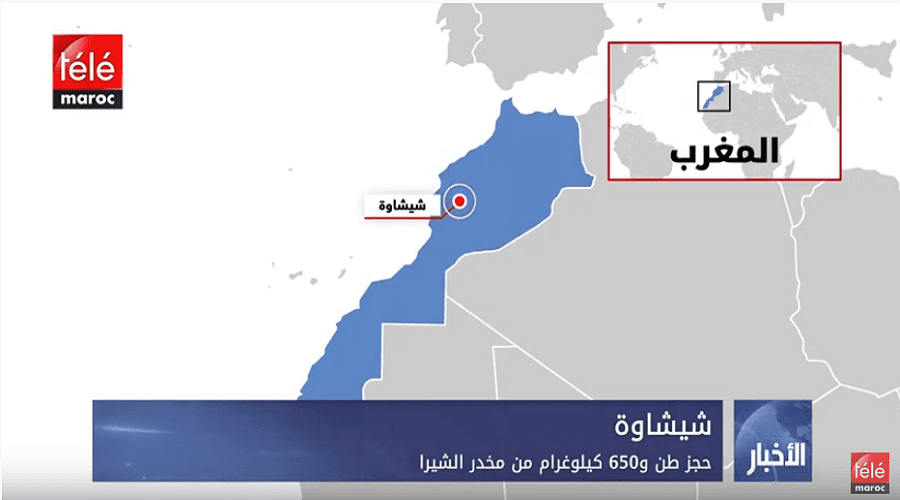
حجز طن و650 من مخدر الشيرا

الحكومة تخصص 26 مليارا لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة

فيلات فاخرة للشيشة تغزو جماعة السهول بسلا

المغرب الثامن عربيا في مؤشر الجوع العالمي

مديرية الأمن تعلن مباراة لتوظيف 7700 شرطي

مسؤولون كبار يحتلون سكنات الدولة بالمليارات

هذه أبرز الملفات التي تلاحق العماري بعد الاستقالة ومغادرة البلاد

خريجة "ستار أكاديمي" تفضح التحرش الجنسي بالمجال الفني

المحكمة تجرد إيمان صبير من رئاسة جماعة المحمدية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 17 أكتوبر

عمر هلال: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية

المغرب يحل في المركز 42 عالميا والثامن عربيا ضمن مؤشر الجوع العالمي

السطو على عقارات يجر 4 موظفين للتحقيق

صفقة وهمية للكهربة تجر مستشارا ورئيس جماعة للتحقيق

مسؤول يرسل مقاولا حاول إرشاءه بـ6 ملايين إلى السجن

سوء التغذية والسمنة يتهددان حياة الأطفال المغاربة

أرقام صادمة حول وضعية المسنين في المغرب

خارجون عن القانون يراسلون عبد النبوي

مشروع قانون المالية على طاولة المجلس الحكومي

هجرة جماعية من تلاميذ المدارس الخاصة إلى التعليم العمومي

عفو ملكي عن هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في قضيتها

الداخلية ترد على اتهامات "البيجيدي" بحماية "البلطجية"

قراءة في الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 16 أكتوبر
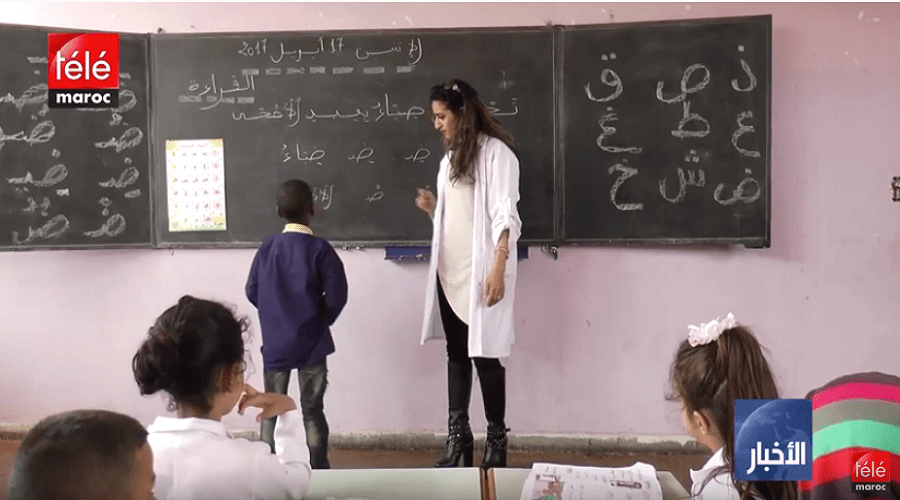
أمزازي يعد بإعداد دراسة حول نفور التلاميذ من التعليم العمومي

ارتفاع حركة النقل بنسبة 11.68 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى

بعد الرجاء.. فضيحة تحرش جنسي بيوسفية برشيد

340 ألف مغربي مصابون بالسكيزوفرينيا

بعد استقالة مزوار..ضبابية حول خليفته على رأس الباطرونا

9 ملايين مغربي مهددون بالفقر

الداخلية تسمح بتسجيل الأطفال خارج الزواج في "الحالة المدنية"

12 سنة سجنا لـ"دينامو" الهجرة السرية بالشمال

حاليلوزيتش في موقف صعب بعد سقوط المنتخب أمام الغابون

أعضاء ورؤساء جماعات ينشرون غسيل المجلس الإقليمي بالصويرة

أخنوش يترأس افتتاح سوق الجملة الجديد للسمك في إنزكان

قراءة في الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 15 أكتوبر

انهيار منشأة بجامعة مولاي إسماعيل قبل زيارة مجلس جطو

هكذا سيتم تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق

العثماني يتجاهل التعليمات ويحتفظ بصورة غير رسمية للملك

قطار ينحرف عن سكته قرب بوسكورة

الأساتذة المتعاقدون يعودون للاحتجاج بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة
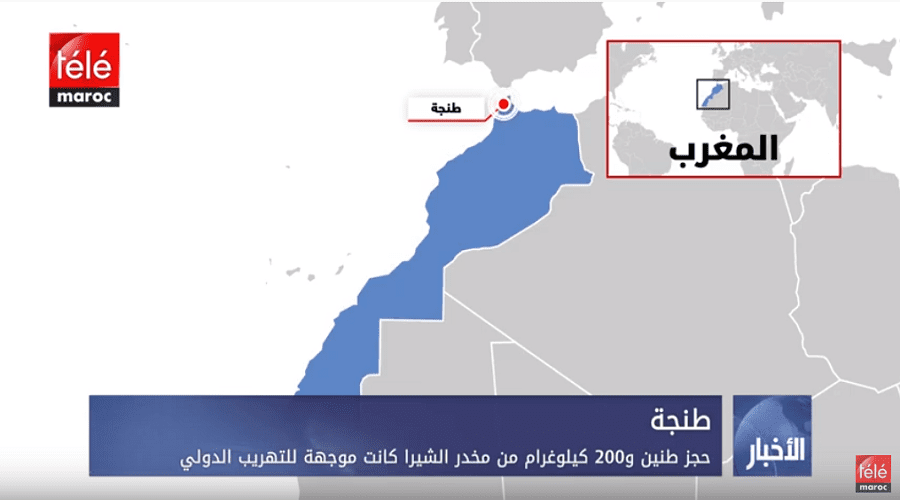
حجز طنين و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي

الملك يهنئ قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

الداخلية تشرع في عزل رؤساء جماعات لهذا السبب

اعتقال ثلاثيني انتحل صفات مسؤولين كبار في الأمن والدرك

الداخلية تكشف حقيقة اتخاذها عقوبات تأديبية في حق رجال السلطة

قراءة في الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 14 أكتوبر

مقتل سائح فرنسي وإصابة عسكري في عملية طعن بتونس

الداخلية تتجند لاسترجاع أملاك الجماعات

احتجاجات تطيح بمدير عام ريضال في الرباط

مسعود أكوزال.. من "عطّار" إلى نادي الأغنياء

أمهات الوزراء ورجالات الدولة

هكذا علق القروي على فوز سعيد بالرئاسة التونسية

سائق مخمور يدهس مجموعة مواطنين في محل للمأكولات بمراكش

الحرية الفردية تحرج قيادة التوحيد والإصلاح

بركة يقطر الشمع على "حكومة العثماني2"

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 12 أكتوبر

القوات المسلحة الملكية لم ولن تقوم بأي حوار مع جبهة "البوليساريو"

هذه حقيقة انقطاع الكهرباء عن الدار البيضاء

هذه أهم رسائل الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان

الاستيلاء على عقارات يجر محاميا وعدلا أمام قاضي التحقيق

الملك: لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة

Eagle Hills الإماراتية تطيح بالمريني وتعين مكانه اليعقوبي

الملك يحث الحكومة وبنك المغرب على دعم الخريجين الشباب

الملك يدعو الأحزاب لخدمة المواطن بعيدا عن الصراعات الفارغة

إصابة 4 أشخاص في عملية طعن ببريطانيا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 11 أكتوبر

إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم قطاع التربية بالمغرب

البنك الدولي يوصي المغرب بالإبقاء على "الإجراءات التقشفية"

الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة

هذه هي العقوبات الصادرة في حق مخالفي الخدمة العسكرية

نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية

هذه حصيلة حريق مستودع حافلات "نقل المدينة"

التحقيق في صفقة سيارات إسعاف كلفت 600 مليون

بالفيديو.. حريق مهول بمستودع حافلات "نقل المدينة" بالبيضاء

الملك يترأس افتتاح السنة التشريعية

التوفيق يمنع الولائم عن الأئمة

التحقيق في اختلالات بـ40 مليارا

لفتيت يشهر الحرب على اللوحات الإشهارية

خُمس المغاربة مصابون بأمراض عقلية ونفسية

السكال يرصد الملايير كنفقات لتسمين حسابات المقاولين والمزودين
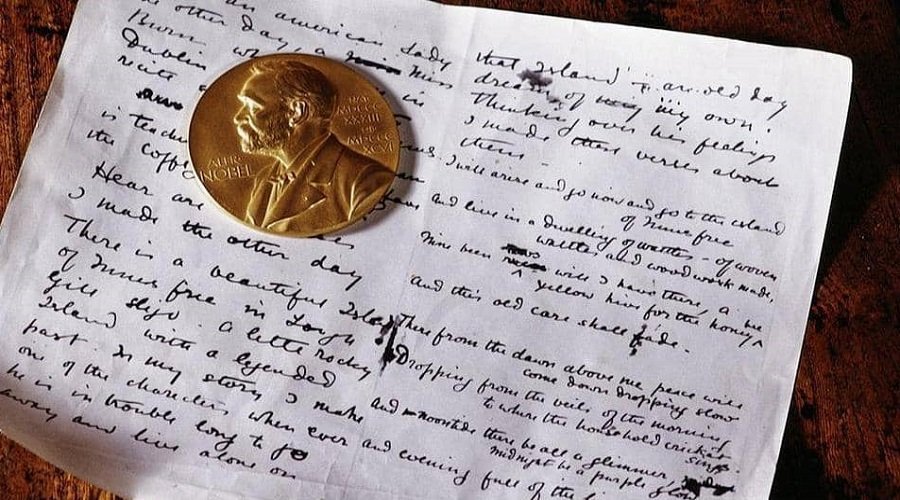
الكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب لسنة 2018

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 10 أكتوبر

الملك يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة

بالفيديو.. ملاكمات وتراشق بقنينات المياه في مجلس الرباط

فرحة عارمة لمستخدمي تعاضدية الموظفين بعد الإطاحة بعبد المومني

أخنوش: قطاع الحبوب يساهم في خلق 30 في المائة من مناصب الشغل

محامون يصطادون الوكلاء عبر "الواتساب"

جمارك مطار محمد الخامس تحبط محاولة تهريب 26 صقرا

أمين عام حزب استولى على 3 ملايير يغادر السجن بكفالة 800 مليون

هكذا توصل عبد المومني بقرار الإطاحة به

إحباط محاولة تصدير غير قانونية ل26 صقرا حيا

القضاء يصدر حكمه في معركة مؤتمر "البام"

أخنوش يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي ويكشف برنامج الوزارة لـ2020

هكذا يستغل "البيجيدي" البناء العشوائي لاكتساح الانتخابات

رسميا.. الإعلان عن حل تعاضدية الموظفين

النيابة العامة تطالب برفع عقوبة بوعشرين إلى 20 سنة

بنشعبون ويتيم يوقعان قرار حل تعاضدية الموظفين

هزة أرضية تضرب إقليم خنيفرة

انقطاع الدواء يهدد حياة مرضى "الهيموفيليا"

رئيس جمعية خريجي مدرسة "ENIM" يكشف حقيقة أحداث البيزوطاج

أخنوش يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد

قراءة في الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 08 أكتوبر

دورية تدعو الجماعات إلى ترشيد النفقات وتبني ميزانيات معقولة

أطباء القطاع العام يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الاطباء"

مواطنون يحتفلون بعيد ميلاد حفرة في إنزكان

خلافات الشوباني تنسف دورة مجلس جهة درعة تافيلالت

الشرطة القضائية تحل بمجلس جهة درعة تافيلالت

مطالب بالتحقيق في وفاة سيدة حامل بمستشفى اشتوكة
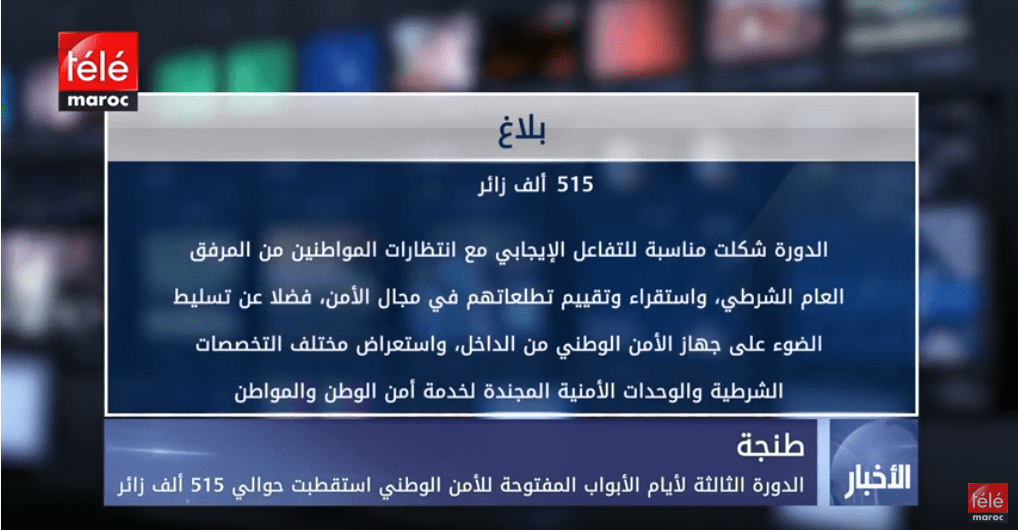
الدورة الثالثة للأمن الوطني استقطبت حوالي 515 ألف زائر

إدارة المدرسة العليا للمعادن تقتص من طلبة البيزوطاج

الشامي يشكو ضعف تفاعل الحكومة مع تقرير مجلسه

قانون النقابات.. تفاصيل سرية مُسحت من ذاكرة تأسيسها

أطباء البلاط.. رعاة رسميون لصحة الملوك والأمراء

ناج من فاجعة زناتة يروي التفاصيل

شاطئ زناتة يلفظ جثة جديدة وعدد الضحايا يرتفع

العرافي تفشل في بلوغ البوديوم للمرة الثانية

ابن تاجر ثري بالرباط يدهس دركيا بالهرهورة ويرديه قتيلا

الداخلية تستعد لتعيين 24 عاملا جديدا بالموازاة مع التعديل الحكومي

السجن لرئيس جماعة وأخيه بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير

مشاريع معطلة بالملايير بمجلس الصويرة

توقيف العقل المدبر لشحنة مخدرات كلميم بمطار محمد الخامس

أمن البيضاء يعتقل 4 شباب بعد تصويرهم لـ "جرائم وهمية"

مديرية الأمن تُطلع المواطنين على طريقة اشتغال رجال الحموشي

إتلاف 163 طنا من البطاطا الملوثة بمبيدات غير مرخصة قادمة من بركان

مديرية الأمن تكشف مميزات نظام المعلومات الجغرافية الجديد

فاجعة زناتة.. البحر يلفظ جثة جديدة

الممرضون وتقنيو الصحة يشلون المستشفيات

رفاق ساجد يتشبثون بالبقاء في حكومة العثماني

أزمة النقل تخلق الجدل وسط مجلس مدينة البيضاء

بنشعبون يتوصل بمقترح حل تعاضدية الموظفين

الجالية المغربية بقطر.. تجارب قاسية وأحلام منكسرة

مريض يحتجز طبيبة و3 نساء بعيادة ويحاول اغتصابهن

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 03 أكتوبر

الاحتباس الحراري يتربص بالمغرب وتوصيات بتعزيز الأمن الطاقي

أطباء القطاع العام يستعدون لخوض إضراب عام عن العمل يوم الإثنين المقبل

توقيف خمسة مشتبه فيهم لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات

إضراب حافلات البيضاء يفاقم أزمة النقل ويثير استياء الساكنة

البيجيدي يعبر عن "أسفه" من خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة

إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية بداية العام المقبل

النيابة العامة تطالب بإدانة البرلماني "مول 17 مليار" ب20 سنة سجنا

جماهير الرجاء ممنوعة من دخول فلسطين

انطلاق عملية التسجيل لقرعة أمريكا

استقالة العماري تحدث ارتباكا بمجلس جهة طنجة

إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية هذه مميزاتها

شاطئ بالوما يلفظ المزيد من الجثث

اعتقال طبيب نساء ومولدة بعد وفاة سيدة حامل وجنينها

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 02 أكتوبر

انطلاق النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة لمديرية الأمن

يتيم يفرج عن مسودة مشروع قانون نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشتغلين

الممرضون وتقنيو الصحة يشلون المستشفيات بإضراب وطني في الثالث والرابع من الشهر الجاري

فتح تحقيق في وفاة شخص عرض نفسه للإيذاء العمدي أثناء توقيفه من قبل مصالح الأمن

قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد صدور القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية

حزب التقدم والاشتراكية يتخذ قرار مغادرة الحكومة

تعويضات عن تنقلات وهمية لرئيس مجلس آسفي تحت المجهر

بعد الرباط الإسبان يفوزون بصفقة تدبير النقل الحضري بالبيضاء

التحقيق في ملابسات وفاة شخص أثناء توقيفه

إضراب عمال "نقل المدينة" يربك حركة النقل بالبيضاء

ارتفاع مهم في أسعار المحروقات

بمساعدة الديستي.. حجز 6.5 طن من المخدرات بكلميم

الدكالي يمرر صفقة 7 ملايير
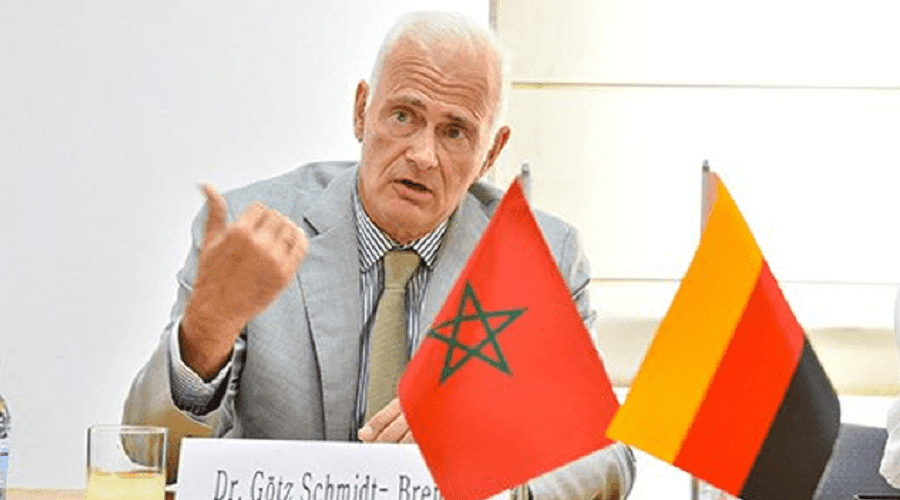
سفير ألمانيا بالرباط تشيد بالنموذج المغربي في "سياسة الهجرة"

المحافظة العقارية تفتح باب "لوجيبات"

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 01 أكتوبر

المغرب يتراجع بسبع مراتب في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019

دكاترة الوظيفة العمومية يعلنون عن إضراب وطني خلال 9 أكتوبر المقبل

توقيف 4 أشخاص وضبط 6 أطنان و400 كلغ من مخدر الشيرا بحوزتهم

عمال مطار محمد الخامس يدخلون في إضراب ومكتب المطارات يوضح

عصابة تسطو على محل تجاري لبيع الهواتف الذكية بطريقة هوليودية بالبيضاء

عودة 800 مهاجر غير شرعي مغربي والحكومة الألمانية تسن قانونا جديدا للهجرة

اشتباكات عنيفة بين عناصر الإلتراس في البيضاء والشرطة تطلق النار لفضهم

إصابة 13 تلميذا إثر انقلاب سيارة للنقل المدرسي

البيزوطاج في البرلمان

تبديد أموال عمومية يجر منتخبين للاعتقال

هذا ما قضت به المحكمة في قضية هاجر الريسوني

الحرارة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق من المملكة

فاجعة زناتة.. العثور على 5 جثث والبحث جار عن مفقودين

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 30 شتنبر
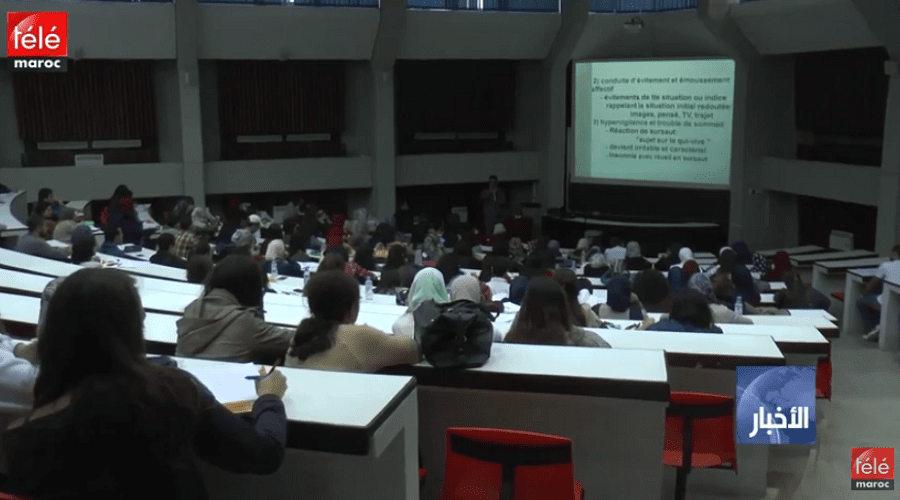
الصمدي: سيتم إعادة رسم “الخريطة الجامعية” وفق احتياجات وخصوصيات كل جهة

مهنيون يرصدون تأخر سحب وزارة الصحة الأدوية المضرة من الصيدليات

الملك يتعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد وطبيبه يوصيه بفترة راحة طبية لبضعة أيام

ولي العهد يمثل الملك في مراسيم تشييع جثمان جاك شيراك

وفاة مهاجر سري داخل مخزن عجلة طائرة "لارام"

اتهامات بالرشوة تقود شرطيين للتحقيق

إتلاف أزيد من 29 طنا من الأسماك الفاسدة

مدريد تسلم المغرب موظفة سرقت 4 ملايير من رجال أعمال

ضربة موجعة لشبكات تهريب الكوكايين

الملك يتعرض لالتهاب فيروسي حاد

تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

أمزازي يعيد البروفيسور بلحوس للعمل

العثور على 7 جثث لمغاربة بينهم امرأة بشاطئ عين حرودة

الداخلية توضح حقيقة الإجراءات التأديبية في حق رجالها

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 27 شتنبر

بوريطة يدعو إلى توحيد الخطاب إزاء إيران

العثماني يدشن الجولة الثانية من المشاورات اليوم الجمعة

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى كلود شيراك إبنة الفقيد

السجن لمجندين جدد في إطار الخدمة العسكرية لهذا لسبب

مقتل عاملين وإصابة آخرين بمحطة القطار بالرباط

حضور قوي للشركات المغربية في النسخة الثالثة لمعرض الطيران الخاص

أحياء مراكش تعاني من الإهمال والعمدة يزين مكتبه بالرخام الإيطالي

التحقيق في تملص شركات من أداء ضرائب بالملايير

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 26 شتنبر

في ظل الاحتقان .. يتيم يكشف مستجدات قانوني الإضراب والنقابات المهنية

الأساتذة المتعاقدون يطلبون "الإدماج بدون قيود ويتهمون الوزارة "بالارتجالية والعشوائية""

وزارة الداخلية تحدث مركزا للإنذار بمخاطر الفيضانات أطلقت عليه اسم "الرائد"

رؤساء جماعات مهددون بالعزل لهذا السبب

هذه هي أسماء أدوية المعدة التي سحبتها وزارة الصحة بسبب احتوائها على مواد مسرطنة

محكمة وجدة تؤجل النظر في قضية ضد العثماني

صفقة "30 مليارا" تجر العثماني واعمارة إلى القضاء

شبكات المتاجرة في الدواء تستنفر الصيادلة

فتح الحدود المغربية الجزائرية لهذا السبب

صراعات الأقطاب تستعر داخل "البام"

مقالع الموت تورط منتخبين

المحكمة تقرر احضار بوعشرين للجلسات بالقوة

أمن البيضاء يوقف 22 شخصا على خلفية أحداث مباراة الوداد والجيش

عاجل... بعد كشف "الأخبار" عن احتواء دواء المعدة مواد مسرطنة وزارة الصحة تسحبه من الصيدليات

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 25 شتنبر

العثماني يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تشبث المغرب بدبلوماسية متعددة الأطراف

وزارة الصحة تسحب أدوية معدة من الأسواق بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية

النمو لن يتجاوز 2.7% واحتياطي العملة الصعبة يكفي لـ 5 أشهر من الواردات

إحداث مركز وطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة

صاحب ودادية سكنية وهمية ينصب على منخرطين في المليارات

تسمّم غذائي يرسل أزيد من 20 طالبا للمستعجلات بتطوان

مصرع مشجع وإصابة آخرين قبل مباراة الوداد والجيش والأمن يعتقل 6 أشخاص

ضبط 256.500 شاحن "مزور" بميناء الدار البيضاء

التحقيق مع برلماني حول جمعية "20 مليار"

غواصون يهربون الحشيش المغربي لإسبانيا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 24 شتنبر

موظفو التعليم ينظمون إضرابا وطنيا نهاية أكتوبر المقبل ووقفات احتجاجية

الحراسة الإلزامية تغضب أطباء القطاع العام

النقابات الأكثر تمثيلية تعبر عن رفضها الأولي لمشروع قانون النقابات
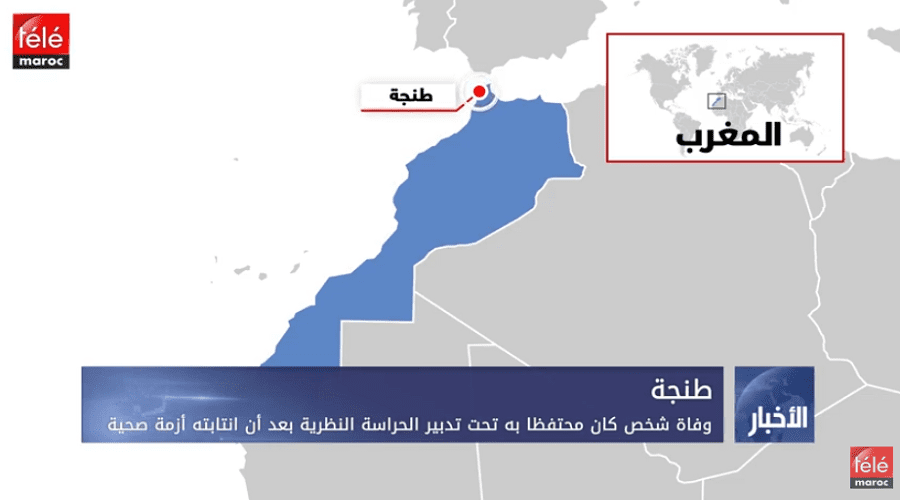
طنجة: وفاة شخص كان محتفظا به تحت تدبير الحراسة النظرية بعد أن انتابته أزمة صحية

العثماني يجري اتصالات مع زعماء الأغلبية لعقد لقاءات انفرادية خلال هذا الأسبوع

الأميرة للا حسناء تطلق مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية

أمن العيون يوقف متهمين بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض

وفاة عبد الله القادري الوزير السابق وزعيم "الحزب الوطني الديمقراطي"

قضية هاجر الريسوني.. المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم

ترامب يهاجم أوباما ويؤكد أنه الأحق بنوبل للسلام

الحراسة الإلزامية تفجر غضب أطباء القطاع العام

اسبانيا توشح الحموشي وحرمو بهذا الوسام الرفيع

قضية الريسوني.. المحكمة ترفض جميع الدفوعات الشكلية

دركية ابنة كولونيل تعربد ليلا بالهرهورة

بيل وهيلاري كلينتون يأكلان الملاوي ويشربان الشاي بضواحي مراكش

حصاد الجماعات المر.. هل حان موعد قطف رؤوس الرؤساء؟

المغرب يحصل على ميداليتين ذهبيتين و7 جوائز في معرض اسطنبول للابتكار

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 23 شتنبر

أمزازي يتراجع عن تصريحاته بخصوص تحفيز التعليم الخصوصي في العالم القروي

عزيز أخنوش يطلق من أكادير مبادرة سياسية جديدة تحت اسم مائة يوم مائة مدينة

توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في صناعة وترويج مسكر ماء الحياة

كشف مئات الملايير المهربة في حسابات سرية لمغاربة بالخارج

بنك المغرب يكشف حقيقة "السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة"

الأحرار يحسم موقفه من التعديل الحكومي ويدعو لفتح نقاش مسؤول حول قانون المالية 2020
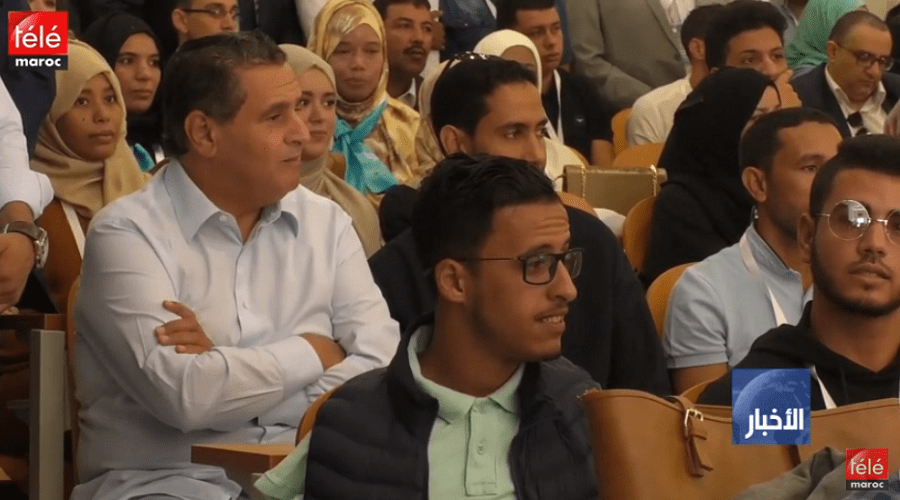
الجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار تعرف تنظيم 14 ورشة

سرقة 120 مليون من بنك المغرب تستنفر السلطات

متابعة شرطيين بعد الإشتباه في تورطهما بمقتل شاب بالجديدة

السجن لطالب جامعي بسبب نشره فيديو يوثق لجريمة "شمهروش"

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 21 شتنبر
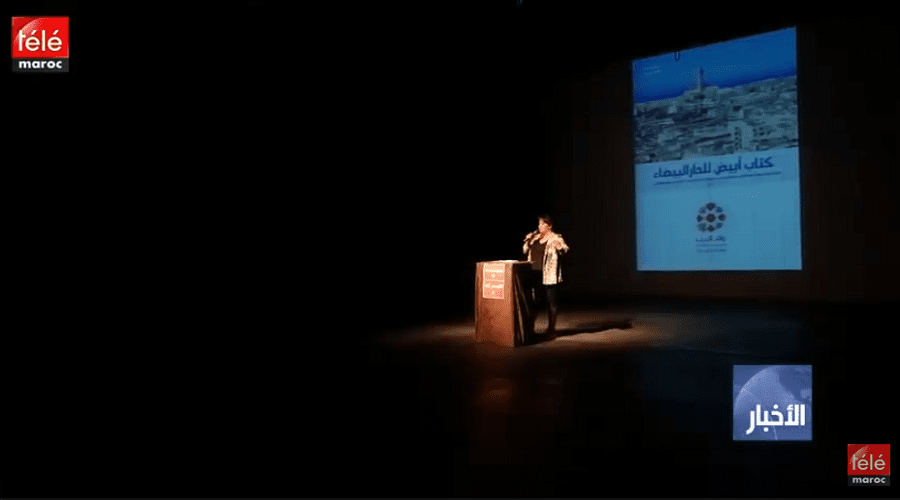
حركة "أولاد الدرب" تقدم مقترحات لحل مشاكل الدار البيضاء

المحمدية: ضبط معمل سري لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة للجامعة الصيفية للأحرار بأكادير

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تنفي صحة وثيقتين يتم تداولهما في مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة تسقط الخيانة الزوجية عن الممثلة الوافي وتتابعها بالتحريض على الدعارة

البيضاء والمحمدية بدون سيارات في هذا التاريخ

"الديستي" تكشف حقيقة وثيقتين عن والدة السيسي

بيل كلينتون يتجول في ساحة جامع الفنا

العدوي تبحث عن 16 مليارا في مجلس آسفي

الراقصون بالسيوف في قبضة رجال الحموشي

وزراء وبرلمانيون لا يؤدون إتاوات احتلال الملك البحري

المديرية العامة للأمن الوطني تكشف حصيلة محاربة الجريمة

انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير”

عبد النباوي يدعو وكلاء الملك إلى عدم متابعة الصحافيين جنائيا بتهم السب والقذف

تحذير.. زخات رعدية ورياح عاصفية بهذه المناطق من المملكة

جمعية ابتسامة رضا.. نمودج لدور المجتمع المدني في مواجهة الانتحار

يتيم يوضح نشر صورة إباحية على حسابه بـ"فيسبوك"

كلاب و قوارض بقلب مجزرة جماعية بضواحي مراكش

مديرية الأمن تؤكد انخفاض الجريمة وتتوعد مروجي الأخبار الزائفة

عمارة يغلق 87 مقلعا بينها من ظلت تشتغل منذ 20 سنة

انتحار سائح بلجيكي رمى نفسه من فندق بمراكش

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 19 شتنبر

اختفاء دواء لمرضى السرطان من الصيدليات

مجلس المنافسة ينفي مسؤوليته بشأن نشر معلومات حول اتفاق بين الشركات الثلاث
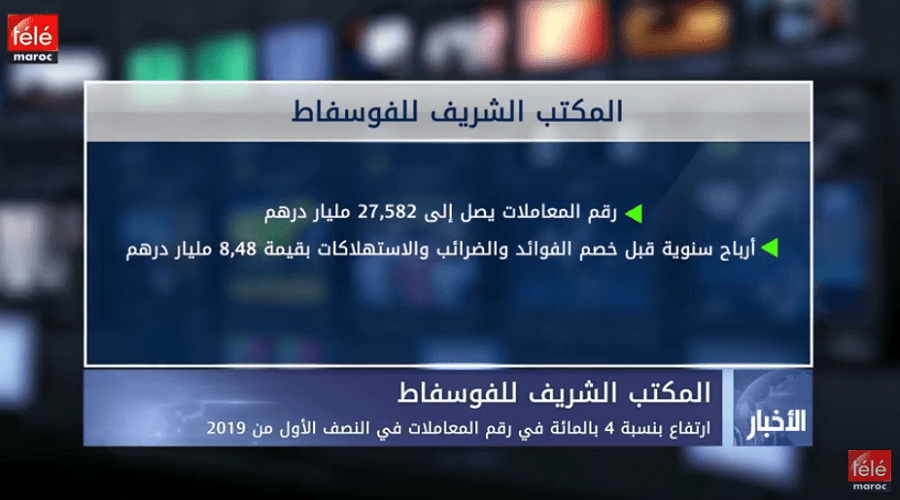
ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في رقم المعاملات في النصف الأول من 2019

وزارة الشؤون العامة تنفي أي زيادة مرتقبة في أسعار "البوطا"
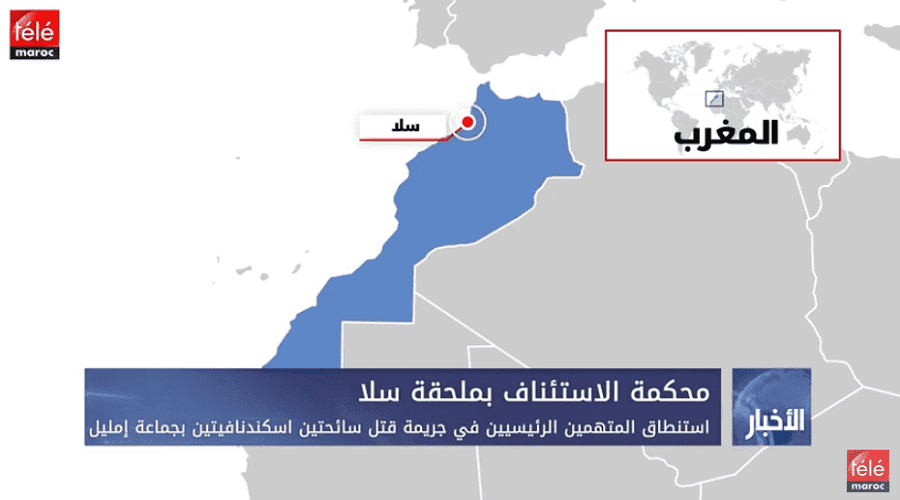
استنطاق المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل

هكذا يتم السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة

الملك يدعو إلى اعتماد أسلوب ناجع في تدبير السياسات المعتمدة في الميدان الاجتماعي

جريمة شمهروش.. المتابعون يعترفون وزعيم الخلية يكشف معطيات جديدة

اختفاء دواء لمرضى السرطان من الصيدليات

كارثة بيئية تواجه القنيطرة

اكتشاف كميات وافرة من الغاز قبالة العرائش

عمدة آسفي أمام قاضي التحقيق بعد متابعته بالتزوير في مشروع ملكي كلف 146 مليارا

عامل طانطان يفضح طريقة إفشال المشاريع بالإقليم

هرّب 423 طنا من المخدرات إلى أوروبا.. بارون يفجرها أمام محكمة جرائم الأموال

مجلس المنافسة يكذب ما نشرته مواقع بشأن اتفاق بين شركات المحروقات حول الأسعار

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 18 شتنبر

الدكالي يعد مشروع مرسوم يحاصر فوضى العيادات الخاصة
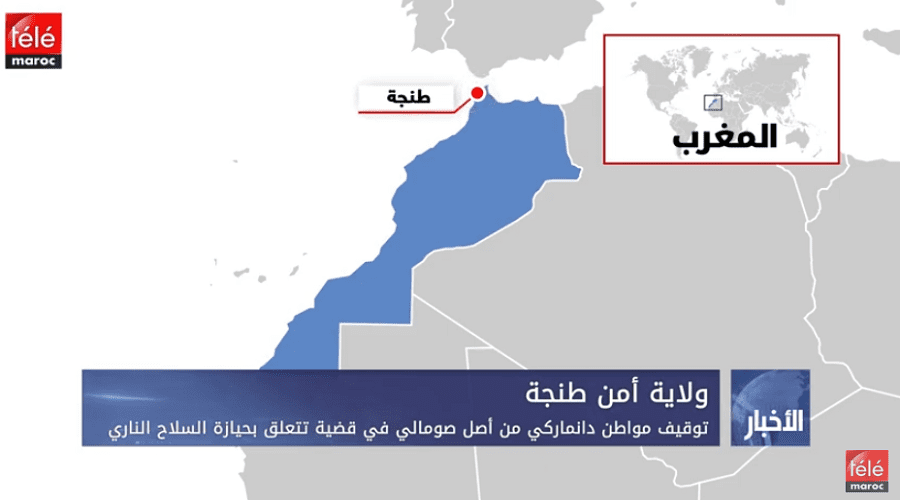
توقيف مواطن دانماركي من أصل صومالي تنفيذا لأمر الدولي في قضية تتعلق بحيازة السلاح الناري

الهاكا توقف برنامج "Kotbi Tonight" على قناة "شدى تي في" بسبب الميلودي

تحذير من وباء خطير يهدد حياة 80 مليون شخص عبر العالم

مطلوب كلاب للعمل في ميناء طنجة المتوسط

أمن الناظور يوقف متهما بتكوين عصابة إجرامية وحجز مسدس و39 رصاصة

أرباب سيارات الأجرة ينتقدون ارتفاع السعر الجزافي للتأمين الصحي

وفاة مفاجئة لمدير "أنابيك" بركان داخل مكتبه

زوجة الخلفي تنجو من الموت في حادثة سير على متن سيارة الدولة

بعد تورطه في محاولة انتحار فتاة.. إعفاء الكاتب العام لوزارة الصحة من منصبه

لجنة علمية بجامعة ابن زهر ترفض أطروحة دكتوراه حول بنكيران

السجن لموظفين تلاعبوا بالملايير

الأمن يفضح ادعاءات سيدة باختطاف ابنتها

الداخلية تصدر قرارات بانتخابات جزئية في عدة أقاليم

كارثة بيئية تضرب منطقة ماسة ونفوق أسماك بالمئات

الجيش يخصص 209 مليارا لاقتناء 8000 قنبلة شديدة الانفجار

جنايات فاس تحدد موعد النطق بالحكم في قضية حامي الدين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 17 شتنبر
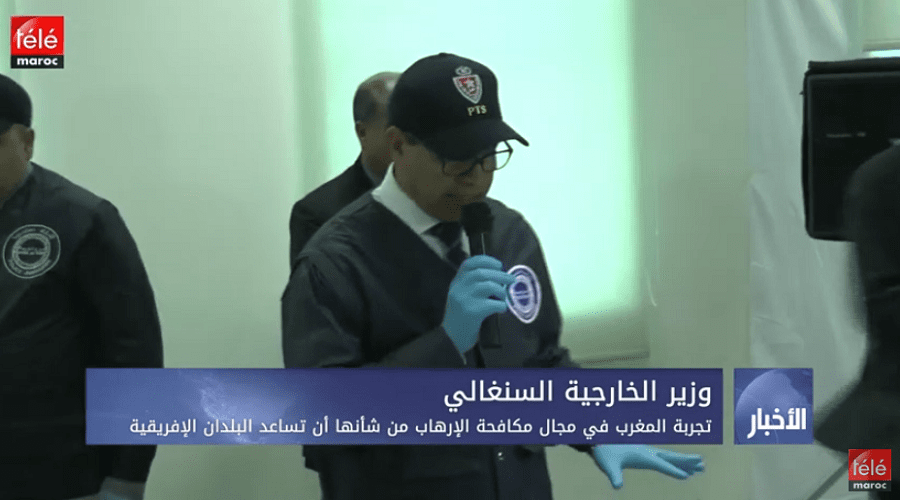
تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من شأنها أن تساعد البلدان الإفريقية

انطلاق محاكمة حامي الدين في قضية آيت الجيد

إجراءات جديدة لمحاربة عصابات السطو على العقارات

التعديل الحكومي: العثماني يرمى كرة المقترحات لزعماء الأغلبية

كشف تزوير مأذونيات 10 طاكسيات تربط بين مراكش والحوز

USB بـ720 درهما وعشاء بـ55 مليون وأساتذة يسرقون الكتب.. هذه عجائب وغرائب تقرير مجلس جطو

افتتاح منطقة خاصة بمراقبة الجوازات المغربية بمطار محمد الخامس

مندوبية السجون ترد على تقرير جطو

مجلس عمالة يمنح جمعية 40 مليونا ويوصي بتخصيصها للترفيه

المحكمة تؤجل قضية الريسوني ووكيل الملك يرفض السراح المؤقت

قلة الموارد وتداخل الاختصاصات.. معيقات في طريق ONSSA لمراقبة المنتجات

لهذا السبب قررت الكاتبة والباحثة أسماء المرابط مغادرة المغرب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 16 شتنبر

السجن للمتابعين في قضية قتل آيت الجيد

إلغاء العمل بجدادية السفر بالمطارات يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 شتنبر الجاري

الداخلية تدخل على الخط وتعقد اجتماعات مع مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين

خروقات الصفقات وفوضى توزيع الدعم تضع الصبيحي في قفص الاتهام

الداخلية تحقق في تعثر مشاريع للتعليم كلفت مئات الملايير

مصدر أمني يكشف حقيقة إلغاء جدادية السفر بالمطارات المغربية

بالصور.. لحظة القبض على المتهم بقتل فتاة وإحرق جتثها بالبيضاء

يحدث في المغرب فقط...وجبة غداء تكلّف جماعة قروية 55 مليون سنتيم

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 14 شتنبر

بنشعبون يفيد بأن الحكومة تحفز الاستثمارات وتواكب دعم المقاولات الصغرى

الرشيدية: العثور على 5 جثث، والحصيلة ترتفع إلى 24 قتيلا

سعيد أمزازي يعلن عن موعد طرح المقرارات الدراسية الثمانية غير المتوفرة في الأسواق

فاجعة الرشيدية.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 28 قتيلا بعد العثور على جثة جديدة

بتعليمات ملكية، وفد رفيع المستوى سيمثل جلالة الملك في الدورة الاستثنائية لمجموعة سيدياو

مطالب بالتحقيق في إهمال مشروع حكومي كلف 8 ملايين درهم بطنجة

برلمانية بالبام تؤكد رفض الداخلية لمؤتمر "تيار المستقبل" والأخير يرد

جطو يرصد كوارث رباح بوزارة التجهيز والنقل

مؤسسة تعليمية ترسّب تلاميذ رغم إعلان نجاحهم بشكل رسمي

غياب المراحيض العمومية بمدينة الدار البيضاء يغضب الساكنة ويحرج الزوار

حملة مكثفة لمحاربة شواحن وبطاريات الهواتف "المغشوشة"
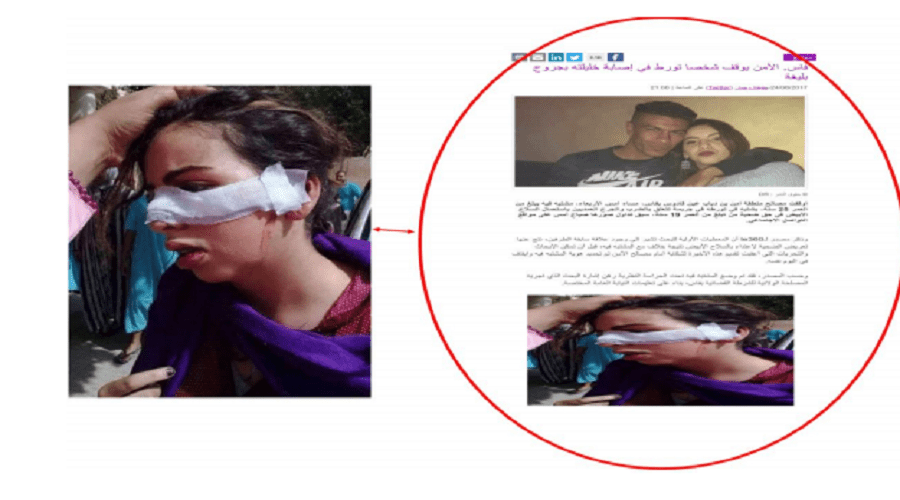
مصالح الأمن تستعرض نتائج الخبرات التقنية حول صور "التشرميل" وتكشف حقيقتها

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 13 شتنبر

إطلاق برنامج يهدف إلى تحسين صحة وتغذية الأم والطفل في ثلاث جهات

عمال النظافة بالدار البيضاء يخوضون إضرابا عن العمل لثلاثة أيام

إقليم الرشيدية: انتشال جثث 5 أشخاص إثر انقلاب حافلة نقل المسافرين

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"

الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة الرسمية للسنة التربوية 2019-2020

تقرير جطو يكشف الاختلالات التي تعرفها خدمة "راميد"

وزارة الوافي ترخص لمنعشين عقاريين بالبناء فوق مرجة بالقنيطرة

أمن مراكش يفكك شبكة إجرامية للتهجير الوهمي نحو دول الخليج

فاجعة الرشيدية.. العثور على جثث 5 أشخاص من ضمن المفقودين

المغرب يدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت

فاجعة الرشيدية.. العثور على جثة رجل من ضمن المفقودين

الحكومة تكشف حقيقة فرض "التصويت الإجباري" على المغاربة

3 سنوات سجنا في حق الشخص الذي قام بتخريب حافلة ألزا بتمارة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 12 شتنبر

300 مليار من الداخلية لإنقاذ مشاريع البيضاء المتعثرة

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي برسم سنة 2018

إعادة انتشار واسعة في الوظيفة العمومية وتغييرات جذرية في نظام التوظيف

تحذير.. زخات رعدية قوية من المستوى البرتقالي بهذه المناطق من المملكة

بعد أسبوع على الدخول المدرسي.. كتبيون يشتكون من غياب بعض المقررات التعليمية

المغاربة يشربون أزيد من مائة مليون لتر من الجعة سنويا

مقتل سائحة وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة بأكادير

تفاصيل سقوط نصاب انتحل صفة مسؤولين كبار في الأمن والداخلية لجمع التبرعات

التحقيق مع القابض الجهوي للجمارك بمراكش لتورطه في اختلاس 4 ملايير

مجلس جطو ينشر تقريره السنوي ويضرب "الطر" للعديد من المؤسسات والإدارات العمومية

"القطار الصغير" يكبد الطرق السيارة خسائر تصل إلى 30 مليون درهم

توقيف شخص اعتدى على طليقته بالسلاح الأبيض في الدار البيضاء

300 مليار من الداخلية لإنقاذ مشاريع البيضاء المتعثرة

الأمن يستمع إلى سائق حافلة الراشيدية

الممرضون يعودون للاحتجاج

عاجل.. الصيدلي الذي قتل زوجته بالصخيرات ينتحر بوادي الشراط

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 11 شتنبر

حجز أزيد من 4.3 طن من الأكياس والمواد الأولية والمتلاشيات البلاستيكية داخل مستودعين سريين

وزارة التربية الوطنية تنهي أزمة أساتذة كليات الطب الموقوفين وتقرر إعادتهم لمزاولة مهامهم

استعمال المفرقعات والألعاب النارية خلال أيام عاشوراء يثير سخط سكان البيضاء

حركة الممرضين وتقنيي الصحة يشرعون يوم الأربعاء تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية

محمد زيان يقرر الانسحاب من الترافع في ملف الصحفي توفيق بوعشرين

وزارة الداخلية تدعو الأحزاب السياسية إلى مناقشة إجبارية التصويت

صيدلاني يقتل زوجته بطلق ناري في الصخيرات

مدارس خاصة تفرض على أسر التلاميذ اقتناء كتب من مكتبتها بأثمنة "تعجيزية"

التعديل الحكومي.. العثماني يقلّص الحقائب الوزارية بنسبة الثلث

"البسيج" يكشف موقعين لصناعة العبوات الناسفة بإقليم الدريوش والخلية الإرهابية استغلت الموقعين لتحضير عبوة متفجرة عن بعد

بالصور.. تدشين مدرسة لتكوين الشرطة بالعيون هذه مميزاتها

زيان يتخلى عن موكله بوعشرين لهذا السبب

هل سيُصبِح التصويت إجباريا في المغرب ؟

فاجعة الرشيدية.. العثور على جثة امرأة من ضمن المفقودين

الوكيل العام باستئنافية فاس يلتمس إدانة المتهمين بقتل أيت الجيد

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 10 شتنبر

إيداع مجندين جدد للخدمة العسكرية السجن لهذا السبب

جولة جديدة من المفاوضات بين الحزب العمالي الاشتراكي و بوديموس لتشكيل الحكومة الجديدة

جمعيات تطالب بإحداث فرق أمنية متنقلة تمنع استغلال الأطفال في التسول

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته لتعديل القانون الجنائي

رصد موقعين بمنطقة جبلية بإقليم الدريوش استغلهما أفراد خلية إرهابية للقيام بتجارب في صناعة المتفجرات

حكيم بنشماش يتوصل بتهديدات بالقتل

الحكومة تفرض على المغاربة ضريبة للتضامن ضد الكوارث

سيارات فارهة مسروقة تدخل المغرب بوثائق مزورة والأمن يدخل على الخط

فرار نزيل بسجن طنجة يطيح بثمانية موظفين

هذا ما قررته المحكمة في حق هاجر الريسوني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته لتعديل القانون الجنائي

أمن القنيطرة يوقف متهمين بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب

الفرقة الوطنية تستدعي رئيس المجلس الإقليمي للصويرة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 09 شتنبر

المغرب يتقدم على تونس والجزائر ويحتل الرتبة السادسة عربيا في التنافسية السياحية
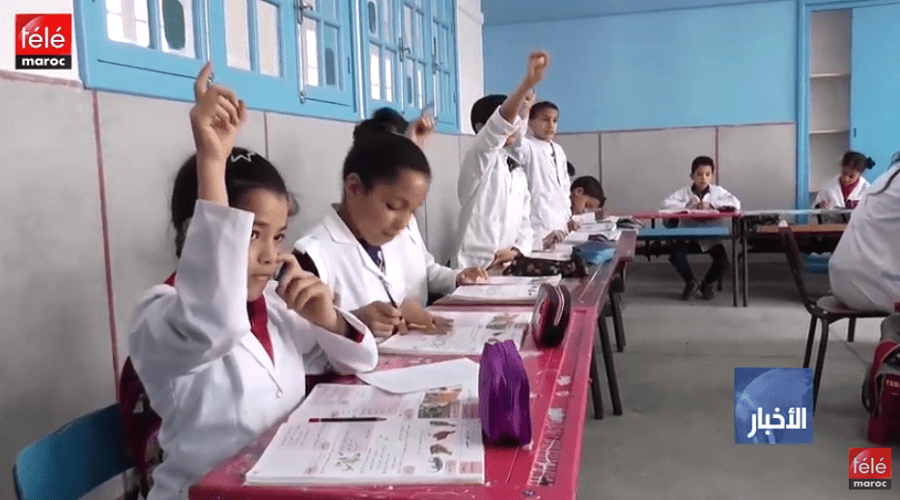
مهنيون يسجلون عدم إدراج كتب اللغة الأمازيغية ضمن مبادرة "مليون محفظة"

الممرضون يستأنفون الاحتجاجات ويضربون عن العمل الأربعاء المقبل

العثماني يبدأ جولة ثانية من مفاوضات التعديل الحكومي مع أحزاب الأغلبية

توقيف 19 شخصا ينتمون إلى فصيل مشجعي فريق لكرة القدم ارتكبوا أعمال شغب

بعد أن لاذ بالفرار.. سائق الحافلة التي انقلبت أمس بالرشيدية يقدم نفسه

هكذا أغرق "البيجيدي" البيضاء في الديون وحولها إلى ورش لأشغال لا تنتهي

فاجعة الرشيدية.. العثور على جثت 3 مفقودين وعدد الضحايا يرتفع

حريق في نفايات السوق التجاري أسواق السلام بطنجة كاد أن يتسبب في كارثة

فاجعة الرشيدية.. ارتفاع عدد الضحايا ووفد رفيع المستوى يتفقد الوضع ويزور الجرحى

فاجعة الرشيدية ..العثور على جثت مفقودين والحصيلة ترتفع

المحكمة الدستورية تجيز القانون التنظيمي للأمازيغية

أوكسيد الكبريت خطر يهدد المغاربة

تقرير دولي يصنف المغرب من أفضل الدول لحياة المهاجرين

بالفيديو.. موكب "هدية" على متن قوارب داخل البحر بالجبهة على أنغام الغيطة الجبلية

ارتفاع حصيلة فاجعة "واد دمشان" والبحث جار عن مفقودين

قتلى ومفقودين في انقلاب حافلة ركاب وسط نهر بالراشيدية

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة عالم نووي مصري توفي في ظروف غامضة بمراكش

الدار البيضاء: إضراب عمال النظافة يغرق المدينة في الأزبال

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 07 شتنبر

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب الحكومة والوزارة بحل ملفات الشغيلة
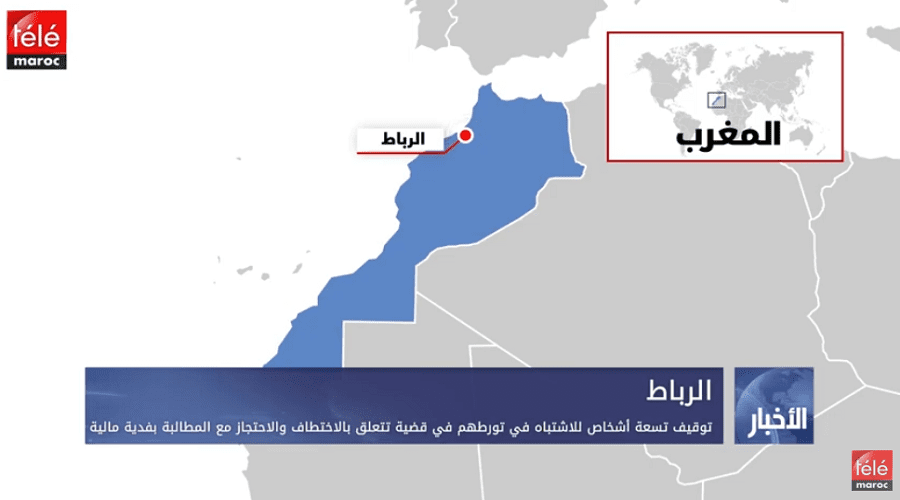
توقيف تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز مع المطالبة بفدية مالية

ارتفاع العجز التجاري للمملكة بنحو 4.3 في المائة ليستقر عند 122.8 مليار درهم

أمن الرباط يوقف 9 مهاجرين بتهمة الاختطاف والمطالبة بفدية مالية

سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية نواحي أصيلة والدرك يعتقل ربانها

54 مليون درهم لمعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة

عطب بـ "طرامواي" الرباط -سلا يربك حركة السير ويثير غضب الركاب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 06 شتنبر

كشف اختلاسات داخل مكتب الكهرباء والماء بالدار البيضاء

بنعبد القادر يعرض خمسة محاور لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية

تفاصيل السطو على 30 مليونا من وكالة تابعة لـ"أمانديس" طنجة

إحالة القباج عمدة أكادير السابق على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد بهذه المناطق من المملكة

امرأة تضع توأما في عمر 74 سنة

تطورات مثيرة في ملف محاولة انتحار فتاة بفندق بأكادير والكاتب العام لوزارة الصحة في مأزق

النيابة العامة تكشف أن اعتقال الصحفية هاجر الريسوني لا علاقة له بعملها بل بالإجهاض

كشف اختلاسات داخل مكتب الكهرباء والماء

عملية توزيع الكتب المدرسية المحينة ستنتهي قبل 25 شتنبر الجاري

حراس ومنظفات مدارس جهة الرباط يستقبلون الموسم الدراسي بالإضراب

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تنشط بين مدينتي بركان والناظور
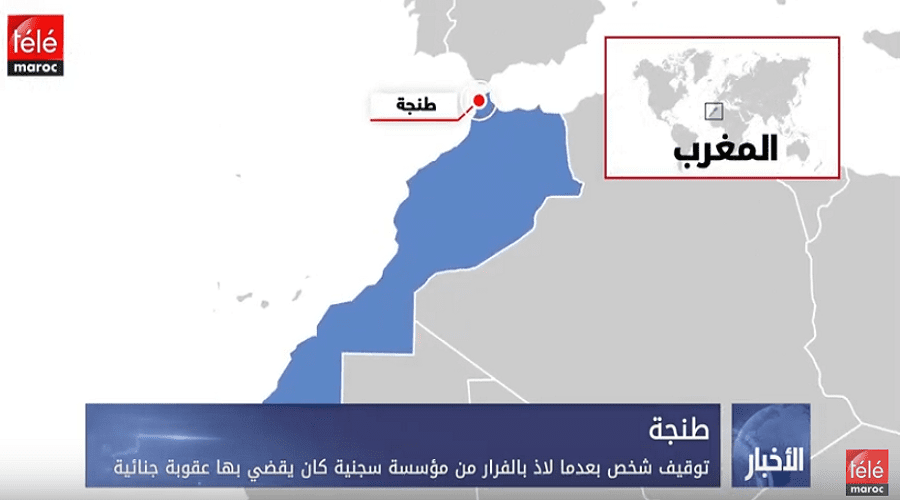
توقيف شخص بعدما لاذ بالفرار من مؤسسة سجنية كان يقضي بها عقوبة جنائية

هكذا أفشلت الحروب الداخلية والتهافت على التعويضات تسيير "البيجيدي" لأكادير

نشرة خاصة.. زخات رعدية عاصفية بهذه المناطق من المملكة

الجيش المغربي يحصل على نظام متطور لصد طائرات "درون"

توقيف المعتقل الذي لاذ بالفرار من مؤسسة سجنية بطنجة

النقابات تتوعد الحكومة بمواجهة قوية لقانون الإضراب

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 5 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

التعديل الحكومي.. تقليص كتاب الدولة وإعادة توزيع الحقائب الوزارية يربك العثماني

حريق غابة "عشاشة" بشفشاون يأتي على 470 هكتارا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 04 شتنبر

زخات رعدية مصحوبة بالبرد ورياح عاصفية بهذه المناطق من المملكة

آسفي: السيطرة على حادث بسيط بالمركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط

خطر السيول والفيضانات يهدد عشرات المدارس بالمجال القروي وأمزازي يراسل مدراء الأكاديميات

مصالح "أونسا" تفاجئ فنادق طنجة بجولات تفتيشية وتحجز موادا فاسدة

وفاة النقابي عبد الرحمان العزوزي بعد صراع مع المرض

إدارة سجن القنيطرة تكشف حقيقة المواجهة بالسكاكين بين معتقلين قاصرين

مخدرات شاطئ أصيلة تطيح بعسكريين وقاضي التحقيق يودعهم السجن

أمن البيضاء يوقف منفذ الاعتداء على شاب بحي مولاي رشيد

بعد خسارة تصويت هام بشأن "بريكست".. جونسون يتجه لانتخابات مبكرة

اصطدام سيارة بمقطورة للترامواي بالدار البيضاء

توقيف شخص حاول السطو على بنك المغرب بالعيون

هكذا غرقت آسفي في الواد الحار بعد 4 سنوات من تسيير "البيجيدي"

الحرائق تجتاح غابات شفشاون

حسابات تورط مسؤولي شركة وطنية

قضاة جطو يفتحصون الجماعات الكبرى

اردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة تمييز واضحة تجاه بلاده

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 03 شتنبر

الدار البيضاء ضمن قائمة ال60 مدينة الأكثر أمانا في العالم

الحكومة تعد مرسوما يهم التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل

وزارة التعليم تكشف حقيقة كتاب مدرسي أثار الجدل

تحذير.. زخات رعدية عاصفية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق من المملكة

اقتطاعات تتراوح ما بين 900 و 1400 درهم من أجور الأساتذة المتعاقدين المضربين

معمل لإنتاج مواد البناء وسط واد بالصويرة يهدد 2000 نسمة بالفيضانات

سلاح عسكري أمريكي يصل المغرب

العدالة والتنمية يمهد لطرد أحد كبار مؤسسيه

وزارة التعليم تكشف حقيقة كتاب مدرسي أثار الجدل

وزير الثقافة يطارد حفاري الكنوز

البنك الدولي : إدارة الكوارث الطبيعية في المغرب كارثة

تفاصيل حادثة قتل شرطي لزوجته بسلا

هذه أغرب الحوادث المأساوية التي أنهت حياة مشاهير وأثرياء وسياسيين مغاربة

مصالح أونسا تتلف دقيقا فرنسيا يسبب "الهلوسة"

العثور على جثة الشخص المفقود جراء فيضانات تارودانت

جمعيات السلفات الصغرى تستعد لرفع أعداد المستفيدين بمراجعة خططها الترويجية

العدول والقابلات والمروضون الطبيون يستفيدون قريبا من التغطية الصحية والتقاعد

فحوصات طبية معمقة للملتحقين بالخدمة العسكرية بعد وفاة مجند

فيضانات تضرب منطقة إمليل وتتسبب في خسائر مادية فادحة

قبيل انطلاق الموسم الدراسي، “أساتذة التعاقد” ينزلون للشارع ويطالبون بالإدماج

بالصور.. تساقط أجزاء من عمارة السعادة في الشارع العام يهدد حياة المواطنين

نشرة خاصة.. زخات رعدية عاصفية بهذه المناطق من المملكة

لمجرد يعود إلى فرنسا للمثول أمام القاضي في جلسة حاسمة

مسؤولون غادروا الصويرة منذ سنوات يحتلون سكنيات وظيفية فاخرة

مشاريع ملكية متوقفة وبيع ممتلكات المدينة.. هذه حصيلة 4 سنوات من تدبير "البيجيدي" لمراكش

بعد فاجعة تارودانت.. الترخيص بإنشاء مشاريع بجانب مجرى واد بسطات ينذر بكارثة

فحوصات طبية معمقة للملتحقين بالخدمة العسكرية بعد وفاة مجند

فيديو مخيف لفيضانات منطقة امليل نواحي مراكش

تحذير.. زخات رعدية عاصفية بهذه المناطق من المملكة

وفاة مجند في إطار "الخدمة العسكرة" إثر مضاعفات في حالته الصحية

شاحنة تدهس أسرة بكاملها ببلقصيري كانت على متن دراجة نارية

"كولومبو" المغرب في ذمة الله

إجهاض عملية تهريب 700 كلغ من مخدر الشيرا بشاطئ أصيلة

الرباح يقطع الطريق بين تاليوين وتافراوت لهذا السبب

مديرية الأرصاد تحذر من زخات رعدية قوية بهذه المناطق من المملكة

توقيف شخص بحوزته قرابة 3 أطنان من مخدر الشيرا أطلق النار على عناصر الأمن

ابن مسؤول كبير يدهس أمنيين بالرباط وهذا ما قرره الوكيل العام

إحباط محاولة اقتحام 400 مهاجرا سريا لمدينة سبتة

فرنسا تحذر من استهلاك دقيق "مسموم" يباع في المغرب

أخنوش يشرف على افتتاح الدورة 12 لمهرجان العنب بجماعة الشراط

فاجعة تارودانت.. تسخير طائرة "defender" ومروحية للبحث عن مفقودين (صور)

توقيف "بيدوفيل" التقط صورا لأطفال مغاربة في شاطئ الرباط

اعتقال موثق نصب على عائلة وزير في 400 مليون

فلاح يقتل شقيقه بالرصاص بسبب نزاع حول الإرث أمام المحافظة العقارية

السكال يبدد ملايين السنتيمات لتزويد موقف للسيارات بالطاقة الشمسية

بعد فاجعة تارودانت.. سيول جارفة تضرب منطقة طاطا وهذا ما قامت به السلطات (فيديو)

سخرية عارمة واستهجان بسبب تدوينة بوليف حول اللغة وتغاضيه عن التعليق حول كارثة تارودانت

فيضانات تارودانت.. العثور على مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة

شخص يدهس جاره بشاحنة ويرديه قتيلا بسبب نزاع حول "الباركينغ"

تحذير.. زخات رعدية من المستوى البرتقالي بهذه المناطق

فاجعة تارودانت.. السلطات تؤكد مقتل 7 أشخاص والأبحاث جارية عن مفقودين

بالفيديو.. فقدان العشرات بعد اقتحام السيول لملعب لكرة القدم نواحي تارودانت

هذا ما قررته محكمة الاستئناف بحق المتهمين في جريمة إمليل الإرهابية

هكذا تتاجر سيارات إسعاف ومصحات خاصة بطنجة في صحة المرضى

إيداع البرلماني السابق والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري عدال سجن عكاشة

طلبة الطب والصيدلة يوافقون على العودة إلى مقاعد الدراسة بهذه الشروط

فرار معتقل من المستشفى كان تحت حراسة الدرك

تلوث مياه الشرب يهدد صحة المغاربة والبنك الدولي يدق ناقوس الخطر

وزارة الفلاحة تؤكد صحة صور القنص الجائر لـ 1400 طائر وهذا ما قررته

"لارام" تكشف سبب إجلاء ركاب طائرتها بفرنسا

رقصات مثيرة داخل مسبح نيكي بيتش تستنفر سلطات مراكش

عمالة آسفي في قلب فضيحة التخلص من وثائق بالغة الحساسية في حاوية للأزبال

هذا ما قالته سلطات الحوز حول نصب تذكاري لـ "محرقة الهولوكوست"

العثماني يلتقي زعماء الأغلبية لحسم لوائح التعديل

بنعبد القادر يتراجع عن تصريحاتهم بخصوص موت اللغة العربية

سيلفي يتسبب في مقتل شاب بشاطئ واد لاو

بالفيديو.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على هامش قمة مجموعة السبع

تلكؤ الحكومة في تنزيل الاتفاق الاجتماعي يخرج النقابات للاحتجاج

إيقاف "راقي" في حالة سكر رفقة فتاتين

200 درهم رشوة تطيح بممرضة "ماجورة"

هذه تفاصيل التحقيق مع الكاتب العام لوزارة الصحة بسبب محاولة فتاة في حالة سكر الانتحار

الألعاب الإفريقية.. المغرب يعزز رصيده في سبورة الميداليات

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى قمة السبع وترامب "لا تعليق"

توقيف شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية

مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا

حريق مهول يأتي على واحة بتافراوت

تقرير.. المغربات في المراتب الأخيرة ضمن النساء الأكثر سعادة

أغنية الرجاء توقع "ميدي 1" في حرج كبير

هذه هي المواد الغذائية الفاسدة التي تم حجزها داخل فنادق مصنفة بالحسيمة

منحة إسبانية جديدة للمغرب بـ 32,2 مليون يورو للحد من الهجرة السرية

مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء بالأردن

مندوبية السجون تتهم عائلات معتقلي الحسيمة بالكذب

الشرطة تحقق مع مسؤول كبير بوزارة الصحة على خلفية محاولة انتحار فتاة بأكادير

تصوير فيلم يتسبب في حريق بمشروع ملكي في مراكش

لقاءات الكواليس داخل أحزاب الأغلبية قبيل التعديل الحكومي

توقيف زوجين متلبسين بحيازة 2040 قرصا مخدرا

سقوط فتاة في حالة سكر طافح من غرفة فندق مصنف بأكادير ومسؤول كبير بوزارة الصحة في قلب فضيحة أخلاقية

تطورات مثيرة في جريمة ذبح زوجة في سيدي سليمان

اختفاء تقرير أسود للوالي زينب العدوي يثير ضجة بمجلس آسفي

تفاصيل تفكيك عصابة تختطف رجال أعمال مغاربة وتستولي على أموالهم

نصاب يستولي على 15 سيارة فاخرة خاصة بوكالات السيارات بمطار مراكش

توقيف شخص ظهر في صور وهو يحمل أسلحة بيضاء

نشطاء يعلنون تأسيس حزب "الحب" بالمغرب

طائرات عسكرية لنقل مجندي الخدمة العسكرية
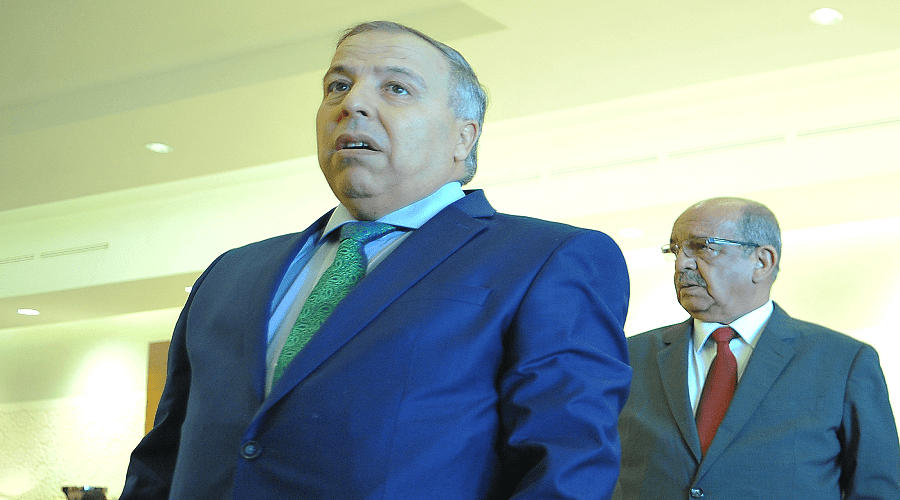
سفير جديد للجزائر بالرباط

بقايا عظام حمير تستنفر أمن البيضاء

«نقانق حشيش» في المحلات الفرنسية ابتداء من 50 درهما

النيابة العامة تودع ثلاثة طلبة سجن العرجات بعد وصفهم بنكيران بالـ »كلب »

الرصاص يلعلع بسيدي قاسم لتوقيف جانح عرض حياة المواطنين للخطر
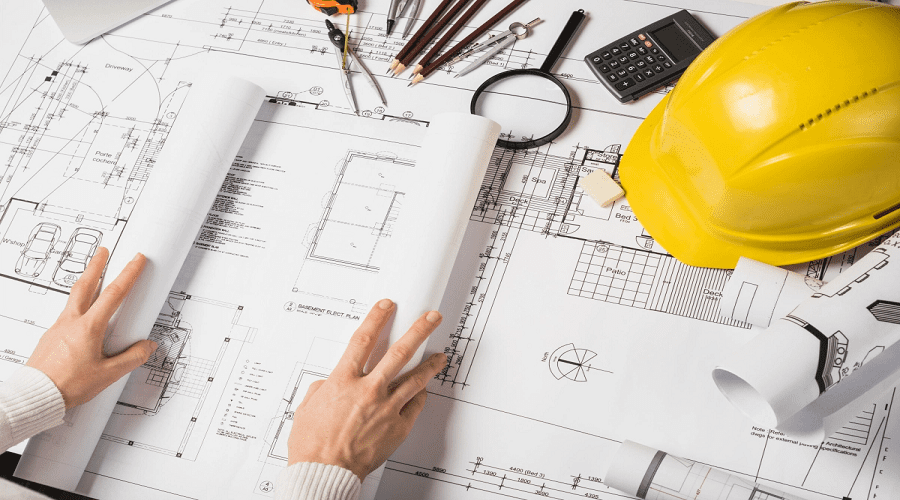
معطيات جديدة تورط مهندسا معماريا وتجر زوجة مدير الوكالة الحضرية بمراكش إلى القضاء

زبناء يفرون من انهيار مقهى بسوق الثلاثاء بشيشاوة

المديرية العامة للأمن : الزوج حاول تحريف مسار البحث بجرح نفسه وخلافات عائلية وراء قتله زوجته

الشرطة القضائية تدخل على الخط في قضية قتل زوج لزوجة بواسطة السلاح الأبيض بسيدي سليمان

خطأ قضائي فادح يغرم الخزينة العامة للدولة 150 مليون سنتيم

بنشماش يهدد بجر منقدي الحزب للقضاء

قنينات مشبوهة تستنفر أمن أكادير
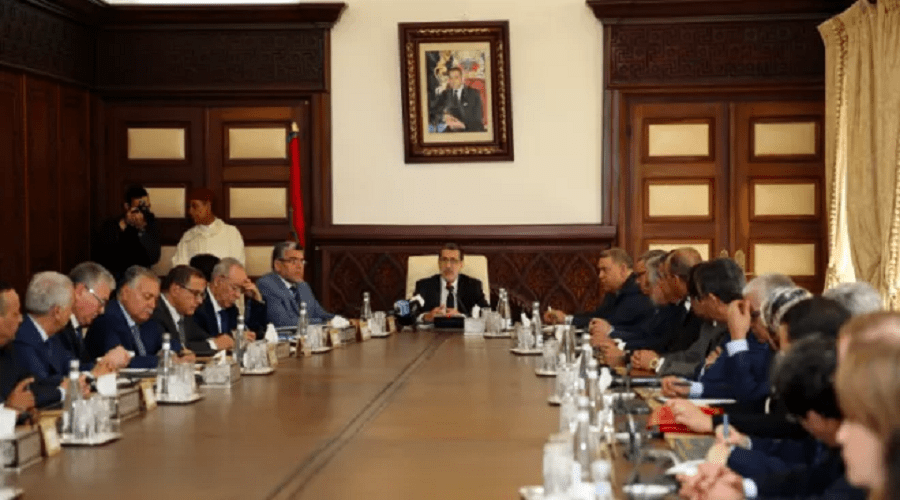
حكومة العثماني تتلكأ في تنفيذ الإتفاق الإجتماعي

زيادات في تسعرت النقل الحضري في الرباط

التبغ والمحروقات يضخان 15 مليار درهم في خزينة الدولة

توقيف هاكر بمكناس اخترق حسابات أحد البنوك

علماء بريطانيون يكتشون بقايا أقدم الديناصورات في العالم نواحي فاس
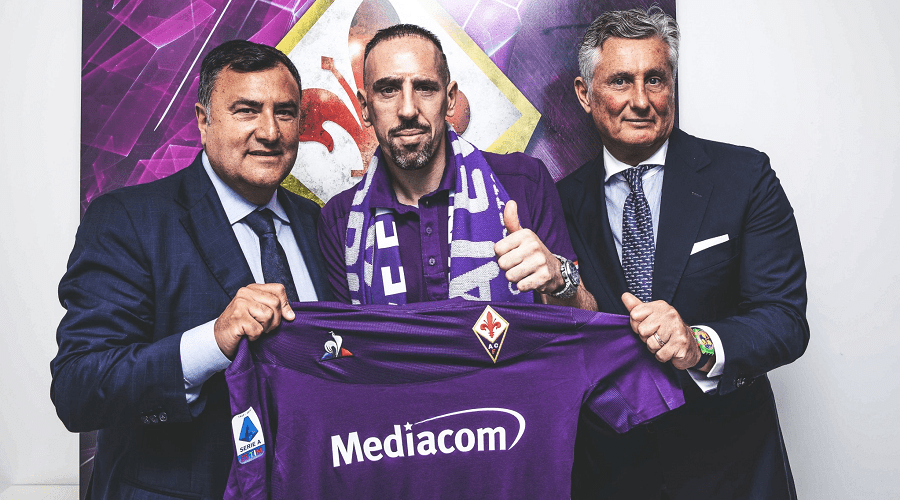
ريبيري ينضم إلى فيورنتينا الإيطالي بـ4.5 مليون يورو

تعرض زوجين للذبح داخل شقتهما يستنفر أمن سيدي سليمان

المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره غينيا الاستوائية بهدفين دون رد

"الأحرار" يثمن مضامين الخطاب الملكي ويدعو لضخ كفاءات وطنية جديدة

تزوير وثائق ملكية السيارات يجر عشريني إلى القضاء بمكناس

الملك محمد السادس : الحصول على شهادة الباكالوريا ليس امتيازا

الملك محمد السادس : الأراضي السلالية رافعة للنهوض بالمشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي

الملك : المغرب حقق نموا اقتصاديا رغم تصنيفه إلى جانب دول تزخر بالبترول والغاز

الملك محمد السادس يحدد ملفات اشتغال لجنة النموذج التنموي

احتجاجات بزاكورة على استمرار انقطاع الماء

صفعة اسبانية جديدة للبوليساريو

فيدرالية الاباء تدعو لمقاطعة المدارس الخاصة بسبب زيادات رسوم

التحقيق مع اربعة أطباء بتهمت تعريض حياة مواطنين للخطر

وزارة الصحة تتهم الاطباء بحرمان المواطنين من العلاج
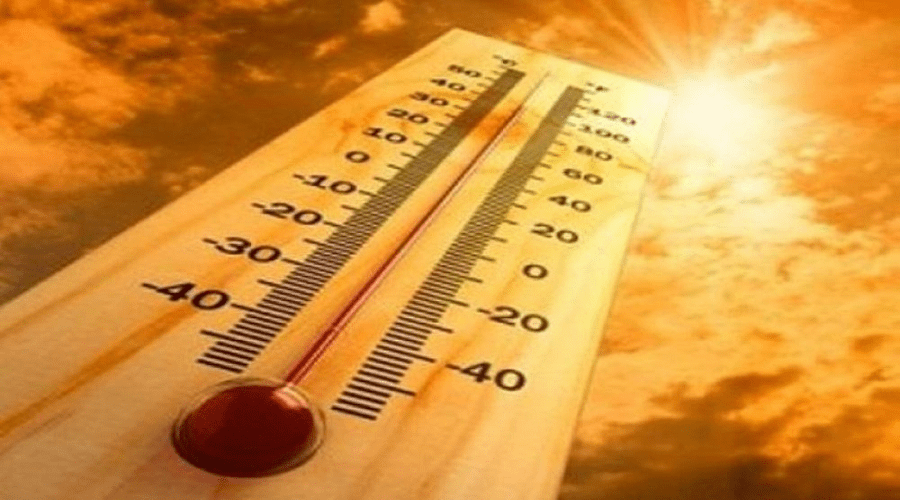
درجات الحرارة تتجاوز 46 ورياح قوية بهذه المدن مساء اليوم

الحكومة تفرض غرامة مليون سنتيم على ملوثي البيئة
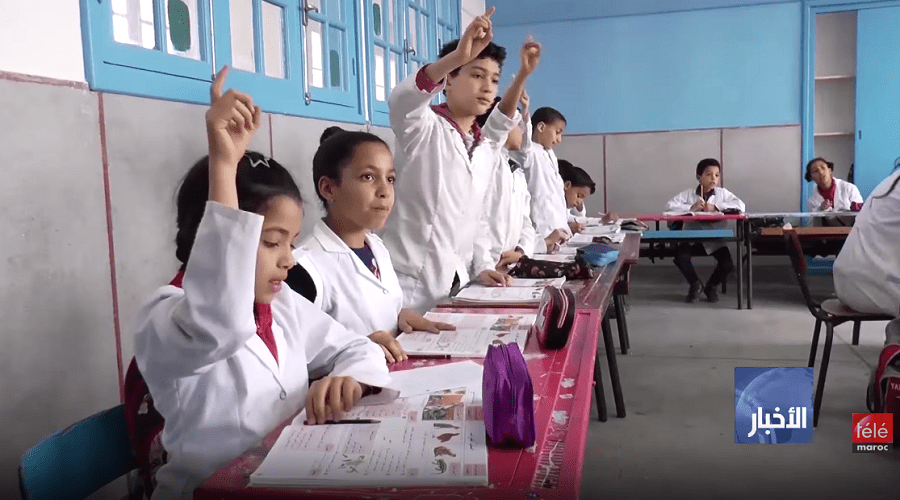
حوالي مليون و700 ألف طفل مغربي سيجدون أنفسهم خارج المدارس بحلول عام 2030

بنكيران يجر ثلاثة طلبة إلى القضاء بعد وصفهم إياه بالـ"كلب"

الملك يصدر عفوه عن 262 شخصا ويوجه خطابا إلى الأمة

السرعة المفرطة تغيير مسار موكب زفاف صوب المستعجلات بالحسيمة

حوادث السير تحصد أرواح 30 شخص خلال الأسبوع الماضي بالمدن المغربية

مولاي رشيد يعطي انطلاقة الألعاب الإفريقية وسط إشادة دولية بحفل الافتتاح

شركة إيطالية تطالب العثماني بتعويض قيمته 500 مليون درهم لهذا السبب

القاعدة الجوية بالقنيطرة تستقبل الفوج الأول من المدعوين للخدمة العسكرية

تقرير: 12 في المائة من المغاربة يدخنون ومضاعفات أمراض التبغ تقتل 18 ألف مغربي سنويا

السلطات الجزائرية ترحل رضا بنشمسي يوما واحدا بعد اعتقاله أثناء مشاركته في الحراك الشعبي بالبلاد

هذا موعد الدخول المدرسي وهذه تواريخ آخر فروض المراقبة المستمرة برسم سنة 2019/2020

الديستي تسقط منتحل صفات بالأمن والداخلية نجح في الاستيلاء على الملايين عن طريق التبرعات

المغرب يتسلم الدفعة الأولى من طائرات F-16 بقيمة 250 مليون دولار

حوادث السير تنهي عطلة البرلمان

حقيقة دواء الأطفال الملوث في الصيدليات المغربية

هل تنتهي أزمة النقل الحضري بالرباط في غشت ؟

محامون يتهمون وكالة اسفار في تطوان بالنصب

غلاء الأسعار يقض مضجع مصطافي مدن الشمال

15 ألف مجند يلتحقون بالخدمة العسكرية غدا الإثنين

حجز 4 ملايير من التوابل المهربة
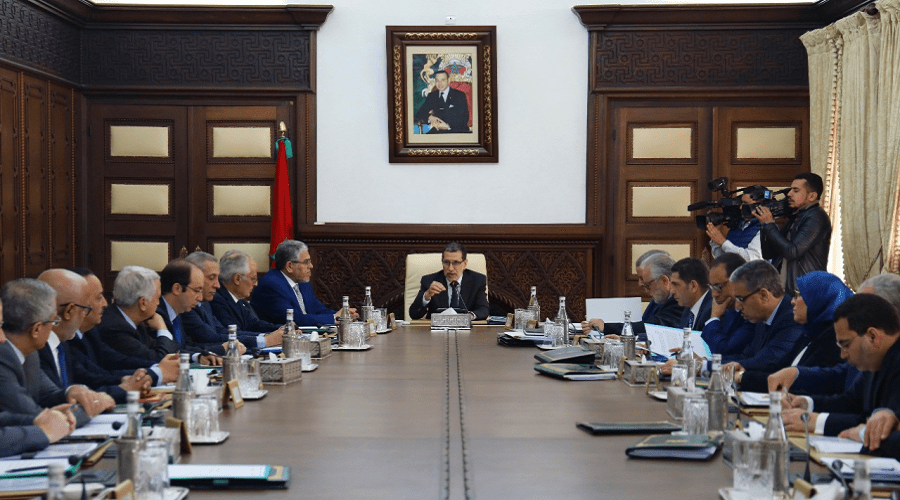
الحكومة تستعد لتغيير جلدها وتقارير تورط أطرا ومسؤولين

مندوب الصحة بالعرائش يجر طبيبين إلى القضاء بعد شلهما جناح الولادة

كوكايين سيدي رحال يجر 18 شخصا إلى القضاء

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 17 غشت

غرامات جديدة ضد السائقين بسبب الـ«كلاكسون» والـ«سويكلاس»

إيرادات المغرب من الغاز الجزائري تتراجع إلى النصف

ربان ينجح في الهبوط بطائرة فوق حقل للذرة بعد هجوم سرب لطيور النورس على محركاتها

إطلاق نار بالقنيطرة لإيقاف جانح عرض حياة موظفين للخطر

حجز 7 آلاف قرص من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة

حافلات جديدة تجوب شوارع البيضاء ابتداء من 2021 لتخفيف أزمة النقل

العثماني ينهي عطلة الوزراء بمجلس حكومي الخميس المقبل

الدكالي يعتزم تخصيص تعويضات جديدة للأطباء لإطفاء غضبهم
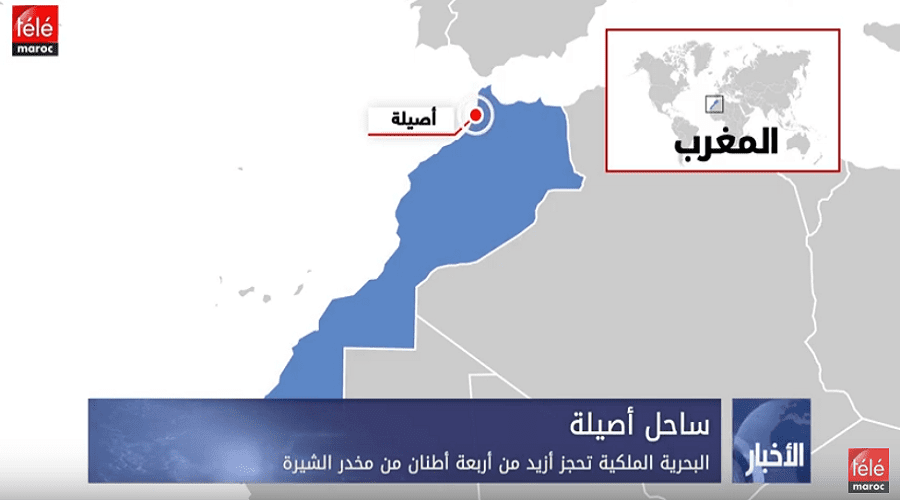
البحرية الملكية تحجز أزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرة

تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي علي يد المافيا الإيطالية

القرقوبي يسقط عنصرا من القوات المساعدة وإبن مسؤول برتبة أدجودان

4 فتيات "يشرملن" شابا في الشارع العام بالقنيطرة

مافيا تهريب المهاجرين بالجيت سكي تعود بقوة

العثماني ينهي عطلة الوزراء بمجلس حكومي

نطحة عجل تنهي حياة أربعيني في سطات

قنينة ماء ب100 درهم في فندق بأكادير تثير ضجة بمواقع التواصل

مقاولات وهمية تسطو على الصفقات العمومية

الوكالة الفرنسية للسلامة الدوائية تحذر من دواء مسموم يباع في الصيدليات المغربية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 15 غشت

بدء رحلات عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن غدا الجمعة

نزيف استقالات أطباء القطاع العام يصل 1300 استقالة

ليديك تكشف أسباب انقطاع الماء يوم العيد

السكر وغاز البوتان يلتهمان سبعة ملايير درهم من صندوق المقاصة خلال النصف الأول من السنة

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

حريق إيفرني يتسبب في خسائر فادحة ويدمر النطاق الغابوي بمنطقة الدريوش

العطش يقتل سائحا اجنبيا بامحاميد الغزلان

الاستيلاء على رزم كوكايين لفظتها أمواج شاطئ سيدي رحال يقود رجل أعمال وإبنه إلى سرية الدرك

تعيين قائم جديد بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط

سحب رخصة محل لبيع المأكولات بجامع لفنا بعد تقديمه وجبة لسياح مقابل 5000 درهم

ليديك تكشف أسباب انقطاع الماء بالدارالبيضاء يوم العيد
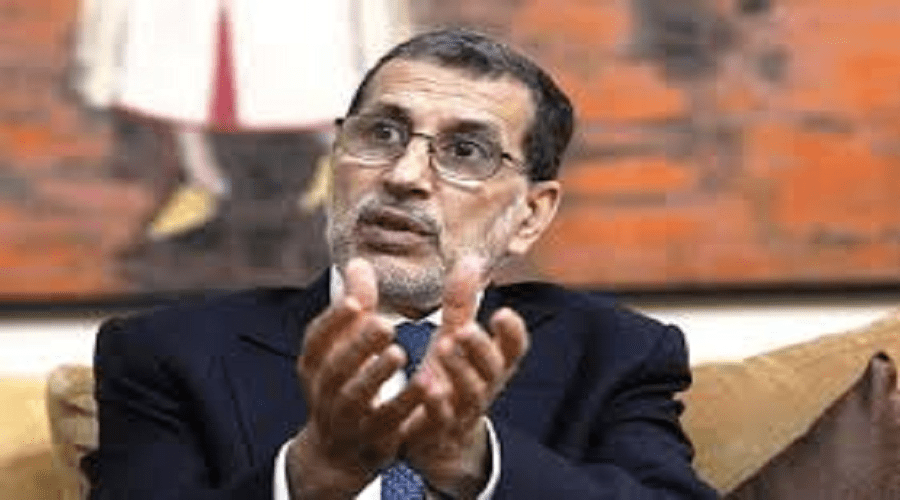
مطالب للعثماني بالكشف عن نتائج الاستراتيجية الوطنية للشباب

نزيف استقالات أطباء القطاع العام يصل 1300 استقالة

الاشادة بالإرهاب تجر خياطا بسلا للاعتقال

الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها للقانون الإطار للتربية وتدعو الحكومة إلى سحبه

أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات الخميس والجمعة ويلوحون باستقالة جماعية

سكان المدينة القديمة بالرباط يرفعون مطالبهم الملحة لتحرير الملك العمومي

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الملك ابتداء من هذه السنة

عجز الميزانية يقفز إلى 28 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري

حوادث السير تحصد أرواح 16 شخص داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

إلقاء القبض على خمسة أشخاص تورطوا في رشق مستعملي الطريق بالحجارة ليلا

إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الملك ابتداء من هذه السنة

الجفاف يهدد المغرب مستقبلا بتراجعات اقتصادية

بالفيديو.. لحظة دهس قاصر لسياح صينيين بفاس ت

ابن الوز عوام... ابن الشوباني يؤسس شركة مع ابن رئيس بلدية تمارة بحثا عن صفقات صينية

بالفيديو... موقف الحسن الثاني من السراويل القصيرة ولباس المغربيات

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 10 غشت

وزارة التعليم تعد الطلبة بنجاح مجاني في الوقت الذي يتشبثون فيه بمقاطعة الامتحانات

المغرب يسجل أعلى معدل حجوزات الطيران في افريقيا اتجاه مكة المكرمة

حجز أزيد من 11 ألف قرص مخدر مدسوسة في علب حليب

توقيف 3 متورطين في تزوير الأوراق النقدية وعرضها للتداول

فنانون يطعنون في الذمة المالية للحاج يونس والأخير يطالب بافتحاص

"وزير الواتساب" يوزع 300 أضحية

إيطاليا.. سالفيني يعلن انهيار الائتلاف الحكومي ويدعو لانتخابات مبكرة

افتتاح حمامات تحت مسجد الحسن الثاني للعموم وهذه أسعارها

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 09 غشت

أمطار رعدية وسيول جارفة تقطع الطريق بين ورزازات و مراكش

اتحاد النقابات العالمي يعتبر مشروع قانون الإضراب محاولة لفرض الأمر الواقع

فرقة الوقاية المدنية تدخلت لإطفاء الحريق الذي أودى بحياة "هبة" في سبع دقائق

حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلى السعودية على دراجات هوائية (فيديو)

قاصر يدهس 14 شخصا بينهم 10 سياح بفاس

إحداث فرق عسكرية خاصة بالأزمات

اعتقال متهمين بالاعتداء على نائب وكيل للملك وزوجته القاضية

لحوم مجازر مراكش ممنوعة على السياح الأجانب لهذا السبب

الداخلية تكشف نتائج التحقيق في فاجعة احتراق الطفلة "هبة"

بالصور.. سرقة محل لصياغة المجوهرات بالدار البيضاء

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

لوران بلان يحل بالمغرب لخلافة رونار

"مهزلة رادس".. الوداد لم يخسر بعد معركته مع الترجي

أزمة مائية خطيرة تهدد ربع سكان العالم بنضوب المياه في الصنابير

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 08 غشت

جمعيات المستهلك تطالب العثماني بإخراج قانون للحد من فوضى مواقف السيارات

المغرب من أكثر الدول المهددة بالجفاف والفقر المائي

مراكش: إيقاف أحد المشتبه فيهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت

مكة المكرمة تستعد لاستقبال 2.5 مليون حاج

عيد الأضحى: العرض من القطيع يتجاوز الطلب بأكثر من 40 في المائة

كموندو أمني لتحرير تاجر مختطف من طرف عصابة للكنوز

قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي تاونات

حقيقة خبر قتل مغتصب حنان لمصور الفيديو المعتقل معه

تفاصيل حرمان باخرة مغربية من نقل مغاربة الخارج

الغش في مواد البناء يهدد بانهيار مشروع ملكي لإعادة الإيواء

السوق السوداء تلهب أسعار تذاكر النقل عبر الحافلات مع اقتراب عيد الأضحى

بعد اعتقال أستاذ.. برلماني يحرّض ضد متطوعات بلجيكيات بسبب لباسهن

اعتقال زوج عذب زوجته طيلة 5 أشهر وحاول قتلها بالغاز (صور)

قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين نواحي تاونات

ممنوع شواء رؤوس الأضاحي هذه السنة في أزقة طنجة بقرار من العمدة

نشرة خاصة.. طقس حار وأمطار عاصفية بهذه المناطق من المملكة

رسميا.. لجنة الانضباط بـ"الكاف" تعلن قرارها في قضية مهزلة رادس

الجامعات المغربية تتديل تصنيف أفضل الجامعات في العالم

اعتقال رئيس جماعة بسبب "شيك" بدون رصيد

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 07 غشت

السلطات تقدم روايتها حول احتراق الطفلة "هبة" وتعلن فتح تحقيق قضائي في الحادث

الأبناك تستنفر مستخدميها على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى لضمان عدم تكرار أزمة السيولة

أزيد من 567 ألف مسافر دخلوا التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط

الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع "المسطرة الجنائية"

إصابة شخصين بطلق ناري يستنفر أمن سيدي سليمان

تهديدات بإغراق البيضاء في الأزبال أيام عيد الأضحى لهذا السبب

تطورات جديدة في ملف العمارة المنهارة بالقنيطرة

أزمة السيولة بـ "الشبابيك" في عيد الأضحى تستنفر الأبناك

توقيف 3 متورطين في قضية اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية

اللجنة التأديبية لـ "الكاف" تصدر قرارها في حق لقجع

“المتعاقدون” يلوحون بالعودة للشارع ويعتبرون الاقتطاعات "سرقة موصوفة"

هذه تفاصيل مراسلة "الكاف" للوداد بشأن مهزلة رادس

"بيم" التركية تطرد عمالا مغاربة ونقابة تدخل على الخط

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 06 غشت

قطاع الصحة: طلبة الطب يردون على وزارة أمزازي ويتوعدون بدخول جامعي ساخن

المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

إحباط محاولة تهريب 840 كيلوغراما من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط

لوبيات العقار تستولي على عشرات الهكتارات قرب "مرجة الفوارات" بالقنيطرة

المكتب الوطني للمطارات يدرس بيع المطارات الكبرى

تفاصيل ايقاف استاذ بالقصر الكبير بتهم التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية والإرهاب

ضمنهم سعودي وبرلماني.. الداخلية توجه إنذارات لمحتلي أراض سلالية

شاطئ سلا يقذف كميات كبيرة من الكوكايين وسط ذهول المصطافين

اعتقال أستاذ حرّض على ارتكاب أفعال إرهابية في حق سائحات أجنبيات عبر "فيسبوك"

سلطات الخميسات تكشف معطيات جديدة حول فاجعة احتراق الطفلة "هبة"

ONCF يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 05 غشت

المديرية العامة للضرائب تعزز المراقبة الضريبية عبر إحداث ثلاث فرق جديدة
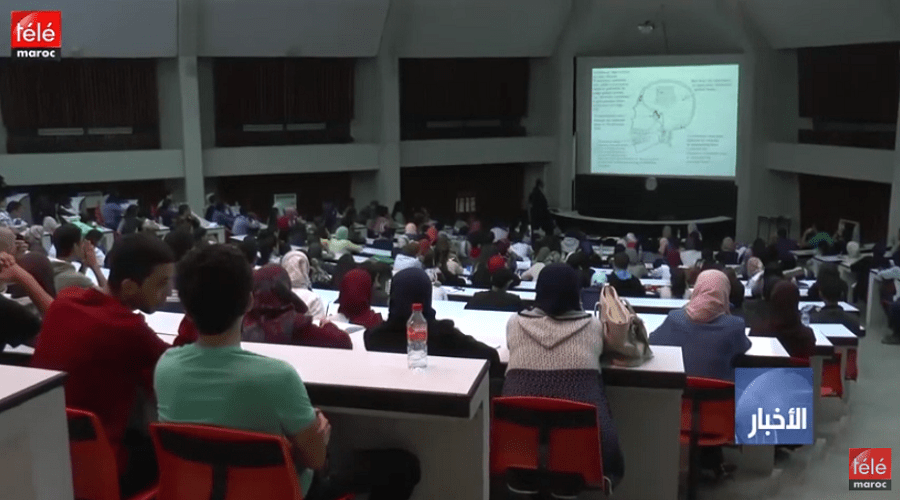
بعد إعلان طلبة الطب مواصلة التصعيد، الوزارة ترد وتعلن مواعيد الامتحانات الاستدراكية

إيقاف المشتبه فيه الثالث بارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق الوطنية

تلاعبات بتبرعات الأضاحي والداخلية تدخل على الخط

تفاصيل حجز 700 طن من الأعلاف المصنوعة بطرق غير قانونية

وزارة أمزازي تعلن موعد امتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة الطب
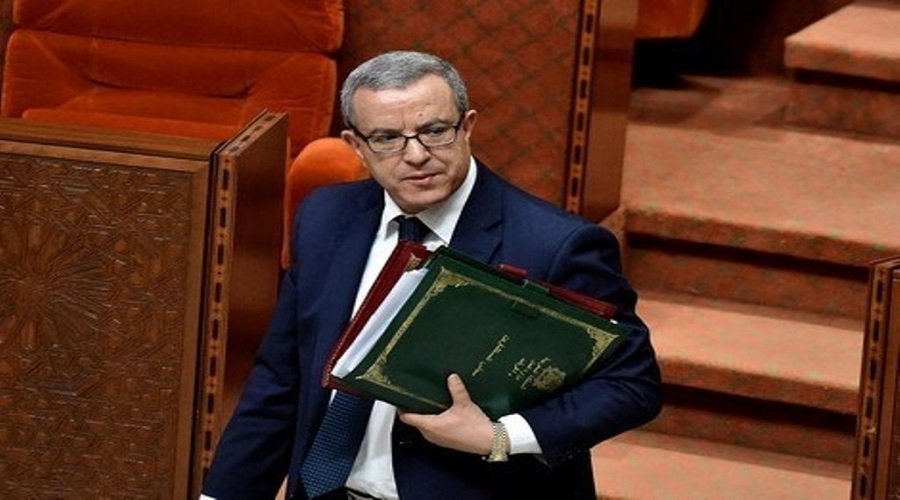
طعن قاض بالسلاح الأبيض يستنفر سلطات آسفي

بالفيديو.. لحظة قتل "سفاح أوهايو" من طرف الشرطة الأميركية

قتلى وجرحى في انفجار وسط العاصمة المصرية القاهرة

مسؤول نقابي يؤكد أن ماء "ليديك" ملوث ويهدد بكشف أسرار خطيرة

إدارة فيسبوك تحذف حسابات مزيفة كانت تستهدف دولا بينها المغرب

جريمة "لاكريم" تطيح بمدير وكالة بنكية تلاعب في أرصدة بالملايير

انهيار سقف مستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة بعد شهور من تدشينه

سرقة تحت التهديد بالسلاح داخل حافلة بالبيضاء والأمن يتدخل

إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال

الملك يعين عبد العالي بلقاسم مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 02 غشت

توقيف المعتدين على مستعملي الطريق الوطنية بمكناس

وزارة الصحة تؤكد توصلها اليوم بست مائة ألف علبة دواء

وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع الولاة والعمال

لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على "القانون الإطار" بالأغلبية
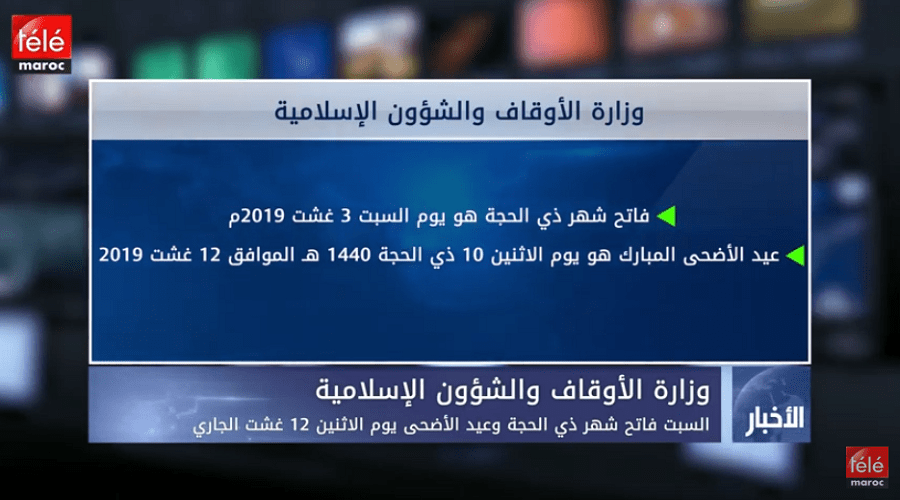
السبت فاتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الاثنين 12 غشت الجاري

ضابط أمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص هدد بالسلاح الأبيض مستخدمي وكالة بنكية

الداخلية تطالب عمدة مراكش بتوضيحات حول اختلالات سوق الجملة

الولايات المتحدة تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة

توقيف إسباني متورط في تنظيم عملية للهجرة السرية بالناظور

"العطش" يحاصر 300 ألف نسمة في قرى آسفي

منتوجات فاسدة على موائد أعراس ومناسبات المغاربة

بالوعات مكشوفة في شوارع وأزقة الرباط تهدد حياة الرباطيين

أمن مكناس يعتقل 5 أشخاص متلبسين بتصوير شريط فيديو لجرائم وهمية

لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على "القانون الإطار" بالأغلبية

لفتيت يعقد اجتماعا مع الولاة والعمال

توقيف المعتدين على مستعملي الطريق الوطنية بمكناس

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 01 غشت

مخطط المغرب الأخضر مكن من تعزيز البنية التحتية للزراعات ومقاومة قساوة المناخ
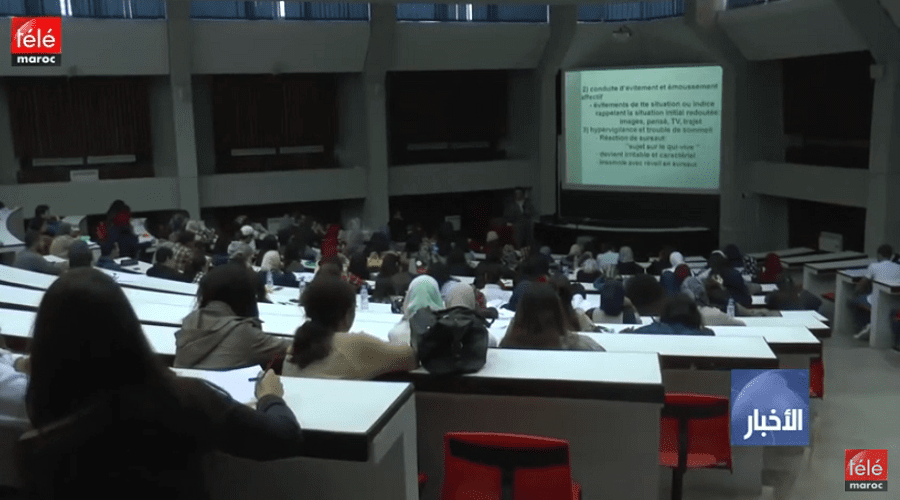
115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية

احتياطات صندوق التقاعد ستنفذ في أفق العشر سنوات المقبلة

الملك يطلق اسم عبد الرحمان اليوسفي على الفوج الجديد من الضباط

الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

كارثة بيئية تهدد الواجهة البحرية لإقليم النواصر

هام للطلبة.. إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاستفادة من السكن الجامعي

نقابات تنتفض في وجه يتيم وتفضح خروقات خطيرة داخل وزارة الشغل

مديرية الأدوية تتعهد بتوفير شهرين من دواء "الغدة الدرقية" بعد نفاذ المخزون

ارتفاع درجة الاستنفار داخل الجيش والجنرال الوراق يحرّك سلاح الجو بالمنطقة العازلة

الشرطة القضائية تحقق في تهريب 505 كلغ من الشيرا بميناء الجزيرة الخضراء

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب مركبة عسكرية

اعتقال امرأة سلمت والدتها المسنة لعشيقها من أجل اغتصابها وقتلها

الرباطيون يقبلون على المسبح الكبير وبعض مرتاديه يشتكون من عدم تنظيمه

تحذير.. الحرارة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق

الملك يطلق اسم عبد الرحمان اليوسفي على الفوج الجديد من الضباط

أمن البيضاء يوقف شخصا قام باختطاف سيدة واحتجازها

سلطات آسفي تكشف حقيقة صورة تقييد شخص بسلسلة

الملك محمد السادس يترأس بطنجة حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد

طلبة الطب يتوعدون بخوض أشكال نضالية احتجاجية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل

بعد تعرضهم لـ "التحايل".. مغاربة العالم يحتجون على بوليف

الفواكه الحمراء المغربية تدخل السوق الأمريكية

هكذا تحولت قرية طبية عالمية قيمتها 250 مليارا إلى مشروع سياحي

عندما كاد العثماني أن يفقد توازنه أمام الملك

"رجاوي فلسطيني" تستنفر وزارة خارجية إسرائيل

بعد فشل مفاوضاتهم مع الحكومة.. طلبة الطب يعودون للشارع

مع اقتراب الانتخابات.. "البيجيدي" يطالب الداخلية باختصاص بناء المسالك

خطاب الملك يجمع الأغلبية

سلطات آسفي تكشف حقيقة صورة تقييد شخص بسلسلة

أستاذ يطلق مبادرة يطلب فيها من 10 ملايين تلميذ دفع درهم رمزي شهريا لبناء 4 مدارس كل شهر

الملك يستقبل عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية بمناسبة الذكرى 20 لتربعه على العرش

فضيحة محاولة السطو على مليار و800 مليون تهز وزارة الصحة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 30 يوليوز

الملك يقرر إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

الملك يجدد التأكيد على التزام المغرب الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر

الملك يصدر عفوه السامي عن 4764 شخصا

الملك : أتألم شخصيا ما دامت فئة من المغاربة لا زالت تعاني الفقر والحرمان المادي

الملك يعلن عن تعديل حكومي ويدعو إلى توفير أسباب نجاح المرحلة الجديدة

الملك يترأس اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش

عفو ملكي يشمل معتقلي أحداث الحسيمة وقضايا الإرهاب

الملك ينتقد الإنغلاق السلبي الذي يخيف الإستثمار الأجنبي ويدعو لثورة حقيقية تغير العقليات

الملك يجدد مد اليد نحو الجزائر

النص الكامل للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش

الملك يعلن عن تعديل في الأغلبية ويوجه رسالة مباشرة لحكومة العثماني

الملك : المنجزات التي حققتها المملكة رغم أهميتها لم تمس كل شرائح المجتمع

الملك يستقبل الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج

"فوربس" تصنف "البراق" ضمن أسرع القطارات في العالم

الملك يستقبل والي بنك المغرب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 29 يوليوز

تدشين حملة تحرير الملك العمومي بالرباط، ومقاهي ومطاعم تسطو على ممرات الراجلين

وزارة الاقتصاد والمالية تكشف أبرز العوائق التي يواجهها تطور قطاع الفلاحة

خطاب العرش سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة مساء اليوم ابتداء من الساعة التاسعة

توفير خدمة للذبح بمجازر البيضاء خلال عيد الأضحى

اعتقال مسؤولة في الحسابات بإذاعة "ميدي1" ونقابة المهنيين تفتح النار على خيار

قاصر يقود حافلة للنقل الحضري بعين الذياب والأمن يتدخل

الفاسي يطيح بمدراء وكالات حضرية

دول إفريقية تمنع أدوية مغربية

الملك محمد السادس يخاطب المغاربة غدا الاثنين بمناسبة عيد العرش

مستشاران ملكيان يقيمان 20 سنة من حكم الملك محمد السادس

الحكومة تعتمد إجراءات تقشفية وتطلب من المغاربة "تزيار السمطة"

الإعدام في حق منفذي جريمة "لاكريم"

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 "دواعش" خططوا لاستهداف أمن المملكة

اتصالات عليا تنهي المقايضة على قانون التعليم

هكذا أصبح الرميد وزيرا غير مرغوب فيه

تاريخ إغلاق أبواب البرلمان يشعل حربا بين المالكي وبنشماش

طفلة تجني 3 ملايين دولار شهريا من الأنترنت

ترقيم أزيد من 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز استعداد لعيد الأضحى

إنذار ... الحرارة ستصل إلى 45 درجة بهذه المناطق من المملكة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 26 يوليوز

الملك يهنئ بوريس جونسون بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة

المصادقة على مشروع مرسوم يهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية
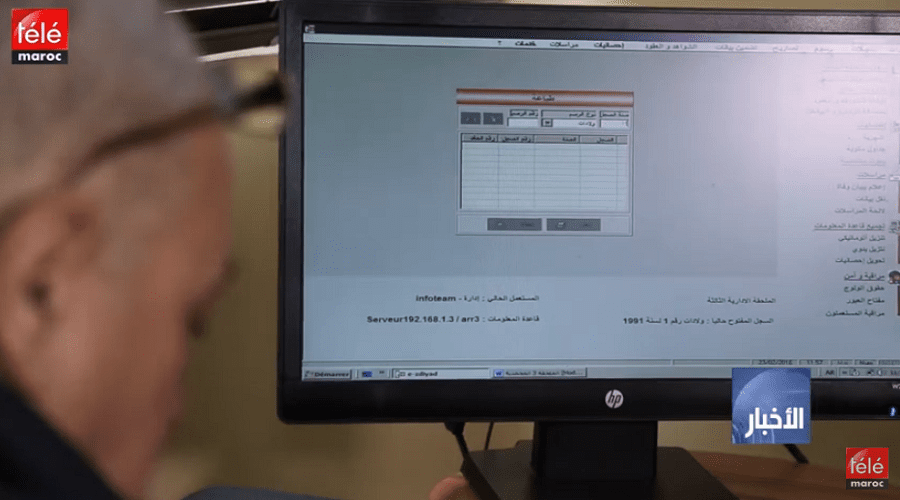
اقتراحات جديدة لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام

عرض حكومي جديد لإنهاء أزمة طلبة الطب يشمل الرفع من عدد مناصب مباريات الإقامة

فاجعة الحوز.. انتشال 15 جثة والبحث جار عن مفقودين

اختلاسات مالية تجاوزت 140 مليونا تهز مستشفى عموميا

مستشار الرميد يهدد بفضح أسرار بنكيران

بوقرعي وماء العينين يصوتان على قانون "فرنسة التعليم" خوفا من التأديب

رجال الحموشي يوقفون مروج "فيديو" لجناية يعلم بعدم حدوثها بالبيضاء

مديرية الأمن تكشف حقيقة فيديو "الطعن حتى الموت"

هذا ما قاله الملك عن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

السلطات تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل فاجعة الحوز

بنكيران يتهم العثماني والرميد ب"ذبح اللغة العربية والتمكين للغة المستعمر"

المحاكم تلزم الدولة بأداء 325 مليار سنتيم سنويا

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر

بالفيديو.. قتلى في انهيار جبلي بمنطقة الحوز

المغاربة يغرمون الدولة 300 مليار سنويا والأحكام تستنزف 950 مليارا من المال العام

إدانة المتهم الرئيسي في تعويضات وهمية عن المرض فاقت 100 مليون

أزيد من 20 مفقودا جرفتهم السيول بمنطقة الحوز

الشيخي وحامي الدين ينتقمان لبنكيران

"البيجيدي" يعاقب الخارجين عن الطاعة

المحامي المسعودي : اعتقالي عادي وليس فيه أي تضييق على نشاطي المهني أو الحقوقي أو السياسي

البرلمان يحسم الجدل ويمنع المبصاريين من قياس النظر

بنكيران يتهم العثماني والرميد بـ"ذبح اللغة العربية والتمكين للغة المستعمر"

الحموشي يستقبل حجاج الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني

"الهاكا" تنتقد التجاوزات الزمنية للإشهارات على القنوات العمومية

اعتقال المحامي المسعودي تنفيذا لحكم قضائي بسبب حادثة سير تعود إلى 2011

تلقيح ما يفوق مليون رأس من الأبقار و17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 24 يوليوز

استثمارات تقدر بحوالي 3،5 مليار درهم مكنت من خلق 252 ضيعة لإنتاج بيض الاستهلاك

قطاع الصحة: أنس الدكالي يكشف عن خصاص مقلق في أطر الصحة

متوسط محصول الحبوب في الموسم الفلاحي الحالي سيتراجع إلى 13 قنطارا في الهكتار الواحد
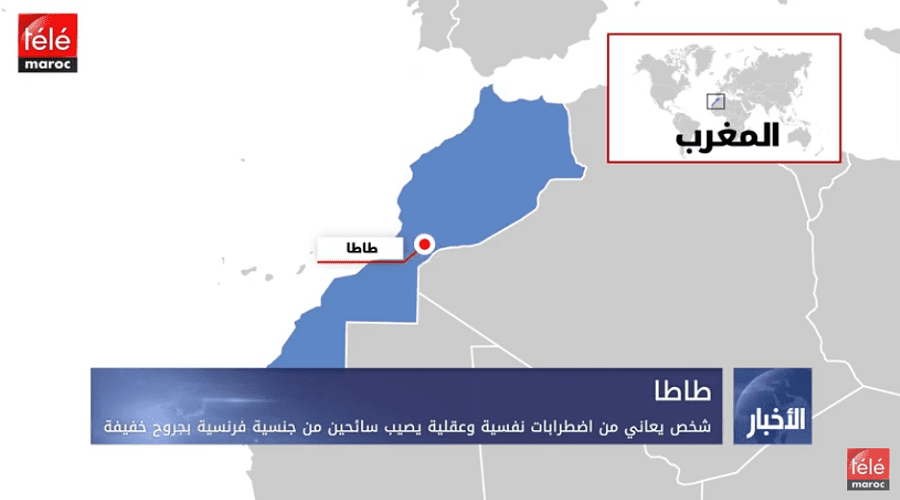
طاطا: شخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية يصيب سائحين من جنسية فرنسية بجروح خفيفة

أمن مراكش يطيح بـ "هاكرز" بلغاري متورط في قرصنة أبناك مغربية

صراع بين رجال أعمال يفجر فضائح نهب الرمال والاستحواذ على عقارات الأجانب

كودار يهاجم بنشماش ويطعن في طرده من "البام"

رباح يتراجع ويلغي قرار ربط المنازل بالكهرباء

رئيس "التوحيد والإصلاح" ينقلب على جماعته بسبب "فرنسة التعليم"

تطور قطاع إنتاج البيض بالمغرب يفند إشاعات استيراده

شخص يهاجم سائحا فرنسيا وابنته بالسلاح الأبيض وسلطات طاطا توضح

مجلس النواب يصادق بالإجماع على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية

أخنوش يعرّي مشاكل الصحة ويتعهد بإحداث ثورة في القطاع

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية وحرارة تصل إلى 46 درجة بهذه المناطق

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 23 يوليوز

العثماني: إنجاز 15 سدا مبرمجا بين سنتي 2017 و 2021

مواجهة بين الحكومة والنقابات.. ورفاق الزاير يطلقون عريضة لسحبه من البرلمان

عبد الحق الخيام: توحيد الجهود هو السبيل الأنجع للقضاء على الإرهاب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق ب"فرنسة التعليم"

أهداف رؤية 2020 تتبخر.. أزمة خانقة بمكتب السياحة تهدد القطاع بالسكتة القلبية

بمساعدة "الديستي".. أمن تمارة يطيح بعصابة إجرامية خطيرة

كارثة بيئية بميناء آسفي... نفايات صناعية وسفن ترسو وسط برك ملوثة

عامل وعمدة آسفي يتذوقان السمك بمهرجان للشهب النارية كلّف نصف مليار

خروقات في تعيينات البرلمان

الداخلية تقرر حركة تنقيلات لرجال السلطة بعد حفل الولاء

بعد فشله في المواجهة.. الصمدي يشتري ود أمزازي

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بـ "فرنسة التعليم"

عشرات البرلمانيين من "البيجيدي" يقاطعون جلسة التصويت على "القانون الإطار"

العثور على جثة "قائد" بالعيون تحمل آثار عيار ناري

نشرة خاصة.. زخات رعدية وطقس حار بهذه المناطق من المملكة

تفاصيل الاعتداء على "قائد" بالسلاح الأبيض

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 22 يوليوز

وزارة الداخلية تواجه تغيير ملامح البنايات العقارية بشكل غير قانوني

الجيش يستدعي أول فوج للتجنيد الاجباري

بنكيران يقصف إخوانه ويصرح بالخروج من البيجيدي والعثماني يرد
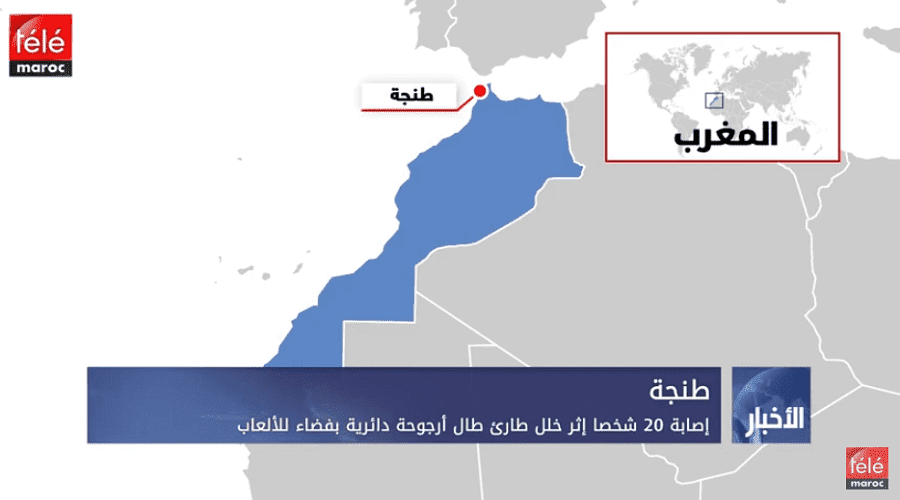
إصابة 20 شخصا إثر خلل طارئ طال أرجوحة دائرية بفضاء للألعاب

هكذا تساهم صراعات الأغلبية في هدر الزمن التشريعي وتعطل مصالح المواطنين

التحقيق في فضيحة تخلص مستشفى من جثتي جنينين بمطرح نفايات

بعد أشهر من "الهدنة".. المتعاقدون يعودون إلى الشارع

بعد "لايف" بنكيران.. العثماني يطلب لقاء الأمانة العامة ببرلمانيي الحزب

اندلاع حريق داخل مستشفى الأطفال السويسي

إصابة 20 شخصا إثر سقوط أرجوحة للألعاب بطنجة

تلاعبات جمركية بـ25 مليارا

الجيش يستدعي أول فوج للتجنيد الاجباري

بعد شرطة البيئة وشرطة الماء.. الحكومة تحدث شرطة المقالع

أونسا يحجز أدوية بيطرية مجهولة المصدر بزحيلكة

منحة إسبانية للمغرب بـ 30 مليون يورو من أجل محاربة الهجرة السرية

هيئات طبية تتهم الحكومة بتعريض صحة المغاربة للخطر

القرارات العاملية لا تساوي شيئا في "مارينا" سلا ومطالب لليعقوبي بالتدخل

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 20 يوليوز

الملك يهنئ عبد القادر بن صالح بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم

الوكيل العام للملك: البحث في قضية اغتصاب "حنان" بدأ يوم 9 يونيو

جماعة طنجة تفوّت مرافقها لشركات التنمية واتهامات للعمدة بالتهرب من الحساب

38% من أجراء القطاع الخاص بالمغرب يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور

العيون.. وفاة شابة وأحداث تخريبية خلال الاحتفالات بفوز الجزائر بـ "الكان"

البطالة تهدد المغاربة.. تزايد أعداد الخريجين الجدد وتراجع فرص الشغل

بسبب بنكيران والتوحيد والإصلاح.. "البيجيدي" يستعد لتغيير تصويته تجاه قانون التعليم

اليوسفي يعود للاتحاد الاشتراكي

هكذا فشلت العسالي في طرد معارضيها

الملك يهنئ عبد القادر بن صالح بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم

الوكيل العام يكشف التهم الجنائية الثقيلة التي تلاحق المتهمين الثمانية في قضية اغتصاب ومقتل حنان

الملك يعين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بالصور.. أصوات النساء تتعالى أمام البرلمان طلبا للحماية من الاغتصاب والقتل

هكذا يساهم المغاربة في إنعاش مؤسسات الضمان الاجتماعي الإسباني

سيارة مجنونة تخترق ممر الراجلين بشارع محمد الخامس قبل اصطدامها بنخلة أمام البرلمان

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة19 يوليوز

تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات
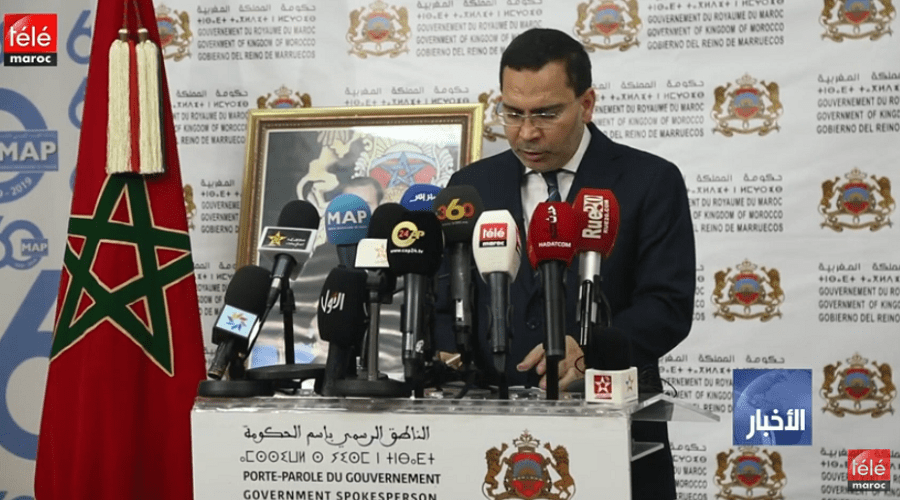
تحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

مائة وثمانية وعشرون سفينة صيد أوروبية تدخل المياه المغربية لمدة 4 سنوات

الإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيد "جريمة شمهروش"

تعويضات وهمية عن المرض بقيمة 100 مليون تطيح بـ 6 أطباء

المدارس البريطانية بالمغرب تشرع في فتح أبوابها

السفارة الأمريكية توضح بخصوص سحب تأشيرات مغاربة

هكذا أطاح اعمارة بـ62 مسؤولا

المنع من البرلمان الإفريقي يغضب البرلمانيين

لشروع في تفعيل بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

توقيف 8 أشخاص في قضية "فيديو" اغتصاب سيدة وقتلها

الإعدام والمؤبد.. القضاء يصدر حكمه في حق متهمي جريمة "إمليل" الإرهابية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 18 يوليوز

عبد النباوي والسغروشني يوقعان اتفاقية تعاون لتنسيق الجهود حول حماية المعطيات الشخصية

التجمع الوطني للأحرار يحصي الإنجازات الكبرى للملك خلال 20 سنة

مسلح يحاول اقتحام مقر 2M

حجز وإتلاف 972 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك

لجنة الداخلية تصادق على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية

اختفاء أكثر من 30 بالمائة من أدوية المستشفيات الجامعية

متهمو جريمة "شمهروش" يقولون كلمتهم الأخيرة قبل النطق بالحكم

اعتقال رجل أعمال ومعه 50 وكالة مزيفة لبيع السيارات

إغلاق مقالع للرمال بأربع مدن لهذا السبب

توزيع شقق فاخرة على مسؤولين كبار يشعل أزمة داخل وزارة التجهيز والنقل

العثماني يوصي الوزراء بالعطلة بعد عيد العرش

هكذا يخطط حامي الدين لإعادة القانون الإطار إلى البرلمان

التوحيد والإصلاح تصوت لصالح قانون التعليم في البرلمان وتدينه في بلاغ

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية

رواندا تقرر فتح سفارتها في المغرب

التزوير في مشروع ملكي وتبديد أموال عامة يجر عمدة آسفي للتحقيق

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 17 يوليوز

الطالبي العلمي يؤكد جاهزية المغرب لاحتضان الألعاب الأفريقية شهر غشت المقبل

تسرب مواد كيماوية إلى البحر يتسبب في إصابات جلدية ونفوق الأحياء البحرية

صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تقليص الفوارق الاجتماعية

تفاصيل النصب على زوجة وزير في أزيد من 4 ملايين درهم

الحكومة تستعد لفتح حضانات لأبناء الموظفات داخل الإدارات
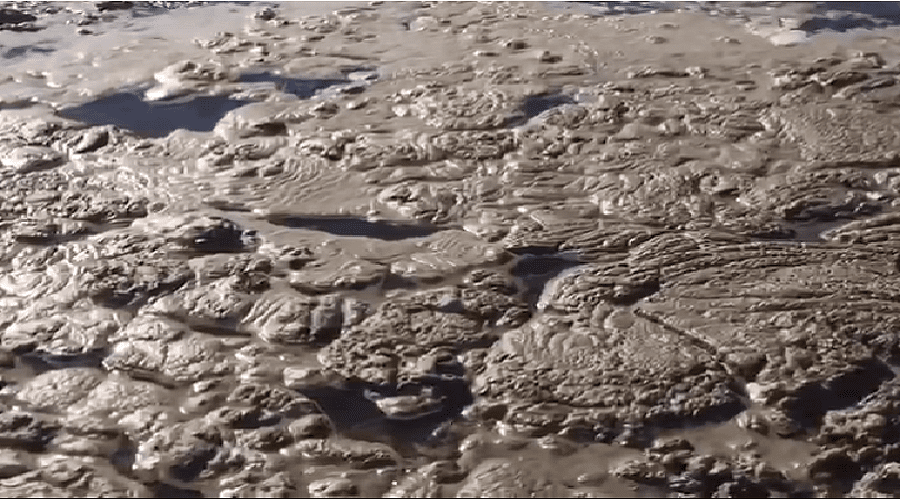
تسرب مواد كيماوية إلى البحر في الجديدة تسببت في إصابات جلدية ونفوق الأحياء البحرية (فيديو)

عناصر الدرك تطيح بعصابة متخصصة في سرقة شاحنات نقل البضائع

عشاء "باذخ" يطيح بوزير من منصبه

تدهور في مستوى المعيشة وارتفاع في نسبة البطالة.. هذا ما ينتظر المغاربة

عناصر الدرك تستعمل الرصاص لإيقاف متهم في صراع ﺗﺠﺎر مخدرات

بعد أن كان من أشد معارضيه.. البيجيدي يصوت لصالح تمرير قانون المشروع الإطار للتعليم

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 16 يوليوز

ارتفاع مقلق لمستويات المعيشة في المغرب وتراجع ثقة الأسر

مديرية الحموشي تنفي الرواية التي تناولها مقال إخباري حول واقعة إطلاق شرطي النار

رؤساء الفرق النيابية يفشلون في التوصل إلى اتفاق حول لغة تدريس المواد العلمية

مواجهة العطش ستكلف المغرب 118 مليار درهم خلال الثماني سنوات المقبلة

هكذا تتهرب شركات وأسماء وازنة من أداء رسوم بـ120 مليارا

أساتذة جامعيون يوزعون 2200 صفر على الطلبة ومطالب بالاطلاع على أوراق الامتحان

فوضى "الشيشة" واحتلال الملك العام يهددان مشروع مارينا ضفتي أبي رقراق

رباح يطرد مستثمرا إيطاليا صاحب مشروع ضخم نحو تونس

مديرية الحموشي تنفي رواية شقيق ضحية إطلاق الرصاص بالدار البيضاء

البرلمان يخالف الدستور ويغلق أبوابه قبل الوقت المحدد

هكذا أغرق الصمدي الجامعات بشهادات أوكرانيا
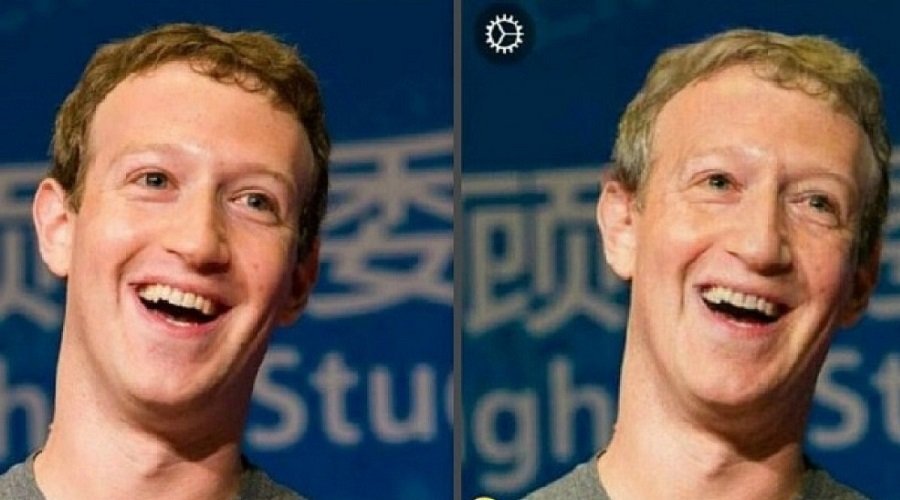
قبل أن تستعمل تطبيق الشيخوخة اقرأ هذا التقرير

أخنوش يترأس يوما تواصليا لفائدة مربي وتجار الدواجن بالجملة والتقسيط بالجديدة

أخنوش يشيد بقطاع الدواجن ويعد بتأهيل الأسواق

"العُلما" يتسببون في وقف بث "راديو مارس" لمدة 15 يوما

لحسن الداودي يقدم استقالته من جديد

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 15 يوليوز
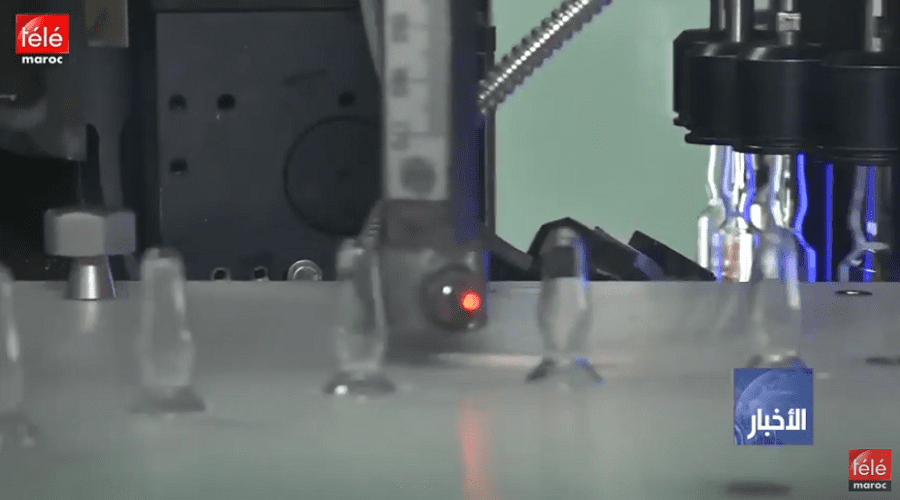
المغرب يتجه للاعتماد على "الطاقة الريحية" والتخلي تدريجيا عن الطاقات الملوثة

ارتفاع جديد في تكاليف الحج يصل إلى أزيد من 3500 درهم

القنيطرة: توقيف شخص ظهر رفقة عدد من المشتبه فيهم وهم يشهرون أسلحة بيضاء

أخنوش يترأس يوما تواصليا بفاس حول أهداف مشروع "سهل سايس"

تنقيلات واسعة وإعفاءات بالجملة في صفوف كبار مسؤولي الدرك

من ضوء السلطة إلى العتمة.. رجال البصري ماذا يفعلون الآن؟

الحموشي يراقب الأسواق وأسعار المواد الاستهلاكية

السنبلة تراجع موقفها من المصباح

الافتتاحية

البيجيدي يضغط لتعيين مرشحته عميدة للمحمدية

اليعقوبي يخوض حربا ضد فوضى المطاعم والمقاهي

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 13 يوليوز

العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى 2019 كاف لسد الطلب

أزيد من 253 ألف ناجح ممدرس في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين العادية والاستدراكية

ترحيل جثامين المواطنين المغاربة ضحايا القصف الذي طال مركز الهجرة غير النظامية بليبيا

31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية أدوا رشوة مقابل ذلك

أخنوش يترأس يوما تواصليا بفاس حول أهداف مشروع "سهل سايس"

مكافأة بمليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن برلماني مطلوب للعدالة

هذا عدد الناجحين في امتحانات "الباك" هذه السنة

مناقشة تقرير النيابة العامة بمجلس النواب بدون عبد النباوي

هكذا تتم عرقلة قوانين الأراضي السلالية داخل البرلمان

الشوباني يضغط لإعادة نوابه إلى "بيت الطاعة"

هذه إجراءات ترحيل جثامين المغاربة ضحايا قصف مركز للهجرة بليبيا

هذا سعر أضحية عيد الأضحى لهذه السنة

أخنوش يترأس افتتاح "أيام الذوق والتذوق" بتازة ويتفقد مشاريع للتنمية القروية بالإقليم (صور)

قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لدعم "قطاع التربية"

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 12 يوليوز

لفتيت يأمر بصرف زيادات في الأجور وتعويضات عائلية نهاية الشهر الجاري
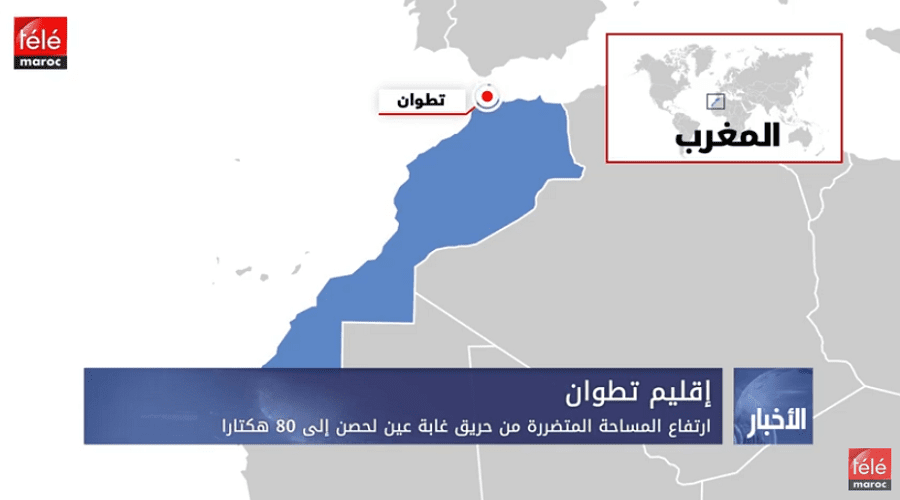
تطوان: ارتفاع المساحة المتضررة من حريق غابة عين لحصن إلى 80 هكتارا
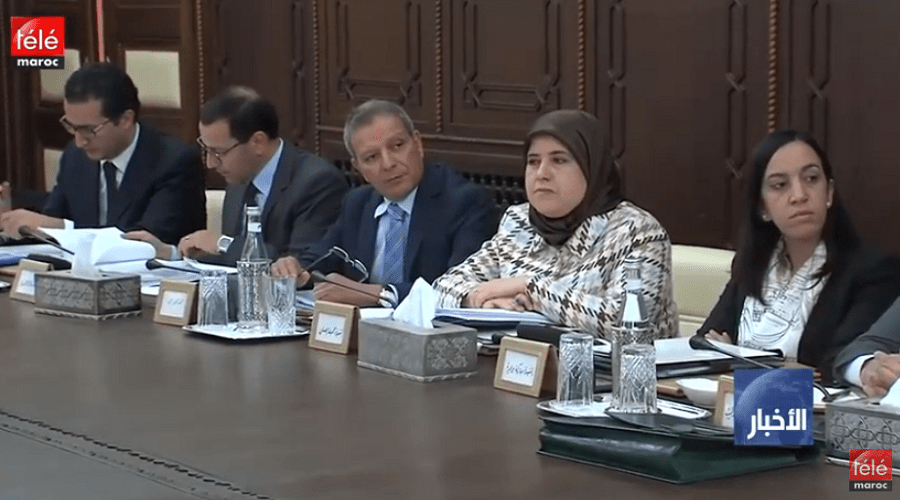
الحكومة تحدث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الذي يحل محل "كنوبس"

المرأة القوية داخل الحركة الشعبية تخسر معركة عضوية مجلس المستشارين

هكذا تحولت لجان الاستطلاع إلى مجال لخرق القانون

المحكمة الدستورية تكشف عجز مجلس المستشارين في التشريع

عدل ومحام و4 موظفين جماعيين يتابعون بالسطو على عقارات

هكذا تسبب الدكالي في احتقان داخل وزارة الصحة

العماري يخصص ملياري سنتيم لإبادة الفئران والحشرات بالدار البيضاء

تركيا تتحدى ترامب وتعلن تسلم الأجزاء الأولى من منظومة إس 400 الروسية

مصالح "أونسا" تحجز وتتلف لحوما فاسدة بالدار البيضاء

مصرع 3 عمال وإصابة آخرين في انهيار أنبوب مائي ببنجرير

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 11 يوليوز

لجنة حكومية تقدم ضمانات لطلبة الطب واجتماع ثان الخميس المقبل

تطوان: حريق يأتي على حوالي 40 هكتارا من الغطاء الغاباوي بجماعة عين لحصن

الصيد البحري: السفن الأوروبية تعود إلى المياه المغربية قبل نهاية الشهر الجاري

عيد الأضحى 2019: "أونسا" ترقم ستة ملايين رأس من الأضاحي وتعد 30 سوقا إضافيا للأغنام والماعز

السيطرة على حريق غابة عين لحصن بإقليم تطوان بعد إتلاف 40 هكتارا

جريمة بيئية بآسفي.. اقتلاع ألف شجرة أوكاليبتوس وإتلاف جذورها

الحكومة تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد على ظهور الموظفين

بريمات وترقيات توقف احتجاجات موظفي مجلس المستشارين

التدبير المالي لمجلس جهة مراكش تحت المراقبة البرلمانية

العثماني يدافع عن ريع الوزراء ويرمي بإصلاح معاشاتهم إلى الملك

أخنوش يقف على آخر الاستعدادات لمرور عيد الأضحى في أحسن الظروف

تقارير سوداء تطارد مسؤولين كبارا بالوقاية المدنية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 10 يوليوز

عزيمان : تعليم ذا جودة وقائم على تكافؤ الفرص ليس اختيارا متقاسما بين الجميع

سعد الدين العثماني يقر بفشله في إلغاء تقاعد الوزراء ويدعو البرلمان للتدخل
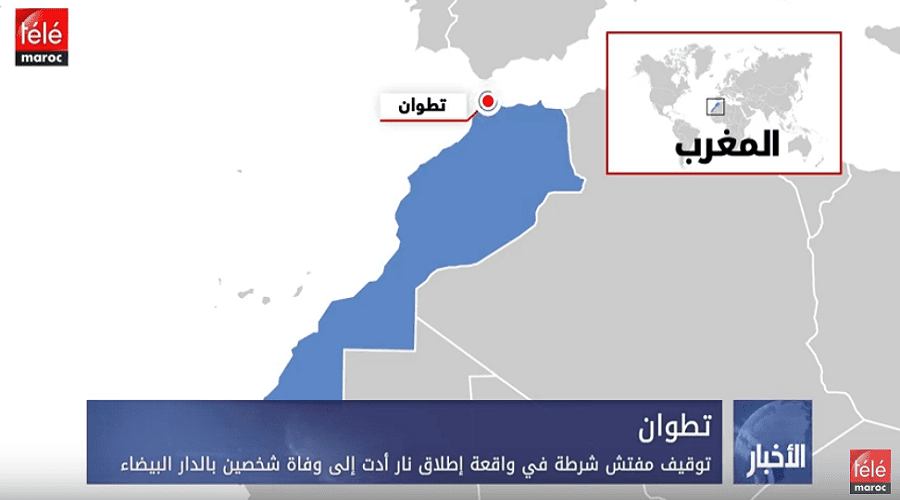
توقيف مفتش شرطة في واقعة إطلاق نار أدت إلى وفاة شخصين بالدار البيضاء

لهذا يطالب جطو الوزيرة الحقاوي بالكشف عن مصير هذه الملايير

"ديستي" تحذر وزير الصحة من أدوية مهربة تهدد صحة المغاربة

فاجعة في أكادير هذا الصباح... مصرع 4 شبان وإصابة فرنسية بجروح

هكذا حولت الحكومة برنامج "تيسير" إلى برنامج "تعسير"

برلماني ملياردير من "البام" يحطم الرقم القياسي في الغياب عن البرلمان

توقيف الشرطي الذي قتل شخصين بالرصاص في الدار البيضاء واعتقال 6 آخرين

بعد مطالبته بالكشف عن مصير 600 مليون.. بنعزوز يبحث عن الإقامة في فرنسا

جرحى في حادث اصطدام حافلة للنقل الحضري بمحول كهربائي بتطوان

مدارات طرقية عبارة عن نقط سوداء بسلا تتحول إلى شبح يقلق السائقين

تفاصيل اعتقال الشرطي الذي قتل شخصين أثناء تدخل أمني

التحقيق مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش يهدد بتفجير فضائح عمرانية كبيرة

حاليلوزيتش يخرج عن صمته ويتحدث عن تدريب المنتخب المغربي

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 09 يوليوز
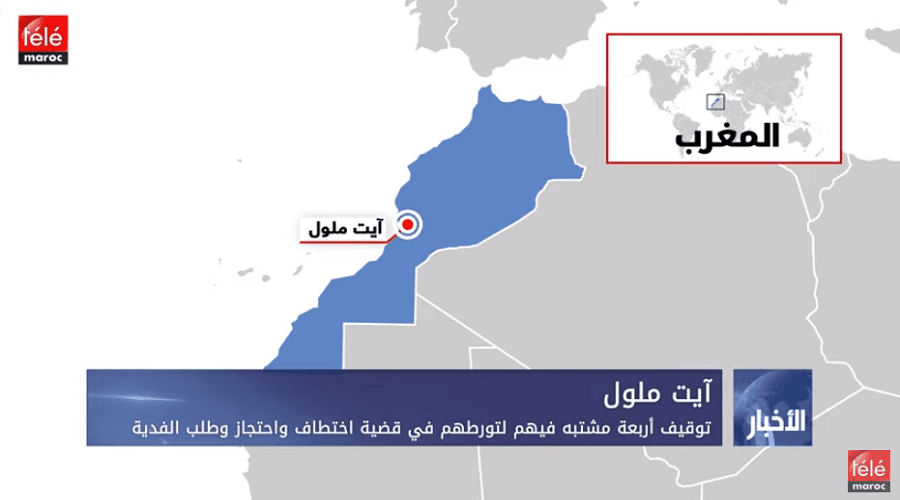
توقيف أربعة مشتبه فيهم لتورطهم في قضية اختطاف واحتجاز وطلب الفدية

الحموشي يصدر أوامره بتوقيف شرطي قتل مشتبه بهما بالرصاص

حصة الدخل من الناتج المحلي الإجمالي عرفت تراجعا بنسبة 3،4 في المائة

برلمان: التنظيم النقابي يطالب الحكومة بسحب القانون المتعلق بتحديد شروط الإضراب

وزراة الصحة: العقارب والأفاعي تودي بحياة 50 مغربيا سنويا
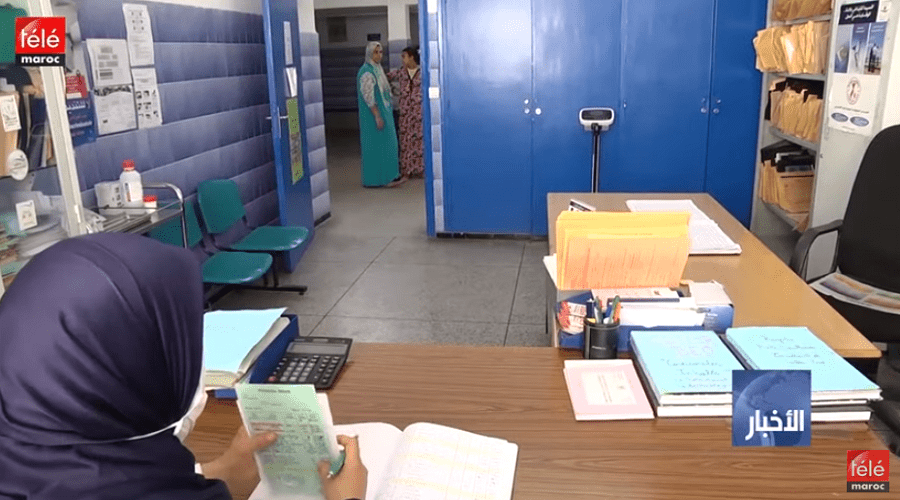
صحة: النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعلن انضمامها إلى تيار المحتجين على السياسات الحكومية

الحكومة تستعد لإلغاء جميع صناديق الاحتياط الاجتماعي وتعويضها بصندوق واحد

حشوات "سليكون" مسرطنة لتكبير الصدر تهدد صحة المغربيات

للبلد رب يحميه 2.2

نزار بركة يكتشف من تطوان تصدعات داخل البيت الإستقلالي

صدق أو لا تصدق... "البيجيدي" يتقدم بقانون لاعتقال سيارات المواطنين بـ "الصابو"

ما قدو فيل زادوه فيلة.. تخصيص 60 مليار سنويا لإخراج قناة البرلمان التلفزيونية

حجز أطنان من البطاطس الفاسدة في مصنع سري لإعداد "الفريت" نواحي المحمدية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 08 يوليوز
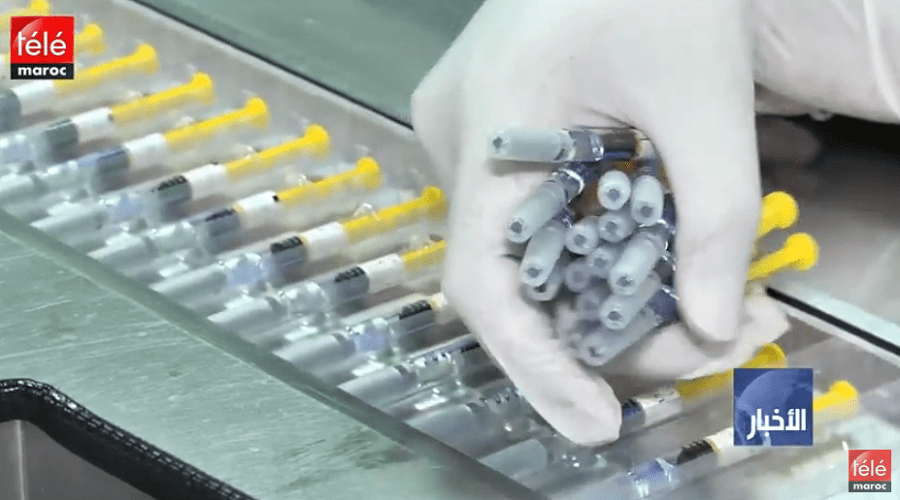
مهنيون يحذرون من المس بجودة الأدوية بسبب الخفض من أسعارها

بـ 23 ميدالية 10 منها ذهبية.. المنتخب المغربي يحرز لقب البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين

عبد المولى يرفض تسليم ملفات صفقات وتوظيفات مشبوهة للجنة الافتحاص

الشيخ بن زايد يغرد على تويتر معلنا تلقيه اتصالا من الملك محمد السادس

تفاصيل الإطاحة بموظفة متورطة في عمليات نصب بلغت 4 مليارات سنتيم

تفاصيل إحباط محاولة لتهريب أزيد من 27 طنا من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

اختطاف عصابة لمسؤول قضائي ومطالبته بفدية يستنفر أجهزة الأمن

هكذا ردت شميشة على إساءة مذيع "راديو مارس" للمرأة

للبلد رب يحميه 2.1

معسكر تدريبي مكثف للسفراء الجدد

أمن العرائش يفك لغز اختفاء فتاة ويكشف "مفاجأة"

مساندة "البيجيدي" للعماري لتقنين "الكيف" تخلق الجدل

قضاة جطو يفتحصون مصير 38 مليارا صرفت لدعم جمعيات الوزارات

قاضي التحقيق يحقق مع مدير الوكالة الحضرية لمراكش بمحكمة جرائم الاموال

فتح بحث قضائي في تدخل أمني نتج عنه وفاة شاب وفتاة بالدار البيضاء

تفاصيل اعتقال نصاب جنى مئات الملايين من عمليات نصب استهدفت شركات كبرى

هكذا تدخلت الداخلية لمحاورة متضررين من هدم الأسواق بتطوان

تفاصيل إدانة مستشارا من التقدم والاشتراكية بأربع سنوات حبسا نافذا

بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة.. العثور على مليار و200 مليون في بيت مدير الوكالة الحضرية بمراكش

زلزال يضرب أزقة سيدي سليمان والسبب امرأة

سياسيون وفنانون ورياضيون عبروا بـ"قشلات" التجنيد الإجباري

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 06 يوليوز

توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بمحاولة الاختطاف والاحتجاز المقرونة بالسرقة

أخنوش يترأس المجلس الإداري لـ "أونسا" ويطلع على حصيلة إنجازاته

توظيفات مشبوهة بوزارة لغراس تثير الغضب

اليعقوبي يشن حربا على محتلي الملك العام بالرباط

وزير يصطحب موظفة لم ترسم بعد إلى مؤتمر دولي لمدة أسبوعين

الحكم بسجن الفكاهي الساخر ديودوني سنتين بتهمة التهرب الضريبي

اتصلت بالبرنامج تعبر عن متمنياتها بهزيمة المنتخب والمذيع طلب منها البقاء في مطبخها وإدارته توقفه ثلاثة أيام

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 05 يوليوز

أوجار : استقلال القضاء ممارسة يومية تتكرس بالالتزام بالقانون

تونس تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

الخلفي: برمجة حصص إضافية لفائدة طلبة كليات الطب لتمكينهم من اجتياز الدورة الاستدراكية

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

تزوير رخصة بناء فندق مستثمر مقرب من "البيجيدي" تجر مسؤولين للتحقيق

آخر مكاين فالعمليات الجراحية فالمغرب... اعتقال ممرض متدرب بسبب عملية جراحية وهمية

الداخلية تستعد لإطلاق حركة انتقالية واسعة ورجال السلطة في حالة ترقب

إيداع مدير الأمن الجزائري السابق الحبس بتهم "فساد"

بالتنسيق مع الأمن الإسباني.. "البسيج" يطيح بشخص ينتمي لجماعة إرهابية

موظفو مجلس المستشارين يهددون بالتصعيد وأمينه العام خارج التغطية

تفاصيل الصراع داخل اللجنة البرلمانية المغربية- الأوروبية بسبب الرئاسة

هذا ما قام به يتيم للتغطية على فشل الحكومة في تدبير ملف "كنوبس"

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يقدم تقريرا حول أحداث الحسيمة

الرقم الأخضر يطيح بمدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بتسلم رشوة من مقاول

الحكومة تستعين بـ"الحصص الإضافية" لحل مشكل طلبة الطب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 04 يوليوز

بالصور.. انطلاق الشرطة الإدارية في الدار البيضاء وهذه اختصاصاتها
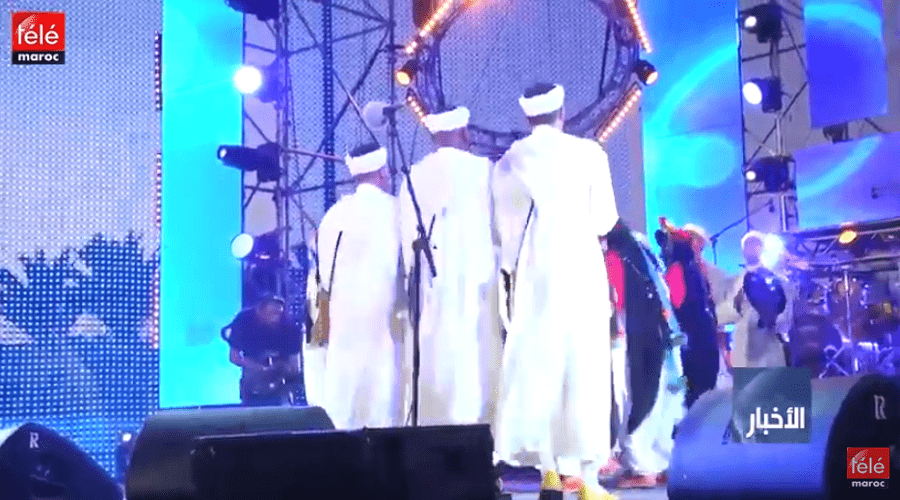
انطالق فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للموسيقى بأكادير "تيميتار، علامات وثقافة"

المغرب يحتل المرتبة ال66 عالميا في مؤشر الدول الأكثر جاذبية لسنة 2019

13 طبيبا شرعيا فقط في المغرب.. ووزير يقر بالخصاص

دفاع ضحايا "جريمة لاكريم" يطالب بأزيد من 100 مليار سنتيم كتعويض

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يقدم تقريره حول أحداث الحسيمة

ما بين 500 و800 عملية إجهاض سرية داخل عيادات وقانون "الإجهاض" يثير الجدل

رئيس تعاونيات سكنية يختفي بعد سطوه على الملايير

طبيب يحمل بندقية.. تصفية تشي غيفارا

محاكمة أشهر منفذ لعمليات الهروب من السجون تستنفر أمن الرباط
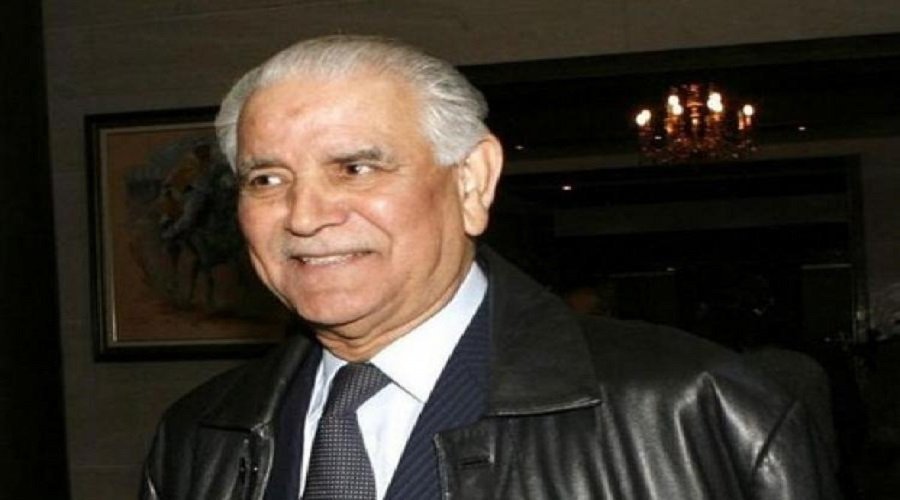
عرشان يعتزل الحياة السياسية ويحاول إنقاذ حزبه بالسلفيين

أوجار يشدد العقوبة على البيدوفيليين

حكومة العثماني تستبق غضبة ملكية بهذا القانون

هذه تفاصيل مدونة أخلاقيات الإدارة التي أفرج عنها لفتيت

أنباء عن وجود مغاربة ضمن ضحايا قصف مركز للهاجرين في ليبيا

الحجز على مدينة طبية بمراكش والتحقيق مع مسؤولين كبار

برلمانيون يتجاهلون التهديد بالاقتطاعات ويواصلون "السليت"

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 03 يوليوز

حضور مغربي في التشكيلة المثالية لدور المجموعات بكأس إفريقيا

76 منبرا إعلاميا ورقيا وإلكرونيا استفادت من دعم فاقت قيمته 73 مليون درهم

94 مليون دولار منحة أمريكية للمغرب

المغرب مهدد بفقدان 19 ألف وظيفة بحلول عام 2030 بسبب الاحتباس الحراري

13 قتيلا و 1832 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرىة
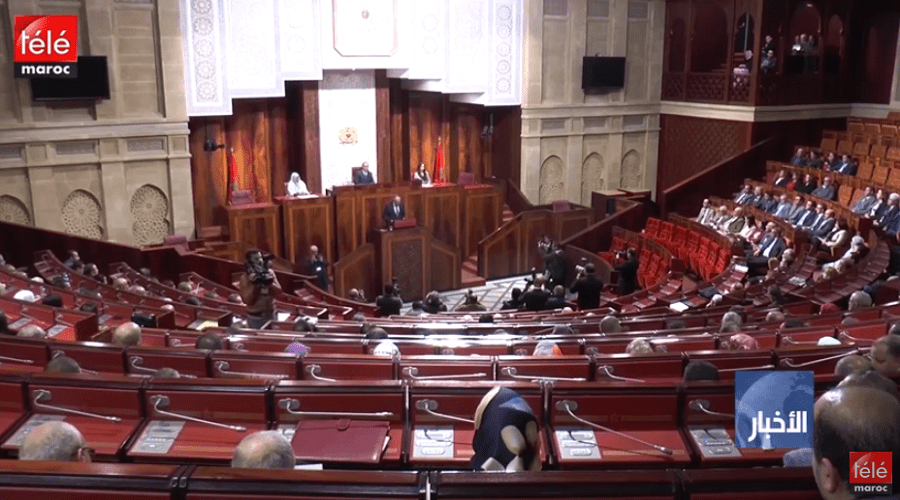
اختلاف فرق الأغلبية حول مضامين قانون قياس البصر يوقفه بالبرلمان
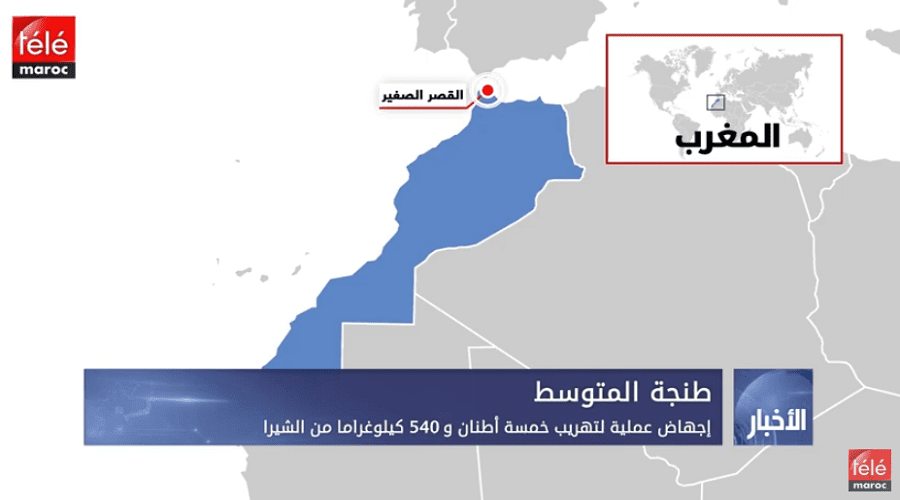
طنجة: إجهاض عملية لتهريب خمسة أطنان و540 كيلوغراما من الشيرا

إيداع نجل رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المالك سلال السجن

دراسة "غريبة" لوزارة الوظيفة العمومية تصنف الإدارة المغربية الأولى عالميا

الشرطة القضائية تدخل على خط اختلالات التعمير بجماعة الرباط

تحليل رياضي.. احذروا السناجب

رئيس جماعة يحول ثانوية إلى إسطبل لخيول "التبوريدة"

اتفاق مغربي برازيلي على تبادل "المجرمين"

هكذا ورط عبد المولى عبد المومني عامل أزيلال

بنكيران غاضب من الإدريسي بسبب مجلس حقوق الإنسان

هكذا يستفيد برلمانيون ومسؤولون من ريع "الكان"

اغتيال مالكوم إكس.. المسلمون يقتلون بعضهم في أمريكا

الأعرج يؤكد استفادة 76 منبرا إعلاميا من دعم فاقت قيمته 73 مليون درهم

مديرية الحموشي تكشف حقيقة "فيديو" الاعتداء على محل للملابس الرياضية

نمو الاقتصاد الوطني يتراجع من 3 ,5 إلى 2,8%

رئيس مجلس مدينة بنسليمان وابنه المستشار مهددان بالعزل لهذا السبب

إيقاف خليجي بمطار المسيرة بإنزكان بحوزته أكثر من 160 حبة مهلوسة

الداخلية تدخل على خط ملف "جوطية بن عباد" بالقنيطرة

لجنة مختلطة تحقق في الترامي على مئات الهكتارات بحوض أم الربيع

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 02 يوليوز

أساتذة التعليم الفني يحتجون ضد توقف رواتبهم لـ 7 أشهر ويهددون بالتصعيد

الوالي اليعقوبي يجر العمدة الصديقي إلى القضاء

المغرب "شريك رئيسي" في مجال الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي
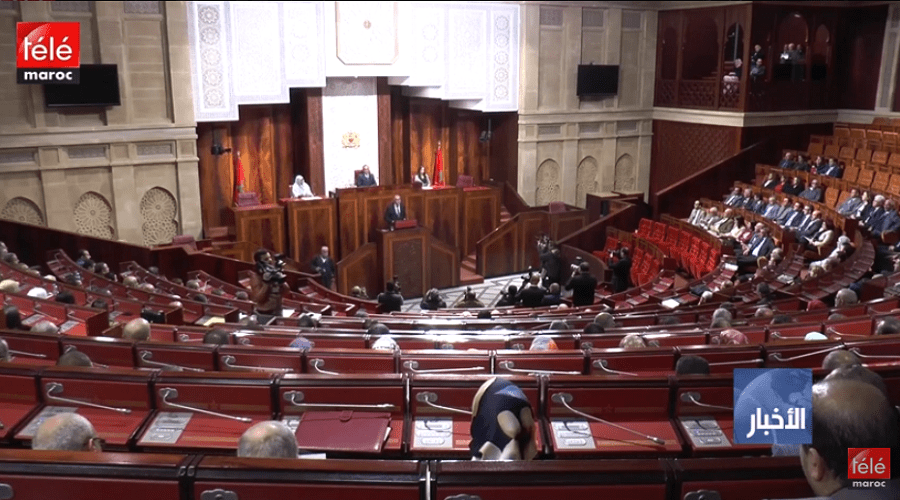
بنشعبون يكشف عن وجود مشاكل في أداء الديون بين المقاولات المغربية في القطاع الخاص

الداخلية تضع نظاما جديدا لتسجيل أسباب الوفاة وشهادتها

تفاصيل حركة انتقالية واسعة لـ2000 دركي همت كل المراكز الترابية بالمملكة

عملية سطو جديدة تستهدف وكالة بنكية بطنجة

فيديو لفقيه وتلامذته يشاهدون مباراة الأسود داخل "مسيد" يشعل مواقع التواصل

العثماني يعفو عن بنكيران ويسمح له بالظهور على الموقع الرسمي لـ "البيجيدي"

مساكن جديدة للولاة والعمال لتوفير مصاريف الكراء

شركة تنمية السعيدية تطلق مهرجان الصيف وتعلن تقديم خدمات عديدة

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يستعرض إنجازاته خلال السنة الماضية

وزارة الخارجية ووكالة المحافظة العقارية يوقعان اتفاقية هامة لمغاربة العالم

عبد المولى رئيس تعاضدية الموظفين يخسر دعاويه ضد "الأخبار"

10 سنوات سجنا لطالبة حاولت تهريب 30 ألفا من حبوب الهلوسة

نحن وموريتانيا.. زعماء موريتانيون عاشوا ودرسوا وتزوجوا في المغرب

عندما كان التلفزيون أثقل صناعة في المغرب.. كواليس التلفزيون خلال سنوات الرصاص

هكذا استفز العثماني طلبة الطب

تفاصيل توقيف سيارة تابعة للأمانة العامة لـ"البيجيدي" بدون تأمين

الأحرار يجمع 1300 من سائقي سيارات الأجرة بإنزغان لتدارس مشاكل القطاع

اندلاع حريق في خيام مهاجرين أفارقة بالبيضاء والسلطات تتدخل

حجز أدوية بيطرية بسوق أسلي بوجدة تباع بطريقة غير قانونية

أخنوش يستعرض استراتيجية الأحرار للخمس سنوات المقبلة أمام أزيد من 1000 مهندس وإطار بطنجة

شاهد مناورات أفراد وحدة خاصة للبحرية الملكية في عِرض البحر وعلى متن فرقاطة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 29 يونيو

الأمير مولاي الحسن يمثل الملك في حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2

لجنة مكافحة الإرهاب تدعم جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب
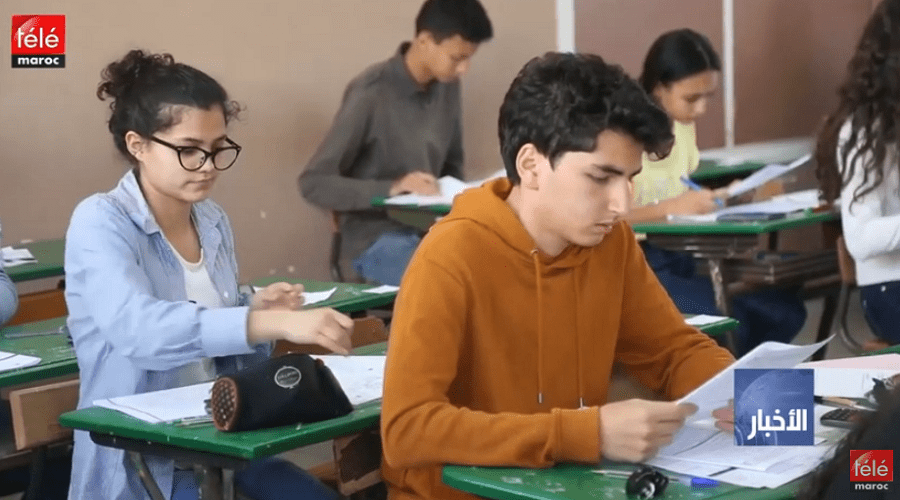
الحكومة تتخذ تدابير مالية استثنائية لمواجة نسبة النجاح المرتفعة في امتحانات الباكالوريا

بوشعيب المكاوي متقاعد في السبعين من عمره تمكن من التفوق في امتحانات الباكالوريا

توقيف شخصين قاما بتخريب 16 سيارة بالدار البيضاء

هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام الكوت ديفوار

315 ألف مغربي حصلوا على تأشيرة فرنسا سنة 2018

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 28 يونيو

الدار البيضاء والرباط أغلى مدن شمال إفريقيا في تكلفة المعيشة
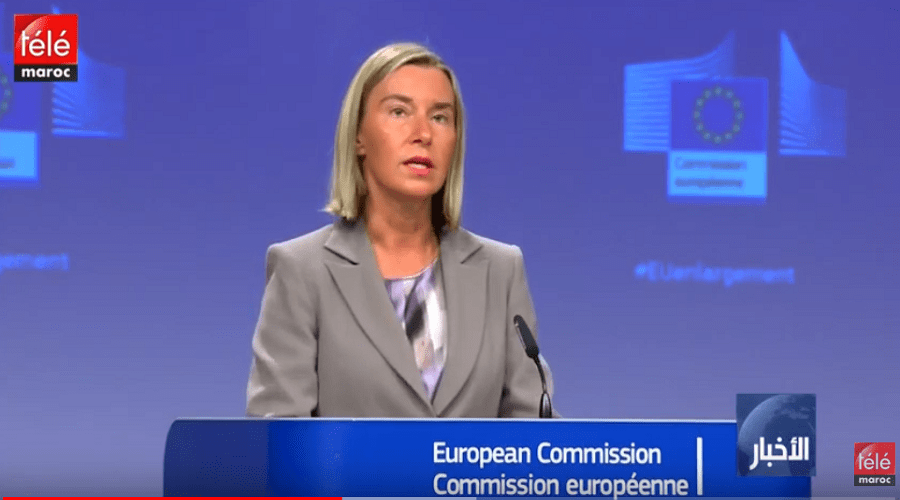
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتمدان لأول مرة خطابا موحدا حول قضية الصحراء

العثماني يقترض 48 مليار سنتيم لإدماج الشباب
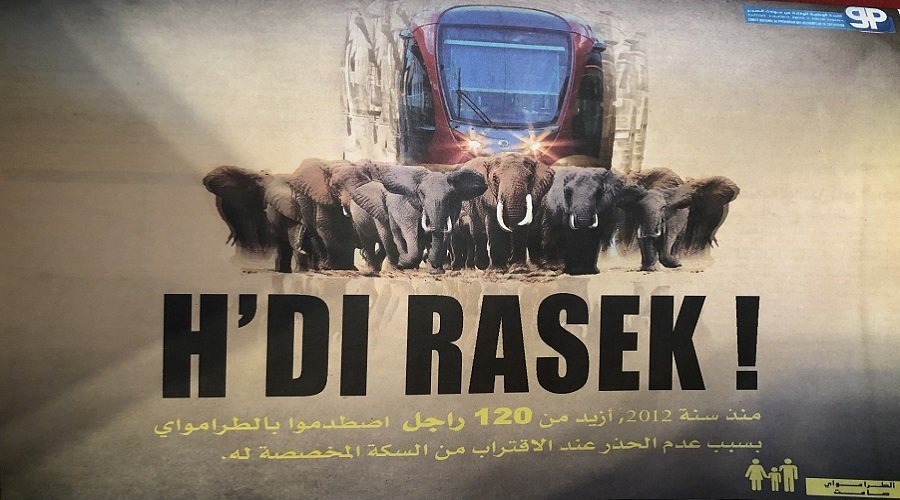
حضي راسك.. الإشهار الذي حول البيضاويين إلى قطيع أفيال

ترقب وسط جهاز الدرك لحركة انتقالية واسعة تشمل آلاف الدركيين

طعون في اقتراحات الصمدي

لهذا رفض القضاء إعادة تصحيح امتحان المحاماة

جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا تطالب العثماني بالإفراج على المنحة السنوية

العثماني يقترض 48 مليارا لإدماج الشباب

الملك يعبر عن استنكاره وإدانته للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت تونس

"البسيج" يرصد مخبأين تابعين للخلية الإرهابية الموالية لداعش بالحوز

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 27 يونيو

ولي العهد يترأس حفل تخرج الفوج ال19 للسلك العالي للدفاع والفوج ال53 لسلك الأركان
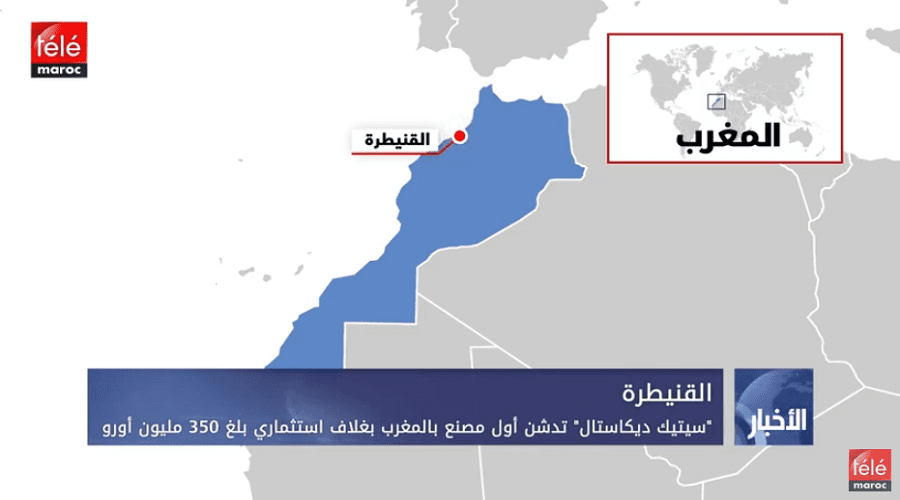
القنيطرة: "سيتيك ديكاستال" تدشن أول مصنع بالمغرب بغلاف استثماري بلغ 350 مليون أورو

بنشعبون يصدر تعليمات جديدة لاحترام آجال الأداء

أعطاب تهدد بـ"إفلاس" منتجع سيدي حرازم

هكذا فشلت الحكومة في مفاوضات شراء حقوق البث وحرمت المغاربة من متابعة "الكان"

دكاترة وزارة التربية والتكوين يدخلون في اعتصام ويدعون لمسيرة وطنية

كودار يطلب المصالحة

أزمة واستقالات داخل اتحاد "الباطرونا"

عمالة سلا تشرع في "تشميع" مقاهي الشيشة

إطلاق عملية تمليك نموذجية ل76 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة بالغرب والحوز

موظفو البرلمان يخرجون للاحتجاج بسبب "البريمات"

ولي العهد يترأس حفل تخرج الفوج الـ19 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ53 لسلك الأركان

عارضة أزياء تطيح بنجم المنتخب المصري من "الكان" بسبب التحرش

استئنافية البيضاء تصدر حكمها الأخير في حق عصابة "بائعي لحوم الكلاب"

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 26 يونيو

أمن طنجة يوقف عناصر شبكة إجرامية متورطة في سرقة أزيد من 3 ملايين درهم

أخنوش يشرف على انطلاق عملية تجريبية لتمليك 67 ألف هكتار بالغرب والحوز من الأراضي السلالية ل31 ألف من ذوي الحقوق
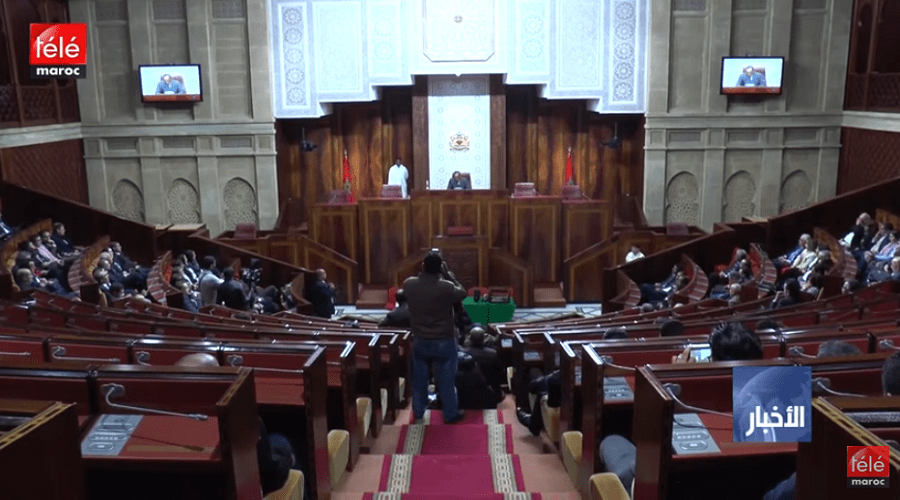
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون المسطرة الجنائية

ترقيم أزيد من أربعة ملايين ونصف مليون رأس من الأغنام والماعز بحلقة عيد الأضحى
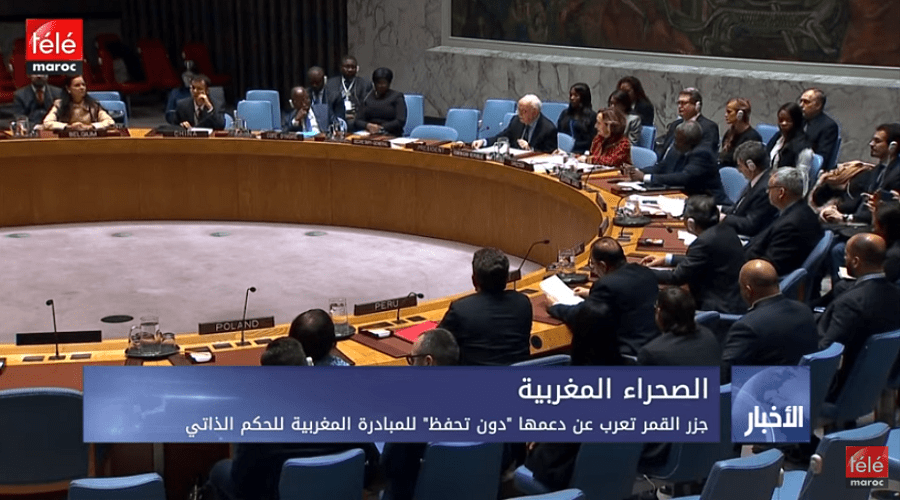
جزر القمر تعرب عن دعمها "دون تحفظ" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الملك يعين عددا من السفراء الجدد و يستقبل عددا من السفراء الأجانب بعد انتهاء مهامهم
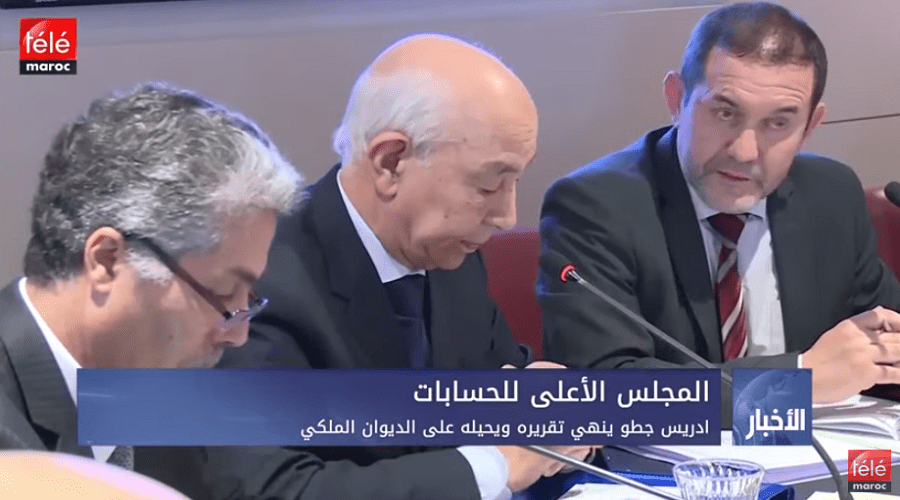
ادريس جطو ينهي تقريره ويحيله على الديوان الملكي

عمال الأمتعة يهددون بشل مطار محمد الخامس في أيام الصيف

قروض الحكومة تتجاوز ألف مليار درهم.. هكذا أغرق بنكيران والعثماني البلاد في الديون

الخارجية الأمريكية ترصد عدد الأقليات الدينية في المغرب وعدد المسيحيين يبلغ 6 آلاف

أكثر من 12 ألف منصب شغل ينتظر الإعلان عنه

تلميذ من جمهورية الكونكو يرفع التحدي ويحصل على البكالوريا بميزة مشرفة

جطو ينهي تقريره ويحيله على الديوان الملكي

الشركة الحلوفة

مستشار بآسفي يشتري فيلا بـ240 مليونا ويضمن لابنه الجنسية الأمريكية

القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر"

تسمم جماعي لـ 44 تلميذا في حفلة نهاية السنة الدراسية

"أونسا" يرقم أزيد من 4 ملايين ونصف مليون رأس من الأغنام والماعز بحلقة "العيد"

تاطولانطيت

98 في المئة من مياه شواطئ المغرب مطابقة لمعايير الاستحمام

بكالوريا 2019: 181 نزيلا نالوا شهادة البكالوريا بمختلف المؤسسات السجنية

المصادقة على قانون الشراكة في الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي

العثماني يعد بتنفيذ ورش الإصلاح الجهوي والقضاء على المركزية

تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة متشددين موالين ل"داعش" ينشطون بمنطقة الحوز

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يطالب باعتقال سيارات المواطنين بـ"الصابو"

أطباء العيون يقصفون النظاراتيين ويحذرون من "الفحص البصري المجاني"

هكذا يحرق الدكالي 40 مليار سنتيم سنويا

المغرب يعلن مشاركته في مؤتمر المنامة بإطار في المالية مع التشبث بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 4 "دواعش" بمنطقة الحوز

منتدى صندوق الإيداع والتدبير يناقش التقاعد

مجلس النواب يصادق على قانون الشراكة في الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي

181 نزيلا نالوا شهادة البكالوريا بمختلف المؤسسات السجنية

مديرية الحموشي تتفاعل مع منشور في "فايسبوك" حول الأمن بالدار البيضاء

المحافظة العقارية تؤكد ريادتها في جودة الخدمات

مطالب بالقيام بعملية افتحاص شامل للمنظومة الدوائية في المغرب

الحكومة ترفض قانون التعليم وتقترض 500 مليار سنتيم لتنزيله
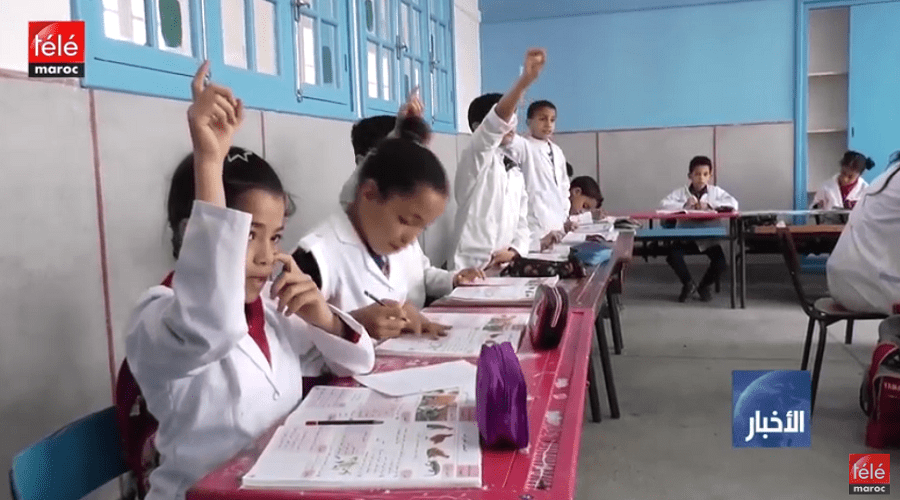
كتبيون وموزعون يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تغيير المناهج التعليمية

المغرب حاضر في "قمة الضفتين، منتدى المتوسط " بمارسيليا

إطلاق نار على مصلين بمسجد بمدينة سبتة والشرطة الإسبانية تحقق

لهذا تم احتجاز بادو الزاكي من طرف الشرطة الإسبانية بمطار مدريد

التحقيق مع نجل دبلوماسي خليجي بتهمة قتل مغربي بمراكش

تخصص تخراج العينين

الجامعة الوطنية لعمال الطاقة على صفيح ساخن

الصويرة: تزاوج روحاني بين حميد القصري وسوشيلا رامان في ختام فعاليات الدورة 22

"البيجيدي" يضع لائحة سوداء للصحافة

الحكومة ترفض قانون التعليم وتقترض 500 مليار لتنزيله

يتيم يهدد 250 مفتش شغل بالتنقيل

نسبة النجاح 65 % وأعلى معدل 19.40 .. هذه تفاصيل نتائج الباكالوريا

لقجع يؤكد أمام وزراء المالية العرب التزام الملك محمد السادس بتحسين ظروف عيش الفلسطينيين

محامي الشيطان
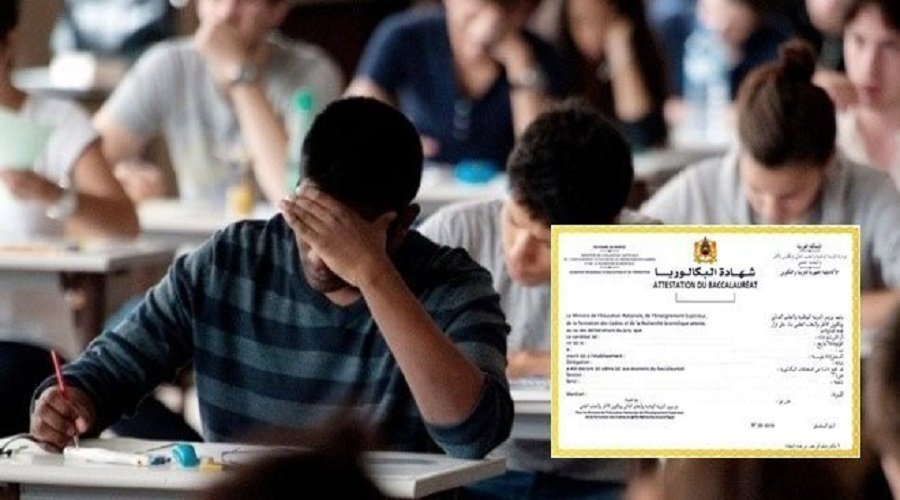
الإعلان عن نتائج امتحان "الباك" وهذه طريقة الاطلاع على النتائج

بمشاركة 15 دولة.. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجتمع بالصخيرات

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 22 يونيو

منتدى الصويرة لحقوق الإنسان يناقش قوة الثقافة لمواجهة ثقافة العنف

البنك الدولي يدعم تطوير التعليم الأولي بالمغرب بمليارات الدراهم

ما سر دفاع مضيان عن معاشات البرلمانيين؟

"البيجيدي" يستغل رسالة الإكوادور لتصفية الحساب مع بنشماش

اليد الخفية

هكذا أطاح أمزازي برئيس جامعة ابن زهر

احتقان غير مسبوق داخل مديرية الأدوية بوزارة الصحة

الصويرة: افتتاح الدورة ال22 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم

ها الضحك الباسل كيفاش كايسالي... اعتقال الشخصين اللذين اعترضا قطار بتهمة المس بسلامة الراكبين

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 21 يونيو

متحف بنك المغرب يفتتح معرضه بمرآة جماعية بتشكيلة مختلفة

الملك يترأس حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة "بي سي أ" بالمغرب

الدار اليبضاء: توقيف أربعة أشخاص لإلحاقهم أضرار مادية بحافلة للنقل الحضري وتعريض ركابها للتهديد

سائقون يدقون ناقوس الخطر بشأن جسر حديدي معلق بين الصخيرات وبوزنيقة

وزارة التعليم تعلن عن نتائج امتحانات الباكالوريا قبل موعدها

الفرقة الوطنية تستدعي مستخدمين بتعاضدية الموظفين للتحقيق في اختلاس الملايير

اليد الخفية

بالفيديو.. أمن البيضاء يطيح بالمنحرفين الذين روعوا ركاب حافلة للنقل الحضري

بعد النعناع.. ONSSA يشن حربا على المجازر العشوائية

السجن النافذ في حق أبطال فيديو الاستحمام في حافلة عمومية

إقبال ضعيف للمغاربة على القروض الحلال

تفاصيل إطاحة العلمي بـ21 مسؤولا بوزارته

هكذا أطلق "البيجيدي" يده على مجلس عزيمان

تفاصيل ترؤس الملك حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة "بي إس أ" بالمغرب

اللجنة المنظمة تعتذر عن بتر الصحراء المغربية في أغنية " الكان"

الحكومة ترد على محاولات الإنتقاص من الوحدة الترابية للمملكة

مجلس المدينة يصرف مليار سنتيم للوداد والرجاء

الحكومة توسع اختصاصات الإدارات المركزية التابعة للحموشي

مطالب باستدعاء الرميد في قضية شمهروش

شركة بريطانية تستثمر 200 مليار في بنك بنجلون

مهنيو "ميدي 1 تي في" يتهمون الإدارة بالإجهاز على المكتسبات وينضمون وقفة احتجاجية

حقائق مخيفة حول خلية تطوان

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 20 يونيو

انتعاش في السوق السوداء بعد اختفاء أدوية حساسة من الصيدليات

الحشرة القرمزية التي تضرب الصبار تستنفر الداخلية ومصالح "أونسا"

أمزازي: الرفع من القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية

تعطل كاميرات مراقبة كلفت مجلس مراكش 4 ملايير ونصف

باينة للعمى
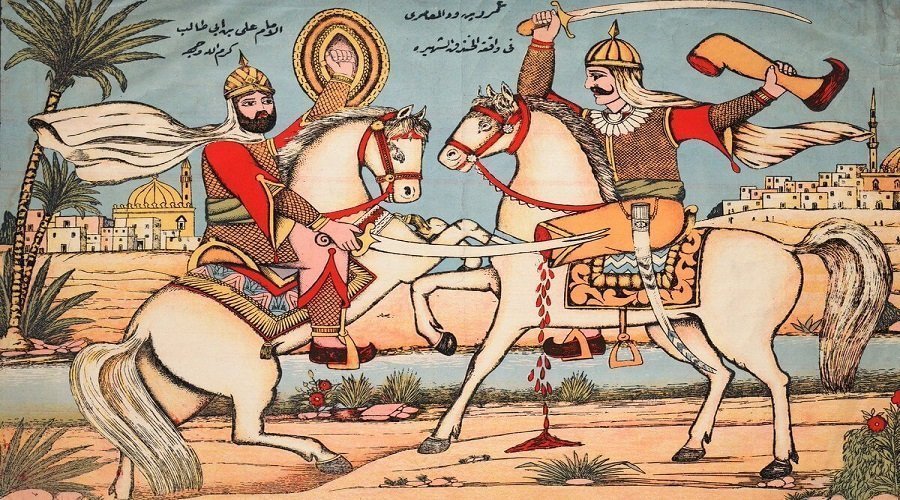
دولة الخلافة على وقع الاغتيالات.. مقتل علي بن أبي طالب

أخنوش يحيل ملفات تلوث "النعناع" بالمبيدات على القضاء

التحقيق مع إسباني متهم بالنصب وهتك عرض قاصر بطنجة

4 ملايير تقرب الحموتي من القضاء

برلمانيون في ضيافة مديرية الضرائب

إحالة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي إلى المحاكمة بتهم "فساد"

الصندوق العربي للإنماء يمول إنشاء مشاريع في الصحراء والجهة الشرقية

الأسر المغربية تتحمل أعباء تمويل الصحة

تعويضات الامتحانات تفجر الغضب ضد أمزازي

اختفاء أدوية حساسة من الصيدليات وسط صمت الوزارة

البرلمان يقبر قانون إصلاح التعليم

خمسة قتلى في حادثة سير خطيرة ببنسليمان

نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب يتم جلبها بشكل غير قانوني

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 19 يونيو

مديونية شركة الطرق السيارة تصل إلى 39 مليار درهم في 2018

الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة

رئيس الحكومة: المغرب سيعتمد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أمزازي يمنح طلبة الطب نهاية الدورة الاستدراكية لإنقاذ السنة أو الترسيب والفصل

لجان سياحية

هكذا تستر الأزمي على جرائم شباط بفاس

مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في حادث بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين

إصابة دركي و13 شخصا في مواجهات دامية بين رعاة صحراويين وقبائل عبدة

تثبيت 552 "رادار" بجميع جهات المملكة لمراقبة مخالفات قانون السير

وزارة الثقافة تعلن عن هيئة لضبط قطاع الاشهار

1442 مسجدا مغلقا ينتظر الفتح من جديد

عمر هلال: لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب ووحدته الترابية

استئناف محاكمة حامي الدين على وقع الاحتجاجات

المالية تحقق في ملايير صفقات الدراسات

الكيبيك تصدم المغاربة بإلغاء 18 ألف طلب هجرة

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 18 يونيو

كيبيك: آلاف المغاربة مهددون برفض طلبات الهجرة بسبب مشروع قانون جديد

التوفيق: الزيادة في حصة المؤطرين المغاربة لتبلغ 800 مؤطرا

ألمانيا تجهز الشوارع المغربية ب500 جهاز رادار متطور

تفكيك خلية إرهابية بتطوان تتكون من خمسة أفراد للاشتباه في صلتهم ب"داعش"

شركة مايلان الأمريكية المتخصصة في الأدوية الجنيسة تؤسس أول وحداتها الصناعية بالمغرب

شريط صوتي يجر قيادية بنقابة "البيجيدي" إلى القضاء

تفاصيل اختطاف مهندس دولة وتعذيبه من طرف عصابة "اولاد الفشوش"

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 5 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

"تعاطي" سياسي

الحقاوي تطيح بثمانية مسؤولين بوزارتها

بنعزوز يلجأ إلى "دارت" للنجاة

سفارات بلدان الشمال الأوروبي بالمغرب تنخرط في في حملة نظافة بشاطئ الوداية

"النوار" في العقار يستنفر حكومة العثماني

الأساتذة يعودون للاحتجاجات الصيفية

حتى لا يتكرر سيناريو 1991

استقالة مهندس رفض المصادقة على مشاريع كلفت 16 مليارا بآسفي

اتهامات لوزارة الصحة بالرضوخ لضغوطات لوبيات الأدوية بعد رفع أسعار 40 دواء

الصحة العمومية بالمغرب.. من المجد والمجانية إلى الحضيض

نخب البرلمان.. أميون وأشباح ومطلوبون للعدالة

انفجار قنينة غاز يتسبب في إصابة 12 شخصا ببرشيد

هكذا حول عامل آسفي 12 مليونا من المال العام لـ "مصروف جيب"

غش الأكابر.. وزراء وبرلمانيون وسياسيون ورياضيون يتهافتون على الريع العلمي

وزارة العدل تتفاعل مع محاولة عبد المومني توريطها في خرق القانون

"الباك" يسقط 150 شخصا

الصمدي يغرق الجامعات بشهادات باريس

"البيجيدي" يطبق سياسة "كُوي وبخ" في قضية طلبة الطب

إسبانيا تسلم المغرب متهما في أحداث مدريد الإرهابية

مقترح قانون يحاصر اختصاصات جطو

تسعة أئمة ضمن خلية شمهروش

المغرب ضيف شرف معرض القنص "غيم فير 2019" بفرنسا

"أورانج" تورط الأولى ودوزيم وميدي1 تي في بسبب الإرهاب

أمن طنجة يوقف المتورط في جريمة الاعتداء على مواطنة ألمانية

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 15 يونيو

الأميرة لالة حسناء تترأس افتتاح الدورة ل25 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

وزارة الوظيفة العمومية تفرج عن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي

حرب النسا تندلع بين نساء البيجيدي... وزيرة تتهم ماء العينين بـذات الوجهين والأخيرة تعتبر ذلك تشفيا رخيصا

لارام توفر رحلات لمصر لحضور ال"كان" ابتداء من 3000 درهم

الإعلان عن نتائج اختبارات الباكالوريا برسم دورة 2019 يوم 26 يونيو الجاري

هذا موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا

فتح تحقيق في اعتداء بالسلاح الأبيض على سائحة ألمانية بطنجة

الزيادة في أجور مليون موظف مدني وعسكري تكلف 1450 مليار سنتيم

قلب رباح "مغرم" بكندا

السكال ينافس الصديقي على السفريات الفخمة من المال العام

رباح يبحث عن الخبراء بـ8 ملايين

تفاصيل توقيف 5 بريطانيين بتهمة تزوير عملات أجنبية بمراكش

المغرب ضيف شرف "Game Fair" أكبر معرض للقنص في فرنسا

الحكومة تخصص 190 مليون درهم لطي ملف "الزنزانة تسعة"

الحكومة تصادق على الزيادة في الأجور وتحدد الحد الأدنى في 3300 درهما شهريا

الاحتفالات بعيد العرش ستتم وفق العادات والتقاليد الجاري بها العمل

أمزازي يتجاهل الاحتجاجات ويحدد تواريخ امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة

هذه تعليمات "القصر" حول الاحتفال بالذكرى الـ20 لتربع الملك على العرش

مجلس آسفي يقتلع 442 شجرة أوكاليبتوس ويبيعها بـ20 مليونا

"أونسا" يحجز ويتلف 3 أطنان من فضلات الدجاج كانت موجهة لتسمين الماشية

العدالة والتنمية ينقلب على موقفه بخصوص تقنين الإجهاض

أسباب إعفاء شرفات تعود للواجهة

مطالب يهودية بافتحاص تركة سيرج بيرديغو

هكذا ورط عبد المولى القضاء في خرق القانون

تفاصيل إيقاف مستشارين جماعيين بتهمة النصب والاحتيال

الدار البيضاء تحتضن النسخة الخامسة من المعرض السنوي المتخصص في مجال البودكاست

أزيد من ستة آلاف مترشح يجتازون اختبارات البكالوريا بعمالة عين الشق وسط مراقبة صارمة

الزيادة في ثمن "البنج" تدفع أطباء الأسنان بالقطاع الحر للاحتجاج ضد وزارة الصحة

مديرية التعليم بمكناس توضح حقيقة النصاب الذي جرد تلاميذ الباكالوريا من هواتفهم

وزير الداخلية يتسلم استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون

الخلفي يهدد طلبة الطب بالرسوب والطرد ويتهم "العدل والإحسان" بممارسة التحريض

انتخاب يونس مجاهد رئيسا للفدرالية الدولية للصحافيين

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 13 يونيو

مجلس التعليم يرصد هشاشة مستوى التعليم لدى الأسر

الأكياس البلاستيكية تورط شركات كبرى

20 في المائة من التلاميذ انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة

اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لشركة "إنوي"

بن عبد القادر يؤكد عدم وجود علاقة بين اضطرابات النوم وزيادة ساعة إضافية
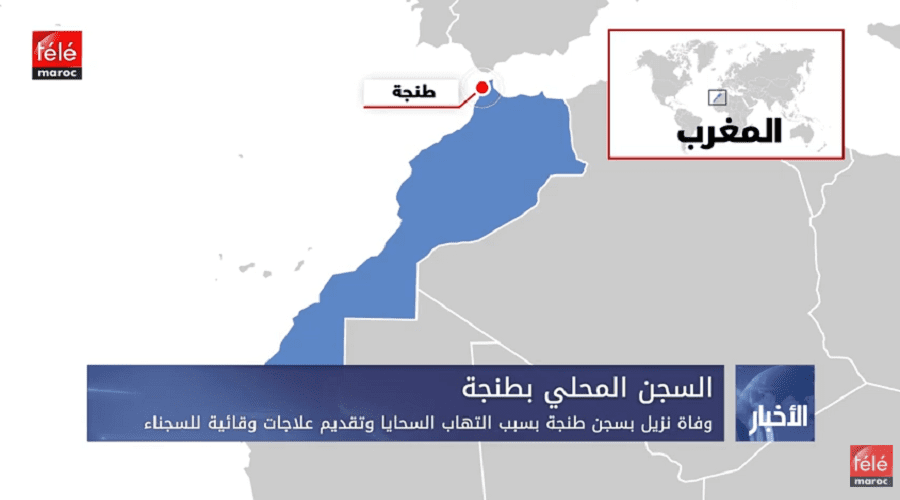
وفاة نزيل بسجن طنجة بسبب التهاب السحايا وتقديم علاجات وقائية للسجناء

وزارة الصحة تقرر الرفع من ثمن 14 دواء والزيادات تصل إلى 150 درهما

توقيف مواطن هولندي للاشتباه في تورطه في قضية تزوير جوازات سفر أجنبية

خاص.. هذه نتائج دراسة "الساعة الإضافية" وتأثيراتها على صحة المغاربة والاقتصاد

استئناف محاكمة المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بـ إمليل

اختفاء إمام ومرشد بهولندا بعد انتهاء مهمة بعثة الأئمة المغاربة في رمضان

نصاب ينتحل صفة "مسؤول" ويجرد مرشحين للباكالوريا من هواتفهم

شركات تتحرك في كواليس البرلمان

هكذا تدخل الحموشي لملاحقة المجرمين بالقنيطرة

تفاصيل اعتقال هولندي متهم بتزوير جوازات سفر أجنبية بمراكش

أزيد من 25 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية في 2018

اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لشركة "إنوي"

التعاون في مجال الصيد البحري في صلب مباحثات أخنوش مع نظيره الإسباني

أمزازي يوقف 3 أساتذة جامعيين لتضامنهم مع طلبة الطب المحتجين

الحكومة تلجئ لجيوب المغاربة لفرض التغطية الصحية على الوالدين

تهريب 260 مليارا في عمليات استيراد مشبوهة

ابتدائية مراكش تصدر أحكامها في حق شبكة الاجهاض

عطور سامة تهدد رئات المغاربة

فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة يضع ثقته في القضاء المغربي لإنصاف ضحايا بوعشرين

مصر.. السجن المؤبد لـ 32 متهما بمحاولة اغتيال السيسي

المنظومة الصحية في حاجة لإعادة التأهيل والمغرب يعاني نقصا حادا في الأطر الطبية

ربط مطار العيون ب38 رحلة جوية أسبوعيا 53 محلية و3 جوية

وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك: اتخاذ عدد من القرارات التي تهم قطاع النقل

بنعبد القادر: لاتوجد أي علاقة بين اضطرابات النوم وزيادة ساعة إضافية

أونسا تدعو إلى اليقظة وتعزز المراقبة لتجنب دخول بكتيريا تصيب النباتات

جهاز قياس نسبة الكحول يطيح بضابط أمن تسبب في حادثة سير

تفاصيل إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي بالناظور
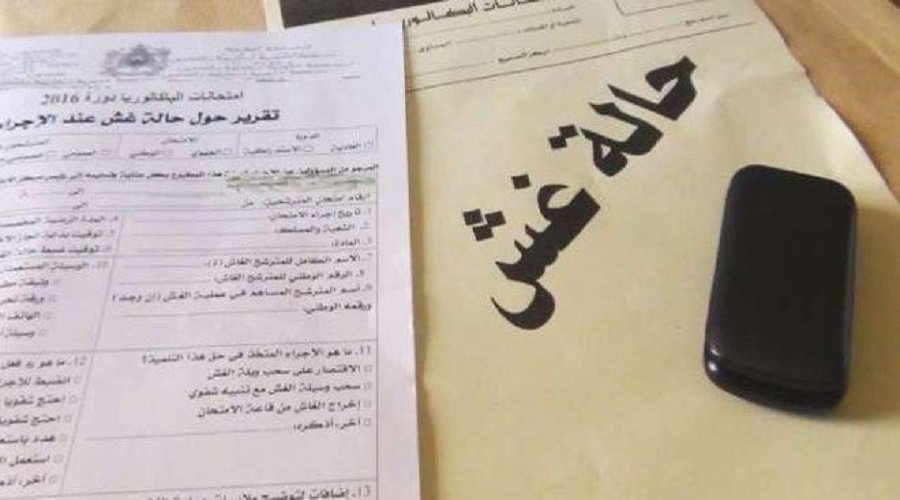
بعد البرلماني قشبيل.. ضبط مستشار جماعي متلبسا بالغش في امتحان "الباك"

صور ومحادثات جنسية تورط قياديا بـ"البيجيدي"

هجوم على مطار "أبها" السعودي ووقوع ضحايا

زيادة عشوائية في أسعار سيارات الأجرة الكبيرة تثير غضب البيضاويين

باشا سلا يتساءل عن اختفاء 140 مليونا خصصت للتشجير

تفاصيل إعفاء الرباح لـ 22 مسؤولا بوزارته

مراكش...المغرب يتوج عن جهوده في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم

779 نزيلا بسجون المملكة يجتازون امتحان "الباك"

التحقيق مع بطل "ماستر شيف" بتهمة النصب

وسطاء التأمين يحتجون بإضراب وطني

طلبة الطب يتهمون الحكومة بعسكرة الكليات

التوفيق يوقف إماما ربط الحاجب ومارتيل بالدعارة

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 11 يونيو

المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة

وزير الشؤون العامة والحكامة: التقلبات في أسعار النفط هي التي جعلت الحكومة تؤخر تسقيف المحروقات

200 ألف شخص سيستفيدون من التغطية الصحية للوالدين ولن تتقدم الصحة دون تضامن

أزيد من 400 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات الباكالوريا

محاكمة أربعيني يستغل أزيد من 100 فتاة في الدعارة الراقية بمراكش

عاجل... وزارة التربية الوطنية تمنع برلماني "البيجيدي" من الترشح لامتحانات الباك سنتين
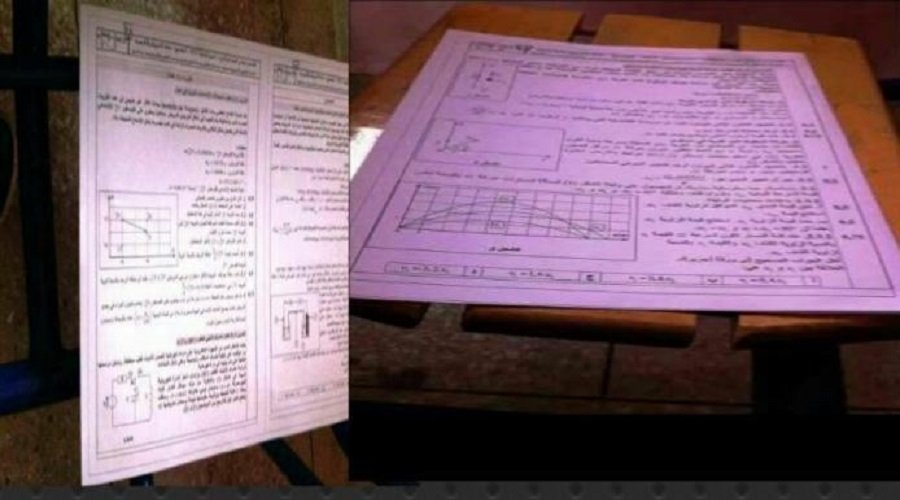
تسريبات الباك

تفاصيل احتجاز مهاجر مغربي ثري رفقة زوجته وتعذيبهما من أجل السرقة

تطورات مثيرة في قضية البرلماني "الغشاش" والنيابة العامة تدخل على الخط

شكوك قد تلغي مباراة التوظيف بمجلس المستشارين

الوزراء يتوصلون بأكثر من 800 "بون" لأداء الحج

المبصاريون يعودون للاحتجاج ضد أطباء العيون

بعد أزمات العطش..الحكومة تفرج عن المجلس الأعلى للماء
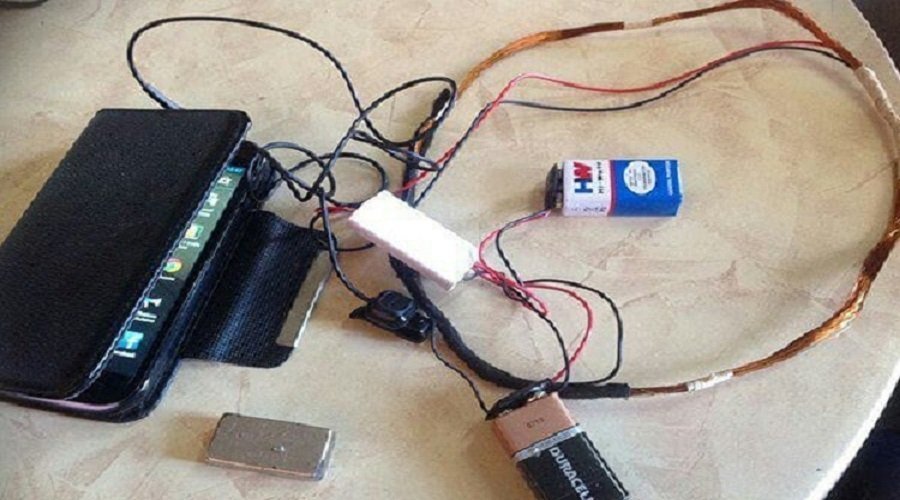
شبكة تمرير الأجوبة حصيلة الحرب على الغش في البكالوريا

تفكيك شبكة للإتجار في البشر والمخدرات

زيادات مهمة في تعويضات الشيوخ والمقدمين

الداخلية تكشف عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية وتحدد موعد تشكيل الفوج الأول

برلمانية تدافع عن البرلماني "الغشاش" وتصف منتقديه بـ "الكلاب المسعورة"

اجتماع حاسم لتحديد موعد مباراة الوداد والترجي

هكذا رخص الدكالي لشركة أمريكية "شبح" للمشاركة في صفقة ضخمة

الحكومة تعتزم إطلاق دعم للفقراء وحذف الإعفاء ات الضريبية الموجهة للعقار

طنجة: توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات

صحة: إضراب جديد للممرضين وتقني الصحة

عريضة تطالب بإعفاء معاشات متعاقدي المغرب من ضريبة الدخل

وزارتا الصحة والتعليم تقدمان مقترحها لطلبة الطب وتدعوان لعدم عرقلة سير الامتحانات

برقية تهنئة من الملك إلى عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الجلوس الملكي

طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات

اختلالات مالية وإدارية وبيع الممتلكات.. هكذا فشل "البيجيدي" في تسيير المدن

تفاصيل إيقاف عشرات المتهمين بالغش في امتحان الباكلوريا

هكذا يتساهل عامل سلا مع "الشيشة"
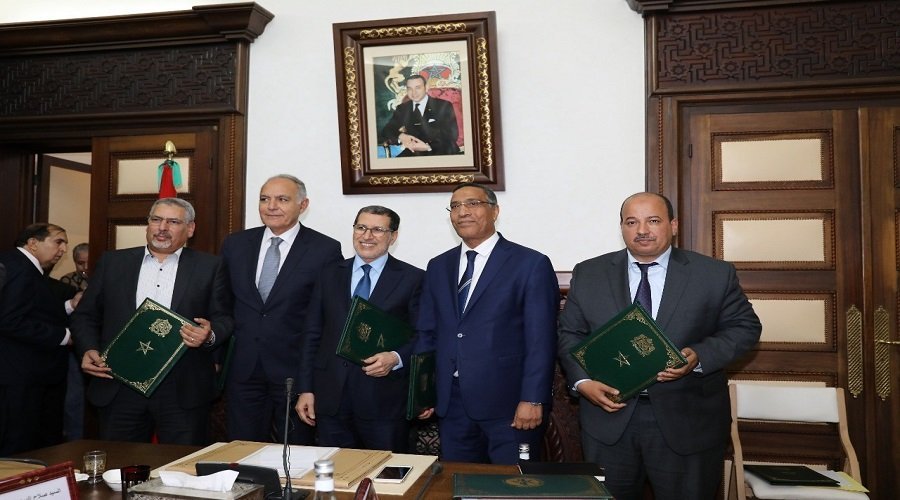
لهذا تأخر تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور

حقيبة تحل لغز مافيا طانطان

تنسيق أمني يسقط إرهابيا مغربيا-اسبانيا

رسميا ..تيفيناغ على النقود و"الباسبورات"

المغرب يتوج بميداليتين ذهبيتين و5 جوائز في معرض دولي للاختراعات

المغاربة ثاني شعوب العالم حصولا على تأشيرة فرنسا

العدالة والتنمية يحقق مع برلماني ضبط في حالة غش أثناء اجتيازه امتحان "الباك"

ضبط برلماني عن "البيجيدي" في حالة غش في امتحانات الباك وإحالته على الشرطة

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في اقتراف سرقة وكالة تجارية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 08 يونيو

عودة المغرب إلى التوقيت الصيفي في ظل جدل وسط المواطنين والمؤسسات التشريعية

عبد الإله بنكيران مطلوب للمثول أمام القضاء الفرنسي لهذا السبب

تحقيقات في حساب فريق "البام"

الداخلية تُحدث 31 جماعة جديدة بهذه العمالات

الدكالي وأمزازي يحددان الاثنين المقبل موعدا لإجراء امتحانات كليات الطب

الحكومة تعيد "الساعة" ابتداء من هذا التاريخ

تفاصيل توقيف شخص سرق وكالة بنكية باستخدام غاز مسيل للدموع

إتلاف حقول النعناع الملوث بمبيدات غير مرخصة

هذه هي المنتجات الحيوانية التي ستبيعها مندوبية السجون

تفاصيل تفكيك عصابة متخصصة في ترويج أموال مزيفة من فئة 200 درهم

مجلس المستشارين ينتصر لأطباء العيون ونقابتهم تعلق مسطرتها الاحتجاجية

أجواء روحانية في مسجد الحسن الثاني في أول أيام عيد الفطر

الإحتفاظ بشرطية تحت تدابير الحراسة النظرية بالرباط لهذا السبب

عفو ملكي يشمل مدانين في أحداث الريف وجرادة والإرهاب

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء

غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر بالمغرب

مساع لحل أزمة كليات الطب

رسوم جامعية تجر أمزازي للمسائلة البرلمانية

التحقيق في المتاجرة بالدقيق المدعم

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 04 يونيو

الحكومة توافق على إعتماد حرف تيفيناغ رغم معارضة البيجيدي

بنعبد القادر ينتقد ظاهرة تغيب الموظفين ويتوعد بإجراء ات عقابية

إضراب عمال خدمات الأمتعة يشل مطار محمد الخامس

قتلى وعشرات الجرحى في حادث انقلاب حافلة شمال أكادير

أطباء العيون يحتجون ضد وزارة الصحة بعد تمرير صلاحياتهم للنظاراتيين

شاشة تفاعلية: المغاربة ضمن الشعوب الأكثر غضبا وتوترا في العالم

عطلة استثنائية للموظفين بمناسبة عيد الفطر

هجرة الأدمغة تستهدف وزارة الداخلية

النظام الأساسي لموظفي الامن ..تفاصيل جديدة

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 03 يونيو

أطباء العيون يخوضون إضرابا وطنيا

جنايات مراكش تستدعي متهمين في ملف كازينو السعيدي

الفايسبوك يستنفر اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية

اختفاء 253 قاصرا مغربيا باسبانيا

الحموشي يوقف مسؤولا أمنيا اعتدى على مهاجر سري بباب سبتة

تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بإسبانيا بعد اختفاء 253 قاصرا مغربيا

المغرب الثالث مغاربيا والعاشر عربيا في مؤشر الطفولة العالمي

الحكومة تفوت 8 في المائة من حصتها في اتصالات المغرب

"الترمواي" يدهس مسنا بعد صلاة التراويح بالقرب من محطة المسافرين

مديرية الأمن تزوّد شرطة المرور برادارات فائقة الدقة لزجر القيادة السريعة

مصدر مقرب من "الكاف" يؤكد إعادة مباراة نهائي أبطال إفريقيا في "بلد محايد"

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش" بكل من الراشدية وتنغير

الداخلية تحدد موعد الانتخابات الجزئية بمجلس المستشارين

هكذا أطاح الفاسي بـ37 مسؤولا بوزارته

صينيون على لائحة الممنوعين من دخول المغرب

الخدمة العسكرية ..اللمسات الأخيرة

غرفة خاصة لرصد اختلالات التعليم بمجلس جطو

التعذيب يلاحق ثمانية دركيين

هكذا يستفيد برلمانيون من تعويضات تبلغ 2500 درهم يوميا بدون عمل

قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 01 يونيو

انطلاق ايداع طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي للموسم الجامعي المقبل

الاحتفاظ ب12 شخصا تحت الحراسة النظرية بسبب ارتكابهم لأفعال إجرامية مخالفة لقانون السير

أمير المؤمنين يترأس مساء اليوم السبت بالقصر الملكي حفل إحياء ليلة القدر المباركة

اعتقال 12 سائقا وحجز مركباتهم بسبب التهور ومخالفة قانون السير

التحقيق مع مزارعين متورطين في قضية "النعناع الملوث" وتدمير محاصيلهم

المدرسة البريطانية الدولية تكشف عن طموحاتها في المغرب بعد سنتين من افتتاحها

إفطار جماعي لفائدة نزيلات مركز حماية الطفولة درب السلطان بالدارالبيضاء

علاج "توكال الجن" يدفع الهاكا إلى توقيف برنامج "بسم الله أرقيك" على MFM

الخلفي: ليس هناك جديد حول تسقيف أسعار المحروقات

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 23 ماي

عمل جمعيات أولياء التلاميذ يتسم بالضعف وتمثيليتها محدودة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

الملك يسلم جائزة "محمد السادس" للمتفوقين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد
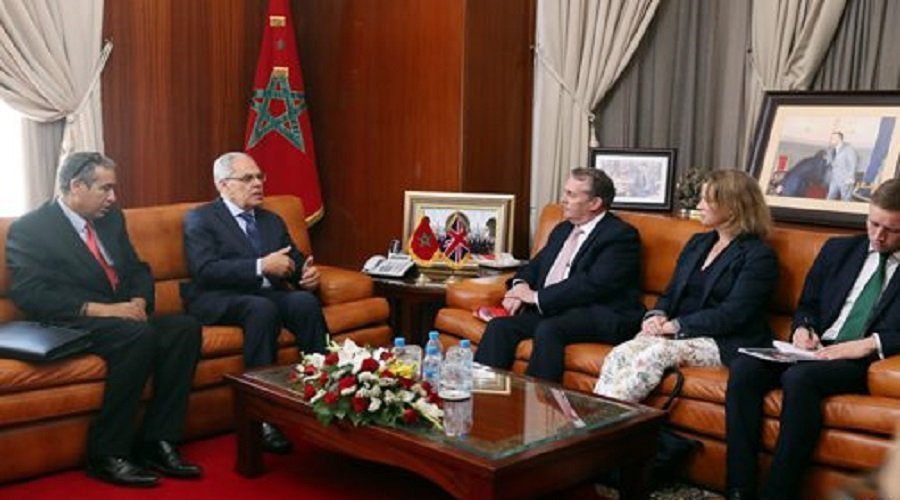
لوديي يستقبل وزير التجارة البريطاني لتباحث التعاون العسكري بين البلدين

هكذا تسبب لقجع و500 مليار في إضراب أساتذة الجامعة

تفاصيل تعويضات بالملايين لأعضاء مجلس المنافسة

إيطاليا تشيد بالأمن المغربي بعد الإطاحة بـ"مافيوزي" خطير

شاشة تفاعلية: الأحزاب الشعوبية واليمينية تكتسح انتخابات أوروبا

اختفاء أكثر من 50 دواء من الصيدليات

حكومة العثماني ترفع من وثيرة الخوصصة

السجن ينتظر كل من عرقل الامتحانات أو ساهم في ذلك

أزيد من 441 ألف مترشح للبكالوريا هذه السنة والوزارة تتوعد الغشاشين

تعديلات على بعض مقتضيات المسطرة الجنائية تتصدى لمافيا العقار في المغرب

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر

الحكومة تدعو طلبة كليات الطب لاجتياز الامتحانات وتؤكد أن لا وجود لسنة بيضاء
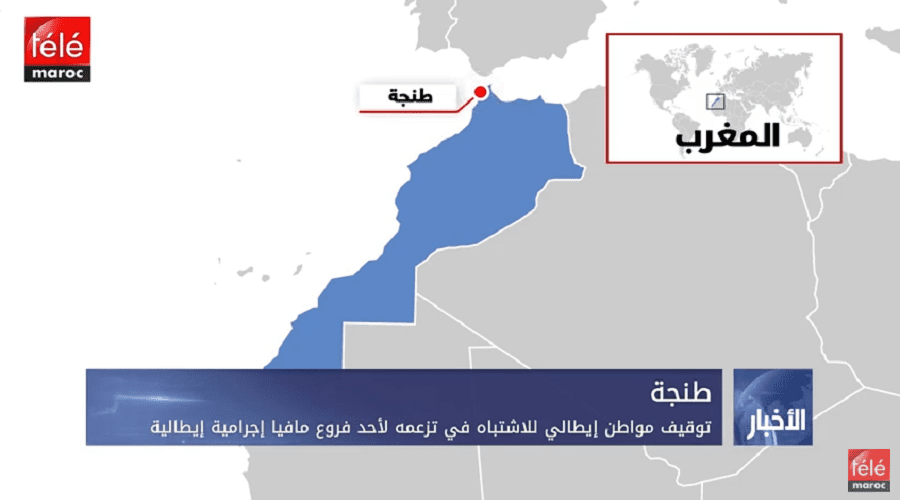
توقيف مواطن إيطالي لاشتباه في تزعمه لأحد فروع مافيا إجرامية ايطالية

هكذا تحول المغرب إلى مصيدة لأخطر المجرمين المطلوبين دوليا للعدالة

الحرف الأمازيغي "تيفيناغ" يفجر الأغلبية الحكومية

هكذا ساهم بنك المغرب في خفض مبيعات السيارات

تفاصيل توقيف الأمن المغربي لأحد زعماء المافيا الإجرامية الإيطالية "لا كامورا"

بالفيديو.. تحويل حافلة نقل حضري لحمام يخلف استياء سياح أجانب بأكادير

تحذيرات من "نعناع مسموم" يهدد صحة المغاربة

الدكالي :"لا مبررات لإضراب طلبة الطب والامتحانات ستجرى في وقتها"

الحكومة تستعد لتسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية

طلبة الطب يرفضون "سياسة التهديد" ويتوعدون أمزازي بمسيرة وطنية تصعيدية

الملك يدشن ببنسليمان مركزا لطب الإدمان

الملك يقيم مأدبة إفطار على شرف جاريد كوشنير المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي

قرض جديد لمكتب الماء والكهرباء بـ9 ملايير سنتيم

"سليت" الأطباء يحرك وزارة الداخلية

شكايات جديدة لعاملات حقول الفراولة بإسبانيا

صفقات "مشبوهة" بوزارة الصحة

الحموشي يصدر تعليمات صارمة لمحاربة "السياقة الاستعراضية"

العثماني يدعو المعارضة إلى إسقاط حكومته

نصف البرلمان يقاطع العثماني

البرلمان يحقق في نهب رمال السواحل

هام للراغبين في الحصول على فيزا إسبانيا

جطو : هذه المعطيات حول الفوسفاط المغربي يمنع نشرها

الملك محمد السادس يشرف على تدشن مركز لطب الإدمان ببنسليمان

الملك يستضيف مستشار ترامب حول مائدة إفطار

النيابة العامة تحقق في وفاة أب أستاذة متعاقدة وتأمر بتشريح الجثة

الداخلية تستعد لحركة انتشار واسعة

تلاعبات في بطاقة راميد بمراكش

مصالح "أونسا" تتلف 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة لموائد المغاربة

اقتلاع زليج كورنيش آسفي قبل افتتاحه بعدما كلف أزيد من ملياري سنتيم

نشرة خاصة.. موجة حرارة ستصل إلى 43 درجة بهذه المناطق من المملكة
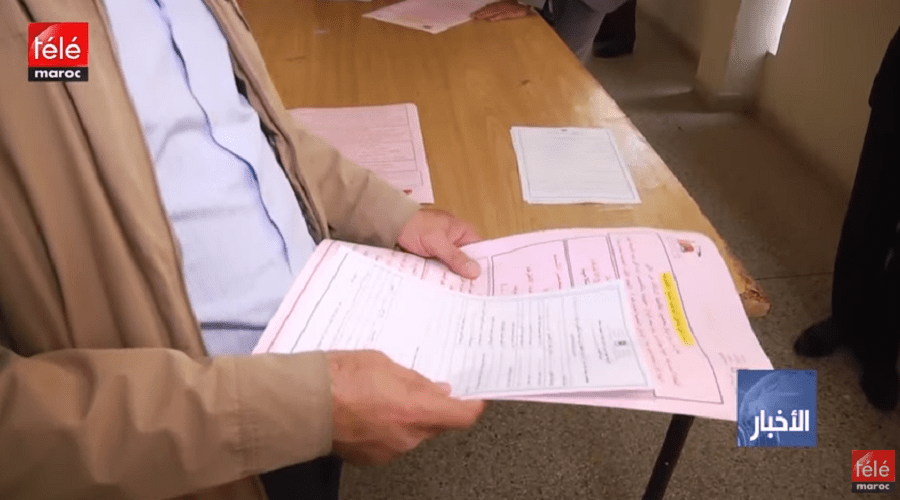
عقوبات تأديبية وسجنية تصل لخمس سنوات وغرامات كبيرة تنتظر الغشاشين

العثماني يتحدى المعارضة البرلمانية ويدعوها للجوء إلى الفصل 105 لإسقاط الحكومة

الملك يعطي انطلاقة البرنامج الوطني لدعم مشاريع فائدة 478 من السجناء السابقين

لماذا تشدد العدالة والتنمية مع ماء العينين وتساهل مع اعمارة ؟

تفاصيل فضيحة مالية هزت شركة العمران كلفت هدر 10 ملايير

شكوك حول ميزانية مجلس المستشارين

العثماني يعترف بفشل الداودي ويرمي بتسقيف المحروقات على بنشعبون

هذا هو مقدار الزكاة لهذا العام

الملك محمد السادس يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

تغيير العادات الاستهلاكية لدى المغاربة في رمضان وهدر كبير للمواد الغذائية

بالفيديو.. قائد ترامواي يسير بأبواب مفتوحة ويعرض الركاب للخطر

على عهد ساجد أصبحت تونس أقوى سياحيا من المغرب...والعهدة على هذا الوزير

نهضة بركان يسقط في خطأ إداري

حجز 44 طن من المواد الفاسدة في الطريق لموائد المغاربة

مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في حادثة سير ببلقصيري

بمساعدة "الديستي" ...حجز صفائح ذهب بالدارالبيضاء

أزمة المناصب العليا في الحكومة.. العلاقات الحزبية بدل الكفاءة والخبرة

وفاة راكب دراجة نارية جراء اصطدامه بقاطرة ترامواي الدار البيضاء

الممرضون يشلون حركة المستشفيات لأسبوع كامل

زوم: جمعية متطوعي الأمل توفر 700 وجبة إفطار يومية لفائدة المحتاجين والفقراء

الممرضون يصعدون ضد الحكومة ويشلّون المستشفيات لأسبوع كامل

هيئة فلكية تعلن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

أمواج البحر تلقي بكميات ضخمة من الحشيش بشواطئ الغرب

هكذا أحرجت حركة التوحيد والإصلاح الخارجية المغربية
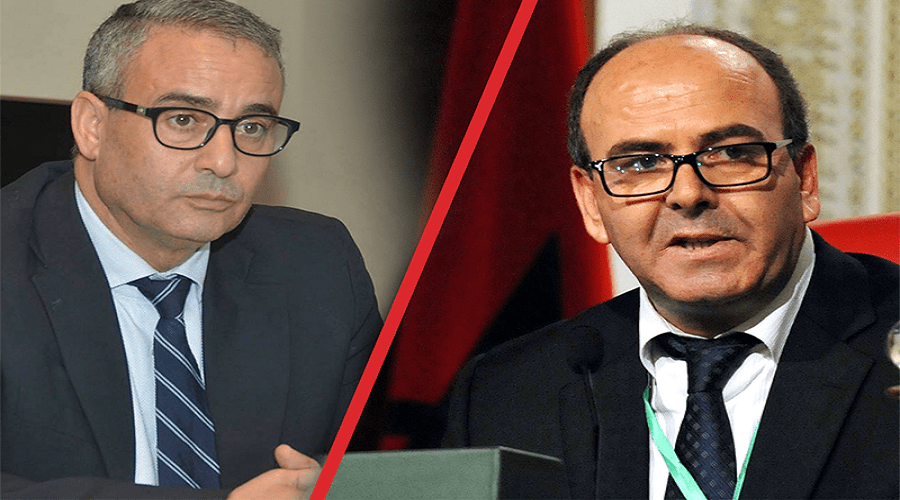
بنشماش يطالب بنعزوز بتبرير صرف 300 مليون

نكبات "كارد كورات" الملوك.. من رايمون ساسيا إلى المديوري

تراجع الصناعة التقليدية بالرباط والحرفيون يدقون ناقوس الخطر

المغرب يتجه لاقتناء نظام جو أمريكي عوض "إس 400 الروسي"

وزراء يتسترون على الأشباح

ثلثا الأطفال المعاقين خارج المدرسة

طلبة الطب يمنحون الحكومة الفرصة الأخيرة

الأجور تفجر غضب الأساتذة الباحثين

أزمة جديدة داخل الأغلبية بسبب الأوراق المالية

جنايات مراكش ترفض إعادة فتح مقهى لاكريم

صلاة التروايح بمسجد الكتبية بمراكش تجلب أنظار السياح

مجلس المستشارين يمنع مرشحين من مباراة التوظيف

هكذا وافق العثماني لجمعية على امتلاك مليار سنتيم

قتلى وجرحى في حادث اصطدام حافلتين لنقل العمال بطنجة

عقوبات وتدابير إدارية جديدة تتعلق بمعاينة مخالفات السير

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اصطدام حافلتين لنقل العمال

توقيف مواطنين إسبانيين ومغربيين للاشتباه في حيازتهم لكميات من الذهب

مصحة بالبيضاء تقترح على أسرة شاب التنازل عن قلبه وكليته مقابل 23 مليون

الملك يسلم جائزة "محمد السادس" للمتفوقات في برنامج محاربة الأمية بالمساجد

هكذا تفاعلت وزارة التعليم مع مقاطعة أساتذة التعاقد لـ "حوار الخميس"

أونسا تتلف حوالي 28 طنا من المشروبات موزعة ما بين الماء المعدني والمشروبات الغازية بوجدة

"عمليات جراحية مؤجلة منذ سنة".. غياب طبيب التخدير يهدد بموت عشرات المرضى

"عطيني نعطيك" في توظيف الأساتذة

جطو يكشف عيوب الحكامة داخل "لارام"

هكذا باع الفيسبوك ملايين المغاربة

تقرير يفضح آلاف الأشباح في الوظيفة العمومية

المتعاقدون : لا حوار دون اسقاط التعاقد

اندلاع حريق مهول بإحدى حافلات "نقل المدينة"

دراسة : أكثر الدول التزاما بمبادئ الإسلام ليست إسلامية

المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات تنفي إغلاق مستشفى القرب بسيدي مومن

مخلفات مواد البناء تعمق إشكالية النفايات بالدار البيضاء

امتحانات الباكالوريا.. فرق "الاعتكاف" تستعد لطبع ملايين النسخ تحت حراسة مشددة

هذا ما ينتظر نصف مليون موظف بالإدارات العمومية

مقاطعات الرباط بدون ميزانية

هكذا أطاح "البيجيدي" بالأمازيغية من النقود

شاشة تفاعلية: المغاربة يتفوقون على الصينيين والروس في اقتناء العقارات بإسبانيا

السجن والغرامة في حق النقيب زيان وأمال الهواري

جدل الأمازيغية يعود إلى الواجهة

هذه خطة الحكومة لمراقبة "سلايتية" الطرق السيارة

جطو يعري اختلالات المغرب الرقمي

إضراب بمصحات الضمان الاجتماعي

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 22 ماي

قطاع التعليم: الأساتذة المتعاقدون يطلبون أمزازي بالالتزام بمخرجات حوار 10 ماي

طنجة: توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة أزيد من 8 آلاف قرص مخدر

المجلس الحكومي: تعديلات جديدة على مدونة السير من بينها إلغاء سحب رخصة السياقة

ذعيرة 400 درهم للسائقين اللذين يستعملون مسار الحافلات تخلق الجدل بالرباط

"رشوة بمليار سنتيم".. تطورات مثيرة في ملف كولونيلات الدرك والمخدرات

تغيير مواعيد الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا

لهذا ربط بنكيران العمل السياسي بـ"السجن والقتل"

هكذا يحرم الوزراء والبرلمانيون الدولة من 10 ملايير سنويا

إفطار جماعي لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع

مصدر أمني يكشف ملابسات "فيديو" إطلاق النار بالدار البيضاء

تعديلات جديدة في مدونة السير

الحموشي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ترقيات الأمنين

أمزازي يهدد طلبة كليات الطب: "الامتحانات ستجرى في وقتها ولي ماجاش اتحمل المسؤولية"

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 21 ماي

المعلقات مبادرة شبابية توفر للمحتاجين أدوية الأمراض المزمنة

إضراب أرباب حافلات النقل الدولي

المغاربة ينفقون حوالي ملياري درهم على الحج والعمرة

مدير وكالة بنكية يسطو على مئات الملايين من حسابات زبائنه الأثرياء
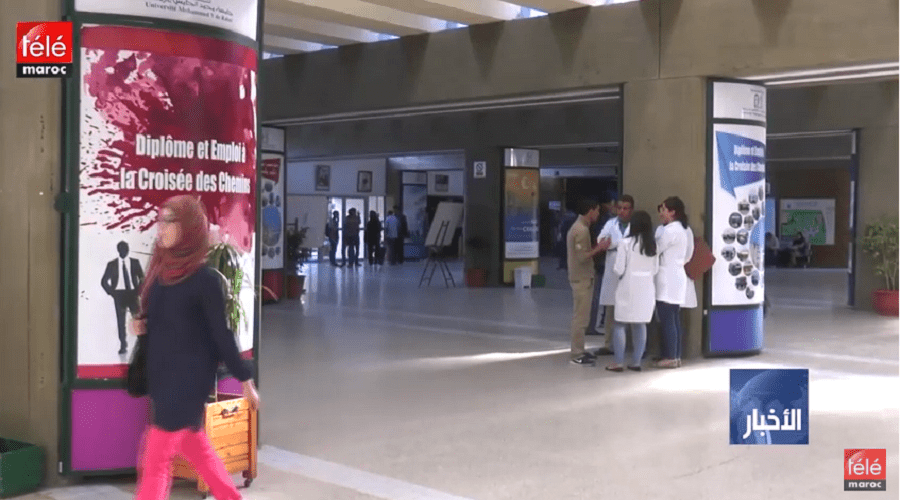
أمزازي يؤكد أن بعض مطالب "طلاب الطب" غير مشروعة

متابعة هاكر من أسفي بتهمة قرصنة قنوات أجنبية

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الأساتذة الجامعيون ينتفضون ضد أمزازي

الحكومة تمنع نشر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات

تفاصيل اعتقال شخص استعمل "كاميرا تجسس" داخل مقر للدرك

اليعقوبي في مواجهة منتخبي "البيجيدي"

وزراء مستاؤون من "تطاول" الرميد على اختصاصات العثماني

شاشة تفاعلية: الارتشاء وثمن البيع غير المصرح به أكثر أشكال الرشوة انتشارا في العقار

بنكيران يلقي درسا أمام الملك

حوارات الملك.. مواقف طريفة يرويها صحافيون حاوروا الملوك الثلاثة

رجل أعمال يسدد كامل ديون طلاب جامعة أمريكية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 20 ماي

مصرع ثلاثة عمال اختناقا في قناة للصرف الصحي

يتيم يتوقع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين قبل نهاية السنة الجارية

طلبة الطب يرفضون مشروع الاتفاق الذي تقدم به أمزازي والدكالي

قنطرة كلفت 4 ملايير في مهب الريح بالمحمدية

الحوار مع المتعاقدين يعود للصفر

هكذا تعرقل "لوبيات العقار" قوانين الأراضي السلالية

بنكيران يقاطع أعضاء الأمانة العامة لـ "البيجيدي"
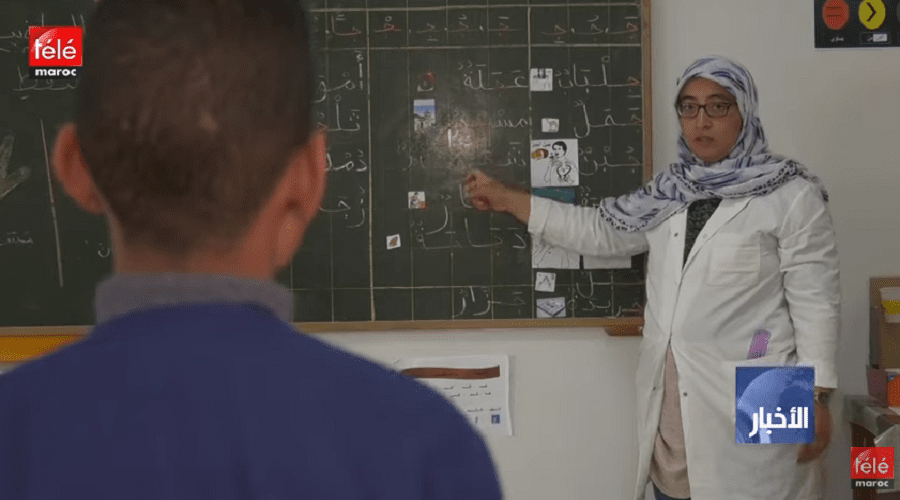
زوم: مؤسسة منى.. فضاء يقدم للأطفال الصم وسطا تعليميا يمكنهم من التعلم

مجلس العاصمة يفرض ضريبة على الموتى وأزمة المقابر تندلع بالرباط

تفاصيل محاولة اغتيال الحارس الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني

مديرية الأمن تفتح تحقيقا حول اتهام أمين الراضي لشرطي بتعنيفه والأخير يشكر الأمن

300 رجل سلطة ينتظرون الترقية والتعيين

هجمات إلكترونية تضرب قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 18 ماي

شاطئ عين الذئاب قبلة البيضاويين المفضلة لتناول وجبة الإفطار

20 في المئة من الأطفال حديثي الولادة يعانون من الهزال

حجز وإتلاف أزيد من 56 ألف كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان

الإعلان عن مستجدات تخص المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي

نساء يقبلن على التبرع بالدم خلال الشهر بمسجد الكوثر بحي مولاي رشيد

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 17 ماي

شركة الترامواي بالبيضاء تعلن إطلاقها عربات جديدة تحد من مشكل الاكتظاظ في صفوف الركاب

الملك يدين الاعتداءات المغرضة التي استهدفت منشآت طاقية حيوية سعودية

الرباط: أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

الحكومة تتبرأ من تصريحات العثماني حول "فتح الحدود مع الجزائر"

طرق جديدة لصرف "ريع التعويضات" بمجلس المستشارين

بعد اتهامه بالتحرش بتلميذات.. توقيف مدير الثانوية الفرنسية "فيكتور هيغو" بمراكش

تفاصيل مباريات "مشبوهة" بجامعة محمد الخامس بالرباط

صفقات عسكرية ضخمة للقوات المسلحة الملكية

فواتير مزورة بألف مليار

الداخلية تعتقل 5000 منصب شغل

الصيادلة يحذرون من المكملات الغذائية

ايقاف متورطين في سرقة معهد التكنولوجيا التطبيقية بمراكش

هذا ما قررته المحكمة في حق المتابعين في جريمة "شمهروش"

استئناف محاكمة المتورطين في جريمة "شمهروش" والإعدام في انتظار 3 منهم

عمدة البيضاء يوزع "الحيوانات" على السكان المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة

الداودي يكشف موعد رفع الدعم عن السكر والدقيق و"البوطا"

هكذا تحرم "الفوضى" ميناء البيضاء من 80 في المائة من السياح

صرف أكثر من مليار سنتيم على مبيت البرلمانيين في الفنادق

تأجيل غامض لاجتماع لجنة التعمير حول جسر سيدي معروف بالبيضاء

مفتشية الداخلية تحقق في توظيفات مشبوهة

رباح : الحكومة لن تتدخل لانقاد لاسامير

أوجار يلاحق سماسرة المحاكم

مقاضاة 16 رئيس جماعة

مداخيل الجمارك برسم 2018 تتجاوز 100 مليار درهم

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 15 ماي

54،4% من نساء المغرب تعرضن للعنف وأعلى النسب في الوسط الزوجي
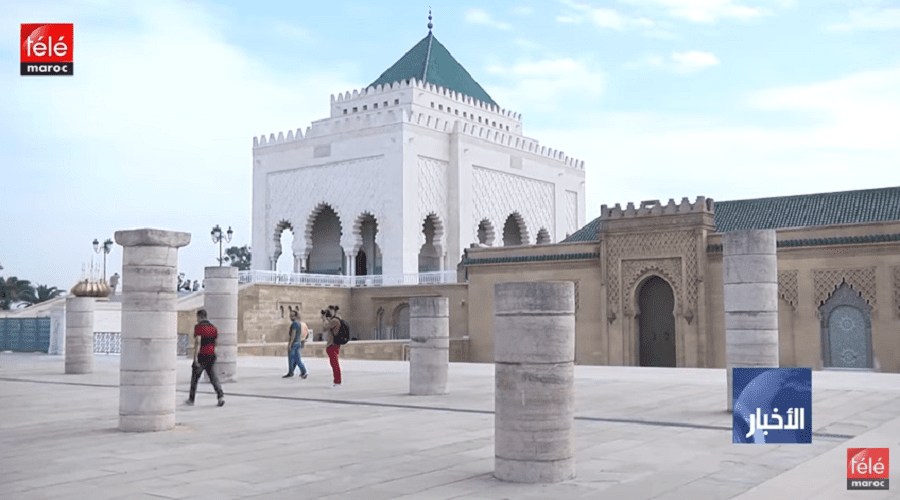
عدد السياح الذين زاروا المغرب عرف زيادة بنسبة 4،1 في المائة

وزير الإسكان يقر بفشل الدولة في القضاء على السكن الصفيحي

شباب يركبون أسطح الحافلات في شوارع الدار البيضاء

بنشعبون يسترجع أموالا مختلسة بقيمة 4 ملايير سنتيم

هكذا اعتدى العثماني على اختصاصات الملك

ارتفاع صاروخي في سعر البصل تزامنا مع دخول رمضان

هكذا ردت منيب على استقالة بلافريج

الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 63 لتأسيسها

رباح يسطو على اختصاصات التوفيق

مجهولون يرجمون مثليين في مراكش

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 14 ماي

العثماني يتحدث بشكل رسمي عن التعديل الحكومي

استئناف محاكمة حامي الدين

أطلنطا للتأمينات تطلق منصة إلكترونية تجمع ما بين المتطوعين والجمعيات

الدكالي يرمي كرة الزيادة في أجور الأطباء إلى المالية

نيويورك: الملك محمد السادس يتوج بالجائزة الدولية "اميدالية إيليس آيلاند" الشرفية 2019

ربان وأطباء متورطون في تهريب أدوية من الخارج والإجهاض السري

تقرير الخارجية الأمريكية حول "الإخوان" يرعب "البيجيدي"

هكذا تغازل ماء العينين النقابة للعودة إلى البرلمان

زوم: إطلاق "شباك وحيد متنقل لمغاربة العالم" في مرحلته الأولى لفائدة مغاربة إسبانيا
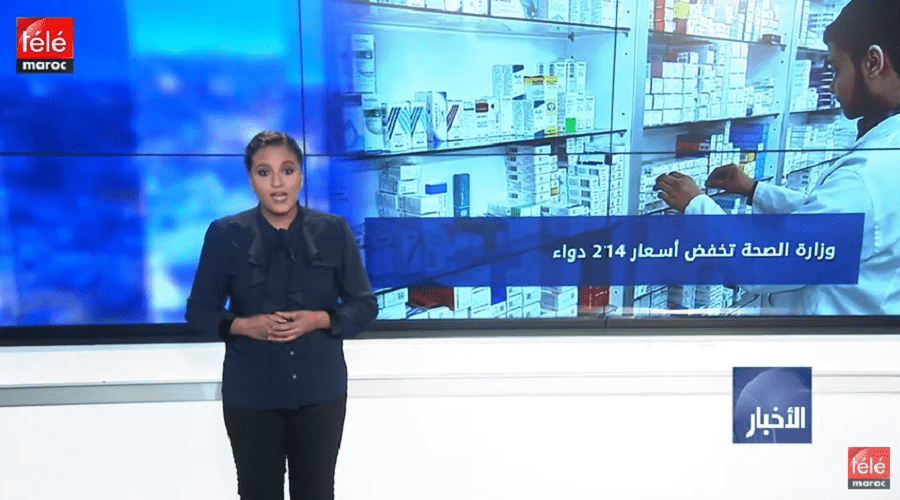
شاشة تفاعلية: ثلاثة آلاف دواء لاتعوضه صناديق التغطية الصحية

تتويج الملك محمد السادس بجائزة دولية مرموقة

وكالة الطاقة الدولية : الحكومة عاجزة أمام لوبي المحروقات

الدكالي يواصل استفزاز طلبة الطب ويطالبهم باستئناف الدراسة

المساجد تضع المغرب في الصدارة مغاربيا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 13 ماي
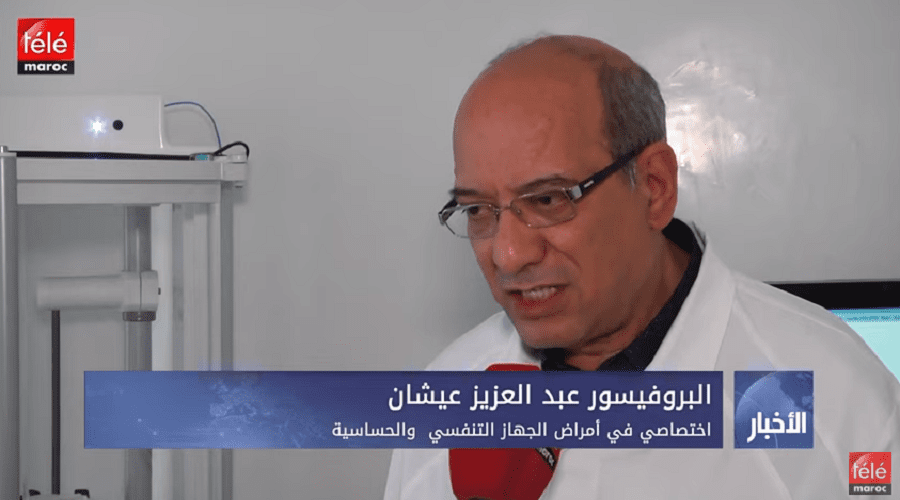
أطباء يحذرون من تزايد إصابة أطفال الدار البيضاء بمرض الربو بسبب التلوث

إقليم الحوز: العثور على جثة مواطنة من جنسية فرنسية بعد سقوطها عرضيا بمنحدر صخري

بوريطة في البرلمان لعرض مستجدات قضية الصحراء المغربية

فيديو هروب الغوريلا من المطر على طريقة البشر يحصد ملايين المشاهدات

الأزمي يعترف ببيع ممتلكات المجلس الجماعي لفاس في المزاد العلني

من محاربة الفساد إلى "عفا الله عما سلف".. أين تبخرت وعود "البيجيدي" ؟

هكذا تهدد "مافيا العقار" شواطئ المغرب بالتآكل والأمم المتحدة تحذر

مئات الهواتف ونقاط الاشتراك تثير الريبة داخل البرلمان

العثماني يواصل "إغراق" البلد باقتراض 300 مليار

تفاصيل العثور على جثة مواطنة فرنسية بإقليم الحوز

أونسا يضيق الخناق على المتلاعبين بسلامة المنتجات الغدائية

بالفيديو.. إغماءات بسبب تسرب للغاز بإحدى معامل الكابلاج بالمنطقة الصناعية بورحمة بإقليم القنيطرة

هكذا يستغل "البيجيدي" مشاريع الصين انتخابيا

إذا كنت موظفا هذا ما ينتظرك ابتداء من فاتح يوليوز المقبل

الحموشي يلتقي السفير الجديد للسعودية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 11 ماي

عشوائية علامات التشوير الطرقي ونقصها يتسبب في حوادث بالرباط

موظف شرطة يستخدم سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين يتبادلان الضرب بالسلاح الأبيض

بعد جولة الحوار الأولية، أمزازي يعد "المتعاقدين" بوقف العقوبات الزجرية
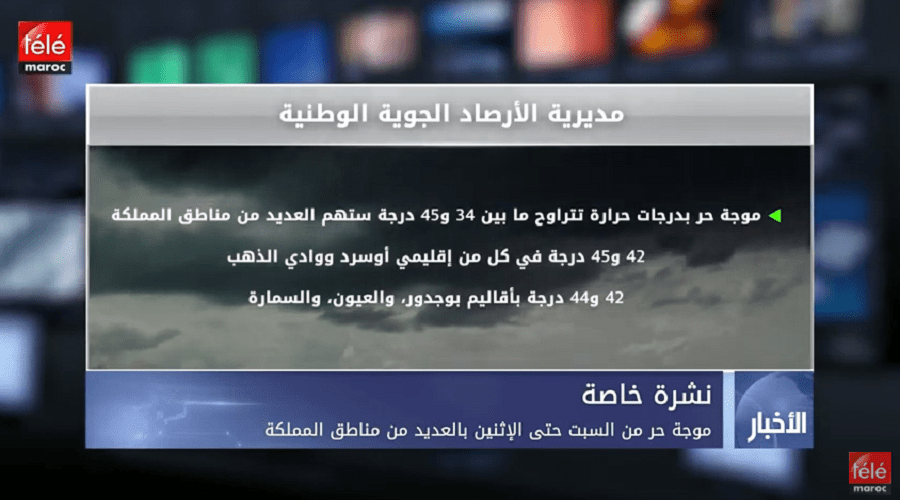
موجة حر من السبت حتى الإثنين بالعديد من مناطق المملكة

فرامل مغشوشة بالأسواق المغربية تهدد سلامة آلاف السائقين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 10 ماي

ورطة الصيادلة مع الأدوية النفسية تدفعهم للمطالبة ب"فتح نقاش جاد"

الحكومة تفرض قيودا صارمة على تسويق المشروبات الطاقية

الخلفي: الأمم المتحدة أسقطت وجود مسؤولية ل"البوليزاريو"على شرق المنظومة الأمنية

التحقيق في إطلاق نار على مسجد أثناء صلاة التراويح في لندن

محكمة طنجة تصدر حكمها في حق الشاب الذي حاول سرقة بنك

نشرة خاصة.. موجة حر تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق من المملكة

الداخلية ترصد اختلالات في تحصيل الملايير من الضرائب الجماعية

رسميا.. افتتاح قنطرة "سيدي معروف" المثيرة للجدل

كاميرات مجلس النواب تثير غضب الموظفين

مديرية الضرائب تجني 340 مليارا من "المتملصين"

من هو خليفة لفتيت على رأس الداخلية ؟

أسعار البصل والطماطم خلال رمضان تدفع وزارة الفلاحة للتوضيح
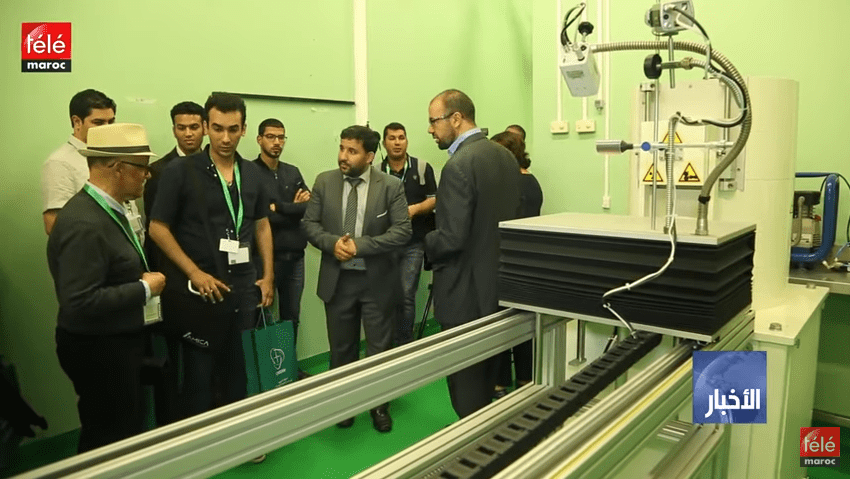
يوم إعلامي للتعريف بالمركز الوطني للتقنيات النووية وإبزار أدواره العلمية

تركي آل الشيخ يرغب في خطف رونار

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 09 ماي

وزارة الداخلية تنتهي من إحصاء المغاربة المرشحين للتجنيد

نهاية "بومبارديي" في البرلمان

ورطة الصيادلة مع الأدوية النفسية

أسماك سامة موجهة للاستهلاك في أول أيام رمضان

البنوك تشرع في منح قروض السكن والاستهلاك للأساتذة المتعاقدين
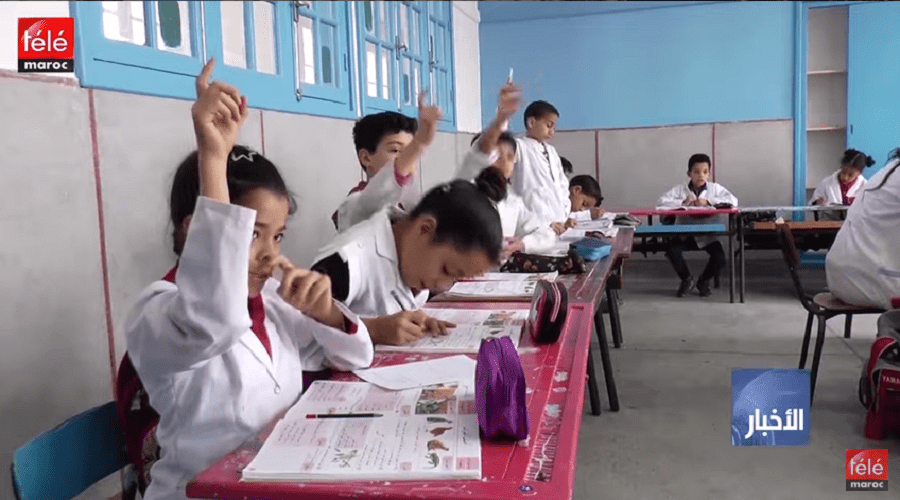
" أساتذة التعاقد" يتهمون الوزارة بعدم الالتزام بوعودها ويهددون بالعودة للشارع

"أونسا" يوسع البرنامج الوطني لمحاربة الحمى القلاعية ليشمل الأغنام والماعز

الملك يعطي انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1440"

هكذا تسبب كوب ماء مثلج في وفاة لاعب كرة قدم

مسؤول بالمالية يتهم المصحات الخاصة بالتعامل بالنوار والتملص الضريبي

في غياب الإجراءات الزجرية.. برلمانيون يقاطعون مجلس المستشارين

بنعبد الله يخبر قادته بقرب التعديل الحكومي

المخابرات الفنزويلية تعتقل النائب الأول لخوان غوايدو

العثماني يقدم حصيلة حكومته أمام مجلسي البرلمان

الداخلية تحقق في اختلالات شركات التنمية

محاكمة 51 متهما في قضية مراكز النداء

مليار و400 مليون تحرج كولونيلا في الدرك

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 08 ماي

تفاصيل حجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا جنوب طنجة

فوضى سوق الجملة بالرباط يدفع السلطات إلى نقله إلى ضواحي سلا

بعد المتابعات التي طالتهم.. الصيادلة يطالبون باعتماد طرق المراقبة الدولية

أساتذة التعاقد يتهمون أمزازي بـ "الإخلال بالالتزام" ويهددون بالعودة للشارع

الخدمة العسكرية.. الداخلية تنهي إحصاء المرشحين وتنتظر تبريرات الراغبين في الإعفاء

هكذا يبيع رؤساء جماعات عقارات المدن في "الدلالة"

هكذا تحول برلمانيو "البيجيدي" إلى أشباح

بنكيران يوقف "لايفاته" ويعتذر للعثماني

جامعة الكرة تفاوض مدرب ليون الفرنسي.. هل سيخلف لاركيط أم رونار؟
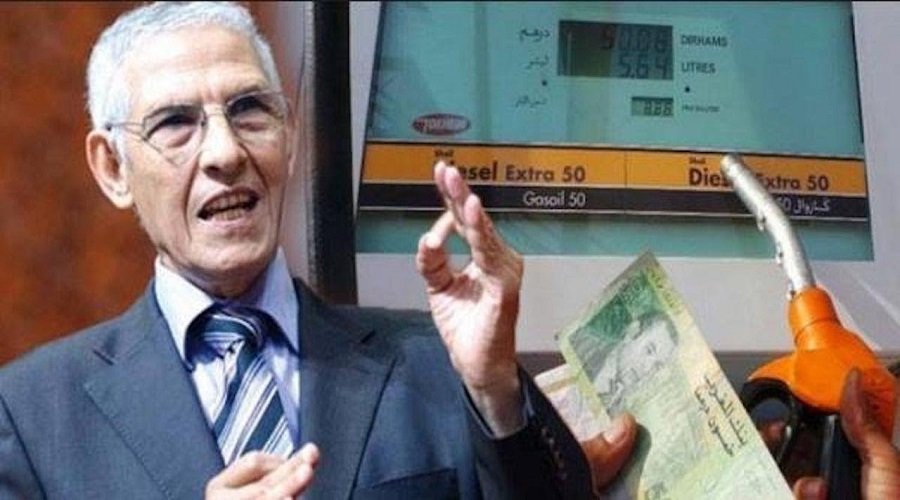
هكذا كذب الداودي على المغاربة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات

مسلح يحتجز رهائن داخل متجر في مدينة تولوز الفرنسية

برامج تجسس تتعقب سيارات المغاربة

المحروقات تجر الداودي للمساءلة

تجميد عضوية نقيبين في طنجة

سائقو سيارات الأجرة يشكون منافسة شركات التطبيقات الذكية بسبب عملها خارج القانون
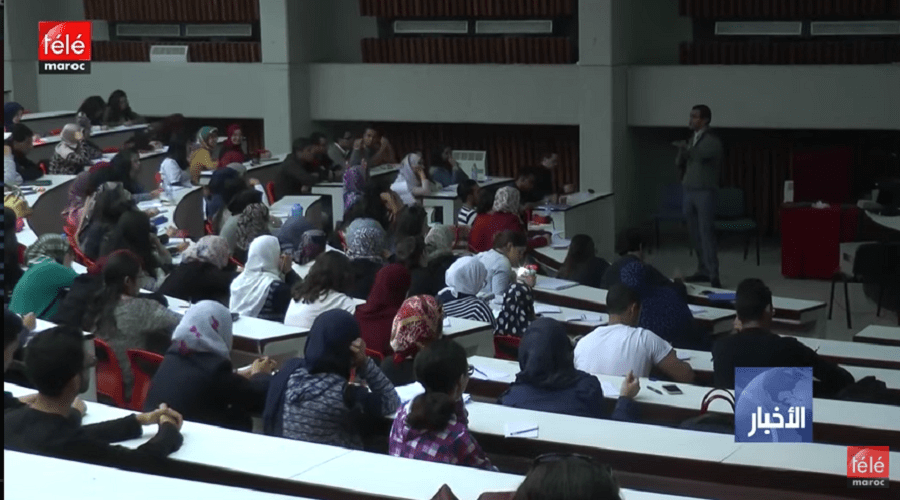
طلبة الطب يرفضون بلاغ أمزازي والدكالي ويواصلون المقاطعة

مندوبية السجون رحلت 44 ألف سجين لتقريبهم من عائلاتهم

في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، الداودي يؤكد أن "التسقيف قادم"

تفاصيل اعتقال "إسكوبار الشمال" وقناة إسبانية في قلب فضيحة تحقيق مفبرك

هكذا تفاقمت عطالة الخريجين والشباب في 2019

اعمارة يطيح بمدير السلامة الطرقية

هكذا خصص السكال 200 مليون من مالية الجهة لتلميع صورته

زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات تغضب المسافرين
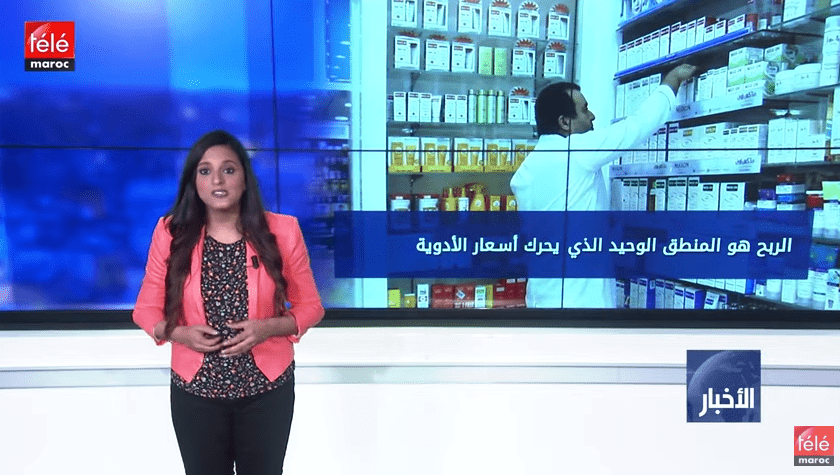
شاشة تفاعلية: المغاربة يدفعون أكثر من الأوروبيين لشراء الأدوية

الديستي تجنب سيرلانكا تفجيرات ارهابية جديدة

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 06 ماي

بنكيون متهمون باختلاس 600 مليون

عاملة نظافة تعوض أستاذة في حراسة امتحان

الأزمي يبيع ممتلكات فاس لأداء الديون

البرلمان يستعد للمصادقة على استفادة الوالدين من التغطية الصحية

تراجع معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من 2019

طلبة الطب يرفضون الالتحاق بمدرجاتهم ويدعون الوزارة لاستجابة الفورية لمطالبهم

تاريخ... مواقف طريفة في علاقة الملوك بالمصورين المغاربة والأجانب

تسخينات انتخابية ومطالب بتعديل الدستور.. هذه كواليس السباق نحو رئاسة الحكومة

صادم.. نصف المغاربة يعانون مشاكل نفسية

العثماني يحمل بنكيران مسؤولية التأثير على نفسية المغاربة

لهذا يخاف العثماني من تقنين امتيازات الوزراء

رسميا.. الثلاثاء أول أيام رمضان بالمغرب

عقوبة الإعدام تنتظر ارهابيي امليل

الحموشي يصرف مبالغ استثنائية لأرامل رجال الأمن الوطني

وفايات جديدة في خيرية تيط مليل

مختصون مغاربة يحدّدون أول أيام رمضان ويكشفون سبب تعذر رؤية الهلال "فلكيا"

وزارة بنعتيق تنظم قافلة الشباك المتنقل لتتبع أوضاع المغاربة بالخارج

لهذا كثرت حوادث السير في المغرب... الفرامل المغشوشة تغزو الأسواق

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 04 ماي

اصدار تقرير حول مؤشرات حرية الصحافة في المغرب

الحكومة تسعى لتشديد المراقبة على مخزون وجودة المحروقات

بنشعبون يؤكد أن 140 شركة فقط تؤدي 50% من الضرائب في المغرب

طائرة "بوينغ" تهبط فوق نهر ونجاة 143 شخصا بأعجوبة

انقلاب طائرة خاصة بمطار مراكش

معاشات البرلمانيين تعود للواجهة

جطو يحرج "البيجيدي" في فاتورة بـ5 ملايين ونصف

هكذا يتهرب أعضاء "البام" من المساهمات

الصخيرات تحتضن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

قابلة كشفت فضيحة وفيات رضع بمستشفى ابن سينا فتمت مجازاتها بإعفائها

ضحايا في حادث انقلاب حافلة نواحي ورزازات

عناصر "البسيج" توقف عنصرا آخر مرتبط بأفراد خلية طنجة

الجامعة تقيل المدير التقني الوطني ناصر لارغيت

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 03 ماي

تأجيل النظر في قضية المتهمين في جريمة إمليل بإقليم الحوز إلى 16 ماي الجاري

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الاستشفائي
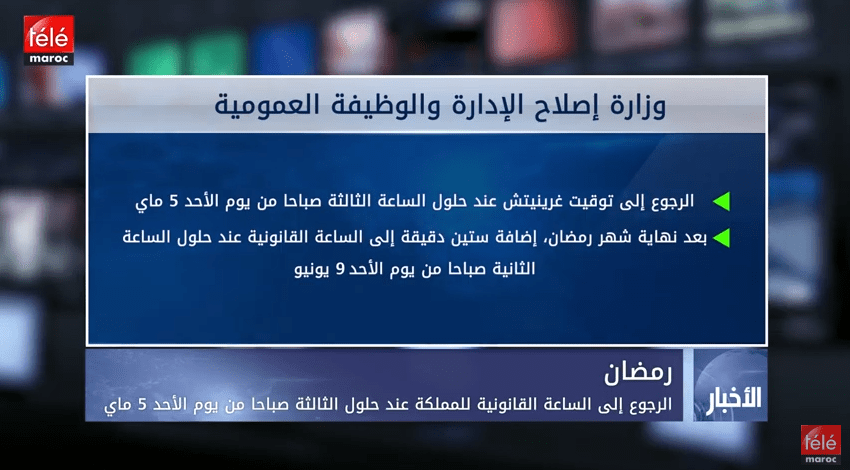
الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي

سجين يقدم على الانتحار شنقا بالسجن المحلي لتطوان

تفكيك خلية إرهابية بطنجة واعتقال 8 دواعش
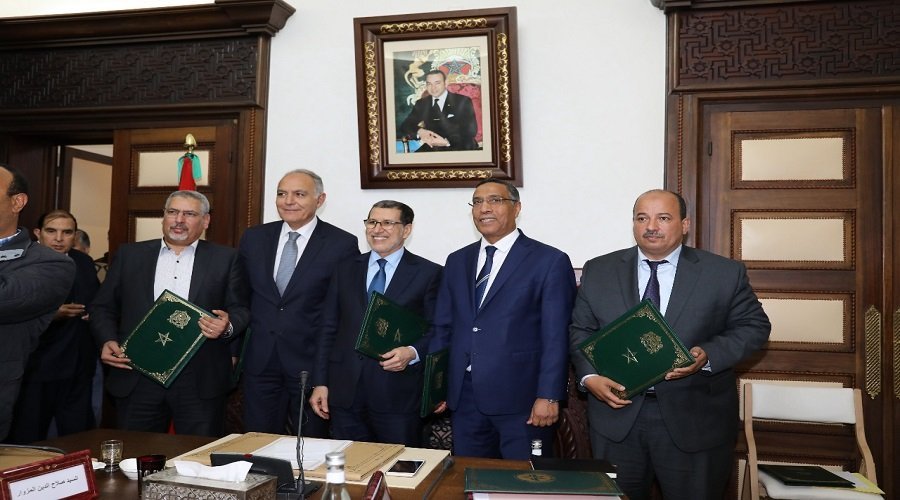
تفاصيل صفقة "سرية" بين النقابات والحكومة

الشوباني يقاطع وزارة الداخلية

لماذا يرفض العثماني تطبيق الدستور؟

الأساتذة الباحثون ينقلون احتجاجاتهم إلى الرباط للزيادة في أجورهم

متابعات جديدة لمدراء مراكز النداء

هذا ما قررته المحكمة في قضية قتل السائحتين الاسكندنافيتين

مئات العمال مهددون بفقدان وظائفهم لهذا السبب

التزوير يورط مستشارا جماعيا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 02 ماي

عدادات الأداء الخاصة بركن السيارات تربك البيضاويين

انطلاق عملية ترقيم الأغنام و الماعز المعدة لعيد الأضحى 1440

هذه مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات خلال رمضان

موظفو مجلس المستشارين يصعّدون ضد بنشماش ويحتجون أمام مكتبه

المؤبد لـ"أجودان" متهم بقتل موظفة

مواجهات ساخنة بين دركيين ومسؤولين متابعين في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

"أونسا" يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى

الولايات المتحدة لا تستبعد التدخل العسكري في فنزويلا

عبد المومني يصرف تعويضات خيالية لأعضاء مجلسه الإداري

تفاصيل إبعاد ماء العينين من العدل والتشريع

هكذا تعيق الحقاوي قانون الإعاقة

سقوط طائرة عسكرية جزائرية

النقابات تخلد فاتح ماي على وقع الانقسام و الشغيلة تعلن رفضها الاتفاق الثلاثي

العثماني يحتج ضد نفسه في عيد العمال

فرنسا تعيّن سفيرة سابقة في إسرائيل على رأس بعثتها الدبلوماسية بالمغرب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 01 ماي

قبيل رمضان.. التمور والمكسرات والقطاني تعرف إقبالا كبيرا وتخوف من ارتفاع الأسعار

الدكالي يقترح التوظيف بالتعاقد لتجاوز مشكل الاستقالات الجماعية للأطباء

الصحراء المغربية: مجلس الأمن يعرب عن "قلقه" إزاء انتهاكات "البوليساريو" للاتفاقات العسكرية

الصحراء المغربية: بوريطة يثمن قرار مجلس الأمن ويؤكد أهميته في حل النزاع

النقابات تحتفل بالعيد العمالي على وقع الفرقة

رسميا.. "الكاف" يعتمد تقنية "الفار" خلال كأس إفريقيا بمصر

تفاصيل فشل مهرجان كلف مقاطعة زواغة بفاس عشرات الملايين

العثماني يقاطع بنكيران نهائيا

قيادة "البيجيدي" تمنع ماء العينين من مسؤولية برلمانية أخرى

تحويلات مشبوهة بـ 16 مليارا

الحموشي ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا

فيلا العثماني تعود إلى الواجهة

مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 30 أبريل

منظمة "أوكسفام": 1،6 مليون مغربي يعيشون الفقر

الحكومة تقر بمحدودية برامج السكن الاجتماعي وتفكر في مراجعة الدعم العمومي

الأمير مولاي الحسن يترأس حفل تدشين الإفريز التاريخي لمؤسسة أبو بكر القادري للفكر و الثقافة

يحدث الآن بهذه المدينة

القصة الكاملة لبتر قدم طفل بمصحة خاصة بمراكش

المستشفيات بدون أدوية مضادة لالتهاب الكبد الفيروسي منذ 3 سنوات

مجلس جطو يطالب هذه الأحزاب بالإدلاء بحساباتها المالية

قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بأكادير

بعد منع واتساب.. الداخلية تعد مخططا لحماية أمن الشبكات المعلوماتية

الحكومة تعرض مؤسسات عمومية جديدة للبيع

مؤسسة غالوب: المغاربة من بين أكثر الشعوب غضبا في العالم

"البوليساريو" تواجه الغاضبين بالدبابات والأسلحة الثقيلة

1.6 مليون مغربي يعيشون الفقر

مجلس حقوق الإنسان يكشف تفاصيل وقف سجناء أحداث الحسيمة لإضرابهم عن الطعام

زوم: بيت نموذجي للزيارة العائلية لفائدة النزلاء الأكثر انضباطا بإصلاحية عين السبع

ترقب وسط الرباطيين لاستقبال حافلات النقل الحضري الجديدة

الأطباء يشلون المستشفيات لأسبوع انطلاقا من اليوم ويتظاهرون في الرباط

الأساتذة المتعاقدون يعودون اليوم إلى الأقسام

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 29 أبريل

قرابة ألف طبيب يقدمون استقالتهم ووزارة الصحة تعتبرها غير قانونية

رغم توقيع "اتفاق الزيادات في الأجور".. نقابيون يعبئون لاحتجاجات حاشدة

أساتذة التعاقد يحذرون الحكومة من التلاعب بملفهم المطلبي بعد تعليق الإضراب

أساتذة التعاقد يعلقون إضرابهم "مؤقتا" ويعودون إلى الأقسام غدا

التحقيق مع مدير الأمن الوطني الجزائري السابق وابنه في "ملفات فساد"

عبد المولى يواجه أحكاما قضائية ثقيلة تستنزف أموال المنخرطين بالتعاضدية

مناصب المسؤولية تشعل حربا داخل مجلس النواب

تقاعد بنكيران يبلغ 250 مليونا

أساتذة التعاقد يعلّقون إضرابهم "مؤقتا" لهذا السبب

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 27 أبريل

أمزازي يتعهد بتنزيل "اتفاق 13 أبريل" شريطة إنهاء أساتذة التعاقد لإضرابهم
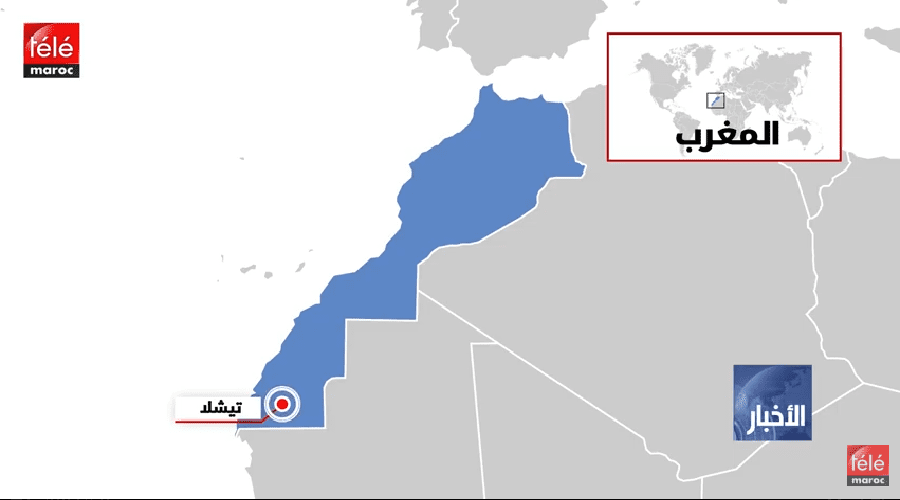
مقتل عنصرين من القوات المسلحة الملكية في تحطم مروحية

مصرع 16 مرشحا للهجرة السرية في حادث سير بين السعيدية والناظور

استقالة جماعية لأزيد من 120 طبيبا بجهة بني ملال خنيفرة

لفتيت يكلف مديرية الانتخابات بملف التجنيد

15 قتيلا في تفجير انتحاري جديد بسيريلانكا

هكذا يتجه "البام" للإطاحة ببنشماش

مزوار في مرمى نيران الفلاحين بعد توقيعه على اتفاق الحوار الإجتماعي

تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومقتل ضابطين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 26 أبريل

طلبة الطب يقاطعون الامتحانات وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق

النزلاء المضربون عن الطعام بسجني طنجة وفاس يتقدمون بإشعارات بفك إضرابهم
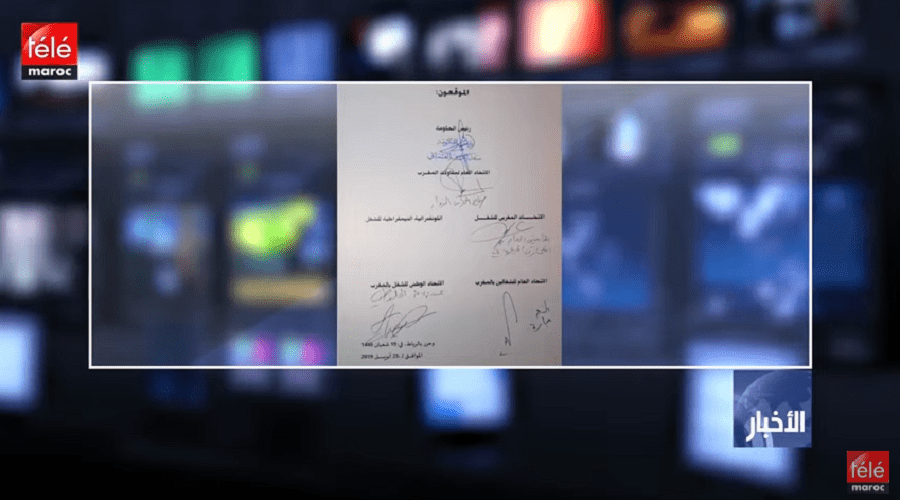
الحوار الاجتماعي: الحكومة والنقابات توقعان اتفاق الزيادة في الأجور

السلطات المغربية تسلم روسيا مطلوبا بتهم الانتماء للجماعات المسلحة

تفاصيل إعفاء كولونيل للدرك بمطار محمد الخامس ووضع دركيين بسجن العرجات

100 ألف موظف شبح يختفون في إدارات المغرب بينهم مسؤولون كبار

عمدة آسفي أمام قاضي التحقيق بعد متابعته بالتزوير وتبديد أموال عامة

لهذا فك معتقلو ملف أحداث الحسيمة إضرابهم عن الطعام

منصب مدير الدراسات يشعل حربا داخل البرلمان
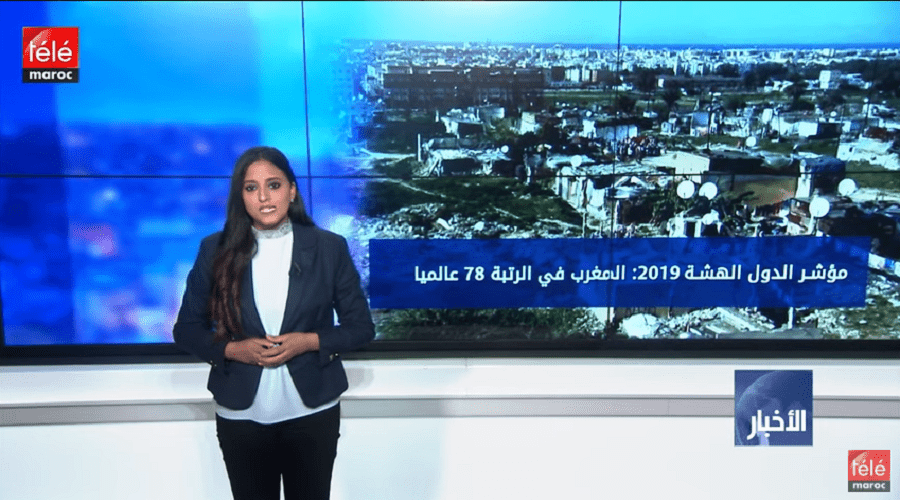
شاشة تفاعلية: المغرب في الرتبة 78 بين 178 دولة حسب مؤشر الدول الهشة ل2019

هكذا عطلت صفقة بملياري سنتيم جلسة دستورية
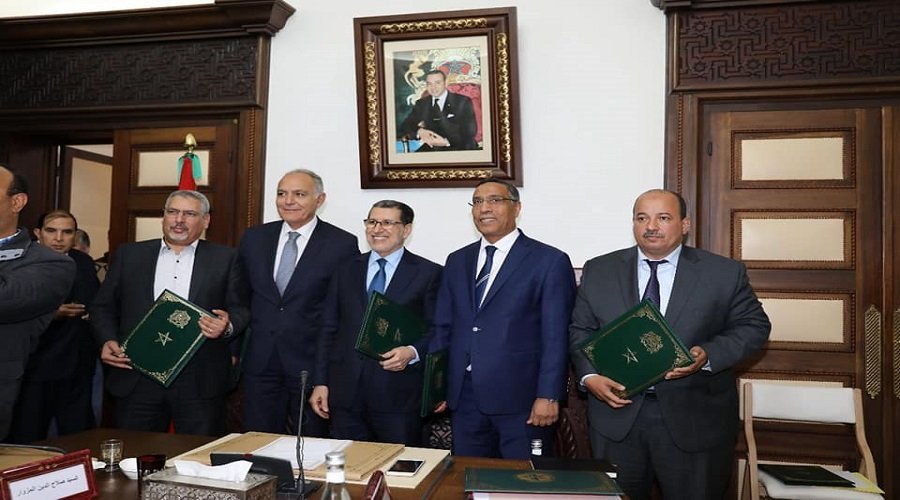
رسميا.. الحكومة والنقابات توقعان اتفاق الزيادة في الأجور وهذه التفاصيل

هذا تعليق الحكومة على فض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين"

أمن بوزنيقة يطلق النار لتوقيف عصابة لترويج المخدرات

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 25 أبريل

وزارة التجهيز والنقل تعقد سلسلة من الاجتماعات مع التمثيليات المهنية

إحالة ملفات التعويض عن الولادات القيصرية على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

الرباط: الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرىة العامة للأمن الوطني

بعد فض اعتصامهم أمام البرلمان.. "أساتذة التعاقد" يصعّدون ضد الوزارة ويمددون الإضراب

الداخلية تمنع الواتساب

التحقيق في صرف أموال دعم إنتاج اللحوم الحمراء

السلطات اليابانية تخلي سبيل كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار
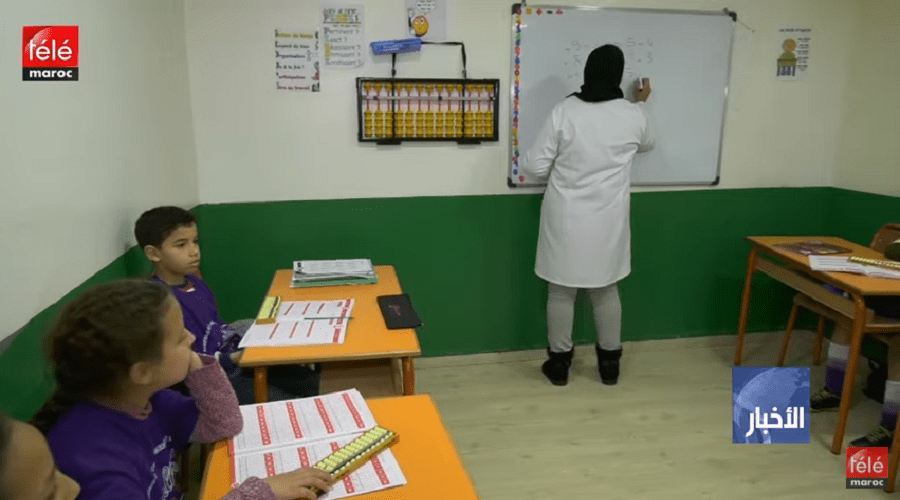
تلاميذ نجباء يتعلمون الحساب الذهني لتطوير مهاراتهم بالدار البيضاء

وفاة عباسي مدني مؤسس الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ

الداخلية تراجع قوانين الانتخابات والجماعات

قرصنة المكالمات.. توقيف 8 مستخدمات داخل مركز نداء غير مرخص

هكذا ساهمت المخابرات المغربية في الكشف عن منفذي هجمات سريلانكا

الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني

مجلس الأمن يتجه للتمديد لـ"المينورسو" في الصحراء المغربية

أمن طنجة يوقف برتغاليا مبحوث عنه دوليا في قضايا الاتجار في المخدرات

هذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص التكفل بالولادات القيصرية

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 24 أبريل

دراسة: إفلاس 8 آلاف مقاولة مغربية في 2018

وزير الصحة يصف الاستقالة الجماعية لمئات الأطباء بغير القانونية

التحقيق مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز للنداء بتهمة قرصنة المكالمات

الداخلية تعلن تدابير جديدة لمراقبة الأسعار خلال رمضان وتتوعد "الغشاشين"

نواب الصحراء غاضبون من بنشماش لهذا السبب

بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا عبر قطار مصفح قبل لقاء بوتين

هكذا أقبر "البيجيدي" تقرير السجون

التحقيق مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز للنداء بتهمة قرصنة المكالمات

ولاة وعمال مهددون بالورقة الحمراء

إفلاس 8 ألاف مقاولة مغربية في 2018

الداخلية تعلن تدابير جديدة لمراقبة الأسعار خلال رمضان وتتوعد "الغشاشين"

توقيف عنصر آخر على علاقة بالخلية الإرهابية التي تم تفكيكها صباح اليوم

هذا موعد الرجوع رسميا إلى الساعة القانونية للمملكة

عقار بـ15 مليار يورط برلمانيا

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 23 أبريل

المغربيات ممنوعات من الولادات القيصرية لهذا السبب

الأساتذة المتعاقدون يواصلون الاحتجاج وأمزازي يعلق الاجتماع مع النقابات

شكاوى على مكتب لفتيت بسبب نافذ في الوزارة يتحكم في صفقات النظافة

أخنوش: الموسم الفلاحي الحالي سيكون متوسطا بالنسبة لإنتاج الحبوب

إنجاز أزيد من مليوني عملية بواسطة "تطبيقية" تدبير صناديق وحسابات المحاكم

برلماني من "البيجيدي" يصف سكانا من تمارة بـ"بوزبال"

تفاصيل إحباط عملية لتهريب حوالي 7 أطنان من مخدر الشيرا

عناصر "البسيج" تطيح بخلية إرهابية خططت لاستهداف أمن المملكة

توقف البرنامج المعلوماتي لتعاضدية الموظفين في ظروف غامضة

هكذا رد أمزازي على أساتذة التعاقد بعد اختيارهم "التصعيد"

لفتيت يخضع مشروع التنمية البشرية لأكثر من 30 عملية افتحاص

مكتب الصرف يفتحص شركة مستشار ماكرون "بن علة"

النقابات تحشد لفاتح ماي ساخن ضد حكومة العثماني

رئيس جماعة من البيجيدي أمام القضاء

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 22 أبريل

المغاربة المقيمون بالخارج يحولون أزيد من 7 ملايير دولار إلى المغرب خلال العام الماضي

مصحات خاصة توقف طلبات تحمل الولادات نهائيا ردا على قرار "كنوبس"

بمساعدة "الديستي".. تفكيك شبكة إجرامية سطت على بنك بمدينة وارزازات
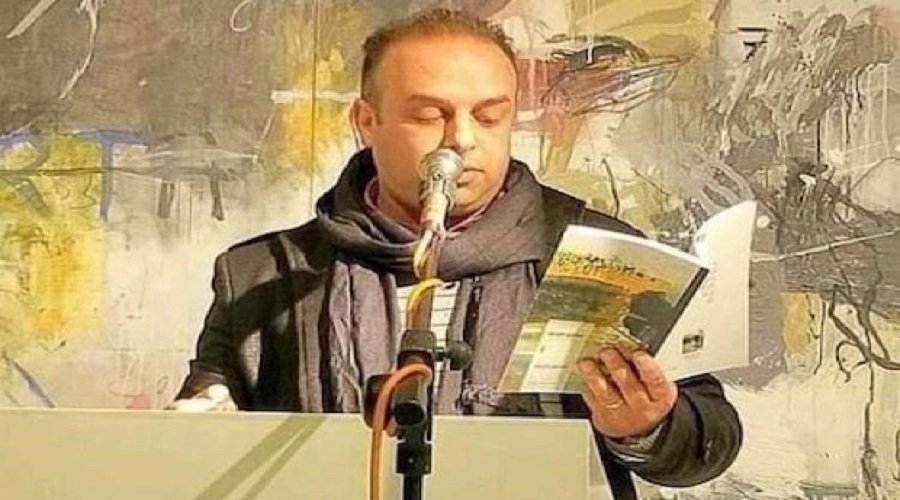
صعقة كهربائية تقتل شاعرا وهو يلقي كلمة في قاعة الندوات

شاهد.. متظاهرون جزائريون يطردون وزيرا سابقا من مسيرة بفرنسا

التعديل الدستوري يثير الرعب بـ"البيجيدي" لهذا السبب

سعدات اللي عندو جداتو فالعرس

غضبة ملكية تستنفر العثماني

الفرقة الوطنية للدرك تفتح الملفات السوداء بالهرهورة وتستمع لكبار الموظفين

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم السبت 20 أبريل

ارتفاع قوي للطلب الخارجي على المنتوجات التقليدية المغربية

ارتفاع رصيد الاحتياطات التقنية بأزيد من 11 بالمائة سنة 2018

أزيد من 300 طبيب يقدمون استقالة جماعية

توقيف قائد حاصره مزارعو الكيف والتحقيق مع مسؤول كبير

هكذا دشن المالكي ولايته بخرق القانون

الوداد - الرجاء.. لمن تقرع طبول "ديربي" مراكش ؟

شركة ستيام تطلق عروضا جديدة احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها

الدارالبيضاء: انطلاق الدورة الخامسة لاجتماع حول المعلومة المالية

سيام 2019: توافد آلاف الزوار على قطبي تربية المواشي والمنتوجات المحلية

ساكنة مارينا تحذر عمدة سلا من حريق جديد يهدد منازلهم بسبب المطاعم

اتفاقية بقيمة 500 ألف أورو لوضع خريطة مردودية الأنشطة الفلاحية والقروية

تسريبات تكشف اسم الفائز بـ "لالة العروسة" قبل بث حلقته النهائية

نشرة خاصة.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية عاصفية بهذه المناطق من المملكة

تفاصيل حجز وإتلاف 830 طنا من المنتجات الغذائية

التامك لمنظمة العفو الدولية : عزلة بوعشرين اختيارية والسجين يستفيد من جميع حقوقه أسوة بباقي النزلاء

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 19 أبريل

السودان: مظاهرات حاشدة أمام وزارة الدفاع للمطالبة بسلطة مدينة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح وتجديد رخص الصيد البحري ومدونة التجارة البحرية

نقابة حزبية تؤكد رفضها للعرض الحكومي وتدعو لمسيرة الأحد

اتفاق الحوار الاجتماعي في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء

أزيد من 300 طبيب يقدمون استقالتهم لوزارة الصحة

بسبب إعفاء مسؤول أمني من التفتيش.. الحموشي يطيح برئيس أمن مطار "العروي"

الشرطة الفرنسية تكشف سبب حريق كاتدرائية "نوتردام"

تفاصيل اعتقال رجل أعمال حاول إرشاء الدرك وتصويرهم

موظفون يشكون عمدة الرباط إلى الوالي اليعقوبي

ضغوطات تربك لجنة افتحاص البرلمان
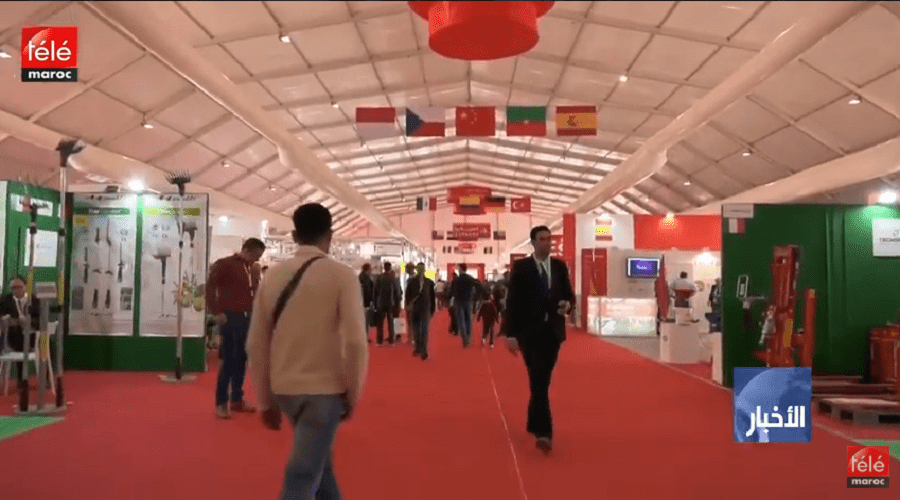
سويسرا تعتزم تقاسم تجربتها في مجال التنمية الفلاحية المستدامة مع المغرب

الملك يترأس جلسة عمل هامة بالرباط.. هذه تفاصيلها

سجين يضع حدا لحياته شنقا بالسجن المحلي بتطوان

استخراج جثة سيدة توفيت منذ أيام بعد سماع صوت أنين بالقرب من قبرها

بوريطة : المغرب تفاعل مع متدخلين دوليين في ملف الصحراء المغربية
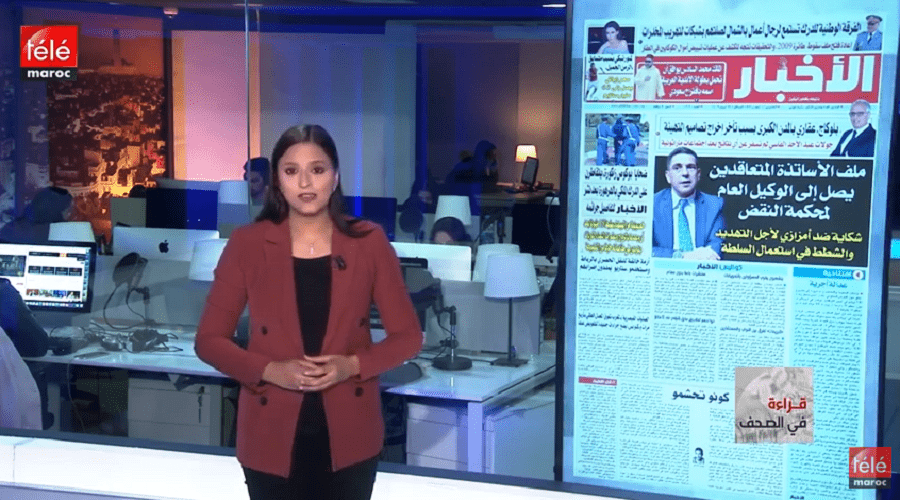
قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 18 أبريل

سكان "جزر عمرانية" بالدار البيضاء يشتكون العزلة وضعف المرافق

أخنوش: النهوض بالعالم القروي يتطلب مواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الفلاحة

طلبة كليات الطب والصيدلة يرفضون عرض الدكالي وأمزازي

CNOPS : اشتراط الإدلاء بتقرير طبي يعلل اللجوء إلى العملية القيصرية

التحقيق مع رجال أعمال بالشمال لصلتهم بشبكات لتهريب المخدرات

"البريمات" تفرق بين النواب والمستشارين

التحقيق مع وزير سابق بتهمة الترامي على 52 هكتارا

ملف الأساتذة المتعاقدين على طاولة الوكيل العام لمحكمة النقض

المعرض الدولي للفلاحة بمكناس: الدورة 14 تتميز بمشاركة دول من القارات الخمس وسويسرا ضيفة شرف

أزيد من 70 في المائة من المغاربة لا يثقون في مصلحة الضرائب

اتفاق نهائي للزيادة في الأجور

الصيادلة يرفضون بيع القرقوبي

الحكومة ستجبر المغاربة على دفع ضريبة عن الكوارث

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الأربعاء 17 أبريل

الداخلية تراقب الأسعار خلال رمضان وتتوعد "الغشاشين"

الصيادلة يهددون بوقف صرف أدوية الأمراض النفسية تخوفا من المتابعات القضائية

وزارة الداخلية: منع تداول المعلومات وتبادل المراسلات الرسمية التي تهم الوزارة عبر تطبيق الواتساب

تصريحات أمزازي تغضب الأساتذة المتعاقدين وتدفعهم لتمديد الإضراب

الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

تفاصيل الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على الأموال من حسابات بنكية دولية

ضحايا مقاولتي و"إفلوسي" يحذرون الشباب من برامج التشغيل الذاتي

عمدة البيضاء يواصل إغراق المدينة في الأزبال

نقل رجل أعمال إلى مصحة خاصة بعد خسارته الملايين بجلسة "قمار" بكازينو طنجة

مثول متهمين بقتل صحافي أمام استئنافية الرباط من جديد

هكذا استبعد العثماني زوجة حامي الدين

المغرب يحل ثانيا في هجرة الأدمغة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أسواق البيضاء تغير حلتها لاستقبال رمضان المبارك

الرميد يتهم بنكيران بالتشويش على قانون التعليم

بالفيديو.. لحظة القبض على شخص متلبسا بمحاولة سرقة وكالة بنكية بطنجة

الداخلية تمنع الواتساب

ولي العهد يعطي انطلاقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

الحكومة تقرر حذف ساعة خلال رمضان

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الثلاثاء 16 أبريل

أمزازي يؤكد أن مطلب الإدماج لن يتم أبدا

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال ترميم عدة مشاريع

"خيانة زوجية" في قضية مصرع قيادية بـ"البيجيدي" داخل شقة كراء

استئنافية البيضاء تؤيد الحكم بحل جمعية "جذور"

العزل والسجن في انتظار رؤساء جماعات بسبب قضايا فساد

السيزي يتهدد جماعة طنجة... عرضت ممتلكاتها للبيع ومع ذلك لا أمل

الملك محمد السادس يزور فاس ويتفقد مشاريع كلفت 583 مليون درهما

بنشماش يهدد بالاستقالة لمنع ترشح وهبي

سائقو الأجرة يعانون من منافسة التطبيقات الذكية ويتهمونها بالعمل خارج القانون

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الإثنين 15 أبريل

"الأستاذ المعجزة" قلبها غنى وخرج كليب

انقسام في صفوف تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين بخصوص تعليق الإضراب

هذه حقيقة عين الماء التي انفجرت بجبل أكادير "أوفلا"

غاز السيارات المسبب الرئيسي لـ"الضيقة" عند أطفال البيضاء

النيابة العامة تحجز 16 مليارا من شركة للتسويق الشبكي

دراسة: غازات السيارات السبب الرئيسي لأمراض الربو لدى أطفال الدار البيضاء

إضراب العمال يشل حركة النقل الحضري بالعاصمة

قضية الصحراء المغربية.. بوريطة يوجه رسالة مفتوحة لجنوب إفريقيا

حوادث نقل العاملات الفلاحيات تسائل يتيم وبوليف

الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين.. هكذا أنقذت الداخلية "الحوار الاجتماعي"

ضياع أرشيف بلدية آسفي واختفاء وثائق خاصة بالممتلكات العقارية

إلغاء صفقة 350 حافلة يزيد من معاناة البيضاويين مع النقل

حرب بسبب رئاسة اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية

هكذا تمرد نواب "البيجيدي" على العثماني

إضراب العمال يشل حركة النقل الحضري بالرباط

زوجة وزير "كاتصور" 400 مليون

أمزازي يفشل في حل أزمة المتعاقدين والأساتذة اتهموا الوزارة بـ"الابتزاز"

أبناء الوزراء والبرلمانيين مطلوبون للتجنيد

الحوار الاجتماعي يكلف خزينة الدولة 8.6 ملايير درهم

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى الرئيس التشادي

تلاميذ مغاربة يشاركون في مسابقة لتصميم المركبات الفضائية من تنظيم "ناسا"

هذا ما قضت به المحكمة في حق السويسري المتابع في جريمة "شمهروش"
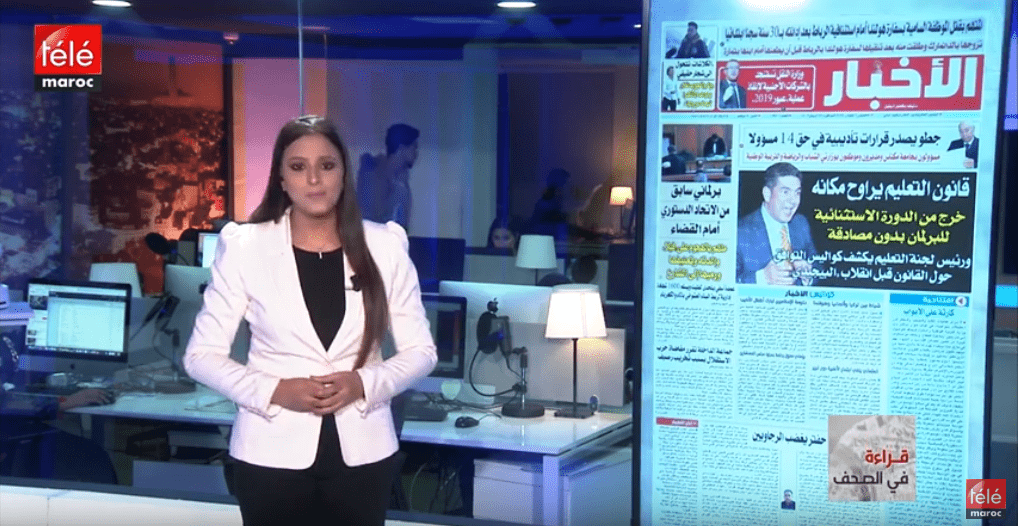
قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الجمعة 12 أبريل

الأساتذة المتعاقدون يتهمون أمزازي بالابتزاز ويقررون مواصلة الإضراب

العثماني يبرز أهمية مشروع "مدن مهن كفاءات" في إعداد الشباب للاندماج في سوق الشغل

رئيس الحكومة يؤكد قرب صدور "أخبار مفرحة" في الحوار الاجتماعي

عمدة آسفي يضع سيارة مصلحة فاخرة كلفت 35 مليونا مع المتلاشيات

شكاوى التحرش تحاصر رئيس "الكاف" أحمد أحمد

تفاصيل اعتقال عصابة اختطفت قاصرين مغاربة بإسبانيا وطلبت فديات من أهلهم

المجلس العسكري بالسودان: لا نطمع في السلطة والحكومة الجديدة ستكون "مدنية"
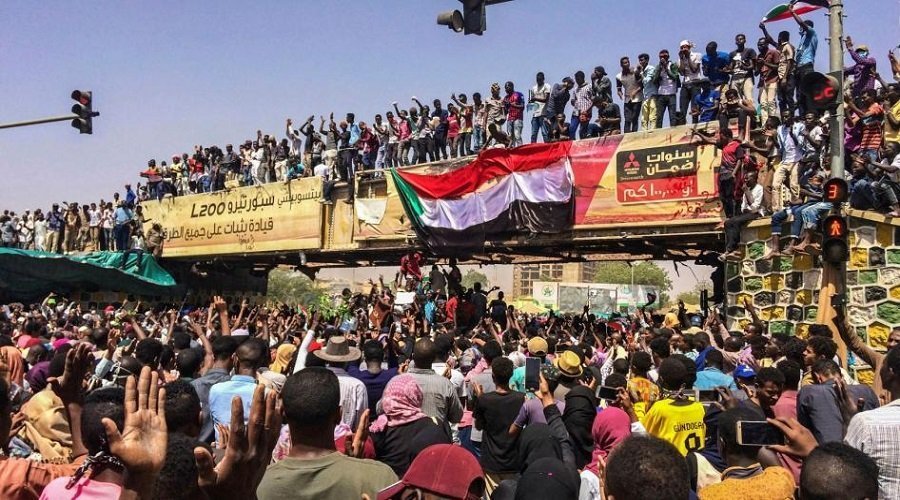
بعد الإطاحة بالبشير.. المجلس العسكري السوداني يلتقي بـ "القوى السياسية"

هكذا أنهى "البيجيدي" أحلام ماء العينين

انطلاق التصاميم الهندسية لأنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا

سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يتوعدون بالتصعيد بسبب تردي أوضاعهم المهنية

رسالة من الملك محمد السادس إلى سلطان عمان

توافق بين النقابات والحكومة حول الزيادة في الأجور

رئاسة النيابة العامة تكشف ضبط 73 عملية رشوة

"دونور" يفتح استثنائيا للوداد في حفل التتويج بالبطولة ونهائي عصبة الأبطال

مناورات عسكرية مغربية على مقربة من الحدود الجزائرية

11 مستشفى بالدارالبيضاء دون إدارة

وزارة النقل تستنجد بالشركات الأجنبية لإنقاذ عملية "عبور 2019"

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم

قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية ليوم الخميس 11 أبريل

قانون المساعدة على الانجاب يدخل حيز التنفيذ

المكتب الوطني للسكك الحديدية: تحقيق رقم معاملات بقيمة 4 ملايير درهم برسم سنة 2019
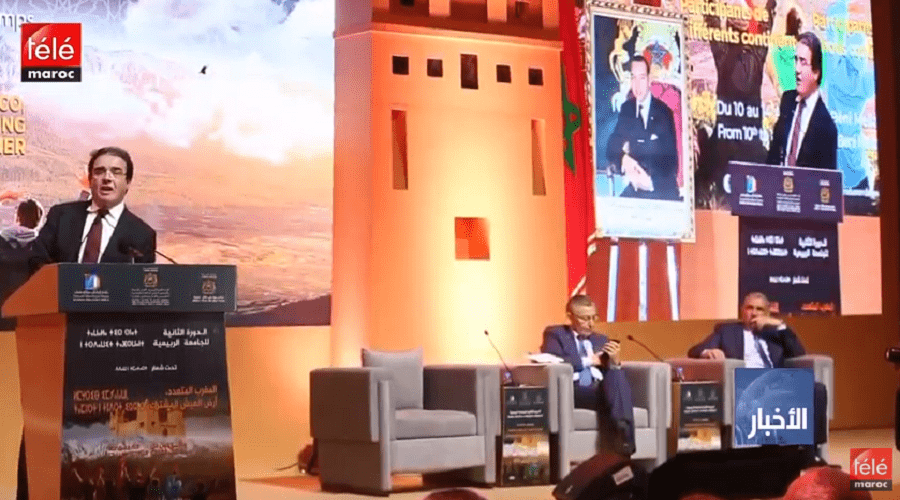
بنعتيق يفتتح الجامعة الربيعية الثانية لفائدة أبناء الجالية من إقليم أزيلال

ترحيل معتقلي أحداث الحسيمة إلى مؤسسات سجنية بشمال المملكة

عمدة آسفي يتحدى الداخلية ويسلم شهادات لربط البناء العشوائي بالماء والكهرباء

حكومة العثماني تصادق على قانون "أطفال الأنابيب"

عصابة تختطف رجل أعمال بالعرائش وتسلبه 60 مليونا

محاكمة برلماني سابق متهم بالهجوم على "فيلا" والدته وتعنيفها ورميها إلى الشارع

شباط ينقل كل أمواله إلى الأبناك الأوروبية

الحكومة تقترح على النقابات زيادة شاملة في الأجور

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى ملك البحرين

أكثر من 80 في المائة من الأسر المغربية عاجزة عن الادخار

إصدار المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

سكان البرنوصي بالدار البيضاء يشتكون من الكلاب الضالة التي تجوب الشوارع

أمزازي يدعو الأساتذة المتعاقدين للالتحاق بالأقسام ويتعهد بوقف التدابير الزجرية

السجن في انتظار الفارين من التجنيد ومن يساعدهم

أبناء نافذين ورجال سلطة ضمن لوائح الخدمة العسكرية والداخلية تحذر أعوان السلطة من التلاعب

تَواصل الاشتباكات في ليبيا وجلسة طارئة لمجلس الأمن

أردوغان يطعن في نتائج الانتخابات بإسطنبول ويطالب بإلغائها

سكانير شراه وزير الصحة السابق الوردي بـ 6 ملاير خسر وخلا الناس بلا فحص

مجلس جطو يصدر قراراته في حق عشرات المسؤولين

عناصر "البسيج" تطيح بأربعة دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

سفيان البحري يحجب حساباته الخاصة بتتبع أنشطة العائلة الملكية

تجار سوق درب عمر بالدار البيضاء مستاؤون من تغيير موقع السوق

إصلاحات تعرفها شوارع البيضاء تتسبب في اختناقات مرورية وتغضب السائقين

هذه هي الخطوات الآي يجب اتباعها للراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

الفرنسيون والصينيون يتلقون "صعقة كهربائية" مؤلمة من الإسبان

مسيرة حاشدة للأساتذة المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية

تجار سوق درب عمر بالدار البيضاء مستاؤون من تغيير موقع السوق

الملك يهيب بالحكومة للإسراع في توفير الرعاية الصحية الأولية لكل المغاربة

حرب "البوطا" تندلع بين الحكومة والمهنيين

البرلمان الجزائري يختار خليفة بوتفليقة

"أكابس" تفتحص فواتير وحسابات تعاضدية الموظفين

لفتيت يستعين بجيش من المحامين لحماية الأراضي السلالية من "مافيا العقار"

الدراجات الثلاثية العجلات تعمق إشكالية النقل بالبيضاء

هام... ها كيفاش تعرف واش سميتك كاينة فلوائح الخدمة العسكرية ولا مكايناش

هذه حقيقة وفاة 5 رضع بمستشفى "السويسي" بالرباط

واردات المغرب من التبغ تتراجع إلى 236 مليون درهم

أطباء العيون يؤجلون إضرابات أبريل

الأساتذة المتعاقدون يتشبتون بالاحتجاج ويرفضون مقترحات أمزازي

وزير التعليم: "مايمكنش نقري ولادي في مدرسة عمومية ضعيفة"

الملك يهيب بالحكومة للإسراع في توفير الرعاية الصحية الأولية لكل المغاربة

الجيش السوداني يتصدى لهجوم قوات الأمن على المعتصمين

أساتذة "التعاقد" يرفضون الحوار مع أمزازي وينزلون للشارع من جديد

"بلوكاج" التشريع بالبرلمان.. هل ستسقط الحكومة بسبب التعليم؟

انقلاب شاحنة كانت تقل عاملات زراعيات ووقوع ضحايا

بالوثائق: أمزازي يفضح مغالطات الوزيرة السابقة بنخلدون

بوزنيقة تحتضن مهرجان الريح الأول بافريقيا احتفاء بالطبيعة

سعيد عويطة يتوعد بمقاضاة الجهات التي استغلت مرض والده النفسية للنيل منه

إصابة 16 شخصا جراء انفجار نجم عن تسرب للغاز وسط مدريد

الأحد أول أيام شعبان

استئناف البيضاء تؤيد الأحكام الابتدائية في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

سعد الدين العثماني يهدد بنكيران بالانسحاب

الحبيب المالكي ممنوع من السفر لهذا السبب

عويطة : با ماشي أب مثالي وتزوج على مي وجرا علينا من الدار وعمرني ما حسّيت بيه كأب

هذا هو رئيس الحكومة الذي سقط وتكسر تم نقله للمستشفى أمس

بالفيديو.. الرميد يستفز الأساتذة المتعاقدين والتنسيقية تتهمه بـ "التضليل"

العثور على جثة سائحة أمريكية ضواحي مراكش أياما بعد تحذير السفارة الأمريكية لرعاياها بالمغرب من هجمات إرهابية

المرضى النفسيون بالمغرب يعانون من غلاء حصص العلاج وثمن الدواء

توقف مشروع سكني بالمنصورية يخرج 1200 منخرطا بالودادية إلى الشارع

عاجل...القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقا في اتهامات فساد طالت صفقات عمومية

تيار الاستوزار يناصر تعدد اللغات

شركة بعيوي تفوز بصفقة تهييء ملتقى مدارة غاندي

توقف مشروع سكني بالمنصورية يخرج 1200 منخرطا بالودادية إلى الشارع

مخطط تسريع التنمية الصناعية يحدث 405 آلاف وظيفة بالمملكة

أمن طنجة يوقف 3 أشخاص بتهمة سرقة عيادات ومحلات تجارية

هذا ما قررته المحكمة في حق منفذ "الهجوم الإرهابي" بنيوزيلندا

بعد تحذير أمريكا لرعاياها من هجمات إرهابية بالممكة.. المغرب يرد

"صقور البيجيدي" يتوعدون بإقبار قانون التعليم

الملك يجتمع برئيس الحكومة ومستشاريه وأعضاء الحكومة لهذا السبب

أمزازي يحمّل "البيجيدي" مسؤولية عرقلة التوافق على قانون التعليم

ضغط الوداد يجبر السلطات على فتح ملعب محمد الخامس بشكل استثنائي

إضرابات قطاع التعليم تشعل سوق الساعات الإضافية

حريق ولد مينة يعيد النقاش حول ضرورة إعادة هيكلة الأسواق الكبرى بالبيضاء

أطباء القطاع الخاص يدخلون في إضراب وطني ويشلّون العيادات والمصحات

تأجيل التصويت على قانون التعليم للمرة الثالثة بسبب تراجع العدالة والتنمية

توقف أشغال تهيئة كورنيش آسفي وأزيد من ملياري سنتيم في مهب الريح

تسلل أثرياء الجزائر يستنفر الجيش المغربي على الحدود

بعد تنحي بوتفليقة.. الجزائريون يطالبون بإسقاط رموز النظام

هكذا يستعد مجلس البيضاء لاقتلاع درب عمر ودرب غلف

إحداث 23 شباكا مهنيا بكافة أنحاء المغرب للتبليغ عن حالات الغش

شاشة تفاعلية: زيادة ثانية في أسعار السجائر ابتداء من فاتح أبريل تكوي جيوب المدخنين

التصويت على قانون التعليم.. "قربلة" داخل البرلمان وتأجيل الحسم

إغلاق جلسة التصويت على قانون التعليم يثير "قربالة" بالبرلمان

بوتفليقة يوجه "رسالة الوداع" للشعب الجزائري

مواد مسرطنة بالمطرح الجديد للبيضاء

وزارة العدل تفتح تحقيقا حول طعون ضد مهندسين متهمين باختلاق وثائق

عمال النظافة يحتجون للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل
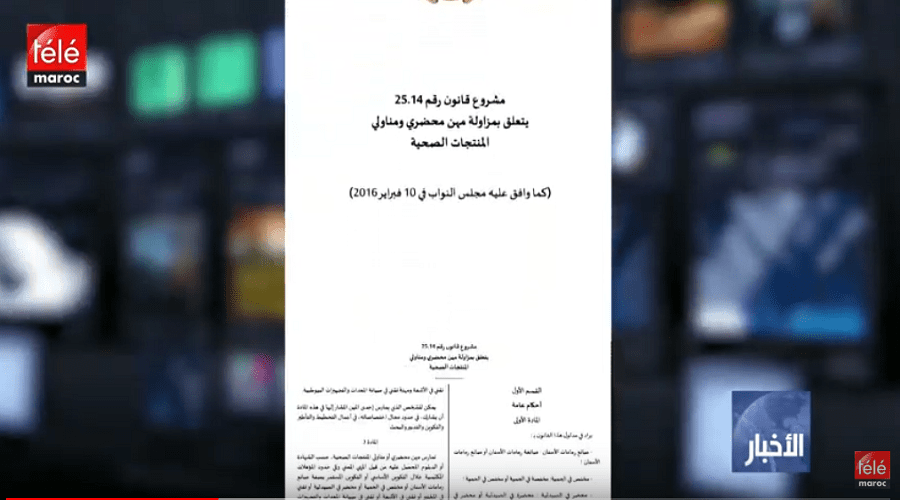
أطباء أسنان يطالبون بتسريع المصادقة على قانون يحمي المهنة

قرض جديد من البنك الدولي لحكومة العثماني بـ5 مليارات دولار

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بشاحنة

هكذا استنفر ألماني درك المطار بالبيضاء بسبب قنينة "كريموجين"

الفرقة الوطنية تدخل على خط اتهام رئيس اتحاد علماء المسلمين بالإشراف على قتل أيت الجيد

بالصور.. قتلى في حادثة سير مروعة بين سيارة تقل عاملات فلاحيات وشاحنة

توقعات سلبية لمندوبية التخطيط بشأن أسعار اللحوم الحمراء ومردوية الحبوب والقطاني

ساجد يعرقل توقيع عقد برنامج بين الدولة و"لارام"

المكتب الشريف للفوسفاط يخطط لتحلية 40 مليون متر مكعب من مياه البحر في أفق 2021

بنشماش يفشل في توزيع مناصب مجلس النواب

الرجل القوي يغادر ثلاجة الحكومة

جطو يضع يديه على أموال جمعيات الوزارات

أطباء القطاع العام يصعدون ضد الحكومة ويتوعدون بشلّ المستشفيات

كلفة الفساد تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي

تهريب المخدرات يجر كولونيلات للقضاء

صفقة كلفت الملايين تتحول إلى متلاشيات بالرباط

تطور مثير: "البام" يلتحق ب"البيجيدي" ويعلن مقاطعة التصويت على قانون التعليم

رونار في مأزق ويلجأ إلى الخطة البديلة قبل "الكان"

إصلاح الوظيفة العمومية يثير مخاوف الموظفين وبن عبد القادر يؤكد ارتكازه على الكفاءة

أطباء القطاع العام ينخطرون في إضراب وطني يومي 29 و 30 أبريل

غوتيريس : حل نزاع الصحراء المغربية ممكن ويتطلب إرادة سياسية قوية

عاجل: "البيجيدي" ينسف اجتماع المصادقة على قانون التعليم بالبرلمان

صفقة بالملايير لتوفير 350 ألف طاولة تسائل الوزير السابق حصاد

"مليار سنتيم" تشعل أزمة بين الوداد والداخلية

هكذا أنقذت القوات المغربية والأمريكية ضحايا هجوم "نووي" بأكادير
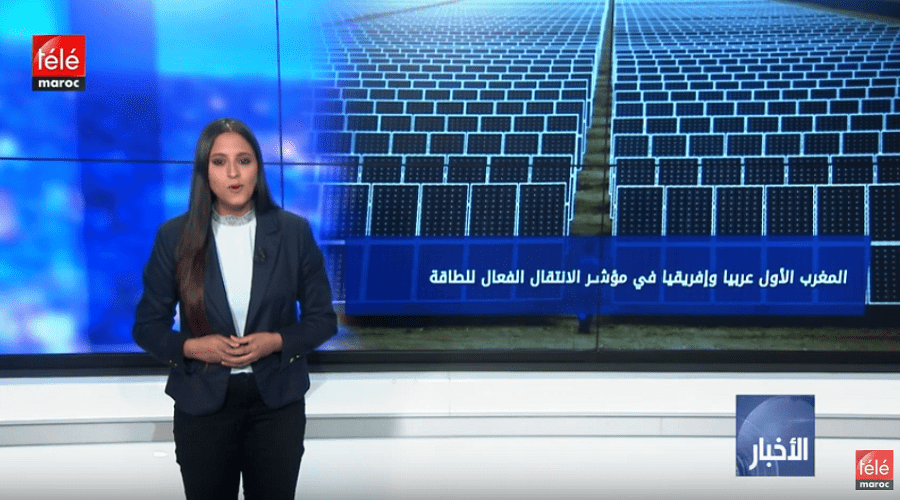
شاشة تفاعلية: المغرب الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر الانتقال الفعال للطاقة

فضيحة دولية تهز قطاع الصحة بالمغرب

هل يخرق العثماني تعهداته؟

برلمانيون يتوجسون من المتابعة القضائية

الأراضي السلالية تنتظر استثمارات ضخمة

الحموشي يزود الشرطة بأجهزة متطورة لقياس نسبة الكحول لدى السائقين

جنس جماعي بالناظور

خزينة الدولة تغرق في الديون

انطلاق عملية إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في هذا التاريخ

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن "نداء القدس" الذي وقعه الملك والبابا

تهريب أموال سعودية بالعملة الصعبة

عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة تنتظر المتورطين في تزوير عقود العقارات

تمليك الأراضي السلالية.. قوانين جديدة وتحذيرات من "مافيا" العقار

الشروع في إغلاق مدارس أمريكية بعد تعرض التلاميذ للنصب والاحتيال

الأساتذة المتعاقدون يقررون تمديد إضرابهم للأسبوع الخامس

القمة العربية تشيد بـ "نداء القدس" الذي وقعه الملك والبابا فرنسيس

هذا أول ضحايا "البام"

هكذا انقلب "البيجيدي" على تصويت بنكيران

حجز "سلاح " رشاش بحوزة برلماني مغربي

الانتخابات التركية.. حزب اردوغان يخسر أنقرة وإسطنبول لصالح المعارضة

بنكيران يدعو نواب حزبه إلى الإطاحة بحكومة العثماني

سباق "لاديفاران" يحتفي بالنساء المصابات بالسرطان ببوسكورة

البابا فرانسيس يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية للمملكة

أمير قطر يغادر القمة العربية بتونس احتجاجا على انتقاد تركيا

تزوير بملياري سنتيم

تفاصيل التحقيق في جريمة "لاكريم"

عرقلة الاستثمارات تورط ولاة وعمالا

تفاصيل القداس الكبير الذي حضره بابا الفاتيكان في ثاني يوم من زيارته للمغرب

توقيف إسباني بتطوان فر من السجن بعد إدانته بجرائم القتل ودخل المغرب بهوية مزورة

زيادة الهواتف لساعة تربك المغاربة من جديد

حاول استعطاف الملك.. تفاصيل اعتقال القاصر الذي اعترض الموكب الملكي

الملك محمد السادس يدعو إلى التعارف والتربية لمواجهة التطرف

الملك محمد السادس : التطرف الذي يعرفه العالم مرده إلى الجهل بالآخر والجهل عامة

بالصور.. الملك والبابا يلقيان خطابا أمام عشرات الآلاف بباحة مسجد حسان

محوراهتمام الحكومة هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية بما فيها صون مصلحة التلاميذ

الملك يهنئ نادي الرجاء الرياضي بمناسبة فوزه بالكأس الإفريقية الممتازة لكرة القدم لموسم 2019

عقوبات قاسية تنتظر قضاة ومحامين وموثقين وعدولا لهذا السبب

عبد المولى يحاصر الموظفين داخل التعاضدية

حرب اقتسام المناصب تندلع داخل "البام"

بنكيران غاضب من تنازل "البيجيدي" في التعليم

بنشماش يخرج عن صمته : الرميد هو أمر بمتابعة الصحافيين الأربعة

23 في المائة من الشباب المغاربة يرغبون في الهجرة إلى أوروبا وأمريكا

أشغال الجسر المعلق لسيدي معروف تشارف على نهايتها

وزير من أصول مغربية يستقيل من حكومة ماكرون

بعد موقف الملك محمد السادس وملك الأردن.. السعودية تعتبر الجولان "أرض سورية محتلة"

الخلفي يؤكد أن التوظيف الجهوي خيار لا تراجع عنه

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

تفاصيل تسبب صانع أسنان في مقتل طفل أثناء اقتلاع ضرسه

هذه هي الشوارع والمدارات التي سيمنع الوقوف فيها بالرباط خلال زيارة البابا

ضحايا "الزيوت المسمومة" يقررون الاعتصام أمام وزارة الاقتصاد

أمزازي يشهر الورقة الحمراء في وجه الأساتذة المتعاقدين

تفاصيل انتحار طبيبة نفسية فرنسية في الصويرة

ما حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض...العثماني يوقع على قرض جديد بـ 92 مليارا

الملك يوافق على تعيين مدير بالنيابة

رباح يواصل سباق التعيينات

تصريحات بنكيران بالتحرش تغضب العثماني

"الريجيم القاسي" يودي بحياة بطل كمال أجسام مغربي

المغرب والأردن يجددان دعمهما للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة

أطباء العيون ينتفضون ضد الدكالي

حملة لمقاطعة البيجيدي في 2021

الحموشي يطلق نظاما جديدا للترقية

قرار ترامب بشأن الجولان يترك واشنطن وحيدة في مجلس الأمن

عيوب تعري فضيحة ملعب طنجة

الداخلية تحقق في مصير 4000 مليار

تنسيقية الأساتذة المتدربين ترد على تهديدات أمزازي

النساء المغربيات لا توثقن مساهمتهن في تنمية الأسرة أثناء إقامة العلاقة الزوجية

عمال النظافة يخوضون إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء

العاهل الأردني يحل بالدار البيضاء في زيارة صداقة وعمل للمغرب

بعد الدعوة لعزل بوتفليقة.. الإعلام الجزائري ينفي انعقاد المجلس الدستوري

مجموعة بحث مغربية إسبانية تكتشف علاجا لسرطان البروستات

قانون التعليم.. توافق يسبق التصويت بالإجماع

طلبة الطب يدخلون في إضراب مفتوح

شركات توزيع المحروقات تنفي اتفاقها مع الوزير الداودي

شاشة تفاعلية: مراكش تتفوق على نيويورك ودبي في سلم أفضل الوجهات السياحية

هكذا يحرض الصمدي أساتذة "البيجيدي" على رؤساء الجامعات

الاكتضاض وتغيير المسار يغضب مستعملي الترامواي

بعد توقيف زيان.. المحامي شارية يواجه تهم التحريض

الأكادمية تعوض التعاقد بالتوظيف الجهوي وتتخذ إجرائات صارمة في حق المحتجين
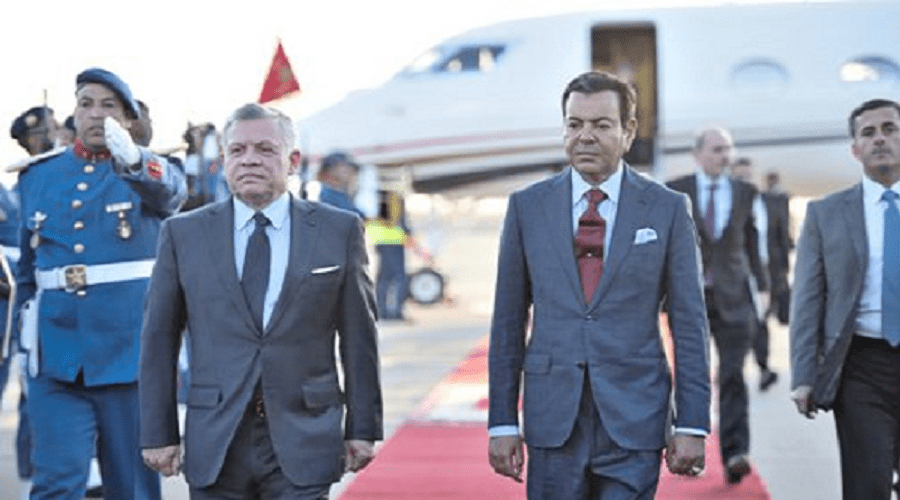
العاهل الأردني يحل بالدار البيضاء في زيارة صداقة وعمل للمغرب

مراكش تتفوق على نيويورك ودبي كأفضل الوجهات السياحية في العالم

أمزازي يهاجم تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ويتوعدهم بالعزل

صفقة استثنائية لتسليح الجيش

تسمم 81 طالبا من البيجيدي في الجديدة

بعد فشله في ثني النقابات عن الإضراب.. أمزازي يستعين بالمتدربين

المغرب الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر الانتقال الفعال للطاقة لهذه السنة

معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من افتقار مواقف السيارات لأماكن مخصصة لهم

إدانة المحامي زيان وتوقيفه لثلاثة أشهر

التحقيق مع شخص تسبب بمقتل فتاة تحت عجلات شاحنة بعدما تحرش بها

تفاصيل إدخال بوتفليقة إلى مستشفى جنيف بهوية مزورة

رئيس المجلس الإقليمي للصويرة يقتني سيارتين له ولكاتبته بـ80 مليونا

هكذا أنقذ لفتيت المناصب المالية لتلاميذ الوقاية المدنية

وأخيرا بنكيران يعترف بمصداقية ما نشرته الأخبار حول ماء العينين ويقول لها أنت في طريق خاطئ (فيديو)

الملك يترأس مجلسا وزاريا

"فيصل تراص" أول طبيب عربي يفوز بجائزة فينوس الدولية في طب الكلي

سائق قطار حادثة بوقنادل يستعد لمغادرة السجن

رئيس مجلس الأمة الجزائري يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس

تفاصيل إدانة المحامي زيان وتوقيفه لثلاثة أشهر

هذه رواية الداخلية حول ليلة فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالرباط

منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان

هذه هي العقوبة التي تواجه المصري الذي أحرق جثة مغربي بطنجة

المغرب يقلب موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي

التحقيق في تلاعب مصحات بأسعار الدواء

إجراءات مشددة لاستقبال البابا

السجن لمختلسي ملايير البنك الشعبي

التحقيق مع متهمين بتبييض الأموال في المحمدية

الشاي الصيني في قلب زوبعة صحية من جديد

البرلمان ينظر في تعديلات قانون منع "الميكا"

المغرب في المرتبة 92 عالميا في مؤشر تكلفة المعيشة والدار البيضاء على رأس القائمة

الأساتذة المتعاقدون يكملون شهرا من الإضراب والوزارة تستعين بالمتدربين

هكذا البطيخ المغربي يغزو إسبانيا ويتسبب في العطش

مفتشية الداخلية ومجلس الحسابات يُحاصران عمدة آسفي بتقرير أسود

إليسا تفتح النار على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وتصفه بـ "المحتل الوقح"

"أوبر" تستحوذ على منافستها "كريم" بـ 3.1 مليار دولار

مهنيو نقل البضائع يرفضون عرض اعمارة و يتوعدونه بالتصعيد

اجتماع النقابات مع أمزازي لم يسفر عن أي جديد و الأساتذة ينفدون إضرابهم

الاتحاد يمرر قانون الوظيفة العمومية المثير للجدل

غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

احتجاجات "المتعاقدين" تضع مليون تلميذ من العالم القروي في مهب الريح

أحكام قضائية في حق 2000 شخص من محتجي "السترات الصفراء" بفرنسا

ترامب يوقع رسميا على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

تجار مكناس يقاطعون لقاء العثماني

نشرة خاصة.. رياح قوية وأمواج خطيرة بهذه المناطق من المملكة

بركة يساند المتعاقدين ويهاجم حكومة العثماني

متولي يعود إلى أحضان الرجاء

الداودي يرمي كرة تسقيف ارباح المحروقات إلى العثماني

تأخر أشغال حديقة الجامعة العربية يثير استياء بيضاويين و مطالب بتعجيل الأشغال

تأجيل إصلاح الوظيفة العمومية بسبب تعالي الأصوات الرافضة له

عبد الوافي لفتيت يجمع النقابات غدا للحسم في موضوع الزيادة في الأجور

بنكيران يهاجم الأساتذة والعثماني يفرق اعتصام المتعاقدين بالقوة

تصريحات متضاربة وخلافات تعصف بالحزب الرئاسي في الجزائر

عمدة يصف معطلا بـ"الحمار" أمام وزير

مجلس البيضاء يغير أسطول سيارات الأعضاء والمنتخبين بأربعة ملايير سنتيم

بالفيديو.. بنكيران يتحول إلى "حلايقي" في جامع لفنا

تفاصيل اجتماع وزاري مصغر لمواجهة أساتذة التعاقد

تجار وباعة جائلون يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية أمام مستشفيات الرباط

"الهوليود سمايل" تقنية جديدة لتجميل الأسنان تعرف إقبالا من طرف المغاربة

مجلس المدينة يتجاهل الأسوار الآيلة للسقوط و مخاوف من انهيارها

الأساتذة المتعاقدون يردون على تدخل الأمن لفض اعتصامهم أمام البرلمان

الثالثة ثابتة.. الزواج الثالث في حياة مشاهير السياسة والفن والرياضة والدين

قصف صاروخي يسقط جرحى إسرائيليين

الداخلية تراقب الصيادلة

تأجيل إصلاح الوظيفة العمومية

الحكومة تلوح باستيراد اللحوم الحمراء

الحموشي يحارب تزوير المحاضر

ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشواهد

ميسي يغيب رسميا عن ودية المغرب والأرجنتين بطنجة

شرطي يطلق النار لإيقاف شجار بالسلاح الأبيض في ساحة جامع الفنا بمراكش

الغزاة الحقيقيون 2.2

هكذا ستتحول وزارة العدل إلى مستشار قانوني

الداخلية تحدث موقعا للتجنيد الإجباري

افتتاح المنتدى المغربي البلجيكي وبنعتيق يعتبره فرصة لنقل خبرة المغاربة إلى وطنهم

الغزاة الحقيقيون 2.1

الداودي يطمئن حول تموين الأسواق ويؤكد أن المواد الغذائية متوفرة بكمية كافية

التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات "يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه

فضيحة تهز وزارة الصحة بعد صدور مرسوم التكافؤ الحيوي للأدوية

عمال النظافة يهددون بإغراق أحياء البيضاء في الأزبال

إدانة رئيس جماعة عن "البيجيدي" سلم رشوة داخل حانة بالقنيطرة

فضيحة جديدة.. هكذا يعرض "فيسبوك" ملايين الحسابات للاختراق

تشييع ضحايا نيوزيلندا بحضور رئيسة الوزراء

الصمدي يعاكس الإرادة الملكية

رباح يؤسس شبكة إعلامية لتلميع صورته

منع تلاميذ يرتدون أقمصة الرجاء من ولوج ثانوية يخلق ضجة

أزمور.. توقيف فرنسية متهمة بالقتل مبحوث عنها من طرف "الإنتربول"

بالفيديو.. برلماني في مريرت يستقبل نزار بركة بطلقات رصاص

قضية بن علا.. مجلس الشيوخ الفرنسي يحيل مقربين من ماكرون على النيابة العامة

انطلاق "مائدة مستديرة" ثانية بجنيف حول الصحراء المغربية
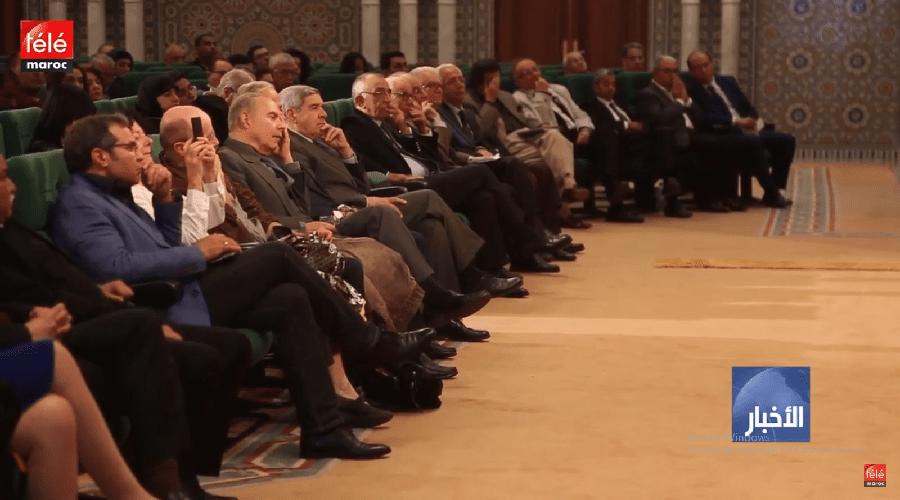
أكادمية المملكة تكرم عبد الكبير الخطيبي بحضور أدونيس

السجن لعمدة وجدة ورئيس جهة الشرق بسبب اختلاسات رصدها مجلس جطو

الأكاديميات تقرر تحويل أجور "فوج 2016" و المتعاقدون يتهمون الوزارة بالابتزاز

تفاصيل العثور على مخزن لأسلحة نارية و87 خرطوشة بآسفي
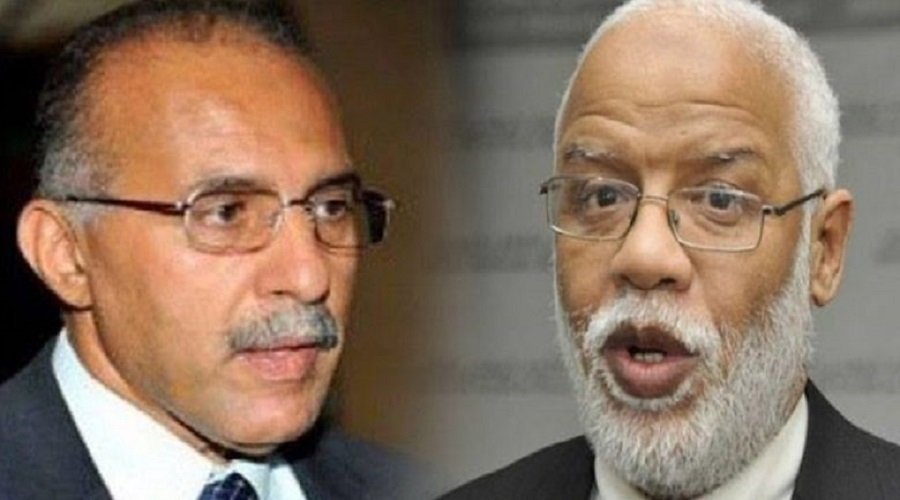
شركات "مستوطنة" داخل تعاضدية الموظفين

البحث عن رجل أعمال حاول تهريب 3.5 أطنان من المخدرات إلى فرنسا

أثمنة خاصة لرحلات "البراق" بمناسبة مباراة الأسود والأرجنتين

فرنسي يجري عمليات تجميل غير قانونية داخل رياضات مراكش

استقالة نقابة للتعليم العالي احتجاجا على موخاريق

المغرب غاضب من المقررين الدوليين

الدرك يدخل على الخط في خروقات الهرهورة

ماكرون يستعين بالجيش لمواجهة محتجي "السترات الصفراء"

شح التساقطات المطرية يثير قلق الفلاحين بجهة سطات

سلطات تيزنيت تكشف عن تدابير جديدة لتدبير النشاط الرعوي بالإقليم

الرباط و الدار البيضاء ضمن المدن الأفضل عربيا على مستوى جودة الحياة و المعيشة

رجال الحموشي يطيحون بعناصر يشتبه في ارتباطها بداعش بسيدي سليمان وتيزنيت

المجمع الشريف للفوسفاط يحقق أرباحا بلغت 5.4 ملايير درهم

السجن لعمدة وجدة ورئيس جهة الشرق بسبب اختلاسات رصدها مجلس جطو

مفاجآت في لائحة "الأسود" النهائية لمواجهة مالاوي

إذا كنت مسافرا إلى أوربا وتريد أخذ 10 مليون معك عليك قراءة هذا المقال

الداخلية تدخل على خط التصعيد بين أمزازي والأساتذة

المالكي يكشف أسباب منع الوفد الإيراني

المكفوفون يشكون حكومة العثماني للأمم المتحدة

أصوات غريبة تحت الأرض بدوار في أزيلال

ائتلاف وطني للدفاع عن التعليم العمومي يدعو لمسيرة وطنية
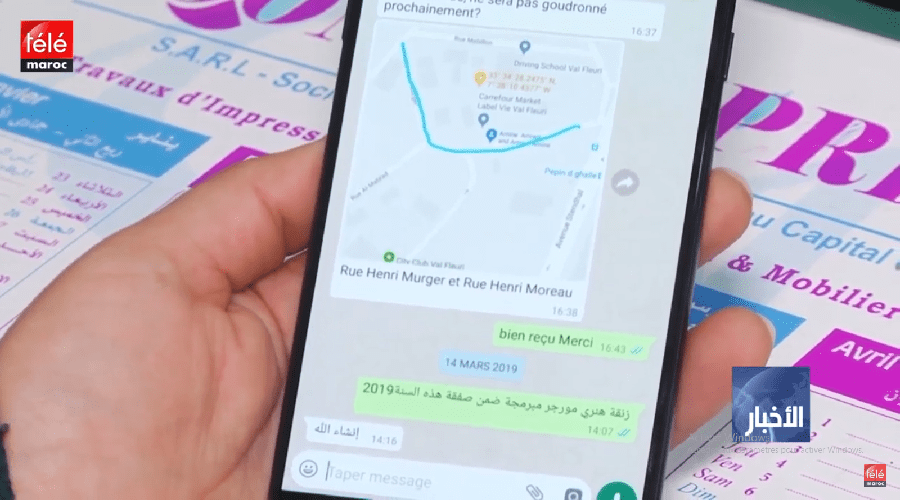
الاستماع عبر "الواتساب" خدمة جديدة أطلقتها مقاطعة المعاريف لتقريب الإدارة من المواطن

الوالي أحميدوش يوقف شركتي النظافة بالمدينة ويضع دفتر التحملات تحت المجهر
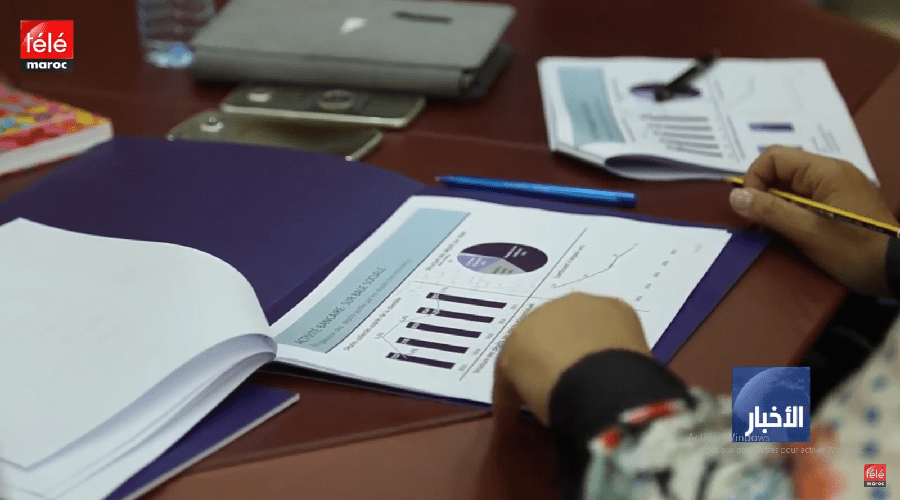
الجواهري: حصيلة المرحلة الأولى من إصلاح الصرف "إيجابية"

تفاصيل الإطاحة بـ 4 دواعش في تيزنيت خططوا لاستهداف أمن المملكة

أمزازي يشهر ورقة الطرد في وجه المتعاقدين

غموض في صفقة 130 سيارة إسعاف تسلمها الدكالي

مباراة توظيف داخل مجلس المستشارين تثير الشكوك

أستراليا تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات أردوغان

لفتيت يصفي تركة إدريس البصري

منصة "دابا دوك" تطلق خدمة الاستشارة الطبية عبر الفيديو

شيخ يفارق الحياة بآسفي وهو ساجد في المسجد الذي واظب على الصلاة به

متهربون من الضرائب في صفقات عمومية

خروقات في استثمارات عقارية للدولة

رحلات جوية بين المغرب وفرنسا بـ86 درهما !!

الداخلية تعزل أول رئيس جماعة بورزازات

الأساتذة المتعاقدون يواصلون الاحتجاج والوزارة تباشر تعويض الأساتذة المتغيبين

هذا سعر الكيلو غرام من اللحم خلال رمضان

بعد الخروج من اللائحة السوداء.. استنفار لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأجيل محاكمة حامي الدين إلى هذا التاريخ

عمدة مراكش يبيع ممتلكات المدينة في المزادات العلنية

أمزازي يخيّر الأساتذة المضربين بين العودة للأقسام أو "العقاب الإداري"

السلطات الهولندية تكشف معطيات جديدة عن منفذ هجوم أوتريخت

بوليميك سياسي يؤخر الاتفاق مع أوربا

ترقيم المغاربة ما زال في ثلاجة الحكومة
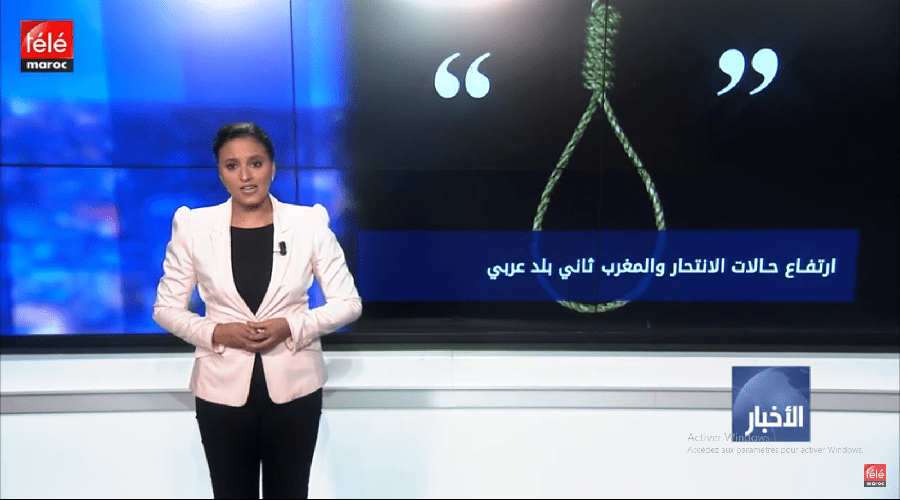
ارتفاع عدد حالات الانتحار في المغرب سنة 2018 ليحتل المرتبة الثانية عربيا

الخلفي : لا سنة بيضاء هذا الموسم

الدرك الأسفل من النفاق

هجوم نيوزيلندا.. "فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو ويتكبد خسائر فادحة

المحكمة الدستورية تحسم الجدل الذي أثير بشأن الساعة الإضافية

أطر الإدارة التربوية بالمملكة تطالب وزارة أمزازي بتنفيد ملفها المطلبي

الأساتذة المتعاقدون يصعدون في وجه الحكومة للأسبوع الثالث على التوالي
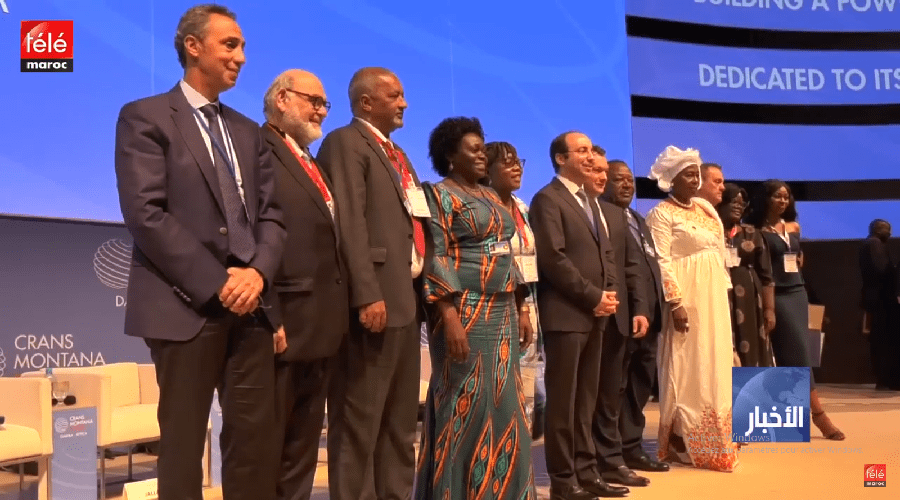
اختتام أشغال الدورة السنوية الخامسة لمنتدى كرانس مونتانا بتتويج 60 شابا إفريقيا

مشاهير في مصحات نفسية.. سياسيون وفنانون خضعوا لحصص علاج نفسي

التحقيق في إبادة 60 هكتارا من غابة تابعة لجماعة سلالية بالقنيطرة

77 قتيلا وعشرات المفقودين في فيضانات غزيرة بإندونيسيا

هكذا خرقت الحكومة الدستور بإضافة ساعة إلى التوقيت القانوني

لقاء للجمعيات و المنظمات الأفريقية الشبابية في إطار فعاليات منتدى كرانس مونتانا

تعيينات حكومية على السريع
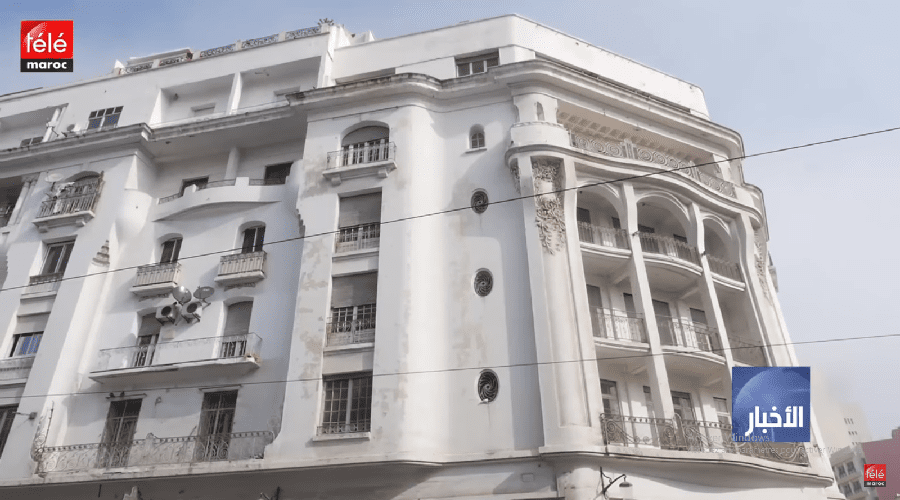
فعاليات مدينة الدارالبيضاء تدعو لإنقاد الإرث المعماري للمدينة من الإهمال

"البيجيدي" يطلق حملة انتخابية في العالم

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات و الداودي لازال يلوح بالتسقيف
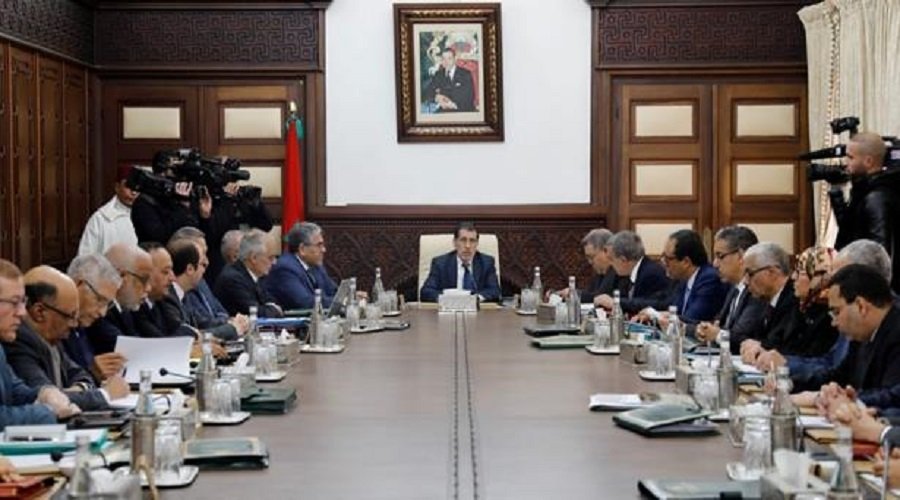
الحكومة تصادق على التعويضات عن الإرهاب

زووم: عنف الملاعب بالمغرب.. التأمين على الجماهير الرياضية بالمغرب بين النص و التطبيق

لفتيت يجتمع برؤساء الجهات لمناقشة هذه الملفات

المحكمة الدستورية تعيد نقاش الساعة الإضافية

النصب باسم الملك على "مولات المليار"

اعتقال شاب بسبب تدوينة "فيسبوكية" أشاد فيها بالاعتداء الإرهابي في نيوزيلند

الملك : الشباب الإفريقي في حاجة إلى العناية والتكوين وتنزيل حلول وجيهة

أكادميات وباحثات يقاربن تطور حقوق المرأة بالمغرب بالجامعة الدولية بالرباط

المغرب سجل انخفاضا ملحوظا في معدلات وفيات الأمهات و الأطفال

عبد النباوي يتعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون

لائحة تعيينات الملك تتسع

الغموض يلف إعفاء الدكالي لـ 31 مسؤولا

شاشة تفاعلية: 40% من المغاربة يعانون من أمراض نفسية وعقلية

تنظيم ورشة حول الشباب و تبادل الخبرات قبيل الافتتاح الرسمي لكرانس مونتانا

الملك محمد السادس يدين بشدة الاعتداء على مسجدين بنيوزيلاندا

الجامعة تشترط البطاقة الوطنية لاقتناء تذاكر مباراة المغرب والأرجنتين وهذه نقاط البيع

تقنية الكرة الشاملة تدخل المغرب لأول مرة بالمحمدية

خبرات كندية تدرب تلاميذ مغاربة لاجتياز امتحانات الباكالوريا

نقابات: 90 في المائة نسبة المشاركة في الإضراب العام بالتعليم

أمزازي يتخلى عن نظام التعاقد لإنقاد الموسم الدراسي من سنة بيضاء

ضمنهم وزير سابق.. إحالة ملفات مسؤولين كبار على جرائم الأموال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 100 موقع في غزة وسقوط ضحايا

السكال يرصد 700 مليون لمعارض التوجيه بدل تخصيصها لصيانة المؤسسات التعليمية

السفارة المغربية : لا وجود لمغاربة ضمن ضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي

حرب التعاقد تشتعل داخل مجلس النواب

العثماني يفوض للرميد لجنة الحصول على المعلومة

ضغط أوروبي على حكومة العثماني لعقد دورة استثنائية للبرلمان

المرقة بالبرقوق

سقوط رافعة ضخمة على سيارة وسط شارع بالقنيطرة
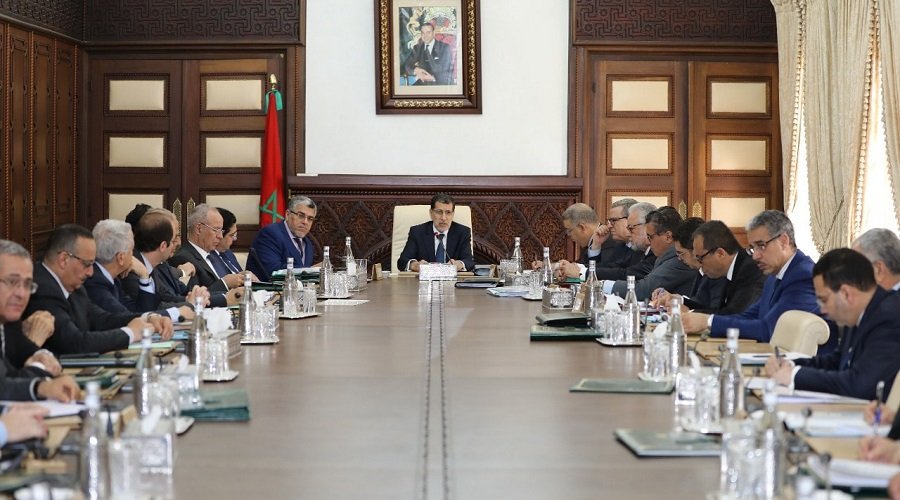
الحكومة تستعد لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية

القضاء الفرنسي يُبقي على تهم الاغتصاب في حق طارق رمضان

تطورات جديدة في قضية عصابة الفدية التي اختطفت ابن ثري بفاس

النصر يخصص طائرة خاصة لأمرابط تعيده إلى السعودية بعد ودية الأرجنتين

الفرقة الوطنية للدرك تفتح ملف فوزي بنعلال

مجلس الرباط يفشل في تنظيم قطاع بيع الدراجات النارية

مصرع شخص في انهيار سور مصنع مهجور ومحاصرة عمال تحت الأنقاض

باخرة "بانامية" جانحة بشاطئ طرفاية تهدد بكارثة بيئية

تقارير سوداء تهدد بعزل رؤساء مجالس جماعية

عامل آسفي في ورطة بعد ترخيصه ببناء مطاعم فوق كثبان رملية

"جونسون آند جونسون" تعوّض سيدة أمريكية بـ 29 مليون دولار

"بلوكاج" في تعيين 13 عميدا
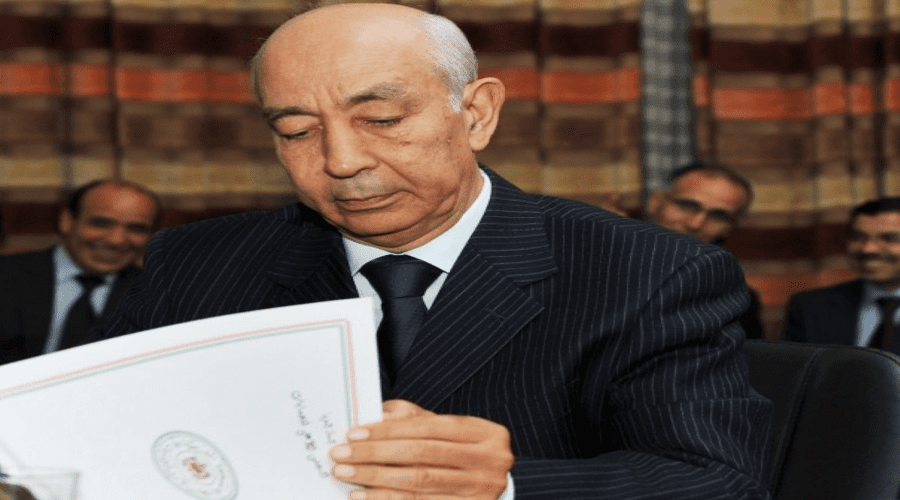
جطو ممنوع من رقابة ثروات مسؤولي البرلمان

هكذا تدخل العثماني لإنقاذ مديرته

بالصور.. وفاة عاملين تحت الأنقاض إثر انهيار حائط فوق ورش للبناء بالدار البيضاء

تفكيك خلية إرهابية واعتقال 6 دواعش خططوا لاستهداف أمن المملكة

بسبب "حملة المقاطعة".. هذه خسائر شركة "أولماس"

قطر تدخل سباق التنقيب عن البترول بالمغرب وتحصل على 30 في المائة من ترخيص طرفاية

"الفيفا" يدرس زيادة عدد المشاركين في مونديال قطر إلى 48 منتخبا

وزارة الحقاوي تتهم مكفوفين بالاعتداء على حارس وإرهاب موظفين

لهذا تراجع الرجاء عن خوض "ديربي الإمارات"

اعتقال لاعب دولي سابق بسبب حيازة "الكوكايين"

إنتاج المغاربة من النفايات سيصل إلى 37 مليون طن بحلول سنة 2030

أطباء يتهمون وزارة الصحة بتعريض حياة المغاربة للخطر

مجلس مدينة الدار البيضاء يرصد 600 مليون سنتيم لتدراسة مشروع تهيئة محطة ولاد زيان

أمزازي يستعجل الأكادميات لتعديل قانون "التعاقد" والنقابات تتوعد بالتصعيد

هام للحجاج المغاربة.. إطلاق المرحلة الثانية لاستخلاص الواجبات

ألوان "مثليي الجنس" في أدراج شارع بشفشاون تثير زوبعة

اختفاء 300 مليون من الاستثمارات بمسبح آسفي بعد تفويته بـ30 مليونا

مركز الكفاءات المناخية يغرق في الديون ويواجه دعاوى قضائية

النقابات تعلن عن إضراب عام سيشل المؤسسات التعليمية والمستشفيات

بنعزوز يغرق الطرق السيارة بالديون الخارجية

تعاون عسكري بين المغرب وكرواتيا

الحكومة تغير منظومة التعيينات

هكذا فضحت حادثة سير رئيس بلدية ميدلت من "البيجيدي"

536 موقعا الكترونيا يواجه الحجب والغرامات

إغلاق الحدود في وجه عمدة آسفي

أساتذة بإقليم برشيد يستنكرون تزايد حالات الاعتداء على الأطر التروبية

القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يدخل اليوم حيز التنفيذ

الجزائريون ينزلون للشارع رفضا لتمديد حكم بوتفليقة

انقلاب شاحنة عسكرية ضواحي أزيلال وإصابات في صفوف جنود

ابتداء من اليوم.. من حق المغاربة الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة

بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم في إطلاق النار بكلميم

مطالب بالتحقيق في مصير الملايين من مداخيل ملاعب القرب بالقنيطرة

احتقان غير مسبوق داخل المندوبية السامية للتخطيط

"البام" يتراجع عن قانون عدم معاقبة الصحافيين

المبادرة الوطنية تستنفر الوالي اليعقوبي

كلية الحقوق تستعد لاستقبال ولي العهد

هكذا ورط عبد المولى عامل أزيلال في تدشين غير قانوني

قتيل و11 مصابا في إطلاق نار بكلميم والأمن يوقف الجاني

اعتداء وحشي ودامي على الحكم الزايدي

التوظيف بـ"الكونترا ".. قنبلة اجتماعية موقوتة

تفاصيل جديدة في شبكة تجنيس الإسرائيليين

القضاء يحسم في ملف بنعبد الله و"قادمون"

جطو يدقق في جيوب رجال السلطة

رئيسة البرلمان الإماراتي في زيارة للمشاريع العقارية بالرباط وسلا ومدراء شركة "eagle hills" على فوهة مدفع
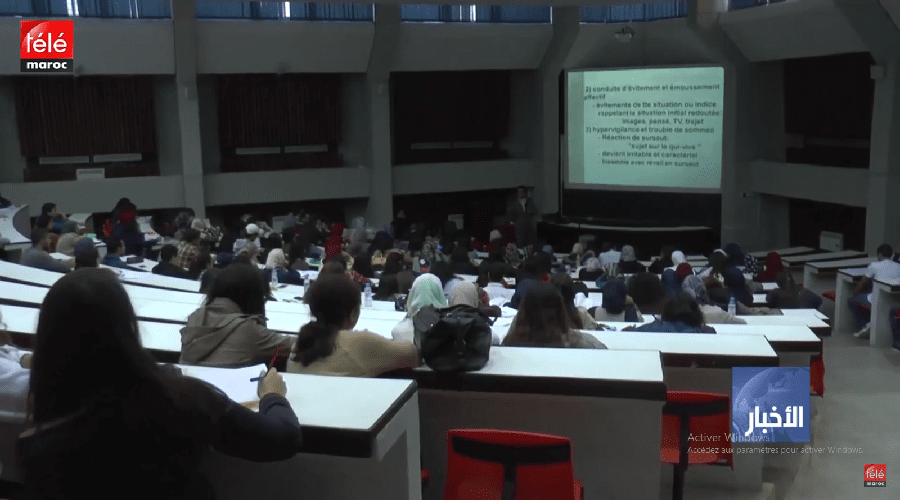
استياء شديد وسط طلبة الطب بسبب امتحان التخرج الذي فرضته الوزارة

خزينة الدولة تخسر 40 مليار درهم سنويا بسبب القطاع غير المهيكل

بطلة فيديوهات "بورنوغرافية" تسلم نفسها لأمن المضيق

شي تقاعد وشي تعاقد

بعد حادث تحطم طائرة إثيوبيا.. هل تعلق "لارام" العمل بطائرات بوينغ 737

هكذا نجا وزير عربي بأعجوبة من تحطم الطائرة الإثيوبية

واشنطن تهنئ المغرب على ترحيل مواطنين مغاربة من مناطق النزاع بسوريا

يعقوبي غاضب من جماعة جامع المعتصم

لفتيت يخضع 300 مليار للتنمية البشرية لـ100 عملية افتحاص

احتكار "البام" لجل الامتيازات يغضب أطر مجلس المستشارين

مغربيان ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المتحطمة

تفاصيل اختراق اسرائيلي للأجهزة

ارتفاع مرتقب للبطالة في 2019

عمال النظافة بالبيضاء ينتفضون في وجه العماري

الحموشي يأمر بالتحقيق في اتهامات خطيرة لمخبرين

في مديح التفاهة

متحول جنسيا يحمل وينجب طفله الأول

العثماني : طلبت من أمزازي الحوار مع النقابات التعليمية بحضور "الأساتذة المتعاقدين"

الملك يوافق على تعيين مدير CNSS

العثماني يضمن لخليع في اقتراض 250 مليارا

المغرب يشرع في تسويق غاز "تندرارة"

في خرجة جديدة.. بنكيران يهاجم بوعياش والكراوي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

المجلس الحكومي.. لا تراجع عن التوظيف بالتعاقد وسنراجع النظام الأساسي

حليمة ومجيدة سيدتان وراء مقود سيارة الأجرة

التلاعب بمشروع ملكي يجر عمدة آسفي للمتابعة بالتزوير وتبديد أموال عامة

لغراس يستعين بمتخصص في العشب مديرا

خروقات في تنزيل التصاميم تلاحق السلطات الإدارية والمنتخبة بسلا

الاستقلال يتجه للإطاحة برئيسه

لفتيت يكون رجال السلطة في مجال "الحكامة الإلكترونية"

المغرب يتصدر الترتيب كأفضل دولة عربية في المساواة بين الجنسين

أدوية فاسدة تحرك رئاسة الحكومة

فمك لحسو كلب – 2

تفاصيل التحقيق مع إرهابي خبير المفخخات

مرضى السل في الرباط بدون مستعجلات

"أونسا" تلقح أزيد من 2.5 مليون رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية

أمزازي يعد الأساتذة المتعاقدين بتعديل نظامهم الأساسي

قرصنة حسابات مقاولات بالملايير

نقابيو الاستقلال يهاجمون الحكومة ويتهمونها بإفشال الحوار الاجتماعي

صفقات الـ28 مليارا بمراكش ترفع عدد المستجوبين إلى أزيد من 30

برلماني من "البام" يبني مسجدا قبلته مقلوبة

زخات مطرية وتساقط ثلوج بهذه المناطق من المملكة

هكذا تحول اليازمي إلى شبح بمجلس الجالية

"البيجيدي" يعرقل دورة استثنائية

بنكيران يطلب التخفيف عن ماء العينين

22 شركة تتنافس على محاربة الفئران بمجلس النواب

أمزازي : التعاقد "خيار استراتيجي" وحكومة بنكيران هي من اعتمدته

أمن العيون يوقف 3 متورطين في سرقة وكالة تجارية للتأمينات

الحكومة تفرج عن نص ينهي الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية

تذمر البيضاويين من خدمات حافلات "نقل المدينة" في انتظار حافلات جديدة متم أكتوبر

مهنيو النقل الطرقي يعودون للإضراب الوطني

الكانوني يكشف حصيلة العمران في 2018

فمك لحسو كلب 1/2

مسؤولون من الحزب الحاكم يقفون ضد بوتفليقة ويدعون الشعب للتظاهر

الأمطار تعود للمملكة بهذه المناطق

السيدة التي تبرعت بمليار ونصف بأكاديمية البيضاء تنجو من عملية نصب خطيرة

تطورات مثيرة في فضيحة تبييض واختلاس 4 مليارات من إدارة الضرائب

المخابرات المغربية حذرت برلين من هجوم إرهابي.. وألمانيا تجاهلت التحذيرات فوقعت الكارثة

بنكيران منزعج من "جون أفريك"

حروب "البام" تفشل النموذج التنموي

السفريات والمصالح وراء تحكم "ويستمنستر" بمجلس بنشماش

التقدم والاشتراكية يعول على مناديبه في الصحة لدعم الحزب

المقاطعة تمنع دانون من توزيع أرباح على المساهمين
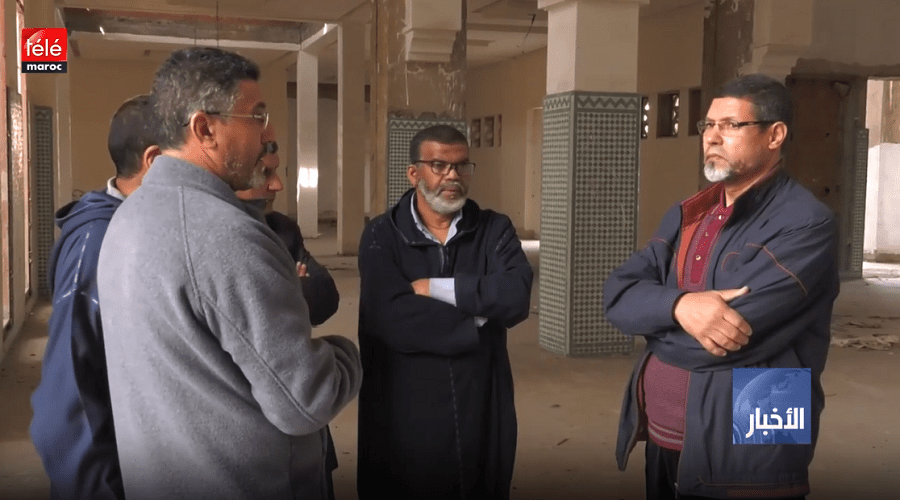
سكان يناشدون وزارة الأوقاف لإتمام أشغال بناء مسجد بعين السبع بعدما أصبح مرتعا للمتشردين

تفاصيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

هذا ما قضت به المحكمة في حق عصابة الذبيحة السرية ولحوم الكلاب

هذا برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب

تلاعبات في سكن الفقراء

اعتقال اربعيني متزوج من سيدتين بوثائق مزورة

توقيف مسؤول حزبي في الرباط لهذا السبب

أخنوش "عاطي النخال" لبنكيران

استياء في صفوف المغاربة بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات

ماريا بوطييا : إسبانيا ترتبط بعلاقات " متميزة " مع المغرب في المجال الأمني

السفير هلال يطلع كوتيريس وأعضاء مجلس الأمن على اعتماد اتفاق الصيد البحري

تفاصيل سقوط عصابة الإغراء الجنسي بواسطة الحسناوات لإسقاط ضحايا بتمارة

تسجيل ثاني حالة شفاء من داء "السيدا" في التاريخ

تهمة التزوير تلاحق مسؤولين كبارا بوزارة الأوقاف

الخلفي يعود للحملة الانتخابية بدائرته بسيدي بنور
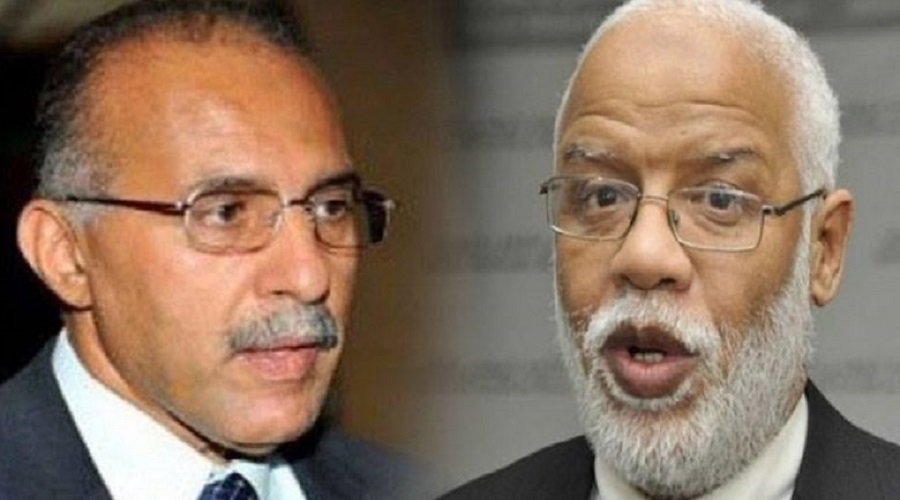
يتيم يفضح خروقات عبد المومني

اعتقال "مول الزريعة" الذي ضبطت عنده وثائق حساسة ووزارة رباح على صفيح ساخن

نشرتها جريدة "الأخبار".. رباح يفتح تحقيقا بشأن تسريب وثائق إدارية انتهت عند مول الزريعة

مجلس الاتحاد الأوروبي يصادق على قرار اتفاق الصيد البحري مع المغرب

الأطباء يحملون الشارة الحمراء و يستعدون لأسبوعين من الإضراب

الأساتذة المتعاقدون يخوضون إضراب وطنيا مرفوقا باعتصام لمدة ستة أيام

اعتقال موظف بالضريبة بسبب اختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم

بمساعدة "الديستي".. أمن فاس يطيح بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات

تهريب الأموال بفواتير تركية

الداودي يفشل في الوصول إلى توافق مع شركات المحروقات

تفاصيل تحويل قرية طبية عالمية إلى مشروع سياحي سكني بقيمة 250 مليارا

مسعودة هي السبب

الداودي لا يزال يلوح بالتسقيف وسط ارتفاع ملموس في أسعار البنزين

بنكيران يطالب الحكومة برفع سن تقاعد الموظفين إلى 65 سنة عوض 63

تصاميم بناء مزورة تجر 36 شخصا أمام الوكيل العام

العثور على وثائق ديبلوماسية حساسة عند "مول الزريعة" بسلا

نحن وبريطانيا.. أسرار غير مروية من زمن الحرب والسلم عن الرباط ولندن

رغم وعود بوتفليقة.. الاحتجاجات في الجزائر تتواصل

الحركة تعيد المغضوب عليهم إلى الواجهة

بنشماش يستعطف "ويست منيستر" للبقاء

وزراء يتحايلون في مناصب التوظيف

سوق الطاقة النظيفة في المغرب تجذب المستثمرين وتعزز حضوره دوليا

نتا اللي جا معاك التفاؤل

55 ألف أستاذ يخوضون إضرابا وطنيا لمدة ستة أيام ويعتصمون في مختلف الأكاديميات

حجز 875 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع

دراسة لمعهد الجزيرة للدراسات تؤكد أن عمود «شوف تشوف» كان وراء رفع نسبة مبيعات وقراء ثلاث جرائد منذ 2003 وإلى اليوم

النصب بشركات وهمية

تحويلات مشبوهة في "كازا بارك"

شروط جديدة لمِنَح الطلبة

جثة أمام البرلمان تستنفر أمن الرباط

أخنوش يطلق مشاريع فلاحية وأخرى لفك العزلة عن دواوير قروية بإقليم تيزنيت

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تتضامن مع احتجاجات طلاب الطب ضد خصخصة القطاع

توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات

مع استمرار جدل التسقيف تغير جديد في أسعار المحروقات يزعج المستهلكين

إغلاق مطرح مديونة وإنشاء بديل مراقب يستجيب للمعايير الدولية

أوجار يفتح معهد القضاة أمام مدراء الشركات

العثماني يعلق التعيينات للمرة الثانية

بوعياش تستعين بصديق اليوسفي

مخالفات مهنية تعصف بمسؤولين أمنيين

كحلوش يتسبب للقناة الأولى في إنذار

المعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية فرصة لتنمية الطاقات المتجددة

بعد إعلان أمريكا مكافأة للقبض عليه.. السعودية تسقط الجنسية عن نجل بن لادن

التحقيق مع شخصين لتورطهما في اختلاس 39 مليون درهم

الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

رسالة إلى العنوان الغلط

تلقيح أزيد من 5,2 مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية إلى حدود 28 فبراير
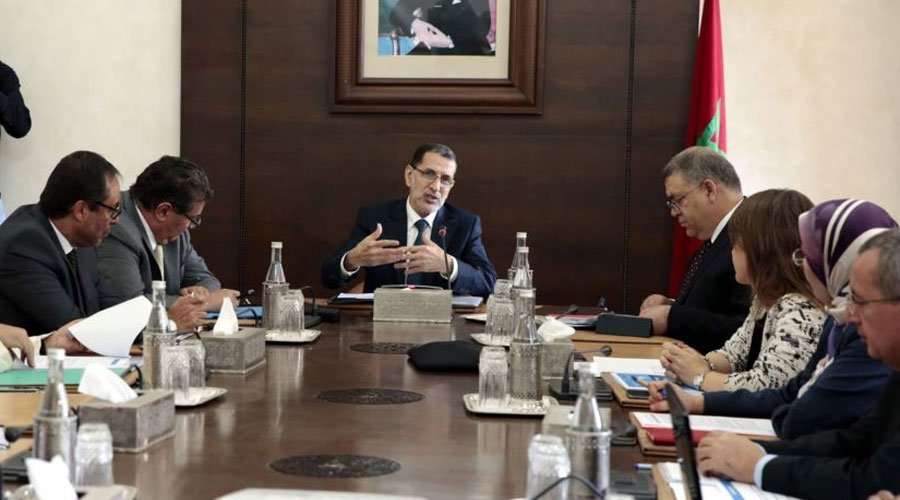
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية

وزارة الشباب والرياضة تكشف آخر الاستعدادات لاحتضان المغرب دورة الألعاب الأفريقية

الولايات المتحدة تعرض مكافأة بمليون دولار للقبض على نجل بن لادن

العاطلون في المغرب يحطمون رقم المليون و100 ألف

المغرب وإسبانيا ومحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر

العثماني متخوف من الدفاع عن التعاقد

لجنة التعليم تتلكأ

قيادي بـ"البيجيدي" يرفض تسليم وثائق للجنة برلمانية

"أونسا" يعوض الفلاحين عن إتلاف 400 رأس من الأبقار و1559 رأسا من الأغنام والماعز

الحكومة تحدد السن الأقصى لاستحقاق المنح الجامعية للطلبة

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني

رئيس الحكومة يحث الوزراء والإدارة على الاهتمام بانتظارات المقاولين والمستثمرين

حرب التعيينات تستعر من جديد في التعاون الوطني

صحفيو التلفزيون الحكومي الجزائري ينضمون للمحتجين ضد العهدة الخامسة

المكفوفون المعطلون يهددون بتنفيذ انتحار جماعي خلال الأيام المقبلة

ضابط شرطة يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة

لفتيت يؤكد أن المجال القروي يعاني من مجموعة من الاختلالات

إحالة عمدة مراكش السابق الجزولي على الجنايات بسبب تبديد الملايير

مديرية الحموشي تكشف حقيقة اختطاف فتاة إيطالية واغتصابها

المكفوفون يصعدون ضد الحقاوي ويهددون بانتحار جماعي

الدكالي يوزع مناصب المسؤولية على أعضاء حزبه

نائب عمدة مراكش يحطم رقم الغيابات

شبهات حول رئيس وكالة محو الأمية

بنعبد القادر يتلكأ في ترقية موظفيه

صحفيو التلفزيون الحكومي الجزائري ينضمون للمحتجين ضد العهدة الخامسة

امرأة تنجب توأما عن عمر 61 عاما

المغاربة يثقون أكثر في "الكاش" تزايد أداء الفواتير عبر الأنترنيت
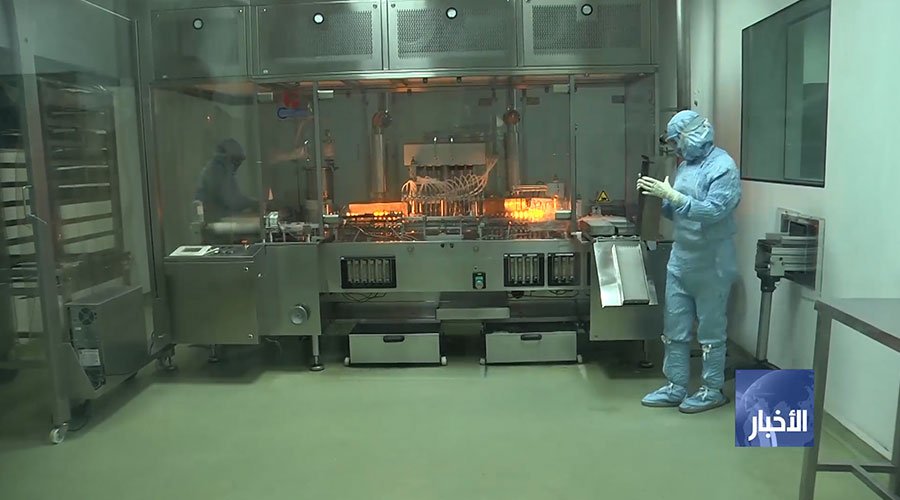
قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يصدر بالجريدة الرسمية

تبييض أموال بالتأمينات

الشوباني يخصص نصف مليار لدعم مهرجان في أفقر جهات المغرب

لجنة حكومة لمناقشة ملف المتعاقدين

معاناة البيضاويين مع الازدحام في أوقات الذروة والاختناقات المرورية

الأمير مولاي رشيد يستقبل مبعوثا من الرئيس الموريتاني حاملا رسالة إلى الملك

فضائح بمعاهد السياحة

بالفيديو.. لحظة الاصطدام والانفجار في محطة مصر

بعد طرحه للبيع في المغرب.. "ديكاتلون" تتراجع عن تسويق الحجاب الرياضي في فرنسا

طارق رمضان يقاضي متهماته... قال إنه عاشرهن جنسيا برضاهُن
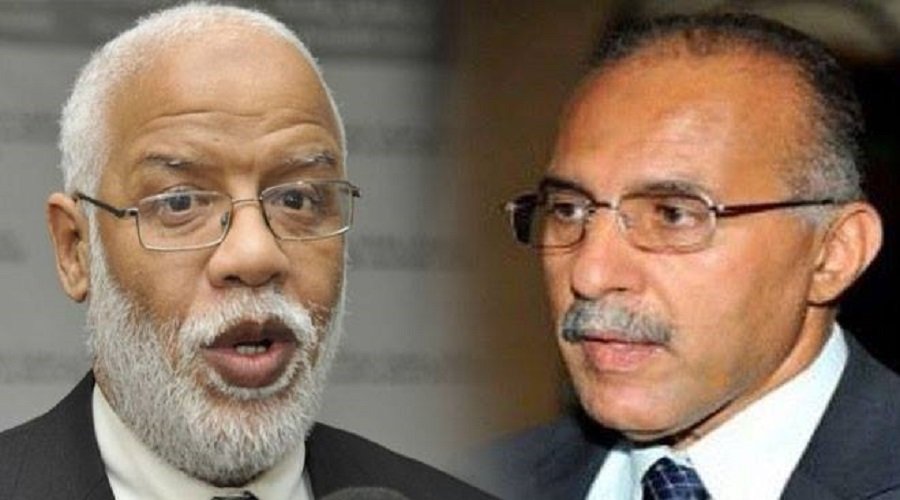
يتيم يصفع عبد المولى ويلغي حملات طبية غير قانونية

خيانة زوجية تنتهي بسقوط العاشق من الطابق الثاني فرارا من سكين الزوج

الشوباني ينشر الفوضى وسط مهنيي السينما

انطلاق مزاد بيع مؤسسات الدولة

قانون جديد لضحايا الألغام

المارة والتجار بساحة ماريشال يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة من ممر تحت أرضي

بالصور.. أخنوش يشرف على تسليم محركات مراكب الصيد التقليدي لعدد من البحارة بتغازوت

"سراقين الضو" يفوتون على الدولة 43 مليار سنتيم

اسبانيا ترفع طول السياج الحدودي لسبتة إلى 10 أمتار

قضية أيت الجيد تجر أربع "بيجيديين" للمحكمة

هذه تفاصيل محاكمة المتهمين في جريمة مقهى "لاكريم"

الدوادي يكشف موعد رفع الدعم عن البوطا

دفاع ضحايا بوعشرين ينتقد تقرير الأمم المتحدة ويؤكد فقدان فريقه الأهلية

حبر على ورق

"الأخطاء" تكلف البيضاء 6 ملايير سنتيم سنويا

التحقيق في مكونات السجائر السويسرية السامة

الفايسبوك متهم بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة

تعميق التحقيق مع نافدين في فضيحة "كازا بارك"

مدير المصالح الجماعية بآسفي يصرف أموالا عامة لمستشاري "البيجيدي"

الداودي يكشف عن الموعد المتوقع لرفع الحكومة للدعم المخصص لمادة البوتان

الملك يقيم حفل شاي على شرف الأمير هاري وعقيلته

شركات تحتكر صفقات بالملايير بوزارة الصحة

إدانة مديرة دار للثقافة وشقيقها وصهرها بالحبس وتعويض الضحايا بمليار

محكمة أسترالية تدين وزير اقتصاد الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال

الشوباني يكلف مكتبا ألمانيا لإعداد البرنامج الجهوي

لفتيت يوافق على إعادة انتشار الباشوات والقياد

الخلفي يعتدي على اختصاصات وزير خارجية

مديرة المقاصة بين بنكيران والعثماني

فيديو.. الملك محمد السادس يستقبل الأمير هاري وعقيلته

ما الذي جعل وزير التجهيز والنقل عمارة ينفجر في وجه رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ؟
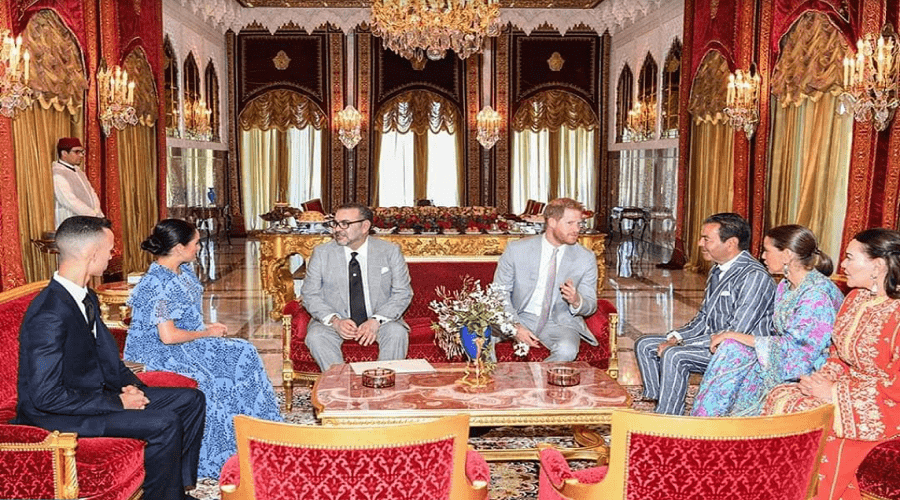
الملك يقيم حفل شاي على شرف الأمير هاري وعقيلته

بالفيديو.. حريق مهول يلتهم المركز التجاري "أسيما" بالبيضاء

رباطيون مستاؤون من تأخر مشاريع الرباط عاصمة الأنوار أمام صمت مسؤولين ومنتخبين

الملك يعلن تكفل المغرب بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل

الملك يدعو إلى "تفكير جدي وعميق" في مستقبل التعاون الأوروبي-العربي

الحموشي ينّوه بشرطي ويصرف له مكافأة مالية لهذا السبب

النقابات تتشبت بزيادة 600 درهم وتستنكر "السياسات التفقيرية للحكومة"

الأمير هاري وعقيلته ميغان يتذوقان "البريوات" و"البسطيلة"

لجنة الشفافية لحزب PJD تتستر حول مداولاتها بشأن ماء العينين

الأساتذة المتعاقدون يعلنون عن إضراب وطني في هذا التاريخ

أطباء العيون ينتفضون بسبب "حملة طبية"

القضاء البلجيكي يعطي الضوء الأخضر لترحيل "الأرملة السوداء" إلى المغرب

مواطنون يستقبلون الرميد بالاحتجاج في سطات

رجال أعمال ممنوعون من السفر بسبب عملية نصب

الملك : الأمن القومي العربي يجب أن يبقى شأنا عربيا وهناك دول تهدد أمن المنطقة

مطار محمد الخامس الدولي.. توقيف برازيليتين للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين

شرم الشيخ.. بدء أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ بمشاركة المغرب

الأمير هاري وعقيلته يقومان بزيارة لمؤسسات تابعة لجمعية "التعليم للجميع"

الامير هاري وعقيلته يلتقيان نساء مقاولات مغربيات ورياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة

الملك : القمة العربية - الأوروبية الأولى ستشكل لحظة قوية في مسار الحوار العربي الأوروبي

مشاهير مغاربة بدون قبور.. ارتبط موتهم بسياقات وظروف مختلفة وغامضة

قاضي التحقيق يودع رئيس جماعة من "البام" ومقاولين سجن عكاشة

"عصابة الفدية" تطيح بـ10 أشخاص ضمنهم 3 فتيات وصاحب وكر للدعارة

عامل آسفي يدشن مقهى

الحركة تستحوذ على التكوين المهني

بنشماش بدون رئيس ديوان

جدل الولاية الثالثة لمخاريق بـ"umt"

بالصور.. الأمير هاري وزوجته يزوران قرية أسني وميغان تنقش يدها بالحناء

المصحات الخاصة تلوح بوقف التعامل بملفات التغطية الصحية

90 مليار سنتيم لنظافة الدارالبيضاء

لفتيت يحذر الولاة من السياسة

الرئيس الإيفواري يستقبل ناصر بوريطة حاملا رسالة شفوية من الملك محمد السادس

البنية التحتية والزراعة والطاقة على رأس الاستثمارات الأوربية بالمغرب

إلغاء الرسوم على الأدوية المحددة في 0.25 في المائة من ثمن الدواء

متخصصون في تربية الأحياء المائية يدعون للاستفادة من التكنولوجيات من أجل تطوير القطاع

رادارات أمريكية متطورة تراقب سيارات المغاربة

تعيينات الدكالي لمندوبي الصحة تفجر الأغلبية الحكومية

حقائب ديبلوماسية لتهريب الأموال

قنبلة قرب مقر "ميدي1 تيفي" تستنفر درك طنجة

الأمير مولاي الحسن يستقبل الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل

الإحسان بنون النسوة.. مبادرات خيرية أحيت إرث أم البنين

التحقيق مع سيدة يشتبه تورطها في استعمال العنف وسوء المعاملة في حق طفل قاصر

بعد 30 سنة من سوء تدبير قطاع النقل الحضري الرباطيون ينتظرون الحافلات الجديدة

الأمير هاري وعقيلته ميجان ماركل يحلان اليوم بالمملكة

دراسة إسبانية..المغرب ضمن الأسواق الصاعدة للعام الحالي

أمزازي يصدر توجيهات بتكوين أساتذة العلوم باللغتين الفرنسية والإنجليزية

تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يناير 2019

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى

مندوبية التخطيط تعري واقع النقابات والحماية الاجتماعية للأجراء

تخفيض عقوبة "أبو البتول الذباح" التشادي إلى عشر سنوات

مجلس الحكومة بدون تعيينات

مجلس المستشارين يوظف أبناء موظفيه

كرة العنف التي تكبر

مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة ومحتجون يتوجهون إلى القصر الرئاسي

نهاية مارس الموعد النهائي لتوقيف المصحات الخاصة التعامل بالتغطية الصحية

الخلفي: ليس هناك أي اتفاق يسمح برسو السفن الإسبانية في الموانئ المغربية

الاحتفاظ بزوجين مشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تعريض فتاة قاصر للضرب والجرح

انتشار الأشغال في أحياء وشوارع وأزقة العاصمة وعدم انتهائها يزعج الرباطيين

معرض "أليوتيس".. المكتب الوطني للصيد يعزز سبل التعاون مع شركائه الفرنسيين

المصدرون المغاربة يدعون إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة

الموانئ المغربية حققت خلال سنة 2018 ارتفاعا في الرواج بلغت نسبته 1,9 في المائة

مجلس جطو ينتقد أداء الجماعات الترابية ويعتبرها معيقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الداخلية تكشف حقيقة الاتفاق مع إسبانيا لنقل المهاجرين إلى الموانئ المغربية

العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية بالرباط تروم المحافظة على الأمن والنظام

الخلفي : الحكومة منفتحة كل الملاحظات الكفيلة بتطوير النظام الخاص بأطر هيئة التدريس

16% من النشيطين يمارسون شغلا بلا أجر و59% من المستأجرين بلا عقود عمل

الخلفي : ليس هناك توتر في العلاقات مع السعودية والإمارات

بسبب تغيبه عن الجلسات جنايات مراكش تحضر رئيس بلدية بالقوة العمومية

280 رادارا جديدا بقيمة 27 مليون درهم لتكثيف مراقبة السرعة

القضاء يصفع رباح ويفضح تستر وزارته على "ريع" المقالع

اونسا يتواصل مع المغاربة بالأمازيغية

عمدة سابق يتهم أستاذا بالنصب عليه والاستيلاء على أزيد من 500 مليون

"استنطاق" وزير سابق مساهم في جريدة "أخبار الْيَوْمَ" حول قضية بوعشرين

"البيجيدي" يمرمد القانون

التوفيق يطلب الدعم من لفتيت لحماية المساجد

تفاصيل إيقاف شخص ينتسب للصحافة متلبسا في عملية ابتزاز

عودة الاحتقان إلى كليات الطب والطلبة يهددون بالتصعيد
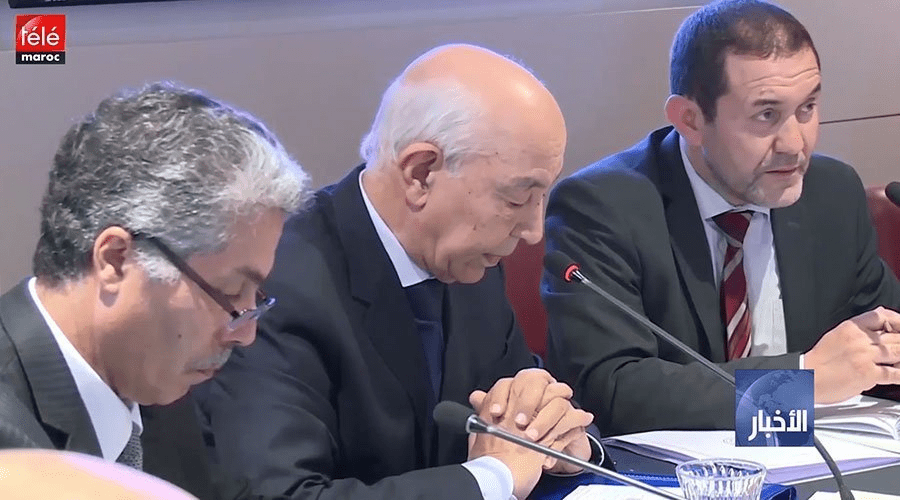
مجلس جطو يهاجم الحكومة ويفضح اختلالات تنزيل برنامج التنمية

اجتماعات عاصفة للدوادي بأرباب محطات المحروقات

الشامي يدعو إلى التعويض عن "الشوماج"

ملوثات خطيرة تصل إلى ميناء البيضاء

اتصالات المغرب تواكب التطور الرقمي في تشاد

الحكومة تصادق على مشروع دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

هجرة المهندسين تحير أمزازي

مواد خطيرة تدفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتعزيز مراقبة حفاظات الأطفال

الداودي يواصل اجتماعاته مع النفطيين و يؤكد أن التسقيف قرار لا رجعة فيه

أين اليسار؟

الأساتذة المتعاقدون يحتجون في مسيرة حاشدة بالرباط

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تغيير زي الشرطة

جطو يفجر فضيحة في وجه حكومة العثماني

فضيحة تعويضات فلكية تضع هيئة الأطباء في قفص الاتهام

صراع حول منصبي الكاتبين العامين بمجلسي النواب والمستشارين

ميارة يتخلص من مكتب نقابة الاستقلال بتعاضدية الموظفين

الحكومة تنزع 5000 هكتار من أصحابها

وزارة العلمي تراقب ليكوش

مجلس جطو يكشف وجود نواقص في تنفيذ خطة "التنمية المستدامة 2030"

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري "أليوتيس" بأكادير

6 وفيات جديدة بخيرية تيط مليل

"بركاسات" بالتيليكونود في الدارالبيضاء

اختلالات تراخيص الأدوية تفجر غضب المهنيين ضد الدكالي

قتل زوجته وأضرم النار في جثتها بأكادير

أوجار : الحكومة مندهشة من رأي فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص ملف بوعشرين

الفاو :"أكثر من مليون مغربي يعانون الجوع"

إدارية مراكش تلغي صفة النقل بأسفي

ايقاف رئيس ودادية سكنية نصب على قضاة

درك آسفي يعتقل منقبا عن الكنوز في ثالث عملية في أقل من شهر

الصمدي يعد بتعميم المنحة على طلبة سلك الدكتوراه بنسبة 100 في المائة

وزراء أفارقة وأوروبيون يدعمون مبادرة "الحزام الأزرق" التي أطلقتها المملكة

حطيئة زمانه

تفاصيل توقيف متهم باختطاف شخص وتعذيبه حتى الموت

التحقيق في صفقة حافلات النقل المدرسي بجهة درعة- تافيلالت

الجنرال حرمو يعصف بضباط كبار في جهاز الدرك

العلام يتنحى من رئاسة اتحاد كتاب المغرب

الصبار في فوهة مدفع بوعياش

كاتب عام متقاعد داخل وزارة المالية

الاستقلال يحرج "البيجيدي"

انفجار قنينات غاز في حادث سير خطير بين مراكش وأكادير

وزير الداخلية الليبي يعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف المجالات

ثلاث نقابات تعليمية تعلن عن إضراب وطني جديد يومي 22 و23 فبراير

إغلاق مصانع في أكبر حي صناعي بالرباط يتسبب في تفشي البطالة وسط شباب العاصمة

مسؤولون يناقشون بأكادير إمكانيات قطاع الصيد البحري في خلق فرص الشغل والثروة

فضيحة صفقة طاولات بوزارة التربية الوطنية

الداودي يتجه لاستبعاد التسقيف بعد صدمة موقف مجلس المنافسة

استثناءات ملغومة تستنفر الداخلية

بسبب حملة المقاطعة.. "دانون" تعترف بخسارة الملايير

تفاصيل المخطط الدموي لخلية أسفي

اعتقال أستاذة متزوجة من رجلين في مكناس

الأميرة للا حسناء تترأس حفل تدشين المركز الصحي الحضري "المسيرة 2" بعد خضوعه لأشغال التجديد

الداخلية تحقق في اختلالات تدبير المطارح العمومية

مقتل 3 عناصر من الشرطة المصرية في تفجير عبوة ناسفة

بنكيران يتهم حكومة العثماني بالمكر والتآمر ضد المغرب

اختلالات في إعادة تعيين رئيس جامعة مكناس

بنشعبون بدون ديوان

الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد

المغاربة يحدثون حوالي 92 ألف شركة سنة 2018

الحكومة و الباطرونا يلتقيان تحديد إجرءات جديدة بخصوص احترام آجال الأداء من طرف المقاولات

المالكي: 80 في المئة من القوانين التي صادق "حظيت بالإجماع"

وزيرة خارجية الهند: العالم يقدر الدور القيادي للمغرب في التصدي للإرهاب وللفكر المتطرف

إحداث 550 رادارا جديدا لمراقبة السرعة

السطو على 60 مليارا بمشروع عقاري في الدارالبيضاء

الأساتذة المتعاقدون يرفضون التوقيع على ملاحق عقود جديدة

الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب سجلت رقما تجاوز 550 ألف زائر

المديرية العامة للضرائب تشدد الخناق على المصحات الخاصة

النفطيون يرفضون التسقيف والداودي يؤكد أن القرار مازال واردا

توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضية قتل عمد مقرون بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية

نجاة بلقاسم فالو تحكي عن تجربتها بديار المهجر في رواق مجلس الجالية

حجز كيلوغرام من الكوكايين عالي التركيز لدى شابين بسلا

سيارة بارود تستنفر الأمن في شيشاوة

تجديد ولاية عبد السلام أحيزون رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب

المصحات الخاصة تحت مجهر الضرائب

فضيحة تزوير تهز وزارة أمزازي بقرصنة برنامج "مسار"

هكذا فجر مستثمر إيطالي فضيحة رشوة بديوان الوزير رباح

تساقطات ثلجية ومطرية وطقس بارد ابتداء من اليوم بهذه المناطق

إدريس لشكر يستعد للإطاحة برئيس فريقه

العثماني يساوي بين أجرة رئيس الحكومة ومجلس المنافسة

فتح تحقيق في تركة الرميد بحظيرة سيارات العدل

عندما كان المغاربة يشترون الفرنسيين.. أسرار تاريخ العبودية في المغرب
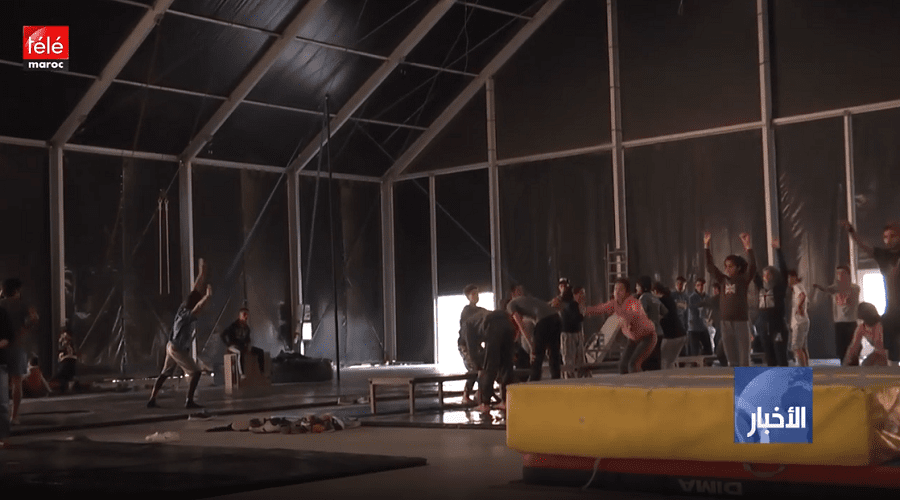
"شمسي" أو مدرسة الفرصة الثانية.. فضاء فريد لإعادة إدماج الأطفال غير المتمدرسين

اختفاء دفاتر تلقيحات يحرج الدكالي

أطباء الأسنان يتوعدون وزير الصحة بمزيد من التصعيد

أمزازي:2.5 مليون شاب مغربي عاطل عن العمل ولا يتابع أي دراسة أو تكوين

اعتداء على زوجين من جنسية فرنسية باستعمال الحجارة من طرف شخص بغرض السرقة

ضابطات من أصول مغربية في غرف قيادة الأمن والجيش بالمهجر

أساتذة "الكونطرا" يرفضون تجديد العقود

بركة يهاجم الحكومة ويدعو إلى تعديل دستوري

اعتقال كولونيل وجنود اختلسوا مواد غذائية

تفاصيل القبض على نصاب باسم القصر الملكي

المغرب ينوه بالتنصيص الصريح على استخدام الاعتمادات المخصصة للمملكة للمساعدة في الصحراء

حوالي 1.4 مليون مواطن مغربي يعاني من سوء ونقص التغذية

إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بتدقيق معطيات الترشيح لفائدة مترشحي الباكالوريا

المديرية العامة للأمن الوطني.. الإعلان عن إنشاء حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"

سيدة أعمال تتبرع بمليار و200 مليون لبناء مؤسستين تعليميتين بإقليم سطات

الداخلية تتدخل لحل مشكل رسوم مشروبات المقاهي والمطاعم بالمغرب

دراسة علمية.. الرجال أصبحوا قادرين على الولادة

معهد باستور يؤكد أنه لم يكن السبب في نفاذ لقاح الإنفلونزا من صيدليات المملكة

الحسيمة .. هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على سلم ريشتر

التحقيق مع سفير الفاتيكان في فرنسا بتهمة التحرش بموظف شاب
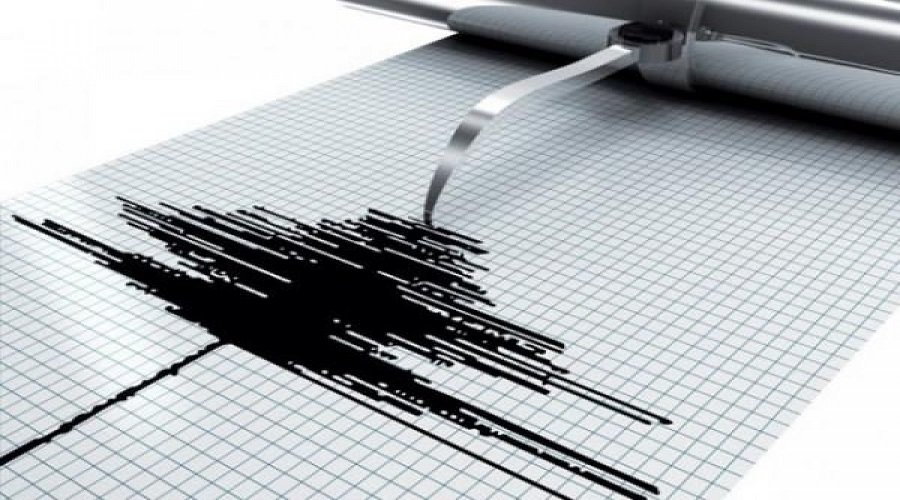
هزة أرضية بقوة 4,7 درجات تضرب إقليم الحسيمة

حروب الحلفاء

وجبة بيض فاسد تُرسل أزيد من 23 تلميذة إلى المستعجلات

ملف رباعي ينافس المغرب على استضافة الذكرى المئوية لكأس العالم

الرباط - مدريد

العاهل الإسباني الملك ''ضون " فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا يغادران المغرب

أمير قطر يوافق على اتفاقية مشاريع البنية التحتية بالمغرب وتركيا تدشن استثماراتها من مراكش

بالفيديو.. اندلاع حريق داخل معرض الكتاب بالبيضاء

توقيف أجانب متورطين في النصب العاطفي على مغاربة

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمجلس المنافسة

دخول العشرات من سائقي الحافلات في إضراب يشل حركة النقل بالدار البيضاء
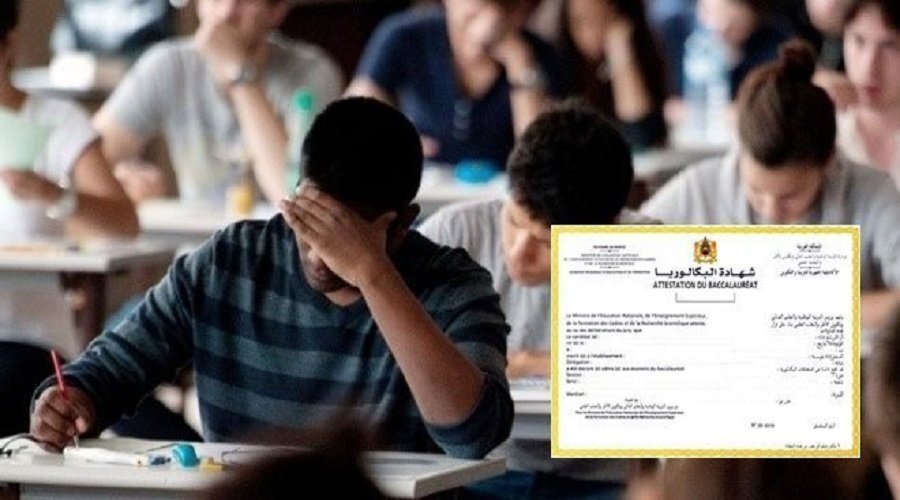
هذه مميزات خدمة "تدقيق" الخاصة بالمرشحين لامتحانات الباكالوريا

اختفاء أسلحة يستنفر القيادة العليا للدرك

القبض على نصاب متلبسا بانتحال صفة موظف في صندوق الضمان الاجتماعي

مجلس المستشارين على صفيح ساخن

"البسيج" يتمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش

البوحاطي

العثماني يبرز الإشادة الإفريقية الواسعة بتقرير الملك حول الهجرة

إسبانيا تدعم جهود كوتيريس و كوهلر من أجل التوصل إلى حل سياسي

المغرب-إسبانيا .. تعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة جميع أشكال الجريمة لاسيما الإرهاب

عاهلة إسبانيا الملكة ليتيثيا والأميرة للا مريم تزوران مدرسة الفرصة الثانية

أمزازي يدعو النقابات الأكثر تمثيلية لاجتماع من أجل الحسم في الملفات المطلبية

الأكاديمية الجهوية تنفي تناول التلميذات لمادة مخدرة و الأمن يوقف مشعوذا

8 مقترحات بـ250 مليارا

وزارة الصحة تسحب دواء لعلاج السعال بسبب خطورته على القلب

حجز 8 أطنان من الحليب الفاسد في طريقها للأسواق

تشريح جثة مواطن أرخص من تشريح أضحية العيد

تفاصيل تسريب أزيد من 50 فيديو إباحي للمخرج خالد يوسف مع 200 فنانة وفتاة

العاهلان الاسبانيان يزوران ضريح محمد الخامس

مطالب بفتح تحقيق في استفادة بنكيران ووزرائه من تقاعد البرلمان

تفاصيل اعتقال سيدة الأعمال المغربية هند العشابي من جديد

بسبب إضراب مستخدمي النقل.. الدار البيضاء دون حافلات

ماء العينين تقاطع اجتماعات مكتب مجلس النواب

القضاة يحذرون من المس باستقلاليتهم

الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف العاهلين الإسبانيين
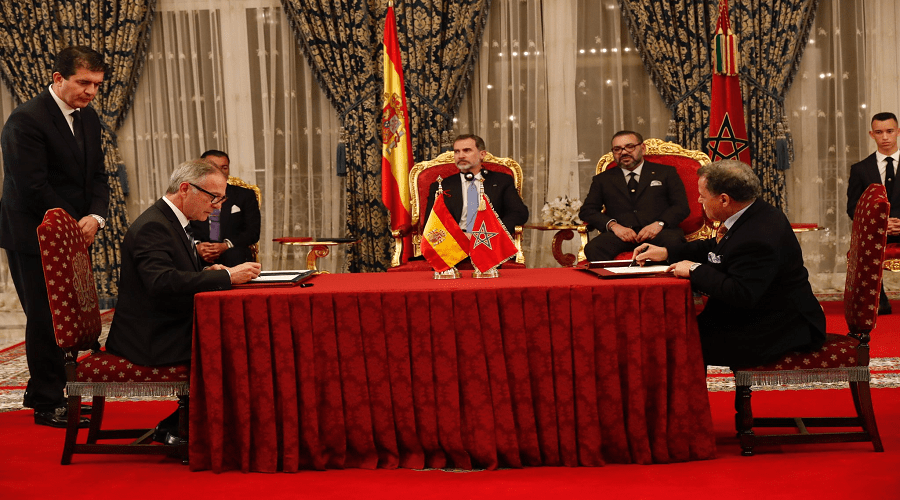
بالصور.. الملك محمد السادس والعاهل الإسباني يترأسان حفل التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي

لشكر يستغرب جمع بنكيران بين تقاعد البرلمان والحكومة

بعد أشهر من مغادرتها السجن.. اعتقال المليارديرة المغربية هند العشابي

العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة "ضونا" ليتيثيا يحلان بالمغرب

وزارة الثقافة تدخل على خط اختفاء مدافع أكادير أوفلا

بركة : 20 مليار درهم تقتطع من جيوب المواطنين

هذه حقيقة حالات البكاء الهستيري لتلميذات بإحدى المؤسسات التعليمية بالبيضاء

الحجز على كلية الحقوق "طريق جديدة" بالدارالبيضاء

وزارة الصحة تقر بثلاثين حالة وفاة بسبب الانفلونزا

أزبال البيضاء تلتهم 300 مليار سنتيم

مقترح قانون يقضي بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة

العثماني يؤكد أن جميع التقارير تؤكد تقلص معدل “الفقر” و”الهشاشة”

القضاء الأوروبي يوجه صفعة جديدة للبوليساريو

برلمانية استقلالية تفتح النار على العثماني وتتهم العدالة والتنمية بـ "تدمير البلاد"

التحقيق في اختلالات بصفقات "كوب 22"

اقتناء سيارات إسعاف بـ 600 مليون وركنها بمستشفى طنجة يخلق الجدل

مجلس المنافسة يحسم رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات

طبيبة سعودية تؤكد أن "ماء زمزم" مضر لمرضى السرطان

أمزازي يستعين بشركات خاصة لتعويض الأساتذة المتغيبين

الحكومة عاجزة عن توفير 1000 مليار لإصلاح التعليم

وكالة المحافظة العقارية تواكب المستجدات التكنولوجية بإطلاق خدمة جديدة

مديرية الحموشي تجهز فرق مركزية وجهوية للتدخل بعربات حديثة

توقيف 3 فرنسيين بتهمة تمويل الإرهاب

البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

"كافر مغربي" داخل معرض الكتاب

هذا ما قررته المحكمة في قضية حامي الدين

الإنكار كجواب

مغاربة مقيمون بالخارج يروون قصة عودتهم إلى بلادهم في رواق مجلس الجالية

شركة الصابو بالرباط تتجه نحو الافلاس

خروقات المقالع تحرك لجنة برلمانية للاستطلاع

عودة مشروع قانون التربية والتكوين إلى الصفر

محاكمة حامي الدين تشعل المواجهة بين اليساريين و"البيجيديين"

اختلالات التسيير تسقط 20 رئيس جماعة

اغتصاب تلميذة داخل مكتبة بطنطان

الرصاص لإيقاف مروج مخدرات بأصيلة

مجلس القنيطرة يستمر في بيع الممتلكات العقارية الاستراتيجية بالمدينة

فوج كامل من المهندسين المتخرجين حديثا يغادر المغرب

المجلس الحكومي يتدارس ملف قوانين تمليك 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية

كريستيانو رونالدو يفتتح أول فندق له بالمغرب

هذه تفاصيل تعويضات أعضاء مجلس المنافسة التي تتجاوز 5 ملايين

بنكيران يفضح نفسه ويعترف بجمعه بين تقاعد البرلمان وتعويضات رئاسته للحكومة

15 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية مملوكة للجماعات السلالية تسيل لعاب ملايين المواطنين

بنعزوز يطلب طي ملف تقصي الحقائق

هذا ما قاله الشارع المغربي حول معاش بنكيران ؟

توقيف شخصين للشتباه في تورطهما في حيازة مخدر الكوكايين والسياقة في حالة سكر

الملك محمد السادس يستقبل المديرة الجديدة لصندوق الحسن الثاني ومدير صندوق إثمار الموارد

الشروع في تعويض الفلاحين عن الخسار التي تكبدوها بسبب المرض

خط أحمر

البرلمان الأوربي يصوت على اتفاق الصيد البحري

البيضاء تحسم صفقة نظافتها لصالح هذه الشركات

اعتقال موظفين بالقصر

الفئران والحشرات تلتهم 413 مليونا من ميزانية مجلس النواب

عميد شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض عناصر الشرطة للخطر

هكذا يتحايل وزراء وبرلمانيون على جطو

تحويلات المغاربة بإسبانيا لذويهم فاقت بـ 11 مرة قيمة اتفاق الصيد البحري

"الأخبار" تنفرد بنشر وثائق معاش بنكيران وتكشف حصوله على معاش مدني وصرف الحكومة له 140 مليونا

العنصر يطالب بـ100 مليون سنتيم

اجتماع طارئ للحكومة حول هذا الملف

المغرب أكثر الدول عرضة للتهديدات الإلكترونية

تفكيك عصابة كنوز بالدارالبيضاء

مدونة الأسرة تجمع محاميي المهجر بمراكش

وزارة الثقافة والاتصال.. استكمال تفعيل البرنامج المتعلق بتأهيل الموسيقى الحسانية

الدار البيضاء.. مجلس المدينة يحسم في تدبير ملف النظافة و ينتدب شركتين

إشادة بجهود الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه

فضيحة ريع بوزارة بوليف

صفقات أدوية تورط مسؤولين بالصحة أمام مجلس جطو

بعد نجاته من حادث خطير.. زوج ملكة بريطانيا يتخلى عن رخصة السياقة بعمر 97 عاما

بالصور.. كارنافال شعبي في مراكش احتفالا بالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

أسبوع الصناعة التقليدية يفتتح فعاليته ب"كرنفال" جاب مراكش وعرض منتوجات الجهات

بوريطة : خبر أسوشايتد بريس حول استدعاء سفير المغرب بالسعودية غير مضبوط

قيود جديدة على اللوحات الإشهارية ومنح الشركاء والمخالفين 5 سنوات للتأقل

نقل جثمان الشابة المغربية التي قضت في حريق مبنى سكني بباريس نحو المغرب

وزارة الداخلية تراسل عمال الأقاليم وتضيق الخناق على المخابز العشوائية

إسبانيا تتبرع بممتلكات "تياترو سيرفانتيس" للمغرب

أمزازي يؤكد أن هجرة الأدمغة دليل على جودة التعليم في المغرب

الإعدام لقاتل طفلة بعد اغتصابها

تأجيل المجلس الحكومي بدون مبرر

الخلفي يرفض تفويض توقيعه لكاتبه العام

داعية سعودي يحرض من عين حرودة على الجهاد في ليبيا إلى جانب حفتر

الماء والماء ثم الماء

بنكيران لا يرضى تبرج ماء العينين لزوجته وبناته وينتقد تعامل الحزب معها ويفتح النار على الرميد

هذا هو الشرط الذي وضعته مدريد لكي تصادق على التبرع بمسرح "سيرفانتيس" للرباط

عاجل...القبض على منى فاروق وشيما الحاج والمخرج خالد يوسف بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية

ممرات جديدة خاصة بالحافلات تحدث حالة ارتباك في لسائقي العاصمة

تلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية إلى حدود 6 فبراير

التجار الصغار يجرون العثماني للبرلمان

محامون وقضاة يقاربون بمراكش موضوع مدونة الأسرة بعد 15 عاما من التطبيق

توقيف قاتل الشرطي بفاس

ضابط مغربي سابق يعترف بتعاونه مع المخابرات الفرنسية لضرب المغرب

أوجار : وزارة العدل بصدد اجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة

المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع في مجال النقل و النظافة و الاشهار

تأجيل انعقاد مجلس الحكومة المقرر الجمعة إلى تاريخ لاحق

القضاء يعوض محاميا متمرنا عن تأخيرات القطار بمليونين

وفاة شرطي بعد صدمه من طرف جانح

"أونسا" يؤكد تلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية

اعمارة يؤكد أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة

الملك يعين مجموعة من السفراء باقتراح من رئيس الحكومة

الملك يأمر بتجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية

وثائق تفضح كيفية التلاعب في صفقات تعاضدية الموظفين

رئيس البرلمان يخصص ميزانية بمئات الملايين لمحاربة الفئران ووضع كاميرات المراقبة

عمليات إجهاض سرية بواسطة خلطات الأعشاب ب5000 درهم والأمن يداهم الوكر ويعتقل "الفاسية"

هذه حقيقة استدعاء الرباط لسفيرها في الرياض

ترامب: لقاح الإنفلونزا أكبر عملية احتيال في التاريخ الطبي

التجار الصغار يجرون العثماني للبرلمان

أمزازي يعيد النظر في منح الطلبة بالخارج

مجلس جطو يحل بوكالة محو الأمية
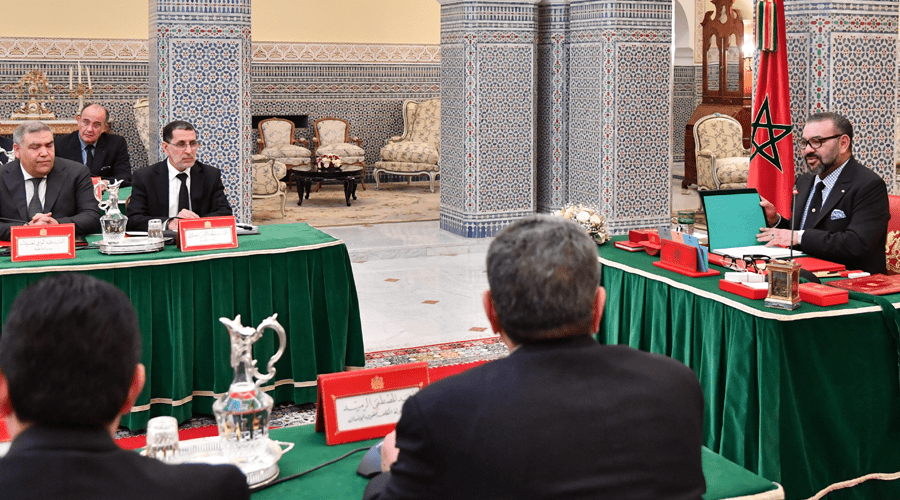
مهيدية واليا على طنجة تطوان واليعقوبي واليا على الرباط

تسجيل 40 ألف إصابة جديدة بمرض السرطان في المغرب سنويا

ابريق شاي يكلف جماعة تارودانت 23 مليون سنتيم

جطو يحيل 44 منتخبا على العثماني من أجل العزل
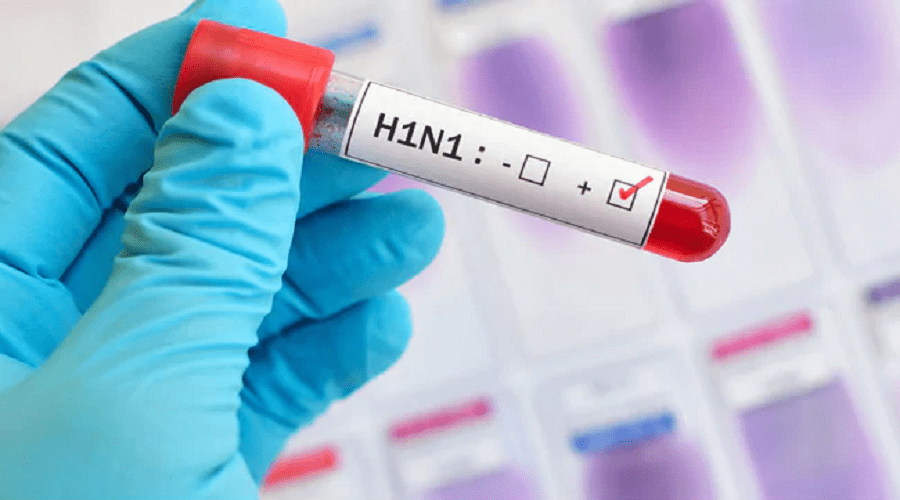
شكوك حول سلامة لقاح الانفلونزا

الطاعون يحصد 32 رأسا من الأغنام واستنفار لمحاصرة الداء
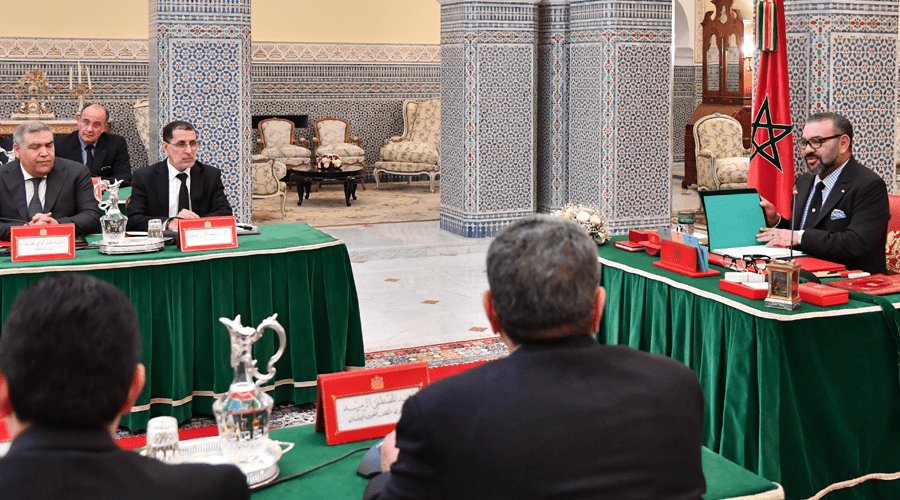
هذه تفاصيل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بمراكش

إصابة 4 أشخاص في اعتداء بالسلاح الأبيض بينهم فرنسي

منشور لدورة تدريبية مقابل شهادة في "الرقية الشرعية" يخلق الجدل

التوقيع على أربع اتفاقيات لتعزيز عرض التكوين لفائدة مهن صناعة السيارات

قنصلية المغرب بباريس على اتصال مع أسرة المغربية التي لقيت حتفها في حريق بمبنى سكني

الداودي يتهم بنكيران بالكذب في حقه

أزمة نفاذ الأنسولين تعصف بالمستشفيات العمومية

أبناء النافدين بالبيضاء ضمن عصابة للاغتصاب الجماعي

سكانير ب400 مليون يتعرض للإتلاف

خطير... هكذا يتم تلويث مياه واد سبو في القنيطرة بمياه الواد الحار

قضاة جطو يضعون ممتلكات الوزراء و المسؤولين تحت المجهر

بوريطة: المغرب يلعب دورا أساسيا في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش"

رسميا.. هذه مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الحالية

الحكومة التونسية ترضخ لمطالب المحتجين وتقرر زيادة الأجور

جرائم الأموال تدين موظفا بوزارة الخارجية بـ 5 سنوات سجنا بتهمة الاختلاس

الرئيس يرفع الجلسة لصلاة لم يؤدها سوى بعض المستشارين

موظف شبح مطلوب لدى وزارة الرميد

بعد المغرب.. إنفلونزا الخنازير تجتاح 26 دولة أوروبية

حذر و إجراءات وقائية بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروسH1N1 إلى 16

تراجع نسبة البطالة منتقلة من 10.2 بالمائة خلال 2017 إلى 9,8 بالمائة سنة 2018

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

المغرب حاضر في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة "داعش"

أمزازي يكشف عن الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها

تفاقم العجز التجاري بالمغرب بنسبة 10,9 في المائة

وزارة التربية الوطنية تلزم الآباء بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة

عقدة الفرنسية

حذر و إجراءات وقائية بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروسH1N1 إلى 16

العدالة والتنمية يغضب الوداد والرجاء

حرب المناصب تستعر داخل مجلس النواب

الفرقة الوطنية تحقق في اتهامات لرؤساء جماعات بتبديد الأموال

"خبراء فوق العادة" يورطون العثماني

قروض المغاربة من الأبناك تتجاوز 200 مليار درهم

30 في المائة من تلاميذ المستوى الثاني المغاربة لا يجيدون القراءة

كوكايين "الجديدة" يطيح بتجار مخدرات في الشمال

وفاة شرطي وإصابة ابنه بجروح خطيرة جراء اعتداء بالسلاح الأبيض على يد مختل عقليا

هكذا تهدد الطيور صحة البيضاويين

الجامعة تغيّر ملعب مباراة المغرب والأرجنتين

فضيحة بوزارة الصحة.. اختفاء أدوية جنيسة مضادة لأنفلونزا الخنازير مصنعة بالمغرب

هذه هي التغييرات التي ستعرفها الصناعات السينمائية بالمغرب

فلاح يجر رجال درك وجنود أمام جرائم الأموال ضمن شبكة للهجرة السرية

صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات

شركة واحدة تستحوذ على صفقات مجلس المستشارين

هذه أجندة المجلس الوزاري

الملك يدشن مشروعين تضامنيين لتعزيز العرض الصحي بالمدينة العتيقة لمراكش

مجلس الجالية يشارك في معرض الكتاب بنقاشات وعروض وألعاب وإصدارات جديدة

مؤسسة التعاون بين الجماعات تخلص العاصمة الاقتصادية من ورطة "مدينة بيس"

الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب "لا تدعو للقلق"

جطو يلف حبل العزل حول 67 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم

عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير يبلغ 16 حالة وارتفاع عدد المصابين

قروض وهبات من ألمانيا للمغرب بقيمة 330,5 ملايين أورو لدعم التنمية المستدامة

المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي الإفريقي للأنتربول بكيغالي

وزارة الصحة تقتني أغلى دواء للأنفلونزا في العالم

اضراب وطني بقطاع الصحة

الفساد يلاحق حدائق البيضاء

200 ألف إصابة بالسرطان في المغرب

منعش عقاري نصب على مواطنين في 7 مليارات

انتشار انفلونزا الخنازير بالمغرب.. المنظمة العالمية للصحة تدخل على الخط

شكون يشكرك أ العروس

رسميا.. مجلس البيضاء يفسخ عقد "نقل المدينة"

أسبوع الصناعة التقليدية بمراكش يحتفي ب1200 صانع تقليدي من كافة جهات المملكة

اعمارة يكشف عن اجراءات جديدة لتدبير القطاع

أمزازي: فرض الرسوم على الطلبة الموظفين من صلاحيات الجامعات

برلمانيون يتهمون الدكالي بسوء تدبير انتشار انفلونزا الخنازير

أنفلونزا الخنازير يحصد المزيد من الضحايا والحصيلة ترتفع إلى 11 قتيلا و30 مصابا

التعديل الحكومي على طاولة اجتماع الأغلبية

مصرع 4 أطفال في حريق بإنجلترا والشرطة تحقق

برلماني من "البيجيدي" متهم بالنصب والاحتيال عن طريق العمل الخيري

مصرع 8 أشخاص في حريق داخل مبنى سكني في فرنسا

الداخلية تحسم في 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية

المحققون يعثرون على جثة في حطام الطائرة التي كان على متنها سالا

اجتماع مرتقب لزعماء الأغلبية لرأب الصدع و تجاوز الخلافات

قاضي التحقيق يستمع للسويسري المتهم في جريمة إمليل

أغلبية العثماني تجتمع لطي صفحة الخلاف

دركيون أمام القضاء بتهم ثقيلة

المؤبد لمغتصب 20 امرأة بطنجة

احتضار سياسي

مجلس البيضاء يفسخ عقده مع "نقل المدينة"

موظفو مجلس البيضاء يضربون احتجاجا على تجاهل العمدة لمطالبهم

"أدوية" جزائرية مسرطنة بعيدة عن أعين وزارة الصحة

وزارة العدل تنهي زواج الفاتحة

بنكيران يدافع عن معاشه الاستثنائي ويهاجم الصحافة التي فضحته

مسلحون يداهمون بنكا بضواحي البيضاء ويسرقون 20 مليونا

إلياس العماري ممنوع من "الإنجليزية" لهذا السبب

أمانة "المصباح" تسحب كعكة التعويضات من ماء العينين

أدوية فاسدة بالمستشفيات العمومية

إصابة ممثل مغربي وأسرته بفيروس إنفلونزا الخنازير

الحكومة تشرع في ترقيم المغاربة لتوزيع الدعم الاجتماعي

المغرب يلقّح نصف مليون رأس من الأبقار ضد "الحمى القلاعية"

153 من الدواعش المغاربة في قبضة سوريا

تعويض الفلاحين ضحايا الحمى القلاعية

انفلونزا الخنازير تثير الهلع في طنجة ومراكش

جثة تحت الأنقاض تستنفر أمن فاس

الداخلية تطوق سماسرة الأراضي السلالية

صفقات عمومية تورط رئيس الحكومة

مقرقب يقطع أصبع ضابط بأنيابه في الدارالبيضاء

الأمير مولاي الحسن يخطف الأنظار في تشييع جثمان كونت باريس

"تيلي ماروك" تعتذر لمشاهديها وتسحب إحدى حلقات برنامج "منطقة محظورة"

مراكش..نمو صادرات الصناعة التقليدية بأزيد من31 في المائة خلال سنة 2018

البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة التعلم في المغرب

عجز الميزانية يتفاقم في 2018 بملياري درهم

سعد الدين العثماني..الحوار الاجتماعي مستمر، ووزارة الداخلية لم تدخل على الخط

انفلوانزا الخنازير تربك المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء وتجر الدكالي للمسائلة

إنفلونزا الخنازير تحصد أرواح 9 أشخاص والدفعة الأولى من مضادات الفيروس تصل المغرب

الحكومة تصادق على قانون ترقيم المغاربة

الرميد يتوعد ماء العينين بإجراءات صارمة ويصفها بذات الوجهين

بنعزوز تحت طائلة المتابعة الجنائية

حروب كعكة المناصب البرلمانية تنطلق

حامي الدين يواصل إقبار التغطية الصحية للوالدين

حوار الطرشان

المعرض الدولي للكتاب يرفض مشاركة 548 دارا للنشر بسبب "أكلها" حقوق المؤلفين

عصيد يراسل أمزازي : أساتذة يحرضون التلاميذ ضد آبائهم بسبب الحجاب أو عدم أداء الفرائض وأستاذة تدرس الفرنسية بالفصحى

الدكالي يطلق أكبر عملية تشخيص لحالة المستشفيات في المغرب

المجلس الحكومي .. ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على برنامج الدعم الاجتماعي

لحسن الداودي يكشف تاريخ "تسقيف المحروقات" ويتوعد المخالفين بذعائر مالية كبيرة

الحمى القلاعية.. عملية التلقيح لاتزال مستمرة وهذه هي المناطق المستهدفة

المغرب يتقدم على الدول المغاربية في مؤشر الحرية الاقتصادية

وزارة الصحة تؤكد على أهمية التلقيح والتطعيم من الأنفلونزا قبل بداية كل موسم

وزارة الصحة .. تسجيل خمس حالات وفاة بأنفلونزا "أش 1 إن 1" بالمغرب
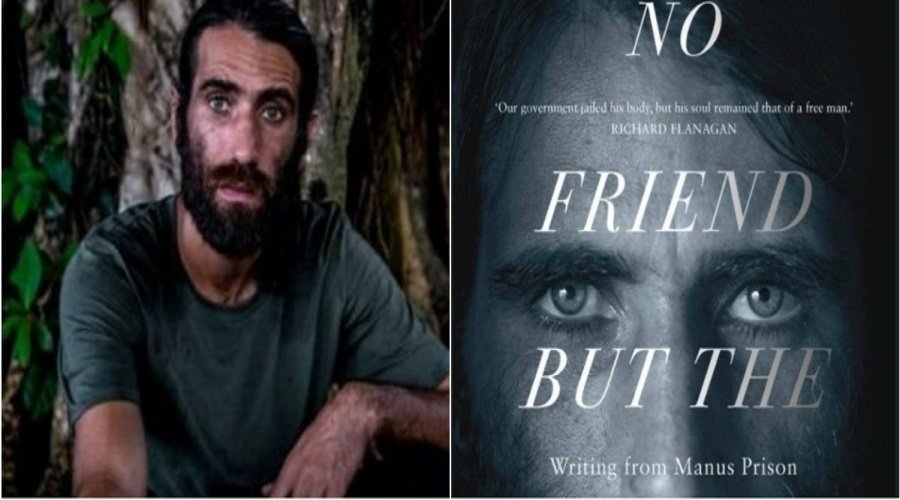
لاجئ كردي كتب رواية عبر واتس آب يفوز بأرفع جائزة أسترالية

رئيس الحكومة يخسر دعوى قضائية ضد مستشار جماعي

بعد اتهامه بتعاطي "المنشطات".. بدر هاري يوجه رسالة لجمهوره

نشرة خاصة.. أمطار عاصفية ورياح قوية ستبلغ سرعتها 100 كلم في الساعة

هكذا أجهضت وزيرة البيئة مشروعا استراتجيا يموله البنك الدولي

تأجيل اجتماع زعماء الأغلبية و"بلوكاج " داخل البرلمان

بنشماش يضع النظام الداخلي في الثلاجة

ارتفاع عدد وفيات "إنفلونزا الخنازير" إلى 5 وحالة استنفار بوزارة الصحة

المالكي يعقد صفقة لإدماج موظفي "البيجيدي"

الحكومة تخرج عن صمتها وتؤكد وفاة سيدتين مصابتين بإنفلونزا الخنازير

موجة صقيع قياسية تجتاج الولايات المتحدة

بعد الحليب الملوث.. تحذيرات من حفاضات أطفال سامة

وفاة امرأة ثانية واكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية

خصاص المحاكم يصل إلى 400 قاض

"همزات" الجماعات تستنفر وزارة الداخلية

الحمى القلاعية تحرّك الدرك والجيش

التعريب يشعل البرلمان

تسجيل إصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير في الدار البيضاء

إحالة "مخازنية" على النيابة العامة في قضية التهريب الدولي للمخدرات

بعد إخضاعه لفحوصات طبية.. مجلس حقوق الإنسان يكشف الحالة الصحية للزفزافي

قضاة جطو يحلون بجامعة القاضي عياض

وزير سابق أمام قسم جرائم الأموال بالرباط

ارتفاع الصادرات المغربية نحو إسبانيا بنسبة 5,4 في المائة عند متم نونبر 2018

مشروع سكني بكورنيش العاصمة يعاني عزلة تامة بعد إغلاق المنافذ المؤدية إليه

كلاشات حكومية

الاستقلال يحذر من "بلوكاج" حكومي جديد و يحذر من "المزاجية"

حجز وإتلاف 5441 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك خلال سنة 2018

تقرير يوصي بالاقتصاد الأزرق لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمغرب

اقتطاعات جديدة في الأجور تعمق أزمة الموظفين

إدانة أمريكي في مراكش متورط في اغتصاب وتصوير أشرطة خليعة لقاصرات ومتزوجات

المطارات تفتح أبوابها من جديد أمام "غير المسافرين"

لأول مرة في المغرب...مجلس طاطا يعرض منحة شهرية قيمتها 1500 درهم على الأطباء للإشتغال بالإقليم

بنعزوز مطالب بكشف صرف 270 مليونا

"البيجيدي" يدافع عن معاش جديد لبنكيران

4 ملايير تجبر الحموتي على التلويح باستقالته

"أونسا" يستعرض حصيلة مراقبته للمواد الغذائية خلال السنة الماضية

المحطة الجوية 1 ترفع الطاقة الاستيعابية تتجاوز 14 مليون مسافر في السنة

النقابات تنتظر رد الحكومة والكونفدرالية الديموقراطية للشغل تخوض إضرابا وطنيا
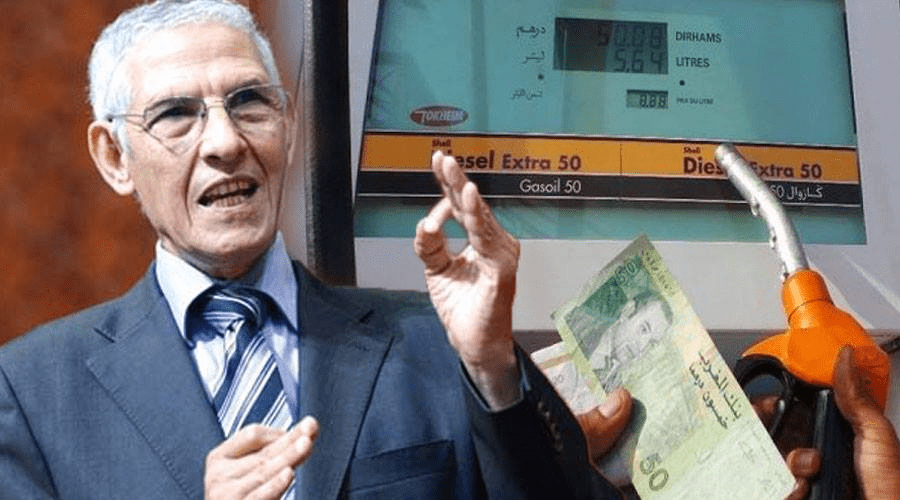
الداودي يكشف عن زيادة جديدة في ثمن الكازوال مع بداية فبراير

أمطار محليا قوية مع هبوب رياح متوقعة يوم الجمعة المقبل بعدد من أقاليم المملكة

برنامج "تمكين"

"مالاريا لاسا" يهدد حياة لاعبي الوداد

مدرب مازيمبي والأهلي يقترب من الرجاء

العطش يطيح برئيس جماعة الهراويين

عجز الميزانية يصل 38 مليار درهم في 2018

المغرب خامس أفضل بلد عربي للعيش

الحكومة تخشى اعتقال وزراءها

تعويضات مهمة لرجال الأمن

مجلس الأمن يعقد مشاورات بشأن قضية الصحراء المغربية بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام

مجلس جطو يشرع في افتحاص ممتلكات و ثروات منتخبين و موظفين سامين

تركيا تعتقل عشرات الطيارين العسكريين في قضية الانقلاب الفاشل

كندي يعترف بتشويه وقتل 8 مثليين جنسيين

"زيت العود" يعوض لقاح "تاميفليو" لعلاج إنفلونزا الخنازير بالمستشفيات

هكذا يستغل رجال سلطة السكن الوظيفي لجني مداخيل شهرية

عاجل.. رضيع السيدة المتوفاة بسبب إنفلونزا الخنازير يفارق الحياة

الداخلية تتعقب مستشارين أشباح لإقالتهم

أعضاء المكتب الفيدرالي لـ"البام" يقبلون حضور بنشماش على مضض

هكذا تمردت ماء العينين على الأزمي لرئاسة جلسة البرلمان

لفتيت يكشف سجله الاجتماعي قبل رفع الدعم

مجلس النواب يلغي مباريات الترقية
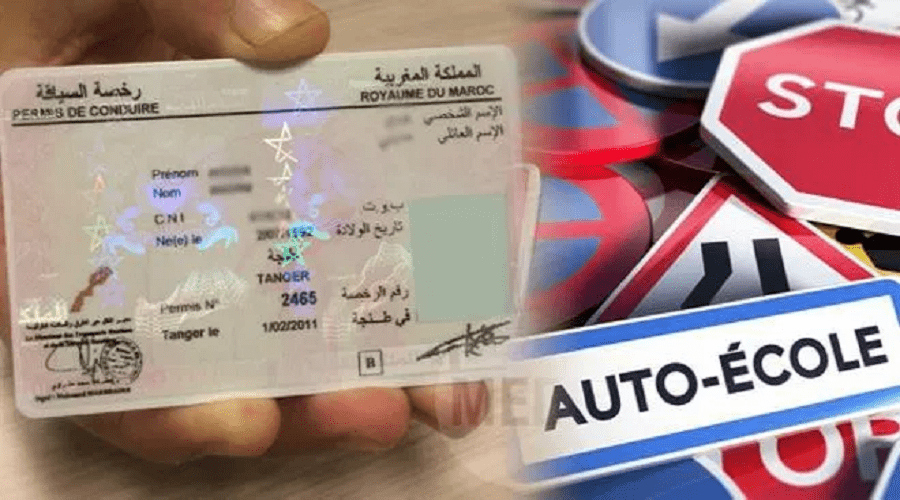
تعطل النظام المعلوماتي لاختبارات رخصة السياقة.. الوزارة توضح

لفتيت يفتح آفاق الترقية أمام أعوان السلطة ويعد بتحسين وضعيتهم
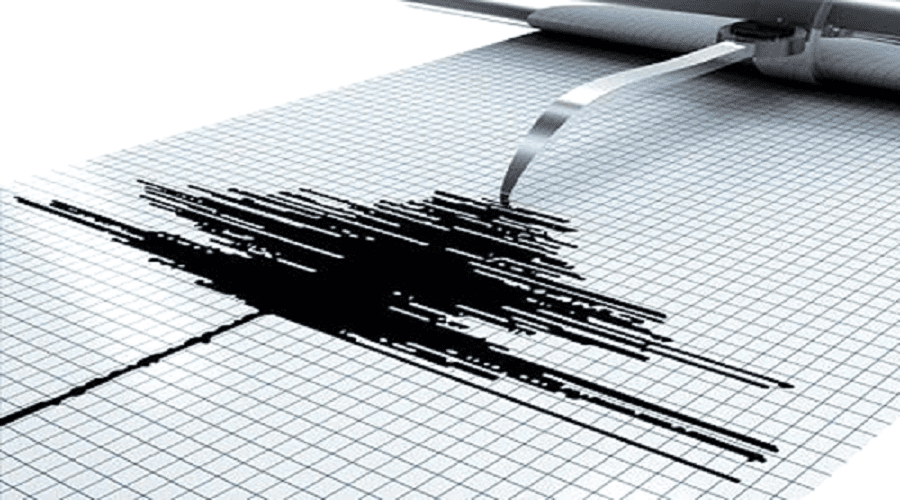
هزة أرضية قوية تضرب ساحل الحسيمة
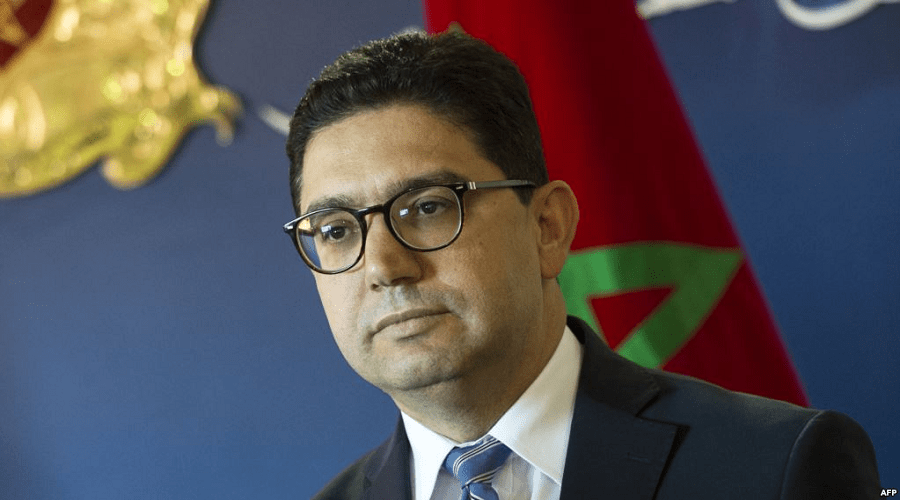
المغرب أول بلد عربي يتباحث مع رئيس فنزويلا بالنيابة.. والأخير يتعهد بإعادة النظر في قضية الصحراء

بعد إغلاق معاهده.. "الأستاذ المعجزة" مطالب بتسديد 300 مليون كضرائب

حقيقة موجة البرد القارس التي ستعم المغرب نهاية هذا الأسبوع

السجن سنة في حق مدونين في صفرو

عمليات تهجير وهمية إلى كندا تنتهي بعشرات المغاربة عالقين فالمطارات التركية

إدارة مستشفى الشيخ خليفة تكشف تفاصيل وفاة السيدة المصابة انفلونزا الخنازير

إدارة السجون : الزفزافي يعاني من خلل خلقي والطبيب أخبره بذلك ووصف له العلاج المناسب

تعثر مشاريع التنمية يجر غضبة ملكية على مسؤولي الدارالبيضاء

تعذر الإستماع إلى الوزير رباح في ملف التلاعب بصفقات والقضية تصل أمام جرائم الأموال

أطباء الأسنان ينتفضون ضد نظام الفوترة الإكترونية

قاصرون مغاربة تحت رحمة عصابات إسبانية

الجيش الإلكتروني لـ"البيجيدي" يعلن النفير بعد فترة كمون

هذه هي المعركة التي تنتظر المغرب في أبريل المقبل

"نزهة احتجاجية" بأكادير أوفلا

عبد النبوي يأمر بفتح تحقيق حول اتهامات لشخصيات قضائية على خلفية مقتل المغنية زاينة

حليب ملوّث يهدد حياة الآلاف من الأطفال المغاربة

العثماني يخصص 40 مليارا للمعاشات الاستثنائية

موقع "البيجيدي " يتبرأ من معاش بنكيران

حوادث سير وهمية تجر شرطيا وطبيبة بمراكش للقضاء

لفتيت يجمد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها بوليف لنافذين

الحكومة تفرج عن مشروع السجل الموحد لاستهداف الفقراء

أمينة ماء العينين ترفع جلسة البرلمان لمدة عشر سنوات وتنفجر ضاحكة ... فيديو

جبن سياسي

استغلال معطيات خاصة يجر مواقع إلكترونية إلى التحقيق

التحقيق مع مفتش شرطة يشتبه تورّطه في قضية رشوة

الأزبال تهزم العماري بالدارالبيضاء

سفر مغربيات نحو دول عربية يفجر الجدل من جديد

912 مليار كلفة استيراد الحبوب وشركات تحكم سيطرتها على قنوات الإستيراد والتوزيع

اقتطاعات جديدة للموظفين لإنقاذ هذا الصندوق

عمال الانعاش الوطني يحتجون أمام البرلمان

هذه هي الوكالات التي يجب أن يحذر منها المعتمرون

الخدمة العسكرية... هذا تاريخ تخرج أول فوج

الداخلية تجمد رخص بوليف

القضاء الإداري بمراكش يطيح برئيس جماعة من "البيجيدي"

وفاة سيدة حامل مصابة بـ "انفلونزا الخنازير"

أرباب الشاحنات يصعدون ضد الوزارة ويدخلون في إضراب وطني جديد

السعودية تطلق سراح العمودي مالك لسمير

بداية الطلاق بين "الحمامة" و"المصباح" بالمجالس الجماعية

لعنة بنكيران تكلف الموظفين 80 مليار سنتيم

الخدمة العسكرية.. هذا موعد الشروع في تدريب الفوج الأول

تعيين مدير للمستشفى الجامعي بمراكش خارج التباري

لفتيت يرسِّم الحق في الحصول على المعلومة

المعرض الدولي للفلاحة يختار التشغيل موضوعه العام

"البيجيدي" يتبرأ من الفوترة

وزارة الصحة توضح حقيقة تسجيل حالات لأنفلونزا (اش1ن1)

بعد لقاءه مع ممثلي النقابات .. لفتيت يجتمع مع مزوار بخصوص الزيادة في الأجور

المجلس الجماعي يتدارس آخر الترتيبات قبيل الإعلان عن الشركات الثلاث الفائزة بالصفقة

نقص في علامات التشوير الطرقي ووضع بعضها عشوائيا يتسبب في حوادث بالرباط

الإدارة تفرض النظام إثر محاولة أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خلق الفوضى

لفتيت يلاحق 200 موظف ترقوا بطرق مشبوهة

قصة امرأة ثرية تتورط في قتل شرطي بالبيضاء

تغييرات جديدة في صفوف ضباط سامين بالجيش

الأساتذة المتعاقدون يعودون للاحتجاج الشهر المقبل

تأجيل التحقيق التفصيلي مع المتهمين في اختلالات "روح فاس"

حذاء مسافرة مغربية يتسبب في رعب بمطار أورلي

جطو يترصد ممتلكات برلمانيي الغرفة الثانية

الداخلية تحقق في متاجرة رجال سلطة في سكن الفقراء

أرباب وسائقو الشاحنات يلوحون بإضرابات جديدة

عمال الإنعاش الوطني ينظمون مسيرة ووقفة أمام البرلمان

برقية تهنئة من الملك إلى رئيس جمهورية الهند بمناسبة العيد الوطني لبلاده

مجلة "nouvel obs" الفرنسية تحاور مدير جريدة "الأخبار" حول نشر صور ماء العينين بدون حجاب

تراجع أداء قطاع العقار يعمق من خسائره للعام الرابع على التوالي

اقتسام كعكة المناصب يفجر فضيحة أخلاقية بالمجلس الحكومي

توجيه منشور جديد يدعو الجماعات الترابية إلى توفير المعلومة

ارتفاع الدرهم مقابل الأورو ب0,15 في المائة وانخفاضه ب0,15 مقابل الدولار

الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا أرست أسسا متينة لتطوير العلاقات بين البلدين

البرلمان يحقق في تلاعبات الدقيق المدعم

هذه حقيقة الحجز على سيارات المواطنين الذين لم يؤدوا الضريبة

تعيين ابن المالكي يثير جدلا داخل الحكومة

العثماني يواصل الحرب الصامتة على أمزازي

وزير الخارجية الروسي يكشف عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية

سعد الدين الديماغوجي

الخلفي : موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالكيان الوهمي يعزز وجاهة مواقف المملكة

المصادقة على مرسومين يتعلقان بكيفيات تطبيق قانون الخدمة العسكرية

عدد الأقاليم التي يستهدفها البرنامج انتقل هذه السنة من 22 إلى 27 إقليم

تغيرات في مسار الترامواي تحدث ارتباكا وتثير غضب البيضاويين

فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل بالمغرب بسبب النسيج التركي

الملك يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

رؤساء جماعات ونواب يتهربون من التصريح بالممتلكات

الدار البيضاء.. مصالح ولاية الجهة تحصي شركات الحراسة والنظافة

اختلالات في تدبير نظام المساعدة راميد تكشف عزوفا عن تسلمها

الخلفي يدعو النقابات إلى التفاعل ويؤكد أنه ليس هناك جمود ولا بلوكاج

الحكومة تؤكد توقيع اتفاق مع التجار مع العمل على تنزيل مطالبهم المشروعة

تطوان ..وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة الطبية على خلفية قضايا مخدرات

ابنة بنكيران تتحدث عن "التقاعد الاستثنائي" وتقصف قادة البيجيدي

هؤلاء هم المعفيون من الخدمة العسكرية

هذه تفاصيل إعادة تمثيل جريمة "محاولة قلب البراق"

بريطانيون يبحثون عن النفط في سواحل المحمدية

ماء العينين تقاطع جلسة برلمانية وتظهر بالحجاب في بيروت

هكذا تحول "البيجيدي" إلى محام لـ "بيم" التركية بالبرلمان

عاجل... وزارة التعليم تغلق مقرات معهد "الأستاذ المعجزة"

الحكومة تتراجع عن الرفع من نسبة المساهمة الأدنى، وتبقيها في حدود 0.50 في المائة

تقرير دولي يصنف أجور الأساتذة المغاربة في المرتبة ما قبل الأخيرة

إسبانيا تطالب بمنح المغرب مبلغ 140 مليون اورو قبل شهر مارس المقبل

العثماني : الحكومة ستحرص على انتظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

التجنيد الإجباري.. الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم شهريا

ماكرون يكشف عن موقف بلاده من أزمة الرئاسة الفنزويلية

سرقة مجوهرات بقيمة 25 مليونا من "فيلا" قاضية

تفاصيل توقيف مفتش شرطة ممتاز بمطار مراكش بسبب مواطن بريطاني

لعبة الاختباء وراء الملك

فيروس يربك 4400 مدرسة لتعليم السياقة

الجمارك تترصد بارونات تزوير المواد الغذائية
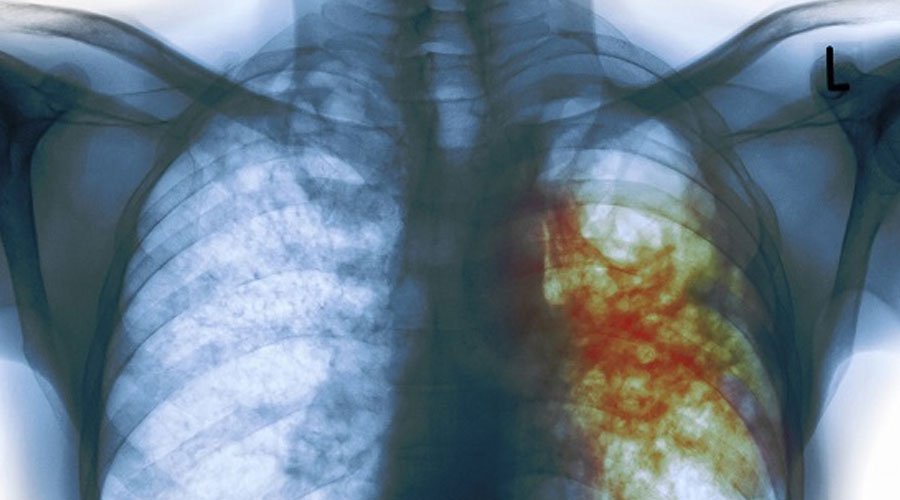
داء السل يهدد البيضاويين

اعتقال فرنسي بمطار البيضاء بشبهة الإرهاب

عصابات نصب في حافلات "المدينة بيس" بالدارالبيضاء

البيروقراطية الأوروبية تحرم المغرب من التوصل بـ 140 مليون أورو

العلبة السوداء لقطار بوقنادل أمام ابتدائية سلا

الحكومة ترمي كرة المحروقات الملتهبة لمجلس المنافسة

مشاكل اتحاد المغرب العربي مرتهنة بما تعرفه العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب

الإعلان عن القضاء على بؤر الحمى القلاعية في المغرب

2500 مليار من جيوب المغاربة في حسابات خاصة

تفاصيل مثيرة حول مذكرة اعتقال أحمد منصور بسبب "الزواج العرفي"

سجائر سويسرية سامة في رئات المدخنين المغاربة

نائبتان اتحاديتان تثيران ضجة في البرلمان بسبب "هاداك الشلح" و"سامحيني"

تقارير سوداء حول صفقات تستنفر وزراء

اعتقال زعيم معذبي فتاة الوشم

التوفيق يغلق سنويا 250 مسجدا لهذا السبب

لغز اختفاء مدافع من أكادير

يهم الشباب... بدء عملية إحصاء المجندين للخدمة العسكرية

لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي تصادق بأغلبية واسعة على اتفاق الصيد البحري

سلا..تجار المدينة يشلون الحركة وينادون بـ”العدالة الضريبية”

دراسة حديثة تكشف مواد سامة في "حفاضات الأطفال"

التحقيق مع قاض بسبب اتهامات بالرشوة

الداخلية تطلق يد الولاة والعمال على المنتخبين

مستشار من "البيجيدي" يشهر بندقية في وجه خصومه

محكمة الأسرة تقضي بطلاق وزير في حكومة العثماني وتحكم لزوجته بهذا المبلغ

الملك يعطي انطلاقة الخط الثاني لترامواي البيضاء.. وهذه هي الأحياء التي سيغطيها

"وجهة المغرب" تستقطب أزيد من 12 مليون سائح خلال 2018

لفتيت يفرج عن أكبر قانون لتوزيع 10 ملايين هكتار

أوقفوا النزيف

إسبانيا تسلم المغرب "صدام" المتهم في جريمة قتل الطالب " إزم"

لفتيت يشهر العين الحمراء في وجه رؤساء الجماعات المتقاعسين

تجهيزات متهالكة تلغي افتتاح مركز تصفية دم كلّف 300 مليون

أرباب الشاحنات يلوحون بإضراب وطني ويتهمون بوليف بالتماطل

خلاف الأغلبية حول قانون الأمازيغية على طاولة العثماني

تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا ينشطون بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية

هكذا يخطط بنكيران لإسقاط حكومة العثماني وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها

لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي تصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

معطيات جديدة في قضية مقتل الطفلة "إخلاص"

العلمي يتهم كبار التجار بتحريك الإضرابات للتهرب من أداء الضريبة

برلماني سابق يجرجر والدته المسنة أمام المحاكم

بالفيديو.. موجة غضب على برلمانية اتحادية بسبب عبارة "مول الحانوت.. هاداك الشلح"

احتقان داخل "أخبار اليوم" ومسكين يبحث عن موقع في جزيرة الدوحة

لفتيت يفرج عن أكبر قانون لتوزيع 10 ملايين هكتار

عاجل ...تفكيك خلية إرهابية من 13 عنصرا ينشطون بقلعة السراغنة وسلا والبيضاء والمحمدية

الملك يدشن المحطة الجوية 1 الجديدة لمطار محمد الخامس

الشروع رسميا في الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين ويكشف أسماءهم

رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران يعترف باستفادته من تقاعد استثنائي

توقيع معاهدة فرنسية ألمانية تمهيدا لإنشاء "جيش أوروبي"

هذه أجور وتعويضات المشاركين في الخدمة العسكرية الإجبارية

وثائق تفضح خروقات خطيرة في ميزانية تعاضدية الموظفين

شهادات ماستر مزورة تستنفر وزارة التعليم العالي

الحكومة تبسط حصيلتها وتؤكد رصد أزيد من مليار و200 مليون درهم

أبناك خارج القانون

نماذج النمو التي اعتمدها المغرب خلقت فجوات و الشغل أصبح من الترف

السراح المؤقت لأستاذ الماستر مقابل المال بفاس

الدرك الملكي يعثر على جثة الطفلة المفقودة إخلاص

رباح يؤكد أن الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة

هكذا وضع أحمد منصور قادة "البيجيدي" في قلب فضيحة زواج عرفي

وفاة لاعب فريق المغرب التطواني في حادثة سير مروعة

هذه هي المنشآت العامة التي منحها البرلمان للقطاع الخاص

لجنة لافتحاص ميزانية مجلس المستشارين

أجواء باردة وأمطار بهذه المناطق من المملكة

بسبب التهرب الضريبي.. منعشون عقاريون وبرلمانيون ممنوعون من مغادرة البلد

حرب حول صرف الملايير من أموال "البام"

هكذا فتحت ماء العينين باب الصفقات لصديقها

مجلس جطو يجر 12 مستشارا للمحاكم بسبب الحملات الانتخابية

المغرب يصدر مذكرة اعتقال في حق صحافي الجزيرة أحمد منصور
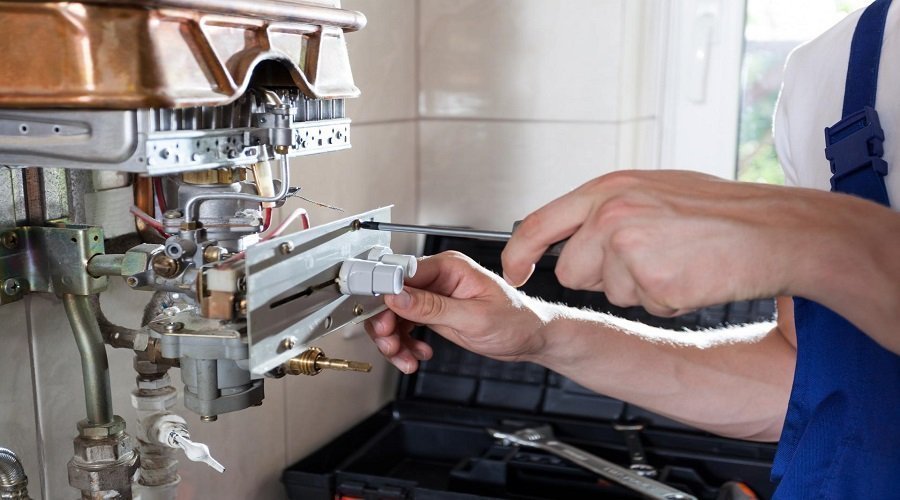
سخانات الغاز تحصد أرواح 15 مصريا

الشرطة تطلق النار لتوقيف متهم في جريمة قتل

حاتم إيدار ينجو من حادثة سير خطيرة قتل خلالها 3 أشخاص

تحطم طائرة حربية تابعة للقوات الملكية الجوية

ملفات ثقيلة على طاولة تحقيق فرقة جديدة للاستخبارات الاقتصادية

هذه هي أحياء المدن الساحلية المغربية التي ستختفي من الوجود حسب وزيرة البيئة نزهة الوافي

اختفاء 160 نوعا من الأدوية

بعد ضمها للمؤسسات العامة.. مدراء 4 مؤسسات سيتم تعيينهم من طرف الملك

البنك الإفريقي للتنمية يوصي المغرب بالابتكار واعتماد التكنولوجيا في الفلاحة

خلق تنسيقية وطنية لتجارة القرب للدفاع عن مصالح التجار وتحديد هوامش الربح

فيلا رئيس الحكومة في قلب الجدل والبوقرعي يدافع عن الفيلات الفخمة لقادة "البيجيدي"

التسبب لشخص في عاهة يجر طبيبا وممرضين وحراس للقضاء

الأمين العام للأمم المتحدة "عطى حمارو" : لا حق لدي بالتحقيق في مقتل خاشقجي

أمطار وثلوج بهذه المناطق من المملكة

تخوفات من تعيينات "اعطيني نعطيك" بوزارة الحقاوي

تفاصيل محاكمة 26 مسؤولا دركيا بينهم 5 كولونيلات في قضية مخدرات

النقابات تهاجم أمزازي و العثماني بسبب الاقتطاعات من الأجور

إغلاق مدارس بالمدينة القديمة بالرباط يتسبب اكتظاظ غير مسبوق

الأمن يفك لغز اختفاء فتاتين قاصرتين من أمام المدرسة

حريق جديد بمحلات تجارية بالدار البيضاء

إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية يروم تنظيم مجال الإعلام الرقمي

النفايات المنزلية .. المغرب استثمر مليارين و400 مليون درهم في مجال تدبير

المحكمة التجارية تصدر قراراً يأذن باستمرار نشاط "لاسامير" لمدة ثلاثة أشهر جديدة

المديرية العامة للأمن الوطني..نظام معلوماتي جديد لاستخلاص الغرامات المرورية

الحكومة تستميل رضى الشركات بـ40 مليار درهم

أفتاتي يهاجم ماء العينين ويتهمها بالازدواجية

الـ"ديستي" تطارد شبكة للاختطاف والاحتجاز

جامعات المملكة تتبوأ مراكز متأخر في التعليم العالي

سعد الدين العثماني.. المغرب متأخر في مجال الحكومات الرقمية

الشرطة تحقق في وفاة شاب داخل عيادة طبيب أسنان

الاهتداء إلى مكان تواجد مواطنة صينية كانت موضوع بلاغ بالبحث لفائدة العائلة

البرلمان الألماني يصنف المغرب بلدا آمنا ويؤكد تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

طرفاية..إنقاذ 30 شخصا بعد اصطدام قارب صيد مغربي بأحد الشعاب البحرية

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الكولومبي إثر الاعتداء الإرهابي ببوغوتا

صناعة الغضب

زخات مطرية وثلوج بهذه المناطق

الشيخي يواصل تحطيمه لأرقام السفريات

هكذا دفعت إشاعة توزيع الأراضي السلالية الآلاف للتوافد على العمالات

هذا ما قضت به المحكمة في حق أسامة الخليفي الذي دعا لقتل قادة "البيجيدي"

الفرقة الوطنية تستجوب عامل بنمسيك لهذا السبب
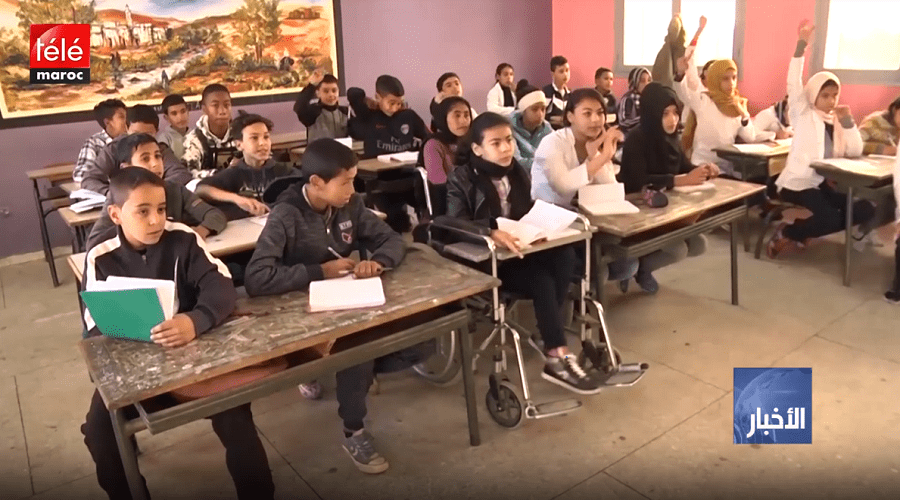
تحصيل التلاميذ المغاربة يندرج ضمن خانة المستوى المنخفض

إحباط نحو 89 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية بالمغرب خلال سنة 2018

الدولة كخصم

الحموشي ينوه بضابط أمن ممتاز رفض تسلم رشوة

تفاصيل اعتقال مدرب كرة قدم بمراكش للاشتباه في اغتصابه قاصرا

أنس الدكالي يعتمد خطة جديدة لـ"إعادة النظر" في منظومة الصحة

الخلفي .. موقع البوابة الوطنية لتلقي الشكايات استقبل 80 ألف شكاية

حكومة العثماني تصادق على مشروع مرسوم يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

إصدار مذكرة توضيحية حول رقم التعريف الموحد للمقاولة

الجزائر تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

عمادة كلية الحقوق أكدال تشعل الخلاف بين أمزازي و"البيجيدي"

تفاصيل العثور على فتاة محتجزة بإسطبل للبهائم لأزيد من 20 سنة

لهذا أعاد بنشماش برلمانيا من المطار

برلمانيون تائهون في برلمان إفريقيا

البرنامج الاستعجالي تحت رحمة الشرطة القضائية

بعدما خسرت المعركة.. "البوليساريو" تهاجم البرلمان الأوروبي

الملك محمد السادس يستقبل فيديريكا موغيريني

الحكومة تصادق على مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

لفتيت يتباحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن

وزارة الصحة .. التكفل بأكثر من 27 ألف حالة إدمان خلال 7 سنوات

"لارام" تلغي رحلاتها إلى تونس لهذا السبب

مجلس المسشارين يضع مؤسسات عمومية في "الدلالة"

سفارة الصين تشارك ثلاث مدن مغربية احتفالات عيد الربيع الصيني

بنكيران يتمتع بمعاش قدره 9 ملايين في الشهر و"ضارب الطم"
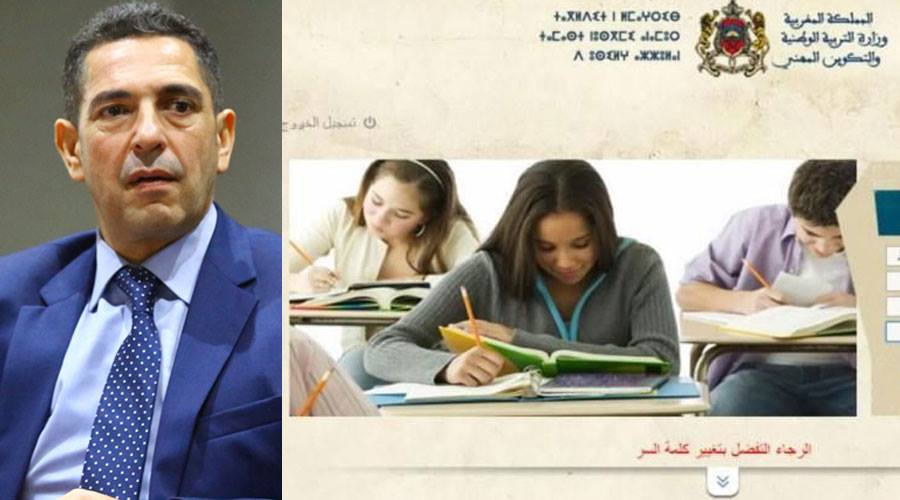
عُطْل "مسار" يربك الموسم الدراسي
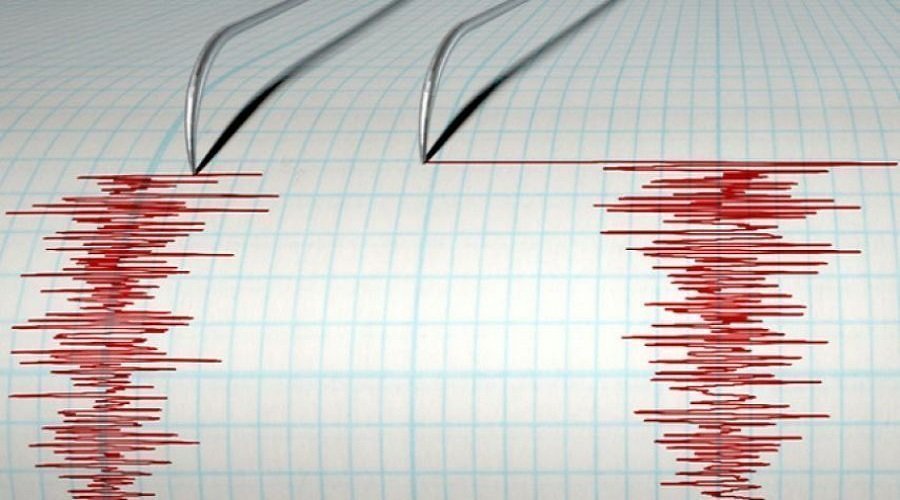
هزة أرضية تضرب إقليم الدريوش صباح اليوم

هذا برنامج رحلات القطارات بمناسبة العطلة المدرسية

مجلس بنشماش يطبق بشكل ملتو مسطرة ضبط الغياب

هكذا تهدد حافلات "مدينة بيس" حياة البيضاويين (صور)

العماري يرفض الاستقالة من البرلمان

وزير سابق مطلوب للشهادة في دعوى رئيس اتحاد الكتاب

تفاصيل توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة

أغرب حركة احتجاجية في العالم... مغاربة يحرثون شارعا ويزعون به البطاطس

سكان الدار البيضاء يقومون بإجراء 7.8 مليون من التنقلات يوميا

وزارة الداخلية ترفض مقترح النقابات بالزيادة في الأجور بقدر يصل إلى 600 درهم

موغيريني تحل بالرباط اليوم في زيارة للمملكة تمتد ليومين

الخارجية: أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن توقيعه إلا من طرف المغرب

احتراق حافلة ثانية لـ "نقل المدينة" بالبيضاء والشرطة العلمية تحقق

امرأة تحاول تصفية قائد حرقا بالنواصر

الاتحاد الأوروبي يصادق بالأغلبية على الإتفاق الفلاحي مع المغرب

هجرة الأدمغة ..600 مهندس يغادرون المغرب سنويا

بعد اعتقال مستشار متلبسا بالرشوة داخل حانة.. اتهامات خطيرة بين أعضاء "البيجيدي"

الجمارك للتجار ... بضاعتكم ردت إليكم

تلميذة تصفع رئيسة خلية الإنصات بإعدادية بالخميسات

الحكومة تخصص 17 مليار درهم لمحاربة الفوارق الاجتماعية في 2019

اتفاق أولي ينهي أزمة التجار والفوترة الجديد

هند العشابي تستعد بعد السجن للعودة للصحافة

فرمان من بنكيران

الأزمي وراء إزاحة ماء العينين من الرئاسة

زيارة الملك محمد السادس تستنفر سلطات البيضاء

بالصور.. هذه حصيلة حريق سوق الجملة بالدار البيضاء

هل حصل بنكيران على تقاعد استثنائي ؟

نهر من الشوكولاتة يُغرق ولاية أميركية

الخطيب المعزول بسبب "بابا نويل" يشرح سبب توقيفه ويوجه رسالة للتوفيق

هذا موعد الشروع في استغلال الخط الثاني لترامواي الرباط

فيديو احتجاز شخص وتعريضه للعنف.. الشرطة القضائية تدخل على الخط

اعتداء دموي على استاذ بالجديدة

الأمطار تعود للمملكة ابتداء من الغد بهذه المناطق

"لايف" غير مباشر

الدكالي: تقديم 20 مليون خدمة طبية في إطار نظام المساعدة الطبية راميد

يتيم: الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي في جميع أبعاده

أمزازي ينهي نظام إنجاح التلاميذ بنقطة أقل من المعدل

التحقيق في صفقات للجماعات بقيمة 1500 مليار سنتيم

اللبان .."فياغرا" مغربي يشعل الخليج

ابتدائية الرباط تمنح ممرضتي "الليمون" السراح المؤقت

العثماني يشهر "الفيتو" في وجه بنكيران

الحكومة ترفض القضاء على "لهطة" السياسيين

لهذا وصف بنكيران برلمانييه ومنتخبيه بـ "الأنذال"

كي كنتو وكي وليتو

البيجيدي يطالب بمحاكمة عادلة لحامي الدين امتثالا للقانون ويغفل ذكر اسم ماء العينين

الملك محمد السادس يتفقد عددا من مشاريع برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط

عمر عزيمان يبسط الحصيلة المرحلية لرؤيته 2015-2030 لإصلاح التعليم
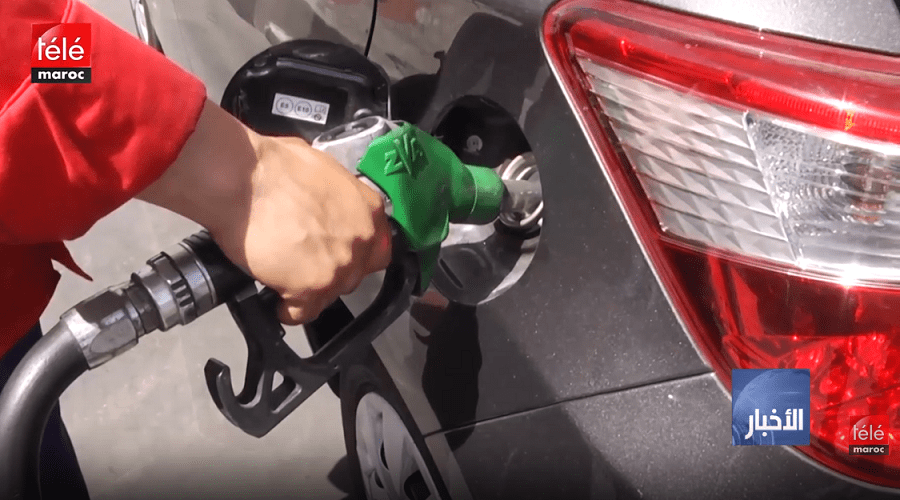
مجلس المنافسة يتدارس تسقيف الأسعار و يرد على الداودي في منتصف فبراير

الشرطة القضائية تحقق في واقعة إضرام شخص للنار في جسده

بعد 3 سنوات من الانتخابات.. مجالس الجماعات تحت مجهر التفتيش

وزارة الخارجية تحقق في اتهام سفير مغربي بالتحرش الجنسي

المغرب جذب استثمارات كبيرة إليه بفضل سياساته الاقتصادية

حزب العدالة و التنمية يرفض إلحاق حامي الدين بالأمانة العامة

وزارة أمزازي تعلن عن إحداث النظام الوطني للطالب المقاول

الشرطة القضائية تحقق في واقعة إضرام شخص للنار في جسده

طائرتا درك وكلاب مدربة وإنزال أمني لإيقاف بارونات مخدرات

قرار للدكالي يصب الزيت على لهيب أزمة المستشفيات العمومية

غاضبون من شباب "البيجيدي" بفاس يلحقون بالأحرار

"البيجيدي" يبني مقرا جديدا له بحي الرياض بـ3 ملايير سنتيم

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتضع المغاربة في صدارة المهاجرين إلى أوروبا

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة

التحقيق مع موظف شرطة بتهمة انتحال صفة وسرقة دراجة نارية

النصب على أطر بوزارة المالية في 13 مليار

رسميا.. التوقيع ببروكسل على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الجيش المغربي يطلق النار على الحدود

مقتل 15 شخصا في تحطم طائرة إيرانية فوق مجمع سكني

عصابة تسطو على سلاح ناري من فيلا باشا

"البيجيدي" يرفض إلحاق حامي الدين بالأمانة العامة

ضربني وبكا

إجراءات تربوية صارمة تنتظر التلاميذ الذين يصورون داخل فصول الدراسة

الدار البيضاء.. بعد تهديدهم بإغراق المدينة في النفايات، السلطات المحلية تجتمع مع عمال النظافة

موظفان بفرقة الشرطة القضائية يضطران لإشهار أسلحتهما الوظيفية لتوقيف أحد الأشخاص

دواعش الناظور خططوا لاستهداف الدرك والأمن

"الكمّايا" ينعشون الحكومة بـ1080 مليار

كولونيل وكومندار أمام المحكمة العسكرية بتهمة اختلاس 800 مليون

بعد تعرضه لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لعبد الهادي بلخياط

إحالة 4 أشخاص ضمنهم 3 قاصرين على النيابة العامة بتهمة سرقة منزل مهاجر مغربي

سيدة تقتل زوجها رميا بالرصاص

فيديو.. هذه حقيقة الفئران فوق الأغذية بالمركز التجاري "كارفور"

الأعرج يدعو مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف

15 ألف مدير بوزارة التربية الوطنية يلوحون بالاستقالة الجماعية

النقابات التعليمية تلوح بالتصعيد ووزارة أمزازي تتوعد المضربين بالاقتطاع

العيون..توقيف ستة أشخاص يسطون على محلات تجارية
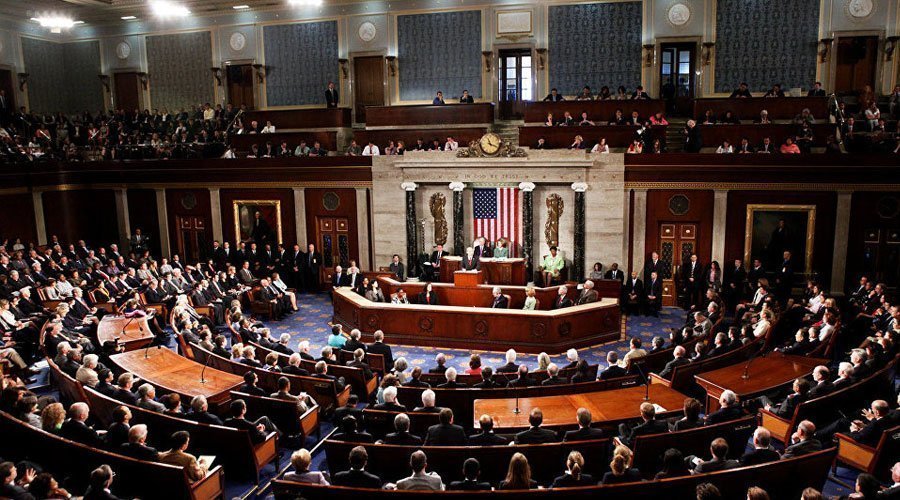
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإعادة فتح بعض الوكالات الاتحادية

إقبال مكثف على مقاطعات بالرباط واتهامات لموظفين بالتقاعس في أداء عملهم

فرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية غير صحيح

الحكومة تحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين

فاعلون سياسيون صحراويون يدعون إلى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري

السجن لـ 12 عسكريا و 6 "حمالة" في قضية تهريب طنين من المخدرات

يتيم يفتح باب هجرة أساتذة التعليم نحو قطر

"البيجيدي" يخوض حربا على أمزازي

انقسامات "البام" تصل إلى القضاء

لاوجود لكتاب مدرسي مصادق عليه يتضمن خريطة بدون اسم فلسطين

المغاربة أنهوا سنة 2018 بكثير من التشاؤم حول الخدمات الإدارية والتعليم والصحة
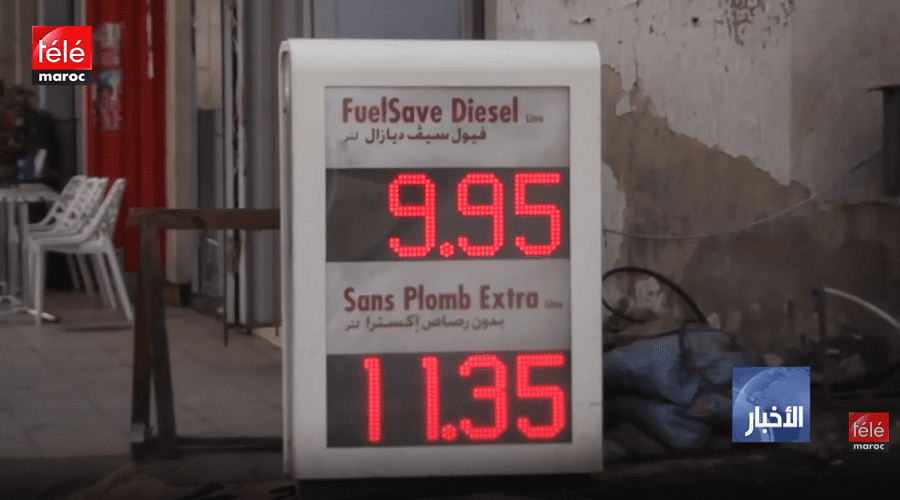
مجلس المنافسة يعقد مشاورات مع الفاعلين من أجل إعداد جواب بخصوص تسقيف الأسعار

الجامعات المغربية تغيب عن قائمة "يوني رانك" لأفضل الجامعات عبر العالم
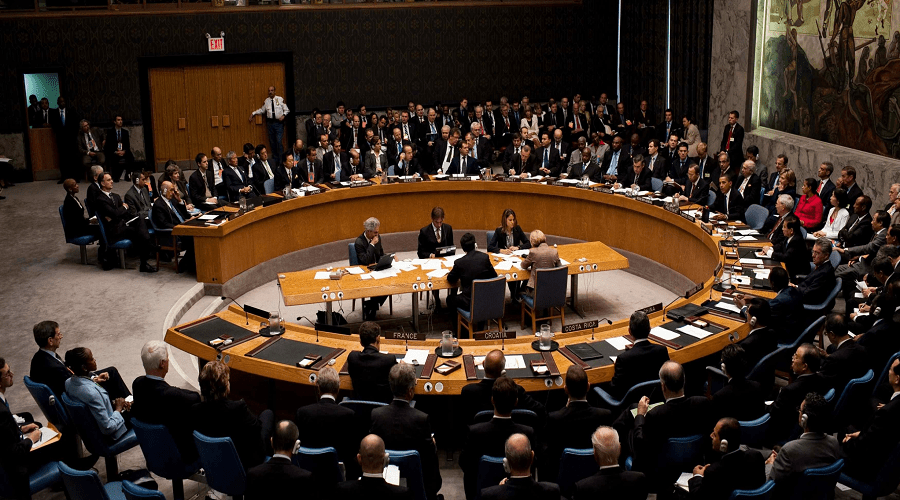
المغرب يطلع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات "البوليساريو"

المغرب يطلع مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة على انتهاكات "البوليساريو"

93 في المائة من المغاربة لاحظوا تدهور المناخ و مستعدون للحد من السيارات

أخنوش يلتقي الفدرالية البيمهنية للحوامض لتدارس مستجدات سلسلة القطاع بالمغرب

أخنوش يتفقد مشاريع الري و انتاج العنب و الزيتون بجهة الشرق

الاتحاد الأوروبي يؤكد بأن المغرب استفاد من دعم بقيمة 140 مليون أورو

عمدة مدينة ورئيس ديوان شبح

صحافة التنجيم الإلكتروني

الحكومة ترضخ لاحتجاجات التجار و توقيف الإجراءات الضريبية

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. إيداع الجداول التعديلية رهن إشارة العموم من 10 إلى 17 يناير

البرلمان الأوربي يصوت على اتفاق الصيد البحري مع المغرب في 16 يناير

بوريطة يستقبل مبعوثا للرئيس التونسي حاملا رسالة إلى الملك

بوريطة يستقبل مبعوثا للرئيس التونسي حاملا رسالة إلى الملك

"كولونيلات" بالدرك أمام جنايات الأموال

وزير الداخلية الإيطالي يدعو إلى "ربيع أوروبي" بقيادة بولندا وإيطاليا

وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل الحرب على "داعش" رغم الانسحاب من سورية

في محاولة لامتصاص غضب التجار.. العثماني يعلن وقف الإجراءات الضريبية "مؤقتا"

مطالب بمنع التصوير داخل الأقسام و عدم التسرع في إدانة الأساتذة

الحكومة تحاول إخماد غضب التجار الرافضين لإجراءات فرض نظام الفوترة

برلمان راسي يا راسي

لا جنود مغاربة في الغابون

التوفيق يعزل 116 إماما في 2018

مراحيض عمومية الكترونية للبيضاويين بـ6 ملايير سنتيم

أملاك الدارالبيضاء في المزاد

تدهور المستوى المعيشي ل41 في المائة من الأسر المغربية وارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكثر من 81 في المائة من الأسر المغربية عاجزة عن الادخار

هذا ما قاله بنكيران لماء العينين عن صورها الباريسية

اختلالات البرنامج الاستعجالي تصل إلى مكتب عبد النباوي

الخلفي يقبر مقترحا لتأسيس الجمعيات

الاستقلال يطالب بتحويل أموال الفنادق لتسديد تقاعد البرلمانيين

بنشماش يدعم غياب البرلمانيين برفضه تطبيق القانون

ديسك حافي

مديرية الحموشي تكشف كمية المخدرات المحجوزة أمس الأربعاء بطنجة

ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأحنبية المباشرة بأزيد من 36 في المائة نهاية نونبر 2018

الاتجار في البشر..السلطات المغربية أبلغت عن عشرين جريمة عام 2017

توقع تراجع معدل النمو بالمغرب إلى 2.9 في المائة خلال 2019

تأخر الأمطار كابوس يؤرق الفلاحين بجماعة سيدي بنحمدون ببرشيد

80 في المائة من المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار الكهرباء

نشرة خاصة.. جو بارد وانخفاض كبير في درجة الحرارة بهذه المناطق

حزب الصالونات

المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالخدمة العسكرية والمراكز الجهوية للاستثمار

الأطباء يلتحفون الأسود و يتوعدون الوزارة بمزيد من التصعيد ابتداء من بداية فبراير

القوات المسلحة تطلق النار بكلثة زمور لهذا السبب

الأدوية تتصدر قائمة المواد المسببة لتسمم المغاربة

التحقيق في تلاعبات بصفقات كلفت وزارة التعليم 50 مليار سنتيم

إيقاف سجين محكوم بـ 10 سنوات أفرج عنه بالخطأ

الداخلية تتابع 16 رئيس جماعة أمام القضاء

مفتشية وزارة العدل تستمع لموظفين في ملف "مافيا" العقار بالبيضاء

فضيحة بوكالة يرأسها المستشار الاقتصادي لبنكيران

بنشماش غير مرغوب فيه

بعد دعمها من نجوم ومشاهير.. تخفيف عقوبة المؤبد لشابة أمريكية

تقاعد البرلمانيين يعود إلى الواجهة

صور ماء العينين تقسم وزراء "البيجيدي"

واجب وطني

موظفو الجماعة عن غضبهم من الاقتطاعات المفاجئة التي وصلت إلى 600 درهما

مباشرة بعد اختيار مصر لتنظيم "الكان".. "بين سبورت" توقف بث قنواتها بمصر

مديرية الضرائب توضح: هؤلاء هم المعنيون بنظام الفوترة الجديد

رئيس جماعة أمام جرائم الأموال بتهم الرشوة وتبديد أموال عمومية والتزوير

في الحاجة للنضج

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعد بإصدار جواز سفر إفريقي موحد

العثماني: المغرب أول مصدر للسيارات في لإفريقيا وسيتجاوز إيطاليا

العثماني ينفي الزيادات في الأسعار و يؤكد أن حكومته تدعم القدرة الشرائية للمغاربة

العدوي تفتحص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بعد رصد تحركات مريبة لـ "البوليساريو".. الجيش المغربي يجري مناورات عسكرية بالصحراء

لعنة "الدولة البوليسية" تتعقب بنعزوز

بعد فضيحة الصور.. بنكيران غاضب من أمينة ماء العينين

إغلاق MFM أطلس يسائل حكماء "الهاكا"

عائلة آيت الجيد تضع شكاية ضد الريسوني

تفاصيل تفكيك خلية ارهابية خططت لتنفيذ عمليات بالعبوات الناسفة والسموم

"السترات الصفر" تحتج على بوانو بمكناس

البسيج يفكك خلية إرهابية ويعتقل ثلاثة دواعش

مكتب الصرف يقوم بنشر نظام التصريحات البنكية وحزمة بيانات الفاعلين

عزيمان يقر بأن المغرب مازال بعيدا عن تمتيع الأطفال في وضعية إعاقة بالحق في التمدرس

المغرب وسلطنة عمان.. تمسك بالعمل العربي القائم على التعاون وحسن الجوار

الأمطار تعود للمملكة ابتداء من هذا التاريخ

هكذا أشعلت سياسات حكومة العثماني نيران الاحتجاجات

تبادل إطلاق النار بين الدرك وتجار مخدرات بضواحي القنيطرة

الداخلية تطلق طلبات عروض لتمويل مشاريع مخصصة لتشجيع تمثيلية المرأة المغربية

الداخلية والمالية تحاصران التلاعبات في صفقات الجماعات الترابية

مكتب الصرف يعلن الحرب على تهريب الأموال والممتلكات للخارج

اخشيشن يبحث عن الحماية السياسية
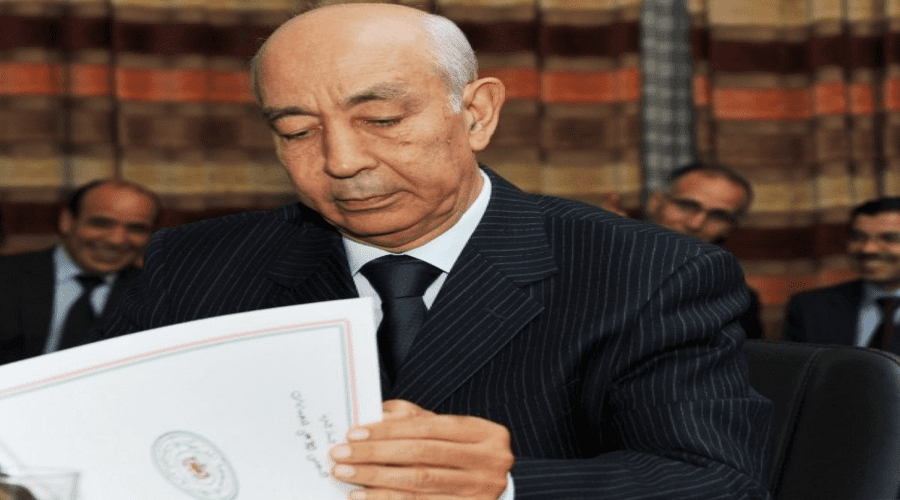
مجلس جطو يكشف اختلالات داخل صندوق الإيداع والتدبير

صفقات بنعيسي مع "البام" وإلياس

الضرائب تحصد أزيد من 158 مليار سنتيم

الرميد يرتق بكارته الحزبية

النفطيون المغاربة يؤكدون عدم معارضتهم قرار الحكومة "تسقيف" أسعار المحروقات

النصب في صفقات نقل بـ13 مليار سنتيم

سقوط عصابة بيع الرضع

بعد صورة le moulin rouge صورة جديدة لماء العينين بساحة Vendôme

خطاب مزدوج

مصالح الأمن تحجز أزيد من 13 طنا من مخدر الحشيش بميناء طنجة المتوسط

الحموشي يعاقب 4 أمنيين في قضية "مثلي مراكش"

فضائح ماستر بجامعة ابن زهر تورط وزارة التعليم العالي

مكتب الصرف يتابع مصدّرين هربوا 250 مليارا

غرامات ثقيلة في انتظار 4500 موقعا إلكترونيا

بمؤازة جمعية حقوقية.. مثلي مراكش يقاضي مسؤولين أمنيين

أستاذة تتعرض لهجوم بالسلاح الأبيض وسط القسم وتصاب بجروح خطيرة

إلباييس: الدعم الإضافي الذي طالب به المغرب إسبانيا يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار

الداودي يمهل مجلس المنافسة شهرا لإبداء رأيه في تسقيف المحروقات

طنجة.. حجز 13 طنا و750 كيلوغراما من مخدر الحشيش

العدوي تحيل ملفات فساد مدراء مؤسسات ورؤساء جماعات على القضاء

المغاربة يصرفون 17 مليار سنتيم على أدوية الاكتئاب

بوريطة يترأس مع نظيره العماني أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية-العمانية المشتركة

ثلاثة إجراءات جديدة بالنسبة للضريبة السنوية على العربات

الإدارة تنفي ادعاءات دخول سجين معتقل في إطار ملف أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام

المغرب يحتل الرتبة الثالثة كأفضل دولة ملائمة للاستثمار في إفريقيا

ملفات فساد داخل مؤسسات عمومية على طاولة محاكم جرائم الأموال

الهاكا تنذر "دوزيم" و"ميدي 1 تيفي" و"مدينة إف إم" لهذا السبب

العاصفة "بابوك" تقتلع الأشجار وأسطح المباني وتودي بحياة شخص

الحكومة تحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

العثماني يعلن عن قرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الداخلية تدخل على الخط وتدعو زعماء النقابات لاجتماع عاجل

الخيام: لا يمكن التغلب على الإرهاب بدون تعزيز التعاون بين الدول

شرطة طنجة تُوقف فرنسيين متورطين في حيازة والاتجار في المخدرات

مديرية الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة بالنسبة للضريبة السنوية على العربات

تعيينات "عطيني نعطيك" في التكوين المهني

الخيام يكشف معطيات خطيرة عن السويسري المعتقل في قضية ذبح السائحتين الاسكندنافيتين

تباطؤ طفيف في النمو خلال الفصل الأول من عام 2019

مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي تسجل أرقاما استثنائية مع نهاية سنة 2018

لا تأثير لحادث الدار البيضاء الميناء على السير العادي لحركة القطارات
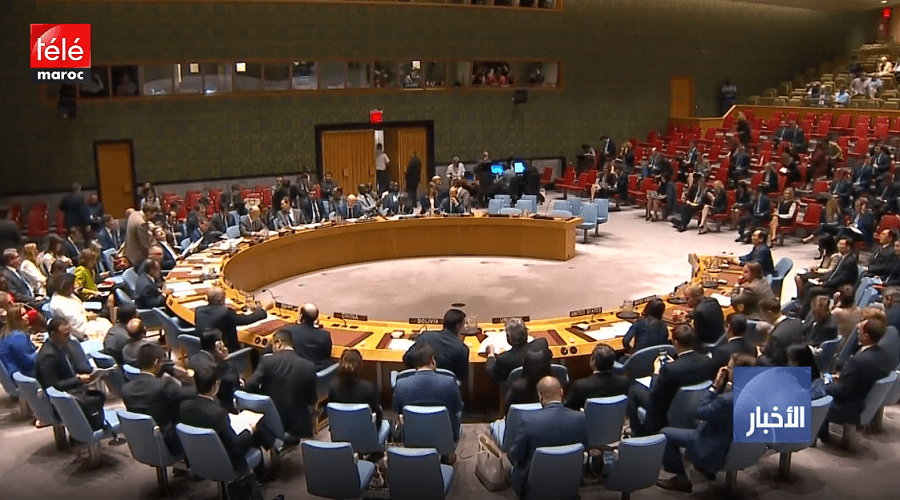
مجلس الأمن يعقد مشاورات جديدة حول تطورات ملف الصحراء المغربية

مديرية الحموشي تكشف حقيقة فيديو يزعم توثيق مقتل طالب جامعي بطنجة

الهاكا تغرّم "دوزيم" و"الأولى" 380 مليونا لهذا السبب

ليالي الأنس في باريس

تطورات جديدة قد تعيد لمجرد إلى السجن

مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة تصل 3 ملايير درهم

حكومة العثماني تقر بفشلها في القضاء على الأكياس البلاستيكية

لهذا ألغت الداخلية مباراة توظيف في مجلس جهة العماري

الخلفي يرد على النقابات بعد إضراب عام شل المؤسسات التعليمية

الخلفي: استفزازات "البوليساريو" شرق المنظومة الدفاعية تصرفات يائسة

هكذا استنفرت حافلة مشبوهة أمن البيضاء ليلة رأس السنة

مكتب السكك الحديدية يكشف اسباب حادث قطار الدار البيضاء

معطيات جديدة عن السويسري المعتقل على خلفية جريمة شمهروش

العثماني يطلق يد مستشاره الخاص

حرب بين ساجد ومصلي والعثماني يتفرج

"البيجيدي" غير مقتنع برئيسة بلدية المحمدية

الأحكام القضائية تستنزف خزينة الدولة بمبالغ تفوق 325 مليارا

عاجل ..انقلاب قطار بالدارالبيضاء

القطريون يتبرعون لخشيشن بـ 200 مليار لبناء جامعة دولية

طنجة..تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

النقابات تتوعد الحكومة بيناير ساخن و تجدد رفضها للعرض الحكومي

العثماني: 2019 ستكون سنة تنفيذ الإصلاحات الكبرى واخراج مجموعة من القوانين

موظفون موضوعون رهن إشارة الجماعات المحلية يستنكرون الاقتطاعات من أجورهم

في أجل 15 يوما تثير غضب المهنيين تصريحات ليتيم حول أداء المستحقات المالية للصيادلة

جريمة شمهروش: إحالة 7 متهمين آخرين بينهم سويسري على قاضي التحقيق

ماء العينين تتوعد مروجي صورتها في باريس بدون حجاب

المغرب المراتب الأولى عالميا من حيث التزامه بالشفافية في سياسته المناخية

أطباء القطاع العام يؤكدون عزمهم مواصلة الاحتجاجات إلى غاية توقيع اتفاق نهائي مع الوزارة

عمال النظافة يخوضون إضرابا عن العمل لمدة يومين للمطالبة بتحسين أوضاعهم

كوكايين الداخلة يورط أربعة أمنيين بطنجة

المصادقة على مقترحي قانون و36 مشروع قانون منذ بداية الدورة التشريعية الحالية

جماعة الدار البيضاء ملزمة بأداء 300 مليار لـ "مدينة بيس"

هكذا ستقتطع الحكومة 14 في المائة من أجور الموظفين

الإعدام والمؤبد لقاتلي أربعيني بعد هتك عرضه بالرباط

جريمة "واد إيفران" تطيح بسائق سيارة أجرة والراعي يواجه تهما ثقيلة

هذه خبايا إلغاء تعيينات مجلس الحكومة الأخير

محامي يحصل على 1.6 مليار كتعويض عن تمثيله لشركة "لاسامير" أمام القضاء

الحموشي يأمر بإجراء بحث لتحديد ملابسات تسريب صور شخص ظهر في مخالفة للقانون بمراكش

تورط مسؤولين كبار في استغلال جنسيات أجنبية لتهريب الثروة

إدارة الضرائب تضع مداخيل 230 جمعية ذات منفعة عام تحت المجهر

الدكالي يسارع باتفاق لطي صفحة الخلاف مع أطباء القطاع العام

الحموشي يخصص مساعدات مالية لعلاج الأمنيين من الأمراض المزمنة

المغاربة يحتلون الصدارة في الهجرة السرية نحو إسبانيا بعد مالي وغينيا

إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال

ارتفاعات صاروخية في أثمنة السجائر و الحكومة تتوقع جني 1100 مليار من جيوب المدخنين

ارتفاع الدرهم بـ 0,12 في المائة أمام الأورو وبـ 0,06 في المائة مقابل الدولار

تدابير جديدة لعمليات صرف العملات ابتداء من منتصف الشهر

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن البلدان التي بها مخاطر منخفضة

الداخلية تكثق حملات التفتيش بمدن مختلفة للتحقيق في محميات الأكياس البلاستيكية

الداخلية تزود المقدمين بكاميرات لرصد بؤر البناء العشوائي

جطو يفتحص جمعيات منفعة عامة تتصرف في 80 مليار سنتيم

العثماني يثمن العلاقات مع البرازيل في حفل تنصيب بولسونارو

المخدرات تورط 16 عسكريا بالحدود

التدخين يقتل أكثر من 17 ألف مغربي سنوياً

الدكالي يسارع باتفاق لطي صفحة الخلاف مع أطباء القطاع العام

بالفيديو.. شابتين تتعرضان للتحرش على الملأ والبوليس السري يتدخل

المدخنون يستقبلون العام الجديد بزيادات صاروخية في أسعار السجائر

بالصور.. هكذا نجحت مديرية الحموشي في تأمين أجواء احتفالات رأس السنة

تنصيب اليميني المتطرف جاير بولسونارو رئيسًا للبرازيل

محطات الوقود تشتكي شركات المحروقات إلى مجلس المنافسة

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة

الملك يهنئ رئيس جمهورية السودان بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها

تفاصيل جديدة عن السويسري المعتقل على خلفية جريمة "شمهروش"

إدارة الضرائب تطارد 230 جمعية ذات منفعة عام

القضاء يحل جمعية "جذور" بسبب "عشاء الأغبياء"

هذا هو تاريخ حسم حكومة العثماني في التوقيت الرسمي للمغرب

ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الانتاج لقطاع الصناعات التحويلية

إجرائات أمنية مشددة ترافق احتفالات رأس السنة بالرباط

ليلة بيضاء للعناصر الأمنية وحجز كيلوغرامات من المخدرات ليلة رأس السنة
